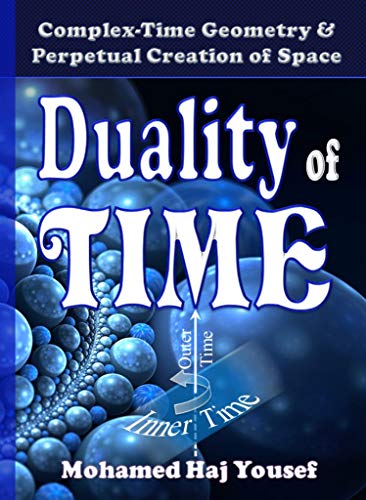المكتبة الأكبرية: القرآن الكريم: سورة البقرة: [الآية 237]
 |
|
 |
| سورة البقرة | ||
|
|
تفسير الجلالين:
تفسير الشيخ محي الدين:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
أصل التكاليف مشتق من الكلف وهي المشقات «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» وهو ما آتاها من التمكن الذي هو وسعها ، فقد خلق سبحانه لنا التمكن من فعل بعض الأعمال ، نجد ذلك من نفوسنا ولا ننكره ، وهي الحركة الاختيارية ، كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ، ونجد ذلك من نفوسنا ، كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها ، وبذلك القدر من التمكن الذي يجده الإنسان في نفسه صح أن يكون مكلفا ، ولا يحقق الإنسان بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن ، هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا ؟ وإن كان مجبورا في اختياره ، ولا يمكن رفع الخلاف في هذه المسألة ، فإنها من المسائل المعقولة ولا يعرف الحق فيها إلا بالكشف ، وإذا بذلت النفس الوسع في طاعة اللّه لم يقم عليها حجة ،
فإن اللّه أجلّ أن يكلف نفسا إلا وسعها ، ولذلك كان الاجتهاد في الفروع والأصول «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» لما كانت النفوس ولاة الحق على الجوارح ، والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه ، مطيعة بكل وجه ، والنفوس ليست كذلك ، فإذا عملت لغير عبادة لا يقبل العمل من حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة ، لكن من حيث أن العمل صدر من الجوارح أو من جارحة مخصوصة ، فإنها تجزى به تلك الجارحة ، فيقبل العمل لمن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة كصلاة المرائي والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة ، وأما أعمال الشر المنهي عنها فإن النفس تجزى بها للقصد ، والجوارح لا تجزى بها لأنها ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات ، فإنها مجبورة على السمع والطاعة لها ، فإن جارت النفوس فعليها ، وللجوارح رفع الحرج ، بل لهم الخير الأتم ، وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح ، لذلك قال تعالى : «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فميز اللّه بين الكسب والاكتساب باللام وعلى ، وهذه الآية بشرى من اللّه حيث جعل المخالفة اكتسابا والطاعة كسبا ، فقال : «لَها ما كَسَبَتْ» فأوجبه لها .
وقال في المعصية والمخالفة : «وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فما أوجب لها الأخذ بما اكتسبته ، فالاكتساب ما هو حق لها فتستحقه ، فتستحق الكسب ولا تستحق الاكتساب ، والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق ، والعفو من اللّه يحكم على الأخذ بالجريمة «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» اعلم أن الرحمة أبطنها اللّه في النسيان الموجود في العالم ، وأنه لو لم يكن لعظم الأمر وشق ، وفيما يقع فيه التذكر كفاية ، وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين اللّه في موطن التكليف ، إذ كانت المعاصي والمخالفات مقدرة في علم اللّه فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة ، فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من اللّه حيث يشهده ويراه ، والقدر حاكم بالوقوع فاحتجب رحمة بالخلق لعظيم المصاب ، قال صلّى اللّه عليه وسلم:
إن اللّه إذا أراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم ، حتى إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، فلا يؤاخذهم اللّه به في الدنيا ولا في الآخرة ، فأما في الآخرة فمجمع عليه من الكل ، وأما في الدنيا فأجمعوا على رفع الذنب ، واختلفوا في الحكم ، وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في
أشخاص المسائل ، مثل الإفطار ناسيا في رمضان وغير ذلك من المسائل ، فإن اللّه تعالى الذي شرع المعصية والطاعة وبيّن حكمهما ، رفع حكم الأخذ بالمعصية في حق الناسي والمخطئ «رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» وهذا تعليم من الحق لنا أن نسأله في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال ، «وَاعْفُ عَنَّا» أي كثر خيرك لنا وقلل بلاءك عنا ، أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكثر ما ينبغي أن يكثر ، فإن العفو من الأضداد يطلق بإزاء الكثرة والقلة ، وليس إلا عفوك عن خطايانا التي طلبنا منك أن تسترنا عنها حتى لا تصيبنا ، وهو قولنا : «وَاغْفِرْ لَنا» أي استرنا من المخالفات حتى لا تعرف مكاننا فتقصدنا «وَارْحَمْنا» برحمة الامتنان ورحمة الوجوب ، أي برحمة الاختصاص.
------------
(286) التنزلات الموصلية - الفتوحات ج 1 / 341 - ج 2 / 381 - ج 3 / 348 ، 123 ، 511 - ج 2 / 535 ، 684 - ج 3 / 381 - ج 1 / 435 ، 434تفسير ابن كثير:
وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض ، وإذا طلق الزوج قبل الدخول ، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة والله أعلم .
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء ، لا خلاف بينهم في ذلك ، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها ، فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق ، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج ، وإن لم يدخل بها ، وهو مذهب الشافعي في القديم ، وبه حكم الخلفاء الراشدون ، لكن قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد ، أخبرنا ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه قال : في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق ; لأن الله يقول : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) قال الشافعي : هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب .
قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به ، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس فهو يقوله .
وقوله : ( إلا أن يعفون ) أي : النساء عما وجب لها على زوجها من النصف ، فلا يجب لها عليه شيء .
قال السدي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله : ( إلا أن يعفون ) قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم ، رحمه الله : وروي عن شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، ومجاهد ، والشعبي ، والحسن ، ونافع ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وعطاء الخراساني ، والضحاك ، والزهري ، ومقاتل بن حيان ، وابن سيرين ، والربيع بن أنس ، والسدي ، نحو ذلك . قال : وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال : ( إلا أن يعفون ) يعني : الرجال ، وهو قول شاذ لم يتابع عليه . انتهى كلامه .
وقوله : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ قال ] : " ولي عقدة النكاح الزوج " .
وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة ، به . وقد أسنده ابن جرير ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره ولم يقل : عن أبيه ، عن جده ، فالله أعلم .
ثم قال ابن أبي حاتم ، رحمه الله : وحدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود ، حدثنا جرير ، يعني ابن حازم ، عن عيسى يعني ابن عاصم قال : سمعت شريحا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت له : هو ولي المرأة . فقال علي : لا بل هو الزوج .
ثم قال : وفي إحدى الروايات عن ابن عباس ، وجبير بن مطعم ، وسعيد بن المسيب ، وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشعبي ، وعكرمة ، ونافع ، ومحمد بن سيرين ، والضحاك ، ومحمد بن كعب القرظي ، وجابر بن زيد ، وأبي مجلز ، والربيع بن أنس ، وإياس بن معاوية ، ومكحول ، ومقاتل بن حيان : أنه الزوج .
قلت : وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ، ومذهب أبي حنيفة . وأصحابه ، والثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، واختاره ابن جرير . ومأخذ هذا القول : أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج ، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها ، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير ، فكذلك في الصداق .
قال : والوجه الثاني : حدثنا أبي ، حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا محمد بن مسلم ، حدثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال : ذلك أبوها أو أخوها ، أو من لا تنكح إلا بإذنه ، وروي عن علقمة ، والحسن ، وعطاء ، وطاوس ، والزهري ، وربيعة ، وزيد بن أسلم ، وإبراهيم النخعي ، وعكرمة في أحد قوليه ، ومحمد بن سيرين في أحد قوليه : أنه الولي . وهذا مذهب مالك ، وقول الشافعي في القديم ; ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه ، فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها .
وقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن الربيع الرازي ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فأي امرأة عفت جاز عفوها ، فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه .
وهذا يقتضي صحة عفو الولي ، وإن كانت رشيدة ، وهو مروي عن شريح . لكن أنكر عليه الشعبي ، فرجع عن ذلك ، وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه .
وقوله : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) قال ابن جرير : قال بعضهم : خوطب به الرجال ، والنساء . حدثني يونس ، أخبرنا ابن وهب ، سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو .
وكذا روي عن الشعبي وغيره ، وقال مجاهد ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، والربيع بن أنس ، والثوري : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها ، أو إتمام الرجل الصداق لها . ولهذا قال : ( ولا تنسوا الفضل [ بينكم ] ) أي : الإحسان ، قاله سعيد . وقال الضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وأبو وائل : المعروف ، يعني : لا تهملوه بل استعملوه بينكم .
وقد قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عبد الله بن عبيد ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على الناس زمان عضوض ، يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل ، وقد قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) شرار يبايعون كل مضطر ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه ، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه " .
وقال سفيان ، عن أبي هارون قال : رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي ، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول : صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما ، حين رأيتهم أحسن ثيابا ، وأطيب ريحا ، وأحسن مركبا [ مني ] . وجالست الفقراء فاسترحت بهم ، وقال : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع له : رواه ابن أبي حاتم .
( إن الله بما تعملون بصير ) أي : لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم ، وسيجزي كل عامل بعمله .
تفسير الطبري :
التفسير الميسّر:
تفسير السعدي
أي: إذا طلقتم النساء قبل المسيس, وبعد فرض المهر, فللمطلقات من المهر المفروض نصفه, ولكم نصفه. هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة, بأن تعفو عن نصفها لزوجها, إذا كان يصح عفوها, { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة, لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو, وأن من عفا, كان أقرب لتقواه, لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر, ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف, وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة, لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب, وهو: أخذ الواجب, وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان, وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق, والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة, ولو في بعض الأوقات, وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة, أو مخالطة, فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }.
تفسير البغوي
وقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض وإن مات أحدهما قبل المسيس فلها كمال المهر المفروض والمراد بالمس المذكور في الآية : الجماع واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ولم يوجب العدة وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وبه قال الشافعي رحمه الله .
وقال قوم : يجب لها كمال المهر وعليها العدة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ومثله عن زيد بن ثابت وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن " ( 49 - الأحزاب ) فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخت بهذه الآية وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها .
وقوله تعالى ( وقد فرضتم لهن فريضة ) أي سميتم لهن مهرا ( فنصف ما فرضتم ) أي لها نصف المهر المسمى ( إلا أن يعفون ) يعني النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج .
قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) اختلفوا فيه : فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه : إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها وقال بعضهم : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهو قول علي وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة وقالوا : لا يجوز لوليها ترك الشيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها وقالوا : معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق فعلى هذا التأويل وجه الآية : الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) موضعه رفع بالابتداء أي فالعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى والخطاب للرجال والنساء جميعا لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه : وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها حثهما جميعا على الإحسان ( إن الله بما تعملون بصير ) .
الإعراب:
(وَإِنْ) الواو عاطفة (إِنْ) شرطية جازمة (طَلَّقْتُمُوهُنَّ) فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به وحركت الميم بالضم للإشباع، وهو فعل الشرط (مِنْ قَبْلِ) متعلقان بالفعل قبلهما (أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل جر بالإضافة.
(وَقَدْ) الواو حالية قد حرف تحقيق (فَرَضْتُمْ) فعل وفاعل (لَهُنَّ) متعلقان بفرضتم (فَرِيضَةً) مفعول به (فَنِصْفُ) الفاء رابطة لجواب الشرط نصف خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب نصف أو مبتدأ والتقدير فعليكم نصف والجملة في محل جزم جواب الشرط.
(ما فَرَضْتُمْ) ما اسم موصول في محل جر بالإضافة، والجملة صلة الموصول (إِلَّا) أداة حصر أو استثناء (إِنْ) حرف مصدري ونصب (يَعْفُونَ) مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل والمصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال والتقدير: فنصف ما فرضتم إلا حال عفوهن (أَوْ) حرف عطف (يَعْفُوَا) فعل مضارع منصوب بالفتحة معطوف (الَّذِي) اسم موصول فاعل (بِيَدِهِ) متعلقان بمحذوف خبر (عُقْدَةُ) مبتدأ مؤخر (النِّكاحِ) مضاف إليه والجملة صلة الموصول (وَإِنْ) الواو استئنافية (أَنْ تَعْفُوا) المصدر المؤول من الفعل وأن الناصبة في محل رفع مبتدأ تقديره: والعفو.
(أَقْرَبُ) خبر (لِلتَّقْوى) متعلقان بأقرب (وَلا تَنْسَوُا) الواو عاطفة لا ناهية جازمة تنسوا فعل مضارع مجزوم والواو فاعل (الْفَضْلَ) مفعول به (بَيْنَكُمْ) ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من الفضل والجملة معطوفة.
(إِنَّ اللَّهَ) إن ولفظ الجلالة اسمها (بَصِيرٌ) خبرها (بِما) متعلقان ببصير، وجملة (تَعْمَلُونَ) صلة الموصول وجملة (إِنَّ اللَّهَ) تعليلية لا محل لها.