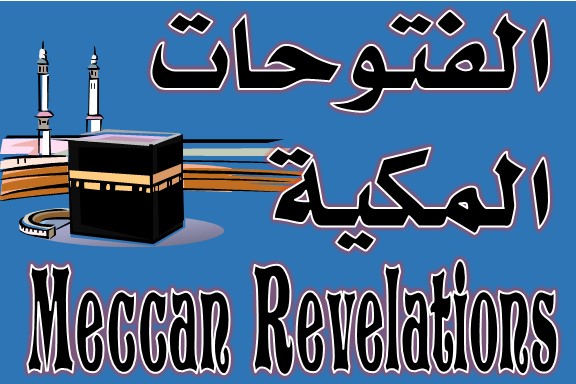المكتبة الأكبرية: القرآن الكريم: سورة البقرة: [الآية 83]
 |
|
 |
| سورة البقرة | ||
|
|
تفسير الجلالين:
تفسير الشيخ محي الدين:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (286)
أصل التكاليف مشتق من الكلف وهي المشقات «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» وهو ما آتاها من التمكن الذي هو وسعها ، فقد خلق سبحانه لنا التمكن من فعل بعض الأعمال ، نجد ذلك من نفوسنا ولا ننكره ، وهي الحركة الاختيارية ، كما جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ، ونجد ذلك من نفوسنا ، كحركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فيها ، وبذلك القدر من التمكن الذي يجده الإنسان في نفسه صح أن يكون مكلفا ، ولا يحقق الإنسان بعقله لما ذا يرجع ذلك التمكن ، هل لكونه قادرا أو لكونه مختارا ؟ وإن كان مجبورا في اختياره ، ولا يمكن رفع الخلاف في هذه المسألة ، فإنها من المسائل المعقولة ولا يعرف الحق فيها إلا بالكشف ، وإذا بذلت النفس الوسع في طاعة اللّه لم يقم عليها حجة ،
فإن اللّه أجلّ أن يكلف نفسا إلا وسعها ، ولذلك كان الاجتهاد في الفروع والأصول «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» لما كانت النفوس ولاة الحق على الجوارح ، والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه ، مطيعة بكل وجه ، والنفوس ليست كذلك ، فإذا عملت لغير عبادة لا يقبل العمل من حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة ، لكن من حيث أن العمل صدر من الجوارح أو من جارحة مخصوصة ، فإنها تجزى به تلك الجارحة ، فيقبل العمل لمن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة كصلاة المرائي والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة ، وأما أعمال الشر المنهي عنها فإن النفس تجزى بها للقصد ، والجوارح لا تجزى بها لأنها ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات ، فإنها مجبورة على السمع والطاعة لها ، فإن جارت النفوس فعليها ، وللجوارح رفع الحرج ، بل لهم الخير الأتم ، وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح ، لذلك قال تعالى : «لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فميز اللّه بين الكسب والاكتساب باللام وعلى ، وهذه الآية بشرى من اللّه حيث جعل المخالفة اكتسابا والطاعة كسبا ، فقال : «لَها ما كَسَبَتْ» فأوجبه لها .
وقال في المعصية والمخالفة : «وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ» فما أوجب لها الأخذ بما اكتسبته ، فالاكتساب ما هو حق لها فتستحقه ، فتستحق الكسب ولا تستحق الاكتساب ، والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق ، والعفو من اللّه يحكم على الأخذ بالجريمة «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا» اعلم أن الرحمة أبطنها اللّه في النسيان الموجود في العالم ، وأنه لو لم يكن لعظم الأمر وشق ، وفيما يقع فيه التذكر كفاية ، وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم وبين اللّه في موطن التكليف ، إذ كانت المعاصي والمخالفات مقدرة في علم اللّه فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة ، فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من اللّه حيث يشهده ويراه ، والقدر حاكم بالوقوع فاحتجب رحمة بالخلق لعظيم المصاب ، قال صلّى اللّه عليه وسلم:
إن اللّه إذا أراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم ، حتى إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، فلا يؤاخذهم اللّه به في الدنيا ولا في الآخرة ، فأما في الآخرة فمجمع عليه من الكل ، وأما في الدنيا فأجمعوا على رفع الذنب ، واختلفوا في الحكم ، وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في
أشخاص المسائل ، مثل الإفطار ناسيا في رمضان وغير ذلك من المسائل ، فإن اللّه تعالى الذي شرع المعصية والطاعة وبيّن حكمهما ، رفع حكم الأخذ بالمعصية في حق الناسي والمخطئ «رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ، رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ» وهذا تعليم من الحق لنا أن نسأله في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال ، «وَاعْفُ عَنَّا» أي كثر خيرك لنا وقلل بلاءك عنا ، أي قلل ما ينبغي أن يقلل وكثر ما ينبغي أن يكثر ، فإن العفو من الأضداد يطلق بإزاء الكثرة والقلة ، وليس إلا عفوك عن خطايانا التي طلبنا منك أن تسترنا عنها حتى لا تصيبنا ، وهو قولنا : «وَاغْفِرْ لَنا» أي استرنا من المخالفات حتى لا تعرف مكاننا فتقصدنا «وَارْحَمْنا» برحمة الامتنان ورحمة الوجوب ، أي برحمة الاختصاص.
------------
(286) التنزلات الموصلية - الفتوحات ج 1 / 341 - ج 2 / 381 - ج 3 / 348 ، 123 ، 511 - ج 2 / 535 ، 684 - ج 3 / 381 - ج 1 / 435 ، 434تفسير ابن كثير:
ذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر ، وأخذ ميثاقهم على ذلك ، وأنهم تولوا عن ذلك كله ، وأعرضوا قصدا وعمدا ، وهم يعرفونه ويذكرونه ، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . وبهذا أمر جميع خلقه ، ولذلك خلقهم كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) [ الأنبياء : 25 ] وقال تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) [ النحل : 36 ] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها ، وهو حق الله تعالى ، أن يعبد وحده لا شريك له ، ثم بعده حق المخلوقين ، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين ، كما قال تعالى : ( أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ) [ لقمان : 14 ] وقال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) الآية إلى أن قال : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) [ الإسراء : 23 - 26 ] وفي الصحيحين ، عن ابن مسعود ، قلت : يا رسول الله ، أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة على وقتها " . قلت : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " . قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : " أمك " . قال : ثم من ؟ قال : " أمك " . قال : ثم من ؟ قال : " أباك . ثم أدناك أدناك " .
[ وقوله : ( لا تعبدون إلا الله ) قال الزمخشري : خبر بمعنى الطلب ، وهو آكد . وقيل : كان أصله : ألا تعبدوا كما قرأها بعض السلف فحذفت أن فارتفع ، وحكي عن أبي وابن مسعود ، رضي الله عنهما ، أنهما قرآها : " لا تعبدوا إلا الله " . وقيل : ( لا تعبدون ) مرفوع على أنه قسم ، أي : والله لا تعبدون إلا الله ، ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . وقال : اختاره المبرد والكسائي والفراء ] .
قال : ( واليتامى ) وهم : الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء . [ وقال أهل اللغة : اليتيم في بني آدم من الآباء ، وفي البهائم من الأم ، وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا ] ( والمساكين ) الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم ، وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء ، التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ) الآية [ النساء : 36 ] .
وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا ، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف ، كما قال الحسن البصري في قوله : ( وقولوا للناس حسنا ) فالحسن من القول : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويحلم ، ويعفو ، ويصفح ، ويقول للناس حسنا كما قال الله ، وهو كل خلق حسن رضيه الله .
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح ، حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تحقرن من المعروف شيئا ، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق " .
وأخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي [ وصححه ] من حديث أبي عامر الخزاز ، واسمه صالح بن رستم ، به .
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا ، بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل ، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك ، وهو الصلاة والزكاة ، فقال : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله ، أي : تركوه وراء ظهورهم ، وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به ، إلا القليل منهم ، وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء ، بقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) [ النساء : 36 ]
فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ، ولله الحمد والمنة .
ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره :
حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ، حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن صبيح ، عن حميد بن عقبة ، عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه ، فقيل له : ما شأنك ؟ تسلم على اليهودي والنصراني . فقال : إن الله يقول : ( وقولوا للناس حسنا ) وهو : السلام . قال : وروي عن عطاء الخراساني ، نحوه .
قلت : وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام ، والله أعلم .
تفسير الطبري :
التفسير الميسّر:
تفسير السعدي
وهذه الشرائع من أصول الدين, التي أمر الله بها في كل شريعة, لاشتمالها على المصالح العامة, في كل زمان ومكان, فلا يدخلها نسخ, كأصل الدين، ولهذا أمرنا بها في قوله: { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا } إلى آخر الآية. فقوله: { وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ } هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به, استعصوا؛ فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة, والعهود الموثقة { لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ } هذا أمر بعبادة الله وحده, ونهى عن الشرك به، وهذا أصل الدين, فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها, فهذا حق الله تعالى على عباده, ثم قال: { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } أي: أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين, أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان, والأمر بالشيء نهي عن ضده. وللإحسان ضدان: الإساءة, وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة, وهذا محرم, لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى, والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد, بل تكون بالحد, كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا } ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكر, وتعليمهم العلم, وبذل السلام, والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله, أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق, وهو الإحسان بالقول, فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار, ولهذا قال تعالى: { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده, أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله, غير فاحش ولا بذيء, ولا شاتم, ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق, واسع الحلم, مجاملا لكل أحد, صبورا على ما يناله من أذى الخلق, امتثالا لأمر الله, ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. { ثُمَّ } بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل, عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها,, وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم { تَوَلَّيْتُمْ } على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى, وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: { إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ } هذا استثناء, لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم, عصمهم الله وثبتهم.
تفسير البغوي
قوله تعالى: {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل} في التوراة، والميثاق العهد الشديد.
{لا تعبدون إلا الله} قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (لا يعبدون) بالياء وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى: {وقولوا للناس حسناً} معناه ألا تعبدوا فلما حذف أن صار الفعل مرفوعاً، وقرأ أُبي بن كعب: "لا تعبدوا إلا الله على النهي".
{وبالوالدين إحساناً} أي ووصيناهم بالوالدين إحساناً، براً بهما وعطفاً عليهما ونزولاً عند أمرهما، فيما لا يخالف أمر الله تعالى.
{وذي القربى} أي وبذي القرابة، والقربى مصدر كالحسنى.
{واليتامى} جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له.
{والمساكين} يعني الفقراء.
{وقولوا للناس حسناً} "صدقاً وحقاً في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولاتكتموا أمره" هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج ومقاتل.
وقال سفيان الثوري: "مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر.
وقيل: هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق.
وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: حسناً بفتح الحاء والسين أي قولاً حسناً.
{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم} أعرضتم عن العهد والميثاق.
{إلا قليلاً منكم} وذلك أن قوماً منهم آمنوا.
{وأنتم معرضون} كإعراض آبائكم.
الإعراب:
(وَإِذْ) إذ ظرف زمان متعلق بفعل محذوف تقديره اذكر يا محمد أو اذكروا يا بني إسرائيل.
(أَخَذْنا) فعل ماض وفاعل.
(مِيثاقَ) مفعول به.
(بَنِي) مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
(إِسْرائِيلَ) مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة اسم علم أعجمي. وجملة: (أخذنا) في محل جر بالإضافة.
(لا تَعْبُدُونَ) لا نافية لا محل لها تعبدون فعل مضارع وفاعل.
(إِلَّا) أداة حصر.
(اللَّهَ) لفظ الجلالة مفعول به.
(وَبِالْوالِدَيْنِ) الواو عاطفة الباء حرف جر الوالدين اسم مجرور بالياء؛ لأنه مثنى. والجار والمجرور متعلقان بالفعل المحذوف وأحسنوا. وجملة: (لا تعبدون) مقول القول لفعل محذوف تقديره قلنا لا تعبدون والنفي هنا للنهي. والجملة معطوفة على جملة لا تعبدون.
(إِحْسانًا) مفعول مطلق لفعل محذوف.
(وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ) أسماء معطوفة، ذي اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة.
(وَقُولُوا) الواو عاطفة، قولوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة معطوفة على جملة أحسنوا المحذوفة.
(لِلنَّاسِ) متعلقان بقولوا.
(حُسْنًا) صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره قولوا قولا ذا حسن. أو قولا حسنا.
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) الجملة معطوفة.
(وَآتُوا) فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعله.
(الزَّكاةَ) مفعول به.
(ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ) والجملة معطوفة على جملة مقدرة محذوفة أي قبلتم ثم توليتم.
(إِلَّا) أداة استثناء.
(قَلِيلًا) مستثنى منصوب.
(مِنْكُمْ) متعلقان بقليل.
(وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) الواو حالية أنتم مبتدأ معرضون خبر والجملة حالية.