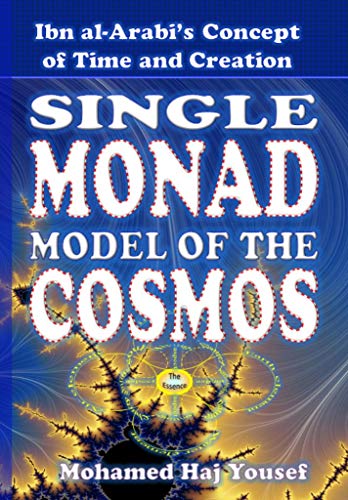كتاب جواهر النصوص
في حل كلمات الفصوص
تأليف: الشيخ عبد الغني النابلسي
فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية
 |
 |
فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية
15 - فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية .شرح جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص الشيخ عبد الغني النابلسي
كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص الشيخ عبد الغني النابلسي على فصوص الحكم الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي
قال الشيخ رضي الله عنه : (
عن ماء مريم أو عن نفخ جبرين .... في صورة البشر الموجود من طين
تكوّن الرّوح في ذات مطهّرة ...... من الطّبيعة تدعوها بسجّين
لأجل ذلك قد طالت إقامته ...... فيها فزاد على ألف بتعيين
روح من اللّه لا من غيره فلذ .......... أحيا الموات وأنشأ الطّير من طين
حتّى يصحّ له من ربّه نسب ....... به يؤثّر في العالي وفي الدّون
اللّه طهّره جسما ونزّهه ......... روحا وصيّره مثلا بتكوين)
هذا فص الحكمة العيسوية ، ذكره بعد حكمة العزير عليه السلام ، لأنه كان في بني إسرائيل بعد العزير عليه السلام ، وقد ادعى فيه ما ادعي في العزير من طائفة من اليهود ، ولأن حكمة عيسى عليه السلام نبوية روحانية تناسب ذكرها بعد مبحث النبوة في حكمة العزير عليه السلام .
(فص حكمة نبوّية) منسوبة إلى النبوّة من النبأ وهو الخبر والنبوة وهي الرفعة في (كلمة عيسوية).
إنما اختصت حكمة عيسى عليه السلام كونها نبوّة ، لأنه من روح اللّه تعالى والنبوة إخبار الروح بالوحي في القلوب على وجه خاص من روحانية جبريل عليه السلام عن أمر اللّه تعالى [ شعر ]
(عن ماء ) متعلق يتكون في البيت الثاني مريم ، أي منها الذي نزل أو عن نفخ جبرين بالنون بدل عن اللام لغة في جبريل وهو الملك المعروف عليه السلام في صورة متعلق بنفخ البشر الموجود من طين ، وهو مريم عليها السلام .
قال تعالى :" وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ" ( 91 ) [ الأنبياء : 91 ] .
والوارد في الأحاديث : أن حمل مريم بعيسى عليه السلام كان بنفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها فحملت به ووضعته من وقتها على الأشهر كرامة لها ومعجزة له صلى اللّه عليه وسلم وإنما نسب النفخ في الآية إلى اللّه تعالى جريا على عادته سبحانه في نسبة الأمور إليه تعالى تارة إلى الواسطة أخرى لقوله تعالى :" اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها " [ الزمر : 42 ] مع قوله سبحانه : " قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ" [ السجدة : 11 ] .
وقوله تعالى :زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ[ النمل : 4 ]
مع قوله سبحانه :" وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ" [ الأنفال : 48 ].
(تكون) بالتشديد للواو أي تصور (الروح) ، وهو عيسى عليه السلام من قوله تعالى :" وَرُوحٌ مِنْهُ " في ذات نورانية شريفة مطهرة عن حكم الطبيعة ، أي غلبتها عليه بمقتضياته تدعوها ، أي تلك الطبيعة يعني تسميها الذات المطهرة بسجين كما قال تعالى :" كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ" [ المطففين : 7 ] ، أي أنفسهم المكتوب فيها بأقلام حركاتهم الاختيارية في مخالفة الأوامر الإلهية لَفِي سِجِّينٍ وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ ( 8 ) كِتابٌ مَرْقُومٌ" [ المطففين : 7 - 9 ] ، وهو غلبة الطبيعة عليهم بمقتضياته .
وقال تعالى : " يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ" [ آل عمران : 55 ] ، أي مخرج لك عن حكم الطبيعة وَرافِعُكَ إِلَيَّ، أي إلى حضرتي في جوار الملأ الأعلى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، أي من حالتهم التي غلبت عليهم فيها الطبيعة بمقتضياته .
(لأجل ذلك) ، أي كونه مطهرا من حكم الطبيعة المقتضية التركيب والانحلال بسرعة قد طالت إقامته فيها ، أي في تلك الذات المطهرة ولم ينفصل عنها من حين ولد إلى الآن فزاد عمره عليه السلام على ألف سنة بتعيين .
لأنه رفع قبيل بعثة نبينا عليه السلام فله الآن حياة بالحياة النورانية الغالبة عليه من حكم غلبة الروح الأمري في صورته البشرية ، وصاحب هذه الحياة لا يموت أبدا كالخضر عليه السلام ، فإنه حي بهذه الحياة النورانية لا الحياة الظلمانية الطبيعية ، التي يموت صاحبها بالموت الطبيعي .
وينحل تركيبه لغلبة الحيوانية فيه على الإنسانية ، ولعل الخضر حين يقتله الدجال في آخر الزمان يكون بعد غلبة الطبيعة عليه ، ولهذا يظهر له فيعرفه ويقدره اللّه تعالى كما أقدر اليهود على زكريا ويحيى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام فقتلوهم .
فإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يخالط الأحياء بالحياة الطبيعية ، كما كان نبينا صلى اللّه عليه وسلم نيابة عنه في شريعتنا هذه المحمدية فيأكل ويشرب ويتزوج وينكح ، ثم يموت بالموت الطبيعي ، ويدفن في حجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم كما مات نبينا صلى اللّه عليه وسلم متابعة سنته عليه السلام .
لأنه يصير من أمته عليه السلام فالموت النفساني فرض في الحياة الدنيا كما قال عليه السلام : « موتوا قبل أن تموتوا » . الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ابن حجر العسقلاني
وقال تعالى في عيسى عليه السلام :يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ[ آل عمران : 55 ] ،
أي من حظوظ نفسك فنفسك قائمة بيدي لا بيدك وهو قول نبينا عليه السلام : « والذي نفسي بيده » والموت الطبيعي سنة محمدية ، وعيسى عليه السلام مات الموت النفساني ، ثم رفع إلى السماء ولم يمت الموت الطبيعي فلا بد أن ينزل في آخر الزمان ، ويموت الموت الطبيعي أيضا كما مات نبينا صلى اللّه عليه وسلم ويدفن معه في حجرته كما ورد في الأخبار الصحيحة .
(روح) ، أي عيسى عليه السلام منفوخ (من) أمر (اللّه) تعالى بلا واسطة قال تعالى :" وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ" [ النساء : 171 ]( لا) روح (من غيره) سبحانه كالروح الحيواني المنفوخ بواسطة الطبيعة فإنه عليه السلام لما نفخ في فرج مريم لم يتدنس بطبيعة أب جسماني ، ولا انبعث في رحم أمه عن مقتضى شهوة نفسانية ، فلم يكن كغيره من الناس أصلا ، ولهذا أمكن أن يبقى في السماء من غير قوت كما هو مقتضى الخلقة الملكية ، ونبينا صلى اللّه عليه وسلم لما صعد إلى السماء ليلة المعراج بعد الإسراء كان ذلك له من غلبة الروحانية الأمرية عليه كعيسى عليه السلام ، ولكن حقيقة مقامه المحمدي الجامع للطبيعة وغيرها اقتضى هبوطه إلى الأرض في تلك الليلة وعدم بقائه في السماء شرفا لمقام الكشفي الجامع .
(فلذا) ، أي لكونه عليه السلام روحا من اللّه تعالى من أمر اللّه تعالى بلا واسطة أحيا الجسم الموات بإذن اللّه تعالى وإنشاء ، أي خلقه عليه السلام بإذن اللّه تعالى (الطير من طين) .
قال تعالى :" وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي" [ المائدة :110]
وقال تعالى حكاية عنه عليه السلام :" وَرَسُولًا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ " تعالى [ آل عمران : 49 ] .
(حتى يصح له من ربه) ، الذي خلقه (نسب) بقطع الأنساب عنه وصدوره عنه بلا واسطة ؛ ولهذا قال :" وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا" [ التحريم : 12 ] ونسب تعالى النفخ إليه سبحانه مع أنه بالملك ، كما أن جميع الأنساب ترتفع يوم القيامة في ذلك النشىء الأخروي " وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى"( 47 ) [ النجم : 47 ] .
وفي الحديث يقول تعالى : " اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم " رواه الحاكم
وهو قوله تعالى : " فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ" ( 101 ) [ المؤمنون 101 ].
فتكون الناس في يوم القيامة مثل خلقة عيسى ابن مريم عليه السلام عن اللّه تعالى سبحانه ، ويظهر سر قوله عليه السلام : « إن اللّه خلق آدم على صورته ».
وفي رواية : « على صورة الرحمن » وهم في الدنيا كذلك ، ولكن حجاب الطبيعة مانع من شهود الأمر على ما هو عليه عند البعض ، وليس في القيامة إلا ظهور الأمر على ما هو عليه ، وشهود الكل له كما قال تعالى : "وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ " [ النور : 25 ]
وقال تعالى :" فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ " [ ق : 22 ] ، وقال تعالى :" يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ "[ آل عمران : 106 ] الآية .
به ، أي بسبب هذا النسب المخصوص (يؤثر) عيسى عليه السلام بإذن اللّه تعالى (في العالي) ، وهو إحياء الموتى ونفخ الروح في الطير ، لأنه تصرف في العالم الروحاني وهو أعلى من الجسماني (وفي الدون)، أي السافل وهو تصوير صورة الطير من الطين وإبراء الأكمه والأبرص .
(اللّه) سبحانه (طهّره) ، أي عيسى عليه السلام (جسما )، أي من حيث جسمه فغلبت عليه الروحانية ، وانسلخ من عالم الطبيعة ، فخرج من الظلمات إلى النور على معنى أنه تعالى خلقه طاهرا كذلك حيث لم يخلقه بواسطة الأب الجسماني الطبيعي ، بل بالأب الجسماني النوراني ، وهو صورة البشر السوي التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى مريم .
فخرج عيسى عليه السلام كذلك صورة جسمانية نورانية لا طبيعية ظلمانية ، فكان صورة جبريل عليه السلام لما جاء أمه فاستعاذت منه مخافة أن يكون جسما طبيعيا ظلمانيا ، فعرفته فنفخ فيها حتى ظهر عيسى عليه السلام في صورة الملائكة عليهم السلام ، فهو إنسان ملك لا إنسان حيوان ، ولما طلبوا نزول الملائكة بأحكام الشريعة للتبليغ من غير واسطة بشر بقولهم :"وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً" [المؤمنون : 24 ] .
قال تعالى :" وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ" ( 9 ) [ الأنعام : 9 ] ، يعني من الصورة الإنسانية وحقق تعالى ذلك بخلق عيسى ابن مريم عليه السلام كما قال سبحانه :" إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ( 59 ) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ( 60 ) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ " [ الزخرف : 59 - 61 ] ؛ ولهذا ينزل عليه السلام في آخر الزمان فيكون نزوله من أشراط الساعة .
(ونزّهه) عليه السلام (روحا) ، أي من حيث هو روح ، لأنه من أمر اللّه تعالى فله التنزيه التام والتقديس العام (وصيّره مثلا )، أي نظيرا له تعالى في خلافته عنه في الأرض ، يحكم بأحكامه ويقوم بصفاته ويتسمى بأسمائه ويتحقق بذاته ويفعل بأفعاله كما قال (بتكوين) ، أي بسبب تكوينه أي خلقه الطير من الطين أو مثلا مكونا ، أي مخلوقا . وهذا معنى كون آدم عليه السلام مخلوق على صورة الحق تعالى .
قال الشيخ رضي الله عنه : (اعلم أنّ من خصائص الأرواح أنّها لا تطأ شيئا إلّا حيي ذلك الشّيء وسرت الحياة فيه . ولهذا قبض السّامريّ قبضة من أثر الرسول الّذي هو جبرئيل عليه السلام وهو الرّوح . وكان السّامري عالما بهذا الأمر . فلما عرف أنّه جبرئيل ، عرف أنّ الحياة قد مرت فيما وطئ عليه ، فقبض قبضة من أثر الرّسول بالضّاد أو بالصّاد أي بملء يده أو بأطراف أصابعه ، فنبذها في العجل فخار العجل ، إذ صوت البقر إنّما هو خوار ، ولو أقامه صورة أخرى لنسب إليه اسم الصّوت الّذي لتلك الصّورة كالرّغاء للإبل والثّؤاج للكباش واليعار للشياه والصّوت للإنسان أو النّطق أو الكلام . )
(اعلم) يا أيها السالك (أن من خصائص الأرواح) القدسية التي هي وجوه الروح الأعظم الأمري ورقائق شعاعاته المبثوثة في جميع العوالم أنها (لا تطأ) ، أي تمس (شيئا) من صور العالم الكثيفة أو اللطيفة (إلا حيي ذلك الشيء) ، أي صار حي وسرت الحياة الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية أو الجمادية (فيه) ، أي في ذلك الشيء ، كما سرت الحياة النباتية في الفروة ، وهي وجه الأرض التي جلس عليها الخضر عليه السلام ، وهو يتحقق بغلبة الروحانية كما ذكرنا ، فاخضرت تلك الأرض وسمي الخضر لأجل ذلك كما قيل ، ومن مشى على الماء أو في الهواء وهو هذه الحالة فقد سرت منه الحياة الجمادية في الماء والهواء في وقت مشيه ذلك ، والملك الذي جاء مريم عليها السلام في صورة البشر السوي لما نفخ فيها سرت في نطفتها داخل فرجها الحياة الإنسانية ، فكان عيسى عليه السلام .
(ولهذا) ، أي لما ذكر (قبض السامري) في بني إسرائيل (قبضة من أثر الرسول الذي هو جبريل) عليه السلام لما جاء وقت الذهاب إلى الطور ، وقد كان موسى عليه السلام وعد قومه أربعين ليلة أنه يذهب لميقات ربه ليأتيهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فجاء جبريل عليه السلام على فرس يقال له « فرس الحياة » ولا تصيب شيئا إلا حيي ليذهب بموسى عليه السلام إلى ربه (وهو) ، أي المقبوض من أثره (الروح ) الذي به تحيا الأشياء .
وكان السامري رجلا صالحا قد أظهر الإيمان بموسى عليه السلام على وجه النفاق ، وكان من قوم يعبدون البقر عالما بهذا الأمر ، أي بأن الروح لا يمس شيئا إلا حيي فلما عرف أنّه ، أي ذلك الرسول الذي جاء إلى موسى عليه السلام جبريل عليه السلام ورأى موضع قدم فرسه يخضر في الحال فيعطي الحياة النباتية للمستعد له عرف ، أي السامري أن الحياة قد سرت فيها ، أي في وجه الأرض الذي وطيء ، أي داس عليه ذلك الفرس بحافره ، وقال : إن لهذا الفرس شأن فقبض بيده قبضة من أثر ، أي تربة حافر فرس الرسول الذي هو جبريل عليه السلام والقبضة بالضاد المعجمة أو بالصاد المهملة كما قرىء بذلك .
أيبملء يده وهي القبضة بالمعجمة (أو بأطراف أصابعه) ، وهي القبضة بالمهملة ، وهذا بناء على أنه ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره حيي ، وقد كان موسى عليه السلام لما ذهب إلى الميقات خلف أخاه هارون عليه السلام في بني إسرائيل فقال لهم هارون : قد تحملتم أوزارا من زينة القوم ، أي حليهم فإنهم كانوا قد استعاروا حليا كثيرا من قوم فرعون قبل خروجهم من مصر بعلة غرض لهم .
فأهلك اللّه تعالى فرعون وقومه ، وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل ، فقال لهم هارون : تطهروا منها ، فإنها نجس وأوقد لهم نارا وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا ، فأقبل السامري إلى النار وقال : يا نبي اللّه ألقي ما في يدي قال : نعم وهو يظن أنه حلي فقذفه فيها فقال : كن عجلا جسدا له خوار .
(فنبذها) ، أي تلك القبضة أو القبصة (في العجل) حتى صار عجلا من ذهب والعجل ولد البقر إلى أن يكبر قيل : خرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون (فخار) ذلك (العجل)إذ ، أي لأن (صوت البقر إنما هو خوار . )
قال السدي رحمه اللّه تعالى : كان يخور ويمشي فقال السامري : هذا إلهكم وإله موسى فنسي ، أي تركه ههنا وخرج يطلبه ، وأخطأ طريق إصابته فافتتنوا به ودعاهم إلى عبادته فعبدوه .
(ولو أقامه) ، أي السامري (صورة أخرى) غير العجل (لنسب إليه) ، أي إلى ما أقامه (اسم الصوت الذي لتلك الصورة كالرغاء) بالغين المعجمة للإبل والثّؤاج) بالمثلثة والجيم للكباش من الغنم واليعار بالمثناة التحتية والعين المهملة (للشاة والصوت للإنسان أو النطق أو الكلام) ، ولكن إنما أقامه عجلا ، لأنه كان من قوم يعبدون البقر كما ذكرن .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فذلك القدر من الحياة السّارية في الأشياء يسمّى لا هوتا ، والنّاسوت هو المحلّ القائم به ذلك الرّوح فسمّي النّاسوت روحا بما قام به .
فلمّا تمثّل الرّوح الأمين الّذي هو جبرئيل لمريم عليهما السّلام بشرا سويّا تخيّلت أنّه بشر يريد مواقعتها فاستعاذت باللّه منه استعاذة بجمعيّة منها ليخلّصها اللّه منه لما تعلم أنّ ذلك ممّا لا يجوز . فحصل لها حضور تامّ مع اللّه وهو الرّوح المعنويّ .
فلو نفخ فيها في ذلك الوقت على هذه الحالة لخرج عيسى عليه السّلام لا يطيقه أحد لشكاسة خلقه لحال أمّه.
فلمّا قال لها :إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ جئت لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا[ مريم : 19 ] انبسطت عن ذلك القبض وانشرح صدرها فنفخ فيها في ذلك الحين فخرج عيسى .
وكان جبرئيل ناقلا كلمة اللّه لمريم كما ينقل الرّسول كلام اللّه لأمّته .
وهو قوله :وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ[ النساء : 171 ] . )
(فذلك القدر من الحياة السارية) من الروح (في الأشياء يسمى لا هوتا) .
فاللاهوت أثر الروح الساري فيما مسه من ذلك الشيء على حسب ذلك الشيء .
(والناسوت هو المحل القائم به ذلك الروح) من الأشياء المحسوسة بالروح وهو الجسم (فيسمى الناسوت) الذي هو الجسم (روحا بما) ، أي بسبب الروح الذي (قام به) لغلبته عليه واستهلاك حكم الناسوت فيه ، كما سمي ناسوت عيسى عليه السلام روحا باعتبار غلبة الروح عليه وسمي جبريل عليه السلام روحا في حال مجيئه إلى مريم في صورة البشر السوي .
(فلما تمثل) ، أي دخل في عالم المثال وهو برزخ بين الوجود والعدم واسع جدا فيه صورة كل شيء لا تدخله إلا الروحانيون من الملائكة والجن والإنس ، فإذا دخلوه استتروا بأي صورة شاؤوا منه ، فيراهم الرائي فيها على حسب ما يريدون وهم على ما هم عليه في خلقتهم الأصلية لا يتغيرون أصلا ، نظير الملابس التي تلبسها الناس فتظهر بها من غير أن يتغير اللابس عن حاله الأصلي (الروح الأمين الذي هو جبريل لمريم عليها السلام بشرا سويا) ، أي مستوي الخلقة معتدل الهيئة حسن الصورة (تخيلت) ، أي مريم عليها السلام أنه ، أي جبريل عليه السلام .
(بشر) من الناس ولم تعلم أنه ملك نزل في صورة إنسان وتوهمت (أنه يريد مواقعتها) عليها السلام .
(فاستعاذت باللّه تعالى منه) ، أي التجأت إليه تعالى واحتمت به باطنا وقالت :
ظاهرا أعوذ بالرحمن منك ، وخصت اسم الرحمن دون اسم اللّه ، لأنها طلبت أن اللّه تعالى يرحمها بالحفظ والصيانة من شره وأذاه (استعاذة) كانت (بجمعية) قلبية (منها) ، أي من مريم عليها السلام ، فتوجهت همتها من حضرة الرحمن المستوي على عرش قلبها بالرحمة ، فتحرك لسانها بذكره (ليخلصها اللّه) تعالى (منه) ، أي من ذلك البشر السوي لما تعلم ، أي لعلمه أن ذلك الأمر الذي توهمت منه مما لا يجوز في الشرع فيحصل لها عند ذلك حضور تام مع اللّه تعالى ، أي استحضار لقيوميته عليها وشهود لتجليه في باطنها وظاهرها فرارا من نفسها إليه سبحانه ليحميها ودخولا في ظل عنايته ليصونها ويريبه .
وهو ، أي ذلك الحضور التام الروح المعنوي الذي سرى فيها من توجيه الروح السوي الذي هو جبريل عليه السلام إليها وتأثير باطنه فيها (فلو نفخ) ، أي جبريل عليه السلام فيها ، أي في مريم عليها السلام (في ذلك الوقت على هذه الحالة) التي كانت عليها مريم عليها السلام من القبض والجلال (لخرج عيسى عليه السلام) صاحب قبض وجلال بحيث لا يطيقهأحد من الناس (لشكاسة) ، أي صعوبة (خلقه) ، أي عادته وطبيعته لحال أمه مريم عليها السلام ، لأن أحوال الأمهات والآباء لها تأثير في أخلاق الأولاد في خلقتهم باطنا وظاهر .
(فلما قال) ، أي جبريل عليه السلام لها ، أي لمريم عليها السلام "إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ".
علمت أنه جبريل عليه السلام ، ثم قال لها : جئت ، أي من عند اللّه تعالى إليك ("لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا") [ مريم : 19 ] ، أي طيبا طاهرا .
فعند ذلك (انبسطت) لقوله عن ذلك القبض الذي كان فيها وزال عنها الجلال الذي قد اعتراه وانشرح صدرها لما يريده اللّه تعالى منها فنفخ ، أي جبريل عليه السلام فيها ، أي في مريم عليها السلام (في ذلك الحين فخرج عيسى) عليه السلام مفعول نفخ ، لأنه عين النفخ الجبريلي والروح الأمري والسر الإلهي (فكان جبريل عليه السلام ناقلا كلمة اللّه) تعالى (لمريم) عليها السلام كما ينقل الرسول من الأنبياء عليهم السلام كلام اللّه تعالى القديم المنزه عن الحروف والأصوات (لأمته) ، أي أمة ذلك الرسول بلسانه هو وحروفه وأصواته ، فيتكلمون به هم بألسنتهم وحروفهم وأصواتهم من غير أن يتغير كلام اللّه تعالى القديم عما هو عليه في الأزل ، ولا ينقطع توجه ذلك القديم الذي هو صفة من صفات المتكلم به أزلا وأبدا عن ذلك العبد المتكلم به ، وعما أتى به من الحروف والأصوات .
بحيث تبقى تلك الحروف والأصوات إذا نوى القارئ بها أنه يقرأ كلام اللّه تعالى القديم بمنزلة الصورة المثالية التي يتصوّر بها الروحاني فيستتر بها ويظهر فيها ، وهي فعله الممسوك به وهو قيومها الماسك لها ، فهي هو عند الناظر وهو غيرها في نفس الأمر ، وإذا كانت هي هو كان وجوده ظاهرا فيها وهي معدومة بعدمها الأصلي ، فلا تغير لوجوده عما هو عليه ، وإذا كان هو غيرها في نفس الأمر لم يكن لها وجود في نفسها أصل .
(وهو قوله) تعالى في عيسى عليه السلام ("وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ") [ النساء : 171 ] سبحانه ، فعيسى عليه السلام كلمة اللّه تعالى ، كما نقول الآن من غير فرق أصلا للكلمة التي نتكلم بها نحن من القرآن والآية أنها كلمة اللّه تعالى عندنا حقيقة ، على معنى أنها مظهر للكلمة الإلهية وصورة لنا في لساننا من غير حلول ولا اتحاد ولا انحلال ، لأن قيوم الوجود لا يصح أن يحل أو يتحد أو ينحل عنه ذلك الشيء القائم به المعدوم في نفسه ، فجسد عيسى عليه السلام المشتمل على تركيب أعضائه الإنسانية بمنزلة حروف تلك الكلمة وباطنه عليه السلام مما تضمنه من الأسرار والعلوم بمنزلة معنى تلك الكلمة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فسرت الشّهوة في مريم فخلق جسم عيسى من ماء محقّق من مريم ، ومن ماء متوهّم من جبرئيل ، سرى في رطوبة ذلك النّفخ لأنّ النّفخ من الجسم الحيواني رطب لما فيه من ركن الماء .
فتكوّن جسم عيسى من ماء متوهّم ومن ماء محقّق ، وخرج على صورة البشر من أجل أمّه ، ومن أجل تمثّل جبرئيل على صورة البشر حتّى لا يقع التّكوين في هذا النّوع الإنساني إلّا على الحكم المعتاد .
فخرج عيسى يحيي الموتى لأنّه روح إلهيّ ، وكان الإحياء للّه والنّفخ لعيسى كما كان النّفخ لجبرائيل والكلمة للّه . )
(فسرت الشهوة في مريم) عليها السلام حين اطمأن قلبها بأنه ملك لا بشر ، وانبسطت عن قبضها ، وانشرح صدرها ، وأمنت منه السوء والفاحشة فخلق جسم عيسى عليه السلام ("مِنْ ماءٍ") ، أي من مني محقق وجوده من مريم عليها السلام ، ولا ينكر منها سريان الشهوة فيها عند رؤية البشر السوي لأنه أمر طبيعي لا يدخل تحت التكليف ، كحالة الجوع والعطش عند رؤية المأكل والمشرب خصوصا ، وليس من جهتها قصد لوجود ذلك ولا إرادة له .
وللّه تعالى في ذلك إرادة مقتضية لحكمة عظيمة ، فأنفذها سبحانه على طبق قضائه الأزلي وتقديره ومن ماء متوهم وجوده (من جبريل) عليه السلام لما جاء في صورة البشر السوي ، فإن النفخ كان من فم ذلك البشر السوي ، والفم فيه ماء الريق (سرى ذلك) الماء (في رطوبة ذلك النفخ ، لأن النفخ من الجسم الحيواني) وهو ماء فيه حياة نامية متحركة بالإرادة (رطب لما فيه).
أي في ذلك النفخ (من ركن الماء) فكان الهواء والماء من صورة النافخ ، والنار والتراب من صورة المنفوخ فيه ، وهو مريم عليها السلام ، فالنار من الشهوة والتراب من كثافة جرم المني ، فقد اجتمعت العناصر الأربعة على طريقة سائر المولدات (فيكوّن) بسبب ذلك جسم عيسى عليه السلام من ماء متوهم الوجود وماء محقق الوجود كما قال تعالى في حق كل إنسان إنه "خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ ( 6 ) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ "( 7 ) [ الطارق : 6-7] .
(وخرج) عيسى عليه السلام (على صورة البشر من أجل أمه) ، فإنها صورة بشر (ومن أجل تمثل جبريل) عليه السلام (في صورة البشر) فقد ظهر بشر من بين بشرين بحسب الظاهر كغيره من الناس (حتى لا يقع التكوين في هذا النوع الإنساني إلا على هذ الحكم المعتاد) والأمر في الباطن ليس كذلك ، فإنه ظهور روح من بين روح وبشر ، فرفع مع الأرواح بعد نزوله منها ، وسينزل نزولا آخر على المنارة البيضاء شرقي دمشق نظير نزوله أوّلا على المنارة العذراء البيضاء ، ويغلب عليه حكم تلك المنارة ، فتأخذه الطبيعة النورانية المنيرة له ، فيتزوج وينكح ويتبع الشريعة المحمدية ، ويموت ويدفن بالحجرة كما ذكرناه قريب .
(فخرج عيسى) عليه السلام ("يحى الموتى"لأنه روح إلهي) من أمر اللّه تعالى وكان الإحياء للموتى الظاهر من عيسى عليه السلام للّه تعالى فالمحيي هو اللّه تعالى وحده والنفخ في الطير الذي خلقه من طين وأحياه بالتوجه على أجسام الموتى وأرواحهم المفارقة لعيسى عليه السلام ، فالنافخ هو كما كان في خلقه عيسى عليه السلام النفخ في مريم عليها السلام لجبريل عليه السلام والكلمة ، أي تفصيل حروفها بتبيين أعضاء عيسى عليه السلام وتركيب بنيته وهيئته وتسوية صورته وتوجيه معانيه الباطنية بانتشار قواه الروحانية للّه تعالى وحده ، فالنافخ هو جبريل عليه السلام والمتكلم بإظهار كلمته هو اللّه تعالى .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وكان إحياء عيسى عليه السّلام للأموات إحياء محقّقا من حيث ما ظهر عن نفخه كما ظهر هو عن صورة أمّه . وكان إحياؤه أيضا متوهّما أنّه منه وإنّما كان
للّه . فجمع لحقيقته الّتي خلق عليها كما قلناه إنّه مخلوق من ماء متوهّم وماء محقّق ينسب إليه الإحياء بطريق التّحقيق من وجه وبطريق التّوهّم من وجه .
فقيل فيه من طريق التّحقيق وَأُحْيِ الْمَوْتى وقيل فيه من طريق التّوهّم فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ [ آل عمران : 49 ] فالعامل في المجرور فيكون ، لا أنفخ . ويحتمل أن يكون العامل فيه أنفخ فيكون طيرا ، من حيث صورته الحسّيّة الجسميّة .
وكذلك وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ [ المائدة : 110 ] وجميع ما ينسب إليه وإلى إذن اللّه .
وإذن الكناية في مثل قوله :بِإِذْنِي وبإذن الله فإذا تعلّق المجرور بتنفخ ، فيكون النّافخ مأذونا له في النّفخ ويكون الطّائر عن النّافخ بإذن اللّه . وإذا كان النّافخ نافخا لا عن الإذن ، فيكون التّكوّن للطّائر .
فيكون العامل عند ذلك فيكون فلو لا أنّ في الأمر توهّما وتحقّقا ما قبلت هذه الصّورة هذين الوجهين . بل لها هذان الوجهان لأنّ النّشأة العيسويّة تعطي ذلك . )
(فكان إحياء عيسى) عليه السلام (للأموات إحياء محققا من حيث ما ظهر عن نفخه) في الطير والميت بالتوجه الروحاني ، لأنه كذلك في الحس والعيان (كما ظهر هو) ، أي عيسى عليه السلام (عن صورة أمه) مريم عليها السلام ظهورا متحققا في الحس والعيان وكان إحياؤه ، أي عيسى عليه السلام أيضا ، أي كونه محققا متوهما أنه ، أي ذلك الإحياء منه ، أي من عيسى عليه السلام ، لأنه ظهر به وإنما كان ذلك الإحياء للّه تعالى وحده حقيقة ، لأنه هو الذي يحيي ويميت كما هو معلوم عند كل مؤمن بنبي )فجمع( عيسى عليه السلام )بحقيقته( الإنسانية الروحانية )التي خلق عليها كما قلن( فيما مر إنه .
أي عيسى عليه السلام )مخلوق من ماء متوهم( من نفخ جبريل عليه السلام ومن )ماء محقق( من أمه مريم عليها السلام ، فهو بسبب ذلك )ينسب إليه(، أي عيسى عليه السلام )الإحياء بطريق التحقيق( باعتبار الظاهر من وجه وبطريق التوهم ظاهرا أيض )من وجه(آخر فقيل فيه ، أي في عيسى عليه السلام من طريق التحقق وأحيي الموتى من أن المحيي هو اللّه تعالى المتجلي بصورة عيسى عليه السلام.
وقيل فيه من طريق التوهم فتنفخ فيه ، أي فيما خلقه لهم كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن اللّه تعالى فالعامل في المجرور ، أي الذي يتعلق به الجار والمجرور في قوله تعالى : بِإِذْنِ اللَّهِ هو قوله فيكون .
أي يكون طيرا بإذن اللّه تعالى لا قوله تنفخ فيبقى نفخه مثل نفخ غيره من الناس إذا نفخ ، وإنما الخصوصية في اعتبار اللّه تعالى نفخه ذلك وتكوينه تعالى للطير عقيب نفخه إجابة له وتصديقا لدعواه ويحتمل أن يكون العامل فيه ، أي في المجرور بأن يكون الجار والمجرور متعلقا بـ تنفخ فيكون نفخه بإذن اللّه تعالى ليس كنفخ غيره من الناس .
فالخصوصية في النفخ لا في تكوين اللّه تعالى الطير ، فكل من نفخ مثل ذلك النفخ بإذن اللّه تعالى كان عنه ما أراد كما نقل أن أبا يزيد البسطامي قدس اللّه سره نفخ في نملة ماتت فأحييت بإذن اللّه تعالى فيكون طيرا من حيث صورته الجسمية الحسية على حسب ما خلقه من تلك الهيئة .
وكذلك قوله تعالى عنه (وتبريء الأكمه والأبرص) بإذن اللّه تعالى وجميع ما نسب إليه ، أي إلى عيسى عليه السلام وإلى إذن اللّه تعالى وإلى إذن الكناية عن اللّه تعالى وهي ضمير المتكلم في مثل قوله تعالى بإذني وبإذن اللّه تعالى كما ذكرنا فيما مر من قوله تعالى :" وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي" [ المائدة : 110 ] .
وقوله تعالى :"أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللَّهِ" [ آل عمران : 49 ] .
فإذا تعلق الجار والمجرور وهو قوله بإذني وقوله : بإذن اللّه بتنفخ في الآية الأولى وأنفخ في الثانية فيكون النافخ مأذونا له في النفخ من جهة الحق تعالى ويكون الطير ، أي يتكون ويظهر طيرا عن النافخ بإذن اللّه تعالى .
وإذا كان النافخ في الآيتين نافخا لا عن الإذن ، أي إذن اللّه تعالى فيكون التكوين للطائر طائرا بإذن اللّه تعالى فيكون العامل في تعلق الجار والمجرور به عند ذلك قوله فيكون .
فلولا أن في الأمر الإلهي والشأن الرباني المتوجه على خلق عيسى عليه السلام توهما من وجه وتحققا من وجه آخر فهو متوهم من حيث الصورة ومتحقق من حيث الوجود .
فمن هذه صورته ليس هذا فعله ولا تأثير له أصلا ومن هذا وجوده فهو الفاعل المؤثر ولا صورة له فهذا هو وليس هذا هو فهو لا هو فكأنه هو فلا هو إلا هو ما قبلت هذه الصورة العيسوية هذين الوجهين وجه التوهم في كونه يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ووجه التحقق منه في ذلك أيضا بل لها .
أي للصورة العيسوية هذان الوجهان لأن النشأة ، أي الخلقة العيسوية من أصل تكوينها عن جبريل عليه السلام النافخ في مريم عليها السلام تعطي ذلك ، أي الوجهين المذكورين وجه التوهم في صدوره عن ماء متوهم ووجه التحقق في صدوره عن ماء محقق كما مر .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وخرج عيسى من التّواضع إلى أن شرّع لأمّته أنيُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ [ التوبة : 29 ] وأنّ أحدهم إذا لطم في خدّه وضع الخدّ الآخر لمن لطمه ولا يرتفع عليه ولا يطلب القصاص منه . هذا له من جهة أمّه إذ المرأة لها السّفل ، فلها التّواضع لأنّها تحت الرّجل حكما وحسّ .
وما كان فيه من قوّة الإحياء والإبراء فمن جهة نفخ جبرئيل في صورة البشر فكان عيسى يحيي الموتى بصورة البشر .
ولو لم يأت جبرئيل في صورة البشر وأتى في صورة غيرها من صور الأكوان العنصريّة من حيوان أو نبات أو جماد لكان عيسى عليه السّلام لا يحيي الموتى إلّا حين يتلبّس بتلك الصّورة ويظهر فيه . )
(وخرج عيسى) عليه السلام فيه شبهان : شبه بأمه مريم عليها السلام وشبه بأبيه جبريل عليه السلام وهو البشر السوي وإن كان لا يسمى أباه ، لأن اجتماعه بمريم لا على وجه اجتماع الزوجين ، ولا كان حملها منه بإيلاج الذكر ، وإنما هو نفخ في الفم ، وهي عذراء بكر على ما هي عليه ، فكان عيسى عليه السلام (من التواضع) الذي في أخلاقه المرضية (إلى أن شرّع) بالبناء للمفعول .
أي شرع اللّه تعالى في ملتنا المحمدية (لأمته) عليه السلام وهم النصارى الزاعمون بقاء ملته وعدم نسخ أحكام التوراة والإنجيل ، فجاء في ملتنا المحمدية الناسخة لجميع الملل والأديان إبقاؤهم على ما يزعمون وإقرارهم على ما في دينهم بالجزية في أموالهم والخراج في أراضيهم حتى ينزل هو عليه السلام من السماء ، فيكذبهم فيما هم فيه ، ويلزمهم باتباع شريعتنا هذه المحمدية ، فيقتلهم أو ليسلموا والذي شرع أن يعطوا الجزية في أموالهم عن يد وهم صاغرون .
أي متذللون كما قال تعالى : " قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ "( 29 ) [ التوبة : 29 ] .
وهذا حكمهم في شريعتنا بسبب زعمهم البقاء على ملته واستقرارهم على متابعته ، فاقتضى تواضعه أن يكون من يزعم أنه متابع له قائما في هذه الذلة والصغار وبذل المال .
(وأن أحدهم) ، أي الواحد منهم معطوف على أن شرع ، أي خرج من التواضع إلى أن الواحد منهم ، أي من أمته شرع له في ملتهم المنسوخة إذا لطم ، أي لطمه أحد من الناس (في خده وضع الخدّ الآخر لمن لطمه ، ولا يرتفع عليه ولا يطلب القصاص منه) ، أي في مقابلة فعله معه هذا الأمر له ، أي لعيسى عليه السلام من جهة شبه أمه مريم عليها السلام إذ ، أي لأن مطلق المرأة لها السفل من الرجل فلها التواضع خلقة لأنها تحت الرجل حيث خلقت منه فهي متواضعة له فأسفل مرتبتها حكما شرعيا . قال تعالى :" وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "[ البقرة : 228 ] وقال عليه السلام : « أخروهن من حيث أخرهن اللّه » وحسا لنقصانها عنه عقلا كما ورد : أنهن أنقص عقلا ودينا تمكث إحداهن شطر عمرها من غير صلاة .
وقال تعالى :" الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ" [ النساء : 34 ] الآية .
(وما كان فيه) ، أي في عيسى عليه السلام (من قوة الإحياء) للموتى (والإبراء) للأكمه والأبرص (فمن جهة) شبه الملك النافخ في أمه حتى حملت به ووضعته لأنه متكوّن من (نفخ جبريل) عليه السلام حين جاء إلى مريم (في صورة البشر) السوي (فكان عيسى) عليه السلام لأجل ذلك يحيي الموتى بصورة البشر التي هو مخلوق عليها مشابهة لصورة البشر السوي التي جاء بها جبريل إلى مريم عليها السلام حين النفخ فيها ولو لم يأت جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام في صورة البشر السوي ولكن أتى إليها في صورة أخرى غيرها من صورة الأكوان العنصرية .
أي المركبة من العناصر الأربعة التراب والماء والهواء والنار من حيوان أو نبات أو جماد لكان عيسى عليه السلام لا يحيي الموتى وكذلك لا يبرئ الأكمه والأبرص إلا حتى يتلبس بتلك الصورة التي جاء بها جبريل إلى أمه عليها السلام ويظهر متمثلا فيها حتى يكون على صورة أبيه وطبيعته المقتضية لنفخ الروح والسر السبوحي .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولو أتى جبرئيل بصورته النّوريّة الخارجة عن العناصر والأركان - إذ لا يخرج عن طبيعته - لكان عيسى لا يحيي الموتى إلّا حين يظهر في تلك الصّورة الطبيعيّة النّوريّة لا العنصريّة مع الصّورة البشريّة من جهة أمّه فكان يقال فيه عند
إحيائه الموتى هو لا هو .
وتقع الحيرة في النّظر إليه كما وقعت في العاقل عند النّظر الفكريّ إذا رأى شخصا بشريّا من البشر يحيي الموتى ، وهو من الخصائص الإلهيّة ، إحياء النّطق لا إحياء الحيوان بقي النّاظر حائرا ، إذ يرى الصّورة بشرا بالأثر الإلهي .
فأدى بعضهم فيه إلى القول بالحلول ، وأنّه هو اللّه بما أحيا به الموتى ، ولذلك نسبوا إلى الكفر وهو السّتر لأنّهم ستروا اللّه الّذي أحيا الموتى بصورة بشريّة عيسى) .
فقال تعالى :" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ " [ المائدة : 17 ] فجمعوا بين الخطأ والكفر في تمام الكلام كلّه لا بقولهم هو اللّه ولا بقولهم ابن مريم .
ولو أتى جبريل إلى مريم عليها السلام بصورته النورية التي خلقه اللّه تعالى عليها الخارجة عن العناصر الأربعة والأركان التي لا بد لكل مولد من المركبات الجسمانية أن يكون مستمدا منها إذ ، أي لأنه يعني جبريل عليه السلام لا يخرج عن طبيعته التي هو مركب الصورة منها .
وهي منقسمة إلى أربعة أقسام نظير العناصر الأربعة والأركان الأربعة ، وهي :
1 - الحرارة
2 - والبرودة
3 - والرطوبة
4 - واليبوسة .
وأرواح الملائكة العلوية عليهم السلام منفوخة في صور جسمانية لطيفة طبيعية مركبة من هذه الطبائع الأربع المذكورة من العناصر (لكان عيسى) عليه السلام (لا يحيي الموتى) ولا يبرئ الأكمه والأبرص ولا يخلق الطير من الطين أيض (إلا حين "حتى" يظهر في تلك الصورة) الملكية الجبريلية (الطبيعة النورية لا العنصرية مع) ظهوره أيضا في الصورة البشرية الإنسانية العنصرية من جهة أمه مريم عليها السلام .
لأنه متولد عن هاتين الصورتين حينئذ الصورة الطبيعية الملكية والصورة العنصرية الإنسانية (فكان يقال فيه عند إحيائه الموتى) وإبراء الأكمه والأبرص حيث يظهر في الصورتين معا فيكون ملكا بشر (هو) .
أي عيسى عليه السلام من حيث الصورة البشرية ، لأنه بشر ابن مريم عليها السلام (لا هو) عيسى عليه السلام ، لأنه في الصورة الطبيعية الملكية ، لأنه ملك من نفخ جبريل عليه السلام .
(وتقع الحيرة) حينئذ عند العقلاء (في النظر إليه) ، لأنهم يرون بشرا يفعل فعل ملك فيقولون بشر للصورة ، ويقولون ملك للفعل ، كما قالت النسوة المفتتنات بيوسف عليه السلام عنه من فرط حسنه وجماله .
وحكى تعالى ذلك حيث قال : " فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ " [ يوسف : 31 ] .
(كما وقعت) ، أي الحيرة (في) الإنسان (العاقل عند النظر الفكريإذا رأى شخصا بشريا)، أي من البشر يحيي الموتى وهو ، أي إحياء الموتى من جملة الخصائص الإلهية إحياء النطق الإنساني ، لأنه أبلغ لكمال الحيوان الناطق لا إحياء مطلق الحيوان من غير نطق كإحياء أبي يزيد رضي اللّه عنه النملة .
وإحياء شيخنا الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي اللّه عنه الهرة وكان اسمها لؤلؤة ، وقد ماتت وألقيت على المزبلة فناداها لؤلؤة ، فجاءت مسرعة إليه .
والملا عبد الرحمن الجامي قدس اللّه سره أحيا الدجاجة التي وضعها السلطان مطبوخة قدامه وهي ميتة لا مذبوحة امتحانا له ، فصفق بيديه حتى قامت من الصحن مسرعة .
ومثل هذا الأمر لا يوقع حيرة بل كرامة عند الناظرين ، وإنما الحيرة في إحياء إنسان ، فإنه إذا صار من أحد.
(بقي الناظر) إلى ذلك (حائرا) فيه إذ يرى الصورة من ذلك الشخص الذي صدر منه إحياء الميت بشرا وهو مع ذلك ظاهر (بالأثر الإلهي) " والأثر إلهيا " .
الذي هو مخصوص به سبحانه وهو إحياء الموتى فأدى ، أي أوصل هذا الأمر بعضهم ، أي بعض العقلاء فيه ، أي في حق ذلك الشخص الذي أحيا الميت (إلى القول بالحلول) أي حلول اللّه تعالى المخصوص بإحياء الموتى في ذلك الشخص .
كما قالته طائفة من النصارى في عيسى عليه السلام وفي رهابينهم وقسيسهم .
وتبعتهم الرافضية في علي وأولاده رضي اللّه عنهم .
والدروز والتيامنة والنصيرية في الحاكم بأمر اللّه وفي عقلائهم ، والباطنية في كل شيء ، وهو كفر صريح كما أوضحوا رده في علم الكلام .
وقد رميت به المحققون من أهل اللّه تعالى عند من لا خلاق له من جهلة العلماء الذين لا يعرفون اصطلاح الشرع في الكتاب والسنة .
ويعدلون عنه إلى اصطلاح آخر درج عليه أهل الكلام وأدى ذلك أيضا بعضهم وهم طائفة من النصارى أيضا إلى القول في عيسى عليه السلام أنه هو اللّه تعالى بما أحيا به من الموت وذلك مخصوص باللّه تعالى لا يقدر عليه غيره سبحانه ولذلك ، أي لأجل ما صدر منهم من القول المذكور نسبوا في شرعنا المحمدي إلى الكفر كما يأتي .
وهو ، أي الكفر معناه الستر لأنهم ، أي القائلين بذلك ستروا اللّه تعالى الذي أحيا الموتى وهو متجل عند الناظرين بصورة بشرية عيسى عليه السلام كما هو متجل بصورة روحانية عنده فقال اللّه تعالى :" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ " [ المائدة : 17 ] .
وهم النصارى قالوا ذلك من جهلهم بما الأمر عليه في نفسه فجمعوا بين الخطأ بترك ما هو الصواب والكفر في الدين في تمام الكلام الذي قالوه كله وهو قولهم :إ" ِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ " ، لا جمعوا بين الخطأ والكفر بقولهم : "هُوَ، أي عيسى عليه السلام اللَّهَ من حيث إنه تعالى متجل بالصورة العيسوية بسبب أنه قيوم عليها إلا أنها مخلوقة له لا بالحلول ولا الاتحاد ولا الانحلال .
واللّه تعالى يتجلى في أي صورة شاء في الدنيا والآخرة من غير أن يتغير عن إطلاقه الحقيقي وتنزيهه الذاتي عن مشابهة كل شيء لما ظهر لموسى عليه السلام في صورة النار والشجر "فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى( 11 ) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ " [ طه : 11 - 12 ] .
وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « رأيت ربي في أحسن صورة » . رواه الدارمي والطبري
وقال صلى الله عليه وسلم : " ويتحوّل يوم القيامة في الصور لأهل المحشر " .
كما ورد في حديث مسلم ولا بقولهم أيضا هُوَعيسى عليه السلام ابْنُ مَرْيَمَ، لأنه ابن مريم من غير شبهة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فعدلوا بالتّضمين من اللّه من حيث أحيا الموتى إلى الصّورة النّاسوتيّة البشريّة بقولهم ابن مريم وهو ابن مريم بلا شكّ .
فتخيّل السّامع أنّهم نسبوا الألوهيّة للصّورة وجعلوها عين الصّورة وما فعلوا بل جعلوا الهويّة الإلهيّة ابتداء في صورة بشريّة هي ابن مريم ، ففصلوا بين الصّورة والحكم .
لا أنّهم جعلوا الصّورة عين الحكم .
كما كان جبرئيل في صورة البشر ولا نفخ ، ثمّ نفخ ، ففصل بين الصّورة
والنّفخ وكان النّفخ من الصّورة ، فقد كانت ولا نفخ .
فما هو النفخ من حدّها الذّاتي ؟ )
(فعدلوا ) ، أي الكافرون (بالتضمين من اللّه ) تعالى ، أي بسبب جعلهم اللّه تعالى في ضمن بشرا آخر غيره وهو الصورة (من حيث) أنهم وجدوا منه إحياء الموتى وذلك مخصوص باللّه تعالى عدولا منهم إلى الصورة العيسوية (الناسوتية البشرية) الظاهرة لهم بقولهم ، أي بسبب قولهم هو المسيح ابن مريم فما قالو :
هو المسيح فقط ، ولا قالوا هو ابن مريم فقط .
وإنما جمعوا بينهما وقالوا هو المسيح ابن مريم فأخطأوا وكفروا .
فإنه إذا كان هو المسيح من حيث ظهوره في صورته في حال تجليه بها من باب القيومية لا يكون ابن مريم في ذلك الاعتبار لاستهلاك الصورة الناسوتية في الحقيقة الروحانية التي هو من أمر اللّه تعالى .
وأمر اللّه تعالى كلمح بالبصر ، وهو مقام الفناء الذي عند العارفين باللّه تعالى ، الذي لا يمكن التحقق بالمعرفة والتجليات الإلهية عندهم إلا به ، وإذا كان هو المسيح ابن مريم باعتبار الصورة الناسوتية لم يكن هو اللّه تعالى أصلا ، ولا كان جانب الروحانية الأمرية معتبرا فيه ، بل المعتبر فيه حينئذ جانب الطبيعة وجهة الالتباس في الخلق الجديد ، فجعله في تلك الحالة هو اللّه قول بكون اللّه مخلوقا ، وهو كفر ، وجمع الشيئين فيه حلول للإله في الخلق وهو كفر أيضا وجهل محض .
(وهو) ، أي عيسى عليه السلام باعتبار صورته الناسوتية (ابن مريم بلا شك) ، لأنها ولدته فتخيل السامع في نفسه من قولهم ذلك (أنهم نسبوا الألوهية للصورة) حيث قالوا : إن اللّه هو المسيح ابن مريم ، أي الذي ولدته مريم وتخيل أنهم جعلوها .
أي الألوهية عين الصورة العيسوية الناسوتية وهم ما فعلوا ذلك بل جعلوا الهوية .
أي الذات الإلهية ابتداء ، أي من حين ابتداء ظهور عيسى عليه السلام حالة في صورة بشرية ناسوتية هي .
أي تلك الصورة ابن مريم وقالوا بالحلول وهو كفر ففصلوا بقولهم ذلك بين الصورة البشرية العيسوية الناسوتية والحكم الصادر منها وهو إحياء الموتى لا أنهم جعلوا تلك الصورة العيسوية عين الحكم فكان منها إحياء الموتى ، وإنما قالوا في ذلك كما كان جبريل عليه السلام في صورة بشر ولا نفخ ، فكانت صورة بشرية .
(ثم نفخ) فظهر حكم آخر غيرها على خلاف مقتضاه (ففصل بين الصورة) التي ظهر بها أوّلا (والنفخ) الذي ظهر ثاني (وكان النفخ) ظاهرا من الصورة فأشبه أن يكون منها فيكون النافخ عينها ولكنه تبين (فقد كانت) الصورة البشرية ظاهرة ول نفخ منها فما هو النفخ من حدها الذاتي بحيث يكون داخلا في ماهيتها بل هو أمر آخر عرض لها بسبب حلول حقيقة أخرى فيها ، وذلك النفخ ظاهر عن تلك الحقيقة الأخرى وهكذا قولهم في عيسى عليه السلام وهو خطأ وكفر.
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فوقع الخلاف بين أهل الملل في عيسى ما هو ؟ فمن ناظر فيه من حيث صورته الإنسانيّة البشريّة فيقول هو ابن مريم ومن ناظر فيه من حيث الصّورة الممثّلة البشريّة فينسبه لجبرئيل عليه السّلام ؛ ومن ناظر فيه من حيث ما ظهر عنه من إحياء الموتى فينسبه إلى اللّه بالرّوحيّة فيقول روح اللّه ، أي به ظهرت الحياة فيمن نفخ فيه . فتارة يكون الحقّ فيه متوهّم - اسم مفعول - وتارة يكون الملك فيه متوهّما ، وتارة تكون البشريّة الإنسانيّة فيه متوهّمة : فيكون عند كلّ ناظر بحسب ما يغلب عليه ، فهو كلمة اللّه وهو روح اللّه وهو عبد اللّه.)
(فوقع الخلاف بين أهل الملل) ، أي الأديان من المسلمين والكافرين في عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ما هو في نفس الأمر فمن ناظر فيه عليه السلام من حيث صورته الإنسانية البشرية فيقول عنه إنه هو ابن مريم وهو عبد اللّه ورسوله .
وإحياء الموتى كان من اللّه تعالى المتجلي بصورته ، لأنه قيوم عليه ممسك بقدرته كالذي يمسك السكين مثلا بيده ويقطع بها فالقاطع هو الممسك لا السكين .
ولهذا يرجع إليه المدح والذم ويلحقه الثواب والإثم فيما فعل ، والسكين صورة ظهر منها فعل ممسكها لا هي القاطعة .
وإذا قيل عنها أنها القاطعة كان هذا وصفها باعتبار اليد الممسكة لها لا باعتبارها هي في نفسها ، ولا حلول لليد فيها ولا اتحاد لها ، وإنما هي حقيقة واليد حقيقة أخرى ، وهكذا جميع الأسباب عند المهتدين .
وللّه المثل الأعلى في السماوات والأرض ، وأهل هذا القول هم المسلمون المحمديون ، فإذا أحيا اللّه تعالى الموتى بصورة عيسى عليه السلام لا يلزم أن يكون اللّه تعالى هو عيسى عليه السلام ، كما أن الكاتب إذا كتب بالقلم مثلا لا يلزم أن يكون الكاتب هو القلم .
وإذا اعتبر القلم لا مدخل له بالكلية في الكتابة ، وإنما الكتابة فعل ، والكاتب وحده يصح أن يقال حينئذ إن الكاتب هو القلم بعد فناء القلم واضمحلاله في وجود الكاتب حيث لا تأثير له البتة .
وفي عيسى عليه السلام كذلك إذا لم يعتبر فيه وجوده المستفاد من القيوم عليه واضمحلت رسوم الأنانية في حقيقته يصح فيه ذلك قولهم عنه بعد ذلك إنه ابن مريم واعتبار وجود صورته الناسوتية يأبى ذلك ومن ناظر فيه ، أي عيسى عليه السلام
(من حيث الصورة ) الروحانية (المتمثلة البشرية فينسبه لجبريل) عليه السلام ويقول فيه : إنه مثل جبريل عليه السلام لما تمثل في صورة البشر السوي ، فهو ملك بشر وهو قول المسلمين أيضا ، والمحيي للموتى هو اللّه تعالى أيضا متجليا بصورته كما تجلى على مريم بصورة جبريل عليه السلام بعد تصوّره في صورة البشر السوي ، ونفخ سبحانه في مريم ، فكان عيسى عليه السلام ، ولهذا نسب تعالى النفخ فيه ، فقال :"وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا"[ الأنبياء : 91 ] .
فيكون هنا في إحياء الموتى بعيسى عليه السلام للّه تعالى تجل بثلاث صور : صورة جبريل الأصلية من غير أن تتغير ، وصورة البشر السوي التي جاء بها جبريل إلى مريم عليها السلام ، وصورة عيسى عليه السلام ، وذلك في إبراء الأكمه والأبرص .
وهذا هو التثليث الصحيح في الملة العيسوية المعبر عنه باسم الأب ، وهو صورة البشر السوي ، والابن وهو صورة عيسى عليه السلام ، وروح القدس وهو جبريل عليه السلام بصورته الأصلية النورية الملكية . وهذه الثلاثة هو اللّه تعالى باعتبار تجليه سبحانه بهذه الصور الثلاث التي بعضها فوق بعض بالمراتب الوجودية ، على معنى أنه قيوم عليها وهي ممسوكة به ، لا أن له حلولا في شيء منها ، ولا اتحادا له بها ، ولا انحلالا لها منه : "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( 3 ) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ"( 4 ) [ الإخلاص 3 - 4 ] .
(ومن ناظر فيه) ، أي عيسى عليه السلام (من حيث ما ظهر عنه من إحياء الموتى فينسبه إلى اللّه) تعالى (بالروح) ، أي بسبب روحه الأمري المنفوخ فينقطع استهلاكه بالصورة الناسوتية في الحقيقة اللاهوتية فيقول فيه إنه روح اللّه كما قال سبحانه :وَرُوحٌ مِنْهُوهذا القول قريب مما قبله لكن لا اعتبار فيه للصورة المتمثلة أي به ، يعني بعيسى عليه السلام الذي هو روح اللّه ظهرت الحياة فيمن نفخ فيه من الطير والموتى ، وهذا القول أيضا للمسلمين لورود القرآن والسنة به ، وإنما الكافرون أخذوا القول الأوّل منها وهو كونه ابن مريم وادعوا حلول الألوهية فيه .
وبعضهم أخذ القول الثاني وادعى اتحاد الألوهية ، وأنه بهذا الاعتبار نفس الإله ، فقالوا : إن الإله تثلث وانقسم إلى أب وابن وروح قدس .
ثم قالوا : إله واحد ، وجعلوا الثلاثة أقانيم ، والأقنوم في لغتهم معناه الأصل ، أي أصول ثلاثة ، ثم سموها ثلاث صفات فقالوا : وجود وحياة وعلم .
ثم قالوا : حل أقنوم العلم وحده في عيسى ابن مريم .
ثم قالوا فيه : أنه صلب ناسوته فانفصل منه أقنوم العلم ورجع إلى أصله وخبطوا خبطا فاحشا وجهلوا جهلا خبيثا .
وقد رد عليهم أهل الكلام بعد رد القرآن العظيم حيث كفروا كفرا : "تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا ( 90 ) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً ( 91 ) وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً"( 92 )[ مريم : 90 ] .
والحق ما عليه أئمة الإسلام وهو الصواب في نفس الأمر أن عيسى عليه السلام كانت حقيقته الظاهرة قابلة لثلاث اعتبارات بحسب ما ذكر فتارة يكون الحق تعالى فيه ، أي في عيسى عليه السلام متوهما بصيغة اسم مفعول حيث هو من روح اللّه والروح من أمر اللّه كما قال تعالى: "وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي" [ الإسراء : 85 ] .
وبهذا الاعتبار تكون ملكيته وبشريته مستهلكتين في أمر اللّه تعالى النازل بالحقيقة العيسوية وتارة يكون الملك بفتح اللام واحد الملائكة عليهم السلام فيه ، أي في عيسى عليه السلام متوهما بصيغة اسم مفعول لأنه نشأ في فرج أمه مريم عليها السلام بنفخ الملك فيها بأمر اللّه تعالى ، لأن الملائكة عليهم السلام لا يعملون إلا بأمر اللّه تعالى .
قال سبحانه :" وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ " [ الأنبياء 27 ] ولا ينشأ عن الملك إلا ملك كما أنه لا ينشأ عن الإنسان إلا إنسان وعن الطير إلا طير .
وهكذا وبهذا الاعتبار تكون الحضرة الأمرية الإلهية والنشأة البشرية غائبتين في الحقيقة الملكية الروحانية منه .
وتارة تكون البشرية الإنسانية فيه أي في عيسى عليه السلام متوهمة أيضا بصيغة اسم مفعول ، لأنه نشأ عن صورة البشر السوي الموهومة وعن الصورة البشرية المحققة من أمه مريم عليها السلام ولا ينشأ عن البشر إلا بشر فيكون ، أي عيسى عليه السلام عند كل ناظر إليه كما ذكر بحسب ما يغلب عليه ، أي على ذلك الناظر من اعتبار النشأة العيسوية بحسب الوجوه الثلاث فهو ، أي عيسى عليه السلام كلمة اللّه تعالى وقول اللّه كما قال تعالى :وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ.
وقال سبحانه : " ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ"[ مريم : 34 ] .
باعتبار الوجه الأوّل لكون الحق تعالى فيه متوهما اسم مفعول .
وهو أيضا روح اللّه كما قال سبحانه : "وَرُوحٌ مِنْهُ ".
باعتبار الوجه الثاني لكون الملك فيه متوهما وهو أيضا عبد اللّه .
كما قال تعالى : "إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ" [ الزخرف : 59 ] ، وقال تعالى : " لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً" [ النساء : 172 ] .
وقال تعالى : " إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً" [ مريم : 93 ] .
وقال تعالى :" إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" [ آل عمران : 59 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وليس ذلك في الصّورة الحسّيّة لغيره ، بل كلّ شخص منسوب إلى أبيه الصّوري لا إلى النّافخ روحه في الصّورة البشريّة .
فإنّ اللّه إذا سوّى الجسم الإنسانيّ كما قال :فَإِذا سَوَّيْتُهُ [ الحجر : 29 ] نفخ فيه هو تعالى من روحه .
فنسب الرّوح في كونه وعينه إليه تعالى . وعيسى ليس كذلك ، فإنّه اندرجت تسوية جسمه وصورته البشريّة بالنّفخ الرّوحيّ ، وغيره كما ذكرناه لم يكن مثله .
فالموجودات كلّها كلمات اللّه الّتي لا تنفذ ، فإنّها عن « كن » وكن كلمة اللّه .
فهل تنسب الكلمة إليه بحسب ما هو عليه فلا تعلم ماهيّتها أو ينزل هو تعالى إلى صورة من يقول « كن » فيكون قول كن لتلك الصّورة الّتي نزل إليها وظهر فيها ؟
فبعض العارفين يذهب إلى الطّرف الواحد ، وبعضهم إلى الطّرف الآخر ، وبعضهم يحار في الأمر ولا يدري . )
(وليس ذلك) ، أي الوجوه الثلاثة المذكورة (في الصورة الحسية لغيره) ، أي عيسى عليه السلام من جميع الناس ولا لآدم عليه السلام ، فإن اللّه تعالى ما خلقه بواسطة ملك تصوّر في صورة بشر ، وإنما خمر طينته بقدرته سبحانه ، ثم سواها بلا واسطة ونفخ فيه من روحه بلا واسطة ، والمثلية في قوله تعالى :إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍثم قال له كن فيكون باعتبار ما ذكره من خلقه من تراب ، ثم تكوينه له بنفخ الروح فيه ولا واسطة بالنظر إليه تعالى ، ولهذا قال في عيسى عليه السلام : فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا [ الأنبياء : 91 ] .
ولم يذكر سبحانه واسطة نفخ الملك ، وهذا معنى التقييد بالعندية في قوله تعالى :إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ، ولم يطلق سبحانه : فإِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ.
وأما مثله عندنا فليس كذلك لاعتبارنا الواسطة كما هي كذلك في عيسى عليه السلام دون آدم عليه السلام .
ولهذا اعتبرها سبحانه في موضع آخر من كلامه حيث قال : " فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّ ( 18 ) قالَ: " إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا " ( 19 ).
بل كل شخص من الناس منسوب إلى أبيه الصوري المتوجه على إلقاء نطفته في رحم أمه ؛ ولهذا قال تعالى : " ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ " [ الأحزاب : 5 ] .
وقال تعالى : "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ" [ البقرة : 332 ] ، وهو الأب ، فإذا زال حكم الدنيا وتكوين الناس فيها عن الوسائط الظاهرة في الطبيعة وكان يوم القيامة ظهرت عندية اللّه .
قال تعالى : " فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ" [ المؤمنون : 101 ] ، وسبب ذلك النشأة الأخرى التي يتكوّن فيها الكل عن أمر اللّه تعالى من غير واسطة .
وقال تعالى " :يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ( 34 ) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ " [ عبس : 34 - 35 ].
وذلك لبطلان النشأة التي كانت في الدنيا مبنية على السببية بالوسائط وارتفاع الأنساب بالنشأة التي قال تعالى : " وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى( 47 )" [ النجم : 47 ]
فيشبه الناس حينئذ خلق آدم عليه السلام بظهور الأمر لهم في عين ما طلبه إبراهيم عليه السلام في الدنيا بقوله :" رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى" [ البقرة : 260 ] .
فيريهم اللّه تعالى كلهم كيف يحيي الموتى في ذلك اليوم الآخر وهو قوله تعالى : " يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ "( 6 ) [ المطففين : 6 ] ، أي لا لأنفسهم ولا لبعضهم بعضا لا منسوب إلى الحق تعالى النافخ فيه روحه من أمره تعالى في الصورة البشرية التي صورناها من النطفة في رحم الأم بالملك الذي أرسله لذلك .
فإن اللّه تعالى إذا سوى الجسم الإنساني من النطفة في الرحم كما قال تعالى في آدم عليه السلام من غير واسطة ، وفي غيره بواسطة الملك المرسل إلى الرحم كما ورد في الحديث فإذا سويته والتسوية تصويره في الصورة الإنسانية ونفخ فيه ، أي في ذلك الجسم المسوّى هو ، أي اللّه تعالى من روحه فنسب الروح في كونه ، أي وجوده لنفسه وفي عينه ، أي تعينه بالصورة المخصوصة المنفوخ هو فيها إليه تعالى فقيل : روح اللّه .
وقال تعالى: " فَأَرْسَلْنا إليها رُوحَنا " [ مريم : 17 ]
وقال تعالى : " وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" [ الحجر : 29 ] .
فالروح منسوب إلى اللّه تعالى قبل النفخ وبعده ، لأنه مخلوق من أمره بلا واسطة .
وعيسى عليه السلام في خلقته ليس كذلك ، أي ليس مثل كل شخص من الناس فإنه اندرجت تسوية جسمه وصورته البشرية بالنفخ الروحي فيه فكان النافخ مسويا جسمه وصورته الإنسانية ومعطيا له الروح فيها بفعل واحد وهو النفخ الواحد وغيره .
أي غير عيسى عليه السلام من كل شخص من الناس كما ذكرناه قريبا لم يكن مثله ، أي مثل عيسى عليه السلام بل كان جسمه الإنساني قد سوّاه اللّه تعالى أوّلا ، فلما تمت تسويته نفخ فيه من روحه فلم يخلق اللّه تعالى أحدا كخلقه عيسى عليه السلام أصلا ، ولهذا صحت فيه الوجوه الثلاثة المذكورة دون غيره من المخلوقات .
وإن صح في كل شيء أن يقال إنه كلمة اللّه وإنه روح اللّه وإنه عبد اللّه باعتبار خلق اللّه تعالى كل شيء بقوله :كُنْ فَيَكُونُوقيام كل شيء به تعالى ، لأنه الحي القيوم وبأمره سبحانه كما قال : "أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ " [ الروم : 25 ] ،
ويتنزل الأمر بينهنّ .
وقال :" ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ " [ الطلاق : 5 ] ، وأخبر
أن كل شيء يسبح بحمده ولا يسبح إلا ذو روح ، فكل شيء له روح من أمر اللّه قيوم عليه باللّه ، وكل شيء عبد اللّه كما قال سبحانه :إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً( 93 ) [ مريم : 93 ].
ولكن لم يخلق اللّه تعالى شيئا مثل كيفية خلقه لعيسى عليه السلام كيفية باعتبار ترتيب الوسائط لا باعتباره وهو سبحانه الخالق لكل شيء ، لأنه مافِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ[ الملك : 3 ]
وخلقه كله سواء بالنسبة إليه تعالى كما ذكرناه ، وإنما الفرق بالنسبة إلينا ؛ ولهذا قال تعالى :إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِكما قدمناه .
فالموجودات كلها المحسوسات منها والمعقولات والموهومات كلمات اللّه تعالى التي لا تنفد
كما قال سبحانه : " قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً "( 109 ) [ الكهف : 109 ] .
وقال تعالى : " وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ " [ لقمان : 27 ] فإنها ، أي جميع الموجودات صادرة عن اللّه تعالى بقوله سبحانه كن لكل شيء منها فيكون وكن كلمة اللّه تعالى ، وقد تضمنت الشيء لتوجهها به عليه ، فالشيء لها بمنزلة الحروف الحاملة بطريق الدلالة للمعنى المراد ، وكُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُوهو كن لتوجهها منه تعالى لأنها أمره ، فالأمر الإلهي هو الكلام النفسي ، والخلق بمنزلة الكلام اللفظي كما قال تعالى :"أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ "[ الأعراف : 45 ].
فهل تنسب الكلمة الإلهية التي هي كن إليه تعالى بحسب ما هو تعالى عليه من التنزيه المطلق الذي لا يعلم به إلا هو فلا تعلم ، أي لا يعلم أحد ماهيتها ، أي تلك الكلمة كباقي حضراته تعالى فنسلمها له ونؤمن بها على ما يعلمه هو منها لا على ما نعلم نحن ، لأنه تعالى يعلم ونحن لا نعلم جميع ما يكون له سبحانه كما قال :وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[ البقرة : 216 ] .
وقال الملائكة : " سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا " [ البقرة : 32 ]
أو نقول : ينزل هو ، أي اللّه تعالى إلى صورة من يقول من ملائكة أو بعض خلقه كن للشيء الذي يريده اللّه تعالى .
فيكون حينئذ قول كن حقيقة معلومة لنا منسوبة لتلك الصورة التي نزل إليها الحق تعالى فتجلى بها وظهر فيها بقيوميته عليه
فبعض العارفين من أهل اللّه تعالى يذهب إلى الطرف الواحد وهو الأوّل.
وبعضهمأي العارفين يذهب إلى الطرف الآخر وهو الثاني
وبعضهم ، أي العارفين يحار في الأمر الإلهي ولا يدري ما هو .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وهذه مسألة لا يمكن أن تعرف إلّا ذوقا كأبي يزيد حين نفخ في النّملة الّتي قتلها فحييت فعلم عند ذلك بمن ينفخ فنفخ فكان عيسوي المشهد .
وأمّا الإحياء المعنويّ بالعلم فتلك الحياة الإلهيّة الذّاتيّة العليّة النّوريّة الّتي قال اللّه فيها :أَ وَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ[ الأنعام 122 ].
فكلّ من يحيي نفسا ميتة بحياة علميّة في مسألة خاصّة متعلّقة بالعلم باللّه ، فقد أحياه بها فكانت له نورا يمشي به في النّاس أي بين أشكاله في الصّورة .
فلولاه ولولانا ... لما كان الذي كان
فإنا أعبد حق ... وإن الله مولان
وإنا عينه فاعلم ... إذا ما قلت إنسان
فلا تحجب بإنسان ... فقد أعطاك برهان
فكن حقا وكن خلقا ... تكن بالله رحمان
وغذ خلقه منه ... تكن روحا وريحان
فأعطيناه ما يبدو ... به فينا وأعطان
فصار الأمر مقسوم ... بإياه وإيان
فأحياه الذي يدري ... بقلبي حين أحيان
فكنا فيه أكوان ... وأعيانا وأزمان
وليس بدائم فين ... ولكن ذاك أحيانا )
(وهذه) ، أي مسألة الأمر الإلهي المتوجه على إيجاد الكائنات من قوله تعالى : (كُنْ فَيَكُونُ)(مسألة) عظيمة (لا يمكن أن تعرف) ، أي يعرفها أحد (إلا ذوقا ) ، أي كشفا من نفسه وهو النظر التام في قوله تعالى :أ " َفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( 17 ) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ( 18 ) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ( 19 ) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ" [ الغاشية : 17 - 20 ] .
وقوله تعالى : " أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً" [ النحل : 48 ] .
وهو نظر الاعتبار ورؤية المعرفة والاستبصار كأبي يزيد البسطامي رضي اللّه عنه حين نفخ في النملة التي قتلها فحييت بإذن اللّه تعالى فأمات وأحيا بإذن اللّه تعالى فعلم ، أي أبو يزيد عند ذلك ، أي عند الإحياء بمن ينفخ ، أي بربه القيوم عليه فنفخ به سبحانه لا بنفسه هو بحيث كان النافخ هو الحق تعالى بفم أبي يزيد ، مثل جبريل كما نفخ عيسى عليه السلام في مريم عليها السلام ، فإن نفخه ذلك كان باللّه تعالى ، بل هو نفخ تعالى بجبريل عليه السلام .
وكذلك عيسى عليه السلام لما أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص ونفخ في الطير كان ذلك منه باللّه تعالى ، بل من اللّه تعالى به .
وأبو يزيد رضي اللّه عنه ذاق ذلك في نفسه وتحقق به (فكان عيسوي المشهد) ، أي يشهد من الحق تعالى ما يشهد عيسى عليه السلام وهذا في الإحياء الحسي .
(وأما الإحياء المعنوي بالعلم) باللّه تعالى للموتى بالجهل به كالكافرين والمشركين والمغرورين والغافلين فتلك هي الحياة الإلهية ، أي المنسوبة إلى الإله تعالى الذاتية ، أي التي لا تفارق من اتصف بها ، لأنها كمال له باعتبار ذاته لا عرضية مفارقة له كالحياة الحسية العلية ، لأنها حياة الحق تعالى .
والحياة الحسية التي هي بسريان الروح الأمري في الجسم مستحيلة على الحق تعالى ، لأنها حياة سفلية طبيعية النورية ، لأنها بالنور الذي هو العلم الإلهي ، والحياة الحسية ظلمانية ، لأنها بالغير والغير ظلمة .
وإن كان لا حياة في نفس الأمر إلا بالعلم الإلهي والحياة بالروح كذلك ، لأنها إذا لم يصحبها العلم باللّه عن ذوق وكشف كانت مجرد حركات طبيعية وإدراكات وهمية في أجسام حيوانية وعقول شيطانية في نفوس شهوانية .
فهي موت لا حياة وإن عدها صاحبها حياة لعدم ذوقه الحياة كما قال تعالى وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ[ فاطر : 22 ] .
ولهذا كان شرط وجود الحياة العلمية الحقيقية الموت من تلك الحياة الطبيعية الوهمية النفسانية فقال عليه السلام : « موتوا قبل أن تموتوا » ، أي موتوا اختيارا قبل أن تموتوا اضطرارا التي قال اللّه تعالى فيها ، أي في تلك الحياة المذكورة " أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً " [ الأنعام : 122 ] .
ذكره ابن حجر العسقلاني في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع يعني بالجهل باللّه تعالى وهو الموت الحقيقي فَأَحْيَيْناهُ بالحياة العلمية النورانية الحقيقية المذكورة "وجعلنا له نورا" [ الأنعام : 122 ] .
وهو الروح العلمي الذي نفخه فيه فأحياه بالحياة المذكورة " يَمْشِي بِهِ " [ الأنعام : 122 ] ، أي بذلك النور وهو قوله تعالى :اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [ النور : 35 ] .
وفي الحديث : " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه " في الناس ، أي بين أمثاله فيعرفهم ولا يعرفونه ويؤمن بهم ويجحدونه ، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولو جعل اللّه تعالى لهم ما جعل له من النور لمشوا به فيه كما مشى هو به فيهم .
قال تعالى :" وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ " [ النور : 40 ] .
فكل من أحيا نفسا ميتة بالجهل باللّه تعالى بالحياة العلمية الألوهية ولو في مسألة خاصة متعلقة بالعلم باللّه تعالى لا بما سواه فإن ذلك ليس بعلم أصلا في نفس الأمر عند العارف ، وإن سماه الجاهل علما ، لأن أحوال الناس متفاوتة كما قال تعالى :"كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" [ المؤمنون : 53 ] .
فقد أحياه بها ، أي بتلك المسألة الإلهية حياة ذاتية لا عرضية علوية ، ولا سفلية نورانية ، ولا ظلمانية قلبية ، ولا نفسانية حقيقية ، ولا وهمية باقية ، ولا فانية دينية ، ولا دنيوية .
وكانت ، أي تلك المسألة له نورا يمشي به في الناس أي بين أشكاله وأمثاله في الصورة الآدمية فيعلو عليهم بالعلم ويسفلون عنه بالجهل
شعر :
قال رضي الله عنه :
( فلولاه ولولانا ... لما كان الذي كانا)
(فلولاه )، أي الحق تعالى الذي هو نور السماوات والأرض بالعلم الإلهي الظاهر في القابل المستعد له من أهل السماوات والأرض على حسب قابليته واستعداده ، والكل قابل ومستعد لما هو فائض عليه من ذلك النور ومن طلب فوق قابليته واستعداده لا يجد ذلك ؛ ولهذا قال :
ولولانا فإن النور عين الوجود ، وقد اتصف بالوجود كل شيء ، فهو متصف بالعلم ولا علم إلا باللّه كما أنه لا جهل إلا باللّه تعالى ، والجاهل ناقص العلم باللّه تعالى ، فلا جهل باللّه من كل وجه بل الكل عالم باللّه .
ولكن قال تعالى : " وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ " [ يوسف : 76 ] ، وأخبر أنه سبحانه :"رَفِيعُ الدَّرَجاتِ"[ غافر 15 ] ،
وقال سبحانه : " يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ " [ المجادلة 11 ]
والكل آمنوا ولو من وجه والكل أُوتُوا الْعِلْمَ ولو بشيء ، فهم مرفوعون ولكن رفعتهم درجات متفاوتة ، وذلك عين ما هم فيه وهي درجاته ، لأنه رفيع الدرجات لما كان الذي كانا وهو الظهور الصفاتي في عين البطون الذاتي ؛ ولهذا قال :
(فإنا أعبد حق ... وإن الله مولانا)
(فإنا) معشر الكائنات (أعبد) جمع عبد (حقا) على حسب ما في كل واحد من العبودية ، فالبطون بالربوبية على مقدار الظهور بالعبودية .
فمن كثرت عبوديته كثر فيه ظهور ربوبية اللّه تعالى .
ومن قلّت فيه العبودية ، كثر فيه بطون الربوبية .
وأن اللّه سبحانه (مولانا) بربوبيته لنا وهذا حكم الظهور والبطون وهما تجليان صفاتيان.
وأما التجلي الذاتي فقد أشار إليه بقوله:
(وإنا عينه فاعلم ... إذا ما قلت إنسانا )
(وأنا) معشر الكائنات أيض (عينه) ، أي بعد فنائنا في أنفسنا ذوقا وكشفا ،لأنه لا يبقى إلا هو.
(فاعلم) يا أيها السالك هذه الأنانية الذاتية بعد تلك الأنانية الصفاتية الاسمائية ، وهذا الجمع بعد ذلك الفرق إذا ما قلت أنت أو أنا إنسانا فإن الإنسان هو الكامل في النشأة ، العارف بنفسه وبربه الجامع بالمعنى الفارق بالصورة ، وما عداه من الناس فهو إنسان ناقص ، غلبت عليه الحيوانية ، ولم يكمل فيه ظهور الربوبية لنقصان العبودية .
(فلا تحجب بإنسان ... فقد أعطاك برهان )
(فلا تحجب) يا أيها السالك عن العين الإلهية الحقيقة الوجودية المطلقة (بإنسان) كامل أو ناقص ، فإنه ظهور لتلك العين المطلقة على التمام أو على النقص .
فقد أعطاك ، أي الحق تعالى برهانا فيك على أنه عينك تشهده منك ذوقا وكشفا في طور كمالك ، وهو قوله تعالى في يوسف عليه السلام :" لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ " [ يوسف : 24 ] .
ثم أشار إلى جمع الجمع وهو الفرق الثاني بعد الجمع بقوله :
(فكن حقا وكن خلقا ... تكن بالله رحمانا)
(فكن) يا أيها السالك (حقا) بعين وجودك القائم الدائم (وكن خلقا) بصورك الثلاث الصورة الروحانية العقلية ، والنفسانية الخيالية ، والجسمانية الطبيعية العنصرية .
تكن حينئذ باللّه تعالى متحققا من حيث صورتك الروحانية العقلية رحمانا مستويا بصورتك النفسانية الخيالية على عرش جسمانيتك الطبيعية العنصرية.
وصورتك الجسمانية الطبيعية العنصرية لها قلب وهو عرشه ، ودماغ وهو كرسيه ، وصفات سبعة هي كواكبها ، في أفلاك سبعة ، وهي قواها العرضية ، في مواضع سبعة هي سمواتها ، ويظهر عن تلك الكواكب في سباحتها في أفلاكها مواليد أربعة جماد العمل القاصر ، ونبات العمل المتعدي ، وحيوان الاعتقاد القاصر ، وإنسان الاعتقاد المتعدي ، عن عناصر أربعة : تراب الخاطر ، وماء النية ، وهواء العزم ، ونار الهمة .
وهو قوله :
(وغذ خلقه منه ... تكن روحا وريحانا )
(وغذّ) أمر من الغذاء وهو القوت الذي به القوام (خلقه) تعالى ، أي مخلوقاته وهي المواليد الأربعة فيك العمل القاصر والمتعدي ، والاعتقاد القاصر والمتعدي ، فعملك واعتقادك خلقه سبحانه .
وذلك في يوم القيامة متصوّر في صورة حسنة أو قبيحة ، يحشر مع صاحبه ويوزن ويحاسب عليه ويجازى به ، فأمره أن يغذيه أي يقيته ويمده منه تعالى بماء النية ومأكل الإخلاص تكن حينئذ يا أيها الفاعل ذلك روحا لذلك العمل والاعتقاد القاصر والمتعدي الذي خلقه اللّه فيك فيكون عملك حيا .
وكذلك اعتقادك بنوعيه فيحملك بكونه مظهرا لك كونك متجليا به ، فهو كلمك الطيب الصاعد بك إلى ربك كما قال سبحانه: " إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ" [ فاطر : 10 ]
كما أن عمل ربك حي بربك ، وعلمه كذلك فهو مظهر له لأنه متجل به ، فهو نازل إليك منه تعالى وتكن ريحانا ، أي زكاء أو طيبا لعملك واعتقادك القاصر والمتعدي ، أو أن المعنى قيام السالك بالفرق والجمع حتى يكون متحققا في نفسه بجمع الاسم اللّه ، وظاهرا بين الناس بفرق الاسم الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء .
فهو مأمور حينئذ أن يغذي خلق اللّه من كل من وجده مؤمنا به بالغذاء الرحماني ، وهو العلم الإلهي منه تعالى لا من نفسه بحسب فتوح الوقت ، فإنه يكون له حينئذ روحا معنويا بنفخه فيه ، فيحييه به حياة علمية ذاتية إلى الأبد ، وريحانا : أي جنة معنوية يدخله فيها ، عيونها جارية وقطوفها دانية .
(فأعطيناه ما يبدو ... به فينا وأعطان )
(فأعطيناه ) ، أي الحق تعالى (ما يبدو) ، أي يظهر من العمل والاعتقاد بنوعيه به ، أي بقدرته فينا ، وهو الكلم الطيب الذي يصعد إليه ، وإذا أعطيناه ذلك فلا يبقى عندنا دعوى له ، فإذا قدمنا عليه لا نقدم عليه بشيء بل نقدم عليه به ، لأنه هو الذي يبقى عندنا فنعمل به ما نعمل وأعطانا هو أيضا ما يبدو ، أي يظهر بنا من عمله وعلمه وهو كلماته التامات .
فإذا قدم علينا لا يقدم علينا أيضا بشيء ، وإنما يقدم علينا بنا لأننا نحن الذين نبقى عنده فيعمل بنا ما يعمل ، أو المعنى أن الذي نغذي به خلقه من الطالبين لمعرفته إذا أعطيناهم إياه فقد أعطيناه ما يظهر به سبحانه فينا من فيضه ، وأعطانا هو أيضا ما يظهر بنا فيه من استعدادنا لكماله وفيض جلاله وجماله
.
(فصار الأمر مقسوم ... بإياه وإيانا )
(فصار) بسبب ما ذكر منا ومنه سبحانه الأمر الإلهي الواحد (مقسوما ) بيننا وبينه بإياه وهو البطون والجمع وإيانا وهو الظهور والفرق .
(فأحياه الذي يدري ... بقلبي حين أحيان )
(فأحياه) سبحانه من حيث ظهوره بنا الوجود الحق (الذي) هو (يدري) به ، أي يعلمه فلا يعلمه غيره وهو لقلبي الذي وسعه كما ورد : « ما وسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن ".
حين أحيانا نحن أيضا من حيث بطونه عنا بما أحيا به نفسه في ظهوره بن .
(فكنا فيه أكوان ... وأعيانا وأزمان )
(فكنا) بانقلاب الأمر الذي وسعناه به وهو قلبن (فيه) سبحانه (أكوانا) جمع كون وأعيانا جمع عين وأزمانا جمع زمان ، وذلك جميع العوالم في بصائر العارفين كلها ثابتة من غير وجود لأنه عين الوجود ، فلا يصير وصفا لغيره وهو قوله تعالى :" يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا" [ إبراهيم : 27 ].
أي يجعلهم ثابتين لا منفيين فإن المنفي هو المحال وهم ممكنون والمضارع حكاية الأزل .
ثم قال تعالى بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وهو عين الوجود الحق من حيث هو أمر نازل كلمح بالبصر .
ثم عمم تعالى هذا الحكم فيهم فقال: " فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ" [ إبراهيم : 27 ] ، أي يحيرهم فلا يهديهم إلى معرفة الأمر على ما هو عليه لظلمهم لأنفسهم أو لغيرهم ، فكلما عدلوا عن الحق عدل بهم " فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ"[ يونس : 32 ] .
(وليس بدائم فين ... ولكن ذاك أحيانا )
وليس ما ذكر من شهود الثبوت في الوجود بدائم فينا معاشر المؤمنين ولكن ذاك أحيانا ، أي في أوقات دون أوقات ، فلا بد من شهود الثبوت في الوجود ، وشهود الوجود في الثبوت ، فالوجود واحد والثبوت كثير ، والوجود مطلق والثبوت مقيد ، والوجود له الظهور والبطون والثبوت له الظهور والبطون ، وهما كالليل والنهار ، بل الليل والنهار كما قال تعالى :" وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وهي القمر وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً"[ الإسراء : 12 ] وهي الشمس .
وفي الحديث : " فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر " رواه الترمذي في سننه
. وفي رواية أخرى : " كما ترون الشمس في الظهيرة ". رواه الدارقطني
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وممّا يدلّ على ما ذكرناه من أمر النّفخ الرّوحاني مع صورة البشر العنصريّ هو أنّ الحقّ وصف نفسه بالنّفس الرّحماني ولا بدّ لكلّ موصوف بصفة أن يتبع جميع ما تستلزمه تلك الصّفة ، وقد عرفت أنّ النّفس في المتنفّس ما يستلزمه فلذلك قبل النّفس الإلهيّ صور العالم . فهو لها كالجوهر الهيولانيّ ، وليس إلّا عين الطّبيعة .
فالعناصر صورة من صور الطّبيعة وما فوق العناصر وما تولّد عنها فهو أيضا من صور الطّبيعة ، وهي الأرواح العلويّة الّتي فوق السّموات السّبع . )
(ومما يدل على ما ذكرناه) في مسألة (أمر النفخ الروحاني ) الذي هو من اللّه تعالى (مع صورة البشر العنصري) ولا يمكن أن يعرف إلا ذوقا كواقعة أبي يزيد رضي اللّه عنه المذكورة هو ، أي الذي يدل على ذلك أن الحق تعالى وصف نفسه بسكون الفاء.
أي ذاته على لسان نبيه عليه السلام بالنفس بفتح الفاء الرحماني قال عليه السلام : " أني لأجد نفس الرحمن يأتيني من جهة اليمن " ، ولا بد لكل موصوف بصفة أن تتبع الصفة جميع ما تستلزمه تلك الصفة من الأمور التي لا ثبوت لتلك الصفة إلا بها .
وقد عرفت يا أيها السالك أن النفس بفتح الفاء ، أي الهواء الداخل إلى الجوف الحيواني ثم الخارج منه في المتنفس به من الحيوانات ما يعني أي شيء يستلزمه من الحرارة أو البرودة أو الاعتدال وانفتاح صور الصوت فيه وصور الحروف والكلمات ، وحيث اتصف الحق تعالى بالنفس فقد اتصف نفسه بما يتصف به النفس من صور الطبائع والعناصر والمولدات فلذلك ، أي لما ذكر قبل النفس بفتح الفاء الإلهي صور العالم كلها محسوسها ومعقولها وموهومها فهو ، أي النفس الإلهي لها ، أي لصور العالم كلها كالجوهر ، أي الجزء الذي لا يتجزأ الهيولاني حيث يتركب منه الجسم فيكون ذلك الجسم هيولي ، أي مادة الصور كثيرة تجعل منه كالخشبة تجعل الباب والصندوق والكرسي ، والطين يجعل منه الكوز والجرة والخابية ، والعجين يجعل منه الرغيف والقرص والكعك ونحو ذلك .
(وليس) كالجوهر الهيولاني (إلا عين الطبيعة) الكلية الحاملة لصور العالم التي تنقسم إلى أربعة أقسام وتتكاثف بالعناصر (فالعناصر) المنقسمة إلى أربعة أيضا (صورة من صور الطبيعة) وجميع ما فوق العناصر وفوق ما تولد عنها ، أي عن العناصر من السماوات السبع وملائكتها عليهم السلام فهو أيضا من صور الطبيعة المذكورة وهي ، أي ما فوق العناصر والمتولد منها الأرواح العلوية وهم الملائكة عليهم السلام التي فوق السماوات السبع ملائكة العرش والكرسي .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا أرواح السّموات السبع وأعيانها فهي عنصريّة ، فإنّها من دخان العناصر المتولّد عنه .
وما تكوّن من كلّ سماء من الملائكة فهو منها ، فهم عنصريّون ومن فوقهم طبيعيّون ، ولهذا وصفهم اللّه بالاختصام - أعني الملأ الأعلى - لأنّ الطّبيعة متقابلة .
والتّقابل الّذي في الأسماء الإلهيّة الّتي هي النّسب إنّما أعطاه النّفس .
ألا ترى الذّات الخارجة عن هذا الحكم كيف جاء فيها الغنى عن العالمين ؟
فلهذا خرج العالم على صورة من أوجدهم ، وليس إلّا النّفس الإلهيّ . )
(وأما أرواح) ، أي ملائكة (السماوات السبع وأعيانها) ، أي أعيان السماوات السبع وهي ذواته (فهي عنصرية فإنها) متكونة من دخان العناصر وبخارها يوم خلقها اللّه تعالى (المتولد) ذلك الدخان عنها ، أي عن العناصر وما تكون بتشديد لواو (عن كل سماء) من السماوات السبع من الملائكة بيان للمتكون فهو ، أي ذلك المتكون منها ، أي من نوع تلك السماء .
قال تعالى :" وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها " [ فصلت : 12 ] ، وهو الذي تعمل به ملائكة تلك السماء كما قال تعالى :" وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ " [ الأنبياء : 27 ] فهم ، أي ملائكة السماوات السبع عنصريون ، أي مخلوقون من دخان العناصر الأربعة فهم ألطف من الجن والشياطين المخلوقين من العناصر الأربعة وفي الكل قوّة التشكل والتصوّر في الصور المختلفة على حسب ما يريدون من غير أن يتغيروا عن صورهم الأصلية العنصرية لغلبة الروحانية ولطافة الجسمانية ومن فوقهم ، أي من فوق ملائكة السماوات السبع عليهم السلام ملائكة طبيعيون ، أي مخلوقون من الطبيعة لا من العناصر ؛ ولهذا ، أي لكونهم طبيعيين وصفهم اللّه تعالى في القرآن بالاختصام ، أي المجادلة والاختلاف فيما بينهم أعني بهم الملأ الأعلى وهم ملائكة العرش والكرسي وما شاكل ذلك .
قال تعالى عن نبيه عليه السلام :" ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ" [ ص : 69 ] وفي حديث الترمذي بإسناده عن ابن عباس .
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " أتاني الليلة آت من ربي " .
وفي رواية : « أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ، فقال : يا محمد ، فقلت : لبيك ربي وسعديك ، قال هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟
قلت : لا أعلم . قال : فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي ، أو قال في نحري ، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ، أو قال ما بين المشرق والمغرب .
قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ، قلت : نعم في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات . وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
قال : يا محمد ، قلت : لبيك وسعديك ، قال : إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون .
قال : والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام " . رواه الترمذي والدارقطني
لأن الطبيعة باعتبار أقسامها الأربعة متقابلة فبعضها يقابل بعضا ، وبالتقابل يقع الاختلاف ويصدر الاختصام .
(والتقابل الذي في الأسماء الإلهية) المنقسمة إلى أسماء جلال وأسماء جمال وأسماء ذاتية وأسماء فعلية (التي هي) مجرد (النّسب) جمع نسبة وهي الاعتبارات الذاتية إنما أعطاه ، أي أعطى التقابل المذكور (النّفس) بفتح الفاء (الرحماني) الحامل لصور العالم كلها وهو عالم الإمكان والأعيان الثابتة بلا وجود التي هي غير مجعولة ألا ترى الذات الإلهية الخارجة عن هذا الحكم وهو التقابل الذي هو مقتضى النسب الأسمائية الصادر عن النفس الرحماني ، والعالم الإمكاني المعدوم الفاني كيف جاء فيها ، أي في تلك الذات الغنى عن العالمين .
قال تعالى : " واللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ " [ آل عمران : 97 ] ، فلهذا ، أي لكون التقابل الاسمائي مقتضى النفس الرحماني خرج العالم من العدم إلى الوجود على صورة من أوجدهم ، أي أشخاص العالم المختلفة وليس الذي أوجدهم إلا النّفس بفتح الفاء الرحماني الإلهي ثم ذلك النفس المذكور انبعث عنه القلم الأعلى ، وهو العقل الأوّل وهو الروح القدسي ، ثم بقيّة الأرواح المهيمة الذين سماهم اللّه تعالى بالعالمين من الملائكة عليهم السلام .
فقال لإبليس :أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ[ ص : 75 ] ، ثم انبعث عن القلم الأعلى نفسه وهو اللوح المحفوظ وهو الروح الأعظم المنفوخ منه في جميع العالم على حسب الاستعداد ، ثم ظهر عن اللوح المحفوظ عالم الطبيعة فالقلم واللوح والطبيعة منطويات في النفس الإلهي ، لأنها اعتبارات فيه ، وكذلك ما بعدها إلى آخر المراتب . ولهذا قال صلى اللّه عليه وسلم : « إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من جهة اليمن » .
كان ذلك هو الأنصار من أهل الصفة مع أنهم أجسام إنسانية ، فانطوت مراتبهم كلها في أصلهم الثابت فسماهم به .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فبما فيه من الحرارة علا ، وبما فيه من البرودة والرّطوبة سفل ، وبما فيه من اليبوسة ثبت ولم يتزلزل ، فالرّسوب للبرودة والرّطوبة ؛ ألا ترى الطّبيب إذا أراد سقي دواء لأحد ينظر في قارورة مائه ، فإذا رآه راسبا علم أنّ النّضج قد كمل فيسقيه الدّواء ليسرع في النّجح . وإنّما يرسب لرطوبته وبرودته الطّبيعيّة .
ثمّ إنّ هذا الشّخص الإنساني عجن طينته بيديه وهما متقابلتان وإن كانت كلتا يديه يمينا فلا خفاء بما بينهما من الفرقان ، ولو لم يكن إلّا كونهما اثنين أعني يدين .
لأنّه لا يؤثّر في الطّبيعة إلّا ما يناسبها وهي متقابلة ، فجاء باليدين . )
فبما ، أي فبالذي فيه ، أي في النفس الإلهي من الحرارة ، عن اعتبار الطبيعة فيه في ثالث مرتبة من مراتبه علا ، أي النفس على مراتب الأكوان كلها وبما فيه ، أي في النفس بالاعتبار المذكور من البرودة والرطوبة سفل ، فانتهى إلى آخر المراتب في عالم الأجسام العنصرية الأرضية وبما فيه ، أي النفس من اليبوسة ثبت على مقدار واحد وميزان واحد ولم يتزلزل كما هو ظاهر في الحس والعقل . قال تعالى :وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ( 19 ) [ الحجر : 19 ] .
(فالرسوب) على وزن واحد بحيث يلتبس بالجمود كما قال تعالى :وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً[ النمل : 88 ] ، وهي عام في الدنيا والآخرة والخاص في الآخرة قوله تعالى :وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ (للبرودة والرطوبة) في النفس الرحماني باعتبار كونه طبيعة كما ذكرنا .
وذلك للثقل الذي فيهما ألا ترى الطبيب إذا أراد سقي دواء لأحد من المرضى ينظر أوّلا في قارورة مائة ، أي بوله بوضع بوله في قارورة من زجاج فينظر فيه فإذا رآه ، أي ماءه يعني بوله رسب ، أي صفا وسكن علم أن النضج في طبيعة ذلك الداء قد كمل فيسقيه الدواء المناسب له ليسرع في النجح فإن الداء إذا لم يأخذ حده في الاستحكام ويكمل في الإنضاج لا يمكن أن يزول ، لأنه يكون في الزيادة وهي ضد النقصان .
(وإنما يرسب) الماء ، أي البول (لرطوبته وبرودته الطبيعية ثم) اعلم (أن هذا الشخص الإنساني عجن) الحق تعالى (طينته) المجموعة من جميع أجزاء الأرض بيديه سبحانه وهما أسماؤه الجمالية وهي يده اليمنى ، وأسماؤه الجلالية وهي يده اليسرى وهما ، أي اليدان متقابلتان بالجمال والجلال .
وإن كانت كلتا يديه تعالى يمينا كما ورد في الخبر ، لأن صفاته تعالى كلها جمالية ، وسمي بعضها جلالية باعتبار أحوال الممكنات التي بها تعين ذلك .
فإذا رجعت تلك الأحوال إلى ثبوتها الأصلي العدمي عادت صفاته تعالى كلها إلى الجمال ولهذا ورد أن الرحمة تسبق الغضب لزوال ما يقتضي ظهور الرحمة غضبا والجمال جلالا وهذا معنى قوله : « كلتا يديه يمين » . رواه مسلم
وقد ورد : « أن اللّه جميل يحب الجمال » رواه مسلم.
وقال تعالى :" بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " [ آل عمران : 26 ] فما في يده تعالى إلا الخير ، والأشياء إما أن تستعد للخير أو للشر .
فالاستعداد اقتضى وجود النوعين ما دام له حكم في الممكن ، فإذا وضع الجبار قدمه في النار يوم القيامة كما ورد في الخبر زال حكم الاستعداد وظهر الخير المحض والجمال الصرف وهو قوله : « كلتا يديه يمين » فلا خفاء مع ذلك لما بينهما .
أي اليدين من الفرقان ظاهرا فإن حكم الاستعداد إذا زال في العبد استحكامه باطنا زال في تأثر النفوس به لا في ظاهر الاتصاف بمقتضاه ، فالنار لا تزول عن كونها نارا بعد وضع الجبار قدمه فيها وانزواء بعضها إلى بعض . وقوله : قط قط .
فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما ورد عنه أنه أخبر بذلك لم يخرجها عن كونها نارا ، أو أهلها الذين هم أهلها لا يزالون فيها كذلك ولو لم يكن في اليدين بصيغة التثنية كما قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إلا كونهما ، أي اليدين اثنتين أعني يدين لا يد واحدة لأنه ، أي الشأن لا يؤثر في الطبيعة إلا ما يناسبها من طبيعة أخرى وهي ، أي الطبيعة متقابلة بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فجاء سبحانه في خلق آدم عليه السلام باليدين مع .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا أوجده باليدين سمّاه بشرا للمباشرة اللائقة بذلك الجناب باليدين المضافتين إليه .
وجعل ذلك من عنايته بهذا النّوع الإنسانيّ فقال لمن أبى عن السّجود له :ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ على من هو مثلك - يعني عنصريّا -أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ[ ص : 75 ] عن العنصر ولست كذلك . ويعنى بالعالين من علا بذاته عن أن يكون في نشأته النّوريّة عنصريّا وإن كان طبيعيّ .
فما فضل الإنسان غيره من الأنواع العنصريّة إلّا بكونه بشرا من طين ؛ فهو أفضل نوع من كلّ ما خلق من العناصر من غير مباشرة .
فالإنسان في الرّتبة فوق الملائكة الأرضيّة والسّماويّة والملائكة العالون خير من هذا النّوع الإنساني بالنّص الإلهيّ .)
(ولما أوجده) ، أي آدم عليه السلام (باليدين) معا سماه تعالى بشرا فقال سبحانه :وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً[ الحجر : 28 ] من طين للمباشرة اللائقة ، أي المناسبة بذلك الجناب الإلهي القديم المنزه عن مشابهة كل شيء باليدين متعلق بالمباشرة المضافتين ، أي المنسوبتين إليه تعالى على حد ما يعلمه هو سبحانه من ذلك لا على حد ما نعلمه نحن ، لأن الحادث لا يعلم من القديم إلا ما يليق بحدوثه ، ولولا الإيمان بالغيب لتساوى المسلم والكافر .
(وجعل) تعالى ذلك الفعل من عنايته ، أي اعتنائه (بهذا النوع الإنساني) ، لأنه ذكره في معرض التفضيل والمنة عليه فقال اللّه تعالى : لمن أبى ، أي امتنع عن السجود له ، أي لآدم عليه السلام وهو إبليس ما منعك ، يعني أي شيء كان مانعا لك أن تسجد ، أي عن سجود كلِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ بتشديد الياء الثانية تثنية يد أستكبرت ، أي تكبرت على من هو مثلك وهو آدم عليه السلام يعني عنصريا ، أي مخلوقا من العناصر الأربعة أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ[ ص : 75 ] جمع عال وهو المرتفع عن كثافة العنصر ولست ، أي يا إبليس كذلك ، أي من الملائكة العالين الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام لعدم معرفتهم به من كمال استغراقهم في شهود اللّه تعالى .
(ونعني) ، أي نريد نحن معشر العارفين بالعالين كل من علا ، أي ارتفع بذاته عن أن يكون في نشأته ، أي خلقته النورية عنصريا ، أي منسوبا إلى العنصر وإن كان في نشأته طبيعيا ، أي منسوبا إلى الطبيعة فما فضل الإنسان غيره من جميع الأنواع العنصرية ، أي المخلوقة من العناصر الأربعة إلا بكونه ، أي ذلك الإنسان بشرا مخلوقا من طين فهو ، أي البشر من الطين أفضل نوع من كل ما خلق من العناصر الأربعة وما تولد منها من غير مباشرة باليدين الإلهيتين فالإنسان في الرتبة فوق الملائكة الأرضية ودخل فيهم الجن لأنهم عنصريون والملائكة السماوية ، لأنهم من دخان العناصر المتولد منها هم وسماواتهم السبع .
(والملائكة العالون خير من هذا النوع الإنساني) ، لأنهم طبيعيون لا عنصريون ، والطبيعة أقرب إلى الأمر الإلهي وألطف من العنصر بالنص الإلهي وهو هذه الآية في قوله تعالى :" أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ " ، أي الذين لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام ، لأنهم أفضل من هذا النوع الإنساني وخير منه لا أنت خير منه ردا لقوله :" أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" [ الأعراف : 12 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فمن أراد أن يعرف النّفس الإلهيّ فليعرف العالم .
فإنّه من عرف نفسه فقد عرف ربّه الّذي ظهر فيه أي العالم ظهر في نفس الرّحمن الّذي نفّس اللّه تعالى به عن الأسماء الإلهيّة ما تجده من عدم ظهور آثارها ، فامتنّ على نفسه بما أوجده في نفسه .
فأوّل أثر للنّفس الرحماني إنّما كان في ذلك الجناب ثمّ لم يزل الأمر ينزل بتنفيس العموم إلى آخر ما وجد .
فالكل في عين النفس ... كالضوء في ذات الغلس
والعلم بالبرهان في ... سلخ النهار لمن نعس
فيرى الذي قد قلته ... رؤيا تدل على النفس
فيريحه من كل غم ... في تلاوته «عبس»
ولقد تجلى للذي ... قد جاء في طلب القبس
فرآه نارا وهو نور ... في الملوك و في العسس
فإذا فهمت مقالتي ... تعلم بأنك مبتئس
لو كان يطلب غير ذا ... لرآه فيه وما نكس )
(فمن أراد أن يعرف النفس) بفتح الفاء (الإلهي فليعرف العالم) بفتح اللام ، لأنه مقتضى ذلك النفس والنفس حامل له كما أن المتأوّه من أمر إذا تنفس الصعداء كان نفسه متضمنا صورة المعنى الذي في قلبه فإنه ، أي الشأن من عرف نفسه بسكون الفاء ما هي في الوجود الظاهر (فقد عرف ربه) ، أي خالقه الذي ظهر هو فيه سبحانه ( أي العالم ظهر في نفس) بفتح الفاء الرحمن الذي نفّس بتشديد الفاء ، أي فرج اللّه تعالى به ، أي بذلك النفس عن حضرة الأسماء الإلهية ما تجده تلك الأسماء من عدم ظهور آثارها المتوجهة من الأزل على إظهار تلك الآثار بظهور متعلق بنفس آثارها على حسب ترتيبها المستعدة به لقبول فيض التجلي الدائم .
(فامتن) سبحانه على نفسه بفتح الفاء بما أوجده سبحانه من العوالم المختلفة على طبق ما في علمه في نفسه بفتح الفاء فأوّل أثر كان للنفس الإلهي إنما كان في ذلك الجناب أي في حضرة الأسماء الإلهية بالتنفيس عما تجده من ذلك الأمر المذكور ثم لم يزل الأمر الإلهي ينزل شيئا فشيئا بتنفيس الغموم ، وتفريج الغيوم إلى آخر ما وجد من آثار الحي القيوم
[ شعر ]
(فالكل) ، أي جميع الموجودات الحادثة من محسوسات ومعقولات
وموهومات (في عين )، أي ذات النفس بفتح الفاء وهو النفس الرحماني المذكور كالضوء الظاهر آخر الليل في ذات الغلس ، أي نفس الغلس وهو الظلمة بعد طلوع الفجر قبل أن ينتشر الضوء جدا ، فإن ذلك الضوء يظهر في تلك الظلمة التي هي بقية ظلمة الليل شيئا فشيئا حتى ينتشر ويملأ الوجود وتختفي الظلمة فيه .
(والعلم ) باللّه تعالى (بالبرهان) العقلي حاصل في وقت سلخ النهار ، أي تمييزه وانفصاله عن ظلمة الليل كالجلد ينسلخ عن الشاة فينفصل منه .
قال تعالى :" وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ" [ يس : 37 ] لمن نعس ، أي غفل عن الأمر على ما هو عليه لاعتماده على نظره العقلي ، فإنه داخل في عين النفس الإلهي قائم به وهو برهانه ذلك من غير شعور منه .
فيرى ، أي يرى صاحب العلم بالبرهان وهو الناعس من الغفلة الأمر الذي قد قلته من الكلام في قيام العوالم كلها بالنفس الرحماني ، ولكن رؤيا منام لا رؤيا يقظة ، لأنه لم يمت بالموت الاختياري من توهم القيام بنفسه والنظر بعقله وحسه . قال عليه السلام : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهو ".
وقال عليه السلام : " المؤمنون ينظرون بنور اللّه " تدل تلك الرؤيا المنامية التي يراها في نوم غفلته عينها على معرفته بهذا النفس الرحماني وقيام العوالم به ، ولكن معرفته مطموسة بالغفلة والغرور واللهو واللعب .
قال تعالى :وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ[ العنكبوت : 61 ] ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ، وقال تعالى :وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ( 63 ) [ العنكبوت : 63 ] .
وقال تعالى : " قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 84 ) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ ( 85 ) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( 86 ) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ ( 87 ) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( 88 ) [ المؤمنون : 84 - 88 ] .
(فيريحه) ، أي الذي قلته ، أو النفس يريح صاحب البرهان الغافل من كل غم هو فيه من إشكال حاصل له في حال تلاوته قوله تعالى :عَبَسَ وَتَوَلَّى ( 1 ) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى ( 2 ) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ( 3 ) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى( 4 ) [ عبس : 1 - 4 ] الآية نزلت في النبي صلى اللّه عليه وسلم لما طمع في إيمان بعض المشركين ، فكان يلين لهم الكلام ،
فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى ، فعبس صلى اللّه عليه وسلم منه وأعرض عنه لاشتغاله بما هو فيه من الأهم ، فأنزل اللّه تعالى عليه ذلك يعاتبه في حق المؤمن به كما عاتبه تعالى في حق الأنصار ، ومن عرف ظهور الصور في النفس الرحماني لم يشكل شيئا من ذلك ، فيستريح من كل إشكال في الدين مطلق .
(ولقد تجلى) ، أي انكشف النفس الرحماني المذكور الذي قد جاء في طلب القبس وهو الشعلة من النار ، وذلك أن موسى عليه السلام لما قال لأهله :امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً[ طه : 10 ] ، فرآه ، أي النفس الرحماني نارا وهو نور ظاهر في صور الملوك ملوك الدنيا والآخرة وهم العارفون ، أو ملوك الدنيا فقط وهم كبارها وفي صور العسس ، أي الخدام وهم السالكون السائرون في ليل نفوسهم على تهذيب أخلاقها وخدمة ملوك الدنيا ، أو هم الرعايا ، يعني يعم الكلام للعالي والدون من الناس ، يعني أن النفس الرحماني واحد في صورة كل شيء ، وهو نور حق على ما هو عليه وإن اختلفت عليه الصور فاختلفت الأحكام لاختلاف الصور .
(فإذا فهمت) يا أيها الإنسان السالك (مقالتي) هذه في شأن هذا النفس الإلهي الظاهر لموسى عليه السلام في صورة النار مع أنه نور في نفس الأمر ، لأنه كان طالبا للنار فظهر له في صورة حاجته الذي هو طالب له .
تعلم أنت بطريق الذوق حيث ظهر في صورة كل شيء ظهر لك (بأنك مقتبس) ، أي مفتقر إلى صورها ظهر لك بها وإن لم تعلم حقيقة ذلك .
قال تعالى : " وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ" [ البقرة : 216 ] .
(لو كان) ، أي موسى عليه السلام (يطلب غير ذا) ، أي غير القبس من النار (لرآه) ، أي النفس الإلهي ظاهرا له (فيه) ، أي في ذلك الغير من كل ما هو محتاج إليه (وما نكس) ، أي انقلب عما رآه من ذلك .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا هذه الكلمة العيسويّة لمّا قام لها الحقّ في مقام « حتّى نعلم ويعلم » استفهم عمّا نسب إليها هل هو حقّ أم لا مع علمه الأوّل بهل وقع ذلك الأمر أم ل .
فقال له :أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
فلا بدّ في الأدب من الجواب للمستفهم .
لأنّه لمّا تجلّى له في هذا المقام وهذه الصّورة اقتضت الحكمة الجواب في التّفرقة بعين الجمع.
فقال وقدّم التّنزيه سُبْحانَكَ فحدّد بالكاف الّتي تقتضي المواجهة والخطاب .ما يَكُونُ لِيمن حيث أنا لنفسي دون كأَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ أي ما تقتضيه هويّتي ولا ذاتي .إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لأنك أنت القائل في صورتي ، ومن قال أمرا فقد علم ما قال ، وأنت اللّسان الّذي أتكلّم به كما أخبرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ربّه في الخبر الإلهي فقال : « كنت لسانه الّذي يتكلّم به » . فجعل هويّته عين لسان المتكلم ؛ ونسب الكلام إلى عبده .
ثمّ تمّم العبد الصّالح الجواب بقوله :تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي. والمتكلّم الحقّ .
ولا أعلم ما فيها فنفى العلم عن هويّة عيسى عليه السّلام من حيث هويّته لا من حيث إنّه قائل وذو أثر .وَلا أَعْلَمُ [ المائدة : 116 ] فجاء بالفصل والعماد تأكيدا للبيان واعتمادا عليه ، إذ لا يعلم الغيب إلّا اللّه . ففرّق وجمّع ووحّد وكثّر ، ووسّع وضيّق . )
(وأما هذه الكلمة) الإلهية (العيسوية) التي قال تعالى فيه :" وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ" [ النساء : 171 ] (لما قام لها الحق) تعالى (في مقام) : " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حتّى نعلم الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ" [ محمد : 31 ] .
قرأ القراء السبعة بالنون ، وقرأ أبو بكر شعبة عن عاصم وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم بالياء المثناة التحتية في الثلاثة يعني حتى نعلم أو يعلم هو تعالى من حيث نزوله إلى صورة العارفين به الكاملين بوصف القيومية في ظواهرهم وبواطنهم ، فإن علمهم نزول علمه وباقي صفاتهم وأسمائهم وأنها لهم كذلك استفهمها ، أي العيسوية الحق تعالى عما نسب بالبناء للمفعول ، أي نسب الكافرون إليها من دعوى الإلهية هل هو حق أم لا مع علمه تعالى بعدم وقوع ذلك منه عليه السلام العلم الأوّل الذي له باعتبار ذاته قبل النزول بالقيومية إلى صور الكاملين ، فإن علم الكاملين في هذا النزول الإلهي علمه تعالى أيضا العلم الثاني الترتيبي ، والأوّل هو العلم المجموعي بهل متعلق باستفهامه
(وقع ذلك الأمر) وهو دعوى الألوهية أم لا ، أي لم يقع منه .
(فقال) تعالى له ، أي لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس) ، أي لقومك من بني إسرائيل " اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ" ، أي معبودينم ِنْ دُونِ اللَّهِ، أي مع اللّه تعالى حتى يبقى المعبود ثلاثة .
وهذا المذكور مرجع أمر الكافرين ومحط قولهم في التثليث فلا بد في مقام الأدب من الجواب للمستفهم ، أي طلب الفهم ، ولو في التقدير والتنزيل لأنه تعالى لما تجلى ، أي انكشف تعالى له ، أي لعيسى عليه السلام في هذا المقام المذكور وهو النزول بالقيومية إلى الصورة العيسوية من قوله تعالى :أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ[ الرعد : 33 ] .
والتجلي في هذه الصورة اقتضت فيه الحكمة الإلهية الجواب عما وقع السؤال عنه في حال التفرقة بين المتجلي والصورة في مقام الفرق ليكون مخاطبا اسم فاعل ومخاطبا اسم مفعول بعين الجمع بينهما في وحدة الأمر .
(فقال) عيسى عليه السلام (وقدم التنزيه )على التشبيه (سبحانك) فسبحان كلمة تنزيه ، أي أنزهك عن ظاهر معنى هذا الاستفهام من حيث أنت ، وعما لا يليق بك فحدد ، أي شبه بالكاف التي تقتضي المواجهة والخطاب للحق تعالى وذلك يقتضي امتيازه بالصورة والتعيين عن غيب إطلاقه ما يكون ، أي يليق ويحسن لي ، أي (من حيث أنا لنفسي دونك أن أقول) ، أي قولي فاعل يكون ما ليس لي بحق ، أي ما تقتضيه ، أي تتهيأ له وتستعد لقبوله هويتي ، أي ماهيتي الحادثة ولا ذاتي المخلوقة الثابتة في علمك القديم قبل وجودها ، وبعد هذا الاعتذار إليك مما كذب علي الكافرون إن كنت قلته .
أي ما سبق من دعوى الألوهيةفَقَدْ عَلِمْتَهُ[ المائدة : 116 ] فلا يخفى عليك لأنك تكون أنت القائل حينئذ ، لأن لساني ينطق بك وذاتي كلها قائمة بك لك ، فقولي ظهور قولك كما أن ذاتي ظهور ذاتك ، لا قولي قولك وذاتي ذاتك ، كما يظن المشركون .
(ومن قال أمرا )، أي كلام (فقد علم ما قال) خصوصا الذي لا يضل ولا ينسى ومع ذلك أيضا أنت اللسان وهو تشبيه الذي أتكلم به تنزيه لذلك التشبيه ، أي لا اللسان الذي لا يتكلم به وهو القطعة من اللحم في الفم كما أخبرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ربه تعالى في الخبر الإلهي ، أي الحديث القدسي فقال فيه من جملة ما قال كما سبق ذكره (وكنت لسانه الذي يتكلم به .)
(فجعل) الحق تعالى (هويته) ، أي ذاته التي هي الوجود المطلق عين لسان المتكلم من حيث انصباغه بنور الوجود المطلق نظير كل شيء كما قال اللّه تعالى :اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ[ النور : 35 ] ، أي القيوم عليها بوجوده المطلق .
(ونسب) تعالى (الكلام) في هذا الخبر الإلهي إلى عبده لا إليه تعالى بقوله الذي يتكلم به (ثم تمم العبد الصالح) وهو عيسى عليه السلام (الجواب بقوله : )
(تعلم) يا أيها الحق المطلق ما في نفسي من حيث إني الحق المقيد بالصورة الصادرة منك والمتكلم بهذا القول هو عيسى عليه السلام باعتبار أنه الحق المقيد المذكور ولا أعلم أنا من حيث أني مجرد هوية وحادثة وصورة حسية ومعنوية ما فيها .
أي في النفس التي هي الحق المقيد بهويتي المذكورة وصورتي المزبورة لأنها حينئذ نفسك
ولا أعلم ما في نفسك فنفى الحق تعالى العلم عن هوية عيسى عليه السلام ، أي عن ذاته الحادثة وصورته التي هي قيد ذلك الإطلاق من حيث هويته .
أي ماهيته المخلوقة المقيدة لإطلاق القديم بقيوميته عليها لا نفي العلم عنه من حيث إنه ، أي عيسى عليه السلام قائل .
أي متكلم بقوله : تعلم ما في نفسي ، لأنه حينئذ هو الحق المقيد المذكور ولا من حيث إنه ذو أثر كخلق الطير وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، فإنه حينئذ هو الحق المقيد أيضا كما ذكرن .
والحاصل أن الحق تعالى له اعتباران وعيسى عليه السلام له اعتباران أيضا ، والأمر واحد وهو الحق المطلق تقيد بالصورة ، فالاعتباران الأوّلان :
الحق المطلق
والحق المقيد بالصورة .
والاعتباران الآخران :
عيسى عليه السلام من حيث إنه الحق المقيد بالصورة .
ومن حيث إنه نفس الصورة المقيدة للحق ، والمستفهم بقوله :
أأنت قلت للناس هو الحق المطلق في مقام نزوله إلى الحق المقيد بالصورة ؟
استفهم من عيسى عليه السلام من اعتبار كونه نفس الصورة المقيدة للحق حتى يعلم من حيث إنه الحق المقيد بالصورة .
والجواب منه من جهة عيسى عليه السلام من اعتبار كونه نفس الصورة بتكلم عيسى عليه السلام من اعتبار كونه الحق المقيد بالصورة إنك أنت العليم الحكيم فجاء.
أي المتكلم وهو عيسى عليه السلام من اعتبار أنه الحق المقيد تكلم عنه من حيث إنه نفس الصورة والقيد للحق المطلق بالفصل .
أي ضمير الفصل وهو قوله : أنت ويسمى العماد عند الكوفيين من علماء النحو تأكيدا ، أي على وجه زيادة التأكيد إذ التأكيد حاصل من إن واسمية الجملة للبيان ، أي إظهار مضمون هذه الجملة واعتمادا ، أي على وجه الاعتماد من المتكلم عليه ، أي على البيان المذكور إذ ، أي لأنه لا يعلم الغيب مما ذكر وغيره إلا الله تعالى فقرق .
أي عيسى عليه السلام في جوابه المذكور بينه وبين الحق تعالى بقوله :" سُبْحانَكَ " في ابتداء كلامه وبما بعد ذلك وجمع أيضا بينه وبين الحق تعالى بقوله : إن كنت قلته فقد علمته ، وبما بعده ووحّد الحق تعالى
بقوله : إنك أنت وكثر أيضا ذلك الواحد بالصور فاثبت تسبيحا ومسبحا اسم فاعل وهو نفسه ، ومسبحا اسم مفعول وهو الحق تعالى ، وقولا وحكما على ذلك القول بأنه ليس بحق ، وحقا مخلوقا وهو ما تقتضيه الهوية والذات الحادثة ، وأثبت للحق تعالى نفسا وله أيضا نفسا ، وللحق علما وله أيضا علما ووسع بقوله : إن كنت قلته فقد علمته ، وهو توسعة في أن كل ما يقوله العبد أو يفعله ، فهو يعلم الحق تعالى وهو فعل الحق تعالى .
فليقل العبد ما شاء ويفعل ما شاء ، فهو للحق حقيقة ، وله مجازا ونسبته كما قال تعالى :اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[ فصلت : 40 ] .
وقال تعالى :قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلً( 84 ) [ الإسراء : 84 ] وضيق أيضا بقوله :ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ[ المائدة : 116].
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ قال متمّما للجواب ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِه ِفنفى أوّلا مشيرا إلى أنّه ما هو ثمّة . ثمّ أوجب القول أدبا مع المستفهم ، ولو لم يفعل كذلك لاتّصف بعدم علم الحقائق وحاشاه من ذلك ، فقال :إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ وأنت المتكلّم على لساني وأنت لساني.
فانظر إلى هذه التّنبئة الرّوحيّة الإلهيّة ما ألطفها وأدقّها أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فجاء بالاسم « اللّه » لاختلاف العبّاد في العبادات واختلاف الشّرائع ؛ ولم يخصّ اسما خاصا دون اسم ، بل جاء بالاسم الجامع للكلّ .
ثمّ قال :رَبِّي وَرَبَّكُمْ ومعلوم أنّ نسبته إلى موجود ما بالرّبوبيّة ليست عين نسبته إلى موجود آخر ، فلذلك فصّل بقوله :رَبِّي وَرَبَّكُمْ بالكنايتين كناية المتكلّم وكناية المخاطب .إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ[ المائدة : 117 ] فأثبت نفسه مأمورا وليست سوى عبوديّته ، إذ لا يؤمر إلّا من يتصوّر منه الامتثال وإن لم يفعل . )
ثم قال ، أي عيسى عليه السلام متمما للجواب عن الاستفهام المذكور ما قُلْتُ لَهُمْ، أي للناس إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ[ المائدة : 117 ] فنفى ، أي عيسى عليه السلام من حيث إنه الحق المقيد بالصورة يعني نفى قوله لهم أوّلا ، أي في ابتداء هذا الكلام حال كونه مشيرا بقوله هذا إلى أنه ، أي عيسى عليه السلام من حيث إنه نفس الصورة المقيدة للحق تعالى ما هو ، أي موجود ثم بالفتح ، أي
هناك يعني في حضرة الحق المطلق المستفهم له في حضرة تقيده بالصورة .
ثم أوجب ، أي نقض ذلك النفي بإيجاب القول أدبا مع المستفهم الحق فإنه استفهمه عن حضرة نفس الصورة المقيدة للحق حتى ينفي القول عنها مطلقا ، وإنما استفهمه عن حضرة كونه الحق المقيد بالصورة .
ولو لم يفعل ، أي عيسى عليه السلام كذلك ، أي ينفي القول عنه من حيثية كونه نفس الصورة ، ويشتبه من حيثية كونه الحق المقيد بالصورة ، يعني ما قلت لهم شيئا من تلقاء نفسي ، أي قولا بنفسي ، وإنما قلت لهم :ما أَمَرْتَنِي بِهِ، أي قولا بأمرك .
وذلك من حضرة كونه ملكا روحانيا كما قال تعالى عن الملائكةوَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَوالقول عمل اللسان لا تصف عليه السلام بعدم معرفة علم الحقائق وحاشاه من ذلك الاتصاف ، لأنه رسول الحقيقة إلى بني إسرائيل أرسل بها إليهم ليكمل شريعتهم .
كما أرسل موسى عليه السلام بالشريعة إليهم ، فلما كذبوه وما آمن معه إلا قليل أرسل اللّه تعالى محمدا صلى اللّه عليه وسلم إلى كافة العالمين بالشريعة والحقيقة معا ليظهره على الدين كلهوَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ[ التوبة : 32 ] .
فقال ، أي عيسى عليه السلام :ما قُلْتُ لَهُمْإِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِوأنت المتكلم على لساني وفي المشرب المحمدي الذاتي أنت لساني الذي أتكلم به وهو الإشارة إلى كونه ما قال إلا من كونه الحق المقيد بالصورة فانظر يا أيها السالك إلى هذه التثنية في قوله :أَمَرْتَنِيفأثبت نفسه مأمورا مع ربه الآمر له الروحية ، أي المنسوبة إلى الروح لأنه روح اللّه الإلهية لأنه عبد اللّه ما ألطفها من حيث اقتضاؤها الآمر والمأمور ، والروح من أمر اللّه تعالى بحكم قوله :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي[ الإسراء : 85 ] .
وأمره تعالى كما قال :إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[ النحل : 40 ] ومنه قوله تعالى :إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ( 59 ) [ آل عمران : 59 ] .
فعيسى عليه السلام روح اللّه وهو من أمر اللّه وهو مأمور اللّه وهو مخلوق اللّه وهو كلمة اللّه وهو قول اللّه وهو عبد اللّه وما أدقها ، أي هذه التثنية أيضا لخفاء معناها عند الكشف عنها في مقام الأرواح الأمريةأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أي افعلوا عبادته تعالى يا أيها المكلفون به .
فجاء ، أي عيسى عليه السلام باسم اللّه دون غيره من الأسماء الإلهية
(لاختلاف العبّاد) جمع عبد أو بالتشديد جمع عابد في العبادات فكل عبد أو عابد يعبده تعالى بمقدار استطاعته في حضوره في تلك العبادة وبالكيفية المتوجهة عليه منها فيكون أثرا عن تجلي اسم إلهي خاص ولأجل اختلاف الشرائع.
فكل شريعة لأمة من الأمم تكليفا باعتبار ما تقتضيه بحقائقها ، وتستعد له بنفوسها من حضرات الأسماء الإلهية متوجهة على تأثيرها ، كذلك فالأمر من اللّه تعالى لعيسى عليه السلام أن يأمر من لقيهم من الناس تأكيدا للشرائع التي كانت عليها بنو إسرائيل في زمان أنبيائهم ، وحثا لقومه على لزوم أحكامهم وإلزاما لهم بالشريعة المحمدية إن أدركوها في زمانها ، وهذا معنى اختلاف الشرائع في أمر عيسى عليه السلام بالعبادة المختلفة فيه .
(ولم يخص) ، أي عيسى عليه السلام اسما خاصا كقوله : اعبدوا الرحمن أو اللطيف أو القدير أو العليم ونحو ذلك دون اسم آخر من تلك الأسماء الإلهية بل جاء بالاسم الجامع للكل وهو اسم اللّه الجامع لجميع أسمائه سبحانه جمعية ذاتية تقتضي انفراد كل اسم بحيطته الخاصة به ، وإن كان كل اسم إلهي جامعا لجميع الأسماء الإلهية أيضا ، ولكنها جمعية صفاتية لا ذاتية ، لأنها تدخل تحت حيطة ذلك الاسم الجامع لها لا تحت حكم الذات بما تقتضيه ثم قال ، أي عيسى عليه السلامرَبِّي وَرَبُّكُمْ[ آل عمران : 51 ] .
فكان فصل إجمال أسمائه تعالى المجموعة في الاسم اللّه بظهور الربوبية في كل مربوب ومعلوم أن نسبته تعالى إلى وجود ما ، أي شيء من الأشياء بالربوبية التي اقتضت وصف العبودية في كل شيء ليست عين نسبته سبحانه بالربوبية أيضا إلى موجود آخر غير الأوّل فلذلك فصل مجمل ما في لفظ اللّه من الأسماء الكثيرة بقوله :رَبِّي وَرَبُّكُمْتفصيلا حاصلا بالكنايتين وهما الضميران المتصلان كناية ، أي الضمير المتكلم ، وهو الياء المثناة التحتية في الأوّل وكناية المخاطب وهو الكاف والميم الدالة على جميع المذكور في الثانيإِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِفأثبت ، أي عيسى عليه السلام نفسه مأمورا بأمر اللّه تعالى له .
(وليست) نفسه المأمورة ، إذ لا نفس له لأنه روح اللّه ، والروح من أمر اللّه وأمر اللّه تعالى قيوميته على خلقه سوى عبوديته ، أي اتصاف روحه بوصف العبودية للّه تعالى إذ ، أي لأنه لا يؤمر بأمر من الأمور إلا من يتصور منه الامتثال لذلك الأمر وإن لم يفعل ما أمر به لموته قبل وقت المأمور أو امتناعه منه ، وعيسى عليه السلام وإن لم يكن له نفس ففيه قبول وصف العبودية للّه تعالى باعتبار الحقيقة الملكية والصور الآدمية ، ونفسه التي قال عنه :"تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي" هي الحق المقيد
بالصورة كما تقدم ذكره لا نفس الصورة والحق المقيد هو الأمر النازل بالروح والطبيعة ومجموع العناصر .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا كان الأمر يتنزّل بحكم المراتب ، لذلك ينصبغ كلّ من ظهر في مرتبة ما بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة . فمرتبة المأمور لها حكم يظهر في كلّ مأمور .
ومرتبة الآمر لها حكم يبدو فهي كلّ آمر .
فيقول الحقّ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [ البقرة : 43 ] فهو الآمر ، والمكلّف المأمور .
ويقول العبدرَبِّ اغْفِرْ لِي [ الأعراف : 151 ] فهو الآمر والحقّ المأمور .
فما يطلب الحقّ من العبد بأمره هو بعينه يطلبه العبد من الحقّ بأمره .
ولهذا كان كلّ دعاء مجاب .
ولا بدّ وإن تأخّر كما يتأخّر بعض المكلّفين ممّن أقيم مخاطبا بإقامة الصّلاة فلا يصلّي في وقت فيؤخّر الامتثال ويصلّي في وقت آخر إن كان متمكّنا من ذلك . فلا بدّ من الإجابة ولو بالقصد).
(ولما كان الأمر) الإلهي (ينزل) من حضرة الحق تعالى إلى أعيان الكائنات الثابتة في العدم الأصلي (بحكم المراتب) الكونية ، أي على مقتضى ما يليق بها في الحكمة الإلهية لذلك ، أي لأجل ما ذكر ينصبغ كل من ظهر من تلك الأعيان الكونية في مرتبة ما من المراتب المذكورة بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة من الحكم اللائق بها فمرتبة المأمور من المكلفين في كل حال وقت وشريعة لها حكم يظهر ذلك الحكم في كل مأمور بحسبه ومرتبة الآمر ، أي الذي يصدر منه الأمر لها أيضا حكم يبدو ، أي يظهر في كل أمر من الأمرين بحسبه ، فأمر اللّه تعالى لإبليس بلا واسطة اقتضت مخالفته الكفر .
وأمره تعالى بواسطة النبي للأمة اقتضت مخالفته الفسق ، والعصيان دون الكفر ، وأمر الناقل عن النبي اقتضت مخالفته في بعض الأحكام كراهة تحريمية أو تنزيهية ، وخلاف الأولى في البعض الآخر ، وكلما ضعفت الواسطة خف الأمر وسهلت مخالفته ، وكلما قوي ثقلت مخالفته فيقول الحق تعالى لعباده أَقِيمُوا الصَّلاةَ فهو ، أي الحق تعالى الآمر الذي صدر منه هذا الأمر بإقامة الصلاة والمكلف من العباد ، أي العاقل البالغ منهم المسلم في قول دون آخر المأمور بإقامة الصلاة .
(ويقول العبد ) في مقابلة ذلك (رَبِّ) ، أي يا رب (اغْفِرْ لِي) ، أي استر
ذنوبي بمسامحتك لي فهو ، أي العبد الآمر الذي صدر منه هذا الأمر بالمغفرة والحق تعالى وهو ربه المأمور بذلك فكل من العبد والرب آمر ومأمور ، وإنما هي طاعات بطاعات ، فمن أطاع اللّه أطاعه اللّه ومن عصى اللّه عصاه اللّه .
(فما يطلب الحق) تعالى (من العبد بأمره له) في حكم من الأحكام (هو بعينه )، أي ما يطلبه الحق (ما يطلب العبد من الحق) تعالى بأمره له فكل من استجاب لدعاء ربه بحكم قوله تعالى :وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ[ يونس : 25 ] ، أي الجنة .
يعني بالأمر بالأعمال الصالحة ، وقوله تعالى :اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ[ الشورى : 47 ] ، فإن اللّه تعالى يستجيب له دعاءه .
قال تعالى :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] ولهذا كان كل دعاء مجابا ولا بد ، أي هو أمر محقق بعين الإجابة من المدعو ولا اعتبار لخصوص الوصف ، لأنه عين صيغة النفس الآمرة للأمر المطلوب من المأمور ، فمن دعا اللّه تعالى في أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية .
فإن ذلك عين أمر اللّه تعالى له في ذلك الوقت بما هو متوجه عليه في الشرع من الفعل أو الكف ، فإن أراد أن الحق تعالى يستجيب له ما دعاه به فليستجب هو للحق تعالى عين ذلك الأمر في ذلك الوقت على أتم وجوه الاستجابة بعد البحث عنه وضبطه بعينه ، فإنه يجده عين إجابة الحق تعالى له فيما طلب ، وأدنى ذلك أن يجد نفسه قادرا على عين ما دعا الحق تعالى به ، أو متسلية عنه بأعلى منه .
وإن نقص في الإجابة للحق تعالى نقصت الإجابة منه تعالى عن الصفة التي طلبها بمقدار ما نقص من الصفة التي طلبها الحق تعالى منه ، إلى أن تنعدم الاستجابة منه للحق تعالى ببطلان عمله المأمور به من حيث لا يشعر ، إما لجهله أو لغفلته ، فتنعدم الإجابة له فيما دعاه بالكلية ، إلا أن يستدرج وربما يقول دعوت اللّه تعالى في أمر كذا فلم يجبني ويكون ذلك لعدم إجابته هو لأمر اللّه تعالى الذي دعاه به ، وأمر اللّه تعالى بالسجود لإبليس لم يوجد منه استجابة له بالوصف المطلوب ، فلم يوجد من الحق تعالى استجابة لدعائه بالوصف المطلوب له في قوله : قال رب أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( 14 ) [ الأعراف : 14 ]
وكان مطلوبه وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ( 40 ) [ الحجر : 39 - 40 ] ، فقال له :فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ( 37 ) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ( 38 ) [ الحجر : 37 - 38 ] .
ولم يقدره على إضلال جميع من سوى المخلصين ، بل جعله سببا في دخول الجنة للكثير ممن يخالفه في وسواسه ، وجعل لمن جاهده أجر المجاهدين ورفعه في الدنيا والآخرة بالامتناع منه فقد استجاب إبليس بعض ما أمر به في تعظيم آدم عليه السلام بكونه سببا لشرف بعض ذريته ، فكان في مقابلة ذلك إنظار الحق تعالى له إلى يوم الوقت المعلوم ، فإن ذلك بعض ما دعاه به ، إذ ليس مراده مجرد الإنظار وطول العمر بل مراده الأهم ومقصده الألزم إقداره على إغواء كل بني آدم ، وإضلال غير المخلصين منهم ، ولم يعطه اللّه تعالى ما دعاه به كله بل بعضه في مقابلة أنه ما أعطى الحق تعالى ما أمره به كله بل بعضه من حيث لا يشعر .
وهكذا عادة اللّه تعالى جارية في جميع خلقه لمن دقق النظر وأعمل الفكر وإن تأخر ذلك الدعاء إلى وقت آخر في الدنيا أو الآخرة ، فاستجابه اللّه تعالى له في الوقت الذي يريده تعالى لحكمة يعلمها سبحانه كما يتأخر بعض المكلفين عن سرعة الإجابة ممن أقيم مخاطبا اسم مفعول بإقامة الصلاة فلا يصلي تلك الصلاة في وقت وجب عليه فعلها فيه فيؤخر الامتثال للأمر ويصلي في وقت آخر إن كان متمكنا ، أي المخاطب بالصلاة من ذلك الامتثال بأن كان قادرا عليه فلا بد من الإجابة من العبد القادر ولو كان بالقصد للإجابة ونية الامتثال في وقت عجزه ومن الرب سبحانه ولو بالقصد للإجابة في الوقت الذي يريد وكتابته في اللوح وإعلام الملائكة به .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ قال :وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ ولم يقل على نفسي معهم كما قال ربّي وربّكم شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ لأنّ الأنبياء شهداء على أممهم ما داموا فيهم .فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي أي رفعتني إليك وحجبتهم عنّي وحجبتني عنهم كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ في غير مادتي ، بل في موادّهم .
إذ كنت بصرهم الّذي يقتضي المراقبة . فشهود الإنسان نفسه شهود الحقّ إيّاه . وجعله بالاسم الرّقيب لأنّه جعل الشّهود له . فأراد أن يفصّل بينه وبين ربّه حتّى يعلم أنّه هو لكونه عبدا في الواقع وأنّ الحقّ هو الحقّ لكونه ربّا له ، فجاء لنفسه بأنّه شهيد ، وفي الحقّ بأنّه رقيب .
وقدّمهم في حقّ نفسه فقال :عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْإيثار لهم في التّقدّم وأدبا ، وأخّرهم في جانب الحقّ عن الحقّ في قوله :الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْلما يستحقّه الرّبّ من التّقدّم بالرّتبة . )
(ثم قال) ، أي عيسى عليه السلام (وكنت عليهم) ، أي على الناس الذين كانوا في زمانه ، ولم يقل أيضا على نفسي معهم كما قال الشيخ رضي الله عنه : اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيداً، أي شاهدا مطلقا ما دُمْتُ[ المائدة : 117 ] ، أي مدة دوامي قائما فِيهِمْ. لأن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أرسلهم اللّه تعالى ليكونوا شهداء على أممهم ما داموا قائمين فيهم ، قال تعالى :يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً( 45 ) [ الأحزاب : 45 ] . وقال تعالى :لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً[ البقرة : 143 ] .
(فلما توفيتني) بالوفاة الاختيارية وهي الموت الاختياري بغلبة أحكام الروحانية على مقتضيات البشرية (أي رفعتني إليك) ، يعني من حضيض النفس البشرية إلى أوج حضرتك القدسية وحجبتهم ، أي الناس بإشغالهم بأحكام نفوسهم وغفلاتهم المستولية على قلوبهم عني من حيث أني الروح الخالص المصفى من كدرات الطبائع وأوساخ العناصر وحجبتني عنهم بدوام شهودك في حضرة وجودك على بساط كرمك وجودك كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِم ْبهم لا بي في غير مادتي وهي نشأته الروحانية الطبيعية العنصرية بل في موادهم الروحانية الطبيعية العنصرية إذ ، أي لأنك كنت بصرهم الذي يقتضي المراقبة لأفعالهم وإن لم يشعروا بذلك لنفاذ حكمك فيهم بالغواية عن الحق المبين .
(فشهود الإنسان ) ، أي رؤيته ومعاينته نفسه بغفلته أولا ويبصر ثانيا شهود الحق تعالى إياه ، أي رؤيته تعالى ومعاينته لنفس ذلك الإنسان ثانيا في حال اتصافه بالوجود بعد شهوده له أوّلا في حال اتصافه بالثبوت في عدمه الأصلي ، وكما أن الإنسان في شهوده نفسه ورؤيته لها ومعاينته إياها له بصيرة قلبية هي المشاهدة الرائية في نفس الأمر ، وله بصر هو مظهر بصيرته وصورة تجليها على بعض مدركاتها ، فكذلك الحق تعالى له بصر قديم هو صفة من صفات ذاته الأزلية يضاف إليه الشهود والرؤية حقيقة في نفس الأمر ، وله بصيرة وبصر خلقهما لعبده فهما مظهر لبصره القديم ، وصورة تجليه من حيث اسمه البصير كما تجلى باسمه القادر وصفة القدرة في قدرة عبده الحادثة .
وهكذا باقي الأوصاف والأسماء بصفة القيومية واسم القيوم بلا حلول ولا اتحاد .
(وجعله ) ، أي شهود الحق تعالى لهم باسم الرقيب في قوله :كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ لأنه عليه السلام جعل الشهود له بقوله :وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فأراد أن يفصل ، أي يفرق بينه وبين ربه تعالى حتى يعلم بالبناء للمفعول أي يعلم السامع لهذا الكلام من الناس أنه ، أي عيسى عليه السلام هو ، أي عيسى عليه السلام لكونه عليه السلام عبدا من عبيد اللّه تعالى.
كما قال عليه السلام أول ما نطق وهو في المهد :إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وأن الحق تعالى القيوم عليه وعلى نفسه بما كسبت هو الحق تعالى لكونه سبحانه ربا ، أي مالكا له ، أي لعيسى عليه السلام فجاء عليه السلام لنفسه في كلامه بأنه شهيد وجاء في الحق تعالى بأنه رقيب عليهم وقدمهم ، أي الناس في حق نفسه فقال :وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ [ المائدة : 117 ] .
فقوله : شهيدا مؤخر عن قوله عليهم إيثارا ، أي سماحة لهم في التقدم الذكرى وأدبا في المسارعة إلى امتثال الأمر ، لأن الحق تعالى أرسله وأمره بالشهود عليهم ، فإنهم ركن في الامتثال ، فقدمهم مراعاة للأدب مع مولاه الذي أمرهم وأخرهم .
أي الناس في جانب الحق تعالى عن ذكر الحق تعالى في قوله : كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ لما يستحقه الرب سبحانه من التقدم على الكل بالرتبة فإن رتبته أعلى من أن يقال إنها أعلا من كل الرتب .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ أعلم أنّ للحقّ الرّقيب الاسم الّذي جعله عيسى لنفسه وهو الشّهيد في قوله عَلَيْهِمْ شَهِيداً فقال :وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فجاء بكُلِّ للعموم وبشَيْءٍ لكونه أنكر النكرات وجاء بالاسم الشّهيد ، فهو الشّهيد على كلّ مشهود بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود .
فنبّه على أنّه تعالى هو الشهيد على قوم عيسى حين قال : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ[ المائدة : 117 ] فهي شهادة الحقّ في مادّة عيسويّة كما ثبت أنّه لسانه وسمعه وبصره . )
(ثم اعلم) يا أيها السالك (أن للحق) تعالى الرقيب سبحانه الاسم الذي جعله عيسى عليه السلام لنفسه وهو الاسم الشهيد في قوله : أي عيسى عليه السلام وَكُنْتُ عليهم شهيدا ما دُمْتُ فِيهِمْ فقال عليه السلام :وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فجاء بكل في قوله :كُلِّ شَيْءٍ للعموم ، أي عموم الأشياء وجاء بشيء في قوله له كل شيء أيضا لكونه ، أي الشيء أنكر النكرات لأنه اسم لكل مجهول ، فإذا عين باسم أخص وعلم كحجر ومدر وجاء بالاسم الشهيد فهو تعالى الشهيد فعيل بمعنى الفاعل ، أي شاهد من المشاهدة وهي المعاينة على كل مشهود بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود من كونه محسوسا أو معقولا أو موهوما ونحو ذلك من الأقسام فنبه ، أي عيسى عليه السلام على أنه .
أي الحق (تعالى هو الشهيد) ، أي الشاهد على قوم عيسى عليه السلام حين قال ، أي عيسى عليه السلام وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ [ المائدة : 117 ] .
فهي ، أي هذه الشهادة شهادة الحق تعالى ، لأنه على كل شيء شهيد في جميع الأحوال والأزمان في مادة ، أي نشأة وخلقة عيسوية منسوبة إلى عيسى عليه السلام بصفة القيومية الإلهية عليها كما ثبت في الحديث القدسي من المقام المحمدي الذاتي أنه ، أي الحق تعالى لسانه ، أي لسان عيسى عليه السلام وسمعه وبصره حيث قال محمد نبينا صلى اللّه عليه وسلم : « فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » الحديث .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ قال كلمة عيسويّة ومحمّديّة : أمّا كونها عيسويّة فإنّها قول عيسى بإخبار اللّه تعالى عنه في كتابه ؛ وأمّا كونها محمّديّة فلموقعها من محمّد صلى اللّه عليه وسلم بالمكان الّذي وقعت منه ، فقام بها ليلة كاملة يرددها لم يعدل إلى غيرها حتى مطلع الفجر .إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( 118 ) [ المائدة : 118 ] .
« وهم » ضمير الغائب كما أنّ « هو » ضمير الغائب .
كما قال :هُمُ الَّذِينَ كَفَرُو[ الفتح : 25 ] بضمير الغائب ، فكان الغيب سترا لهم عمّا يراد بالمشهود الحاضر . فقال :إِنْ تُعَذِّبْهُمْ بضمير الغائب .
وهو عين الحجاب الّذي هم فيه عن الحقّ . )
(ثم قال) ، أي عيسى عليه السلام بعد ذلك (كلمة عيسوية) ، أي منسوبة إليه عليه السلام (ومحمدية) ، أي منسوبة إلى نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم أما كونها ، أي الكلمة عيسوية فإنها قول عيسى عليه السلام من مقامه الروحاني الإلهي بإخبار اللّه تعالى عنه .
أي عن عيسى عليه السلام بذلك في كتابه تعالى وهو القرآن العظيم وأما كونها ، أي الكلمة (محمدية فلوقوعها من محمد صلى اللّه عليه وسلم بالمكان) ، أي المقام والمحل (الذي وقعت منه) صلى اللّه عليه وسلم من حيث المشرب العيسوي والمرتبة الروحانية الإلهية.
فقام ، أي محمد صلى اللّه عليه وسلم بها ، أي بهذه الكلمة المذكورة ليلة كاملة يرددها .
أي يكررها في القرآن في القراءة في الصلاة النافلة لم يعدل عنها إلى غيرها حتى طلع الفجر
الثاني وهي قوله :إِنْ تُعَذِّبْهُمْ، أي القائلين من الناس أن عيسى وأمه عليهما السلام إلهين من دون اللّه تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ، أي أصحاب عبودية لك وهي غاية الذل بين يديك ولم يشعروا بذلك من نفوسهم لانطماسها بالكفر بك .
("وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ")، أي تستر عنهم المؤاخذة على كفرهم ، لأنه أمر جائز منك غير مستحيل وقوعه فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ[ المائدة : 118 ] ، أي صاحب العزة والعظمة عن أن يقدروا أن يغضبوك بمخالفتهم لك فتشتفي منهم بعذابك لهم .
ونظيره ما روى أبو نعيم في الحلية عن يوسف بن الحسين الرازي قال : سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : ليس أعمال الخلق بالتي ترضيه ولا تسخطه ، إنما رضي عن قوم فاستعملهم بأعمال الرضى ، وسخط على قوم فاستعملهم بأعمال السخط الْحَكِيمُ.
أي صاحب الحكمة البالغة ، فلو غفر لهم لكان ذلك هو الحكمة منك ، فإنها دائرة مع أفعالك كيفما فعلت ، فهو الحكمة ، لا هي أمر مخصوص بحيث تنحصر أفعالك فيها ، تعاليت عن ذلك علوا كبيرا وهم ( ) - من قوله :إِنْ تُعَذِّبْهُمْ، ضمير الغائب كما أن هو ضمير الغائب لكنه للواحد كما قال اللّه تعالى في نظير ضمير الغائب المجموع هم الذين كفروا .
بضمير الغائب المجموع لغيبتهم عن الحضور مع اللّه تعالى فكان الغيب الذي هم فيه بجهلهم وكفرهم سترا ، أي ساترا لهم عما ، أي عن الخلق الذي يراد ، أي يقصد عند العارفين بالمشهود ، لأنهم يشهدونه الحاضر لحضورهم بين يديه على بصيرة منهم بذلك ويقين تام .
فقال ، أي عيسى عليه السلام فيما أخبر اللّه تعالى به عنه إِنْ تُعَذِّبْهُمْ بضمير الغائب المجموع وهو ، أي نواب المفهوم من ضمير الغائب عين الحجاب الذي هم فيه عن شهود الحق تعالى والحضور بين يديه على علم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فذكّرهم اللّه قبل حضورهم حتّى إذا حضروا تكون الخميرة قد تحكّمت في العجين فصيّرته مثلها .فَإِنَّهُمْ عِبادُك َفأفرد الخطاب للتّوحيد الّذي كانوا عليه . ولا ذلّة أعظم من ذلّة العبيد .
لأنّهم لا تصرّف لهم في أنفسهم فهم بحكم ما يريده بهم سيّدهم ولا شريك له فيهم فإنّه قال :عِبادُكَ فأفرد . والمراد بالعذاب إذلالهم ولا أذلّ منهم لكونهم عبادا . فذواتهم تقتضي أنّهم أذلّاء فلا تذلّهم فإنّك لا تذلّهم بأدون ممّا هم فيه من كونهم عبيدا .وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ أي تسترهم عن إيقاع العذاب الّذي يستحقّونه بمخالفتهم أي تجعل لهم غفرا يسترهم عن ذلك ويمنعهم منه .فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ[ المائدة : 118 ] أي المنيع الحمى ).
(فذكرهم اللّه) تعالى في حال غيبتهم عنه وانحجابهم عن شهوده (قبل حضورهم) بين يديه بكشف الغطاء عنهم وارتفاع الحجاب عنهم بالموت والبعث يوم القيامة كما قال تعالى :فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ[ ق : 22 ] حتى إذا حضروا وانكشف عنهم غطاؤهم بين يدي اللّه تعالى تكون الخميرة وهي ما حمض من العجين يوضع فيها يعجن فيستحيل كله خميرا ، وذكر اللّه تعالى لهم في الدنيا على هذا الوصف بلسان نبيين معصومين عليهم السلام اعتناء بهم ونوع حضور منهم وإن لم يحضروا معه .
ولولا حضوره تعالى واعتناؤه لما حضر معه من حضر واعتنى به ، فكان ذكره تعالى لهم بمنزلة الخميرة لحضورهم وذكرهم له في الآخرة قد تحكمت ، أي خميرة ذكره لهم في العجين من حقائقهم المذكورة له تعالى فصيرته ، أي ذلك العجين مثلها ، أي مختمرا بسريانها فيه واستحالته إليها فإنهم عبادك فأفرد الخطاب بالكاف للّه تعالى للتوحيد ، أي لأجل التوحيد الاضطراري الذين كانوا عليه من حيث حقائقهم القائمة به تعالى وإن لم يشعروا لانطماسهم بالكفر ودعوى الشريك معه تعالى .
قال تعالى :وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً ( 67 ) أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ( 68 ) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً( 69 ) [ الإسراء : 67 - 69 ] .
(ولا ذلة أعظم من ذلة العبيد) وهوانهم وحقارتهم (لأنهم) ، أي العبيد (لا تصرف لهم في أنفسهم) أصلا فمنهم ، أي العبيد قائمون بحكم ما يريد بهم سيدهم .
أي مولاهم من جميع الأحوال ولا شريك له ، أي لسيدهم فيهم فإنه .
أي عيسى عليه السلام قال عبادك فأفرد الخطاب للّه تعالى ، لأنهم إذا كانوا عباده وهم كثيرون كان هو سيدهم ومولاهم وهو واحد لا شريك له فيهم .
والمراد بالعذاب من قوله : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ في نفس الأمر إذلالهم ، أي إهانتهم بما يذيقهم من الألم بالنار وغيره (ولا أذل) ، أي أكثر ذلا ومهانة وحقارة (منهم) ، أي من العبيد (لكونهم عبادا) ، أي ذليلون حقيرون من العبادة وهي نهاية الذل وغاية المهانة في طاعة الرب والمولى عز وجل فذواتهم تقتضي أنهم أذلاء .
أي ذليلون حقيرون مهانون بسبب ظهور عبوديتهم لك عند من يعترف بها وإن لم يشعروا بها هم لانطماس قلوبهم بالكفر فلا تذلهم أكثر مما هم فيه من الذل والحقارة فإنك لا تذلهم بأدون .
أي بذل يجعلهم أدون وأقل مما هم فيه من الذل الذي هو مقتضى كونهم عبيدا .
أي متصفين بالعبودية التي هي كمال الذلة بحيث لا يمكن أذل منها لكنهم لا يشعرون بذلك من نفوسهم لانطماسهم بالكفر وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ أي تسترهم ، يعني تغطيهم برداء حكمك الواسع عن إيقاع العذاب المؤلم الموجع بهم الذين يستحقونه منك بمخالفتهم لأمرك وعدم امتثالهم لطاعتك ومعنى تغفر لهم أي تجعل لهم غفرا ، أي سترا وغطاء .
ومنه المغفر لما يجعل على الرأس من درع الحديد ليسترهم عن ذلك ، أي عن إيقاع العذاب ويمنعهم ، أي يحميهم ويحفظهم ويحرسهم ويوقيهم منه ، أي من إيقاع العذاب بهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، أي المنيع ، أي الممنوع المحفوظ الحمى ، أي الجناب .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وهذا الاسم إذا أعطاه الحقّ لمن أعطاه من عباده يسمّى الحقّ بالمعزّ ، والمعطى له هذا الاسم بالعزيز . فيكون منيع الحمى عمّا يريد به المنتقم والمعذّب من الانتقام والعذاب .
وجاء بالفصل والعماد أيضا تأكيدا للبيان ولتكون الآية على مساق واحد في قوله :إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ[ المائدة : 116 ] وقوله :كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ[ المائدة : 117 ] .
فجاء أيضا :فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ المائدة 118 ]
فكان سؤالا من النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم وإلحاحا منه على ربّه في المسألة ليلته الكاملة إلى طلوع الفجر يرددها طلبا للإجابة فلو سمع الإجابة في أوّل سؤال ما كرّر .
فكان الحقّ يعرض عليه فصول ما استوجبوا به العذاب عرضا مفصّلا فيقول له في كلّ عرض عرض وعين عين : "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [ المائدة : 118 ] . )
(وهذا الاسم) الذي هو اسم اللّه العزيز (إذا أعطاه الحق تعالى لمن أعطاه من عباده ) المؤمنين ، أي جعله متخلقا به ظاهرا بمقتضى مدلوله وهو العزة والمنعة والهيبة (يسمى الحق) تعالى حينئذ (بالمعز) ، لأنه أعطى اسمه العزيز لعبده فأعزه به بل ظهر تعالى عزيزا بذلك العبد لأنه قيوم عليه وبطن عنه باسم المعز فهو تعالى المعز والعزيز ويسمى ذلك العبد المعطى له هذا الاسم من أسماء اللّه تعالى بالعزيز ، أي المنيع الحمى فيكون ، أي المعطى له هذا الاسم منيع الحمى ، أي محروس الجناب محفوظ الذات والصفات عما ، أي عن كل سوء يريد به اسم المنتقم والاسم المعذب اسم فاعل اللذين هما من أسماء اللّه تعالى من 0 حلول الانتقام به والعذاب بيان لم
(وجاء ) ، أي عيسى عليه السلام في كلامه هذ (بالفصل) وهو ضمير الفصل ويسمى العماد أيضا وذلك قوله : " فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " (تأكيدا) ، أي على وجه التأكيد للبيان ، أي لإظهار مضمون هذه الجملة كما مر ولتكون هذه الآية من أوّلها إلى آخرها على مساق ، أي أسلوب ونمط واحد .
في قولهأوّلا إنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
وقوله : ثانيا :كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فجاء ، أي عيسى عليه السلام في آخر الآية أيضا .
ثالث بقوله : إنكأ َنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فكان مقتضى هذه الآية ومضمونها سؤالا .
أي طلبا من النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم وإلحاحا ، أي مبالغة في الطلب منه صلى اللّه عليه وسلم على ربه تعالى في هذه المسألة التي هي مقتضى هذه الآية ومضمونها ليلة كاملة من بعد العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر الثاني وهو يرددها .
أي هذه الآية في قراءته لها طلبا من اللّه تعالى للإجابة إلى حصول مضمونها من المغفرة والمسامحة .
فلو سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم الإجابة إلى سؤاله المذكور من اللّه تعالى في أوّل سؤال وقع منه بقراءة هذه الآية ما كرر قراءتها مرة بعد أخرى فكان الحق تعالى يعرض عليه ، أي النبي صلى اللّه عليه وسلم فصول ، أي أنواع ما ، أي بسبب الذي استوجبوا ، أي استحقوا يعني الكافرين به .
أي بذلك السبب العذاب من اللّه تعالى عرضا مفصلا فيقول ، أي النبي صلى اللّه عليه وسلم له ، أي اللّه تعالى في كل عرض من ذلك وكل عين عين بتكرار لفظ العين أي خصوص كل سبب من أسباب العذاب إِنْ تُعَذِّبْهُمْ على ما عرضته علي من هذا السبب المخصوص فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ذلك السبب فتستره ولا تؤاخذهم به فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحقّ وإيثار جنابه لدعا عليهم لا لهم .
فما عرض عليه إلّا ما استحقّوا به ما تعطيه هذه الآية من التّسليم للّه والتّعريض لعفوه .
وقد ورد أنّ الحقّ إذا أحبّ صوت عبده في دعائه إيّاه أخّر الإجابة عنه حتى يتكرّر ذلك حبّا فيه لا إعراضا عنه ، ولذلك جاء بالاسم الحكيم ؛ والحكيم هو الّذي يضع الأشياء في مواضعها ، ولا يعدل بها عمّا تقتضيه وتطلبه حقائقها بصفاته .
فالحكيم هو العليم بالتّرتيب . فكان صلى اللّه عليه وسلم بترداده هذه الآية على علم عظيم من اللّه تعالى . فمن تلا هذه الآية فهكذا يتلو ، وإلّا فالسّكوت أولى به .
وإذا وفّق اللّه عبدا إلى النّطق بأمر ما فما وفّقه إليه إلّا وقد أراد إجابته فيه وقضاء حاجته فلا يستبطيء أحد ما يتضمّنه ما وفّق له ، وليثابر مثابرة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على هذه الآية في جميع أحواله ، حتّى يسمع بأذنه أو بسمعه ، كيف شئت أو كيف أسمعك اللّه الإجابة ، فإن جازاك بسؤال اللّسان أسمعك بأذنك ، وإن جازاك بالمعنى أسمعك بسمعك).
(فلو رأى ) ، أي النبي صلى اللّه عليه وسلم (في ذلك العرض) المذكور (ما يوجب تقديم ) حق الحق تعالى على حق عباده المذكورين وإيثار .
أي اختيار ترجيح جنابه تعالى على جنابهم لدعا صلى اللّه عليه وسلم عليهم بما يستحقونه من العذاب لا دعا لهم بالمغفرة والمسامحة ، ولكنه رأى في ذلك ما يوجب تقديم حق العبد لعجزه وافتقاره على حق الرب تعالى لقدرته وغناه المطلق ، وإيثار جناب العبد في دعاء الحق تعالى بالمغفرة له على جناب الحق تعالى سبحانه في الدعاء على من خالف أمره لكمال عزته وعموم حكمته .
(فما عرض) ، أي الحق تعالى (عليه) ، أي على النبي صلى اللّه عليه وسلم بتلاوته هذه الآية في تلك الليلة التي كان يكررها فيه (إلا ما استحقوا به ما تعطيه هذه الآية ) المذكورة من المغفرة لهم والعفو عنهم (من التسليم ) بيان لما استحقوا به للّه تعالى في جميع أحوالهم التي أراد تعالى وقوعها بهم مما يضرهم كالكفر والضلال ، أو ينفعهم كالذل له في حقيقة نفوسهم واضطرارهم إلى إمداده ظاهرا أو باطنا وإن لم يشعروا بذلك والتعريض لعفوه عنهم والمغفرة لهم بما عندهم من العبودية له وذلك مستفاد من مضمون الآية المذكورة .
(وقد ورد) في الحديث (أن الحق) تعالى (إذا أحب صوت عبده في دعائه إياه ) سواء كان صوت قلب أو لسان ، فإن للقلب كلاما كما وللسان كلاما أخر تعالى الإجابة عنه لدعائه حتى يتكرر ذلك ، أي الدعاء منه ، أي من ذلك العبد حبا ، أي محبة منه تعالى فيه ، أي في ذلك العبد لا إعراضا منه تعالى عنه ، أي عن ذلك العبد الداعي ولذلك جاء ، أي عيسى عليه السلام في كلامه بالاسم الحكيم فقال : إنكأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
(والحكيم) معناه (هو الذي يضع الأشياء في مواضعها) اللائقة بها والمناسبة لها ولا يعدل بها ، أي بالأشياء عما تقتضيه وتطلبه حقائقها ، أي حقائق تلك الأشياء بصفاتها ، أي بسبب ما اتصف به من الأحوال المختلفة فالحكيم هو في المعنى العليم ، أي الذي يعلم جميع الأشياء بالترتيب المتقن الذي هو على أبلغ الوجوه طبق ما هي عليه الأشياء في حال ثبوتها في العلم القديم ، وهي معدومة بالعدم الأصلي وكان ، أي النبي صلى اللّه عليه وسلم بترداده ، أي تكراره هذه الآية المذكورة على علم عظيم من اللّه تعالى ، فإنه أعلم الخلق باللّه تعالى على الإطلاق فمن تلا ، أي قرأ هذه الآية المذكورة فهكذا ، أي على هذا الوصف المذكور من التنبيه للمعاني الإلهية والمناجاة مع الحق تعالى بالأسرار الخفية والجلية يتلو ، أي يقرأ هذه الآية وإلا ، أي وإن لم يتلها هكذا بأن تلاها بفغلة قلب وجهل بالأمور الإلهية وتحريف للأسرار واستصغار للمعاني الكبار فالسكوت وترك التلاوة أولى به حينئذ كما قال تعالى :" أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ( 44 ) [ البقرة : 44] .
وورد في الخبر : « رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه » (وإذا وفق اللّه) تعالى (العبد إلى نطق) ، أي تكلم ودعاه (بأمر ما) ، أي أمر من الأمور فما وفقه ، أي اللّه تعالى إليه ، أي إلى النطق بذلك الأمر إلا وقد أراد إجابته فيه ، أي في ذلك الأمر الذي دعاه به . وأراد قضاء حاجته ، فيما طلب منه تعالى فلا يستبطىء أحد من الناس ما يتضمنه ما ، أي الذي وفق ، أي وفقه اللّه تعالى له من الدعاء فإن قضاء الحاجات له أوقات .
وقد ورد : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول :
دعوت فلم يستجب لي » ولعل قوله : ذلك مبطل للدعاء ، فمانع من الإجابة ،
وامتثال العبد أمر ربه تعالى له بالدعاء في قوله :ادْعُوا رَبَّكُمْ[ الأعراف : 55 ] ، وقوله :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] عين الإجابة من العبد لأمر ربه سبحانه ، فاللّه مستجيب له على كل حال كما مر .
وامتثال العبد أمر ربه تعالى له بالدعاء في قوله :ادْعُوا رَبَّكُمْ[ الأعراف : 55 ] ، وقوله :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] عين الإجابة من العبد لأمر ربه سبحانه ، فاللّه مستجيب له على كل حال كما مر .
(وليثابر) ، أي يواظب الداعي مثابرة ، أي مواظبة (رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على) تلاوة (هذه الآية) في تلك الليلة الكاملة ودعا اللّه تعالى بمضمونها في شأن الكافرين (في جميع أحواله) ، أي الداعي ولا يستبطىء الإجابة فيترك الدعاء حتى يسمع ذلك الداعي بأذنه الحسية أو بسمعه النفساني كيف شئت قلت في ذلك أو كيف أسمعك اللّه تعالى الذي يسمع من يشاء الإجابة لدعائك ذلك فإن شاء تعالى جازاك على دعائك سؤال ، أي طلب اللسان منك للذي أردته أسمعك تعالى الإجابة لدعائك بأذنك قوله القديم : لبيك عبدي وإن جازاك على دعائك فأجابه لك بالمعنى ، أي أعطاك ما طلبته أسمعك إجابة لك بسمعك النفساني بأن يكشف لك عن حصول نفس مطلوبك ، فيكون ذلك دليلا على أنه يذيقك عين ما طلبته في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد أنت ، فإنه يعلم وأنت لا تعلم .
تم فص الحكمة العيسوية
.
....
jKcwHO48vRI
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!