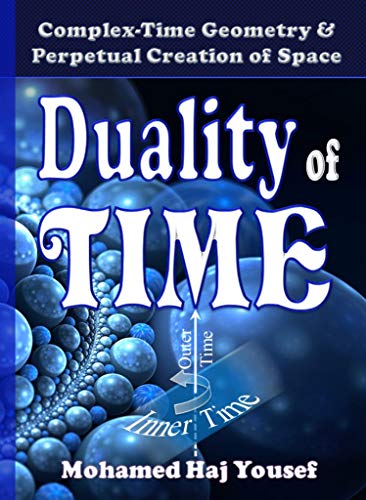مَدَاخِلُ السَفْسَطة وجَحْد العُلوم
ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف بـهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات. فقلت: الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمع في اقتباس المشكلات إل من الجليَّات ، وهي الحسيات والضروريات ، فلا بد من إحكامها أولاً لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في الضروريات ، من جنس أماني الذي كان من قَبلُ في التقليديات ، ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات ، أم هو أمان محققٌ لا غدر فيه ولا غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها ، فانتهي بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضاً ، وأخذت تتسع للشك فيها وتقول : من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم ، بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة ( واحدة ) بغتة ، بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم يكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبـه حاكم العقل ويخونـه تكذيباً لا سبيل إلى مدافعته.