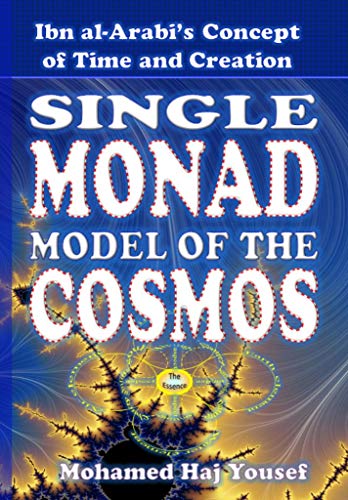المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

كتاب المبادئ والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من المعاني والآيات
ينسب للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
وهو للشيخ فخر الدين عبد اللّه أبى الحسن على بن أحمد ابن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التجيبى الحرّالى
فصل في ذكر رتب الحروف التي نشأت منها مواقع الإعجام وأصول صور الحروف
 |
 |
اعلم أنَّه لمَّا كان للحروفِ مراتبٌ نشأت منها الأعدادُ إلى نهايةِ الألْفِ الذي عاد في لفظِ اسمِها حروفُ الألفِ، ووفى بها عددُ الحروفِ، فكذلك في الحروفِ ترتيب في مكانِ مواقعِها منِ العِلمِ وما وراءه مما العلمُ آيتُه، وذلك ممَّا بين إحاطةِ سواءِ الألفِ، وظهورِه حروفًا في نسقِ الحكمةِ منِ مبدأ الأوليَّةِ للهمزةِ التي هي أوَّلُ مستطاعِ النطُقِ، وأوَّلُ ظهورِ الألفِ إلى نهايةِ تنزُّلِ أمرِه سببًا بوفاءِ التفصيلِ جمعًا يكون قوامًا على ما وضح في معناه، وعن هذا الترتيب الثاني ظهرت إبانةُ العجمةِ في الحروفِ في الكتابةِ العربيةِ لما حوفظ فيها على أن يكونَ صورةُ ما معناه معنى واحدًا متفاوت صورة واحدة؛ ليفصلَ فيه ما يختلفُ معناه باختلافِ الصورةِ، وبين ما يتفاوتُ بإهمالِ الأوَّلِ في الرتبةِ وإعجامِ الثاني، فتزولُ العجمةُ عنهما بذلك، فكان ما يختلفُ معناه مختلفًا في الصورةِ كالياءِ والكافِ مثلًا، وما يتَّفقُ ويتفاوتُ على صورةٍ واحدةٍ، ثم استدرك إبانةَ ذلك بالإعجامِ، وكان ذلك أعربَ منِ أن يستوي المختلفُ والمتفاوتُ في اختلافِ الصورِ ويستغني عن الإعجامِ، فكان هذا الوضعُ أتمَّ بيانًا، وأوضحَ إعرابًا، وتضاعفت العجمةُ بحسبِ تنزُّلِ المعنى في حجابيةِ أمرِ السواءِ ممَّا كان أكثف حجابًا أو أدنى منِ الدناءةِ تنزُّلًاِ كان أزيدَ عجمةً إلى نهايةِ رُتَبِ الثلاثِ الجامعةِ التيهي أدنى تنزُّلِ أمرِ الله تعالى، وخُصَّ الإعجامُ بما فوق الحرفِ فيما حجابيتُه ظاهرةٌ للعيانِ أكثر كالقافِ مثلاً، وخُصَّ بالتحتِ ما حجابيتُه عن تنزُّلٍ وخفاءٍ عن العيانِ، ومسرى بلُطفٍ لقصورِ الأعلى بالإعادةِ إلى أمرِ السواءِ كالياءِ وما كان منِ صورِ الحروفِ أتمُّ إحاطةً وأولى ترتيبًا في جوامعِ الوضعِ لم يحتج إلى عجمةٍ لعلوِّه بالإحاطةِ كصورةِ الألفِ واللامِ والميمِ، والتي هي جوامعُ كليَّةِ الأمرِ كتابًا وإلى هيئةٍ [على ما فُسِّرَ] في الصورتين الجامعتين، وكذلك مبدأُ [ما كان] مبدأَ إحاطةٍ لم يُعجم لظهورِ علوِّ الإحاطةِ، كالدالِ والسينِ، وما كان ظاهرُ استيفاءِ الرُّتَبِ الثلاثِ أظهرَ في صورتهِ الإشاراتِ القائمةَ الثلاثَ كالسينِ والشينِ، وما كان إحاطيًا قُهرت به صورةُ الميمِ التي هي حقيقةُ الإحاطةِ في نهايةِ الظهورِ كالفاءِ والقافِ، وما كان أدى إلى أن يكونَ قائمًا في ذواتِ [أمرِ فَوْتٍ] به صورةُ الألفِ كاللامِ، وأُظهرت صورةُ إحاطةِ التربيعِ في الطاءِ ونحوِها، وكان أقوَمُ الصورِ صورةَ الألفِ لأنَّهُ صورةٌ ما لانحصارٍ لطرفيه وجماعُ أمرِ الصورِ منِ الدائرةِ وقطرِها وما يتركبُ منِ أجزائها، وألْحَظُّ الحُسْنِ ما حوفظِ فيه على التناسبِ للباسِه، لبسُه يناسبُ الحكمةَ في المدركِ المتحسِّنِ، وذلك أنَّ كلَّ مُدركٍ إذا ترك ما يناسب خَلْقَ ذاتهِ وافقه بمطابقةِ ذاتهِ المدرِكةِ، فكان ذلك هو استحسانُه، ولذلك إذا اختلف [خلقُ ذاتين] في التناسبِ اختلفا فيما يستحسنانه، وصار مستفتحُ كلِّ واحدٍ منهما مستحسنَ الآخرِ، وقد يوافقُ المدرِكُ عارضَ حالٍ لذاتِ المدرَكِ، فيعرضُ له استحسانًا بحسبِ تلك الحالِ، وعلى ذلك يجري حالُ المدرَكاتِ في جميعِ الحواسِ منِ الأصواتِ المطابقةِ تناسبُ ذات معانيها أو حالَه، وهذا المعنى العامُ هو حقيقةُ ما حرسه السماعُ، وهو مثالٌ مُدرَكٌ يوافقُ [تناسبُه ما المدرِك] عليه في وقتهِ، فإن كان يناسبه مطابقُ خلقِ ذاتهِ لم يزل مستحسناً له، وإن كان يناسبه مطابقًا حالا عرضت له دام استحسانهِ بدوامهِا، وكذلك حال ما يستفتحه المدرِكُ في حكمِ مخالفةٍ تناسبُ المدرَكَ لما عليه مدرِكُه في وقتهِ، فعلى ذلك يقعُ الاستحسانُ في الحظِّ، وإضافةُ كلِّ حرفٍ فيه قيامٌ على ما دونه هو مُقامٌ بما فوقه يتركبُ صورتُه بين [قائمٍ ومنبسطٍ]، كالباءِ القائمةِ بحكمِ التسبيبِ الذي هو ذاتُها، وهي مُقامةٌ بإطلاقِ التسبُّبِ منِ حكمِ الألفِ، وكذلك اللامُ ولكونها وصلةً بين قيامِ الألفِ وإحاطةِ الميمِ يجبُ أن يكونَ في صورتهِ انحناءٌ يسيرُ، وقصَرٌ عن مقدارِ صورةِ الألفِ؛ لأنَّ إقامته إقامةُ مرسلٍ بجوامعِ صورِ الحروفِ منِ إقامةِ الألفِ وإحاطةِ الميمِ منِ الاستدارةِ، وإحاطةِ الطاءِ منِ التربيعِ، وما يتحركُ منِ ذلك، [ومع ما] يقعُ بين أتمِّ القيامِ وأنهى المقامِ عليه، وتجري إبانةُ الصورِ في الحياةِ في الألسنةِ كلِّها على مقدارِ إبانةِ موقعِ ذلك الحرفِ في إعرابهِ عن كليَّةِ معناه وحظٍّ منه في ذلك اللسانِ، وذلك مضمونُ حكمةِ الله مما وراء أعمالِ الخلقِ ومواضعاتهِم منِ حيثُ لا يشعرون.
وكلُّ لسانٍ كان أبيَنَ [خلقًا كان أبيَنَ صورًا] منِ كتابةِ ما بين لسانِ]السرابين الأوُِل] لسانُ آدم -عليه السلامُ- الذي هو أوّلُ لسانٍ استسَرَّ فيه جامعُ أمرِ الله، وهو ألفُ الألسنةِ إلى اللسانِ العبراني الذي هو عاميُّ اللسانِ السرياني، ولسانُ اعتبارٍ ووصلةٍ، وهو لامُ الألسنةِ إلى نهايةِ تمامِ الوضوحِ في اللسانِ المبين، وهو ميمُ الألسنةِ وختامُها المعرِبُ عن تمامِ البدءِ والمعادِ، والباطنُ والظاهرُ المشيرُ في لحنِ نطقِه إلى ما وراء النطقِ منِ مواجدِ قلوبِ آلِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك فكلُّ كلامٍ في أيِّ لسانٍ كان متى كان مفصِحًا عن أمرٍ مُبَيَّناً عن ختامهِ فهو عربيُّ المواقعِ، وما كان مستسرًا فيه أمرُ ختامهِ فهو سريانيُّ المواقعِ، وما كان أعطى عبرةً إلى ما فوقه، وليس مما عليه قرارُ كمالٍ، فهو عبرانيُّ المواقعِ، وذلك لتندرجَ معاني الجوامعِ منِ الأمورِ بعضِها في بعضٍ، وجملتُها في تفصيلهِا ما دونها.
ولنلخص قولًا فيما أُعجم منِ الحروفِ على سُنةَ مباني التفصيلِ، مما أفادته جوامعُ معناه، وذلك أنَّ الباءَ أُعجمت لرفعِ حجابِ التسبيبِ، وسَفُلَت لتَنزُّلِ الأسبابِ إلى أدنى دنوٍّ، والتاء أعجمت كذلك وضوعفت عُجمتها لعودِ معنى التسبيبِ، وعلاءِ مواقعِ العجمةِ لأنَّ عودَه لاعتلاءٍ، والثاء أُعجمت لبنائها عليهما وانتهى فيها التضعيفُ؛ لأنَّها حجابُ حجابَي طرفين، وهي ثمراتُ الأشياءِ، وثوابُها ومثلاتُها، ومعنى وتريةِ هذه الحروفِ الثلاثة هي التي أوقفت الخلقَ في حُجبِ الإظلامِ منِ بين متمسكٍ للأسبابِ، ومنكرٍ لأمرِ العودِ، ومشتغلٍ بأمرِ الثوابِ والمثلاتِ.
والجيمُ أُعجمت لآيةِ جمعِ سببيةِ الباءِ، وجرت عجمتُه في السُّفلِ مجراها. والخاءُ أُعجمت؛ لأنَّها إظهار خبأ جميع بجهد، والطيِّبُ ما تخلَّص لُبُّه، والخبيثُ ما تعسَّر خبثُه، وعلاء موقعِ عجمتهِ؛ لأنَّه للجيمِ بمنزلةِ التاءِ للباءِ. والذالُ لمَا في مقتضى تذلُّلِ القائمِ بأمرٍ تَنزُّلًا في حقِّ المستتبعِ منِ الاحتجابِ والاختفاءِ، وعنه وقع استحقارُ الأممِ لأنبيائهم والصالحين لمَّا حاولوهم بالذُّلِ، ولم يؤاخذوهم بالأيدِ وسفكِ الدمِ والمدافعةِ، وكان يناسبُ نسَقا عجمتهِ لكنها أُعليت إعلامًا أنَّ حقيقةِ الذالِ إنَّما هو لأهلِ الظهورِ في الدنيا بغيرِ حقٍّ.
والزاي لمَا في مقتضى امتخاضِ علوِّ النسبِ منِ الإجهادِ في أزمةٍ وزجة إلى أن يظهرَ صفوُ بركةِ كليَّتهِ.
والظاء لمكان الظهورِ فيه بالعنفِ والتعالي، كإعجامِ الذالِ في الطرفِ الآخرِ منه، وهما طرفان وسط القيامُ في أمرِهما مزاجُ طرفيهما حتى يكونَ القيامُ بأيدٍ ممتزج برحمةٍ معضودةٍ بأيدٍ، ولذلك قُدِّمت بين يدَي الشرائعِ الرغبةُ والرهبةُ، والبشرى والإنذارُ، والثوابُ والعقابُ براءةً منِ مقتضى القيامِ بإحدى طرفَي الظاءِ والذالِ، فإنَّ القائمَ بالذُّلِ مقهورٌ، ولذلك قتَلت أنبياء الذُّلِ أُمَمُهُم، والقائمُ بالظهورِ مستهلكُ أُمَّته ومنه قهرٌ، وأهلك أنبياءُ الظهورِ أُمَمَهُم، واستعصم منِ طرفيهما الداعي بواسطةِ القيامِ بجميعِ إحاطةِ الأيدي والرحمةِ وسلمت أُمَّتُه منِ الهلاكِ، وعُصِمَ هو منِ عاديَّتها في صورةِ ذاتهِ، وعلى هذا كان أمرُ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم حتى [أنَّ الحربَ] كانت بينه وبين مدعويه سجالًا ونوبًا والعاقبةُ للمتقين، وكان ذلك حالُه وحالُ أُمَّتهِ صلّى الله عليه وسلّم بمقتضى ما دعى به منِ الحروفِ المدعو بها في أوائلِ السورِ خصوصًا في مضمونِ: ﴿ الٓمٓ ﴾ [البقرة: ١]، و ﴿ طسٓمٓ ﴾ [الشعراء: ١]، و ﴿ حمٓ ﴾ [غافر: ١]، و ﴿ حمٓ ۞ عٓسٓقٓ ﴾ [الشورى: ١-٢]؛ لأنَّ في معانيها ما أخذ طرفَي [الإحاطة من] الشدَّة واللين، فإلى نحوٍ منه يشيرُ ما [وصف منِ ذكر] أُمَّتهِ في قولهِ تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ [المائدة: 54].
والنون [لما في حالِ مَن] أعلن بالعلمِ منِ الاشتراكِ بنفسِه، وهو ظاهرُ ما حقيقتُه الشركِ الخفيِّ فيما يشيرُ إليه قولُه -عليه الصلاةُ والسلامُ-: «الشركُ في أمّتي أخفى منِ دبيبِ النمل»، وهو الشركُ الذي هو للباطنِ السابعِ المستترِ آيتُه في حقيقةِ سورةِ براءة الذي أَمَرَ -عليه الصلاةُ والسلامُ- أن لا يبلغها عنه إلاَّ مَن هو منِ أهلِ بيتهِ، فكان حينئذٍ المبلغُ عَليًّا-رضي اللهُ عنه- تلاها ظاهرًا بعرفة، وعرف حقيقَتَها لمَن يسَّر له التخلِص ممن جرى عليه مضاءُ حقيقةِ العهدِ على خفي الشركِ بحكمِ حكمةِ الله الذي تفرَّج فيها منِ عهدِ الله ما جمعه «عليٌّ» في خلوتهِ وِعكوفهِ بعد وفاتهِ صلّى الله عليه وسلّم فيما يشيرُ إليه قولُه: إنَّما عكفتُ على عهدِ الله أجمعُ ما تفرَّج منه، فذلك منِ حقيقةِ تبليغِه سورةَ براءة، ثم جرى بلاغُ ذلك في آلِ محمدٍ -صلى اللهُ عليه وسلّم- غابرَ اليومِ المحمديِّ إلى نهايةِ ختمِ خاتمِه في عصرِه في وسطِ المائةِ الثامنةِ، وفواتحَ الساعةِ العاشرةِ، لإتمامِ ظهورِ أمرِ الله، وعند التخلُّصِ منِ ذلك الشركِ الخفيِّ والبراءةِ منه تظهرُ حقيقةُ انمحاءِ الكُفرِ الذي حقيقتُه في مضمونِ ما تسمَّى به محمدٌ صلّى الله عليه وسلّم في قولهِ: «أنا الماحي الذي يمحو اللهُ بي الكفرَ»، وقد انمحى الكفرُ ولله الحمدُ، وله صلّى الله عليه وسلّم، ولإخوانهِ منِ بعدِه، وذلك حقيقةُ ما اختُصَّ به أمرُ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم وَوَجَبَ له به الختمُ، وهو موجودُ الإعلانِ في لحنِ كتابهِ وخطابهِ لكن لا ينجلي موقعه إلَّا لواحدٍ فتح اللهُ له في ذاتهِ، وعن بركةِ انمحاءِ كليَّةِ الكفرِ تتفتحُ جميعُ معارفِ [النحَِّلِ والمللِ]، والبواطنِ والظواهرِ، والأوائلِ وِالأواخرِ، ووجهِ مَضَاءِ الأحكامِ في كلِّ عالمٍ بمقتضى حظِّهم منِ حكمةِ الله حتى لو حل [مَدِينتَيّ جاب لقاء، وجاب رضا] لا يعرفون الشمسَ ولا القمرَ على ما يؤثرُ في الخبرِ ليقضي بينهم بحكمِ الله الواقعِ على مقتضى حظِّهم منِ حكمةِ الله كما يقضي فيما بين يديه مما تلقَّنه عنه حملةُ العِلمِ دونه، وبالجملةِ فموقعُ الإعجامِ في النونِ منِ مقتضى محلِّ الاحتجابِ بحجابِ النورِ، فإنَّه كمِا أنَّ الجهلةَ محجوبون عن الله بظلمةِ الجهلِ، فالعلماءُ محجوبون عن الله بنورِ العِلمِ على ما يشيرُ إليه قولُه -عليه الصلاةُ والسلامُ-: «حجابُه النورُ»، فأمرُ الله [هو ما] ينمحي فيه نورُ العِلمِ وظِلمةُ الجهلِ، وفرقُ النارِ ومرجُها؛ لأنَّ جميعَ ذلك حُجُبٌ على ما هو أمرُ الله في ذاتهِ. والضادُ أُعجمت لما في الصدقِ عن عوجاءِ الأمورِ منِ حكمِ الاعترافِ الذي تترتَّبُ عليه المضارُّ بإقامةِ الحدودِ، والإلجاءُ إلى النفوذِ في حجابٍ منِ حُجُبِ النارِ لمقصدِ الطهرةِ منِ نزولِ الرتبةِ، وبمقتضى الظاءِ منِ غلبةِ الظهورِ، والضادِ منِ إمضاءِ المضارِّ، كثُفَ الاحتجابُ في أمرِ الملوكِ، فوقفت أذهانُ الخلقِ عند ظهورِهم وضُرِّهم حتى تعبَّدوا لهم، وخافوا الانتقامَ وتقلَّدوا النعِمَ منهم حتى صارت أسماؤهم أقسامًا، وملأوا صدورَهم رغبةً ورهبةً وإعظامًا وشمَلَهُم ظنُّ أنَّ الخيرَ الذي أذاقه اللهُ عبادَه في الدنيا ليأخذوه أنموذجًا لما وعدهم به في الأخرى إنَّما هو موجودٌ في الصورِ التي يتعاطاها أهلُ الدنيا منِ المباني العاليةِ، والأطعمةِ المتنوعةِ، والملابسِ الفاخرةِ، والمراكبِ الجميلةِ، والأعراضِ المِنبسطةِ والإرهاقِ إلى الوجاهةِ، وذلك الظنُّ حجابُ جهلٍ لموقعِ لُطفِ الله، وإنَّما يوجدُ مذاقُ الخيرِ والروح فيما [شاءه الله] لمن هو أقربُ فأقربُ إليه منِ خلقِه إلى رتبةِ ما هو أحبُّ إليه فيودِعه لهم في أيِّ صورةٍ كان منِ أدناها وأعلاها، وما بينهما فيذيقُ لطفَه لأوليائهِ وأحبائهِ في أدنى المساكنِ، وأيسرِ الطعامِ والشرابِ، وأبذلِ الملابسِ، وأيمنِ المراكبِ، وأجمعِ الأعراضِ، وأهونِ المؤنِ، فينفذُ لهم الحياةَ في قلوبِ الخَلقِ أو يجمعُ لهم ما شاء منِ ذواقِ خيرِه في أجملِ الصورِ وأجمعِها وأيسرِها كما جمع النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم منالَه منِ خيرِ الله في الدنيا في الطيبِ والنساءِ والصلاةِ، فيَستطِعمُ أولياءُ الله وأحباؤه فيما تسنى لهم منِ صورِ الدنيا منِ مذاقِ خيرِ الله فيها ما لا ينالُه ملوكُ الدنيا ولا أتباعُهم، ولا يجدون منِ روحِه شيئًا ولا تنساقُ لهم النفوسُ بجزءٍ منِ معشارِه، كما قال أبو سفيان: «لقد رأيتُ مُلكَ كسرى وقيصر، فما رأيتُ كمحمدٍ صلّى الله عليه وسلّم عند أصحابهِ كلما نخم نخامةً ابتدروها يمسحوا بها وجوهَهم»، فلم يَخْفَ على أبي سفيان فضلَ جاهِ أحباءِ الله [على جاهِ] أبناءِ الدنيا بإقبالِ القلوبِ على مَن تولاَّه، وإدبارُها عن أبناءِ الدنيا وإن اضطروا أقبلوا بجسومهِم وظواهرِهم دون نفوسِهم، فبالحقيقةِ مَن زَهدَ في ظاهرِ الدنيا لم يزهد في خيرٍ، ومَن تركها لم يترك إلَّا شرًا نكدًا، فلم يَحرم اللهُ أولياءه وأحباءه خيرًا في الدنيا ولا في الآخرةِ على ما يشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: 97]، ولذلك لم يعطِ أهلَ الدنيا إلَّا صورًا باطنهُا عذابٌ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا ﴾ [التوبة: 85]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ [طه: 131]، فليُعلَم هذا بتأييد من أمرِ الله تعالى ينكشفُ حجابُ المُ ِ لك ويقلُّ موقعهُ في قدرِ ما وراءه، وتذهبُ العجمةُ، ومنِ مضمونِ حرفَي الظاءِ والضادِ، [فيعلوا فيصيرا] طاءً وصادًا، وينتهي النافذُ في حجابِ ظلمتهِا إلى الواقعةِ في حجابِ النونِ الذي هو [حجابُ إحاطةِ النورِ]، وهنالك وقف من سوى آلِ محمدِ، ولم ينفذه إلَّا واحدٌ حقيقةً منِ أمرِ الألفِ الذي هو قوامُ الواوِ الذي هو قوامُ النونِ.
والغينُ أُعجمت لمقتضى معنى الغيبِ والغفرِ الحاجبِ ما هو الغينُ، وهو حجابُ الغفلةِ والغمُّ الذي تاه فيه عامةُ الأنامِ، واسمُ الحرفِ الذي هو الغينُ اسمُ ما هو إحاطةُ هذا المعنى، ومجرى الحرفِ منه في كلمةِ إنَّما هو الوجودُ حظٌّ منه في مضمونِ تلك الكلمةِ؛ لأنَّ أسماءَ الحروفِ هي أسماءُ تسخيرِ المعاني لإحاطةِ تخليطِ أيِّ واحدةٍ، والحروفُ في الكَلمِ بمنزلةِ خُلجٍ منتظمةٍ بعضِها مع بعض.
والفاءُ التي مقتضاها للتغيُّرِ بتصرُّفِ الخَلقِ؛ لأنّها اسمُ إحاطةِ ما أنهى اللهُ الأمرَ في الحكمِ إليه بتولي ظاهرِ قدرتهِ، ومنِ حدِّ إحاطتهِ ظهر تولي الخَلقِ منِ أنفسِهم بمسرى قدرةِ الله منِ حيثُ لا يشعرون، ومخاطبةُ الحقِّ لهم على مقتضى تولِّيهم أنفسهم هو حقيقةُ عهدِهم على الشركِ الخفيِّ في الأفعالِ، ووراءه منِ الشركِ ما هو أخفى منه، ووراء ذلك في الرتبةِ الثالثةِ الشّركُ الأخفى الذي باطلاعِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم [على ذلك] ذهب الشركُ، وظهر حقيقةُ ما هوِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، وانمحى الكفرُ، وكان ما سواهم من الخَلقِ [ ِ كأعضاء بدنٍ] هم قلبُه، فصدق انمِحاءُ الكفرِ بانمحائهِ في قلبِ الكونِ، بل الكونُ منِ محمِدٍ وآلهِ، والحمدُ لله، وبظهورِ موقعِ عجمةِ الفاءِ يظهرُ بدءُ مطلعِ اسمِ الله الأعظمِ إلى نهايةِ ظهورِ موقعِ العجمةِ في الشينِ والغينِ اللذين بانتظامهِما يسمَّى معنى ما هو الغِشُّ به الذي يترتَّبُ عليه حقيقةُ ما يشيرُ إليه قولُه -عليه السلامُ-: «مَن غشَّ فليس منا»، وذلك لبراءتهِ صلّى الله عليه وسلّم وآله مما هو تسخيرُ الغِشِّ والشركِ والكفرِ.
والقافُ أعجمُ كما أعجم النونُ؛ لأنَّ الاقتدارَ حجابُ نورٍ هو ظاهرُ ِالنون، وكلاهُما حجابُ نورٍ منِ أمرَي الهدايةِ بالعلمِ والإقامةِ بالحقِّ، ولذلك كان منِ الحروفِ الكتابيةِ الخطابيةِ حظُّ العامِ منِ القرآنِ الذي هو ما أحاط به سورةُ «ق،» و«ن»، اللذين حظّ المفصّلِ منِ سورةِ الحروفِ.
والشينُ أعجمُ [لمقتضى مشغلةِ] الأشياءِ المُقامِ بها أمورُ الخَلقِ عن آيةِ ما هو السينُ منِ أمرِ السَّمعِ حتى اِستغنى الخَلقُ بما رأوا عَمَّا يسمعون، فالشينُ حجابٌ منِ حُجُبِ آياتِ الله، فهو حجابٌ بمنزلةِ الغينِ منِ العينِ حتى كان العشيُّ حجابَ السعيِّ، والسعيُّ حجابَ ما وراءه إلَّا أنَّ العشيَّ قشرُ أمرٍ يطرحُه، والسعيُّ قشرٌ آخرُ دونه إذن في تركهِ ولحنٌ تنزعه ليظهرَ ما وراءه منِ لُبٍّ في كثافةِ لطافةِ عصرِ زيتٍ في شفاِفةِ لمحِ نورٍ في دفعِ ازدواجِه بالإظلامِ، ووترِه بالنارِ في إطلاقِ أمرِ الله الذي هو حقيقةُ ما يشيرُ إليه اسمُ الألفِ.
والياءُ أُعجمت إعجامًا مضاعفًا لتضعيفِ الاحتجابِ في مقتضى ما هو الباءُ أحدُهما بالإضافةِ إلى سواءِ الألفِ، والثاني بخفاءِ العلوِّ في موقعِ نهايةِ التنزُّلِ لجَوْزِ الإحاطةِ إذ لا يظهرُ وجهُ العلوِّ في التنزُّلِ والدُّنوِّ إلاَّ لعالمٍ على ما يشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾ [المنافقون: 8]، وبقولِه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: 8].
وبالجملةِ فاعلم أنّ اللهّ سبحانه أظهر الأرواحَ في رتبِ الحكمِ وأبان فيها التضادَ، وأخفى بأمرٍ ما وراء ظاهرِ الحكمِ منِ باطنِ حكمتهِ الأضدادَ بعضَها في بعضٍ وراء العقلِ الذي هو منِ [عقالِ ظاهرِ] الحُكمِ أنَّها لا تجتمعُ، فكيف يتحقَّقُ وجودُ بعضِها في ذاتِ بعضٍ، فانعجمت الأسماءُ لإحاطاتٍ بحدودِ كليَّةِ الحُكمِ منِ مقتضى الحروفِ، وأحال العقلُ أن يكونَ الغينُ عينَ العينِ، وأنْ يكونَ الشينُ عينَ السينِ، والظاءُ عينَ الطاءِ، والضادُ عينَ الصادِ، فأجرى الحقُّ ظاهرَ خطابِ التفصيلِ على حكمِ ظاهرِ الحكمةِ، وعقالِ العقلِ، وألاح بخطابِ الحروفِ على ما أجرى عليه كَلمِها منِ التزامِ الوِترِ فيها، وقوامِ أوساطهِا ومواقعِ إعجامهِا، مع لحنٍ منِ خطابِ التفصيلِ، ما أظهره تمامُ الحكمِ وأمرها وراء العقل؛ ليظهرَ الازدواجُ في كليَّةِ الحُكمِ بين عقلِ ظاهرِها وإطلاقِ أمرِها، فيتضحُ عند ذلك فيها معنى الوِترِ ويبدو مطلعُ سواءِ الأمرِ، ولْننُهْي القولَ في هذا المطلعِ الثاني [عند هذه الفائدةِ] بحولِ الله وتأييدِه.
* * *
hXPh3Gy1sKg
 |
 |