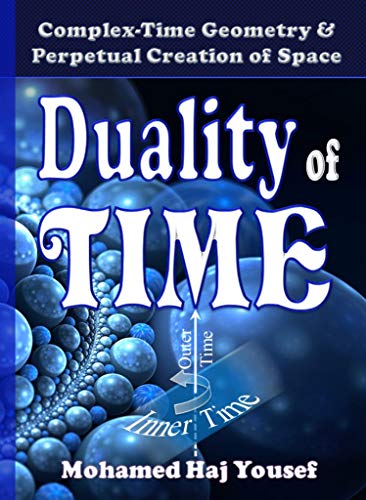المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
أبو طالب المكي (المتوفى: 386هـ)
الفصل الثاني والثلاثون شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين
 |
 |
الفصل الثاني والثلاثون شرح مقامات اليقين وأحوال الموقنين
أصول مقامات اليقين التي ترد إليها فروع أحوال المتقين تسعة، أوّلها التوبة، والصبر، والشكر، والرجاء، والخوف، والزهد، والتوكل، والرضا، والمحبة وهذه محبة الخصوص وهي محبة المحبوب.
ذكر فروض التوبة
وشرح فضائلها ووصف التوابين
قال الله تعالى في البيان الأوّل من خطاب العموم: (وَتُوبُوا إلى الله جميعاً أيُّها الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور: 31 معناه: ارجعوا إليه من هوى نفوسكم ومن وقوفكم مع شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم في المعاد وكي تبقوا بقاء الله عزّ وجلّ في نعيم لا زوال له ولا نفاد ولكي تفوزوا وتسعدوا بدخول الجنة وتنجوا من النار فهذا هو الفلاح، وقال في البيان الثاني من مخاطبته الخصوص: (يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحاً عسى ربُّكُمْ أنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِها الأنهارُ) التحريم: 8، فنصوحاً من النصح جاء على وزن فعول للمبالغة في النصح، وقد قرئت نصوحاً بضم النون فتكون حينئذ مصدر نصحت له نصحاً ونصوحاً فمعناه خالصة لله تعالى وقيل اشتقاقه من النصاح وهو الخيط أي مجردة لا تتعلق بشيء ولا يتعلق بها شيء وهو الاستقامة على الطاعة من غير روغان إلى معصية كما تروغ الثعالب وأن لا يحدث نفسه بعود إلى ذنب متى قدر عليه وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى خالصاً لوجهه كما ارتكبه لأجل هواه مجمعاً عليه بقلبه وشهوته، فمتى أتى الله عزّ وجلّ بقلب سليم من الهوى وعلم خالص مستقيم على السنّة فقد ختم له بحسن الخاتمة، فحينئذ أدركته الحسنى السابقة وهذا هو التوبة النصوح وهذا العبد هو التوّاب المتطهّر الحبيب وهذا إخبار عمّن سبقت له من الله الحسنى ومن تداركه نعمة من ربه رحمه بها من تلوث السوأى وهو وصف لمن قصده بخطابه إذ يقول في كتابه: ( إنَّ الله يُحِبُّ الْتَّوَّابينَ وَيُحِبُّ الْمُتطَهِّرينَ) البقرة: 222، وكما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وسئل الحسن عن التوبة النصوح: فقال هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود إليه.
وقال أبو محمد سهل رحمه الله ليس من الأشياء أوجب على هذا الخلق من التوبة ولا عقوبة أشد عليهم من فقد علم التوبة وقد جهل الناس علم التوبة وقال: من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كاف، ومن رضي بقوله فهو كافر وقال: التائب الذي يتوب من غفلته في الطاعات في كل طرفة ونفس، وقد جعل عليّ كرم الله وجهه ترك التوبة مقاماً في العمى وقرنه باتباع الظن ونسيان الذكر فقال في الحديث الطويل: ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وطلب المغفرة بلا توبة ولا استكانة ففرض التوبة الذي لا بد للتائب منه ولا يكون محقاً صادقاً إلا به الإقرار بالذنب والاعتراف بالظلم ومقت النفس على الهوى وحلّ الإصرار الذي كان عقده على أعمال السيئات وإطابة الغذاء بغية ما يقدر عليه لأن الطعمة أساس الصالحين ثم الندم على ما فات من الجنايات.
وحقيقة الندم إن كان حقاً إذ لكل حق حقيقة أن لا يعاود إلى مثل ما وقع الندم عليه ثم اعتقاد الاستقامة على الأمر ومجانبة النهي وحقيقة الاستقامة أن لا يقابل ما استقبل من عمره بمثل ما وقع الاعوجاج به وأن يتبع سبيل من أناب إلى الله وأن لا يصحب جاهلاً فيرديه ثم الاشتغال بإصلاح ما أفسد في أيام بطالته ليكون من المصلحين الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوا فإن الله عزّ وجلّ لا يصلح عمل المفسدين كما لا يضيّع أجر المحسنين ثم الاستبدال بالصالحات من السيئات والصالحات من الحسنات ليكون ممن تبدل سيئاته حسنات لتحققه بالتوبة وحسن الإنابة لأن التبديل يكون في الدنيا يبدّل بالأعمال السوأى أعمالاً حسنى بدليل قوله تعالى: (إنَّ الله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) الرعد: 11 فإذا غيّر ما بهم من سيّءٍ حسناً بدّل سيئاتهم حسنات ثم الندم ودوام الحزن وحقيقة الندم والحزن على الفوت أن لا يفرط ولا يني في وقت دركه ولا يرجع ولا ينثني في حيز استبداله فيفوت نفسه وقتاً ثانياً إذ كان يعمل في درك ما فات ولا يفوت ما أدرك في حال تيقظه فتكون يقظته شبيهاً بما مضى من غفلته إذ كان في درك ما فات شبيهاً بما مضى من غفلته إذ لا يدرك الفوت بالفوت ولا ينال النعيم بالنعيم ليكون كما وصف الله تعالى: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا علماً صالحاً وآخر سيئاً) قيل: الاعتراف والندم، وقال أبو سليمان الداراني: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على فوت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله.
وقال سهل بن عبد الله: التائب لا يقله شيء يكون قلبه متعلقاً بالعرش حتى يفارق النفس ولا عيش له إلا الضرورة للقوام ويغتمّ على ما مضى والجدّ في الأمر ومباينة النهي فيما بقي ولا يتم له ذلك إلا باستعمال علم اليقين في كل شيء ثم المتابعة بأعمال الصالحات ليكون ممن قال الله تعالى: (وَيَدْرَؤونَ بِالْحسنَةِ السيَّئِّةَ) الرعد: 22 الآية أي يدفعون ما سلف من السيئات بما يعلمون من الحسنات.
وكذلك قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أبي ذر فإذا عملت سيئة فأعمل بعدها حسنة السرّ بالسرّ والعلانية بالعلانية وفي وصية معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وليدخل في الصالحين كما قال الله تعالى: (والَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ في الصَّالِحينَ) العنكبوت: 9، ثم المسارعة إلى الخيرات إذا قدر عليها ليدرك بها ما ضيع وفات ليكون من الصالحين وفي هذا المقام يصلح لمولاه فيحفظه ويتولاه كما قال الله: (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحينَ) الأعراف: 196، وجمل ما على العبد في التوبة وما تعلق بها عشر خصال، أولها فرض عليه أن لا يعصي الله تعالى، والثانية إن ابتلى بمعصية لا يصرّ عليها، والخصلة الثالثة التوبة إلى الله تعالى منها، والرابعة الندم على ما فرط منه، والخامسة عقد الاستقامة على الطاعة إلى الموت، والسادسة خوف العقوبة، والسابعة رجاء المغفرة، والثامنة الاعتراف بالذنب، والتاسعة اعتقاد أن الله تعالى قدر ذلك عليه وأنه عدل منه، والعاشرة المتابعة بالعمل الصالح ليعمل في الكفارات لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي جميع هذه الخصال جمل آثار رويناها عن الصحابة والتابعين يكثر ذكرها، ويقال: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين قال: فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا من أوّلها إلى آخرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها أو يستبدل بها فلا يجد إلى ذلك سبيلاً، وهذا تأويل قوله عزّ وجلّ: (وَحيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ) سبأ: 54 قيل: التوبة وقيل: الزيادة في العمر وقيل: حسن الخاتمة حيل بينهم وبين ذلك كما فعل بأشياعهم من قبل أي بنظرائهم وأهل فرقتهم قال: فإذا كل ساعة تمضي على العبد فهي بمنزلة هذه الساعة قيمتها الدنيا كلها إذا عرف قيمة ذلك فلذلك قيل ليس لما بقي من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من الله تعالى بالتصريف والحكمة
وقيل في معنى قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أنْ يَأْتِيَ أحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أخَّرتني إلى أَجلٍ قَريبٍ) المنافقون: 10 قال: الوقت القريب أن يقول العبد عند كشف الغطاء: يا ملك الموت أخرني يوماً أعبد فيه ربي وأعتب فيه ذنبي وأتزوّد صالحاً لنفسي فيقول: فنيت الأيام فلا يوم، فيقول: أخرني ساعة فيقول فنيت الساعات فلا ساعة، قال: فتبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكظمه عند الغرغرة فيغلق باب التوبة ويحجب عنه وتنقطع الأعمال وتذهب الأوقات وتتصاع الأنفاس يشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره فإذا كان في آخر نفس زهقت نفسه فيدركه ما سبق له من السعادة فتخرج روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة أو يدركه ما سبق له من الشقوة فتخرج روحه على الشرك فهذا الذي قال الله عزّ وجلّ: (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذين يَعْمَلُونَ السَيِّئاتِ حَتّى إذا حَضَر أحدَهُمُ الْمَوْتُ قال إنّي تُبْتُ الآن) النساء: 18، فهذا سوء الخاتمة نعوذ بالله منه وقيل: هذا هو المنافق ويقال: المدمن على المعاصي المصرّ عليها.
وقد قال الله تعالى: (إِنَّما التَّوْبَةُ على الله للَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ منْ قَريبٍ) النساء: 17، قيل: قبل الموت وقبل ظهور آيات الآخرة وقبل الغرغرة أي تغرغر النفس في الحلقوم لأنه تعالى قد حكم أن التوبة بعد ظهور إعلام الآخرة لا تقبل، ومنه قوله عز وجلّ: (يَوْمَ يأْتي بعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنتْ مَنْ قَبْلُ) الأنعام: 158 يعني من قبل معاينة الآيات أو كسبت في إيمانها خيراً قيل: التوبة هي كسب الإيمان وأصول الخيرات وقيل: الأعمال الصالحة هي مزيد الإيمان وعلامة الإيقان وقد قيل: ثم يتوبون من قريب أي عن قريب عهد بالخطيئة لا يتمادى فيها ولا يتباعد عن التوبة وتوبته من قريب أن يعقب الذنب عملاً صالحاً ولا يردفه ذنباً آخر وأن يخرج من السيئة إلى الحسنة ولا يدخل في سيئة أخرى وقيل: أول من يسأل الرجعة من هذه الأمة من لم يكن أدى زكاة ماله أو لم ييكن حجّ بيت ربه فذلك تأويل قول الله تعالى: (فأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصالِحينَ) المنافقون: 10، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: هذه الآية من أشد شيء على أهل التوحيد هذا لقوله تعالى في أوّلها: (يا أيُّها الَّذين آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُم ولا أوْلادُكُمْ عنْ ذِكْرِ اللهِ) المنافقون: 9، وقد قيل: لا يسأل عبد الرجعة عندا لموت وله عند الله عزّ وجلّ مثقال ذرة من خير.
وروينا بمعناه من كان له في الآخرة مثقال ذرة من خير لو أن له الدنيا بما فيها من أوّلها إلى أخرها لم يحب أن يعود إلى الدنيا، وقال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرّين يسرهما إليه يوجده ذلك بإلهام يلهمه، أحدهما إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وأنظر كيف تلقاني كما أخرجتك، وسرّ عند خروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد والرعاية فألقاك بالوفاء والجزاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب؟، فهذا داخل في قوله عزّ وجّل: (والَّذينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) المؤمنون: 8، وفي قوله تعالى: (وأَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) البقرة: 40 عمر العبد أمانة عنده إن حفظه فقد أدى الأمانة وإن ضيّعه فقد خان الله، إن الله لا يحبّ الخائنين، وفي خبر ابن عباس رضي الله عنه من ضيع فرائض الله عزّ وجلّ خرج من أمانة الله وعند التوبة النصوح تكفير السيئات ودخول الجنات، وكان بعضهم يقول: قد علمت متى يغفر الله لي قيل: ومتى؟ قال: إذا تاب علي، وقال آخر: أنا من أن أحرم التوبة أخوف مني من أن أحرم المغفرة، وقال الله تعالى: (وَمَنْ أصْدقُ مِنَ الله حَديثاً) النساء: 87 فتاب عليكم وعفا عنكم وقال تعالى في مثله: (وَهُو الَّذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن السَّيِّئاتِ) الشورى: 25
وقال بعض العلماء: لا تصحّ التوبة لعبد حتى ينسى شهواته ويكون ذاكراً للحزن لا يفارقه قلبه ذاهباً عن الذنب لا يخالج سرّه، وقال بعض علماء الشام: لا يكون المريد تائباً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال معصية عشرين سنة، وقال بعض السلف: من علامة صدق التائب في توبته أن يستبدل بحلاوة الهوى حلاوة الطاعة وبفرح ركوب الذنب الحزن عليه والسرور بحسن الإنابة، وقال بعض العلماء في معناه: لا يكون العبد تائباً حتى يدخل مرارة مخالفة النفس مكان حلاوة موافقتها، وحدثنا في الإسرائيليات: إن الله عزّ وجلّ قال لبعض أنبيائه وقد سأله قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم يرَ قبول توبته فقال له: وعزتي وجلالي لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه ومن بقيت حلاوة المعصية في قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه العود فيها إلا بشدة مجاهدة وكراهة لها ونفي خاطرها عن سره إذا ذكرها بالخوف والإشفاق منها، وقال أبو محمد سهل: أول ما يمر به المبتدئ المريد التوبة وهو تحويل الحركات المذمومة إلى حركات محمودة ويلزم نفسه الخلوة والصمت ولا تصحّ له توبة إلا بأكل الحلال ولا يقدر على الحلال حتى يؤدي حق الله تعالى في الخلق وحق الله تعالى في نفسه ولا يصح له هذا حتى يتبرأ من حركته وسكونه إلا بالله تعالى وحتى لا يأمن الاستدراج بأعمال الصالحات وحقيقة التوبة أن يدع ما له حتى لا يدخل فيما عليه ولا يكون يسوف أبداً إنما يلزم نفسه الحال في الوقت.
وحدثونا عن سري السقطي أنه قال: من شرط التوبة أن ينبغي للتائب المنيب أنه يبدأ بمباينة أهل المعاصي ثم بنفسه التي كان يعصى الله تعالى لها ولا ينيلها إلا ما لا بدّ منه ثم الاعتزام على أن لا يعود في معصية أبداً ويلقى عن الناس مؤونته ويدع كل ما يضطره إلى جريرة ولا يتبع هوى ويتبع من مضى من السلف، وينبغي لأهل التوبة أن يحاسبوا نفوسهم في كل طرفة ويدعوا كل شهوة ويتركوا الفضول وهي ستة أشياء: ترك فضول الكلام، وترك فضول النظر، وترك فضول المشي، وترك فضول الطعام، والشراب، واللباس، قال: ولا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات، وسئل يحي بن معاذ رحمه الله كيف يصنع التائب؟ فقال: هو من عمره بين يومين، يوم مضى ويوم بقي، فيصلحهما بثلاث: أما ما مضى فبالندم والاستغفار، وأما ما بقي فبترك التخليط وأهله ولزوم المريدين ومجالسة الذاكرين والثالثة لزوم تصفية الغذاء والدأب على العمل، ومن علامة صدق التوبة رقة القلب وغزارة الدمع، وفي الخبر: جالسوا التوابين فإنهم أرقّ شيء أفئدة ومن التحقق بالتوبة أن يستعظم ذنوبه فإنه يقال إن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند الله تعالى ويقال: إن استصغار الذنب كبيرة، كما جاء في الخبر: المؤمن الذي يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق الذي يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره، وقد روينا في خبر مرسل: ليتقّ أحدكم أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه في نفسه.
وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل شيء عملته مثل هذا فهذا كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت.
وقد حدثنا عن الله تعالى أنه أوحى إلى بعض أوليائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظمة مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته بها فإنما عظمت الذنوب من تعظيم المواجه بها وكبرت في القلوب لمشاهدة ذي الكبرياء ومخالفة أمره إليها فلم يصغر ذنب عند ذلك وكانت الصغائر عند الخائفين كبائر وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: (ذلك ومَنْ يُعَظّمْ حُرُماتِ الله فَهُو خيْرٌ لَهُ) (وَمَنْ يُعَظِّمْ شعائِرَ الله فإنَّها مِن تَقْوى القُلوُبِ) الحج: 30 - 32 قيل: الحرمات تعظم في قلبه فلا ينتهكها، ومن هذا قول الصحابة للتابعين: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدّها في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الموبقات ليسوا يعنون أن الكبائر التي كانت على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صارت بعده صغائر ولكن كانوا يستعظمون الصغائر لعظمة الله تعالى في قلوبهم لعظيم نور الإيمان، ولم يكن ذلك في قلوب من بعدهم، وأوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: كم من ذنب رأيته منك قد أهلكت بدونه أمة من الأمم.
وقد روينا عن أبان بن إسماعيل عن أنس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنه أهلك الله تعالى أمة من الأمم كانوا يعبثون بذكورهم فأما نسيانه الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين في ذلك فقال بعضهم: حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك وقال آخر: حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك، وهذا طريقان لطائفتين وحالان لأهل مقامين فأما ذكر الذنوب فطريق المريدين وحال الخائفين يستخرج منهم بتذكرها الحزن الدائم والخوف اللازم، وأما نسيان الذنوب شغلاً عنها بالأذكار وما يستقبل من مزيد الأعمال فطريق العارفين وحال المحبين ووجهة هؤلاء شهادة التوحيد وهي مقام في التعريف ووجهة الأولين مشاهدة التوقيف والتحديد وهي مقام في التعريف، ففي أيّ المقامين أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعمل بحكم حالته ومقام شهادة التوحيد أفضل عند العارفين من مقام مشاهدة التعريف وإن كانت هذه أوسع وأكثر إلا أنها في أصحاب اليمين وفي عموم المقربين، وشهادة التوحيد أضيق وأقل وأهلها أعلى وأفضل وهي في المقرّبين وخصوص العارفين وقد يعترض المريد بقصة دواد عليه السلام في تذكره ونوحه على خطيئة فإن الأنبياء لا يقاس عليهم لمجاوزتهم حدود من دونهم وقد يقلبون في أحوال المريدين ويسلك بهم سبيل المتعلمين وذلك لأجل الأمة ليكون طريقاً للعالمين، وأعلم أنه لا يؤمن على ضعيف اليقين قوي النفس عند تذكّر الذنوب نظر القلب إليها بشهوة أو ميل نفس معها بحلاوة فيكون ذلك سبب فتنته فيفسد من حيث صلح كما لا يؤمن على معتاد خطيئة بالنظر إلى سببها حركة النفس إليها وإن كان الأفضل الإتفاق معها ما لم يكن الإتفاق معصية لمجاهدة النفس بالصبر عنها إلا أن ذلك غرور وفيه خطر فترك الاجتماع وقطع الأسباب حينئذ أسلم وما كان أسلم للمريد فهو أفضل وفي نسيان الذنوب الذكر لما يستقبل والانكماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت الثاني.
وقد كان بعض أهل المعرفة يكره للمريد أن يكون وسواسه الجنة أو نذكر ما فيها من النعيم واللباس والأزواج وقال: واستحب للمريد أن يكون وسواسه ذكر الله تعالى وخواطره وهممه متعلقة بالله تعالى لا سواه قال: لأن المريد حديث عهد بتوبة غير معتاد لطول الاستقامة والعصمة، فإذا تذكر نعيم الجنة لم آمن عليه لضعف قلبه أن يشتهي مثله مما يشاهد في الدنيا من اللباس والطيبات والنكاح لأن هذا عاجل وذاك آجل فتطلب نفسه مثل ما تذكرت من نعيم الآخرة معجلاً في الدنيا قال: فإذا كان همه الله تعالى كان أبعد له من زينة الدنيا وشهواتها ولم يجتر العدو بتمثيل ذلك له من العاجل إلى أن يقوى يقينه وتنتقل عادته وتدوم عصمته، وقد اختلف أهل العلم أيضاً في عبد ترك ذنباً وعمل في الإستقامة ونفسه تنازعه إليه وهو يجاهدها، وفي آخر: ترك الذنب وانكمش في الإصلاح فلم تكن نفسه تطالبه فلا تنازعه إلى الذنب ولم يكن على قلبه منه ثقل ولا مجاهدة، أيّ هذين أفضل فقال بعض علماء أهل الشام: الذي تنازعه نفسه إلى الذنب وهو يجاهدها أفضل لأن عليه منازعة وله فضل مجاهدة، ومال إلى هذا القول أحمد بن أبي الحواري وأصحاب أبي سليمان الداراني.
وقال علماء البصرة: الذي سكنت نفسه عن المنازعة بشاهد من شواهد اليقين والطمأنينة فلم يبق فيه فضل لعود ولا طلب لمعتاد أفضل، ومال إلى هذا رباح بن عمرو القيسي وهو من كبار علماء البصريين، وقال: لو فتر هذا لكان هذا أقرب إلى السلامة ولم يؤمن على الآخر الرجوع وهذا كما قال، وقد اختلف العلماء أيضاً في عبدين سئل أحدهما شيئاً: من بذل ماله في سبيل الله فأبت نفسه عليه وثقل عليها ذلك فجاهدها وأخرج ماله، وسئل آخر، بذل ماله فبذله مع السؤال طوعاً من غير منازعة نفس ولا ثقل عليها ولا مجاهدة منه لها أيهما أفضل؟ فقال: قوم المجاهد لنفسه أفضل لأنه جتمع له الإكراه والمجاهدة فحصل له عملان، وذهب إلى هذا القول ابن عطاء وأصحابه، وقال آخرون: الذي سمحت نفسه بالبذل طوعاًمن غير إكراه ولا اعتراض أفضل قال: لأن مقام هذا في سخاوة النفس والتحقق بالزهد أفضل من جميع أعمال الأول من الإكراه والمجاهدة، ومن بذل ماله على ذلك ولأن الأول وإن غلب نفسه في هذه الكرة لأياً من غلبتها له في كرة ثانية أو ثالثة إذ ليس السخاء من مقامها لأنها كانت محمولة عليه وإلى هذا ذهب الجنيد رحمه الله وهو عندي كما قال اللفظ لنا.
وسئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به فيجد حلاوة فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بدّ من الطبع وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى وينكره بقلبه ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه ويدعو الله تعالى أن ينسيه ذكر ذلك ويشغله بغيره من ذكره وطاعته، وقال: فإن هو غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار والحزن فإنه لا يضره، وهذا عندي هكذا لأن التوبة لا تصحّ مع بقاء الشهوة، ويكون العبد مراداً بالمجاهدة، وهذا حال المريدين ومحو الشهوات من القلب بدوام التولي وصف العارفين وربما تعلق بالذنب ذنوب كثيرة هي أعظم منه مثل الإصرار عليه والاغتباط به وتسويف التوبة بعده ووجد حلاوة الظفر بمثاله أو وجد الحزن والكراهة على فوته والسرور بعمله أو حمل غيره عليه إن كان ذنباً بين اثنين أو إنفاق مال الله سبحانه وتعالى فيه فهو كفر النعمة به، وقد قيل: من أنفق درهماً في حرام فهو مسرف ومن ذلك أن يستصغر الذنب ويحتقره فيكون أعظم من اجتراحه أو يتهاون بستر الله تعالى عليه ويستخف بحلم الله تعالى عنه، فيكون ذلك من الإغترار والأمن أو يجهل نعمة الله تعالى عليه في ستره وإظهار ضده كما قال في الدعاء المأثور الذي يمدح الله سبحانه وتعالى به: يا من أظهر الجميل وستر على القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويقال كلّ عاصٍ تحت كنف الرحمن فإذا رفع يديه عنه انهتك ستره
ومن ذلك المجاهرة بالذنب والصول به والتظاهر وهذا من الطغيان، وفي الخبر: كل الناس معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على الذنب، قد ستره الله تعالى عليه فيصبح فيكشف ستر الله تعالى ويتحدث بذنبه وربما سن العاصي بالذنب سنّة أتبع عليها فتبقى سيئات ذنبه عليه ما دام يعمل به وقد قيل: طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه ولم يؤاخذ بها بعده وطوبى لمن لم يعدد ذنبه غيره، قال بعضهم: لا تذهب فإن كان لا بدّ فلا تحمل غيرك على الذنب فتكسب ذنبين، وقد جعل الله تعالى هذا المعنى وصفاً من أوصاف المنافقين في قوله تعالى: (اَلْمُنَافِقُونَ والْمُنافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنع بَعْضٍ يأْمُروُن بِالْمُنْكرِ وَيَنْهَوْن عَنِ الْمَعْرُوفِ) التوبة67 فمن حمل أخاه على ذنب معه فقد أمر بالمنكر ونهى عن المعروف، وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصيته ثم يهونها عليه وقد يعيش العبد أربعين سنة ثم يموت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة يعاقب عليه في قبره إذا كان قد سنّها سنّاً وأتبع عليها إلى أن تندرس أو يموت من كان يعمل بها ثم تسقط عنه ويستريح منها، ويقال: أعظم الذنوب من ظلم من لا يعرفه ولم يره من المتقدمين مثل أن يتكلم فيمن سلف من أهل الدين وأئمة المتقين، فهذه المعاني كلها تدخل على الذنب الواحد وهي أعظم منه ومن ذلك قوله تعالى: (وَنَكْتُبُ ما قَدَّموا وآثارَهُمْ) يس: 12 قيل: سننهم التي عمل بها بعدهم، وفي الخبر: من سنّ سنّة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحتملها الناس فيذهبون بها في الآفاق، وقال بعض أهل الأدب: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق الخلق معها، وفي الخبر الإسرائيلي: إن عالماً كان يضلّ الناس بالبدع ثم أدركته توبة فرجع إلى الله تعالى وعمل في الإصلاح دهراً فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك بالغاً ما بلغ ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار، فأما استحلال المعصية أو إحلالها للغير فليس من هذه الأبواب في شيء إنما ذلك خروج عن الملة وتبديل للشريعة وهو الكفر بالله تعالى كما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه وقد سمّى الله تعالى عملة السوء جهلة فقال تعالى: (أنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجهَالةٍ) الأنعام: 54، وقال تعالى: (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) النمل: 55 وقال: (بل أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون) الأعراف: 81، ويقال: إن العرش يهتز ويغضب الرب تعالى لثلاثة أعمال: لقتل النفس بغير نفس، وإتيان الذكر الذكر، وركوب الأنثى الأنثى، وفي خبر: لو اغتسل اللوطي بالبحار لم يطهّره إلا التوبة ولو لم يكن في يسير المعصية من الشؤم إلا حرمان الطاعة وفقد حلاوة الخدمة ومقت المولى لكان هذا من أعظم العقوبات، كما قال وهيب بن الورد وقد سئل: هل يجد العاصي حلاوة الطاعة قال: لا ولا من هم بمعصية، ولذلك سمّى الله تعالى يحيى سيداً لأنه لم يهمّ بمعصية فصار علامة السيد بقدر سؤدد من لا يهمّ بالمعاصي فصار من لا يهمّ بالمعاصي سيداً، وفي خبر من لبس ثوب شهرة وفي بعضها: من نظر إلى عطفيه فاختال أعرض الله تعالى عنه وإن كان عنده حبيباً كيف وفي المخالفة وجود البعد والوحشة والانقطاع من المعاملة.
وروينا في خبر: إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدت عورته قال: فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه ونوديا من فوق العرش: اهبطا من جواري فإنه لا يجاورني من عصاني، فالتفت آدم إلى حوّاء باكياً وقال: هذا أول شؤم المعصية أخرجنا من جوار الحبيب، وروينا أن سليمان نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما عوقب على خطيئته من أجل التمثال الذي عبد في داره أربعين يوماً وقيل: إن المرأة سألته أن يكون الحكم لأبيها على خصمه فقال: نعم ولم يفعل وقيل: بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه لمكانها فسلب ملكه أربعين يوماً فهرب تائهاً على وجهه وكان يسأل بكفه فلا يطعم فإذا قال: أطعموني فإني سليمان بن داود شج وضرب، ولقد بلغني أنه استطعم من بيت فطرد وبزقت امرأة في وجهه، وفي رواية قال: فأخرجت إليه عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه إلى أن خرج له الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأربعين وهي أيام العقوبة قال: فجاءت الطير فعكفت عليه وجاءت الجنّ والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله، فلما عرفه الصيادون عقروا بين يديه واعتذروا إليه مما كانوا طردوه وشجوه فقال: لا ألومكم فيما صنعتم قبل ولا أحمدكم فيما تصنعون الآن، هذا أمر من السماء فلا بدّ منه ولقد بلغني أنه كان في مسيره والريح تحمله في جنوده إذ نظر إلى قميصه نظرة وكان عليه قميص جديد فكأنه أعجبه فوضعته الريح بالأرض فقال لها لم فعلت ولم آمرك قال: إنما نطيعك إذا أطعت الله تعالى.
وقد قال بعض العلماء في معنى هذا: من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله تعالى أخاف الله تعالى من كل شيء، فكذلك أيضاً: من أطاع الله تعالى سخّر له كل شيء ومن عصاه سخّره لكل شيء أو سلط عليه كل شيء ولو لم يكن في الإصرار على المعصية من الشؤم إلا أن كلّ ما يصيب العبد يكون له عقوبة إن كان سعة عوقب بذلك ولم يأمن بها الاستدراج وإن كان ضيقاً كان عقوبة له، وفي الخبر أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد قيل: الرزق من الحرام من قلة التوفيق للأعمال الصالحة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه ولو لم يكن من بركة التوبة والعلم والاستقامة على الطاعة إلا أن كل ما يصيب العبد فهو خير له إن: كان سعة فهو رفق من الله تعالى به عليه ولطف له منه وإن كان ضيقاً فهو اختبار من الله تعالى وخيره للعبد ويجد حلاوة ذلك ولذته لأنه في سبيله وقد أصابه وهو مقيم على طاعته ولو لم يكن من شؤم الناس ووجد النقص لمخالطتهم إلا أن المعصية معهم أشد وهي بهم أعظم لتعلق المظالم في أمر الدنيا وشأن الدين وكل من قلّت معارفه قلّت معهم خطاياه، وقال بعض السلف: ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاً في المال إنما اللعنة أن لا يخرج من ذنب إلا وقع في مثله أو شّر منه وذلك أن اللعنة هي الطرد والبعد فإذا طرد من الطاعة فلم تيسر له بعد عن القربات فلم يوفق لها فقد لعن.
وقد قيل في معنى الخبر الذي رويناه آنفاً: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه قيل: إن يحرم الحلال ولا يوفق له بوقوعه في المعصية وقيل: يحرم مجالسة العلماء ولا ينشرح قلبه لصحبة أهل الخير وقيل: يمقته الصالحون وأهل العلم بالله تعالى فيعرضون عنه وقيل: يحرم العلم الذي لا صلاح للعمل إلا به لأجل إقامته على الجهل، ولا تنكشف له الشبهات بإقامته على الشهوات بل تلتبس عليه الأمور فيتحير فيها بغير عصمة من الله تعالى ولا يوفق للأصوب والأفضل، وقد كان الفضيل يقول: ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك أورثتك ذلك ويقال: نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات والمنع من تلاوته وضيق الصدر بقراءته والاشتغال عنه بضده عقوبة الإصرار، وقال بعض صوفية أهل الشام: نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشقي فأخذ بيدي فأستحييت منه فقلت: يا أبا عبد الله سبحان الله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للنار فغمز يدي وقال: لتجدّن عقوبته بعد حين قال: فعوقبت بعد ثلاثين سنة، وقال بعضهم: إني لأعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري، وقال آخر: أعرف العقوبة حتى في نار بيتي.
وحدثونا عن منصور الفقيه قال: رأيت أبا عبد الله السكري في النوم فقلت: ما فعل الله بك قال: أوقفني بين يديه في العرق حتى سقط لحم خدي قلت: ولم ذاك قال: نظرت إلى غلام مقبلاً ومدبراً والعقوبة موضوعها الشدة والمشقة، فعقوبة كل عبد من حيث يشتد عليه، فأهل الدنيا يعاقبون بحرمان رزق الدنيا من تعذر الإكساب وإتلاف الأموال وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق الآخرة من قلة التوفيق للأعمال الصالحات وتعذر فتوح العلوم الصادقة ذلك تقدير العزيز العليم، وكان أبو سليمان الداراني يقول: الاحتلام عقوبة: وقال: لا يفوت أحداً صلاة في جماعة إلا بذنب يحدثه فدقائق العقوبات على قدر ترافع الدرجات، وقد جاء في الأخبار ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم، وفي الخبر يقول الله عزّ وجلّ: إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي فهذه عقوبة أهل المعاملات ولو ظهر تغيّر القلب عند المعصية على وجه العاصي لا سودّ وجهه ولكن الله تعالى سلم بحلمه وستره فغطى ذلك في القلب مع تأثيره فيه وحجابه لصاحبه وقسوته عن الذكر وعن طلب الخير والبر والمسارعة إلى الخير وهو من أكير العقوبات ويقال: إن العبد إذا عصى أظلم قلبه ظلمة يثور على القلب منها دخان يشهده الإيمان فهو مكان حزن العبد الذي تسوءه سيئته ويكون ذلك الدخان حجاباً له عن العلم والبيان كما تحجب السحابة للشمس فلا ترى ويكون غلفاً يجده في نفسه للخلق فإذا تاب العبد وأصلح إنكشف الحجاب فيظهر الإيمان فيأمر بالعلم كما تبرز الشمس من تحت الحجاب.
ومن هذا قوله تعالى: (كَلاّ بَلْ رَانَ على قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) المطففين: 14 قيل: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب ويصير الإيمان تحت الحجاب فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً وعندها ينكس أعلاه أسفله إذا استكمل سواده، فحينئذ مرد على النفاق فأملس فيه واطمأن به وثبت إلى أن ينظر الله تعالى إليه فيعطف بفضله عليه، وقد كان الحسن رضي الله عنه يقول: إن بين العبد وبين ربه عزّ وجلّ حداً من المعاصي معلوماً إذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه بعدها للخير، وفي حديث ابن عمر: الطابع معلق بقائمة العرش فإذا انتهكت الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله تعالى الطابع فطبع على القلوب بما فيها، وفي حديث مجاهد: القلب مثل الكف المفتوحة فكلما أذنب ذنباً انقبضت أصبع حتى تنقبض الأصابع كلها فتشد على القلب فذلك هو القفل، ويقال لكلّ ذنب نبات ينبت على القلب فإذا كثرت الذنوب قام النبات حول القلب مثل الكمّ للثمرة فانضمّ على القلب فذلك هو الغلاف، ويقال: إنه الكنان أحد الأكنة التي ذكر الله تعالى أن القلب لا يسمع معها ولا يفقه، وقد حدثني بعض هذه الطائفة عن أبي عمرو بن علوان في قصة تطول قال فيها: فكنت قائماً أصلّي ذات يوم فخامر قلبي هواء طاولته بفكري حتى تولد منه شهوة الرجل قال: فوقعت إلى الأرض واسودّ جسدي كله فاستترت في البيت ثلاثة أيام فلم أخرج وقد كنت أعالج غسله في الحمام بالصابون والألوان الغاسلة فلا يزداد إلا سواداً قال ثم انكشف عني بعد ثلاث فرجعت إلى لوني البياض قال: فلقيت أبا القاسم الجنيد رحمه الله وكان وجه إلي فأشخصني من الرقة فلما أتيته قال لي: أما أستحيت من الله تعالى كنت قائماً بين يديه فسامرت نفسك شهوة حتى استولت عليك برقة فأخرجتك من بين يدي الله تعالى لولا أني دعوت الله عزّ وجلّ لك وتبت إليه عنك للقيت الله تعالى بذلك اللون قال فعجبت كيف علم بذلك، وهو ببغداد وأنا بالرقة ولم يطلع عليه إلا الله عزّ وجلّ، فذكرت هذه الحكايات لبعض العلماء فقال: كان هذا رفقاً من الله تعالى به وخيرة له إذ لم يسودّ قلبه وظهر السواد على جسده ولو بطن في قلبه لأهلك ثم قال: ما من ذنب يرتكبه العبد يصرّ عليه إلا اسودّ القلب منه مثل سواد الجسم الذي ذكره لا يجلوه إلا التوبة ولكن ليس كل عبد يصنع له صنع ابن علوان ولا يجد من يلطف له به مثل أبي القاسم الجنيد رحمه الله ولكل ّ ذنب عقوبة إلا أن يعفو الله والعقوبة ليست على قدر الذنب ولا من حيث يعلم العبد لكنها على تقدير المشيئة وعن سابق علم الربوبية فربما كانت في قلب وهي من أمراض القلوب وربما كانت في الجسد وقد تكون في الأموال والأهل وتكون في سقوط الجاه والمنزلة من عيون علماء الإسلام والمؤمنين وقد تكون مؤجله في الآخرة وهذه أعظم العقوبات وهي لأهل الكبائر من الموبقات الذين ماتوا عن غير توبة ولأهل الإصرار والعزة والاستكبار لأنها إذا كانت في الدنيا كانت يسيرة على قدر الدنيا وإذا تأخرت كانت عظيمة على قدر الآخرة.
وفي الخبر: إذا أراد الله تعالى بعبد خيراً عجّل له عقوبة ذنبه وإذا أراد به شراً أخره حتى يوافي به الآخرة، وأعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا والهم بالحرص عليها من العقوبات والفرح والسرور بما نال من الدنيا مع ما لا يبالي ما خرج من دينه من العقوبات، وقد يكون دوام العوافي واتساع الغنى من عقوبات الذنوب إذا كانا سببين إلى المعاصي، وقد تكون عقوبة الذنب ذنباً مثله أو أعظم منه كما يكون مثوبة الطاعة طاعة مثلها أو أفضل منها، وفي أحد الوجوه من معنى قوله تعالى: (وَعَصَيْتُمْ مِن بعْدِ ما أراكُمْ ما تُحِبُّونَ) آل عمران: 152، قال: الغنى والعافية كما يكون الفقر والسقم برحمة من الله تعالى إذا كانا سبباً للعصمة وهما أمّهات المعاصي إذا كانا سببين لها ومطرقين إليها، واعلم أن الحلم لا يرفع العقوبة ولكن يؤخرها، ومن شأن الحليم أن لا يعجل بالعقوبة وقد يعاقب بعد حين.
وروينا في معنى قوله تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عليْهِمْ أبْوابَ كُلِّ شيءٍ) الأنعام: 44، أي الرخص والرغد حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة قيل بعد ستين سنة، وفي الخبر: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهمّ بطلب المعيشة، وفي لفظ آخر: لا يكفرّها إلا الهموم والأحزان والإهتمام بالمباحات من حاجات الدنيا للفقراء كفارات وهو على ما يفوت من قربات الآخرة للمؤمنين درجات وهو على محب الدنيا والجمع منها والحرص عقوبات، وقال بعض السلف: كفى به ذنباً لا يستغفر منه حبّ الدنيا وقال آخر: لو لم يكن للعبد من الذنوب إلا أنه يقيم بمصائب الدنيا بما لا يقيم بما لا يفوته فيها من نصيب الآخرة والتزودّ لها.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من الأعمال ما يكفّرها أدخل الله عزّ وجلّ عليه الغموم والهموم فتكون كفّارة لذنوبه ويقال: إن الهمّ الذي يعرض للقلب في وقت لا يعرف العبد سبب ذلك فهو كفّارات الهم بالخطايا ويقال: هو حزن العقل عند تذكره الوقوف والمحاسبة لأجل جنايات الجسد فيلزم العقل ذلك الهمّ فيظهر على العبد منه كأنه لا يعرف سبب غمه، ومن أخبار يعقوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: لولا ما سبق لك في علمي من عنايتي بك لجعلت نفسي عندك أبخل الباخلين لكثرة تردادك إليّ بطول سؤالك لي وتأخيري إجابتك ولكن من عنايتي بك أن جعلت نفسي في قلبك إني أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وقد سبق لك عندي منزلة لم تكن تنالها بشيء من علمك إلا بحزنك على يوسف فأردت أن أبلغك تلك المنزلة، وكذلك ما روينا أن جبريل عليه السلام لما دخل على يوسف عليه السلام في السجن قال له: كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: قد حزن عليك حزن مائة ثكلى، قال: فماذا له عند الله تعالى؟ قال: أجر مائة شهيد، وفي خبر رويناه عن السلف: ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً فيقول الله عزّ وجلّ للأرض والسماء كفّا عن عبدي وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ولو خلقتماه لرحمتماه لعله يتوب إليّ فأغفر له لعله يستبدل صالحاً فأبدله حسنات فذلك معنى قوله تعالى (إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَواتِ والأرْضَ أن تَزُولاً) فاطر: 41 أي من معاصي العباد: (وَلَئِنْ زالتا إنْ أمْسَكَهُما مِنْ أحِدٍ مَنْ بَعْدِهٍ إنَّهُ كانَ حليماً) فاطر: 41 أي عن معاصيهم غفوراً لمساوئهم وقيل في تفسير ذلك: إن الله عزّ وجلّ إذا نظر إلى معاصي العباد غضب فترجف الأرض وتضطرب السماء فتنزل ملائكة السماء فتمسك أطراف الأرضين وتصعد ملائكة الأرضين فتمسك على أطراف السموات، ولا يزالون يقرؤون: (قُلْ هَوَ اللهُ أحدٌ) الإخلاص: 1، حتى يسكن غضبه سبحانه وتعالى فذلك قوله تعالى: (إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمواتِ) فاطر: 41 الآية.
وقال بعض العلماء: إذا ضرب الناقوس في الأرض ودعى بدعوة الجاهلية اشتد غضب الرب سبحانه وتعالى فإذا نظر إلى صبيان المكاتب ورأى عمار المساجد وقيل: إذا نظر إلى المتحابين في الله أو المتزاورين له وسمع أصوات المؤذنين حلم وغفر فذلك قوله تعالى: (إِنَّهُ كانَ حليماً غَفُوراً) فاطر: 41 فإذا أتبع العبد الذنب بالذنب ولم يجعل بين الذنبين توبة خيف عليه الهلكة لأن هذه حال المصرّ ولأنه قد شرد عن مولاه بترك رجوعه إليه ودوام مقامه مع النفس على هواه وهذا مقام المقت في البعد وأفضل ما يعمله العبد قطع شهوات النفس أحلى ما يكون عنده الهوى إذ ليس لشهواتها آخر ينتظر كما ليس لبدايتها أوّل يرتسم فإن لم يقطع ذلك لم يكن له نهاية فإن شغل بما يستأنف من مزيد الطاعة ووجد حلاوة العبادة وإلا أخذ نفسه بالصبر والمجاهدة فهذا طريق الصادقين من المريدين.
وقيل في قوله تعالى: (اسْتَعينوا بالله واصْبِروا) الأعراف: 128 أي استعينوا به على الطاعة واصبروا على المجاهدة في المعصية، وقال علي كرمّ الله وجهه: أعمال البرّ كلّها إلى جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتفلة إلى جنب البحر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جنب الجهاد في سبيل الله تعالى كتفلة في جنب بحر والجهاد في سبيل الله تعالى إلى مجاهدة النفس عن هواها في اجتناب النهي كتفلة في جنب بحر لجيّ، وعلى هذا معنى الخبر الوارد رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة النفس، وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر تصديق الصدق وأفضل منازل الطاعة صبر على معصية ثم الصبر على الطاعة، وقد روينا في الإسرائيليات: إن رجلاً تزوّج امرأة في بلدة وأرسل عبده يحملها إليه فراودته نفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم بالله قال: فنبأه الله تعالى فكان نبياً في بني إسرائيل.
وفي بعض قصص موسى عليه السلام: إنه قال للخصر عليه السلام: بأيّ شيء أطلعك الله تعالى على علم الغيب؟ فقال: بترك المعاصي لأجل الله تعالى، فالجزاء من الله تعالى يجعله غاية العطاء لا على قدر العمل لكن إذا عمل له عبد شيئاً لأجله أعطاه أجره بغير حساب ثم إنه لا يتخذ التائب عادة من ذنب فيتعذر بها توبته فإن العادة جند من جنود الله تعالى لولاها لكان الناس كلهم تائبين ولولا الابتلاء لكان التائبون مستقيمين ثم إن يعمل في قطع معتاد إن كان ثم ليصبر على مجاهدة النفس في هوى إن بلي به، فهذه الخصال من أفضل أعمال المريدين وأزكاها ومعها تلهم النفس المطمئنة رشدها وتقواها وبها تخرج من وصف الأمّارة بالسوء إلى وصف المطمئنة إلى أخلاق الإيمان وهذا أحد المعاني في الخبر الذي روى: أفضل الأعمال ما أكرهتم عليه النفوس، لأن النفس تكره خلاف الهوى، والهوى هو ضد الحق والله تعالى يحب الحق فصار جبار النفس على خلاف الهوى وعلى وفاق الحق لأن محبة الحق من أفضل الأعمال كما قال تعالى: (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) الأعراف: 8 الآية، واستثنى من أهل الخسر الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا أوّل اليقين، وحدثت عن بعض أهل الاعتبار: إنه كان يمشي في الوحل فكان يتقي ويشمر ثيابه عن ساقيه ويمشي في جوانب الطريق إلى أن زلقت رجله في الوحل فأدخل رجليه في وسط الوحل وجعل يمشي في المحجة قال: فبكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب منها وذنبين فعندها يخوض الذنوب خوضاً وعلى العبد أن يتوب من الغفلة التي هي كائنة فإذا عرف هذا لم تنقطع أبداً توبته وقد جعل الله تعالى أهل الغفلة في الدنيا هم أهل الخسران في العقبى، فقال عز من قائل: (أولئكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) الأعراف: 179، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ولكن غفلة دون غفلة وخسران دون خسران ولا تستحقرن الغفلة فإنها أوّل المعاصي وهي عند الموقنين أصل الكبائر وقد جعل علي كرم الله وجهه الغفلة إحدى مقامات الكفر وقرنها بالعمى والشك وأمال صاحبها عن الرشد ووصفها بالحسرة فقال في الحديث الذي يروى من طريق أهل البيت: فقام عمار بن ياسر فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ما بني؟ فقال: على أربع دعائم: على الجفاد، والعمى، والغفلة، والشك، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء، ومن عمى نسي الذكر ومن غفل حاد عن الرشد وغرّته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، ومن شكّ تاه في الضلالة.
وقال بعض العلماء: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله تعالى سبع مرات لم يبتل بها، وقال آخر: من تاب عن ذنب واستقام سبع سنين لم يرجع إليه أبداً، وقال بعض العلماء: كفارة الذنب المعتاد أن تقدر عليه عدد ما أتيته ثم لا تقع فيه فيكون كل ترك كفارة لفعل وهذا حال الأقوياء من التوّابين وليس هو طريق الضعفاء من المريدين بل حال الضعفاء والهرب والبعد، ومن حدث نفسه بمعصية في عدمها لم يملك نفسه عند وجودها فليعمل المريد في قطع وساوس النفس بالخطايا وإلا وقع فيها لأن الخواطر تقوى فتكون وسوسة، فإذا كثرت الوساوس صارت طرقاًِ للعدوّ بالتزيين والتسويل فأضرّ شيء على التائب تمكينه خاطر السوء من قلبه بالإصغاء إليه فإنه يدب في هلكته وكل سبب يدعو إلى معصية أو يذكر بمعصية فهو معصية وكل سبب يؤول إلى ذنب ويؤدي إليه فهو ذنب وإن كان مباحاً وقطعه طاعة وهذا من دقائق الأعمال وكان يقال: من أتى عليه أربعون وهو العمر وكان مقيماً على الذنب لم يكد يتب منه إلا القليل من المتداركين، وقد روي في الخبر: المؤمن كل مفتن تواب وإن للمؤمن ذنباً قد اعتاده الفيئة بعد الفيئة يعني حيناً بعد حين.
وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين المستغفرون، وفي الخبر الآخر: المؤمن واه راقع فخيرهم من مات على رقعه أي واه بالذنوب راقع بالتوبة والاستغفار، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بترك متابعة الذنوب وترادف السيئة بالحسنة في قوله تعالى: (وَيَدْرَؤُون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) الرعد: 22، وقد جعل هذا من وصف العاملين الذين صبروا فقال تعالى: (أُولئكَ يُؤْتَوْنَ أجْرَهْمُ مرَّتينِ بِما صبرُوا وَيَدْرَؤُون بِالْحسنةِ السَّيّئةَ) القصص: 54 فجعل تعالى لهم صبرين عن الذنب وعلى التوبة فآتاهم به أجرين وقد اشترط الله تعالى على التائبين من المؤمنين ثلاث شرائط وشرط على التائبين من المنافقين أربعة لأنهم اعتلوا بالخلق في الأعمال فأشركوهم بالخالق في الإخلاص فزاد عليهم الشرط تشديد الشدة دخولهم في المقت واعتل غيرهم بوصفه فخفف عنهم شرطين فقال عزّ وجلّ: (إلاّ الَّذين تَابُوا وأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا) البقرة: 160 قوله تعالى تابوا أي رجعوا إلى الحق من أهوائهم، وأصلحوا يعني ما أفسدوا بنفوسهم، وبينوا فيها وجهان، أحدهما بينوا ما كانوا كتموا من الحق وأخفوا من حقيقة العلم وهذا لمن عصى بكتم العلم ولبس الحق بالباطل وقيل: بينوا توبتهم حتى تبيّن ذلك فيهم فظهرت أحكام التوبة عليهم، وقال في الشرطين الآخرين: (إنَّ الْمُنافِقينَ في الْدَّرْكِ الأسْفِل مِنَ الْنَّارِ وَلَنْ تجِدَ لَهُمْ نَصيراً) النساء: 145 (إلاَّ الَّذين تَابُوا وَأصْلَحُوا واعْتصمُوا باللهِ وأخْلصُوا دَيْنَهُم للهِ) النساء: 146، لأنهم كانوا يعتصمون بالناس وبالأموال وكانوا يراؤون بالأعمال فلذلك اشترط عليهم الاعتصام بالله والإخلاص لله عزّ وجلّ فينبغي أن تكون توبة كل عبد عن ضد معاصيه قليلاً بقليل أو كثيراً بكثير ويكون التائب على ضد ما كان أفسد ليكون كما قال الله تعالى: (إنا لا نُضيعُ أجْرَ الْمُصْلِحينَ) الأعراف: 170، ولا يكون العبد تائباً حتى يكون مصلحاً ولا يكون مصلحاً حتى يعمل الصالحات ثم يدخل في الصالحين.
وقد قال الله تعالى: (وَهُو يَتَولَىّ الصَّالِحينَ) الأعراف: 196، وهذا وصف للتواب وهو المتحقق بالتوبة والحبيب لله تعالى كما قال تعالى: (إنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابينَ) البقرة: 222 أي يتولى الراجعين إليه من أهوائهم المتطهرين له من المكاره، وكما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التائب حبيب الله، وسئل أبو محمد سهل: متى يكون العبد التائب حبيب الله تعالى؟ فقال: حتى يكون كما قال الله تعالى: (التَّائِبُون العابِدُونَ) التوبة: 112 الآية، ثم قال الحبيب: لا يدخل في شيء لا يحبه الحبيب، وقال: لا تصح التوبة حتى يتوب من الحسنات، وقد قال غيره من العارفين: العامة يتوبون من سيئاتهم والصوفية يتوبون من حسناتهم يعني من تقصيرهم في أدائها العظيم ما يشهدون من حق الملك العزيز سبحانه وتعالى المقابل بها ومن نظرهم إليها أو نظرهم إلى نفوسهم بها وهي منة الله تعالي إليهم واصلة، وكان سهل يقول: التوبة من أفضل الأعمال لأن الأعمال لا تصحّ إلا بها ولا تصحّ التوبة إلا بترك كثير من الحلال مخافة أن يخرجهم إلى غيره، والاستغفار قوت التّوابين ومفزع الخطائين، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (اسْتَغْفِروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبوا إليهِ) هود: 52، وقال تعالى: (أفلا يَتُوبُون إلى الله ويستْغَفِرُونهُ) المائدة: 74 فابتدئ التوبة بالاستغفار وعقب الاستغفار بالتوبة، فالاستغفار مع الذنب سؤال الستر من الله تعالى ومغفرة الله تعالى لعبده في حال ذنبه ستره عليه وحلمه عنه ويقال: ما من ذنب ستره الله تعالى على عبده في الدنيا إلا غفره له في الآخرة، إن الله تعالى أكرم من أن يكشف ذنباً كان قد ستره وما من ذنب كشفه الله في الدنيا إلا جعل ذلك عقوبة عبده في الآخرة فالله أكرم من أن يثنى عقوبته على عبده.
وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك وقد أسنداه من طريق الاستغفار بعد التوبة وهو سؤال العبد مولاه العفو عن المؤاخذة ومغفرة الله تعالى لعبده بعد التوبة تكفيره لسيئاته وتجاوزه عنها بالعفو الكريم وهو تبديل السيئات حسنات كما جاء في الخبر أن تفسير قول العبد: يا كريم العفو قال: هو إن عفا برحمته عن السيئات ثم بدلها بكرمه حسنات وقد أحكم الله تعالى ذلك بقوله: (فَاسْتَقيمُوا إلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ) فصلت: 6 بعد قوله تعالى: (إنَّ الَّذينَ قالوا رَبُّنا الله ثم استقاموا تَتنزَّلُ عَليْهِمُ الْملائكِةُ ألاّ تخافُوا ولا تحْزنُوا) فصلت: 30، أي وحّدوا الله تعالى ثم استقاموا على التوحيد فلم يشركوا وقيل: استقاموا على السنة فلم يحدثوا وقيل: استقاموا على التوبة فلم يروغوا معها أن لا تخافوا عقاب الذنوب فقد كفرها عنكم بالتوحيد ولا تحزنوا على ما فاتكم من الأعمال فقد تداركها الله تعالى لكم بالتوبة وبلغكم منازل المحسنين بالاستقامة، ثم قال تعالى: (وَأبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي كُنْتُمْ تُوعدُون) فصلت: 30 في السابق (نَحْنُ أوْلِياؤُكُمْ) فصلت: 31 أي نليكم ونقرب منكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالتثبيت لكم على الإيمان ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي أجسامكم من النعيم المقيم ولكم فيها ما تدّعون أي ما تمنون بقلوبكم من النظر إلى الملك الرحيم، وفي الخبر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مصرّ عليه كالمستهزئ بآيات الله تعالى: وكان بعضهم يقول: أستغفر الله من قولي أستغفر الله باللسان عن غير توبة وندم بالقلب، وفي بخبر: الاستغفار باللسان من غير توبة وندم بالقلب توبة الكذابين، وكانت رابعة تقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار فكم من توبة تحتاج إلى توبة في تصحيحها والإخلاص من النظر إليها والسكون والإدلال بها، فمن عقب السيئات بحسنات وخلط الصالحات بالطالحات طمع له في النجاة ورجا له الاستقامة قبل الوفاة، قال الله تعالى: (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وآخرَ سَيِّئاً عسى الله أنْ يَتُوب عَلَيْهِمْ) التوبة: 102 أي يعطف عليهم وينظر إليهم وقيل: خلطوا علملاً صالحاً هو الاعتراف بالذنوب والتوبة المستأنفة وآخر سيّئاً ما سلف من الغفلة والجهالة، وقد كان ابن عباس يقول: غفور لمن تاب رحيم حيث رخص في التوبة، وقد قال الله تعالى (وإنّي لَغفَّارُ لِمَنْ تابَ) طه: 82 أي من الشرك وآمن بالتوحيد وعمل صالحاً؛ أدّى الفرئض واجتنب المحارم ثم اهتدى كان على السنّة وقيل: استقام على التوبة فهذه صفات المؤمنين فلم يرّد الله تعالى المخلصين إلى ما ردّ إليه المنافقين وهو التوبة وكذلك ردّ إليها المشركين إذ لا طريق للكل إلا منها ولا وصول إلى المحبة والرضا إلا بها.
وقال تعالى في وصف المنافقين: (وآخرون مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إمّا يُعَذِّبُهُمْ) التوبة: 106 أي مع الإصرار وإمّا يتوب عليهم أي بالاستغفار وأحكم ذلك وفصله بما شرط له، كما قال في شأن الكافرين: (فإن تابُوا وأقامُوا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكاة فخلُّوا سبِيلهُمْ) التوبة: 5 وقد قرن الله تعالى الاستغفار للعبادة ببقاء الرسول لله في الأمة ورفع العذاب عنهم بوجوده فضلاًمنه ونعمة، وقال تعالى: (وما كان الله لِيُعَذِّبَهُمْ وأنت فيهم وما كان الله مُعَذِّبَهُمْ وهمْ يَستغفِرُون) الأنفال: 33، وكان بعض السلف يقول: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقي الآخر، فإن ذهب الآخر هلكنا يعني الذي ذهب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي بقي الاستغفار، وسئل سهل رحمه الله عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب فقال: أوّل الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة فالاستجابة أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مولاه وترك الخلق، ثم يستغفر من تقصيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر، فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مأواه ثم ينقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السر وهو الخلّة، ولا يستقر هذا في قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده والتفويض مراده والتوكل صاحبه، ثم ينظر الله تعالى إليه فيرفعه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش وكان يقول العبد لا بدّ له من مولاه على كل حال، وأحسن حاله أن يرجع إليه في كل شيء إذا عصي يقول: يا رب استر علي فإذا فرغ من المعصية قال: يا ربّ تبْ عليّ فإذا تاب قال يا ربّ ارزقني العصمة فإذا عمل قال: يا ربّ تقبّل مني، ومن أحسن ما يتعقب الذنب من الأعمال بعد التوبة وحلّ الإصرار مما يرجى به كفارة الخطيئة ثمانية أعمال: أربعة من أعمال الجوارح وأربعة من أعمال القلوب، فأعمال الجوارح أن يصلي العبد ركعتين ثم يستغفر سبعين مرة.
ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم يتصدق بصدقة ويصوم يوماً، وأعمال القلوب هي اعتقاد التوبة منه وحبّ الإقلاع عنه وخوف العقاب عليه ورجاء المغفرة له، ثم يحتسب على الله تعالى بحسن ظنه وصدق يقينه كفّارة ذنبه، فهذه الأعمال قد وردت بها الآثار، إنها المكفرة للزلل والعثار، وقد يشترط في بعضها فيتوضأ ويسبغ الوضوء ويدخل المسجد فيصلّي ركعتين وفي بعض الأخبار فيصلّي أربع ركعات، قال: ويقال إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه وإن لم يستغفر كتبها، ويقال صدقة الليل تكفّر ذنوب النهار وصدقة السرّ تكفّر ذنوب الليل، وفي بعض الأخبار إذا علمت سيئة فأتبعها حينة تكفرها السرّ بالسرّ والعلانية بالعلانية، وفي أخبار متفرقة جمعناها: ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلقوا ويقول الآخر: ويا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا فيقول الآخر: ياليتهم إذ علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، وفي بعضها: تجالسوا فتذاكروا ما علموا فيقول الآخر: ويا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا مما عملوا، فأول ما يجب لله عزّ وجلّ على عبده أن لا يعصيه بنعمه لئلا تكون معصيته كفراناً لنعمته وجوارح العبد وما له من نعم الله تعالى لأن قوام الإنسان بجوارحه وثبات جوارحه بالحركة ومنافع الحركة بالعافية، فإذا عصاه بالنعمة فقد بدلها كفراً، كما قال تعالى: (بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْراً) إبراهيم: 28 قيل: استعانوا بها على معاصيه ثم توعد على التبديل بالعقاب الشديد فقال: (ومَنْ يُبَدلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتّهُ فإنّ َ الله شديدُ الْعِقابِ) البقرة: 211، على تبديل النعمة بالمعصية معجلاً في الدنيا ويكون مؤجلاً في الآخرة.
وقد يكون العقاب في أسباب الدنيا، وقد يكون في حرمان أسباب الآخرة لأنها مآله ومثواه، وقد يكون فيهما معاً، وقد تكون نفس المعصية بالنعمة عقوبة والجهل بالنعمة وتضييع الشكر عليها واستصغارها والسكون إليها والتطاول والتفاخر والتكابر بها كل هذه الأسباب عقوبات ثم يفترض على العبد إذا عصاه الرجوع إلى مولاه وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه وهو موافقة الهوى بالخطيئة فتأخيره بالتوبة وإصراره على الذنب ذنبان مضافان إلى الخطيئة، فإذا تاب من ذنبه وأحكم التوبة منه اعتقد الاستقامة على الطاعة ودوام الافتقار إلى الله تعالى في العصمة ثم يتوب أبداً من الصغائر إلى الهمّ والتمني، ومن الخوف والطمع في المخلوق، وهي ذنوب الخصوص إلى الطرفة والنفس والسكون إلى شيء والراحة بشيء وهذه ذنوب المقربين حتى لا يبقى على العبد فيما يعلم مخالفة وحتى يشهد له العلم بالوفاء فتبقى حينئذ ذنوبه من مطالعة علم الله تعالى فيه لما أستأثر به عنه من علم غيبه يكاشفه به ومن معنى نفس العبودية وكون الخلقة عن تسليط الربوبية بوصفها وكبرها فيكون هذا الخوف مثوبة له لما فزع من علم نفسه إلى ما لا يمكن ذكره ولا يعرف نشره من ذنوب المقربين التي هي صالحات أصحاب اليمين لفقد مشاهدتها وللجهل بمعرفة مقاماتها عند العموم فيكون حال هذا المقرب الإشفاق من البعد في كل طرفة ونفس إلى وقت اللقاء والخوف من الإعراض والحجب في كل حركة وهم في هذه الدار إلى دار البقاء.
وقد روينا في خبر غريب: إن الله عزّ وجلّ أوحى إلى يعقوب عليه السلام أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف، قال: لا، قال: لقولك لإخوته إني أخاف أن يأكله الذئب لم خفت عليه الذئب ولم ترجني له ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له فهذا معنى قول يوسف للساقي: اذكرني عند ربك، قال الله تعالى: (فأنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكرَ رَبِّهِ فَلبِثَ في السِّجْنِ بَضْعَ سِنينَ) يوسف: 42، فهذا مما يعتب على الخصوص من خفي سكونهم ولمح نظرهم إلى ما سوى الله تعالى وإنما حرم بعض التابعين ذلك المزيد ولم يجدوا حلاوة التوبة لتهاونهم بحال الرعاية وتسامحهم بترك حسن القيام بشاهد المراقبة وذلك يكون من قلة أحكام أمر التوبة ولو قاموا بحكم التوبة من الذنب الواحد وأحكموا حال توّاب من الصادقين في التوبة لم يعدموا من الله تعالى المزيد لأنهم محسنون فهم في تجديد، قال الله تعالى: (سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ) البقرة: 58 فإذا رآك مستقيماً على التوبة عاملاً بالصالحات ولم تجدك على مزيد من مبرّات بوجد حلاوة أو حسن خليقة أو عروض زهد أو خاصية معروفة فارجع إلى باب المرقبة أو موقف الرعاية فتفقدهما وأحكم حالهما فمن قبلهما أتيت، وقال بعض العلماء: من تاب من تسعة وتسعين ذنباً ولم يتب من ذنب واحد لم يكن عندنا من التائبين ولا تغفلن عن التفقد وتجديد التوبة إدبار الصلوات فإنما دخل الخسران على العمال من حيث لا يعلمون من تركهم التفقد ومحاسبة النفس وبمسامحتها مما يعملون، واعلم أن حقيقة كل ذنب عشرة أعمال لا يكون العبد توّاباً يحبه الله تعالى ولا تكون توبته نصوحاً التي شرطها الله تعالى وفسرتها النبوّة إلا أن يحكم العبد عشر توبات من كل ذنب أولها ترك العود إلى فعل الذنب ثم يتوب من القول به ثم يتوب من الاجتماع مع سبب الذنب ثم التوبة من السعي في مثله ثم التوبة من النظر إليه ثم التوبة من الاستماع إلى القائلين به ثم التوبة من الهمة ثم التوبة من التقصير في حق التوبة ثم التوبة من أن لا يكون أراد وجه الله تعالى خالصاً بجميع ما تركه لأجله ثم التوبة من النظر إلى التوبة والسكون إليها والإدلال بها ثم يشهد بعد ذلك تقصيره عن القيام بحق الربوبية لعظيم ما يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالى وعظم كبريائه فتكون توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته ويكون استغفاره لما ضعف قلبه ونقص همّه عن معاينة مشاهدة لعلوّ مقامه ودوام فريدة وإعلامه ولا نهاية لتوبة العارف ولا لغاية وصفه لما هو عليه عاكف ولا وصف محتمل ذكر دقيق بلائه ولا يكبر عن التوبة نبي فمن دونه ولكل مقام توبة ولكل حال من مقام توبة ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة فهذا حال التائب المنيب الذي هو من الله تعالى مقرب وعنده حبيب وهذا مقام مفتن توّاب أي مختبر بالأشياء مبتلى بها توّاب إلى الله تعالى منها لينظر مولاه أينظر بقلبه إليه أو إليها أو يعتكف بهمته عليه أو عليها أو يطمئن إليه بوجودها أو إليها أو يطلب إياه هرباً منها أو إياها فعليه لكل مشاهدة لسواه ذنب وعليه في كل سكون إلى سواه عتب كما له في كل شهادة علم ومن كل إظهار في الكون حكم بذنوبه لا تحصى وتوباته إلى الله تعالى لا تستقصى، فهذه حقيقة التوبة النصوح وصاحبها مسلم وجهه لله تعالى محسن من نفسه مستريح ودينه عند الله تعالى مستقيم ومقامه وحاله من الله تعالى سليم.
وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله يحبّ كل مفتن توّاب، واعلم أن الذنوب على سبعة ضروب بعضها أعظم من بعض، كل ضرب منها مراتب في كل مرتبة من المذنبين طبقة منها معاصٍ يعتلّ بها العبد من معاني صفات الربوبية مثل الكبر والفخر والجبرية وحبّ الحمد والمدح ووصف العزّ والغنى، فهذه مهلكات وفيها من العموم طبقات ومعاصي تكون من معاني أخلاق الشياطين مثل: الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد، فهذا موبقة وفيها من أهل الدنيا طبقات ومعاصي تكون من ضد السنّة وهو ما خالفها إلى بدعة والأحداث المبتدعة وهي كبائر منها ما يذهب الإيمان وينبت النفاق، وست من كبائر البدع، وهي تنقل عن الملة: وهي القدرية والمرجئة الرافضية والإباضية والجهمية والشاطحون من المغالطين وهم الذين لا يقولون بخلق ولا رسم ولا حكم في تعدّي الحدود ومجاوزات العلم فهم زنادقة هذه الأمة ومعاصٍ متعلقة بالخلق من طريق المظالم في الدين والإلحاد بهم عن طريق المؤمنين، وهو ما أضلّ به عن الهدى وأزاغ به عن السنن وحرّفه من الكتاب وتأوّله من السنّة ثم أظهر ذلك ودعا إليه فقبل منه وأتبع عليه.
وقد قال بعض العلماء: لا توبة لهذه المعاصي كما قال بعضهم في القاتل: لا توبة له للأخبار بثبوت الوعيد وحقّ القول عليه، والضرب الخامس من المعاصي ما تعلّق بمظالم العباد في أمر الدنيا مثل ضرب الإنسان وشتم الأعراض وأخذ الأموال والكذب والبهتان، فهذه موبقات ولا بد فيها من القصاص للموافقة بين يدي الحاكم العادل والقطع منه بقضاء فاصل إلا أن يقع استحلال أو يستوهبها الله عزّ وجلّ من أربابها في المآل بكرمه ويعوض المظلومين عليها من جنابه بجوده، وقد جاء في الخبر: الدواوين ثلاثة: ديوان يغفر، وديوان لا يغفر، وديوان لا يترك، فأما الديوان الذي يغفر فذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى وأما الديوان الذي لا يغفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لا يترك فمظالم العباد أي لا يترك المطالبة به والمؤاخذه عليه، والضرب السادس من الذنوب ما كان بين العبد وبين مولاه من نفسه إلى نفسه متعلّق بالشهوات والجري في العادات وهذه أخفها وإلى العفو أقربها، وهذه على ضربين كبائر وصغائر، فالكبائر ما نصّ عليه بالوعيد وما وجبت فيه الحدود، والصغائر دون ذلك إلى نطرة وخطرة والتوبة النصوح تأتي على الجميع ذلك بعموم قوله تعالى: (فتاب عليكم وعفا عنكم) وبإخباره عزّ وجلّ عن حكمه إذ يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبظاهر قوله تعالى (إنَّ الَذين فَتَنُوا المُؤْمنينَ والْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا) البروج: 10، ومثله: (ثُمَّ إنَّ رَبَّك لِلَّذينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا) النحل: 110 إلى قوله: (إنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحيمٌ) النحل: 110 هكذا قراءة أهل الشام بنصب الفاء والتاء ولأن البغية من التوبة إذا كانت غفران الذنب والزحزحة عن النار ونحن لا نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائر بل نجعلهم في مشيئة الله ونجوز تجاوز الله تعالى عنهم في أصحاب الجنة، كما جاء في الخبر في تفسير قوله تعالى: (فَجَزاؤهُ جَهَنَّمُ خالدِاً فِيها) النساء: 93، أي إن جازاه، وكما روينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من وعده الله تعالى على عمل ثواباً فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: يغفر لم يشاء الذنب العظيم ويعذّب من يشاء على الذنب الصغير، وقد قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمِنْ يشاءُ) النساء: 48، فلم يجد للمغفرة ذنباً غير الشرك وترك المسلمين مع سائر الذنوب في مشيئته فقد يحتج محتج بالخبر المأثور في ترك قبول توبة المبتدع إن الله تعالى احتجر التوبة على كل صاحب بدعة فهذا مخصوص لمن لم يتب ممّن حكم عليه بدرك الشقاء، ألا ترى أنه لم يقل إن الله تعالى احتجر قبول التوبة عمّن تاب إنما أخبر عن حكم الله تعالى فيمن لم يتب بأن الله تعالى حجب التوبة عنه، فهكذا نقول أيضاً: إن القاتل إذا كان قد سبق له سوء الخاتمة بأنه يموت على غير توحيد، وكذلك المبتدع إن جعل اسمه في أصحاب النار ثم كان القتل والبدعة علامة ذلك وسببه أنهما جميعاً ممنوعان من التوبة فإنها محتجرة عنهما، سورة وكذلك القول فيمن حقْت عليه كلمة العذاب بسبق سوء الخاتمة فلو أنه تاب سبعين توبة لم تنقذه من النار وليست توبته بأكثر من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى يقول الناس: إنه من أهلها ولا يبقى بينه وبينها إلا شبر ثم يدركه الشقاء.
وفي لفظ آخر: ثم يسبق عليه الكتاب بعمل أهل النار فيدخلها فقد دخلت التوبات في صالح أعماله الحسنات ثم أحبطها عنه في جملة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له، وأما من لم يسبق له سوء الخاتمة ووهب له التوبة النصوح ولم يدركه الشقاء فإنها لم تحتجر عنه وإن الله تعالى يعفو عنه بما وهب له من التوبة كقوله تعالى في المنافقين: (إمَّا يُعَذِّبُهُمّ وإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) التوبة: 106، وليس النفاق دون البدعة ولا كل المنافقين تاب عليهم ولا جميعهم ختم لهم به، ولعموم قوله تعالى: (فَتابَ عَلَيْكُمْ وعفا عنْكمْ) البقرة: 187، فهذا مجمل فيمن تاب والخبر مخصوص فيمن لم يتب، ولقوله تعالى: (ثُمَّ تابَ عليْهِم لِيتُوبُوا) التوبة: 118، ولقوله تعالى: (عسى الله أن يَتُوبَ علَيْهِمْ إنَّ الله غفورٌ رَحيمٌ) التوبة: 102، ثم إن الناس في التوبة على أربعة أقسام، في كل قسم طائفة، لكل طائفة مقام، منهم: تائب من الذنب مستقيم على التوبة والإنابة لا يحدث نفسه بالعود إلى معصية أيام حياته مستبدل بعمل سيئاته صالح حسناته، فهذا هو السابق بالخيرات وهذه هي التوبة النصوح ونفس هذا المطمئنة المرضية، والخبر المروي في مثل هذا سيروا سبق المفردون المستهترون بذكر الله وضع الذكر أوزارهم فوريوا القيامة خفافاً والذي يلي هذا في القرب عبد عقده التوبة ونيّته الإستقامة لا يسعى في ذنب ولا يقصده ولا ينجوه ولا يهتم به وقد يبتلي بدخول الخطايا عليه عن غير قصد منه ويمتحن بالهم واللمم، فهذا من صفات المؤمنين يرجى له الاستقامة لأنه في طريقها وهو ممّن قال الله تعالى: (يَجْتَنِبُونَ كبائِرَ الإثْمِ والْفَواحشِ إلاَّ اللَّممَ إنَّ ربَكَ واسِعُ الْمغفرةِ) النجم: 32 وداخل في وصف المتقين الذين قال الله تعالى فيهم: (والَّذين إذا فَعَلُوا فاحِشةَ أو ظلمُوا أنْفُسَهُمْ) آل عمران: 135 الآية، ونفس هذا هي اللوّامة التي أقسم الله تعالى بها وهو من المقتصدين وهذه الذنوب تدخل على النفوس من معاني صفاتها وغرائز جبلاتها وأوائل أنسابها من نبات الأرض وتركيب الأطوار في الأرحام خلقاً بعد خلق ومن أختلاط الأمشاج بعضها ببعض ولذلك عقبه تعالى بقوله: (هُو أعْلمُ بِكُمْ إذْ أنْشأكُمْ مِنَ الأرضِ وإذ أنْتُمْ أَجِنَّةٌ في بُطُونِ أُمَّهاتِكمُ) النجم: 32 الآية، فلذلك نهى عن تزكية النفس المنشأة من الأرض والمركبة في الأرحام بالأمشاج للاعوجاج فقال تعالى: (فلا تُزكُّوا أنْفُسكُمْ) النجم: 32 أي فهذا وصفها عن بدء إنشائها وكذلك وصف مشيج خليقته بالابتلاء في قوله: (إنَّا خلقْنا الإنسان مِنْ نُطْفَةِ أمشاجٍ نَبْتليهِ فجعلْناهُ سميعاً بصيراً) الإنسان: 2، شوح هذا يطول ويخرج إلى علم تركيبات النفوس ومجبول فطرتها.
وقد ذكرنا أصوله في بعض الأبواب من هذا الكتاب: وفي مثل هذا العبد معنى الخبر الذي جاء المؤمن مفتن توّاب والمؤمن كالسنبلة تفيء أحياناً وتميل أحياناً فإزراء هذا العبد على نفسه ومقته لها عن معرفته بها وترك نظره إليه وسكونه إلى خير إن ظهر عليها يكون من كفارات ذنوبه لأنه من تدبر الخطاب في قوله تعالى: (فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ هُو أعْلمُ بِمَنِ اتَّقى) النجم: 32، والعبد الثالث هو الذي يقرب من هذا الثاني في الحال عبد يذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب ثم يحزن عليه بقصد له وسعي فيه وإيثاره إياه على الطاعة، إلا أنه يسوّف بالتوبة ويحدث نفسه بالاستقامة ويحب منازل التوابين ويرتاح قلبه إلى مقامات الصديقين ولم يأن حينه ولا ظهر مقامه لأن الهوى يحركه والعادة تجذبه والغفلة تغمره إلا أنه يتوب خلال الذنوب ويعاود لتقدم المعتاد فتوبة هذا فوت من وقت إلى وقت ومثله ترجى له الاستقامة لمحاسن عمله وتكفيرها لسالف سيئته وقد يخاف عليه الانقلاب لمداومة خطئه ونفس هذا هي المسوّلة وهو ممّن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليه فيستقيم فيلحق بالسابقين فهذا بين حالين، بين أن يغلب عليه وصف النفس فيحق عليه ما سبق من القول وبين أن ينظر إليه مولاه نظرة تجبر له كلّ كسر ويغنى له كل فقر فيتداركه بمنّة سابقة فتلحقه بمنازل المقرّبين لأنه قد سلك طريقهم بفضله ورحمته ونيته الآخرة، والعبد الرابع أسوأ العبيد حالاً وأعظمهم على نفسه وبالاً وأقلهم من الله نوالاً عبد يذنب ثم يتبع الذنب مثله أو أعظم منه ويقيم على الإصرار ويحدث نفسه به متى قدر عليه ولا ينوي توبة ولا يعقد استقامة ولا يرجو وعداً بحسن ظنّه ولا يخاف وعيداً لتمكّن أمنه، فهذا هو حقيقة الإصرار ومقام بين العتو والاستكبار، وفي مثل هذا جاء الخبر: هلك المصرّون قدماً إلى النار ونفس هذا هي الأمّارة وروحه أبداً من الخير فرّارة ويخاف على مثله سوء الخاتمة لأنه في مقدماتها وسالك طريقتها ولا يبعد منه سوء القضاء ودرك الشقاء ولمثل هذا قيل من سوف الله تعالى بالتوبة أكذبه وأن اللعنة خروج من ذنب إلى أعظم منه، وهذه الطائفة في عموم المسلمين، وهم في مشيئة الله من الفاسقين، كما قال تعالى: (مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله) التوبة: 106 أي مؤخرون لحكمه إما يعذبهم بالإصرار وإما يتوب عليهم بما سبق من حسن الاختيار نعوذ بالله تعالى من عذابه ونسأله نعيماً من ثوابه، وهذا آخر كتاب التوبة.
شرح مقام الصبر
ووصف الصابرين وهو الثاني من مقامات اليقين
قد جعل الله عزّ وجلّ الصابرين أئمة المتقين وتمّم كلمته الحسنى عليهم في الدين فقال تعالى: (وجَعَلْناهمْ أئِمَةً يَهْدُونَ بأمْرِنا) الأنبياء: 73 لما صبروا، وقال تعالى: (وتَمَّتْ كلمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى على بني إسْرائيل بِما صَبَرُوا) الأعراف: 137، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وقال المسيح عليه السلام: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون، وقال بعض الصحابة: ماذا جعل الله تعالى من الشقاء والفضل في التقى والصبر، وقال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان، وقد جعل علي كرم الله وجهه الصبر ركناً من أركان الإيمان وقرنه بالجهاد والعدل والإيقان فقال: بني الإسلام على أربع دعائم، على اليقين، والصبر، والجهاد، والعدل، وقال عليّ كرم الله وجهه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد لا جسد لمن لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له، ورفع رسول الله: الصبر في العلو والفضل إلى مقام اليقين وقرنه به، وكذلك قال تعالى: (وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بأمْرِنا لِمَّا صبَرُوا وكانُوا بآياتِنا يُوقِنُونَ) السجدة: 24، وأخبر النبي لله: إن من أوتي نصيبه منهما لم يسأل ما فاته، وأخبر عليه السلام: إن الصبر كمال العمل والأجر، فقال في حديث يرويه شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من أقلّ ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار ولأن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحبّ إليّ من أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم، ولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضاً وينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه،، ثم قرأ ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزينّ الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وفي حديث ابن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله عن الإيمان فقال الصبر والسماحة، وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (أُولئكَ يُؤْتَوْنَ أجْرَهُمّ مرَّتَيْنِ بِما صبَرُوا) القصص: 54، وقال عزّ وجلّ: (إِنَّما يُوفَّى الصَّابِرون أجْرَهُمّ بِغيْرِ حِسابٍ) الزمر: 10 فضاعف أجر الصابرين على كلّ عمل ثم رفع جزاء الصبر فوق كلّ جزاء فجعله بلا نهاية ولا حدّ فدلّ ذلك أنه أفضل المقامات وجمع للصابرين ثلاثاً فرقها على جمل أهل العبادات، الصلاة، والرحمة، والهدى بعد البشارة في الآخرة والعقبى، وكان عمر رضي الله عنه يقول: نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين، يعني بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى، والعلاوة ما يعلى به فوق الحملين على البعير فيكون كعدل ثالث، وقد أخبر الله تعالى أنه مع الصابرين، ومن كان الله تعالى معه غلب، كما أن من كان معه علا، فقال تعالى: (واصْبِرُوا إنَّ الله مع الصَّابِرينَ) الأنفال: 46، كما قال الله عزّ وجلّ: (وأنْتُمُ الأعلوْنَ والله معكُمْ) محمد: 35 واشترط الصبر لإمداده بجنده ولنصرة تأييده بقوله تعالى: (بلى إنّ تصْبِرُوا وتتَّقوا ويأْتُونكُمْ منْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسةِ آلافِ من الملائكةِ مُسَوِّمينَ) آل عمران: 125، وكان سهل يقول: الصبر تصديق الصدق وأفضل منازل الطاعة الصبر على المعصية ثم الصبر على الطاعة، وقال في معنى قوله عزّ وجلّ: (اسْتَعِنُوا بِالله وَاصْبِروُا) الأعراف: 128 أي استعينوا بالله على أمر الله، وأصبروا على أدب الله، وقال: لم يمدح الله تعالى أحداً إلا من صبر للبلاء والشدة فبذلك يثني عليه، وكان يقول: الصالحون في المؤمنين قليل، والصادقون في الصالحين قليل، والصابرون في الصادقين قليل، فجعل الصبر خاصيّة الصدق وجعل الصابرين خصوص الصادقين، وكذلك الله تعالى وهو أصدق القائلين، قد رفع الصابرين على الصادقين في ترتيب المقامات، فجعل الصبر مقاماً في الصدق إن كانت الأوصاف المنسوقة نعتاً واحداً للمسلمين، وكانت الواو للمدح وإن كانت مقامات فالواو للترتيب، فقد جعل الله الصابرين فوق الصادقين والقانتين أعني في قوله تعالى: (إنَّ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلِماتِ والْمُؤمنينَ والْمُؤمِنَاتِ) الأحزاب::35 الآية، وفي حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما دخل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا فقال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله قال: وما علامة إيمانكم؟ قال: نشكر في الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى القضاء فقال: مؤمنون: ورب الكعبة، والصبر ينقسم على عملين، أحدهما لا صلاح للدين إلا به، والثاني هو أصل فساد الدين، ثم يتنوع الصبر فيكون صابراً على الذي فيه صلاح الدين فيكمل به إيمانه ويكون صابراً عن الذي فيه فساد الدبن فيحسن به يقينه.
روينا في معنى هذا عن عليّ رضي الله عنه: أنه لما دخل البصرة واستاقم له الأمر دخل جامعها فجعل يخرج القصّاص ويقول القصص بدعة، فانتهى إلى حلقة شاب يتكلم على جماعة فأستمع إليه فأعجبه كلامه فقال: يا فتى أسألك عن شيئين فإن خرجت منهما تركتك تتكلم على الناس وإلا أخرجتك كما أخرجت أصحابك، فقال: سل يا أمير المؤمنين فقال: أخبرني ما صلاح الدين وما فساده؟ قال: صلاحه الورع وفساده الطمع قال: صدقت تكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الناس، يقال: إن هذا الشاب هو إمامنا في هذا العلم وهو إمام الأئمة الحسن بن يسار مولى الأنصار البصري، وكان ميمون بن مهران يقول: الإيمان والتصديق والمعرفة والصبر واحد، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: دروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر، وأعلم أن الورع أول الزهد وهو أول باب من أبواب الآخرة والطمع أوّل الرغبة، وهو باب كبير من أبواب الدنيا، وهو استشعار الطمع من حبّ الدنيا، وحبّ الدنيا رأس كل خطيئة، ويقال: أول معصية عصى الله تعالى بها الطمع، وهو أن آدم عليه السلام طمع في الخلود فأكل من الشجرة التي نهى عنها وإبليس طمع في إخراج آدم عليه السلام من الجنة فوسوس إليه فاتفقا في إسم المعصية لربهما تعالى بالطمع، ثم افترقا في المطموع فيه وفي الحكم، فتدورك آدم عليه السلام بحسن سابقته من الله تعالى وهلك إبليس بما سبق عليه من الشقوة ولاطمع هو تصديق الظن، ولذلك وصف الله تعالى به عدوه في قوله تعالى: (ولقد صدَّق عَلَيْهِمْ إبليسُ ظَنَّهُ) سبأ: 20، والظنّ ضد اليقين ولا يغني من الحق شيئاً، وقال الله تعالى في وصف المشركين: (إنْ نَظُنُّ إلا ّظنًّا وما نَحْنُ يِمُسْتَيْقِنين) الجاثية: 32، فمن صبر عن الطمع في الخلق أخرجه الصبر إلى الورع ومن صبر عن الورع في الدين أدخله الصبر في الزهد ومن طمع في تصديق الظنّ الكاذب أدخله الطمع في حبّ الدنيا، ومن استشعر حبّ الدنيا أخرجه حبها من حقيقة الدين.
وقد قال بعض العلماء: ما كنا نعدّ إيمان من لم يؤذ فيحتمل الأذى ويصبر عليه إيماناً وقد فعل الله تعالى ذلك بالمؤمنين اختباراً وأخبر أن ذلك ليس منه عذاباً وإنما هو فتنة لمن أراد فتنته وبلاءه من الناس، فصار ذلك فتنة عليهم وابتلاء لهم وصار رحمة للمؤذي وخيراً في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله فإذا أُوذِي في الله جعل فِتْنَةَ النَّاسِ كعذابِ الله) العنكبوت: 10 له، يعني فتنة الناس به كعذاب الله تعالى يعني إياه أي ليس ذلك عذاباً مني إنما هو رحمة باطنة فهو كقوله تعالى: (وَأَمَّا إذا ما ابتْلاهُ فَقدرَ عليْهِ رِزْقَهُ فيقُول ربّي أهانِنِ) (كَلاّ) سورة الفجر: 16 - 17 أي لم أهنك بالفقر كما لم أكرم الآخر بالإكرام والتنعيم وعلى معنى هذا خاطب نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصبر الذي أمره به فقال تعالى: (اصبِر على ما يَقُولونَ واذْكُرْ عَبْدنا داوُد) ص: 17 فسلاه به وفضله عليه.
وقد روينا في خبر: يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله تعالى جزاء الشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له: أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تعالى: كما أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت لأضعفنّ لك الأجر عليه فيعطي أضعاف جزاء الشاكرين، وكتب ابن أبي نجيح يعزي بعض الخلفاء فقال في كتابه: إن أحقّ من عرف حقّ اللهّ فيما أخذ منه من عظم حقّ الله تعالى عنده فيما أبقى، واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك والباقي بعدك هو المأجور فيك، واعلم أن أجر الصابرين فيما يصابون فيه أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون به، وفي الأخبار: ما من عبد إلا يعطى أجره بحساب وحدّ إلا الصابرين فإنهم يجازفون مجازفة بغير ميزان ولا حدّ، وجاء في الخبر أن أبواب الجنة مصراعان يأتي عليها زحام كثير إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد لا يدخل منه إلا الصابرون أهل البلاء في الدنيا، واحد بعد واحد.
وقد قال الله تعالى في جزاء المخلصين: (أولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ) الصافات: 41، وقال تعالى في جزاء الصابرين (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرون أجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) الزمر: 10، قيل في التفسير: يغرف لهم غرفاً، المعنى في ذلك أن الصبر أشق شيء على النفس وأكرهه وأمرّه على الطبع وأصعبه فيه الألم والكظم عند الذل والحلم ومنه التواضع والكتم وفيه الأدب وحسن الخلق وبه يكون كفّ الأذى عن الخلق واحتمال الأذى من الخلق، وهذه من عزائم الأمور التي يضيق منها أكثر الصدور وفيه إكراه النفوس وحملها على الشدة والبؤس، وقد جاء أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، ولأجل ذلك اشترط الله تعالى على المّتقين والصادقين الصبر في الشدائد والمكاره وحقق بالصبر صدقهم وتقواهم وأكمل به وصفهم وأعمال برّهم فقال تعالى: (والصّابِرينَ في الْبَأْساءِ والضَّرَّاءِ وحينَ الْباسِ أُولئكَ الَّذين صدقُوا وأُولئكَ هُمُ الْمُتَّقُون) البقرة: 177، فمعنى الصبر حبس النفس عن السعي في هواها وحبسها أيضاً عن مجاهدتها لمرضاة مولاها بمثل ما يوجب المجاهدة على قدر ما يبتلي به العبد لأن المجاهدة على قدر البلاء والحبس عن نحو الشرود وحبسها على دوام الطاعة وصبرها عن شره الطبع الذي يظهر سوء الأدب بين يدي الربّ سبحانه وتعالى وصبرها على حسن الأدب في المعاملة، ثم يتفرع الصبر إلى معانٍ شتى: من الصبر عن تفاوت الأهواء والصبر على الثبات في خدمة المولى فمن ذلك ما توجب المجاهدة صرف الهمة عنه وتطهير القلب منه من خطرات الهوى ونزعات الأعداء وتزيين الدنيا، ومن الآفات ما يوجب الصبر كفّ الجوارح عنها وحبس النفس عن المشي فيها، ومن الصبر حبس النفس على الحقّ وعكوفها عليه بمعاملة اللسان والقلب والجسم، وبذلك؛ وصف الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصالحات واشترط لصلاح أعمالهم الصبر وأخبر أن الناس كلهم في خسران إلا من كان من أهل الحق والصبر وعظم الصبر فأفرده بإعادة التواصي به، ومن الصبر حبس النفس على عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وصبرها على القناعة وعلى صنع الرازق، ومن الصبر كفّ الأذى عن الخلق، وهو مقام العادلين يدخل في قوله تعالى: (إنَّ الله يأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسانِ) النحل: 90، ثم احتمال الأذى عن الخلق وهو مقام المحسنين يدخل في قوله: والإحسان، ومن الصبر الصبر على الإنفاق وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم الأقرب فالأقرب وهذا مقام المنفقين يدخل في قوله تعالى: (وإيتاء ذِي الْقُربى وينْهى عَنِ الْفحشاءِ والْمُنْكَرِ والْبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون) النحل: 90 ومنه الصبر على الفحشاء وهو الأمر الفاحش في العلم والإيمان والصر عن المنكر وهو ما أنكره العلماد، والصبر عن البغي وهو التطاول والغلوّ ومجاوزة الحدّ بالكبر والإسراف في أمور الدنيا، فهذه الآية كلها جامعة لمعنى الصبر وهي قطب القرآن، ثلاث منها وهي الأول الصبر على العدل والإحسان والإعطاء، وثلاث منها الصبر عن الفحشاء والمنكر والبغي.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أجمع آية في كتاب الله عزّ وجلّ لأمر ونهي هذه الاية، وقال الله تعالى: (وَنِعِمْ أَجْرُ الْعامِلينَ) آل عمران: 136 الذين صبروا فما أنعم أجرهم حتى وصفهم بالصبر وما أكرم رزقهم ووصفهم حتى مدحهم بالصبر، والصبر يحتاج إليه قبل العلم، ومعه وبعده، يحتاج في أول العمل أن يصبر على تصحيح النّية وعزم العقود والوفاء بها حتى تصحّ الأعمال لأن النبيّ عليه السلام قال: إنما الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى، وقال الله تعالى: (وما أُمِرُوا إلاَّ لِيعْبُدوا الله مُخْلِصينَ لهُ الدين) البينة: 5، وحقيقة النيّة الإخلاص ولأن الله تعالى قدّم الصبر على العمل فقال تعالى: (إلاَّ الَّذينَ صبَرُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولئكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأجرٌ كَبيرٌ) هود: 11، والصبر: التأني في العمل حتى يتم ويعمل لقوله تعالى: (وَنِعَمْ أجْرُ الْعَامِلينَ) آل عمران: 136 الذين صبروا، والصبر بعد العمل هو الصبر على كتمه وترك التظاهر به والنظر إليه ليخلص من السمعة والعجب فيكمل ثوابه كما خلص من الرياء، كما قال الله تعالى: (أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ ولا تُبْطِلوا أعمالَكُمْ) محمد: 33
وقال تعالى في مثله: (لا تُبْطِلُوا صدقاتِكُمْ بِالْمَنِّ والأذى) البقرة: 264، وقال بعض السلف لا يتمّ المعروف إلا بثلاث: تعجيله، وتصغيره، وكتمه، ومن الصبر حبس النفس عن المكافأة والصبر على الأذى توكلاً على المولى عزّ وجلّ، ومنه قوله تعالى: (وَلنَصْبِرنَّ على ما آذَيْتُمُونا وعلى الله فلْيَتوكَّل الْمُتَوكِّلُونَ) إبراهيم: 12 وهذا صبر الخصوص ومنه قال بعض أهل المعرفة: لا يثبت للعبد مقام في التوكل حتى يؤذى ويصبر على الأذى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله عزّ وجلّ: (وَدَعْ أزَاهُمْ وتوَكَّلْ على الله) الأحزاب: 48، وفي قوله تعالى: (فاتَّخِذْهُ وكيلاً) (وَاصْبرْ على ما يَقُولونَ) المزمل: 9 - 10 وهذا هو أوّل الرضا، والمقام الثاني من الرضا: هو الصبر على الأحكام وهو صبر أهل البلاء الأمثل فالأمثل بالأنبياء لقوله: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ولقوله تعالى في المجمل: (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) المدثر: 7، ثم فسرّه في الكلام المفسرّ، وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ومن الصبر حبس النفس على التقوى، والتقوى اسم جامع لكلّ خير، فالصبر معنى داخل في كل برّ فإذا جمعهما العبد فهو من المحسنين وما على المحسنين من سبيل، ومنه قوله تعالى: (إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ ويَصْبِرْ فإنَّ الله لا يضيعُ أجْرَ الْمُحْسنينَ) يوسف: 90 وقال تعالى: (لَتُبْلوُنَّ في أموالِكُمْ وأنْفُسِكُمْ ولَتسْمَعُنَّ مِن الَّذين أُوتُوا الكتابَ مِنْ قبلكمْ ومن الَّذين أشرْكوا أذىً كثيراً وإن تَصبِرُوا وتتَّقُوا فإنَّ ذلك مِنْ عَزْم الأُمورِ) آل عمران: 186 أي إن تصبروا على الأذى عن المكافأة وتتقوا عند الابتلاء والمكاره ولا تجاوزوا فإنه أفضل كما قال تعالى: (وإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل ما عُوقِتْتُمْ بهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خيْرٌ للصّابرينَ) النحل: 126، وقوله تعالى: (ولمنَِ انْتصَر بَعْد ظُلمهُ فأُولئكَ ما عَليْهِمْ من سبيلٍ) الشورى: 41 ثم قال عزّ وجلّ: (وَلَمَنْ صبرَ وغَفرَ إنَّ ذلك لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) الشورى: 43، قال: فالأول أعني المكافأة والانتصار بالحق من العدل والعدل حسن، والثاني أعني العفو والصبر من الفضل وهو الإحسان وهذا مجاز قوله تعالى: (الَّذين يَسْتَمِعُون الْقَول فَيَتَّبِعُونَ أحْسنهُ أُولئكَ الَّذين هداهُمُ الله وأُولئكَ هم أولُوا الألْبَابِ) الزمر: 18، فاستماع القول هو العدل والعدل حسن وهو الانتصار والعفو أحسن وفيه المدح بالهدى والعقل، وهذا هو مقام المخبتين قيل: هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا فالمدح بالوصف لأهل هذا المقام هو الإخبات وهو الخشوع والطمأنينة بحسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى في الآخرة لقرب اللقاء وسرعة فناء الدنيا أمدح كما قال تعالى: (وإنَّ السَّاعَة لآتِيَةٌ فاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ) الحجر: 85، والتقوى والصبر معينان أحدهما منوط بالآخر لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله فصار الصبر أفضل الأحوال من حيث كان التقوى أعلى المقامات إذ الأتقى هو الأكرم عند الله تعالى، والأكرم على الله تعالى هو الأفضل، وقد شرف الله تعالى الصبر بأن أضافه إليه بعد الأمر به فقال: (وَاصْبِرْ وما صَبْرُكَ إلاَّ بِالله) النحل: 127 وقال تعالى: (وَلِربَِّكَ فاصْبِرْ) المدثر: 7 وإن كان كل شيء به وكل عمل صالح له ولا يصف الله تعالى عبداً ولا يثني عليه حتى يبتليه فإن صبر وخرج من البلاء سليماً مدحه ووصفه وإلا بين له كذبه ودعواه، وقيل لسفيان الثوري رضي الله عنه: ما أفضل الأعمال قال الصبر عند الابتلاء.
وقال بعض العلماء: وأي شيء أفضل من الصبر وقد ذكره الله تعالى في كتابه في نيف وتسعين موضعاً ولا نعلم شيئاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر فلا يطمعنّ طامع في مدح الله له وحسن ثنائه عليه قبل أن يبتليه فيصبر له ولا يطمعنّ أحد في حقيقة الإيمان وحسن اليقين قبل أن يمدحه الله تعالى ويثني عليه، ولو أظهر الله تعالى على جوارحه سائر الأعمال ثم لم يمدحه بوصف ولم يثن عليه بخير لم يؤمن عليه سوء الخاتمة، وذلك أن من أخلاق الله تعالى أنه إذا أحبّ عبداً ورضي عمله مدحه ووصفه، فمن ابتلاه بكراهة ومشقة أو بهوى وشهوة فصبر لذلك أو صبر عن ذلك، فإن الله تعالى يمدحه ويثني عليه بكرمه وجوده فيدخل هذا العبد في أسماء الموصوفين ويصير واحداً من الممدوحين فعندها يثبت قدمه من الزلل ويخت له بما سبق من صالح العمل، ومن الصبر، صبر على العوافي أن لا يجريها في المخالفة والصبر على الغنى أن لا يبذله في الهوى، والصبر على النعمة أن لا يستعين بها على معصية، فحاجة المؤمن إلى الصبر في هذه المعاني ومطالبته بالصبر عليها كحاجته ومطالبته بالصبر على المكاره والفقر وعلى الشدائد والضرّ، ويقال: إن البلاء والفقر يصبر عليهما المؤمن والعوافي لا يصبر فيها إلا صديق، وكان سهل يقول: الصبر على العافية أشدّ من الصبر على البلاء، وكذلك قالت الصحابة رضي الله عنهم: لما فتحت الدنيا فنالوا من العيش واتسعوا ابتلينا بفتنة الضّراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السرّاء فلم نصبر فعظموا الاختبار بالسرّاء وهو ما سرّ على الاختبار بالضراء وهو ما ضرّ.
وقد قال تعالى: (الَّذينَ يُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ) آل عمران: 134 فمدحهم بوصف واحد في الحالين المختلفين لحسن يقينهم وسخاوة نفوسهم وحقيقة زهدهم، ومن هذا المعنى قول الله تعالى: (يا أيُّها الَّذين آمِنوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله) المنافقون: 9 لأن فيهما ما يسرّ ويشغل عن الذكر، ثم قال عزّ وجلّ: (إنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وأَولادِكُمْ عَدْوَّا لَكُمْ فاحْذَرُوهُمْ) التغابن: 14 لأن في الأواج والأولاد ما يفرح به فيوافق فيه الهوى ويخالف بوجودهما المولى فصار اعدوين في العقبى لما يؤول إليه من شأنهما، ومن هذا الخبر الذي روى عن النبي لما نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه فنزل عن المنبر واحتضنه ثم قال صدق الله: (إنَّما أمْوالُكُمْ وأوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) التغابن: 15 أي لما رأيت ابني هذا لم أملك نفسي أن أخذته، ففي هذا عبرة لأولي الأبصار، وروي عنه في الحديث أيضاً: الولد محزنة مبخلة مجبنة، فهذه مصادر الحزن والبخل والجبن أي يحمل حب الأولاد والأموال على ذلك، فمن صبر على السرّاء وهي العوافي والغنى والأولاد وغير ذلك وأخذ الأشياء من حقّها ووضعها في حقّها فهو من الصابرين الشاكرين لا يزيد عليه أهل البلاء والفقر إلا بحقيقة الرضا والشكر، وقد جمع الله تعالى بين ما سرّ وضرّ وجعلهما من وصف المتّقين ومدحهم بالإحسان معهما فقال تعالى: (أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ) (الَّذين يُنْفِقُونَ في السَّرَّاء والضَّرَّاء والْكاظِمينَ الْغيْظ والْعافينَ عَنِ النّاسِ والله يُحِبُّ الْمُحْسنينَ) آل عمران: 133 - 134، ومن الصبر كتمان المصائب والأوجاع وترك الاستراحة إلى الشكوى بهما فذلك هو الصبر الجميل قيل: هو الذي لا شكوى فيه ولا إظهار.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء الفرائض لله تعالى، وصبر عن محارم الله تعالى، وصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى، فمن صبر على أداء فرائض الله تعالى فله ثلاثمائة درجة، ومن صبر على محارم الله تعالى فله ستمائة درجة، ومن صبر في المصيبة عند الصدمة الأولى فله تسعمائة درجة، وهذا يحتاج إلى تفسير، ولم يفضل ابن عباس الصبر على المصيبة لأنه أفضل من الصبر عن المحارم وعلى الفرائض بل لأن الصبر على ذينك من أحوال المسلمين والصبر على المصيبة من مقامات اليقين وإنما فضل المقام في اليقين على مقام الإسلام ومن ذلك ما روي من دعاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، فأحسن الناس صبراً عند المصائب أكثرهم يقيناً وأكثر الناس جزعاً وسخطاً في المصائب أقلّهم يقيناً، ومثل هذا الخبر الذي رويناه عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من ترك المراء وهو محقّ بني له بيت في أعلى الجنة، ومن ترك المراء وهو مبطل بني له في وسط الجنة، ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة، فقد علمت أن ترك الكذب وترك المراء مبطلاً أفرض وأوجب فينبغي أن يكون أفضل، ولكن المعنى فيه أن الكذب والمراء بالباطل يتركه المسلمون، فأما المراء والعبد محقّ صادق ثم لا يماري زهداً في التظاهر ورغبة في الصمت والسلامة فلا يصبر على هذا إلا الموقنون وهم خصوص المؤمنين، فمقامه من اليقين، والزهد وإيثار الخمول والصمت على الكلام والشهوة به أفضل وهو من اليقين فصار هذا المؤمن بمقامه أفضل من عموم المؤمنين الذين يتركون الكذب والمماراة وإن كانا أفرض وأوجب فهذا بيان ذلك معناه، ومن الصبر إخفاء أعمال البرّ ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرها وإخفاء المعروف والصدقات فإن كتمه من الأدب مع السلامة في الإعلان وبرء الساحة في الإخبار ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحبّ إلى الله تعالى بل هي من كنوز البرّ أعني هذه الثلاثة إخفاء الأوجاع والمصائب والصدقة أي من الذخائر النفيسة عند تبارك وتعالى، ومن الصبر صون الفقر وإخفاؤه، والصبر على بلاء الله تعالى في طوارق الفاقات، وهذا حال الزاهدين الراضين وأفضل الصبر: الصبر على الله تعالى بالمجالسة له والإصغاء إليه وعكوف الهمّ وقوّة الوجد به، وهذا خصوص للمقربين أو حياءً منه أو حبًّا له أو تسليماً أو تفويضاً إليه وهو السكون تحت جريان الأقدار وشهودها من الأنعام، ومن حسن تدبير الأقسام في شهود المسألة والحكمة فيها والقصد بالابتلاء بها وهو داخل في قوله تعالى: (وَلِرَبِّكَ فاصْبِرْ) المدثر: 7، وفي قوله تعالى: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فإنَّكَ بأعْيُنِنا) الطور: 48 وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وغيره من الأئمة: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر، وروي أيضاً إلا انتظار القضاء، ويقال: من علامة اليقين تسليم القضاء بحسن الصبر والرضا، وهو مقام العارفين، وقال سهل في تأويل قول علي رضي الله عنه: إن الله تعالى يحبّ كل عبد نومة قال: هو الساكن تحت جريان الأحكام يعني من غير كراهة، ولا اعتراض، فأما اشتراط الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى في قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلأنه يقال: إن كلّ شيء يبدو صغيراً ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر، فاشترط لعظم الثواب لها عند أوّل كبرها قبل صغرها وهي في صدمة القلب أوّل ما يبغته الشيء، فينظر إلى نظر الله تعالى فيستحي فيحسن الصبر كما قال: فإنك بأعيننا وهذا مقام المتوكلين على الله تعالى، والصبر أيضاً عن إظهار الكرامات وعن الإخبار بكشف القدرة والآيات داخل في حسن الأدب من المعاملات، وهو من معنى الحياء من الله تعالى، وهذا طريق المحبين لله تعالى وهو حقيقة الزهد، ومن فضائل الصبر حبس النفس عن حب المدح والحمد والرياسة.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً مقطوعاً: الصبر في ثلاث، الصبر في تزكية النفس، والصبر عن شكوى المصيبة، والصبر على الرضا بقضاء الله تعالى على خيره وشرّه، ومن الصبر حبس النفس عن الخمول والتواضع والذلة إيثاراً للآخرة على الدنيا وهرباً إلى الله تعالى وتحققاً بوصف العبودية وترك المنازعة والتشبه بمعاني أوصاف الربوبية تسليماً للإلهية واستسلاماً للأحدية فلا يخرجك قلة الصبرعن ذلك إلى الطلب بشيء منه فتزل قدم بعد ثبوتها نعوذ بالله من ذلك، ومن الصبر صبر على العيال في الكسب لهم والإنفاق عليهم والاحتمال للأذى منهم، فإن في العيال طرقات إلى الله تعالى أدناها الإهتمام بهم، وأعلاها الرضا عن الله تعالى والتوكل عليه فيهم، وأوسطها الإنفاق وحبس الإنفاق وحبس النفس عليهم، واعلم أن أكثر معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، أو قلة الصبر على ما يكرهون، وقد قرن الله تعالى الكراهة بالخير والمحبة بالشر في قوله تعالى: (وعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُو خَيْرٌ لَكٌمْ وعسى أنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُو شَرٌ لَكُمْ) البقرة: 216 وحدّ الصبر وهو أوّله فريضة بمثل أوّل الإخلاص، والصبر أيضاً حيلة من لا حيلة له لأن الأمر إذا كان بيد غيرك لم يكن إلا الصبر عليه ولأن الشيء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً وأنت محتاج إليه لم يكن إلا الصبر عليه وإلا انقطع ذلك القليل، وأصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له لأنه لو قوي يقينه كان الأجل من الوعد عاجلاً إذا كان الواعد صادقاً فيحسن صبره لقوّة الثقة بالعطاء ولا يصبر العبد إلا بأحد معنيين مشاهدة العوض وهو أدناهما، وهذا حال المؤمنين ومقام أصحاب اليمين أو النظر إلى المعوّض وهو حال الموقنين ومقام المقربين، فمن شهد العوض عني بالصبر، ومن نظر إلى المعوّض حمله النظر وقد جعل بعض العارفين الصبر على ثلاثة معان، وإنه في أهل مقامات ثلاث، فقال: أوّله ترك الشكوى قال وهذه درجة التائبين، والثانية الرضا بالمقدور وهذه درجة الزاهدين، والثالثة المحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصادقين وقد نوّع القدماء من السلف الصبر على ثلاثة أنواع.
وروينا عن الحسن وغيره: الصبر على ثلاثة معان صبر عن المعصية وهو أفضلها، وصبر على الطاعة، وصبر في المصائب، وهذا داخل في جمل ما فرقناه من معاني الصبر، ومجمل ذلك أن الصبر فرض وفضل يعرف ذلك بمعرفة الأحكام، فما كان أمراً أو إيجاباً فالصبر عليه أو عنه فرض، وما كان حثاً وندباً فالصبر عليه أو عنه فضل والتصبر غير الصبر وهو مجاهدة النفس وحملها على الصبر وترغيبها فيه وهو التعمّل للصبر والتصنّع للصبور بمنزلة التزهد، وهو أن يعمل في أسباب الزهد ليحصل الزهد والصبر، هو التحقق بالوصف وذلك هو المقام، ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس ولا وجدان المرارة والألم بل يكون مع ذلك صابراً لأن هذا وصف البشرية لما ينافي طبعها، ولكن يكون حاله الكظم عن الشكوى ونفي السخط لحكم المولى لأن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل، وهذان من أعلى مقامات اليقين، وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حدّ الصبر والذي يخرج عن حد الصبر ضده وهو الجزع ومجاوزة الحدّ من السعلم وإظهار السخط وكثرة الشكوى وظهور الذم والتبرّم، ومن رياضة النفس على التصبّر وهو مقام المتصبرين وحال ضعفاء المريدين أن النفس الأمارة إذا جنحت بك إلى فضول الشهوات أو نازعتك إلى مطالبة متقدم العادات أن تمنعها حاجتها من كل شيء فيشغلها منع الحاجة ووجود الفاقة ممّا لا بدّ منه عن طلب فضول الشهوات فإذا رضتها بالمنع ومنعتها محبوبها بالتصبّر عن الحلال انقادت لك بالصبر عن فضول الشهوات فتكون تاركة لشهوة بعوض عاجل من مباح وتكون صابرة عن فضول شهوة لما منعتها من منال الفاقة وتاركة للهوى طمعاً في نوال الحاجة من الغذاء وهذا من أكبر أبواب الرياضات للنفوس الطامحات وفيه فضل الأقوياء من المتصبرين الذين لم تستجب لهم نفوسهم بالصبر والصلاة ولم تنقد بالجوع والظماء، فأما الضعفاء من أهل الطبقة الثالثة لا من الأوّلين أهل الصوم والصلاة ولا من هؤلاء فإنهم لا يصبرون على تصبر النفس عن الحاجة كما لا تصبر نفوسهم عن الشهوة فرياضة هؤلاء لنفوسهم أن يقطعوها من كل حرام معناه من الحلال ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة لتسكن نفوسهم بذلك في حبسها عن المحرّمات وتنقطع شهوتها عمّا وراء ذلك من الموبقات فبهذا تطمئن نفوس الضعفاء، وقد أختلف الناس في الصبر والشكر أيّهما أفضل وليس يمكن الترجيح بين مقامين لأن في كل مقام طبقة متفاوتين، والمحققون من أهل المعرفة يقولون إنه لا يجتمع عبدان في مقام بالسواء بل لا بدّ من أن يكون أحدهما أعلى بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهدة وإن كان الصواب والقصد والأصل واحداً وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه.
وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَديثاً) النساء: 87 ولكل وجهة هو موليها، وقال تعالى: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ يِمَنْ هُوَ أَهْدى سبيلاً) الإسراء: 84، قيل: أقصد وأقرب طريقاً، وظاهر الكتاب والسنّة يدلان على تفضيل الصبر لقوله تعالى: (يُؤْتَون أْجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) القصص: 54 فالشاكر يؤتى أجره مرة فأشبه مقام الصبر مقام الخوف وأشبه مقام الشكر مقام الرجاء، وقد قال الله تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مقامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ) الرحمن: 46، وقد اتفق أهل المعرفة على تفضيل الخوف على الرجاء من حيث اتفقوا على فضل العلم على العمل، فالصبر حال من مقام الخوف فقرب حال الصابر في الفضل من مقامه والشكر حال من مقام الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر من مقامه ومن السنة قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخبر الذي ذكرناه من قبل: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته وذكر الحديث المتقدم فقرن الصبر باليقين الذي لا شيء أعزّ منه ولا أجلّ وارتفاع الأعمال وعلوّ اليقين به، وفي مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا أيوب إني آليت على نفسي لا نشرت للصابرين ديوان توبيخ ولا نظروا إلى حد الصراط ولا أروعهم نقص الميزان دارهم دار السلام.
بيان آخر من تفضيل الصبر
الصبر: حال البلاء، والشكر: حال النعمة والبلاء أفضل لأنه على النفس أشق لقول الله تعالى: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) الزمر: 10، فالشاكر يوفي أجره بحساب لأن إنما تحقيق للوصف ونفي ما عداه.
بيان آخر من فضل الصبر
قد رفع علي كرّم الله وجهه الصبر على أربع مقامات اليقين وجعلها دعائمه التي بها يستبين وجعله فيه فوقها فقال في حديثه الطويل الذي وصف فيه شعب الإيمان: والصبر على أربع دعائم: على الشوق، والشفقة، والزهد، والترقب، فمن أشفق من النار رجع عن المحرّمات، ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات، فجعل هذه المقامات أركان الصبر لأنها توجد عنه وتحتاج إليه في جميعها وجعل الزهد أحد أركانه، وقد جعل الله تعالى الصبر حال التقوى ورفع للمتقين في الإكرام درجات، فقال عزّ وعلا: (إنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ) يوسف: 90 وقال تعالى: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقاكُمْ) الحجرات: 13، فأكرم وأتقى فوق أن يقال كرامكم المتقون لأن أكرم وأتقى يدل على تفاوت، فمن كان أتقى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى، ومن كان أصبر على ما يوجب التقوى كان أتقى، وأعلم أن الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار لأنه جاء في الخبر: خفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات فيحتاة المؤمن إلى الصبر على المكاره ليدخل الجنة ويحتاج إلى الصبر عن الشهوات لينجو من النار، فأما تفصيل التفضيل فعلى ثلاثة أوجه، أحدها: أن المقامات أعلى من الأحوال، وقد يكون الصبر والشكر حالين، وقد يكونان مقامين، فمن كان مقامه الصبر كان حاله الشكر عليه فهو أفضل لأنه صاحب مقام، ومن كان مقامه الشكر كان حاله الصبر عليه فحاله مزيد لمقامه فقد صار الصبر مزيداً للشاكر في مقامه، الوجه الثاني من التفضيل: المقربون أعلى من أصحاب اليمين فالصابرون من المقربين أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمين والشاكرون من المقربين أفضل من الصابرين من أصحاب اليمين فإن قيل: فإن كان الشاكر والصابر من المقربين فيهما أفضل قيل: فقد قلنا إن اثنين لا يتفقان في مقام من كل وجه لانفراد الوجه بمعاني لطائف اللطيف بمثل ما انفردت الوجوه بلطيف الصنعة مع تشابه الصفات واستواء الأدوات، فأفضلهما حينئذ أعرفهما لأنه أحبهما إلى الله تعالى وأقربهما منه وأحسنهما يقيناً لأن اليقين أعزّ ما أنزل الله تعالى.
وجه آخر من بيان التفضيل
نقول: إن الصبر عمّا يوجب الشكر أفضل وإن الشكر على ما يوجب الصبر أفضل، فقد يختلف باختلاف الأحوال تفسيره أن الصبر عن حظ النفس وعن التنعّم والترفّه أفضل إن كان عبداً حاله النعمة فالصبر عن النعيم والغنى مقام في المعرفة وهو أفضل لأن فيه الزهد المجمع على تفضيله، ونقول إن الشكر على الفقر والبلاء والمصائب أفضل إن كان عبداً حاله الجهد والبلاء فالشكر عليه مقام له في المعرفة فهو حينئذ أفضل لأن فيه الرضا المتفق على فضله.
نوع آخر من الاستدلال على فضل الصابر وتفضيل الصبر جملة
الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف لأن الصبر حال الفقر والشكر حال الغنى، فمن فضل الشكر على الصبر في المعنى فكأنه قد فضّل الغنى على الفقر، وليس هذا مذهب أحد من القدماء إنما هذه طريقة علماء الدنيا طرقوا لنفوسهم بذلك وطرقوا الخلق إلى نفوسهم من ذلك، فإن من فضّل الغنى على الفقر فقد فضل الرغبة على الزهد والعزّ على الذلّ والكبر على التواضع، وفي هذا تفضيل الراغبين والأغنياء على الزاهدين والفقراء، ويخرج ذلك إلى تفضيل أبناء الدنيا على أبناء الآخرة: وإنما فضلنا الصبر على الشكر في الجملة والمعنى، لأن الصبر حال من مقامه البلاء، وأهل البلاء هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء ولأن الصبر أبعد من أهواء النفوس وأقرب إلى الضرّ والبؤس وأشدّ في مكاره النفوس وأنفر لطباعها وأشد مباينة لما يلائمها فإذا سكنت معه وجد عندها كان أعجز لوصفها وأعجب في طمأنينتها فمدحت بالسكون والطمأنينة وكانت راضية مرضية، وأيضاً فإن اللهّ تعالى أمر بالصبر وبالغ فيه بالمصابرة ووكدهما بالمرابطة في قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا اصْبِروُا وَصابِرُوا وَرَابِطُوا) آل عمران: 200، قيل: في أحد الوجوه رابطوا عليهما فهذه ثلاثة أمور في مكان واحد بمعنى الصبر، فهذا يدل على تعظيمه للصبر ومحبته تعالى فمن وجد منه ذلك كان أشد تعظيماً لشعائر الله عزّ وجلّ، ومن عظم شعائر الله فهو أتقى لله تعالى، ومن كان أتقى لله كان أكرم على الله لقوله تعالى: (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فإِنَّها مِنْ تَقْوى الْقُلُوبِ) الحج: 32، ثم قال تعالى: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقاكُمْ) الحجرات: 13، والصبر أيضاً مقام أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقدوة بهم وباهى الله تعالى بهم عبده فقال تعالى: (فاصْبِرْ كَما صَبَرَ أولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) الأحقاف: 35 وأيضاً فإن العزائم في الدين أولى من الرخص.
روينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل مسلم البطين: أيما أفضل الصبر أم الشكر؟ فقال: الصبر والشكر والعافية أحبّ إلينا، وقد قيل في معنى قوله تعالى: (الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه) الزمر: 18 قيل: شدائده وعزائمه لأن إباحة حلال الدنيا حسن والزهد فيه أحسن، وقد جعل الله تعالى الصبر من العزائم في قوله: (وإنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمورِ) آل عمران: 186، وقد شرك الله تعالى عباده في الشكر وأفرد عزّ وجلّ لنفسه تعالى الصبر فينبغي أن يكون المفرد للمفرد أعلى من المشترك بالعبد فقال تعالى: (أن اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ) لقمان: 14
وقال تعالى على لسان نبيّه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزّ وجلّ ولم يشرك في الصبر من خلقه أحداً، فقال تعالى: (وَلِربِّكَ فاصْبِرْ) المدثر: 7، وقال: واصبر لحكم ربّك واعلم أن الشكر داخل في الصبر والصبر جامع للشكر، لأن من صبر أن لا يعصي الله بنعمة فقد شكرها ومن أطاع الله فصبر نفسه على طاعته فقد شكر نعمته، وقد سئل الجنيد رحمه الله عن غني شاكر وفقير صابر أيهما أفضل؟ فقال: ليس مدح الغني للوجود ولا مدح الفقير للعدم إنما المدح في الاثنين قيامهما بشروط ما عليهما، فشرط الغني يصحبه فيما عليه أشياء تلائم صفته وتمتعها وتلذّها، والفقير يصحبه فيما عليه أشياء تؤلم صفته وتقبضها وتزعجها، فإذا كان الاثنان قائمين لله تعالى بشروط ما عليهما كان الذي آلم صفته وأزعجها أتم حالاً ممّن متّع صفته ونعّمها، هذا نقل كلام الجنيد رحمه الله تعالى، وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه في ذلك فيقال: إن الجنيد دعا عليه فلحقه ما أصابه من البلاء منه، قتل أولاده، وإتلاف ماله، وزوال عقله أربع عشرة سنة، فكان يقول: دعوة الجنيد أصابتني، ورجع عن قوله في تفضيل الغنى على الفقر، فصار يفضّل الفقر ويشرّفه، وأيضاً فقد روينا في الخبر: أعرفكم بنفسه أعرفكم بما ابتلاه به منها وما ابتلاها به منه فأعظم ما ابتلانا به محبتنا بها وابتلاها بعدواتنا، فمن أفضل ممّن صبر على مجاهدة عدوّه على أنه مع ذلك عدوّ الله تعالى منازع لصفات الربوبية، ومن أشد بلاء ممنّ ابتلي بعداوتك وبتليت بمحبته وأنت في ذلك تترك محبته لمحبة الله تعالى وتصبر على عداوته بدوام مجاهدته لمرضاة الله تعالى، فهذا أعدل العدل وأفضل الفضل ولا سبيل إلى ذلك إلا بفضل أثرة من الله تعالى وحسن عنايته ودوام نظره إذ لا توفيق ولا قوّة ولا صبر إلا به سبحانه وتعالى، فأما المسألة التي سئل عنها بعض القدماء عن عبدين ابتلي أحدهما فصبر وأنعم على الآخر فشكر، فقال: كلاهما سواء قال: لأن الله تعالى أثنى على عبدين أحدهما صابر والآخر شاكر بثناء واحد، فقال تعالى في وصف أيوب عليه السلام: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ص: 30
وقال في وصف سليمان عليه السلام: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ) ص: 30، ففي قول هذا رحمه الله غفلة عن لطائف الأفهام وذهاب عن حقيقة تدبّر الكلام إذ عندنا بين ثناء الله عزّ وجلّ على أيوب في الفضل على ثنائه على سليمان عليهما السلام ثلاثة عشر معنى، وشركه سليمان عليه السلام بعد ذلك في وصفين آخرين وإفراد أيوب عليه السلام بفضل ثناء ثلاثة عشر معنى، أول ذلك قوله عزّ وجلّ في أول مدحه: (واذْكُرْ) ص: 41 فهذه كلمة مباهاة باهى بأيوب عند رسوله المصطفى عليه السلام وشرفه وفضله بقوله تعالى: (واذْكُرْ) ص: 41 يا محمد فأمره بذكره والاقتداء به كقوله تعالى: (فاصْبِرْ كما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) الأحقاف: 35، قيل: هم أهل الشداء والبلاء منهم أيوب عليه السلام قرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير وكانوا سبعين نبياً وقيل: هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء آباء الأنبياء وأفاضلهم لقوله تعالى: (وَاذْكُرْ في الْكِتَابِ ابْرَاهِيَمَ) مريم: 41 ولقوله تعالى: (واذْكُرْ عِبادَنا إبْراهِيمَ وإسْحق وَيعقُوبَ أولي الأيدي والأبْصارِ) ص: 45 يعني أصحاب القوّة والتمكّن وأهل البصائر واليقين، ثم رفع زيوب إلى مقامهم فضمه إليهم وجعله سلوة له ثم ذكره إياه وذكره به، ثم قال تعالى: (عَبْدنا) ص: 41 فأضافه إليه عزّ وجلّ إضافة تخصيص وتقريب ولم يدخل بينه وبينه لام الملك فيقول عبداً لنا فألحقه بنظرائه من أهل البلاء في قوله تعالى: (وَاذْكُرْ عِبادنا إبْراهيمَ وَإِسْحق وَيعْقُوبَ) ص: 45 وهم أهل الابتلاء الذين باهى بهم الأنبياء وجعل من ذرياتهم الأصفياء فأضاف أيوب إليهم في حسن الثناء، وفي لفظ التذكرة به في الثناء ثم قال: (إذْ نادى رَبَّهُ) مريم: 3 فأفرده بنفسه لنفسه وانفرد له في الخطاب بوصفه وقال: ( مَسَّنِي الْضُّرُّ وأنْتَ أرْحَمْ الْرَّاحِمين) الأنبياء: 83 فوصفه بمواجهة التملق له ولطيف المناجاة وظهر له بوصفه الرحمة فاستراح إليه به فناداه فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه، مقام موسى ويونس عليهما السلام في قولهما: سبحانك تبت إليك، وفي قول الآخر: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا خطاب المشاهدة ونظر المواجهة، ثم وصفه بالاستحابة له وأهله لكشف الضرّ عنه وجعل كلامه سبباً لتنفيذ قدرته ومكاناً لمجاري حكمته ومفتاحاً لفتح إجابته، ثم قال بعد ذلك كله: ووهبنا له أهله فزاد على سليمان في الوصف إذ كان بين من وهب لأهله وبين من وهب له أهله فضل في المدح لأنه قال في وصف سليمان: ووهبنا لداود سليمان فأشبه فضل أيوب في ذلك على سليمان كفضل موسى على هارون لأنه قال عزّ وجلّ في مدح موسى عليه السلام وتفضيله على هارون: (وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أخاهُ هارُونَ نَبيّاً) مريم: 53، وكذلك قال في مدح داود: (وَوَهَبْنا لِدَاوُدَ سُلَيْمانَ) ص: 30 فوهب لموسى أخاه كما وهب لداود ابنه وأشبه مقام أيوب في المباهاة والتذكرة به مقام داود عليه السلام لأنه قال تعالى في وصف داود لنبيّه عليه السلام: (اصْبِرْعلى ما يَقُولُونَ واذْكُرْ عَبْدنا دَاوُد) ص: 17 وكذلك قال تعالى في نعت أيوب: (واذْكْرْ عَبْدنا أَيُّوبَ إذْ نادى ربَّهُ) ص: 41، فقد شبه أيوب بداود وموسى عليهما السلام في المعنى ورفعه إليهما في المقام، وهما في نفوسنا أفضل من سليمان عليهم السلام، فأشبه أن يكون حال أيوب على من حال سليمان، وعلم الله تعالى المقدم ولكن هكذا ألقى في قلوبنا والله أعلم، ثم قال تعالى بعذ ذلك كلّ (رَحْمَةً مِنَّا) ص: 43 فذكر رنفسه ووصفه عند عبده تشريفاً له وتعظيماً، ثم قال عزّ وجلّ: (وَذِكْرى لأُولي الألْبابِ) ص: 43 فجعله إماماً للعقلاء وقدوة لأهل الصبر والبلاء وتذكرة وسلوة من الكروب للأصفياء، ثم قال تعالى: (إِنَّا وَجَدْناهُ صابرِاً) ص: 44 فذكر نفسه سبحانه وتعالى ذكراً ثانياً لعبده ووصل اسمه باسمه حباً له وقرباً منه، لأن النون والألف في وجدنا اسمه تبارك وتعالى، والهاء اسم عبده أيوبَ، ثم قال صابراً فوصفه بالصبر فأظهر مكانه في القوة وخلقه بخلقه، ثم قال تعالى في آخر أوصافه: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ص: 44، فهذان أوّل وصف سليمان وآخره ههنا شركه في الثناء وزاد أيوب بما تقدم من المدح والوصف الذي لا يقوم له شيء
فمن قوله عزّ وجلّ: (وَاذْكُرْ عَبْدنا أَيُّوبَ) ص: 41 إلى قوله: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) ص: 44 عظيم من الفرقان عند أهل الفهم والتبيان وجعل في أوّل وصف سليمان أنه وهبه لأبيه داود عليهما السلام فصار حسنة من حسنات داود عليه السلام واشتمل قوله تعالى: (نِعْمَ الْعَبْدُ إنَّهُ أَوَّاب) ص: 44 على أوّل وصفه وأوسطه وهو آخر وصف أيوب عليه السلام، وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام وقد روينا في الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آخر الأنبياء دخولا ً الجنة سليمان بن داود عليهما السلام لمكان ملكه، وآخر اصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان غناه، وفي لفظ آخر: يدخل سليمان بن داود الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً، وقد جاء في الآثار إن أوّل من يدخل الجنة أهل البلاء إمامهم أيوب وهو إمام أهل البلاء وإن أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد، وأوّل من يدخله أهل البلاء فقد زاد أيوب على سليمان عليهما السلام بعموم هذه الأخبار لأنه سيد أهل البلاء وتذكرة وعبرة لأولي النهي وإمام أهل الصبر والضرّ والابتلاء، ولم نقصد بما ذكرناه التفضيل بين الأنبياء لأنّا قد نهينا عن ذلك فيما روينا عن نبيّنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: لا تفضّلوا بين الأنبياء ولكن الله تعالى قد أخبرنا أن بعضهم مفضل على بعض في قوله: (وَلَقَدْ فَضَّلنا بَعْضَ الْنَّبِيَّين على بَعْضٍ) الإسراء: 55 وإنما أظهرنا فضل الثناء المستودع في الكتاب فاستنبطنا باطن الوصف المكرر في الخطاب في قصة أبوب على قصة سليمان عليهما السلام بما ظهر لنا من فهم فصل الخطاب وتدبر معاني الكلام وعلم الله تعالى المقدم وهو عزّ وجلّ أعلم وأحكم وقد ندبنا إلى الاستنباط في قول الرسول عليه السلام: اقرؤوا القرآن والتمسوا غرائبه ولأن في ذلك عزّ الأهل الصبر والبلاء وتقوية لقلوبهم وتعريفاً لسوابغ نعم الله تعالى عليهم وإظهاراً لبواطن النعم وتنبيهاً على لطائف الكلم وتزهيداً في الدنيا والنفس وترغيباً في الآخرة والصبر وتفضيلاً لطريق أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء، فجاء من ذلك تفضيل المتبلي الصابر على بلائه ورضاه بحكم مولاه وتسليماً لمرضاته على المنعم عليه، الشاكر على نعمائه، إذ النعم ملائمة للطبع موافقة للنفس لا يحتاج معها إلى كدّ النفس بالصبر عليها ولا حملها على المشقة فيها بالرضا بها، والبلاء مباين للطبع نافرة منه النفس يحتاج إلى حمل عليه ومشقة فيه، وما كرهته النفس فهو خير وأفضل ولا سبيل إليه إلا بسكينة من الله تعالى وتصبر عليه بقوة به عزّ وجلّ وعناية منه: (وَاصْبِرْ وما صَبْرُكَ إلاَّ بالله) النحل: 127، وهذا آخر شرح مقامات الصبر.
شرح مقام الشكر
ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين
قال الله تعالى: (ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ) النساء: 147 فقرن الشكر بالإيمان ورفع بوجودهما العذاب، وقال تعالى: (وَسَنجْزِي الشَّاكِرينَ) آل عمران: 145، وروي عن النبي لله أنه قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الشكر نصف الإيمان، وقد أمر الله تعالى بالشكر وقرنه بالذكر في قوله تعالى: (فاذْكُروني أذْكُرْكُمْ واشْكُروا لي ولا تَكْفُرُونِ) البقرة: 152، قد عظم الذكر بقوله: (ولذِكْر الله أَكْبَر) فصار الشكر أكبر لاقترانه به ورضا الله تعالى بالشكر مجازاة من عباده لفرط كرمه لأن قوله تعالى: (فاذْكُروني أذْكُرْكُمْ واشْكُرو لي) البقرة: 152 خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشكر لأن الفاء للشرط ولاجزاء والكاف المتقدمة للتمثيل، فقوله تعالى: فاذكروني متصل بقوله: (كما أَرْسَلْنا فيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ) (فاذْكُرُوني) (وَاشْكُرُوا لي) البقرة: 151 - 152، والمعنى كمثل ما أرسلت فيكم رسولاً منكم فاشكروا لي، والعرب تكتفي من مثل بالكاف كما اكتفت من سوف بالسين في قوله تعالى: (سَنُؤْتيهِمْ) (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) الأعراف: 182 وهذا تفضيل للشكر عظيم لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى.
وقد روينا في أخبار أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: إني رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي في كلام طويل، وفي أحد الوجوه من قوله عزّ وجلّ: (لأقْعُدَنَّ لَهُم صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ) الأعراف: 16، قال: طريق الشكر، فلولا أن الشكر طريق يوصل إلى الله تعالى لما عوّل العدو على قطعه ولولا أن الشاكر حبيب ربّ العالمين ما نقصه إبليس اللعين في قوله تعالى: (ولا تَجِدُ أكْثَرَهُمْ شاكِرينَ) الأعراف: 17 وكذلك قال الله تعالى: (وقليلٌ مِنْ عِبادي الشَّكُورُ) سبأ: 13، كما قال تعالى: (ولقدْ صَدَّق عَلَيْهِمْ إبليسُ ظنَّهُ فاتَّبَعُوهُ إلاَّ فريقاً من المؤْمِنينَ) سبأ: 20، وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فيه واستثنى في خمسة أشياء: في الإغناء، والإجابة، والرزق، والمغفرة، والتوبة، فقال تعالى: (فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إنْ شاءَ) التوبة: 28 وقال تعالى: (فيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إليهِ إنْ شاء) الأنعام: 41، وقال تعالى: (يَرْزُقُ مَنْ يشاءُ) البقرة: 212 (وَيغْفِرُ لِمَنْ يشاءُ) المائدة: 40، وقال عزّ وجلّ: (ثُمّ َ يَتُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذلك على منْ يشاءُ) التوبة: 27، وختم بالمزيد عند الشكر من غير استثناء فقال تعالى: (لئِنْ شَكَرْتُمْ لأزيدِنَّكُمْ) إبراهيم: 7، فالشاكر على مزيد والشكور في نهاية المزيد وهو الذي يكثر شكره على القليل من العطاء ويتكرر منه الشكر والثناء على الشيء الواحد من النعم وهذا خلق من أخلاق الربوبية لأنه سماه باسم من أسمائه والمزيد هو إلى المنعم يجعله ما شاء، فأفضل المزيد حسن اليقين ومشاهدة الأوصاف، وأوّل المزيد شهود النعم، إنها من المنعم بها من غير حول ولا قوّة إلا به عزّ وجلّ، وأوسط المزيد دوام الحال ومتابعة الخدمة والاستعمال، وقد يكون المزيد أخلاقاً وقد يكون علوماً وقد يكون في الآخرة وتثبيتاً عند فراق العاجلة، وقد جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الجنة وختام تمنّيهم في قوله تعالى: (الْحَمْدُ لله الَّذي صَدَقنا وَعْدَهُ) الزمر: 74، وقال تعالى: (وآخِرُ دَعْواهُمْ أنِ الْحَمْدُ لله ربِّ الْعالمينَ) يونس: 10، فلولا أنه أحب الأعمال إليه ما بقاه عليهم لديه.
وروينا في مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه في صفة الصابرين دارهم دار السلام إذا دخلوها ألهمتهم الشكر وهو خير الكلام وعند الشكر أستزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم وهذا غاية الفضل، فأوّل الشكر معرفة النعم، إنها من المولى وحده لا شريك له فيها، ولا ظهير له عليها، إذ قد نفى ذلك عن نفسه لأنه هو الأوّل في كل شيء، لا شيء معه ولا ظهير له في شيء إذ قد جعل الضرّاء والسرّاء منه وإليه جاريين على عباده فقال تعالى: (وَما لَهُمْ فيهما مِنْ شِركِ وما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهيرٍ) سبأ: 22، الشرك الخلط والظهير المعين، ثم قال تعالى (وما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ثُمَّ إذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإليْهِ تَجْئرَوُنَ) النحل: 53، وقال تعالى: (وإنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فلا كاشِفَ لَهُ إلاّ هُوَ وإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُو على كُلِّ شيء قديرٌ) الأنعام: 17، وقال تعالى في جمل النّعم بعد إضافتها إليه: (وَسخَّر لَكُمْ ما في السَّمَواتِ وما في الأرْضِ جَميعاً مِنْهُ) الجاثية: 13، وقال تعالى: (وأسْبغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وباطِنَةً) لقمان: 20، فالأسباب مع صحتها والأواسط مع ثبوتها إنما هي حكمه وأحكامه، فظروف العطاء وآثار المعطي لا تؤثر في الحكم بها والجعل لها حكماً ولاجعلاً يعني لا تحكم ولا تجعل لأنها محكومات فكيف تحكم ومجعولات فكيف تجعل لا حاكم إلا الله وحده ولا يشرك في حكمه أحداً وهذا الحرف في مقرأ أهل الشام أبلغ وأوكد لأنه يخرج على الأمر لأنهم قرؤوه بالتاء وجزم الكاف ولا تشرك في حكمه أحداً، فالأسباب أحكام حق وأواسط حكمه فمشاهدة المنعم في النعمة وظهور المعطي عند العطاء حتى ترى النعمة منه والعطاء عنه هو شكر القلب لأن الشكر عند الشاكرين معرفة القلب ووصفة لا وصف اللسان، وقد أخبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك وأمر باقتناء الشكر وإتخاذه مالاً في الآخرة عوضاًمن إاقتناء الأموال في الدنيا، فقال في حديث ثوبان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حين نزل في الكنوز ما نزل سأله عمر: أيّ المال نتخذ؟ فقال: ليتخذنَّ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً.
وروينا في أخبار موسى عليه السلام وداود عليه السلام: يا ربّ كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك، وفي لفظ آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب علي الشكر لك فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتني، وفي خبر آخر: إذا عرفت أن النعم مني فقد رضيت منك بذلك شكراً وشكر اللسان حسن الثناء على الله تعالى وكثرة الحمد والمدح له وإظهار إنعامه وإكرامه ونشر أياديه وإحسانه وأن لا يشكو لمالك إلى المملوك ولا المعبود الجليل إلى العبد الذليل، وفي الخبر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: كيف أصبحت قال: بخير فأعاد عليه النبي السلام السؤال ثانية كيف أنت؟ فقال: بخير فأعاد عليه الثالثة كيف أنت؟ فقال: بخير أحمد الله تعالى وأشكره، فقال: هذا الذي أردت منك يعني إظهار الحمد والشكر والثناء، وإنما كان السلف يتساءلون عن أحوالهم إذا التقوا ليستخرجوا بذلك حمداً لله تعالى وشكره فيكونوا شركاءه في ذلك لأنهم سبب ذكره لله تعالى فمن علمت أنه يشكو مولاه ويتكره عندك قضاءه إذا سألته عن حاله فلا تسأله فتكون أنت سبب شكواه وشريكه في جهله، وما أقبح بالعبد أن يشكو المولى الذي ليس كمثله شيء والذي بيده ملكوت كل شيء إلى عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومن الشكر أن يشكر الله تعالى على اليسير لأن القليل من الحبيب كثير ولأن الله تعالى حكيم فمنعه حكمة وقدرة، فإذا عرف وجه الحكمة في المنع مع القدرة على العطاء علم أنه منعه ليعطيه فثم صار المنع عطاء واليسير منه كثيرا، ً ويعلم أن الذل والصبر عند المنع عزّ وشرف، وهو أفضل وأنفس عند العلماء من التعزز بالعبيد والشرف بهم، وأن الطمع والتذلل إليهم والاستشراف إلى عبد مملوك مثلك ذلّ ذليل وحسن الذلّ للعزيز كحسن الذلّ للحبيب وقبح الذلّ للذليل كقبح الذلّ للعدو.
وقد قال الله تعالى: (إنَّ الَّذين تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فابْتغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ واعْبُدُوهُ) العنكبوت: 17، وقال تعالى في معناه: (إنَّ الَّذين تَدْعُون مِن دُونِ الله عِبادٌ أمْثَالُكُمْ) الأعراف: 194، والعبادة هي الخدمة والطاعة بذلّ ولا يحسن للعبد المقبل أن يظهر فقره وفاقته إ لى غير مولاه الذي يلي تدبيره ويتولاه لأنه عليم خبير بحاله يسمعه ويراه فهو أعلم بما يصلحه منه، وقد قال الله تعالى في معناه: (ولوْ بَسَطَ الله الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا في الأرْضِ) الشورى: 27، فعلى الموقن أن يشكر في القبض والمنع كما يشكر في العطاء والبسط ثم يشهد الشاكر بقلبه شهادة يقين ويعلم أن وصفه وصف العبودية وحكمه أحكام العبيد محكوم عليه بأحكام الربوبية وأنه لا يستحق على الله شيئاً وأن الله عزّ وجلّ يستحقّ عليه كلّ شيء فالعبد خلقه وصنعته والرب صانعه ومالكه، فإذا شهد العبد هذه الشهادة رأى لله عزّ وجلّ عليه كل شيء فرضي منه بأدنى شيء ولم ير له على الله تعالى شيئاً فلم يقنع لله تعالى منه بشيء ولم يطالب مولاه بشيء، فكثرة الذكر وحسن الثناء وجميل النشر للنعماء وتعديد النعم والآلاء هو شكر اللسان لأن معنى الشكر في اللغة هو الكشف والإظهار يقال: كثر وشكر بمعنى إذا كشف عن ثغره فأظهره فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما ذكرناه كما جاء في الخبر ليس شيء من الأذكار يضاعف ما يضاعف الحمد.
وفي الحديث: من قال سبحان الله فله عشر حسنات، ومن قال: لا إله إلا الله فله عشرون حسنة، ومن قال: الحمد لله كتبت له ثلاثون حسنة ليس أن الحمد أعلى من التوحيد ولكن لفضل مقام الشاكر ولأن الله تعالى افتتح به كلامه في كتابه، وفي الخبر: الحمد رداء الرحمن عزّ وجل، ّ وفي الخبر أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، ويكون أيضاً ظهور الشكر وغلبته في القلب شكر القلب، ويكون شكر الله تعالى لعبده كشفه له ما ستره عنه وإظهاره له ما حجبه منه من العلوم والقدر وهو المزيد فيفيده ذلك حسن معرفته به سبحانه وتعالى وعلوّ مشاهدته منه وكله يرجع إلى معنى الكشف والإظهار، وأما شكر الجوارح للمنعم المفضل سبحانه وتعالى فهو أن لا يعصيه بنعمة من نعمه وأن يستعين بنعمته على طاعته ولا يستعين بها على معاصيه فيكون قد كفرها كما قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْراً) إبراهيم: 28، قيل: استعانوا بنعمه علي معاصيه فالخلق لا يقدرون على تبديل نعمة الله عزّ وجلّ ولكن معناه: بدلوا شكر نعمة الله كفراً وهذا من المضمر معناه لظهور دليله عليه لأنه أمرهم بالطاعة بالنعم فخالفوه فعصوه بها فكان ذلك تبديلهم لما أمروا، ومثله قوله تعالى: (وَتَجْعَلونَ رِزْقَكُمْ أنَّكُمْ تُكذِّبُونَ) الواقعة: 82 المعنى شكر رزقكم تجعلونه تكذيبكم برسل الله تعالى وهذا من المحذوف أيضاً وهي في قراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مظهرة مفسّرة.
روينا عنه عليه السلام: أنه قرأ وتجعلون شكركم فهذا ظاهر وبمعناه: ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب أي يعاقب من كفر بالنعمة فضيّع شكرها بمعصيته بها يعاقبه بزوالها، وكذلك قوله تعالى: (وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إنَّ عَذابي لَشديدٌ) إبراهيم: 7، قيل: إن كفرتم النعمة فقد يكون العذاب في الدنيا تبديل النعمة عقوبات وتغييرها هوان ومذلاّت، وقد يكون العذاب مؤجلاً كقوله تعالى: (إنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) الفرقان: 65، قال: طالبهم على النعم بالشكر فلم يكن عندهم فأغرمهم ثمن النعمة فحبسهم في جهنم، وقد قال الله تعالى: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعِمَهُ ظاهِرَةً وباطِنَةً) لقمان: 20، ثم قال: (وَذَرُوا ظاهِرَ الإثْمِ وباطِنهُ) الأنعام: 120 ففيه تنبيه لذوي الألباب الذين وصل لهم القول ليتذكروا أن يذروا ظاهر الإثم شكر الظاهر النعم، ويذروا باطن الإثم شكر الباطن النعم وظاهر النعم عوافي الأجساد ووجود الكفايات من الأموال وظاهر الإثم أعمال الجوارح من معاني حظوظ النفس وباطن النعم معافاة القلوب وسلامة العقود، وباطن الإثم أعمال القلوب السيئة مثل الإصرار وسوء الظن ونيّات السوء، وقال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحبّ إلي ّ من أبتلى فأصبر، لأن مقام العوافي أقرب إلى السلامة، فلذلك اختار حال الشكر على الصبر لأن الصبر حال أهل البلاء.
وقد روينا عن الحسن البصري معنى ذلك الخبر الذي لا شرّ فيه العافية مع الشكر والصبر عند المصيبة فكم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلى غير صابر، وقد روينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معنى هذا في قوله: وعافيتك أحبّ إلي، ّ وقال لعلي رضي الله عنه حين سمعه يثول في مرضه: اللهم إني أسألك الصبر، قال: لقد سألت الله تعالى البلاء فسله العافية، ومن الشكر الأعمال الصالحة، وبالعمل فسرّ الله تعالى ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشكر للمنعم فقال تعالى: (اعْملُوا آل داوُد شُكْراً) سبأ: 13، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لما عوتب في اجتهاده وقيامه حتى تورمت قدماه: أفلا أكون عبداً شكوراً، فأخبر أن المجاهدة وحسن المعاملة شكر المستعمل وجزاء المنعم، وقد قال بعض العلماء: شكر القلب المعرفة بأن بالنعم من المنعم لا غير وشكر العمل كلما وهب الله عزّ وجلّ لك عملاً أحدثت له عملاً ثانياً شكراً منك للعمل الأوّل، وعلى هذا يتصل الشكر بدوام المعاملة، وأوّل الشكر عند العارفين أن لا تعصيه بنعمة من نعمه فتجعلها في طاعة الهوى، فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكلّ نعمة فتجعلها في سبيل المولى وهذا شكر جملة العبد، وحقيقة الشكر التقوى وهو اسم يستوعب جمل العبادة التي أمر الله تعالى بها عباده في قوله تعالى: (يا أيُّها النَّاسُ أعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلقَكُمْ وَالَّذين من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 21، ثم عبّر حقيقة عن الشكر بتقواه وأخبر سبحانه وتعالى أن التقوى هو الشكر فقال سبحانه وتعالى: (فَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون) آل عمران: 123، وفي الشكر مقامان عن مشاهدتين: أعلاهما مقام شكور وهو الذي يشكر على المكاره والبلاء والشدائد واللأواء، ولا يكون كذلك حتى يشهد ذلك نعماً توجب عليه الشكر بصدق يقينه وحقيقة زهده وهذا مقام في الرضا وحال من المحبة، وبهذا الوصف ذكر الله تعالى نبيّه نوحاً عليه السلام في قوله تعالى: (إنَهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) الإسراء: 3 في التفسير أنه كان يشكر الله تعالى على كل حال من خير أو شر أو نفع أو ضرّ.
وروينا في الخبر: ينادي منادٍ يوم القيامة ليقم الحمادون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل: ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله تعالى على كل حال، وفي لفظ آخر: على السرّاء والضرّاء، وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى: (وَأسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنةً) لقمان: 20، قال: ظاهرة العوافي والغنى وباطنه البلوى والفقر فهذه نعم الآخرة، كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا عيش إلا عيش الآخرة، والمقام الثاني من الشكر أن ينظر العبد إلى من هو دونه ممّن فضل هو عليه في أمور الدنيا وأحوال الدين فيعظّم نعمة الله تعالى عليه بسلامة قلبه ودينه وعافيته مما أبتلى الآخر به ويعظّم نعمة الدنيا عليه لما آتاه الله تعالى وكفاه فيما أحوج الآخر وألجأه إليه فيشكر على ذلك ثم ينظر إلى من هو فوقه في الدين ممن فضل عليها بعلم الإيمان وبحسن يقين فيمقت نفسه ويزري عليه وينافس في مثل ما رأى من أحوال من هو فوقه ويرغب فيها، فإذا كان كذلك كان من الشاكرين ودخل تحت اسم الممدوحين.
وقد روينا معنى ذلك في حديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه قال من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابراً شاكراً ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه ونظر في الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابراً ولا شاكرا، ً وقد شرحنا هذا في مقام الرضا، فكرهنا إعادته ههنا، وكل وصف يكون العبد شاكراً به، يكون الشكر مقاماً له فيه، فإن كفر النعمة يلزمه بضده لأن الكفر ضد الشكر، ومن كبائر النعم ثلاث من جهلها أضاع الشكر عليها ومعرفتها شكر العارفين، أولها استتار الله تعالى بقدرته وعزته عن الأبصار ولو ظهر للعباد لكانت معاصيهم كفراً لأنهم لم يكونوا ينقصون من المعاصي المكتوبة عليهم جناح بعوضة ولأنه تبارك وتعالى كان يظهر بوصف لا يمتنعون معه عن المعاصي، ووراء هذا سرائر الغيوب، إلا أنهم كانوا يكفرون بالمواجهة لانتهاك حرمة المشاهدة أيضاً لما كان لهم في الإيمان به من عظيم الدرجات ما لهم الآن لأنهم حينئذ يؤمنون بالشهادة وهم اليوم يؤمنون بالغيب، فرفعت لهم الدرجات بحسن اليقين، ولذلك مدحهم الله تعالى ووصفهم، والنعمة الثانية إخفاء القدر والآيات عن عموم الخلق لأنها من سر الغيب، وصلاح العبيد، واستقامة الدنيا والدين، ولو ظهرت لهم لكانت خطاياهم الصغائر كبائر مع معاينة الآيات، ولما ضوعفت لهم على أعمالهم الحسنات كمضاعفتها الآن للإيمان بالغيب، والنعمة الثالثة تغيّب الآجال عنهم إذ لو علموا بها لما كانوا يزدادون ولا ينقصون من أعمالهم الخير والشرّ ذرّة، فكان مع علمهم بالأجل أشد مطالبة لهم وأوقع للحجة عليهم فأخفى ذلك عنهم معذرة لهم من حيث لا يعلمون، ولطفاً بهم ونظراً لهم من حيث لا يحتسبون، ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم فيحجب بعضهم من بعض، وسترهم عند العلماء والصالحين، ولولا ذلك لما نظروا إليهم، ثم حجب الصالحين والأولياء عنهم، ولو أظهر عليهم آيات يعرفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين من ولاية الله تعالى لهم وقربهم منه لبطل ثواب المحسنين إليهم ولحرم قبول عملهم ولحبطت أعمال المسيئين إليهم، ففي حجب ذلك وستره ما علم العاملون لهم في الخير والشرّ على الرجاء وحسن الظن بالغيب من وراء حجاب اليقين، وتأخرت عقوبات المؤذيين لهم عن المعاجلة لما ستر عليهم من عظيم شأنهم عند الله تعالى وجليل قدرهم، ففي ستر هذا نعم عظيمة على الصالحين في نفوسهم من سلامة دينهم وقلة فتنتهم ونعم جليلة عن المنتهكين لحرمتهم، المصغرين لشعائر الله تعالى من أجلهم، إذ كانوا أساءوا إليهم من وراء حجاب، فهذا هو لطف خفيّ من لطف المنعم الوهّاب سبحانه وتعالى، كما جاء في الخبر: يقول الله عزّ وجلّ: من آذى وليّاً من أوليائي فقد بارزني بالمحاربة، ثم أنا الثائر لوليّ لا أكلّ نصرته إلى غيري.
وعن جعفر الصادق رضي الله عنه في معنى هذه النعم التي أوجبنا الشكر في إخفائها قال: إن الله تعالى خبأ ثلاثاً في ثلاث، رضاه في طاعته، فلا تحتقروا منها شيئاً لعلّ رضاه فيه، وخبأ غضبه في معاصيه، فلا تحتقروا منها شيئاً لعلّ غضبه فيه، وخبأ ولايته في عباده المؤمنين، فلا تحتقروا منهم أحداً لعلّه وليّ الله تعالى، ويكون مثل ذلك مثل من آذى نبيّاً وهو لا يعلم بنبوّته وإن الله تعالى نبأه قبل أن يخبره أنه نبيّ الله عزّ وجلّ ورسوه إليه فلا يكون وزره وزر من انتهك حرمة نبي قد أعلمه أنه نبيّ الله تعالى لعظيم حرمة النبوّة، وللشاكرين طريقان: أحدهما أعلى من الآخر أوّلهما شكر الراجين وهو حسن المعاملة لما أملوه ورجوه من ظواهر النعم فعملوا رجاء إتمامها فكان حالهم المسارعة والمسابقة إلى الأعمال الصالحة شكراً لما ابتدأهم به وخصّهم دون سائر خلقه، وأعلاهما شكر الخائفين وهو خوف سوء الخاتمة والإشفاق من درك الشقاء بحكم السابقة نعوذ بالله تعالى منه فكان خوفهم دليلاً على اغتباطهم بموهبة الإيمان، وكان اغتباطهم يدل على عظيم قدر الإسلام في قلوبهم ونفيس مكانه عندهم فعظمت النعمة به عليهم فمعرفتهم بذلك هو شكرهم فصارالخوف والإشفاق طريقاً لهم في الشكر للرازق.
وقد جعل الله تعالى ذلك نعمة وكل نعمة تقتضي شكراً في قوله تبارك وتعالى: (قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذينَ يَخَافُونَ أنْعم اللهُ عَلَيْهِما) المائدة: 23 قال بعض المفسرين: أنعم الله عليهما بالخوف وهذا أحد وجهي الكلام ولو لم يشكر العبد مولاه إلا أنه تبارك وتعالى على هذه الأوصاف والأخلاق التي هي صفاته وأخلاقه من نهاية الكرم والجود الذي لا غاية له ومن غاية التفضّل والحلم الذي لا نهاية له، فلما كان تبارك وتعالى بهذه الأخلاق المرجوّة والصفات الحسنى وجب أن يشكره العبيد لأجله تعالى لا لأجل نعمه وأفعاله؛ وهذا ذكر المحبين إذ لو كان الله تعالى على غير هذه الصفات والأخلاق التي عرفه بها العارفون ولا بدّ لهم منه أي شيء كان يصنع العباد وأي حيلة كانت لهم فله الحمد كله وله الشكر كله كما هو مستحقه وأهله بحمده لنفسه، ولا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى، كما ينبغي لكرم وجهه وعزّ جلاله إذ كان ولم يزل على ما هو الآن ولايزال أبداً على ما كان من الأوصاف والنعوت التامات والأسماء الحسنى والأمثال العلى، ومعرفة هذا هو شكر العارفين ومشاهدته هو مقام المقربين فشكر هؤلاء للّّه تعالى لأجل الله تعالى ودعاء هؤلاء التحميد والتقديس وأعمالهم الإجلال والتعظيم للأجل وسؤالهم تجلّي الصفات والنصيب من مشاهدة معاني الذات ووصف هذا لا يوصف وشرحه بالمعقول لا يعرف، وهذا داخل في مشاهدة قوله لمن شهد سر الكلام إذ يقول عزّ وجلّ: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ) الشورى: 11 وعن هذه المشاهدة اغتبط موسى عليه السلام بالربوبية وأنس بالتقريب فانبسط بالتمكين فقال لي: ما ليس لك فقال: الله تعالى وما هو، فقال لي: مثلك وليس لك مثل نفسك فقال عزّ وجلّ: صدقت، يعني لي أنت على هذه الأوصاف التي هي غاية الطالبين ولا مزيد عليها للراغبين وليس لك كأنت إذ ليس كمثلك شيء وأن لا إله إلا أنت، فمن غامض النعم الشكر على هذه المعاني ما روي عنك وصرفه من فضول الدنيا فإنه أقل للشغل والإهتمام وأيسر للحساب، ثم ابتلي به غيرك من الدنيا مما شغله به عنه وقطعه دونه، ففي صرف الدنيا عنك وابتلاء غيرك بها نعمتان عليهما شكران وكذلك إذا رأيت مبتلي في دينه بصفات المنافقين أو مبتلي بنفسه بأخلاق المتكبرين أومنهما فيما عليه من أفعال الفاسقين عددت جميع ذلك نعماً من الله تعالى عليك إذ لم يجعلك كذلك لأنك قد كنت أنت ذاك لولا فضل الله عليك ورحمته فتحسب كل ما وجه إلى غيرك من الشرّ أو صرفه عنك من الخيران تعده نعماً عليك بمثل ما وجه إلىك من الخير وصرف عنك من الشرّ لأن النفوس كنفس واحدة في الأمر بالسوء والمشيئة والقدرة واحدة فقد رحمك بما صرف عنك من السوء فذلك من فضل الله تعالى عليك فمعرفته بذلك شكر منك لله تعالى وأكثر عقوبات الخلق من قلة الشكر على النعم وأصل قلة الشكر الجهل بالنعمة، وسبب الجهل بالنعمة قصور العلم بالله تعالى وطول الغفلة عن المنعم وترك التفكر في نعمه والتذكر لآلائه، ومنه سبحانه وتعالى فقد أمر بذلك في قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ) الأعراف: 69 قيل: نعمه.
وقال المفسرون: واذكروا نعمة الله عيكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وبمعناه قوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكبِّرُوا الله على مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون) البقرة: 185، يعني على نعمة الهداية وتوفيق الطاعة فإذا جهل العبد النعمة لم يعرفها، وإذا لم يعرفها لم يشكر عليها وإذا لم يشكر عليها انقطع مزيده، ومن انقطع عنه المزيد فهو في نقصان ما أدّعى وأيضاً فإن من لم يشكر النعم لجهله بها لم يؤمن عليه كفرها، فإن كفرها أدركه العذاب الشديد للوعيد إلا أن تداركه نعمة من ربه وأصول نعم المرافق للأحراث أربعة؛ أوّلها: النطفة التي أخرجت من خزانة الأرحام جميع البهائم والأنام، ثم الحرث الذي أخرج من خزانة الأرض جميع الثمر، ثم الماء الذي لنا منه شراب ومنه شجر، ثم النار التي فيها ضياء ومصالح الأطعمة وبها لأهل البصائر تذكرة، وهذه النّعم هي التي ذكرها المنعم في آخر سورة الواقعة وأضافها إلى نفسه عزّ وجلّ ولم يجعل فيه شريكاً معه وفتح للعباد العمال أبوابها.
ومن أفضل النّعم وأجلّها نعمة الإيمان به سبحانه وتعالى، ثم نعمة الرسول، ثم نعمة القرآن، ثم أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وقبل ذلك أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر المعدومات، ثم جعلنا حيواناً دون سائر الموات، ثم جعلنا بشر دون سائرالحيوان ثم جعلنا ذكوراً دون الإناث، ثم صوّرنا في أحسن تقويم ثم عوافي القلوب من الزيغ عن السنة ومن الميل إلى دواعي النفس الأمّارة، ثم صحة الأجسام ثم كشف الستر، ثم حسن الكفاية لحاجة، ثم صنوف ما أظهر من الأزواج للأقوات، ثم تسخير الصنعة لنا ممّا بين السماء والأرض؛ فهذه أمهات النعم فكلّما كثرت هذه المعاني وحسنت كثر الشكر عليهما فعظيم النّعم بها، (وإنْ تَعدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لاتُحْصُوهَا) إبراهيم: 34 وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خصّ بمعرفة النّعم وبمعرفة عظيم حلم الله تعالى وستره الصديقون.
وقد قال الله تعالى أصدق القائلين وأحسن الواصفين: (وَإنْ تَعُدُّوا نِعْمَة الله لا تُحْصُوها إنَّ الله لَغَفُورٌ رَحيمٌ) إبراهيم: 34، فتمّت النعمة بوصفيه اللذين هو لهما أهل من المغفرة والرحمة ثم قال أيضاً في مثله: (إنَّ الإنّسانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ) إبراهيم: 34 فكان أعظم للنعمة وأوسع في الكرم والمنّة على وصفي الإنسان اللذين هو أهل لهما من الظلم والكفر، فهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة والعبد أهل لما وصفه به مولاه عزّ وجلّ إلى أن يجود عليه بقديم ما به تولاه فبنعمته أطاعه العاملون، ومن نعمته جازاهم وبنعمته عصاه الجاهلون، ومن نعمته ستر وحلم عنهم، ومن النعم إظهار الجميل وستر القبيح فلا ندري أي النعمتين أعظم جميل ما أظهر أو قبيح ما ستر، وقد يمدح الله تعالى بالوصفين معاً في الدعاء المأثور: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ومن النعمة الصحة والفراغ هما أوّل نعيم الدنيا وأصول أعمال الآخرة وبهما تكون المغابنات كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، وقال الفضيل بن عياض: عليكم بمداومة الشكر على النّعم فقلّ نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم، وقال بعض السلف: النّعم وحشية فقيدوها بالشكر، وقد روي في خبر: ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلاّ كثرت حوائج الناس إليه، فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال.
وقد قال الله تعالى: (إنَّ الله لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْم حتّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهمْ) الرعد: 11 قيل: لا يغير نعمه عليهم حتى يغيّروها بتضييع الشكر فيعاقبهم بالتغيير والوجه الآخر لا يغير ما بهم من عقوبة حتى يغيّروا معاصيهم بالتوبة، فذكر بذلك السبب الأوّل من حكمه ثم ذكر السبب الثاني من حكمته وهو مسبّب الأسباب للحكمة والمشيئة ويقال: إن تحت كل شعرة من جسم العبد نعمة، وبكل عرق في جسده نعمتان في تسكينه وتحريكه، وفي كل عظم أربع نعم، وبكل مفصل سبع نعم، وفي جسم الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، ومثل ذلك من العظام، وفي كل طرفة نعمتان، وبكل نفس نعمتان، وفي كل دقيقة تأتي عليه من عمره نعم لا تحصى، والدقيقة جزء من اثني عشر جزءاً من شعيرة، والشعيرة جزء من اثني عشر جزءاً من ساعة، والأنفاس أربعة وعشرون ألف نفس في اليوم والليلة، وفي أخبار موسى عليه السلام: ياربّ كيف أشكرك ولك في كل شعرة من جسدي نعمتان إن لينت أصلها وإن طمنت رأسها.
وقد روينا في الأثر: من لم يعرف نعم اللّّه تعالى عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قلّ علمه وحضر عذابه؛ هذا مع سوابغ العوافي والكفايات والوقايات، ويقال: إن في باطن الجسم من النّعم سبعة أضعاف النّعم التي في ظاهره، وإن في القلب من النّعم أضعاف ما في الجسم كلّه من النّعم، وإن نعم الإيمان بالله تعالى والعلم واليقين أضعاف نعم الأجسام والقلوب؛ فهذه كلّها نعم مضاعفة على نعم مترادفة لا يحصيها إلا من أنعم بها ولا يعلمها إلا من خلقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سوى نعم المطعم والمشرب والملبس والمنكح من دخول ذلك وخروجه وكثرة تكرره وتزايده بأن أدخل مهناه وأخرج أذاه وبأن طيب مدخله ويسرّ مخرجه وبقى منفعته وما أحال من صورته وغيّر من صفته فللتزهيد والذلة والاعتبار والتذكرة؛ وتلك أيضا نعم، قال: يقال إن الرغيف لا يستدير حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صنعة من السماء والأرض وما بينهما من الأجسام والأعراض والأفلاك والرياح والليل والنهار وبني آدم وصنائعهم والبهائم ومعادن الأرض، أوّلها ميكائيل الذي يكيل الماء من الخزائن فيفرغه على السحاب ثم السحاب التي تحمله فيرسله ثم الرياح التي تحمل السحاب والرعد والبرق والملكان اللذان يسوقان السحاب وآخرها الخباز فإذا استدار رغيفاً طلب سبعة آلاف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع؛ فهذه كلها نعم في حضور رغيف فكيف بمازاد عليه مما وراءه، فعلى العبد بكلّ نعمة شكران طولب بشكرنعمة واحدة علي حقيقتها هلك إلا أن تغمّده رحمة من ربه فتغمره لتمام النعمة.
وروينا أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال: هل تدري ماتمام النعمة؟ قال: لا، قال: دخول الجنة وقيل لبعض الحكماء: ما النعيم؟ قال: الغني فإني رأيت الفقير لا عيش له، قيل: زدنا، قال العافية فإني رأيت السقيم لا عيش له قيل: زدنا قال: الأمن فإني رأيت الخائف لا عيش له، قيل: زدنا، قال: الشباب فإني رأيت الهرم لا عيش له، قيل: زدنا، قال: لا أجد مزيداً، وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه في قوله تعالى: (أَذْهَبْتُمْ طَيِبَّاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا) الأحقاف: 20 قيل: الشباب وقيل: الفراغ وقيل الأمن والصحة، وفي قوله تعالى: (وَعَصيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّونَ) آل عمران: 152 قيل: العوافي والغنى، وبمعناه في قوله تعالى: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) لقمان: 20 قيل: ظاهرة العوافي وباطنة البلاوي لأنه سبب نعيم الآخرة ومزيدها لقوله تعالى: (وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُس والثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابرينَ) البقرة: 155، وقد جاء في الخبر: من أصبح معافى في بدنه آمناً في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وأنشدت في معناه لبعض أهل القناعة:
إذا القوت تأتي لك ... والصحة والأمن
وأصبحت أخا حزن ... فلا فارقك الحزن
وأنشد الآخر:
كن وفلقة خبز ... وكوز ماء وأمن
ألذ من كل عيش ... يحويه سحب وسجن
وحدثونا أن عابداً عبد الله تعالى سبعين عاماً، فأرسل الله تعالى إليه ملكاً يبشّره بدخول الجنة برحمة الله تعالى، فهجس في نفسه بل بعملي فاطلع الله تعالى على ذلك منه فأوحى إلى عرق ساكن من عروقه أن تحرك عليه، قال: فاضطرب لذلك وقلق وانقطعت عبادته وذهبت أعماله شغلاً منه بنفسه وقلق بنفسه، ثم أوحى الله تعالى إلى العرق أن اسكن فسكن، فرجع العبد إلى عبادته فأوحى الله تعالى إليه إنما قيمة عبادتك عرق واحد سكن من عروقك فاعترف.
وروينا معناه عن رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوصف آخر أن رجلاً عبد الله سبعين عاماً قال: فيأمر الله عزّ وجلّ به إلى الجنة برحمته فيقول: بل بعملي فيقول الله عزّ وجلّ: أدخلوا عبدي الجنة بعمله قال: فيمكث في الجنة سبعين عاماً فيأمر الله تعالى به أن يخرج، ويقال له: قد استوفيت ثواب عملك قال: فيسقط في يديه ويندم فينظر أقوى شيء كان في نفسه بينه وبين ربه فإذا هوالرجاء وحسن الظن فيقول: ياربّ اتركني في الجنة برحمتك لا بعملي قال: فيقول اللّّه عزّ وجلّ: دعوا عبدي في جنتي برحمتي، وحدثت عن رجل شكا إلى بعض أهل المدينة فقره وأ ظهر لذلك غمه فقال له الرجل: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف؟ قال: لا، قال: فيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف قال: لا، قال: فيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرة آلاف، قال: لا، قال: فيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف؟ قال: لا، قال: أفما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً وهذا كما قال لأن في الإنسان قيم هذه الأشياء من الجوارح وزيادة من المال لأنها ديات جوارحه لو قطعت.
وحدثني بعض الشيوخ في معناه أن بعض القراء المقربين اشتد به الفقر حتى أحزنه وضاق به ذرعاً، قال: فرأى في المنام كأن قائلاً يقول له تود أنا أنسيناك سورة الإنعام وأن لك ألف دينار؟ قال: لا، قال: فسورة هود؟ قال: لا، قال: فسورة يوسف، قال: لا، قال: فمعك قيم مائة ألف وأنت تشكو الفقر فأصبح وقد سرى عنه همه، وهكذا جاء في الخبر: تغنوا بالقرآن أي استغنوا به ومن لم يستغن بآيات الله تعالى فلا أغناه الله عزّ وجلّ وإن القرآن هو الغنى الذي لا فقر معه ولا غنى بعده، ومن آتاه الله القرآن فظن أن أحداً أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله تعالى، وفي لفظ آخر: فقد استخف بما أنزل الله عزّ وجلّ، وفي الخبر: من لم يتغنَّ بالقرآن فليس منا، وفي الخبر المجمل كفى باليقين غنى والقرآن هو حق اليقين.
وروينا عن بعض السلف يقول الله عزّ وجلّ: إن عبداً أغنيته عن ثلاث فقد أتممت عليه نعمتي عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه.
وروينا في مناجاة أيوب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليه: ما من عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكر على نعمائي قال الملكان: اللهم زده نعماً على نعمه، فإنك أهل الشكر والحمد فكن من الشاكرين قريباً وزدهم شكراً وزدهم من النعماء وكفى بالشاكرين ياأيوب علوّ الرتبة عندي وعند ملائكتي، فأنا أشكر شكرهم وملائكتي تدعو لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكي عليهم فكن لي ياأيوب شاكراً ولآلائي ذاكراً ولا تذكرني حتى أذكرك ولا تشكرني حتى أشكر أعمالك أنا أوفق أوليائي لصالح الأعمال وأشكرهم على ما وفقتهم وأقتضيهم الشكر ورضيت به مكافأة فرضيت بالقليل عن الكثير وتقبّلت القليل وجازيت عليه بالجزيل وشرّ العبيد عندي من لم يشكرني إلا في وقت حاجته، ولم يتضرّع بين يديَّ إلا في وقت عقوبته وذكر الكلام وقد جعل الله تعالى الشاكرين بوصف الصالحين والمقربين والعالمين؛ وهذه الأوصاف الثلاث من أعالي مقامات الموقنين، فقال عزّ وجلّ: وقليل من عبادي الشكور كما قال الله تعالى: (إلاّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَّالِحَاتِ وَقَليلٌ مَا هُمْ) ص: 24 وكما قال في وصف المقربين: (ثُلَّةٌ مِنَ الأوّلينَ) (وٍَقَليلٌ مِنَ الآخِرينَ) الواقعة: 13 - 14 وكما قال عزّ وجلّ: (مَا يَعْلمُهُمْ إلاّ قليلٌ) الكهف: 22
وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سلوا الله العافية وما أعطى عبد أفضل من العافية إلا اليقين ففضل العافية على كلّ عطاء ورفع اليقين، فوق العافية لأن بالعافية يتمّ نعيم الدنيا واليقين معه وجود نعيم الآخرة؛ فلليقين فضل على العافية كفضل الدوام على الانتقال، والعافية سلامة الأبدان من الأسقام والعلل واليقين سلامة الأديان من الزيغ والأهواء: فهاتان نعمتان تستوعبان عظيم الشكر من العبد كما استوعب القلب والجسم جسيم النّعم من الملك، ومن أقوى المعاني في قوله تعالى: (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُون) (إِلاّ منّ أَتى اللّّه بِقَلْبِ سَليمٍ) الشعراء: 88 - 89 قيل: سالم من الشك والشرك والسالم الصحيح المعافى وبوجود عافية اليقين في القلوب عدم الشك والنفاق وهي أمراض القلوب، كما قال تعالى: (في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) البقرة: 10 قيل: شك ونفاق وعافية القلب أيضاً من الكبائر كما قال تعالى: (فَيَطْمَعَ الّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ) الأحزاب: 32 يعني الرياء، ويقال: ما من مصيبة إلا ولله تعالى فيها خمس نعم؛ أوّلها: أنها لم تكن في الدين ويقال كل مصيبة في غير الدين فهي طريق من الدين، والثانية: إنها لم تكن أكبر منها، والثالثة: أنها كانت مكتوبة عليه لا محالة فقد نفدت واستراح منها، والرابعة: إنها عجّلت في الدنيا ولم تؤجل في الآخرة فتعظم على مقدار عذاب الآخرة، والخامسة: أن ثوابها خير منها فإن المصيبة إذا كانت في أمر الدنيا فإنها طريق إلى الآخرة وعندنا في قوله تعالى: (إنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار) إبراهيم: 34 قيل: ظلوم بالتسخط كفّار بالمعاصي وبالنعم، وحدثت أن العباس رضي الله عنه لما توفي قعد ابنه عبد الله رضي الله عنه للتعزية فدخل الناس أفواجاً يعزونه فكان فيمن دخل أعرابي فأنشده:
اصبر نكن بك صابرين فإنما ... صبر الرعية بعد صبر الراس
خير من العباس أجرك بعده ... والله خير منك للعباس
فقال ابن عباس: ماعزّاني أحد تعزية الأعرابي واستحسن ذلك، وفي قوله تعالى: (إنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) العاديات: 6 قيل: هو الذي يشكو المصائب وينسى النعم، ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم بحذائها وزيادة قلت شكواه وبدّلها شكراً، ثم إن المصائب لا تخلو من ثلاثة أقسام كلها نعم من الله تعالى، إما أن تكون درجة وهذا للمقرّبين والمحسنين، واما أن تكون كفّارة، وهذا لخصوص أصحاب اليمين وللأبرار، أو تكون هذا عقوبة وهذا للكافة من المسلمين، فتعجيل العقوبة في الدنيا رحمة ونعمة ومعرفة هذه النعم طريق الشاكرين، ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة الإيمان ثم دوامه، لأن دوام الشيء نعمة ثانية لأنه بحكم ثانٍ عن مشيئة ثانية لأن الإرادة منه تعالى بحكم الإظهار لا توجب دوام المظهر فكان الشيء يظهر بإرادته ثم يتلاشى كأن لم يكن إلا أن يحكم سبحانه وتعالى حكماً ثانياً بنعمة ثانية بالثبات والدوام إذ لو لم يرد دوام السموات والأرض ما داما ولو لم يرد دوام ثبات الجبال ما ثبتت، كذلك لو لم يرد دوام الإيمان وثباته في القلوب بعد الكتب لظهر بالكتب ثم انمحى ورجع القلب إلى الكفر لكنه أنعم نعماً لا تحصى بدوامه وثباته في القلب، ومنه قوله تعالى: (يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُ) الرعد: 39 أي يمحو ما لايشاء ثبوته ويثبت ما يحبّ ولا يستطيع العبد شكر نعمة الإيمان ومعرفة بداية التفضّل به وقديم الإحسان من غير قدم من العبد ولا استحقاق بل بفضل الله وبرحمته، وهذا أحد الوجوه في قوله تعالى: (كلا لَمَّا يَقضِ مَا أَمَرَهُ) عبس: 23 أي لا يقضي العبد أبداً شكر ما أمره الله تعالى من نعمة الإسلام الي هي أصول النّعم في الدنيا والآخرة وهي سبب النجاة من النار ومفتاح دخول الجنة ولا أوّل للعبد فيها ولاشفيع كان له إلى الله تعالى بها ثم دوام ذلك وثباته مع الطرف والأنفاس بمدد منه نعم مترادفة.
ومن هذا قوله تعالى: (كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمَان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ) المجادلة: 22 أي قواهم بمدد يثبته ويقوّيه وهو معنى قوله تعالى: (يُثَبَّتُ الله الَّذين آمَنُوا بالقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيَاةِ الدُّنْيَا وفي الآخِرَةِ) إبراهيم: 27 ومن ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يامقلب القلوب أي عن الإيمان ومقلبها في الشك والشرك ثبّت قلبي على طاعتك، ومعرفة هذه النعمة اللطيفة العظيمة تستخرج من القلب خوف سوء الخاتمة لمشاهدة سرعة تقليب القلب بالمشيئة وذلك مزيد شكرها وهذا داخل في معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحبوا الله تعالى لما أسدى إليكم من نعمه ولما يغذوكم به أيضاً، فمن أفضل ما غذانا به نعمة الإيمان له والمعرفة به وغذاؤه لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه وتثبيتنا عليه في تصريف الأحوال إذ هو أصل الأعمال التي هي مكان النوال، فلو قلب قلوبنا عن التوحيد كما يقلب جوارحنا في الذنوب، ولو قلب قلوبنا في الشك والضلال كما يقلب نيّاتنا في الأعمال أي شيء كنّا نصنع وعلى أي شيء كنّا نعوّل وبأي شيء كنّا نطمئن ونرجو؛ فهذا من كبائر النعم ومعرفته هو من شكر نعمة الإيمان والجهلُ بهذا غفلة عن نعمة الإيمان يوجب العقوبة وادعاء الإيمان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوّة وحول هو كفر نعمة الإيمان وأخاف على من توهم ذلك أن يسلب الإيمان لأنه بدل شكر نعمة الله كفراً.
وقد جعل الله تعالى الخيرات من كسب الإيمان وليس لنا فيما يكسبنا الخيرات مكان بل الله تعالى منّ علينا أن هدانا للإيمان وجعله سبباً يكسب لنا بإحسانه الإحسان كما قال تعالى: (أَوْ كَسَبَتْ في إيمَانِهَا خَيْرَاً) الأنعام: 158 قيل التوبة، وقيل: الصالحات كلها كسب الإيمان ومن النّعم بعد الإيمان توفيقنا للحسنى وتيسيرنا لليسرى، ثم صرف الكفر وأخلاق الكفرة وأعمالهم ثم تزيين الإيمان وتحبيبه إلينا وتكريه الفسوق والعصيان فضلاً منه ونعمة إلى ما لا يحصى من نعمه فشكر ذلك لايقام به إلا بما وهب أيضاً وأنعم به من المعرفة بذلك والمعونة عليه، والحياء من تتابع النّعم هو من الشكر والمعرفة بالتقصير عن الشكر شكر، والاعتذار من قلة الشكر شكر، والمعرفة بعظيم الحلم وكثيف الستر شكر، والاعتراف بما أعطى من حسن الثناء وجميل النشر أنه من النّعم من غير استحقاق من العبد بل هو مضاف إلى نعمه بل هو من الشكر، وحسن التواضع بالنّعم والتذلّل فيها شكر، وشكر الخلق بالدعاء لهم وحسن الثناء عليهم لأنهم ظروف العطاء وأسباب المعطى تخلّقاً بأخلاق المولى جلّ وعلا هو من الشكر، وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقّي النّعم بحسن القبول وتكثير تصغيرها وتعظيم حقيرها من الشكر، لأن طائفة هلكت باستصغار الأشياء واستحقار وجود المنافع بها جهلاً بحكمة الله تعالى واستصغار النعمة فكان ذلك كفراً بالنّعم، ومن الناس من يقول إن الصبر أفضل من الشكر وليس يمكن التفضيل بينهما عند أهل التحصيل من قبل أن الشكر مقام لجملة من المؤمنين والترجيح بين جماعة على جماعة لا يصحّ من قبل تفاوتهم في اليقين في المشاهدات لأن بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين لفضل معرفته وحسن صبره، وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين لحسن يقينه وعلوّ مشاهدته، ولكن تفضيل ذلك من طريق الأحوال والمقامات أنا نقول: والله أعلم أن الصبر عن النعيم أفضل لأن فيه الزهد والخوف؛ وهما أعلى المقامات وأن الشكر على المكاره أفضل لأن فيه البلاء والرضا، وأن الصبر على الشدائد والضرّاء أفضل من الشكر على النّعم والسرّاء من قبل أنه أشقّ على النفس وأن الصبر مع حال الغنى والمقدرة أن يعصي بذلك أفضل من الشكر على النّعم من قبل أن الصبر عن المعاصي بالنّعم أفضل من الطاعة بها لمن جاهد نفسه فيها، فإذا شكر على ما يصبر عليه فقد صار البلاء عنده نعمة، وهذا أفضل لأنها مشاهدة المقربين، وإذا صبر عمّا يشكر عليه من النّعم كان أفضل لأنها حال المجاهدة.
وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل يعني الأقرب شبهاً بنا فالأقرب، فرفع أهل البلاء إليه ووصف نفسه به وجعلهم الأمثل فالأمثل منه فمن كان برسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمثل كان هو الأفضل، وقد كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شاكراً على شدة بلائه كذلك الشاكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البلاء إذ هو الأقرب والأمثل بالأنبياء، وكلّ مقام من مقامات المقرّبين يحتاج إلى صبر وشكر، وأحدهما لا يتمّ إلا بالآخر لأن الصبر يحتاج إلى شكر عليه ليكمل، والشكر يحتاج إلى صبر عليه ليستوجب المزيد، وقد قرن الله تعالى بينهما ووصف المؤمنين بهما فقال: (إنَّ فِي ذَلِكَ لأيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) لقمان: 31 فذكرالشكر بلفظ المبالغة في الوصف على وزن فعول، كما ذكرالصبر على وزن فعّال وهو وصف المبالغة أيضاً، ولذلك اقتسما الإيمان نصفين، كما جاء في الخبر: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله؛ لأن اليقين أصلهما وهما ثمرتاه عنه يوجدان لأن الشاكر أيقن بالنعمة أنها من المنعم وأيقن بإنجاز ما وعده من المزيد فشكر كما أيقن الصابر بمسّه بالبلاء لأنه هو المبتلي وأيقن بثواب المبلي وحسن ثنائه على الصابرين فصبر فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم؛ فهما حالا الموقن إذ لا يخلو في أدنى وقت من أحد اثنين؛ بليّة وتحية، إذ في كل شيء له آية فحاله في البليّة الصبر، وحاله في التحية الشكر، والله يحب الصابرين ويحب الشاكر وهذا آخر شرح مقام الشكر والحمد لله ربّ العالمين.
شرح مقام الرجاء
ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين
قال الله تعالى: (الله لَطيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ) الشورى: 19 وقال: جلت قدرته: (وَكَاَنَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) الأحزاب: 43 وقال تعالى: (يَاعِبَاديَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفسهمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله يَغْفِرُ الّذُنُوبَ جَميعاً) الزمر: 53 وروينا في قراءة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ولا يبالي أنه هو الغفور الرحيم، وفي الأخبار لمشهورة فقبض قبضة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي المعنى والله أعلم أن رحمتي وسعت كل شيء فليس يضيق هولاء عنها ولا أبالي بدخولهم فيها، ويكون هؤلاء أيضاً في الجنة، ولا أبالي بأعمالهم السيئة كلها، وقال سبحانه وتعالى في وصف المتقين: (وَالَّذينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةً أوْ ظَلَمُوا أنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله) آل عمران: 135 فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال عزّ وجلّ في وصف المتوكلين: (إلا اللَّمَمَ إِنَّ ربَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَة) النجم: 32 وقال تعالى مخبراً عن الملائكة الحافين حول عرشه: (وَالْملائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَّهِمْ وَيَستَغٌفِرون لمَنْ في الأرض) الشورى: 5 وأخبر عزّ وجلّ أن النار أعدها لأعدائه وأنه خوّف بها أولياءه، فقال تعالى: (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ ظُلَل مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذلِكَ يُخوِّفُ الله بهِ عِبَادَهُ) الزمر: 16 ومثله قول عزّ وجلّ: (واتَّقُوا النار الَّتي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ) آل عمران: 131 وقال: (فَأنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى) الليل: 14 لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال تعالى في عفوه عن الظالمين (وَإنَّ رَبَّك لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) الرعد: 6
ورينا أن النبي عليه السلام لم يزل يسأل في أمته حتى قيل له: أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية: (وَإنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للنَّاس عَلى ظُلْمِهِمْ) آل عمران: 135 وفي تفسير قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) الضحى: 5 قال: لا يرضى محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يدخل واحد من أمته النار، وكان أبوجعفر محمد بن علي رضي الله عنه يقول: أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب اللّّه تعالى قوله تعالى: (يَاعِبَادي الَّذين أَسْرَفُوا على أَنْفُسهِمْ لاتَقْنطُوا مِنْ رَحْمةِ الله) الزمر: 53 الآية، ونحن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى: (وَلَسَوْف يُعْطِيكَ رَبُّك فَتَرْضَى) الضحى: 5 وعده ربه عزّ وجلّ أن يرضيه في أمته، وروينا في حديث أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة جعل عقابها في الدنيا الزلازل والفتن فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتي رجلاً من أهل الكتاب فيقال هذا فداؤك من النار، وروينا في لفظ آخر: يأتي كلّ رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصراني إلى جهنم فيقول: هذا فدائي من النار فيلقي فيها، وفي الخبر: إن الحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمنين من النار، وروينا في تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ لايُخْزِي اللهُ الْنَّبيَّ والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ) التحريم: 8، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تريد أن أجعل حساب أمتك إليك؟ فقال: لا ياربّ أنت خير لهم مني، قال: إذاً لا نخزيك فيهم، وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي لأني أعلم أن الله تبارك وتعالى أرحم بي منهما.
وروينا في خبر سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل ربه تعالى في ذنوب أمته فقال: ياربّ اجعل حسابهم إلي لئلا يطلع على مساوئهم غيري فأوحى الله تعالى إلىه: هم أمتك وهم عبادي وأنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى غيري كيلا تنظر في مساوئهم أنت ولا غيرك، وقد روينا عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه قال حياتي خير لكم وموتي خيرلكم، أما حياتي فإني أبين لكم السنن وأشرع الشرائع، وأما موتي فأعمالكم تعرض عليّ فما رأيت منها حسناً حمدت الله عزّ وجلّ وما رأيت منها شيئاً استغفرت الله عزّ وجلّ لكم.
وروينا في الأثر: إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عزّ وجلّ ملائكته وبقاع الأرض معاصيه وبدلها حسنات حتى يرد القيامة وليس شيء يشهد عليه، وكذلك يقال: إن المؤمن إذا عصاه ستره الله تعالى عن أبصار الملائكة كيلا تراه فتشهد عليه، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم: ياكريم العفو، فقال له جبريل عليه السلام: تدري ما تفسير يا كريم العفو هو أنه عفا عن السيئات برحمته ثم بدلها حسنات بكرمه، وسمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: لا، قال: دخول الجنة، وقد أخبرنا الله تعالى أنه قد أتمّ نعمته علينا برضاه الإسلام لنا؛ فهذا دليل على دخول الجنة، فقال عزّ وجلّ: (اليْوَمَ أَكمْلتُ لَكُمْ دينَكمُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً) المائدة: 3 وقد اشتركنا في ذلك مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنحن نرجو المغفرة لذنوبنا بفضله، فقال عزّ من قائل: (ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتمّ نعمته عليك) ، وفي خبر علي رضي الله عنه: من أذنب ذنباً فستره الله تعالى عليه في الدنيا، فالله تبارك وتعالى أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة، ومن أذنب ذنباً فعوقب عليه في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة، وفي لفظ آخر: لا يذنب عبد في الدنيا فيستره الله تعالى عليه إلا غفر له في الآخرة.
وعن بعض السلف: كل عاصٍ فإنه يعصي تحت كنف الرحمن، والكنف من الإنسان حضنه ما بين يديه وصدره، قال: فمن ألقى عليه كنفه ستر عورته ومن رفع عنه كنفه افتضح، ويقال: إن من فضح في الدنيا بذنب فهو كفّارته ولا يفضح به في الآخرة.
وفي الخبر: إذا أذنب العبد فاستغفر الله، يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا إلى عبد أذنب ذنباً فعلم أن له ربَّاً يغفرالذنب فيأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، وحدثت عن محمد بن مصعب قال: كتب إلى أسود بن سالم بخطّه: إن العبد إذا كان مسرفاً على نفسه؛ يرفع يديه يدعو يقول: ياربّ فإذا قال ياربّ، حجبت الملائكة صوته، فإذا قال الثانية ياربّ، حجبت الملائكة صوته، فإذا قال الثالثة يا ربّ حجبت الملائكة صوته، فإذا قال الرابعة يقول الله تعالى حتى متى تحجبوا صوت عبدي عني، قد علم عبدي أنه ليس له ربّ يغفر الذنوب غيري، أشهدكم أني قد غفرت له، وفي الحديث إذا أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها له ما استغفرني ورجاني.
وفي حديث آخر: لو لقيني عبدي بقراب الأرض ذنوباً، لقيته بقرابها مغفرة ما لم يشرك بي شيئاً، وفي الخبر: إن الملك ليرفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة، وفي لفظ آخر: فإذا كتبها عليه وعمل حسنة، قال صاحب الشمال وهو أمير عليه: ألق هذه السيئة حتى ألقي من حسناته واحدة من تضعيف العشرة وأرفع تسع حسنات فيلقي عنه هذه السيئة ويقال: إن الله تعالى جعل في قلب صاحب اليمين من الرحمة للعبد أضعاف ما جعل في قلب صاحب الشمال مع أنه أمره عليه، فإذا عمل العبد حسنة فرح بها ملك اليمين، ويقال: فرح بها الملائكة فيكتب للعبد بفرحه الحسنات.
وروينا في حديث أنس بن مالك الطويل: إذا أذنب العبد ذنباً كتب عليه، فقال الأعرابي: فإن تاب؟ محي من صحيفته، قال: فإن عاد؟ قال رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكتب عليه، قال الأعرابي: فإن تاب؟ قال محي من صحيفته، قال: إلى متى يارسول الله؟ قال: إلى أن يستغفر: ويتوب إلى الله تعالى، وأن الله لا يملّ من المغفرة حتى يملّ العبد من الاستغفار، فإذا هم العبد بحسنة كتبها صاحب اليمين حسنة قبل أن يعملها فإذا عملها كتبها عشر حسنات ثم ضاعفها الله عزّ وجلّ إلى سبعمائة ضعف، وإذا همّ بخطيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت خطيئة واحدة وراءها حسن عفوالله تعالى: وجاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه ولاأصلي إلا الخمس لا أزيد عليهنّ وليس للّّه تبارك وتعالى في مالي صدقة ولاحجّ ولا أتطوع أين أنا إذا مت؟ فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في الجنة، قال: يا رسول الله معك فتبسم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال نعم معي إن حفظت قلبك من اثنين الغل والحسد ولسانك من اثنين: الغيبة والكذب، وعينك من اثنين: النظر إلى ما حرم الله تعالى وإن تزدري بهما مسلماً دخلت معي الجنة على راحتي هاتين.
وروينا في الخبر الطويل عن أنس رضي الله عنه: أن الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ قال: الله عزّ وجلّ قال: هو بنفسه؟ قال: نعم، قال: فتبسم الأعرابي فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ممّ ضحكت ياأعرابي؟ فقال: إن الكريم إذا قدر عفا وروي تجاوز، وإذا حاسب سامح، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صدق ألا ولا كريم أكرم من الّه عزّ وجلّ هو أكرم الأكرمين، ثم قال عليه السلام: فقه الأعرابي، وفيه أيضاً: إن الله تبارك وتعالى شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بوليّ من أولياء الله تعالى، قال الأعربي من أولياء الله؟ قال: المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى، أما سمعت الله تعالى يقول: (الله وَلِيُّ الَّذين آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ) البقرة: 257، وفي الخبر المفرد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المؤمن أفضل من الكعبة، والمؤمن طيب طاهر والمؤمن أكرم على الله تعالى من الملائكة، وفي الخبر المشهورعن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما وكعب الأحبار أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أشرفك وما أعظمك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتطهير بيته لأوليائه إجلالاِ لهم فشرّف البيت بهم، وفي الخبر عن الله تعالى: من أهان وليّاً فقد بارزني بالمحاربة وأنا الثائر لوليي في الدنيا والآخرة، وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إلىه: تدري لم فرقت بينك وبين يوسف عليه السلام هذه المدة؟ قال: لا قال: لقولك لإخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لم خفت الذئب عليه ولم ترجني له، ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له، ومن سبق عنايتي بك أن جعلت نفسي عندك أرحم الراحمين، فرجوتني ولولا ذلك لكنت أجعل نفسي عندك أبخل الباخلين، فالرجاء هو اسم لقوّة الطمع في الشيء بمنزلة الخوف اسم لقوّة الحذر من الشيء، ولذلك أقام الله تعالى الطمع مقام الرجاء في التسمية وأقام الحذر مقام الخوف فقال: علت كلمته: (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال تعالى: (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) وهو وصف من أوصاف المؤمنين وخلق من أخلاق الإيمان لا يصحّ إلا به كما لا يصحّ الإيمان إلا بالخوف، فالرجاء بمنزلة أحد جناحي الطير لايطير إلا بجناحيه، كذلك لا يؤمن من لا يرجو من آمن به ويخافه وهو أيضاً مقام من حسن الظن بالله تعالى وجميل التأميل له، فلذلك أوصى رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: لا يموتن أحدكم إلاوهو حسن الظن بالله تعالى لأنه قال عن الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي ماشاء، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله تعالى ماأحسن عبد بالله تعالى ظنّه إلا أعطاه الله تعالى ذلك لأن الخير كله بيده أي فإذا أعطاه حسن الظن بالله تعالى فقد أعطاه ما يظنه لأن الذي حسن ظنه به هو الذي أراد أن يحققه له.
وروينا عن يوسف بن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ) البقرة: 195 قال: أي أحسنوا بالله تعالى الظنّ، وكذلك دخل رسول الله على الرجل وهو في سياق الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي، فقال عليه السلام: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما رجا وأمنه مما يخاف، ولذلك قال عليٌّ كرّم اللهُ وجهه للرجل الذي أطار الخوف عقله حتى أخرجه إلى القنوط فقال له: يا هذا أيأسك من رحمة اللهّّ تعالى أعظم من ذنبك؟ صدق رضي الله عنه لأن الإياس من روح الله تعالي الذي يستريح إليه المكروب من الذنوب والقنوط من رحمة الله تعالى التي يرجوها المبتلي بالذنوب أعظم من ذنوبه وهو أشد من جميع ذنوبه لأنه قطع بهواه على صفات الله تعالى المرجوّة وحكم على كرم وجهه بصفته المذمومة فكان ذلك من أكبر الكبائر وإن كانت ذنوبه كبائر.
وهكذا جاء في التفسير: ولاتلقوا بأيدكم إلى التهلكة قال: هو العبد يذنب الكبائر ويلقى بيده ولا يتوب ويقول: قد هلكت لا ينفعني عمل فنهوا عن ذلك إلا أن الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل لا يصلح إلا للكرماء من أهل العلم، والحياء وهو حال يحول عليهم بعد مقام الخوف، يروحون به من الكرب ويستريحون إلىه من مقارفة الذنب، ومن لم يعرف الخوف لم يعرف الرجاء، ومن لم يقم في مقام الخوف لم يرفع إلى مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء، كل عبد من حيث خوفه ومكاشفته عن أخلاق مرجوة من معنى ما كان كوشف به من صفات مخوفة، فإن كان أقيم مقام المخوفات من المخلوقات مثل الذنوب والعبوب والأسباب، رفع من حيث تلك المقامات إلى مقامات الرجاء، بتحقيق الوعد وغفران الذنب وتشويق الجنان وما فيها من الأوصاف الحسان؛ وهذه مواجهات أصحاب اليمين وإن كان أقيم مقام مخاوف الصفات عن مشاهدة معاني الذات مثل سابق العلم وسوء الخاتمة وخفي المكر وباطن الاستدارج وبطش القدرة وحكم الكبر والجبروت، رفع من هذه المقامات إلى مقام المحبة والرضا، فرجا من معاني الأخلاق وأسماء الكرم والإحسان والفضل والعطف واللطف والإمتنان، وليس يصحّ أن نخبر بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء في مقامات الرجاء من قبل أنه لا يصلح لعموم المؤمنين، وهو يفسد من لم يرزقه أشد الفساد فليس يصلح إلا بخصوصة ولا يجديه ولا يستجيب له ولا يستخرج إلا من المحبة ولا محبة إلا بعد نصح القلب من الخوف، وأكثر النفوس لا يصلح إلاعلى الخوف، كعبيد السوء لا يستقيمون إلا بالسوط والعصا ثم يواجهون بالسيوف صلتاً، ومن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطناً في رجائه لأنه لما تحقق برجاء شيء خاف فوته لعظم المرجوّ في قلبه وشدة اغتباطه به، فهو لا ينفك في حال رجائه من خوف فوت الرجاء؛ والرجاء هو ترويحات الخائفين، ولذلك سمّت العرب الرجاء خوفاً لأنهما وصفان لا ينفك أحدهماعن الآخر، ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان لازماً لشيء أو وصفاً له أو سبباً منه، أن يعبّروا عنه به فقالوا: مالك لا ترجو كذا وهم يريدون ما لك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى: (مَا لَكُْم لا تَرْجُونَ للهِ وَقَاراً) نوح: 13 أجمعوا على تفسيره: مالكم لا تخافون لله عظمة، وهو أيضاً أحد وجهي تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ) الكهف: 110 أي يخاف من لقائه ومثل الخوف من الرجاء، مثل اليوم من الليلة لما لم ينفك أحدهما عن الآخر جاز أن يعبر عن المدة بأحدهما فيقال: ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ، ومنه قول الله تعالى مخبراً عن قصة واحدة فقال عزّ وجلّ: (آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَال سَويَّاً) مريم: 10
ثم قال تعالى: (ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزاً) آل عمران: 41 فلما لم يكن اليوم ينفك عن ليلته والليلة لا تنفك عن يومها أخبر عن أحدهما بالآخر لأن أحدهما يشبه الآخر مندرج فيه، ولا يظهر إلا أحدهما بحكمة الله تعالى وقدرته لتفاوت أحكامه فيهما، وافتراق إنعامه بهما، فإذا ظهر النهار اندرج الليل فيه بقدرته تعالى، وإذا ظهر الليل استتر النهار بحكمه تعالى، وهو حقيقة إيلاجه أحدهما في الآخر، وتحقيق تكويره أحدهما على صاحبه، فكذلك حقيقة الرجاء والخوف في معاني الملكوت إذا ظهر الخوف كان العبد خائفاً، وظهرت عليه أحكام الخوف عن مشاهدة التجلي بوصف مخوف، فسمّي العبد خائفاً لغلبته عليه وبطن الرجاء في خوفه، وإذا ظهر الرجاء كان العبد راجياً وظهرت منه أحكام الرجاء عن مشاهدة تجلّي الربوبية بوصف مرجوّ فوصف العبد به لأنه هو الأغلب عليه وبطن الخوف في رجائه لأنهما وصفان للإيمان كالجناحين للطير، فالمؤمن بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه وكلسان الميزان بين كفتيه ومنه قول مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاءه لاعتدلا فهذا أصل في معرفة حقيقة الرجاء وصدق الطمع في المرجوّ، فالمؤمنين في اعتدال الخوف والرجاء مقامان؛ أعلاهما مقام المقرّبين، وهو ما حال عليهم من مقام مشاهدة الصفات المخوفة والأخلاق المرجوّة، والثاني مقام أصحاب اليمين وهو ماعرفوه من بدائع الأحكام وتفاوت الأقسام، من ذلك أنه أنعم سبحانه وتعالى على الخلق بفضله عن كرمه اختياراً لا إجباراً، فلما أعلمهم ذلك رجو تمام النعمة من حيث ابتداؤها، ومن ههنا طمع السحرة في المغفرة لما ابتدؤا بالإيمان فقالوا: إنّا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنّا أول المؤمنين، أي من حيث جعلنا أوّل المؤمنين من هذا المكان نرجو أن يغفر لنا بأن جعلنا مؤمنين به فرجوه منه، وقد ذم الله تعالى عبداً أوجده نعمة ثم سلبها فأيس من عودها عليه فقال تعالى: (وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً ثُم نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ) هود: 9 ثم استثنى عباده الصابرين عليه الصالحين له فقال تعالى: (إِلا الَّذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) هود: 11
وروي أن لقمان عليه السلام قال لابنه خف الله تعالى خوفاً لا تأمن فيه مكره، وارجه رجاء أشدّ من خوفك، قال: وكيف أستطيع ذلك وإنما لي قلب واحد؟ قال: أما علمت أن المؤمن كذي قلبين يخاف بأحدهما، ويرجو بالآخر؟ والمعنى أن الخوف والرجاء وصف الإيمان لا يخلو منهما قلب مؤمن، فصار كذي قلبين حينئذ ثم إن الخلق خلقوا على أربع طبقات، في كل طبقة طائفة فمنهم من يعيش مؤمناً ويموت مؤمناً، فمن ههنا رجاؤهم لأنفسهم ولغيرهم من المؤمنين، إذ قد أعطاهم فرجوا أن يتمّ عليهم نعمته وأن لا يسلبهم بفضله ما به بدأهم، ومن الناس من يعيش مؤمناً ويموت كافراً فهذا موضع خوفهم عليهم وعلى غيرهم لمكان علمهم بهذا الحكم ولغيب حكم الله تعالى بعلمه السابق فيهم، ومن الناس من يعيش كافراً ويموت مؤمناً، ومنهم من يعيش كافراً ويموت كافراً؛ فهذان الحكمان أوجبا رجاءهم الثاني للمشترك إذا رأوه فلم يقنطوا بظاهره أيضاً خوف هذا الرجاء خوفاً ثانياً أن يموت على تلك الحال وأن يكون ذلك هو حقيقة عند الله تعالى، فعلم المؤمن بهذه الأحكام الأربعة ورثه الخوف والرجاء معاً، فاعتدل حاله بذلك لاعتدال إيمانه به، وحكم على الخالق بالظاهر، ووكّل إلى علام الغيوب السرائر، ولم يقطع على عبد بظاهره من الشرّ، بل يرجو له ما بطن عند الله تعالى من الخير، ولم يشهد لنفسه ولا لغيره بظاهر الخير، بل يخاف أن يكون قد استسرّ عند الله تعالى باطن شرّ، إلا أن حال التمام أن يخاف العبد على نفسه ويرجو لغيره لأن ذلك هو وجد المؤمنين من قبل أنهم متعبدون بحسن الظن، فهم يحسنون الظنّ بالناس، ويخرجون لهم المعاذير بسلامة الصدور، وتسليم ما غاب إلى من إليه تصير الأمور، ثم هم في ذلك يسيئون الظنّ بنفوسهم لمعرفتهم بصفاتها، ويوقعون الملاوم عليها ولا يحتجون لها لباطن الإشفاق منهم عليهم، ولخوف التزكية منهم لهم، فمن قلب عليه هذان المعنيان فقد مكر به حتى يحسن الظن بنفسه ويسيء ظنّه بغيره، فيكون خائفاً على الناس، راجياً لنفسه، عاذراً لنفسه، محتجاً لها، لائماً للناس، ذامّاً لهم؛ فهذه أخلاق المنافقين، ثم إن للراجي حالاً من مقامه ولحاله علامة من رجائه، فمن علامة الرجاء عن مشاهدة المرحوّ، دوام المعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التقرب بالنوافل لحسن ظنّه به وجميل أمله منه، وأنه يتقبّل صالح ما أمر به تفضّلاً منه من حيث كرمه، لا من حيث الواجب عليه، ولا الاستحقاق منّا وأنه أيضاً يكفر سئ ما عمله إحساناً منه ورحمةً من حيث لطفه بنا وعطفه علينا لأخلاقه السنيّة وألطافه الخفيّة لا من حيث اللزوم له بل من حيث حسن الظنّ به، كما قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أذنب ذنباً، فعلم أن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفر الله عزّ وجلّ له ذنبه، قال: لأن الله تعالى غيّر قوماً فقال تعالى: (وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظًنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) فصلت: 23 وقد قال سبحانه وتعالى في مثله: (وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً) الفتح: 12 أي هلكى، ففي دليل خطابه عزّ وجلّ أنّ من ظنّ حسناً كان من أهل النجاة، وقد جاء في الأثر: إن من أذنب ذنباً فأحزنه ذلك غفر له ذنبه وإن لم سيغفر، ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقين منها فرض وفضل، فعلى العبد فرض أن يرجو مولاه وخالقه معبوده ورازقه، من حيث كرمه وفضله، لا من حيث نظره إلى صفات نفسه ولؤمه، وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: من سأل الله تبارك وتعالى شيئاً فنظر إلى شيء وإلى أعماله لا يرى الإجابة حتى يكون ناظراً إلى الله تبارك وتعالى وحده وإلى لطفه وكرمه، ويكون موقناً بالإجابة، ولعمري أن من سأل الله تعالى ورغب إلىه في شيء، ورجاه ناظراً إلى نفسه وعمله، فإنه غير مخلص في الرجاء له تعالى لشركه في النظر إليه، وإذا لم يكن مخلصاً لم يكن موقناً، ولا يقبل الله تعالى عملاً ولا دعاء إلا من موقن بالإجابة مخلص، فإذا شهد التوحيد ونظر إلى الوحدانية فقد أخلص وأيقن، وهكذا جاء في الخبر: إذا دعوتم فكونوا موقنين بالإجابة، فإن الله تعالى لا يقبل إلا من موقن ومن داع دعاءً بيناً من قلبه، لأن من استعمله الله تعالى بالدعاء له فقد فتح له باباً من العبادة.
وفي الخبر: الدعاء نصف العبادة ولايقبل الله تعالى من الدعاء إلا الناخلة بمعنى المنخول وهو الخالص، فأقل ما يعطيه من دعائه أن يكون ذلك حسنة منه، يضعفه له عشراً إلى سبعمائة ضعف، وأعلاه أن يدخر له في الآخرة ماهو خير له من جيمع الدنيا وما فيها مما لم يخطر على قلبه قطّ، ويكون ذلك حسن نظر من الله تعالى له واختيار، وأوسط ذلك أن يصرف عنه من البلاء الذي هو لو كان علمه كان صرفه أهمّ عليه وأحبّ إليه مما سأل فيه، وقد روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما من داع دعا موقناً بالإجابة في غير معصية ولا قطيعة رحم، إلا إعطاه الله تعالى إحدى ثلاث؛ إما أن يجيب دعوته فيما سأل، أو يصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له في الآخرة ما هو خير له، وفي أخبار موسى عليه السلام: ياربّ أي خلقك أنت عليه أشدّ تسخطاً؟ فقال تعالى: من لم يرض بقضائي، ومن يستخيرني في أمر فإذا قضيت له كره ذلك، وفي الخبر الآخر: إنه قال ياربّ أي الأشياء أحب إليك وأيها أبغض؟ فقال سبحانه وتعالى: أحب الأشياء إليّ الرضا بقضائي وأبغضها إليّ أن تطري نفسك.
وروينا عن نبيّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه قال للرجل الذي قال: أوصني فقال: لاتتهم الله تعالى في شيء قضاه عليك، وفي الخبر الآخر: أنه نظر إلى السماء وضحك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسئل عن ذلك فقال: عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن في كلّ قضائه له خير، إن قضي له بالسرّاء رضي؛ وكان خيراً له وإن قضي عليه بالضرّاء رضي به وكان خيراً له، ومن حسن الظنّ بالله تعالى لطف التملّق له سبحانه وتعالى، وهو من قوة الطمع فيه، وفي خبر: حسن الظنّ بالله عزّ وجلّ من حسن عبادة الله عزّ وجلّ، كما روينا في تفسير قوله تعالى: (فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) البقرة: 73 إن الكلمات هي قوله عليه السلام: ياربّ هذا الذنب الذي أصبته كان من قبل نفسي أو من شيء سبق في علمك قبل أن تخلقني قضيته عليّ، فقال: بل شيء سبق في علمي كتبته عليك، قال: ياربّ فكما قضيته عليّ فاغفر لي، قال: فهي الكلمات التي لقاه الله تعالى إياها.
وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: فإن لقن الله تعالى العبد حجته قال: ياربّ رجوتك وخفت الناس، قال: لقد غفرت له، وفي الخبرالمشهور: أن رجلاً كان يداين الناس فيسمح لهم ويتجاوز عن المعسر فلقي اللّّ تعالى ولم يعمل خيراً قط، فقال اللّّه تعالى سبحانه وتعالى: نحن أحقّ بذلك منك قال: فغفر له برجائه وظنه، ثم يتفاوت الراجون في فضائل الرجاء، فالمقرّبون منهم رجوا النصيب الأعلى من القرب والمجالسة والتجلّي بمعاني الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به وأصحاب اليمين من الراجين رجوا النصيب الأوفر من مزيده والفضل الأجزل من عطائه يقيناً بما وعد، ومن الرجاء: انشراح الصدر بأعمال البّر وسرعة السبق والمبادرة بها خوف فوتها ورجاء قبولها، ثم مهاجرة السوء ومجاهدة النفس رجاء انتجاز الموعور وتقرّباً إلى الرحيم الودود، ومنه قول أصدق القائلين: (إنَّ الَّذينَ آمَنُواوالَّذينَ هَاجرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ اللهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ) البقرة: 218 وفسّر رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهاجرة والمجاهدة فقال المهاجر: من هجر السوء، والمجاهد: من جاهد نفسه في الله تعالى، وأقام الصلاة التي هي خدمة المعبود، وبذل المال سرّاً وعلانيّةً وقليلاً وكثيراً، وأن لا يشتغل عن ذلك بتجارة الدنيا، كما وصف الله سبحانه وتعالى المحقّقين من الراجين إذ يقول عزّ من قائل: (إنَّ الَّذينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله وأقَامُوا الْصَّلاة وَأنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعلانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُور) فاطر: 29
ومن الرجاء القنوت في ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجّد، والدعاء عند تجافي الجنوب عن المضاجع لما وقر في القلوب من المخاوف، ولذلك وصف الله الراجين بهذا في قوله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّليْل سَاجِداً وقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لا يَعْلمُون) الزمر: 9 فسمّى أهل الرجاء والحذر وأهل التهجّد آناء الليل علماء، وحصل من دليل الكلام: أن من لم يخف ولم يرج غير عالم لنفيه المساواة بينهما، وهذا ممّا يحذف خبره اكتفاء بأحد وصفيه إذ في الكلام دليل عليه فالرجاء هو أوّل مقام من اليقين عند المقرّبين وهو ظاهر أوصاف الصدّيقين، ولايكمل في قلب عبد، ولا يتحقّق به صاحبه حتى يجتمع فيه هذه الأوصاف؛ الإيمان بالله تعالى، والمهاجرة إليه سبحانه وتعالى، والمجاهدة فيه وتلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق في سبيل الله تعالى، ثم السجود آناء الليل، والقيام والحذر مع ذلك كله؛ فهذه جملة صفات الراجين، وهو أوّل أحوال الموقنين ثم تتزايد الأعمال في ذلك ظاهراً وباطناً بالجوارح والقلوب عن تزايد الأنوار والعلوم ومكاشفات الغيوب بالأوصاف الموجودة وفصل الخطاب، إن الخوف والرجاء طريقان إلى مقامين؛ فالخوف طريق العلماء إلى مقام العلم، والرجاء طريق العمال إلى مقام العاملين، وقد وصف الله عزّ وجلّ الراجين مع الأعمال الصالحة لقوة رجائهم بالخوف، تكملة لصدق الرجاء وتتمة لعظيم الغبطة به، فقال تعالى وتقدّس: (وَالّذينَ يُؤتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) المؤمنون: 60 وقال عزّ وجلّ مخبراً عنهم في حال وفائهم وأعمال برّهم: (إنّا كُنَّا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشْفِقينَ) (فَمَنَّ اللّّه عَلَيْنَا) الطور: 26 - 27 وقال عزّ وجلّ: (يُوفُون بِالَّنذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاً) الإنسان: 7 من قبل أن الخوف مرتبط بالرجاء، فمن تحقق بالرجاء صارعه الخوف أن يقطع به دون ما رجا، وقال أهل العربية في معنى قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّام الله) (الجاثية: 14 أي للذين لايخافون عقوبات الله تعالى، فإذا كان هذا أمره بالمغفرة لمن لا يرجو فكيف يكون غفره وفضله على من يرجو، وبعضهم يقول في معنى قوله تعالى: (وَيَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ) النساء: 104 أي تخافون منه ما لا يخافون، فلولا أنهما عند العلماء كشيء واحد ما فسّر أحدهما بالآخر، ومن الرجاء الأنس بالله تعالى في الخلوات، ومن الأنس به الأنس بالعلماء والتقرّب من الأولياء، وارتفاع الوحشة بمجالسة أهل الخير، وسعة الصدر والروح عندهم، ومن الرجاء سقوط ثقل المعاونة على البّر والتقوى، لوجود حلاوة الأعمال والمسارعة إليها، والحثّ لأهلها عليها والحزن على فوتها والفرح بدركها، ومن ذلك الخبر المأثور من سرّته حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن، والخبر المأثور: خيار أمتي الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا لأن المؤمن على يقين من أمره وبصيرة من دينه، والخوف والرجاء وصف الموقن بالله تعالى فهو إذا عمل حسنة، أيقن بثوابها لصدق الوعد وكرم الموعد، وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة لها، وخاف المقت عليها لخوف الوعيد وعظمة المتوعد من قبل أن دخوله في الطاعة، دخول في محبة الله تعالى ومرضاته لما دلّ العلم عليه؛ فهذا رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فكيف لا يسرّه رضاه ومن قبل أن دخوله في المعصية دخول في غضب الله تعالى ومكارهه، بما دلّ العلم عليه فذلك الذي يسوءه لأن مقت الله تعالى اليوم معاصيه وسخطه غداً تعذيبه، ومن هذا قول الله عزّ وجلّ وهو أصدق القائلين: (يُنادَوْنَ لَمَقْتُ الله أَكبَر مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) غافر: 10 قال: لما نظروا إلى أنفسهم بتشويه خلقهم في النار مقتوها فنودوا لمقت الله في الدنيا على معاصيه أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم في العذاب، كما أن رضاه غداً تنعيمهم في جنته كذلك رضاه اليوم عملهم بطاعته ومرضاته؛ وهذا وصف عبد مراد مكاشف بعلم اليقين.
ومن هذا حديث زيد الخيل إذ قال للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جئتك أسألك عن علامة الله تعالى فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال: كيف أصبحت فقال: أصبحت أحبّ الخير وأهله وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه وإذا فاتني شيء منه حزنت عليه وحننت إليه فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذه علامة الله تعالى فيمن يريد ولو أرادك للأخرى هيأك لها، ثم لم يبال في أي أوديتها هلكت، ومن الرجاء التلذذ بدوام حسن الإقبال والتنعّم بمناجاة ذي الجلال وحسن الإصغاء إلى محادثة القريب والتلطّف في التملق للحبيب وحسن الظنّ به في العفو الجميل ومنال الفضل الجزيل، وقال بعض العارفين: للتوحيد نور وللشرك نار، ونور التوحيد أحرق لسيئات المؤمن من نار الشرك لحسنات المشرك، ولما احتضر سليمان التيمي قال لابنه: يابني حدثني بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله تعالى على حسن الظنّ به، وكذلك لما حضر سفيان الثوري رضي الله عنه الوفاة جعل العلماء حوله يرجونه، وحدثنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الموت: اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظنّ، فلولا أن الرجاء وحسن الظنّ من فواضل المقامات ما طلبه العلماء في آخر الأوقات عند فراق العمر ولقاء المولى لتكون الخاتمة به وهم يسألون الله حسن الخاتمة طول الحياة، ولذلك قيل: إن الخوف أفضل مادام حيّاً فإذا حضر الموت فالرجاء أفضل، وقد كان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول في مقامات الرجاء: إذا كان توحيد ساعة يحبط ذنوب خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة ماذا سيصنع بالذنوب؟ وقال أبو محمد سهل رضي الله عنه: لا يصبح الخوف إلا لأهل الرجاء، وقال مرّة: العلماء مقطوعون إلا الخائفين، والخائفون مقطوعون إلا الراجين، وكان يجعل الرجاء مقاماً في المحبة وهو عند العلماء أوّل مقامات المحبة، ثم يعلو في الحبّ على قدر ارتفاعه في الرجاء وحسن الظن، وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث في الرجاء لا يصلح ذكرها لعموم الناس ولكن نذكر من ذلك ما ظهر خلق الله تعالى لجهنم من فضل رحمته سوطاً يسوق الله عزّ وجلّ به عباده إلى الجنة، وخبر آخر، يقول الله تعالى: إنما خلقت الخلق ليربحوا عليّ ولم أخلقهم لأربح عليهم، وفي حديث عطاء بن يسارعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ماخلق الله تعالى شيئاً إلا جعل له ما يغلبه وجعل رحمته تغلب غضبه، والخبر المشهور: إن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي، والأخبار المشهورة عن معاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخركلامه قول: لا إله إلا الله لم تمسّه النار، ومن لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً حرمت عليه النار ولا يدخل النار من في قلبه وزن ذرة من إيمان، وقد قال في خبر آخر: لو يعلم الكافر سعة رحمة الله تعالى ما أيس من رحمته أحد وقد قال تعالى في حسن عفوه عن أكبر الكبائر بعد ظهور الآيات: (ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذلكَ) النساء: 153، وقال في خطاب لطيف لأوليائه يعرفهم نفاذ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يوصل إليه إلا به، حكيم حكم بمشيئته على عباده، ثم يغفر الذنوب جميعاً فلا يبالي كما أجرى على من فضله على العالمين، مقالة الكافرين فلم يضرّهم مع تفضيله لهم إذ قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، فقال: أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضّلكم على العالمين؛ وبهذا المعنى عارض عليّ كرّم اللّّه وجهه رأس الجالوت لما قال له: لم تلبثوا بعد نبيكم عليه السلام إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف فقال عليّ كرّم الله وجهه: أنتم لم تجفّ أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بمايفزعهم وينفرهم، وقال في حديث آخر: بشّروا ولا تنفروا ويسّروا ولا تعسّروا، ولما وعظهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً الحديث، فهبط جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: لم تقنط عبادي؟ فخرج إليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرجاهم وشوّقهم، ولما تلا الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الآية: (إنَّ زَلْزَلَة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) الحج: 1 قال: أتدرون أيّ يوم؟ هذا يوم يقال لآدم عليه السلام: قم فابعث نصيب النار من ذرتك، فقال: كم؟ قيل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى الجنة، قال: فبكوا يومهم ذلك وتركوا الأشغال والعمل، فخرج عليهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ما بالكم أنتم في الأمم مثل شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، والخبر المشهور: لو لم تذنبون لخلق الله تعالى خلقاً يذنبون ليغفر لهم، وفي لفظ آخر: لذهب بكم وجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم، إنه هو الغفور الرحيم أي أن وصفه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، فلابدّ أن يخلق مقتضى وصفه حتى يحق وصفه عليه هذا كما يقول في علم المعرفة: إن له سبحانه وتعالى من كلّ اسمٍ وصفاً ومن كل وصف فعل، وفي هذا سرّ المعرفة ومنه معرفة الخصوص، وحكي لنا معناه عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال: خلا لي الطواف ذات ليلة، وكانت ليلة مطيرة مظلمة فوقفت في الملتزم عند الباب فقلت: ياربّ اعصمني حتى لاأعصيك أبداً، فهتف بي هاتف من البيت: ياإبراهيم أنت تسألني العصمة وكل عبادي المؤمنين يطلبون ذلك، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضّل ولمن أغفر؟ وكان الحسن البصري رضي اللّّه عنه يقول: لو لم يذنب المؤمن لكان يطير طيراً ولكن الله تعالى قمعه بالذنوب.
وفي الخبر مثله: لوم لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو شرّ من الذنوب، قيل: وما هو؟ قال: العجب، ولعمري أن العجب من صفات النفس المتكبرة، وهو يحبط الأعمال، وهو من كبائر أعمال القلوب والذنوب من أخلاق النفس الشهوانية، ولأن يبتلي العبد الشهوانِي بعشر شهوات من شهوات النفس خير له من أن يبتلي بصفة من صفات النفس مثل الكبر، والعجب، والبغي، والحسد، وحبّ المدح، وطلب الذكر؛ لأن هذه منها؛ معاني صفات الربوبية، ومنها أخلاق الأباسلة، وبها هلك إبليس، وشهوات النفس من وصف الخلقة وبها عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى، وقد قال بشر بن الحرث: سكون النفس إلى المدح أضرّ عليها من العاصي، ورأى يوسف بن الحسين مخنثاً فأعرض عنه إزراء عليه، فالتفت إليه المخنث وقال: وأنت أيضاً يكفيك مابك ففزع من قوله، فقال: وأي شيء تعلم؟ قال: لأن عندك أنك خير مني، فاعترف يوسف بقوله، فتاب واستغفر وكان بعض الراجين من العارفين إذا تلا هذه الآية، آية الدين التي في سورة البقرة، يسرّ بذلك ويستبشر لها ويعظم رجاؤه عندها، فقيل له في ذلك: إنها ليس فيها رجاء ولا ما يوجب الاستبشار فقال: بلى فيها رجاء عظيم، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إن الدنيا كلّها قليل ورزق الإنسان فيها قليل من قليل وهذا الدين من رزقه قليل، ثم إن الله تبارك وتعالى احتاط في ذلك ورفق النظر لي بأن وكد ديني بالشهود والكتاب وأنزل فيه أطول آية في كتابه، ولو فاتني ذلك لم أبال به فكيف يكون فعله بي في الآخرة التي لا عوض لي من نفسي فيها.
وكذلك كان بعض الراجين يفهم من قوله تعالى إذا تلا: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونوا يَحْتَسِبُونَ) الزمر: 47 يرجو من ذلك بوادي الجود والإحسان مما لم يحسبه في الدنيا قطّ، وقد كان الجنيد رحمه الله يقول: إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين، وعلى ذلك جاء في الخبر: ليغفرنّ الله تعالى يوم القيامة مغفرة ماخطرت قطّ على قلب أحد حتى أن إبليس يتطاول رجاء أن تصيبه، وفي الخبر: إن لله تعالى تسعًا وتسعين رحمة أظهر منها في الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق فتحنّ الوالدة إلى ولدها وتعطف البهيمة على ولدها، فإذا كان يوم القيامة ضمّ هذه الرحمة إلى تلك التسعة والتسعين، ثم بسطها على جميع خلقه وكل رحمة منها طباق السموات والأرضين، قال: فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك، وقد قال بعض العلماء: إن الله تعالى إذا غفر لعبد في موقف القيامة ذنباً غفر ذلك الذنب لكل من عمله، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعملوا وأبشروا واعلموا أن أحدًا لن ينجّيه عمله.
وفي الحديث الآخر: ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجّيه من النار، قالوا: ولا أنت يارسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة وفضل، وروي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي لفظ آخرأترونها للمصفين المتقين بل هي للمخلصين المتلوّثين وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ وأبي موسى رضي اللّّه عنهما، وقد بعثهما واليين على اليمن فأوصاهما فيما أمرهما به فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفّرا، فعلم المؤمنين بكرم الله تعالي وخفيّ لطفه، ولطيف منه لا يقعدهم عن تأميله، ولا يقصر بهم عن رجاءه، ولا حسن ظنّهم به، ولا يقوى الخوف فيخرجهم إلى الأياس من رحمته، لأجل علمهم بجبريته وكبريائه، من قبل أن المهوب هو المحبوب فمحبته تؤنسهم وترجيهم، وهيبته تزعجهم وتخيفهم فخوفهم في المهابة في لذاذة ونعيمهم بالحبّ في مهابة فهم في مقام الخوف والمحبة معتدلون، وبقوّة العلم بهما متمكنون، وفي مشاهدة المخوف والمحبوب مستقيمون، وهذا المقام هو وصف العارفين من الموقنين؛ وهم أهل كمال الإيمان وصفوة خصوص ذوي الإيقان إذ قد عرفوا أن الله تبارك وتعالى كامل في صفاته لا يعتريه نقصان في وصف دون وصف وإنما الرحمة لسعة العلم، كما العلم لسعة القدرة لما شهدوا من وصفه بما سمعوا من كلامه أنه كان عليماً قديرًا.
كذلك قال تعالى: (وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلمًا) غافر: 7 وكذلك فهموا من قوله تعالى: (وَرَحْمَتي وسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) الأعراف: 156 فدخلت جهنم وغيرها في توسعة الرحمة من حيث كنّ شيئاً وقولّه عزّ وجلّ: (فسَأَكْتُبُهَا لِلَذين يَتَّقُونَ) الإسراء: 44 معناه خصوص الرحمة، وصفها لا كنهها، إذ لا نهاية للرحمة، لأنها صفة الراحم الذي لا حدّ له، ولأنه لم يخرج من رحمته شيء كما لم يخرج من حكمته وقدرته شيء، لأن جهنم والنار الكبرى وغيرهما ليس كنه عذابه ولا كلية تعذيبه، فمن ظنّ ذلك به لم يعرفه، ولأنه لما أظهر من عذابه مقدار طاقة الخلق كما أنه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصالح الخلق وما لا يصلح للخلق، ولا يطيقون إظهاره أكثر مما أظهر من النعيم والعذاب، بل لا ينبغي لهم أن يعرفوا فوق ما أبدى لأن نهاية تعذبيه وتنعيمه من نهاية ملكه الذي هو قائم به وملكه عن غاية قدرته وسلطانه، ولانهاية لذلك، ولا يطيق الخلق كلّه إظهار ذلك، وذلك أيضاً عن تعالي صفاته وبهاء أسمائه المتناهيات، ولا سبيل إلى كشف ذلك من الغيوب، فسبحان من لا نهاية لقدرته ولا حدّ لعظمته ولا أمد لسلطانه، وكذلك شهدوا ما سمعوا من قوله عزّ وجلّ: (إِنَّهُ كَانَ حَليماً غَفُورًا) الإسراء: 44، وقال: (وَكَانَ الله عَليمًا حَليمًا) الأحزاب: 51، فعلموا أن المغفرة على سعة الحلم، كما أن الحلم سعة العلم، فلما رأوا عظيم حلمه رجو عظيم مغفرته، ولما شهدوا كثيف ستره أملوا جميل عفوه، وكذلك يقال: إن حملة العرش يتجاوبون بأصوات سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، فللراجين من العارفين فهوم من السمع للكلام نحو علوّ نظرهم عن سموّ علومهم بمعاني الصفات، وكل صاحب مقام يشهد من مقامه ويسمع من حيث شهادته، فأعلاهم شهادة الصديقون، ثم الشهداء ثم الصالحون، ثم خصوص المؤمنين، فبه تبارك وتعالى استدلوا عليه، ومنه إليه نظروا، هم درجات عند الله والله بصير بمايعلمون، وكان سهل رضي الله عنه يقول: المحسن يعيش في سعة الرحمة والمسيء يعيش في سعة الحلم، وصفاته تبارك وتعالى كاملات، فمن شهد ترجيح بعضها على بعض دخل عليه النقص من مشاهدته لقصور علمه عن تمام علم من فوقه من الشهداء، ولأجل مقامه المراد به دون طريق الصدّيقين من الأقوياء، فعاد ذلك على العبد فصار ذلك مقاماً له في القرب والبعد تعالى وصف المشهود عن النقصان والحدّ، ومثل الرجاء من الخوف مثل الرخصة في الدين من العزائم، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن الله يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، وفي لفظ آخر أبلغ من هذا: وأؤكد أن الله يحب أن يقبل رخصه كما يكره أن يوتى معاصيه.
وروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق: ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى، وخيرالدين أيسره، وقال هلك المتعمّقون، هلك المتنطّعون، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحبّ أن يعلم أهل الكتاب أن في ديننا سماحة، وقال الله عزّ وجلّ: (وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَتّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف: 157، واستجاب للمؤمنين في قولهم: ربّنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، فقال عزّ وجلّ: قد فعلت؛ فهذه العلوم هي أسباب قوّة الرجاء في أولي الألباب كيف وقد جاء ما يغلب حكم الرجاء من غير اغترار ماروي عن الله تعالى أنا إلى الرحمة والعفو أقرب مني إلى العقوبة، وفي الخبر: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بما يفزعهم ويشق عليهم، وفي كلام لعلي رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم مكر الله تعالى، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود عليه السلام: ما لك وحدانيّاً؟ قال: عاديت الخلق فيك، قال: أما علمت أن محبتي أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم بالفضل هنالك، أكتبك من أوليائي وأحبابي ولا تنظر إلى عبيدي نظرة جفاء ولا قسوة، فإذا أنت قد أبطلت أجرك فاحفظ عني ثلاثًا: خالص حبيبي مخالصة، وخالف أهل الدنيا مخالفة، ودينك فقلدنيه، وعن داود وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أحبّني وأحبّ من يحبني وحببني إلى خلقي، قال: يا ربّ هذا أحبّك وأحبّ من يحبّك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ فقال عزّ وجلّ: اذكرني لحسن الجميل واذكر آلائي وإحساني وذكرهم ذلك فإنهم لايعرفون مني إلا الجميل.
وروي عن يزيد الرقاشي عن أنس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله تعالى على منابر من نور يعرفون عليها، قالوا: من هم؟ قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله تعالى ويحببون الله عزّ وجلّ إلى عباده ويمشون في الأرض نصحاء، فقلنا هذا حببوا الله إلى عباده فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحبّ الله وينهونهم عما حرم الله فإذا أطاعوهم أحبهم الله، ورؤي أبان بن عياش في النوم بعد موته، وكان من أكثر الناس حديثاً بالرخص وأبواب الرجاء فقال: أوقفني ربي عزّ وجلّ بين يديه فقال: ما حملك على أن حدثت عني بما حدثت به من الرخص؟ قال: فقلت يا ربّ أردت أن أحبّبك إلى خلقك، قال: قد غفرت لك، وحدثت عن مالك بن دينار: أنه لقي أبانا فقال: إلى كم تحدث للناس بالرخص فقال: يا أبا يحيى إني لأرجو أن ترى من عفو الله تعالى يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح.
وفي حديث ربعي بن حراش عن أخيه، وكان من خيار التابعين وهو ممّن تكلم بعد الموت، قال: لما مات أخي سجّي بثوبه وألقيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعداً وقال: إن لقيت ربي عزّ وجلّ فحياني بروح وريحان وربّ غير غضبان، وإني رأيت الأمر أيسر مما تظنون ولا تغتروا فإن محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينتظرني وأصحابه حتى أرجع إليهم قال: ثم طرح نفسه فكأنه كانت حصاة وقعت في طست فحملناه فدفناه، وقال بكر بن سليمان: دخلنا على مالك رحمه الله تعالى في العشية التي قبض فيها فقلنا كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله تعالى ما لم يكن لكم في حساب، قال: فما برحنا حتى أغمضناه ودفناه، ورؤي يحيى بن أكثم في النوم فقيل: ما فعل الله تعالى بك: فقال: أوقفني بين يديه وقال: ياشيخ السوء فعلت وفعلت قال: فأخذني من الرعب والفزع ما يعلم الله تعالى، ثم قلت ياربّ ما هكذا حدثت عنك، فقال: وما حدثت عني؟ فقلت: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن نبيّك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنك أنك قلت: تباركت وتعاليت أنا عند ظنّ عبدي بي فليظن بي ما شاء، وقد كنت أظنّ بك أن لا تعذّبني، فقال عزّ وجلّ: صدق نبييّ وصدق أنس صدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت، قال: فغلفت وخلع عليّ وألبست ومشى بين يدي الولدان إلى الجنة فقلت يا لها من فرحة.
وفي الخبر: أن رجلاً من بني إسرائيل كان يشدد على الناس ويقنطهم من رحمة الله تعالى فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها، وفي الحديث: أن رجلين تواخيا في الله تعالى من بين إسرائيل فكان أحدهما عابداً والآخر مسرفًا على نفسه، فكان هذا العابد ينهاه ويزجره فيقول له: دعني وربي أبعثت عليّ رقيباً؟ حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال: لا يغفر الله لك قال: فيقول الله تعالى له يوم القيامة: أتستطيع أن تحظر رحمتي على عبادي اذهب فقد غفرت لك، ثم قال للعابد: وأنت فقد أوجبت لك النار، قال: فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته، وروينا في معناه أن لصّاً كان يقطع الطريق أربعين سنة في بني إسرائيل فمرّ عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بني اسرائيل من الحواريين فقال للصّ في نفسه: هذا نبي الله يمرّ وإلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثًا، قال: فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه تعظيماً للحواري ويقول في نفسه: مثلي لا يمشي إلى جنب هذا العابد قال وأحس به الحواري فقال في نفسه: هذا يمشي إلى جانبي قال: فضمّ نفسه وتقدم إلى عيسى عليه السلام فمشى إلى جانبه فبقي اللصّ خلفه، قال: فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: قل لهما يستأنفان العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما، أما الحواري فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقد أحبطت سيئاته بما ازدرى على نفسه قال: فأخبرهما بذلك وضمّ اللص إلىه سياحته وجعله من حواريه.
وروينا عن مسروق بن الأجدع: إن نبيَّا من الأنبياء كان ساجدًا فوطئ بعض العتاة على عنقه حتى الزق الحصى بجبهته قال: فرفع النبي عليه السلام رأسه مغضبًا فقال: اذهب فلن يغفر الله قال: فأوحى الله تعالى إليه تتألى عليّ في عبادي أني قد غفرت له.
قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقنت يدعو علي لمشركين ويلعنهم في صلاته فنزلت ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم إلي قوله: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أوْ يُعَذِّبَهُمْ) آل عمران: 128 قال: فترك الدعاء عليهم، قال: فهدى اللّّه تعالى عامة أولئك الإسلام.
والأخبار فيما يوجب الرجاء وحسن الظن أكثر من أن تجمع ولم نقصد جمعها، وإنما دللنا بقليل على كثير، ونبهنا عقول ذوي التبصير، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّها الإنْسَانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ) الانفطار: 6 فنبه العبد مع غرته على كرمه، وذكره مع جهله حسن تسويته إياه بتعديله، يدل على نعمته.
وروينا عن الضحاك إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعالى عند العرض فيقول: عبدي أتحصي عملك؟ فيقول: إلهي كيف أحصيه من دونك وأنت الحافظ للأشياء، فيذكره اللّّه تعالى جميع ذنوبه في الدنيا في ساعاتها، فيقول: أنت عبدي فقر بما عرفتك وذكرتك، فيقول نعم سيدي، فيقول اللّّه سبحانه أنا الذي سترتها عليك في الدنيا، فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك، ولم أجعل في وجهك شينها، وأنا أغفرها لك اليوم على ما كان منك، بإيمانك بي وتصديقك المرسلين.
وروينا عن محمد الحنفية عن أبيه علي كرم الله وجهه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَميل) الحجر: 85 قال: يا جبريل وما الصفح الجميل؟ قال: يا محمد إذا عفوت عمن ظلمك فلا تعاتب، ثم قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا جبريل فالله مع كرمه تعالى أولى أن لا يعاتب من عفا عنه، قال فبكى جبريل وبكى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبعث الله عز وجل إليهما ميكائيل فقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول لكما: كيف أعاتب من عفوت عنه، هذا ما لا يشبه كرمي.
ومن الرجاء شدة الشوق إلى ما شوق إليه الكريم وسرعة التنافس في كلّ نفيس ندب إليه الرحيم، فأما الرجاء الذي هو همة جملة الناس من الإقامة في المعاصي والانهماك في الخطايا وهو يرجو المغفرة وينتظر الكرامة، فليس هذا برجاء عند العلماء، لأن الرجاء مقام من اليقين، وليس هذا وصف الموقنين؛ لأن هذا اسمه هو اغترار بالله تعالى، وغفلة عن اللّّه تعالى، وجهل بأحكام الله تعالى.
وقد تهدد الله تعالى قومًا ظنوا مثل هذا، وأصروا على حب الدنيا والرضا بها، وتمنوا المغفرة على ذلك، فسماهم خلفاً، والخلف: الرديء من الناس، وتوعدهم بشديد البأس في قوله عزّ وجلّ: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكِتابَ يَأْخُذونَ عَرَضَ هذا الأَدْنَى ويَقولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا) الأعراف: 169 والأخبار في حقيقة الرجاء تزيد المغترين اغتراراً وتزيد المستدرجين بالستر والنعيم خساراً، وهي مزيد للتوابين الصادقين، وقرة عين المحبين المخلصين، وسرور لأهل الكرم والحياء، وروح ارتياح لذوي العصمة والوفاء، ينتفع به، ويشتد عنده حياؤه، ويروح به كروبهم، وترتاح إليه عقولهم، فهؤلاء يستخرج منهم الرجاء وحسن الظن من العبادات ما لا يستروحه الخوف، إذ المخاوف تقطع عن أكثر المعاملات، فصار الرجاء طريقاً لأهله وصاروا رائجين به كما قال عمر رضي الله عنه: رحم الله صهيباً لو لم يخف الله تعالى لم يعصه: أي يترك المعاصي للرجاء لا للخوف، فصار الرجاء طريقه، فهؤلاء هم الراجون حقًا وهذه علامتهم، ولمثل هذا ذكرنا الأسباب التي توجب الرجاء، وتولد حسن الظن في قلوب أهل الصفاء.
ومن الرجاء تحسين الأخلاق مع الخلق، وجميل الصبر عليهم، وحسن الصفح، ولطيف المداراة لهم تقرباً إلى الله عزّ وجلّ بذلك، وتخلقاً بأخلاقه رجاء ثوابه، وطمعًا في تنجيز وعده، واتباعًا لسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومن الرجاء ترك الأهواء الرديئة، والشهوات المطغية ويحتسب في ذلك على الله نفيس الذخائر العالية.
فقد روينا عن حميد عن أنس قال: مقابل عرش الرحمن غرفة يرسل إليها جبريل عليه السلام، فإذا انتهى إليها خر لله ساجدًا، ثم يقول: يارب لمن خلقت هذه، لأي نبي؟ لأ صديق؟ لأي شهيد؟ قال: فيرد عليه عزّ وجلّ: لمن آثر هواي على هواه.
ومن الرجاء افتعال الطاعات، وحسن الموافقات، ينوي بها، ويسأل مولاه الكريم عظيم الرغائب وجليل المواهب، لما وهب له من حسن الظن به.
كما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا سألتم الله تعالى فأعظموا الرغبة، وسلوه الفردوس الأعلى، فإن الله عزّ وجلّ لا يتعاظمه شيء.
وفي حديث آخر فأكثروا وسلوا الدرجات العلى، فإنما تسألون جوادًا كريمًا، وفي الآثار أن رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة، فإذا دخلا الجنة رفع أحدهما في الدرجات العلى على صاحبه، فيقول الآخر: يارب ما كان هذا في الدنيا بأكثر عبادة لك مني فرفعته علي في عليين، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وكنت أنت تسألني النجاة من النار، فأعطيت كل عبد سؤله.
وروينا في الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن رجلاً يخرج من النار فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول له: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: يارب شر مكان، فيقول: ردوه إلى مكانه، قال: فيمشي ويلتفت إلى ورائه، فيقول الله عزّ وجلّ: إلى أي معنى تلفت؟ فيقول له: يارب قد رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها، فيقول تعالى: اذهبوا به إلى الجنة فقد صار الرجاء طريقه إلى الجنة، كما كان الخوف طريق صاحبه في الدنيا إليها.
كما روينا: إن الآخر سعى مبادرًا إلى النار لما قال: ردّوه فقيل له في ذلك، فقال: لقد ذقت من وبال معصيتك في الدنيا ماخفت من عذابه في الآخرة فقيل: اصرفوه إلى الجنة، وقال الله سبحانه في وصف قوم: (أُولئِك الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتغُون إلى رَبِّهِمْ الْوَسيلَةَ أيُّهمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذابهُ) الإسراء: 57 فطرق لأوليائه من القرب والوسيلة الرجاء، كما طرق الخوف منه إليها، وهذا أحد الوجهين في الآية لمن لم يجعله وصفًا للأصنام لأنها قرئت بالتاء تدعون قرأها طلحة بن مصرف، فكذلك ندب المؤمنين إلى طلب القرب منه قي قوله عزّ وجلّ: (يَا أيهُا الذين آمنُوا اتَّقُوا الله وَابْتَغُوا إليْهِ الْوَسيلَةَ) المائدة: 35 فهذه جملة أحكام الرجاء وأوصاف الراجين، فمن تحقّق بجميعها فقد استحق درجات أهل الرجاء، وهو عند الله تعالى من المقرّبين، ومن كان فيه وصف من هذه الأوصاف فله مقام من الرجاء.
واعلم أن مقام اليقين لا يزيل بعضها بعضًا ولكن يندرج بعضها في بعض، فمن غلب عليه حال مشاهدته وصف بما غلب عليه واستمر بما سوى ذلك من المقامات فيه، ومن عمل بشرط مقام منها وقام بحكم الله تعالى فيه نقل إلى ما سواه، وكان المقام الأول له علماً والثاني الذي أقيم فيه له وجدًا، فكتم الوجد لأنه سرّه وعبّر عن العلم لأنه قد جاوزه فصار له علانيّة، ومقام الرجاء هو جند من جنود الله عزّ وجلّ يستخرج من بعض العباد ما لا يستخرج غيره لأن بعض القلوب تلين وتستجيب عن مشاهدة الكرم والإحسان وتقبل وتطمئن بمعاملة النّعم والإحسان ما لا يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب بل قد يقطعها ذلك ويوحشها إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قلوبها.
ومثل الرجاء في الأحوال مثل العوافي والغنى في الإنسان من يقبل قلبه ويجتمع همّه عندهما ويوجد نشاطه وتحسن معاملته بهما.
كما روينا عن الله سبحانه وتعالى: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك ومن عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي، إني بهم خبير، فكذلك من عبادي من لا يصلحه إلا الرجاء ولا يستقيم قلبه إلا عليه ولا تحسن معاملته إلا بوجود حسن الظنّ فهو طريقه إليه ومقامه منه ومنه علمه به وعنده يجد قلبه معه، إلا أنه وإن كان طريقًا يخرج إلى الله عزّ وجلّ فإن الخوف أقرب منه، وما كان أقرب فهو أعلى، كما أن الغنى والعوافي طرقان إلى الله تعالى إلا أن الفقر والبلاء عندي أقرب منهما وأعلى والله غالب على أمره.
وقد روينا عن معمر عن الحسن: أنه قال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن بالله الظنّ وأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء بالله الظنّ ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شرح مقام الخوف
ووصف الخائفين وهو الخامس من مقامات اليقين
قال الله عزّ وجلّ: (ومَا يَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ) العنكبوت: 43 فرفع العلم على العقل وجعله مقامًا فيه وقد قال سبحانه وتعالى: (إنَمَا يَخْشى اللّّه منْ عبَادِهِ الْعُلمَاءُ) فاطر: 28 فجعل الخشية مقامًا في العلم حققه بها، والخشية حال من مقام الخوف، والخوف اسم لحقيقة التقوى، والتقوى معنى جامع للعبادة وهي رحمة الله تعالى للأوّلين والآخرين، ينظم هذين المعنيين قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم الَّذي خَلَقكُمْ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتَّقُونَ) البقرة: 21 وقوله تعالى: (وَلقَدْ وَصَّيَّنْا الَّذين أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أنّ اتَقُوا الله) النساء: 131، وهذه الآية قطب القرآن مداره عليها والتقوى سبب أضافه تعالى إليه تشريفاً له، ومعنى وصله به وأكرم عباده عليه تعظيماً له فقال: (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومَها وَلا دِمَاؤُهَا ولَكِنْ يَنالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم) الحج: 37 وقال: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاكُمْ) الحجرات: 13 وفي الخبر: إذا جمع الله الأوّلين والآخرين لميقات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم يقول: يا أيها الناس إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، فأنصتوا إلي اليوم، فإنما هي أعمالكم ترد عليكم، أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً، فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم، قلت: (إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاكُمْ) الحجرات: 13 وأبيتم إلا فلان بن فلان أغنى من فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ قال: فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلهم الجنة بغير حساب.
والخوف حال من مقام العلم، وقد جمع اللّّّه تعالى للخائفين ما فرقه على المؤمنين، وهو الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وهذه جمل مقامات أهل الجنان، فقال تعالى: (هُدَى وَرَحْمَةٌ للّذينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُون) الأعراف: 154 وقال: (إنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلمَاءُ) فاطر: 28 وقال جل ذكره: (رَضِيَ اللّّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) البينة: 8
وفي خبر موسى عليه السلام: وأما الخائفون فلهم الرفيق الأعلى، لا يشاركون فيه، فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق الأعلى، كا حققهم اليوم بشهادة التصديق، وهذا مقام من النبوة، فهم مع الأنيباء في المزية من قبل أنهم ورثة الأنبياء، لأنهم هم العلماء، قال تعالى: (فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَبِييِّنَ والصِّدِّيقِينَ) النساء: 69، ثم قال تعالى في وصف منازلهم: (وحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً) النساء: 69 بمعنى رفقًا، عبر عن جماعتهم بالواحد، لأنهم كانوا كأنهم واحد، وقد يكون رفيقاً مقاماً في الجنة من أعلى عليين، لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الموت وقد خير بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله تعالى فقال: أسألك الرفيق الأعلى.
وفي خبر موسى عليه السلام: فأولئك لهم الرفيق الأعلى، فدل أنهم مع الأنبياء بتفسير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لذلك، وشرف مقامهم فوق كل مقام، لطلب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك.
فالخوف اسم جامع لحقيقة الإيمان، وهو علم الوجود والإيقان، وهو سبب اجتناب كل نهي ومفتاح كل أمر، وليس شيء يحرق شهوات النفوس فيزيل آثار آفاتها إلا مقام الخوف.
وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: كمال الإيمان العلم، وكمال العلم الخوف، وقال مرة: العلم كسب الإيمان، والخوف كسب المعرفة.
وقال أبو الفيض المصري: لايسقى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه وقال: خوف النار عند خوف الفراق بمنزلة قطرة قطرت في بحر لجيّ، وكل مؤمن بالله تعالى خائف منه، ولكن خوفه على قدر قربه، فخوف الإسلام: اعتقاد العزة والجبرية لله تعالى، وتسليم القدرة والسطوة له، والتصديق لما أخبر به من عذابه وما تهدد به من عقابه.
وقال الفضيل بن عياض: إذا قيل لك تخاف الله فاسكت، لأنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم فليس وصفك وصف من يخاف.
وشكا واعظ إلى بعض الحكماء فقال: ألا ترى إلى هؤلاء أعظهم وأذكرهم فلا يرقون؟ فقال: وكيف تنفع الموعظة من لم يكن في قلبه لله تعالى مخافة، وقد قال اللّّه تعالى في تصديق ذلك: (سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى) الأعلى: 10 - 11 أي يتجنب التذكرة الشقي، فجعل من عدم الخوف شقياً وحرمه التذكرة فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلب عن باطن العلم بالعقد، وخوف خصوصهم وهم الموقنون بباطن القلب عن باطن العلم بالوجد: فأما خوف اليقين فهو للصديقين من شهداء العارفين عن مشاهدة ما آمن به من الصفات المخوفة.
وقد جاء في خبر إذا دخل العبد في قبره لم يبق شيء كان يخافه دون الله عز وجل إلا مثل له يفزعه ويرعبه إلى يوم القيامة فأول خوف اليقين الموصوف الذي هو نعت الموصوفين من المؤمنين، المحاسبة للنفس في كل وقت، والمراقبة للرب في كل حين، والورع عن الإقدام على الشبهات من كل شيء من العلوم بغير يقين بها ومن الأعمال بغير فقه فيها.
وفي خبر موسى عليه السلام: وأما الورعون فإنه لايبقى أحد إلا ناقشته بالحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أستحييهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب، فالورع حال من الخوف، ثم كف الجوارح عن الشبهات وفضول الحلال من كل شيء، بخشوع قلب، ووجود إخبات.
وقال عليّ كرم الله وجهه: ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ثم سجن اللسان وخزن الكلام، لئلا يدخل في دين الله عزّ وجلّ ولا في العلم ما لم يشرعه الله في كتابه أو لم يذكره رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته، أو لم ينطق به الأئمة من السلف في سيرهم مما لم يكن أصله موجودًا في الكتاب والسنة، وتسميته واضحة في العلم، فيجتنب ذلك كله، (وَلاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) الإسراء: 36 خوفًا من المساءلة، ولا يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه ولا لعظيم حظ دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسه لله تعالى لأنها أولى الخلق، ثم ينصح الخلق في الله تعالى فيبتدئ بالنصح في أمور الدين والآخرة، ثم يعقبه في أسباب الدنيا لأن أمور الآخرة أهم، والغش في الدين أعظم، والتزود للمنقلب آثر.
روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: من غش أمتي فعليه لعنة الله، قيل وما غش أمتك يا رسول اللّّه؟ قال: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها، فإذا فعل ذلك فقد غشهم.
وثمرة الخوف العلم بالله عزّ وجلّ والحياء من الله عز وجلّ وهو أعلى سريرات أهل المزيد يستبين أحكام ذلك في معنيين؛ هما جملة العبد إن يحفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان وأن يحفظ بطنه وما وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل: وهذا خوف العموم، وهو أول الحياء.
فأما خوف الخصوص فهو أن لا يجمع ما لا يأكل ولا يبني ما لا يسكن، ولا يكاثر فيما عنه ينتقل ولا يغفل ولا يفرط عمّا إليه يرتحل، وهذا هو الزهد وهو حياء مزيد أهل الحياء من تقوى أصحاب اليمين، وقد روينا معنى ما ذكرناه في حديثين، أحدهما عام والآخر خاص، وكل من لم يستعمل قلبه في بدايته، ويجعل الخوف حشو إرادته لم ينجب في خاتمته، ولم يكن إماماً للمتقين عند علوّ معرفته.
وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلقًا بخوف الخاتمة، لا يسكن إلى علم ولا عمل، ولا يقطع على النجاة بشيء من العلوم وإن علت، ولا لسبب من أعماله وإن جلت، لعدم علمه تحقيق الخواتم، فقد قيل: إنما يوزن من الأعمال خواتمها.
وعن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى يقال إنه من أهل الجنة، وفي خبر: حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار ولا يتأتى في هذا المقدار من الوقت شيء من عمل الجسم بالجوارح، إنما هو من أعمال القلوب بمشاهدة العقول، وهو شرك التوحيد الذي لم يكن متحققًا به، وشكّ في اليقين الذي لم يكن في الحياة الدنيا مشاهدًا له، فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاء، فغلب عليه وصفه وبدت فيه حاله كما يظهر له أعماله السيئة فيستحليها قلبه أو ينطق بها لسانه أو يخامرها وجده، فتكون هي خاتمته التي تخرج عليها روحه، وذلك في سابقته التي سبقت له من الكتاب كما قال تعالى: (أولئكَ يَنَالُهُمْ نَصيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ) الأعراف: 37 تكون عند مفارقة الروح من الجسد (وإنّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ) هود: 109 وقد جاء في خبر حتى لايبقى بينه وبين الجنة إلا فواق ناقة، فيختم له بعمل أهل النار، وهذا يكون عند بلوغ الروح التراقي، وتكون النفس قد خرجت من جميع الجسد، واجتمعت في القلب إلى الحلقوم فهذا هو شبر، وفواق ناقة: هو ما بين الحلبتين، وقيل: هو شوط من عدوها بين سيرين؛ وهذا من تقلّبات القلوب عند حقيقة وجهة التوحيد إلى وجهة الضلال والشرك عندما يبدو له من زوال عقل الدنيا، وذهاب علم المعقول فيبدو له من الله ما لم يكن يحتسب.
وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس: أهل البدع والزيغ في الدين، لأن إيمانهم مرتبط بالمعقول، فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودها فيذهب إيمانه ولا يثبت لمعاينتها، كما تحترق الفتيلة فيسقط المصباح.
والطبقة الثانية أهل الكبر والإنكار لآيات الله عزّ وجلّ وكراماته لأوليائه في الحياة الدنيا، لأنهم لم يكن لهم يقين يحمل القدرة ويمده الإيمان؛ فيعتورهم الشك ويقوى عليهم لفقد اليقين.
والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف: متفرقون متفاوتون في سوء الخاتمة، وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاتمة، لأن سوء الختم على مقامات أيضاً كمقامات اليقين والشرك في عمر الحياة، منهم المدعي المتظاهر الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ناظراً، والفاسق المعلن، والمصرّ المدمن، يتصل بهم المعاصي إلى آخر العمر، ويدوم تقلبهم فيها إلى كشف الغطاء، فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى بقلوبهم، وقد انقطعت أعمال الجوارح فليس يتأتى منهم، فلا تقبل توبتهم، ولا تقال عثرتهم، ولاترحم عبرتهم، وهم من أهل هذه الآية، (ولَيْسَتِ التَّوْبَةُ للَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ: إنِّي تُبْتُ الآنَ) النساء: 18 فهم مقصودون بقوله عزّ وجلّ: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) سبأ: 54 وهم معنيون بمعنى قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوا بَأْسَنا قَالُوا: آَمَنَّا باللهِ وَحْدَهُ) غافر: 84، فنصوص الآية للكفار ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر وذوي الإصرارمن الفاسقين الزائغين، من حيث اشتركوا في سوء الخاتمة ثم تفاوتوا في مقامات منها، تظهر لهم شهوات معاصيهم، ويعاد عليهم تذكرها، لخلو قلبهم من الذكر والخوف حتى يختم لهم بشهادتها؛ فهذه الأسباب تجلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الألباب.
وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: المريد يخاف أن يبتلي بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلي بالكفر.
وكذلك قال أبو يزيد رحمه الله تعالى قبله: إذا توجهت إلى المسجد كان في وسطي زنار أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل المسجد فيقطع عني الزنار، فهذا لي في كل يوم خمس مرات، هذا لعلمهم بسرعة تقلّب القلوب في قدرة علام الغيوب.
وقد روينا معنى ذلك عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي ونحن معشر الأنبياء نخاف الكفر.
وروينا في أخبار الأنبياء: أن نبياً شكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعري سنين فأوحى الله تعالى إليه: أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر بي حتى تسألني الدنيا، فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت يارب فاعصمني من الكفر فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه بعد النبوة، فاعترف النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، ورضي به واستعصم.
وقد كان عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين قبلهما يقول: ماصدق خائف قط ظن أنه لا يدخل النار وما ظن أن يدخل النار إلا خاف أن لا يخرج منها أبداً.
وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إمام العلماء قبلهم: يخرج من النار رجل بعد ألف عام وياليتني ذلك الرجل، هذا لشدة خوفه من الخلود في الأبدية، قال فبعد أن أخرج منها بوقت لا أبالي.
والعدو يدخل على العارفين من طريق الإلحاد في التوحيد والتشبيه في اليقين والوسوسة في صفات الذات، ويدخل على المريدين من طريق الآفات والشهوات، فلذلك كان خوف العارفين أعظم، ومن قبل أن العدو يدخل على كل عبد من معنى همه فيشككه في اليقين كما يزين له الشهوات، فأرواحهم معلقة بالسابقة ماذا سبق لهم من الكلمة، هناك مشاهدتهم، ومن ثم فزعهم، لايدرون أسبق لهم قدم صدق عند ربهم فيختم لهم بمقعد صدق، فيكونون ممن قال تعالى: (إنَّ الّذيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُون) الأنبياء: 101 ويخافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمة، فيكونون ممن قال فيهم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقول اللّّه سبحانه وتعالى هؤلاء في النار ولا أبالي فلا ينفعهم شفاعة شافع، ولاينقذهم من النار دافع، كما قال مولاهم الحق: (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ في النَّارِ) الزمر: 19 وكقوله تعالى: (ولَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ) السجدة: 13 فهذه الآية ومعناها تخويف لأولي الأبصار.
وقال عالمنا رحمه الله في قوله تعالى (وَإيَّايَ فَاتَُّقونِ) البقرة: 41 عموم أي فيما نهيت عنه: وقوله تعالى (وإيَّايَ فَارْهَبُونِ) البقرة: 40 أي في السابقة وهذا خصوص.
وقد نوع بعض العارفين خوف المؤمنين على مقامين فقال: قلوب الأبرار معلقة، بالخاتمة يقولون: ليت شعري ماذا يختم لنا به؟ وقلوب المقربين معلقة بالسابقة يقولون: ليت شعري ماذا سبق لنا به؟ وهذان المقامان عن مشاهدتين: إحداهما أعلى وأنفذ من الأخرى لحالين: أحدهما أتم وأكمل، فهذا كما قيل ذنوب المقربين حسنات الأبرار: أي ما يرغب فيه الأبرار فهو عندهم فضائل، قد زهد فيه المقربون، فهو عندهم حجاب، ومن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق له من مولاه الختم بسوء الاكتساب، لم ينفعه شيء، فهو يعمل في بطالة لا أجر له ولا عاقبة قد نظر إليه نظرة بعذ؛ فهو يزداد بأعماله بعداً من قبل أن سوء الخاتمة قد تكون في وسط العمر، فلا ينتظر بها آخره يوافق معصية تكون سببها كعند الخاتمة، إذ هما في سبق العلم سواء، فالخاتمة حينئذ فاتحة، والوقتان واحد.
فإذا انقطعت الآجال وانتهت الأعمال تناهي في الإبعاد فحلّ في دار البعد، وقد روينا في الخبر والله لا يقبل الله تعالى من مبتدع عملاً إنه ردّ على اللّّه تعالى سننه فرد عليه عمله كلما ازداد اجتهادًا ازداد من اللّّه تعالى بعداً، كما قال الحكيم:
من غص داوى بشرب الماء غصته ... فكيف يصنع من قد غص بالماء بل كيف يصنع من أقصاه مالكه ... فليس ينفعه طب الأطباء
وعن مشاهدة هذا المعنى كان خوف الحسن البصري رحمه الله تعالى وحزنه، لعلمه بأنه عزّ وجلّ لايبالي ما فعل، فخاف أن يقع بوصف الجبرية في ترك المبالاة، وأن يجعله نكالاً لأصحابه، وموعظة لأهل طبقته.
ويقال إنه ما ضحك أربعين سنة وكنت إذا رأيته قاعداً كأنه أسير قدم ليضرب عنقه، وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها، وإذا سكت كأن النار تسعر بين عينيه، وعوتب في شدة حزنه فقال: ما يؤمنني أن يكون قد اطلع عليَّ في بعض ما يكره فمقتني، فقال اذهب فلا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معمل، فنحن أحق بهذا من الحسن رحمه اللّّه، ولكن ليس الخوف يكون لكثرة الذنوب، فلو كان كذلك لكنا أكثر خوفًا منه، إنما يكون لصفاء القلب وشدة التعظيم لله تعالى.
وقد بشر العلاء بن زياد العدوي بالجنة وكان من العباد فغلق عليه بابه سبعاً ولم يذق طعامًا، وجعل يبكي ويقول: أنا في قصة طويلة، حتى دخل عليه الحسن فجعل يعذله في شدة خوفه وكثرة بكائه، فقال يأخي من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، أقاتل نفسك؟ فما ظنك برجل يعذله الحسن في الخوف، وقد كان من فوقهم من عليه الصحابة يتمنون أنهم لم يخلقوا بشرًا وقد بشروا بالجنة يقينًا في غير خبر.
من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: ليتني مثلك ياطير وأني لم أخلق بشرًا، وقول عمر رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشاً ذبحني أهلي لضيفهم، وأبوذر رضي الله عنه يقول: وددت أني شجرة تعضد، وطلحة والزبير رضي الله عنهما يقولان: وددنا أنّا لم نخلق، وعثمان رضي الله عنه يقول: وددت أني إذا متّ لا أبعث، وعائشة رضي الله عنها تقول: وددت أني كنت نَسْيًا مَنْسِيًا، وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليتني أني أكون رماداً، وفي رواية عنه: ليتني كنت بعرة، ليتني لم أك شيئًا في طبقة يكثر عدهم ونحن في ارتكاب الكبائر ونحدث نفوسنا بالدرجات العلى والقرب من سدرة المنتهى، ونسينا أن أبانا آدم صلوات الله عليه أخرج من الجنة بعد أن دخلها بذنب واحد ونحن لم نرها بعد فإنما نضرب في حديد بارد.
وروينا في خبر أن رجلاً من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئًا فقالت أمه هنيئًا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقتلت في سبيل اللّّه تعالى فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وما يدريك فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضرّه، وفي حديث آخر بمثل هذه القصة أنه دخل على بعض أصحابه وهو عليل، فسمع أمه تقول هنيئًا لك الجنة، فقال: من هذه المتألية على الله عزّ وجلّ فقال الرجل: هي أمي يا رسول الله فقال: وما يدرك لعل فلانًا كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه.
وروينا بمثل معنى هذا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى على طفل منفوس، ففي راوية: إنه سمع يقول في دعائه: اللهم قه عذاب القبر وعذاب جهنم وفي رواية ثانية: إنه سمع قائلة تقول: هنيئًا لك عصفور من عصافير الجنة، فغضب وقال: ما يدريك؟ إنه كذلك والله، إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي، إن الله عزّ وجلّ خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلق النار وخلق لها أهلاً لا يزاد فيهم ولاينقص منهم، وقد قاله رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنازة عثمان بن مظعون، وكان من المهاجرين الأول واستشهد لما قالت أم سلمة رضي الله عنها ذلك، وكانت تقول: والله لا أزكي أحدًا بعد عثمان رضي الله عنه، وأعجب من ذلك أنّا روينا عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه قال: والله لا أزكي أحدًا غير رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أبي الذي ولدني قال: فتكلمت الشيعة، فأخذ يذكر من فضائل عليّ كرّم الله وجهه ومناقبه؛ فهذه المعاني أحرقت قلوب الخائفين ولعل ذكر البعد في الأبعاد الذي شيب الحبيب القريب في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شيّبتني هود وأخواتها وسورة الواقعة وإذا الشمس كوّرت وعمّ يتساءلون لأن في سورة هود ألا بعدًا لثمود (ألا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ) هود: 60 ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود، وفي سورة الواقعة: (ليْسَ لِوَقعَتِهَا كَاذِبَةٌ) الواقعة: 2 يعني وقعت السابقة لمن سبقت له وحقّت الحاقة بمن حقّت عليه خافضة رافعة خفضت قومًا في الآخرة كانوا مرفوعين في الدنيا حين ظهرت الحقائق وكشفت عواقب الخلائق، وأما سورة التكوير ففيها خواتم المصير وهي صفة القيامة لمن أيقن وفيها تجلّي معاني الغضب لمن عاين آخر ذلك، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أُزلفت علمت نفس ما أحضرت هذا فصل الخطاب أي عند تسعير النيران واقتراب الجنان، حينئذ يبتين للنفس ما أحضرت من شرّ يصلح له الجحيم أوخير يصلح له النعيم وتعلم إذ ذاك من أيّ أهل الدارين تكون وفي أيّ منزلين تحلّ، فكم من قلوب قد تقطّعت حسرات على الأبعاد من الجنان بعد اقترابها وكم من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها بمعاينة لنيران أنها تصيبها، وكم من أبصار ذليلة خاشعة لمشاهدة الأهوال، وكم من عقول طائشة لمعاينة الزلزال.
وحدثنا عن أبي سهل رحمه الله تعالى قال: رأيت كأني أدخلت الجنة فلقيت فيها ثلاثمائة نبي، فسألتهم ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا؟ فقالوا لي: سوء الخاتمة، فالخاتمة هي من مكر الله تعالى الذي لا يوصف، ولا يفطن له ولا عليه يوقف، ولا نهاية لمكره، لأن مشيئته وأحكامه لا غاية لها.
ومن ذلك الخبر المشهور أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجبريل بكيا خوفًا من الله تعالى، فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: ومن يأمن مكرك؟ فلولا أنهما علما أن مكره لانهاية له، لأن حكمه لاغاية له، لم يقولا ومن يأمن مكرك مع قوله: قد أمنتكما ولكان قد انتهى مكره بقوله، ولكانا قد وقفا على آخر مكره، ولكن خافا من بقية المكر الذي هو غيب عنهما، وعلما أنهما لا يقفان على غيب الله تعالى، إذ هو علام الغيوب، فلا نهاية للعلام في علم، ولا غاية للغيوب بوصف، فلم يحكم عليهما القول لعنايته بهما وفضل نظره إليهما، ولأنهما على مزيد من معرفة الصفات، إذ المكر عن الوصف وإظهار القول لايقضي على باطن الوصف، فكأنهما خافا أن يكون قوله تعالى: قد أمنتكما مكري مكراً منه أيضًا بالقول على وصف مخصوص عن حكمة قد استأثر بعلمها يختبر بذلك حالهما، وينطر كيف يعملان تعبدًا منه لهما به، إذ الابتلاء وصفه من قبل أن المبتلي اسمه فلا يترك مقتضى وصفه لتحقق اسمه، ولا تبدل سنته التي قد خلت في عباده، كما اختبر خليله عليه السلام لما هوى به المنجنيق في الهواء، فقال حسبي الله ربي فعارضه جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال لا، وفاء بقوله حسبي الله فصدق القول بالعمل فقال الله تعالى: (وإبْرَاهِيمَ الّذِي وَفَّى) النجم: 37 بقوله حسبي اللهولأن الله تعالى لا يدخل تحت الأحكام؛ ولا يلزمه ما حكم به على الأنام، ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وأن بدل الكلم هو بتبديل منه، لأن كلامه قائم به، فله أن يبدل به ماشاء، وهو الصادقين في الكلامين، العادل في الحكمين، الحاكم في الحالين، لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه، لأنه قد جاز العلوم والعقول التي هي أماكن للحدود من الأمر والنهي، وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام والأقدار.
وفي مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد، ومقام رفيع من أحوال التوحيد وبمثل هذا المعنى وصف صفيه موسى في قوله تعالى (فَأَوْجَسَ في نفسه خيفة موسى) طه: 66 بعد قوله تعالى (لا تخافا إنني معكما) طه: 46 الآية، فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه في غيبه، واستثنى في نفسه سبحانه ما لم يظهره له في القول، لمعرفة موسى عليه السلام بخفي المكر وباطن الوصف، ولعلمه أنه لم يعطه الحكم إذ هو محكوم عليه مقهور، فخاف خوفًا ثانياً حتى أمنه أمناً ثانياً بحكم ثان، فقال: (لا تخف إنك أنت الأعلى) طه: 68 فاطمأن إلى القائل ولم يسكن إلى الإظهار الأول، لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي لا نهاية لها، ولأن القول أحكام والحاكم لا تحكم عليه الأحكام كما لا تعود عليه الأحكام، وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام، ثم تعود على المحكومات أبدًا، ولأنه جلت قدرته لا يلزمه مالزم الخلق الذي هم تحت الحكم، ولايدخل تحت معيار العقل والعلم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًا، عند من عرفه فأجله وعظمه عن معارف من جهله.
ومن هذا قول عيسى عليه السلام من قوله تعالى: (إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ) المائدة: 116 لما قال له: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوني وَأُمِّيَ إلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّّهِ) المائدة: 116 ومثل هذا قوله في يوم القيامة (إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإنَّهُمْ عِبَادُكَ) المائدة: 118 فجعلهم في مشيئة لعزته وكحمته ولا يصلح أن نكشف حقيقة ما فصلناه في كتاب، ولا ينبغي أن نرسم ما رمزناه من الخطاب خشية الإنكار، وكراهة تفاوت علم أهل المعقول والمعيار إلا أن يسأل عنه من أقيم فيه وأريد به من ذوي القوة والإبصار، فينقل من قلب إلى قلب، فحينئذ يتلوه شاهد منه، أويكشفه علام الغيوب في سرائر القلوب بوحي الإلهام، ويقذفه بنور الهدى للإعلام، والله الموفق لمن شاء من العباد، لما شاء من الحيطة بالعلم وهو الفتاح العليم إذا فتح القلب علمه وإذا نوره بالقين ألهمه.
ومن خوف العارفين علمهم بأن الله تعالى يخوف عباده بمن شاء من عباده الأعلين، يجعلهم نكالاً لأدنين ويخوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض الخصوص من عباده حكمة له وحكمًا منه.
فعند الخائفين في علمهم أن الله تعالى قد أخرج طائفة من الصالحين نكالاً خوف بهم المؤمنين؛ ونكل طائفة من الشهداء خوف بهم الصالحين، وأخرج جماعة من الصديقين خوف بهم الشهداء؛ والله تعالى أعلم بما وراء ذلك.
وقد أخرج جماعة من الملائكة وعظ بهم النبيين، وخوف بهم الملائكة المقربين، فصار من أهل كل مقام عبرة لمن دونهم وموعظة لمن فوقهم، وتخويف وتهديد لأولي الأبصار، وهذا داخل في بعض تفسير قوله عزّ وجلّ: (آَتَيْنَاه آَياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها) الأعراف: 175 قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء: إنه أوتي النبوة، والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر، فكان سبب هلاكه، وهو مقتضى وصف من أوصافه، وهو ترك المبالاة بما أظهر من العلوم والأعمال، فلم يسكن عند ذلك أحد من أهل المقامات في مقام، ولا نظر أحد من أهل الأحوال إلى حال، ولا أمن مكر الله تعالى عالم به في كل حال، كيف وقد سمعوه تبارك وتعالى يقول: (إنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) المعارج: 28 فأجهل الناس من أمن غير مأمون، وأعلمهم من خاف في الأمن حتى يخرج من دار الخوف إلى مقام أمين.
وهذا خوف لايقوم له شيء؛ وكرب لا يوازيه مقام ولا عمل، لولا أن الله تعالى عدله بالرجاء لأخرج إلى القنوط، ولولا أنه روحه بروح الأنس بحسن الظن لأدخل في الإياس، ولكن إذا كان هو المعدل وهو المروح كيف لا يعتدل الخوف والرجاء، ولا يمتزج الكرب بالروح والرضا، حكمة بالغة، وحكم نافذ، لعلم سابق، وقدر جار، ماشاء اللّّه تعالى لا قوّة إلا بالله.
وفي شهود ما ذكرناه علم عن مشاهدة توحيد لمن أشهده، فأقل ما يفيد علم هذا الخائفين ترك النظر إلى أعمالهم ورفع السكون إلى علومهم وصدق الافتقار في كل حال ودوام الانقطاع بكل همّ والإزراد على النفس في كل وصف؛ وهذه مقامات لقوم، فيكون هذا الخوف سبب نجاتهم من هذه الوقائع إذ قد جعل الله تعالى التخويف أمنة من الأخذ بالمفاجأة وسببًا للرأفة والرحمة لمن ألبسه إياه، وهو أحد الوجهين وفي قوله تعالى: (أَفَأمِنَ الَّذين مَكَرُوا السَّيئاتِ أنْ يَخْسِفَ الله بِهِمُ الأرْضَ) النحل: 45 الآية، ثم قال تعالى: (أَوْ يَأْخُذَهُمْ علَى تَخَوُّفٍ فَإنَّ رَبّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحيمٌ) النحل: 47 وليس يصلح أيضًا أن نكشف سرّ المخاوف من الخاتمة والسابقة لأن ذلك يكون عن حقائق معاني الصفات التي ظهرت عن حقيقة الذات فأظهرت بدائع الأفعال وغرائب المآل وأعادت الأحكام على من أظهر بها وجعل لها ممن حقّت عليه الكلمات وجعل نصيبه من معاني هذه السريرة من الصفات فيؤدي ذلك منّا إلى كشف باطن الأوصاف؛ وهذا غير مأمور به ولا مأذون فيه، لأنه لا يجب فلم يؤمر به، ولأنه لم يبح فلم يؤذن فيه، وهو من سرّ القدر وقد نهي عن إفشائه في غير خبر ولو لم يطلع الأولياء عليه لما قيل: فلا تفشوه، فإن أقام الله تعالى عبدًا مقام هذه المشاهدة أغناه بالمعاينة عن الخبر، وآنسه بالمحادثة عن الأثر، وذلك هو العلم النافع الذي يكون العلاّم معلّمه، وذلك هو الأثر اللازم الذي يكون الجاعل مؤثره، (ومَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً وَيَرْزُقْه مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ومَنْ يَتَوَكَّلْ على اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) الطلاق: 3 فالكتب الذي لا يمحي ما كان من نوره والعين التي لا تخفى لأنها بحضوره والنور الذي لا يطفأ لأنه من روحه والروح الذي لا كرب فيه لأنه من ريحانه والمدد الذي لا ينقطع فمن روحه، وقد كتب وأيد وكل كتاب بيد مخلوق فغيرمحفوظ وقد يضيع وكل أيد بغير روحه فمقطوع وما كتبه الصانع بصنعه في قلب حفيظ فمثبت عتيد.
وقد روينا عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: (في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) البروج: 22، قال: قلب المؤمن وقال آخر في قوله: (والبيت المعمور) الطور: 4 قلب العارف، وقال بعض أهل المعرفة: (في بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) النور: 36 قلوب المقرّبين رفعت إلى وصف الخالق عن ذكر المخلوقين ويذكر فيها اسمه بالتوحيد على تجريد الوحدانية عن شهادة الأحدية.
وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله تعالى يقول: الصدر هو الكرسي والقلب هو العرش والله تبارك وتعالى واضع عليه عظمته وجلاله، وهو مشهود بلطفه وقربه، فصدرالمومن أوّله صمدية وآخره روحانية وأوسطه ربوبية، فهو صمديّ روحانيّ ربانيّ وقلبه أوله قدرة وآخره برّ، وأوسطه لطف، فإذا كان كذلك فهو مشكاة فيها مصباح يرى به الزجاج كأنها كوكب دريّ تشهد به الآلاء، فهو مرآة جسدي يرى فيرى به الوجه ويجده عنده كما يراه به من وراء مرآة مشاهدة من قلب موقن بعين يقين، يشهد الصدر الكرسي والقلب العرش والله تعالى عليه.
ولا يحلّ للعلماء أيضاً كشف علامات سوء الخاتمة فيمن رأوها فيه من العمال لأن لها علامات جليّة عند المكاشفين بها وأدلة خفيّة عند العارفين المشرف بهم عليها، ولكنها من سر المعبود في العبد خبيئة وخبأة في خزائن النفوس لم يطلع عليها إلا الأفراد وقد ستر ذلك وعطاه بسعة رحمته وحلمه وكثيف ستره وفضله وسيخرج ذلك الخباء يوم تبلى السرائر عند غضبه وعظيم سطوته، فما له من قوة، من عمل، ولا ناصر من علم لا قوّة له فينتصر بها، لأن النصرة عزّة وهو ذليل، ولا ناصر، لأن الناصر هو الخاذل والمقوّى هو المضعف، فما أسوأ حال من لا ينصر نفسه، وليست له من مولاه صحبة، ولو صحبه لنصره، ولو نصره لأعزه ولو وليه لهرب منه عدّوه.
قال تعالى: (لا يَسْتَطَيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) الأنبياء: 43 وقال تعالى: (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذي يَعلَمُ السِّرَّ في السَّمواتِ والأَرْضِ) الفرقان: 6 الآية.
فمن حكمته غفره ومن رحمته ستره، وقال تعالى: (يُخْرِجُ الْخَبْءَ في السَّمَواتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخفُونَ وَمَا تُعلِنُونَ) النمل: 25؛ فهذه العلوم التي ذكرناها توجب حقائق المخاوف، وهي من سرّ الملك وخباء الملكوت.
على أن للعبد عند الموت علامات ليس يخفى على العارف بسوء الخاتمة بها لمشاهدته لها وللأحياء علامات عند المكاشفين على الاطلاع يعرفون بها سوء الخاتمة منهم، وهذا علم مخصوص به: من أقيم مقام مقامات المكاشفات عن مشاهدة حقيقة من ذات، وهوسرّ علام الغيوب عند من أطلعه عليه من أهل القلوب، لأن الكشف يتنوّع أنواعاً من المعاني، فمنه كشف معاني الآخرة، ومنه كشف بواطن الدنيا، ومنه الاطلاع على حقائق الأشياء المستورة لظواهر الأحكام، فهذا من سر الملكوت، ومن معاني كشوف الجبروت.
وقد جاء في خبر القدر سر الله فلا تفشوه فهذا خطاب لمن كوشف به، وفي خبر آخر ستر الله فلا تكشفوه فهذا خطاب لمن لم يكاشف به، وهذا نهي عن السؤال عنه، وهو داخل في قوله تعالى (ولاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) الإسراء: 36 أي لا تتبع نفسك علم ما لم تكلف، ولا تسأل عما لم يجعل من علمك ولم يوكل إليك، ولأنه إذا علمه لم ينفعه علمه شيئاً، وإنما ينفعه علم الأحكام والأسباب، لأنها طرقات، وبمثل مخاطبة المؤمنين خاطب أنبياءه عليهم السلام في هذا المعنى في قوله تعالى لنوح عليه السلام حين قال: (إنَّ ابني مِنْ أَهْلي وإنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ) هود: 45 لأنه قدكان وعده نجاة أهله فقال سبحانه وتعالى: (إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تَسْأَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) هود: 46 أي دعاءك ومسألتك لي ما لم أجعله من علمك ولم أكله إليك عمل غير صالح، فعندها استغفر ربه واسترحمه.
وإن العبد عند موته في آخر ساعة من عمره يكشف له عند كشف الغطاء عن بصره وجوه كثيرة قد اتخذت آلهة من دون الله أو أشرك بها مع الله تعالى وكلها تزيين وغرور فإن وقف القلب مع أحدها، أو زين له بعضها أوتقلب قلبه في شيئ منها عند آخر أنفاسه ختم له بذلك، فخرجت روحه على الشك أو الشرك، وهذا هو سوء الخاتمة، وهو نصيب العبد من الكتاب في السابقة عند خلق الأرواح، معدومة لها في الأشباح في الآباد والآزال قبل إظهار الأكوار والأدوار، فشهدتها الأرواح هناك غرورًا، ووقفت معها وقد زادت لها زورًا رسوم في القلب في التخطيط قبل خلق الأجسام لها، وقبل حجبها بكشف الهياكل عند ظهورها في الوجود، وقبل إقامتها بشاهد العقل، لكن بشاهد الأولية بدت، وبمعنى القيومية وجدت، وبوصف الجامع جمعت ثم فرقت ههنا، فظهرت الآن عند الفراق، لما كانت شهدت في التلاق، واعترفت في الآخر بما كانت نطقت في الأول وخرجت الروح على ما شهدت، وهذا كان خبر السابقة التي أدركت الأرواح المرافقة لها في الأجسام عند الخاتمة.
ومن ذلك جاء في الأثر: يأخذ ملك الأرحام النطفة في يده فيقول: يارب أذكر أم أنثى؟ أسوى أم معوج، ما رزقه، وما عمله؟ ما أثره ماخلقه؟ قال: ثم يخلق الله تعالى على يده كما قال: فإذا صورة قال: يارب أنفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة فلذلك خرجت الروح بما دخلت به (فَأَمّا إنْ كانَ مِنَ المقَرَّبينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجَنَّةٌ نَعيمٍ وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمينِ، فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ اليَمينِ، وأَمّا إنْ كَانَ مِنَ المُكَذِّبينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ، وَتَصْلِيَةُ جَحيمٍ) الواقعة: 88 - 94 (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَريقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ) الأعراف: 29 (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) الأنبياء: 104 (ولَوْ شِئْنا لآَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها ولكنْ حَقَّ القَوْلَ مِنِّي) السجدة: 13 وقال سبحانه وتعالى: (إنَّ الذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنى) الأنبياء: 101 (إنَّ الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِم كَلِمَةُ رَبِّكَ) يونس: 96 (ولَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنِّ والإنْسِ) الأعراف: 179 (وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلكَ هُمْ لها عَامِلُونَ) المؤمنون: 63 (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) الزمر: 47 (إنَّ في هَذا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدينَ) الأنبياء: 106 فهذه الآي ونظائرها وردت في السوابق الأول والخواتم الآخر، وفيها سرائر الغيوب وغرائب الفهوم، وهي من آي المطلع لأهل الإشراف على شرفات العرش والأعراف.
وقال بعض العارفين: لو علمت أحدًا على التوحيد خمسين سنة ثم حالت بيني وبينه أسطوانة فمات لم أقطع له بالتوحيد، لأني لا أدري ما ظهر من التقليب.
وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل حركة، وكل خطرة وهمة، يخافون البعد من الله تعالى، وهم الذين مدح الله تبارك وتعالى (وقلوبهم وجلة) وقال لا يصح خوفه حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من السيئات.
وقال أيضًا: أعلى الخوف أن يخاف سابق علم الله تعالى فيه، ويحذر أن يكون منه حدث خلاف السنة يجره إلى الكفر، وقال: خوف التعظيم ميزان خوف السابقة.
وكان بعض العارفين يقول: لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الشهادة، قيل ولم؟ قال: لأني لا أدري ما يعرض بقلبي من المشاهدة فيما بين باب الحجرة وباب الدار فيغير التوحيد.
وروينا عن زهير بن نعيم الباني قال: ما أكبر همي ذنوبي، إنما أخاف ما هو أعظم عليّ من الذنوب وهو أن أسلب التوحيد، وأموت على غيره، وروي ابن المبارك عن أبي لهيعة عن بكر بن سوادة قال: كان رجل يعتزل الناس أينما كان يكون وحده فجاء أبو الدرداء فقال: أنشدك الله تعالى ما يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر، قال: أترى في الحي مائة يخافون ما تخاف؟ فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة قال: فحدثت بذلك رجلاً من أهل الشام فقال ذلك شرحبيل بن سمط يعني من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد كان أبوالدرداء يحلف بالله تعالى ويقول: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه، وقد كان بعض علمائنا يقول: من أعطى التوحيد أعطيه بكماله، ومن منعه منعه بكماله إذا كان التوحيد في نفسه لا يتبعض.
ولما احتضر سفيان الثوري رضي الله عنه جعل يبكي ويجزع فقيل له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا، وقال مرة: ذنوبي أهون من هذه ورفع حبة من الأرض إنما أخاف أن أسلب التوحيد في آخر الوقت، وقد كان رحمه الله أحد الخائفين، كان يبول الدم من شدة الخوف، وكان يمرض المرضة من المخافة، وعرض بوله على بعض الكتابيين فقال: هذا بول راهب من الرهبان وكان يلتفت إلى حماد بن سلمة فيقول: يا أبا سلمة ترجو لمثلي العفو أو يغفر لمثلي؟ فيقول له حماد: نعم أرجو له.
وقد كان بعض العلماء يقول: لو أني أيقنت أن يختم لي بالسعادة كان أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس في حياتي أجعله في سبيل الله تعالى.
وحدثني بعض إخواني الصادقين وكان خائفًا أنه أوصى بعض إخوانه فقال: إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي فإذا عاينت فانظر إليّ فإن رأيتني متّ على التوحيد فاعمد إلى جميع ما أملكه فاشتر به لوزًا وسكرًا وانثره على صبيان أهل المدينة وقل: هذا عرس المنفلت، وإن رأيتني متّ على غير التوحيد فأعلم الناس أني قد متّ على غير التوحيد حتى لا يغتروا بشهود جنازتي ليحضر جنازتي من أحبّ على بصيرة لئلا يلحقني الرياء فأكون قد خدعت المسلمين فقلت: ومن أين أعلم أنك قد متّ على التوحيد؟ فذكر له علامة تظهر من بعض الأموات لم نحبّ ذكرها، قال: فكنت عند رأسه أنظر إليه كما أمر، حتى أعاين فرأيت علامة حسن الخاتمة وأمارة الموت على التوحيد قد ظهرت وفاضت روحه، قال: فنفّذت وصيتّه كما أمر ولم أحدّث بذلك إلا خصوص إخواني من العلماء؛ وذلك أن العبد مهما عمل في حياته من سوء أعيد ذكره عليه عند فراق الحياة ووقعت مشاهدته فيه عند آخرساعة من عمره، فإن استحلى ذلك بقلبه أو استهواه بنفسه وقف معه فإذا وقف معه حسب عليه عملاً له وإن قل وكان ذلك خاتمته وكذلك ما عمل من خير أعيد ذكره ومشاهدته عليه فإن عقد عليه بقلبه أو أحبّ وقف معه فحسب عملاً له وكان ذلك حسن خاتمته.
وقال بعض هذه الطائفة في قول الله تعالى: (خَلَقَ المَوْتَ وَالَحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ) الملك: 2 قال: يبلوكم بتقليب القلوب في حال الحياة بخواطر الذنوب وفي حال الموت بإلحاد عن التوحيد، فمن خرجت روحه على التوحيد وجاوزت البلاوي كلها إلى المبلى فهو المؤمن وذلك هوالبلاء الحسن، كما قال الله تعالى: (وَلِىُبْلي المُؤْمِنينَ مِنهُ بَلاءً حَسَناً) الأنفال: 17 فهذه المعاني من العلوم أوجبت خوف الخائفين من علم الله تعالى فيهم فلم ينظروا معها إلى محاسن أعمالهم لحقيقة معرفتهم بربهم؛ وهذا الخوف هو الثواب لعلمهم بما يعلمون، فلما سلموا من مطالبة بما يعملون وصحوا على العلم ظهر لهم خوف علم الله تعالى فيهم نعمة من الله تعالى عليهم، فكان ذلك مقامًا لهم، كما قال الله تعالى: (قَالَ رجُلانِ مِنَ الّذينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا) المائدة: 23 قيل بالخوف.
والمقام الآخر لأصحاب اليمين دون هولاء؛ خوف الجنايات والاكتساب، وخوف الوعيد وسرّ العقاب، وخوف التقصير في الأمر وخوف مجاوزة الحدّ وخوف سلب المزيد، وخوف حجاب اليقظة بالغفلة، وخوف حدوث الفترة بعد الاجتهاد عن المعاملة، وخوف وهن العزم بعد القوّة وخوف نكث العهد بنقض التوبة، وخوف الوقوع في الإبتلاء بالسبب الذي وقعت منه التوبة، وخوف عود الاعوجاج عن الاستقامة، وخوف العادة بالشهوة وخوف الحور بعد الكور؛ وهو الرجوع عن الحجة إلى طريق الهوى وحرث الدنيا وخوف اطلاع الله تعالى عليهم عندما سلف من ذنوبهم ونظره إلىهم على قبيح فعلهم فيعرض عنهم ويمقتهم وهذه كلها مخاوف وطرقات لأهل المعارف وبعضها أعلى من بعض وبعضهم أشد خوفًا من بعض، ويقال: إن العرش جوهرة يتلألأ ملء الكون فلا يكون للعبد وجد في حال من الأحوال إلا طبع مثاله في العرض على الصورة التي يكون عليها العبد فإذا كان يوم القيامة ووقف للمحاسبة أظهرت له صورته من العرش فرأى نفسه على هيئته التي كان في الدنيا فذكر فعله بمشاهدته نفسه فيأخذه من الحياء والرعب ما يجلّ وصفه.
ويقال: إن الله سبحانه إذا أعطى عبدًا معرفة ثم لم يعامله بها لم يسلبه إياها، بل أبقاها عليه ليحاسبه على مقدارها، ولكن يرفع عنه البركة ويقطع عنه المزيد.
وقد ذم الله تعالى عبدًا أوجد له نعمة استعمله بها صالحًا بعد أن كان قد ابتلاه بهواه ففخر الآن بعمله ونسي ما قدمت يداه، ولم يخف أن يعيده فيما قد كان جناه في قوله تبارك وتعالى: (ولَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) هود: 10 ومن المخاوف خوف النفاق، وقد كان السلف لصالح من الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين يخافون ذلك.
كان حذيفة رضي الله عنه يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصير بها منافقاً حتى يلقى الله تعالى، إني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات.
وكان يقول: تأتي على القلب ساعة يمتلئ بالإيمان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إبرة، ويأتي عليه ساعة يمتلئ بالنفاق حتى لايكون للإيمان فيه مغرز إبرة.
وكان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الكبائر وفي لفظ آخر: من الموبقات.
وقد كان الحسن رحمه الله يقول: لوأني أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
وقيل: لايعرى من النفاق إلاثلاث طبقات من المؤمنين: الصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء الذين مدحهم اللّّه تعالى بكمال النعمة عليهم، وألحقهم بمقامات أنبيائه لكمال الإيمان وحقيقة اليقين فيهم، وقيل من أمن من النفاق فهو منافق.
وكان بعضهم يقول: علامة النفاق أن يكره من الناس ما يأتي مثله، وأن يحب على شيء من الجور، وأن يبغض على شيء من الحق، ومن النفاق من إذامدح بما ليس فيه أعجبه ذلك.
وعلامات النفاق أكثر من أن تحصى، يقال هي سبعون علامة، والحديث عن رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أربع هن أصولها تتشعب منها الفروع فقال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من نفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب؛ وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر وفي لفظ آخر إذا عاهد غدر فصارت خمساً.
وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على هؤلاء الأمراء ونصدقهم بما يقولون فإذا خرجنا تكلمنا فيهم، فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروينا عنه من طريق آخر أنه سمع رجلاً يذم الحجاج ويقع فيه فقال له: أرأيت لو كان الحجاج حاضرًا أكنت تتكلم بما تكلمت به؟ قال لا، قال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأشد من ذلك أن نفرًا قعدوا على باب حذيفة رضي الله عنه ينتظرونه، فكانوا يتكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه، فقال: تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتوا، فقال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأعظم من هذا ما كان الحسن رحمه الله يذهب إليه، كان يقول: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، واختلاف اللسان والقلب، والمدخل والمخرج.
فدقائق النفاق وخفايا الشرك عن نقصان التوحيد وضعف اليقين أوجبت المخاوف على المؤمنين خشية مقت الله تعالى، وخوف حبوط الأعمال.
من ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليخرج من منزله ومعه دينه فيرجع إلى منزله وليس معه من دينه شيء، يلقى الرجل فيقول: إنك لذيت وذيت ويلقى الآخر فيقول لأنت وأنت، ولعله لا يخلى منه بشيء، وقد سخط الله تعالى عليه، يعني به التزكية لما لا يعلم، والمدح لمن يستحق الذم، واختلاف قلبه ولسانه، ففي هذا مقت من الله تعالى.
وفوق هذه المخاوف سلب الإيمان الذي هو عندك في خزانة المؤمن، يظهره كيف شاء، ويأخذه متى شاء، لا يدري أهبة وهبه لك فيبقيه عليك لكرمه؟ أو وديعة وعارية أودعك إياه وأعارك هو؟ فيأخذه إذا لا محالة لعدله وحكمته، وقد أخفى عنك حقيقة ذلك، واستأثر بعاقبته.
وقال بعض العارفين: إنما قطع بالقوم عند الوصول مع الخاتمة: وقال آخر: واخطراه كما قال أبو الدرداء وحلف: ما أحد أمن من أن يسلب إيمانه إلا سلبه، أفرأيت الوقت الذي قال حذيفة: يأتي على القلب ساعة فيمتلئ نفاقاً حتى لا يكون فيه للإيمان مغرز إبرة، إن صادف الموت ذلك الوقت وكان هو آخر وقت، أليس تخرج روحه على النفاق، وكذلك تقليبات القلوب في معاني الشرك وتلويحات الشك إن وافق وقت الوفاة كان خاتمته عند لقاء مولاه، وإنما سميت الخاتمة لأنها آخر عمله وآخر ساعة من العمر، وخاتم الشيء آخره ومن ذلك قوله تعالى: (وَخَاتَمَ النَّبِييِّنَ) الأحزاب: 40 أي آخرهم، ومثله: (خِتَامُه مِسْكٌ) المطففين: 26 وخاتمه مسك أي آخر الكأس، بدلاً من الثفل يكون مسكاً.
ومن المخاوف خوف قطع المزيد من علم الإيمان مع بقية المعرفة المبتدأة ليكون مستدرجاً بها كما قال بعض العلماء: إن الله تبارك وتعالى إذا أعطى عبدًا معرفة فلم يعامله بها لم يسلبه تلك المعرفة ولكن بقاؤها فيه حجة عليه ليحاسبه على قدرها وإنما يقطع عنه المزيد وقد يقسى قلبه وتجري عينه وذلك من النقصان الذي لا يعرفه إلا أهل التمام لأنه يمنعه منه ما ينفعه عنده ويعطيه ما يغترّ به ويفتتن عند الخلق لأن عين الوجه من الملك للدنيا وعين القلب من الملكوت للآخرة وقال مالك ابن دينار: قرأت في التوراة: إذا استكمل العبد النفاق ملك عينيه فيبكي متى شاء وقد كانوا يستعيذون بالله عزّ وجلّ من بكاء النفاق وهو أن يفتح للعبد ألوان البكاء ويغلق عنه باب الذل والخشوع.
وقد قال الله عزّ وجلّ: (وَجَاءُوا أَباهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ) يوسف: 16 وكان السلف أيضًا يقولون: استعيذوا بالله من خشوع النفاق قيل: وما هو؟ قال: أن تبكي العين والقلب قاس فلأن يعطي الإنسان رقة القلب في جمود عين خير من أن يعطي دموع عين في قسوة قلب، ورقة القلب عند أهل القلوب هو خشوعه وخوفه وذلّه وانكساره وإخباته، فمن أعطاه هذا في قلبه لم يضرّه ما منعه من بكاء عينه فإن رحج له بفيض العين فهو فضل، ومن أعطاه بكاء العين وحرمه خشوع القلب وذلّه وخضوعه وإخباته فهو مكر به؛ وهذا هو حقيقة المنع وعدم النفع وجملة بكاء العين إنما هو في علم العقل، فأما علم التوحيد بمشاهدة اليقين فلا بكاء فيه لأنه يظهر لشاهد الوحدانية فيحمله على علم القدرة فتفيض الدموع بانتشاق القوّة، وقد وصف الله تعالى الباكين: إن البكاء يزيدهم خشوعاً في قوله تعالى: (يَبْكُونَ وَيَزيدُهمْ خُشُوعًا) الإسراء: 109 فإذا زادنا البكاء كبرًا وفخرًا علمنا بذلك عدم الخشوع في القلب فكان تصنّعاً وعجباً لخفايا آفات النفوس، فأعلى المخاوف خوف السوابق والخواتم كما كان بعض العارفين يقول: ما بكائي وغمّي من ذنوبي وشهواتي لأنها أخلاقي وصفاتي لا يليق بي غيرها إنما حزني وحسرتي كيف كان قسمي منه ونصيبي حين قسم الأقسام وفرق العطاء بين العباد فكيف كان قسمي منه البعد، فهذا الذي ذكرناه هو جمل خوف العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وهم أبدال النبيين وأئمة المتقين، أولو القوّة والتمكين، وسئل أبو محمد رحمه الله: هل يعطي الله أحداً من الخوف مثقالاً فقال: من المؤمنين من يعطي من الخوف وزن الجبل قيل: فكيف يكون حالهم يأكلون وينامون وينكحون؟ قال: نعم يفعلون ذلك والمشاهدة لا تفارقهم والمأوى يظلّهم قيل: فأين الخوف قال: يحمله حجاب القدرة بلطيف الحكمة ويستر القلب تحت الحجاب في التصريف بصفات البشرية فيكون مثل هذا العبد مثل المرسلين، وهذا كما قال لأن مشاهدة التوحيد بالتصريف والحكمة تقيمه بالقيام بالأحكام، وذلك أن نور الإيمان في القلب عظيم لو ظهر للقلب لأحرق الجسم وما اتصل به من الملك إلا أنه مستور بالفضل مغطّى بالعلم لإيقاع الأحكام، وإيجاب التصريف فيها والقيام يجري مجرى الغايات من معاني القدر والصفات لأن الأنوار محجوبة بالأسماء والأسماء محجوبة بالأفعال والأفعال محجوبة بالحركات فتظهر الحركة بالقدرة وهي غيب من ورائها، كذلك يظهر التصريف بالحكمة من نور الإيمان وأنوار الإيمان مستورة من ورائه.
وقال بعض العارفين: لو كشف وجه المؤمن للخلق عند الله تعالى لعبدوه من دون الله تعالى ولو ظهر نور قلبه للدنيا لم يثبت له شيء على وجه الأرض، فسبحان من ستر القدرة ومعانيها بالحكمة وأسبابها حلمًا منه ورحمة وتطريقًا للخلق إليه للمنفعة، وفي قراءة أبيّ بن كعب مثل نور المؤمن، فولا أن نوره من نوره ما استجاز إبدال حرف بغير معناه، وقد كان سهل رحمه الله تعالى يقول: الخوف مباينة للنهي والخشية الورع والإشفاق الزهد، وكان يقول: دخول الخوف على الجاهل يدعوه إلى العلم، ودخوله على العالم يدعوه إلى الزهد، ودخوله على العامل يدعوه إلى الإخلاص، وقال أيضًا الإخلاص فريضة لا تنال إلا بالخوف ولا ينال الخوف إلا بالزهد فقد صار الخوف يصلح للكافة إذ دخوله على العامة يخرجهم عن الحرام، ودخوله على الخاصة يدخلهم في الورع والزهد، لأن من خاف ترك، وقال أيضًا: من أحبّ أن يرى خوف الله تعالى في قلبه فلا يأكل إلا حلالاً ولا يصلح علم الرجاء إلا للخائف، وقال: الخوف ذكر والمحبة أنثى، ألا ترى أن أكثر النساء يدعون المحبة يريد بهذا أن فضل الخوف على الرجاء كفضل الذكر على الأنثى؛ وهذا كما قال لأن الخوف حال العلماء، والرجاء حال العمّال، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضل من علم أحبّ إليّ من فضل من عمل، وخير دينكم الورع واعلم أن الخوف عند العلماء على غير ما يتصوّر في أوهام العامة وخلاف ما يعدّونه من القلق والاحتراق أو الوله والانزعاج لأن هذه خطرات وأحوال ومواجيد للوالهين وليست من حقيقة العلم في شيء، بمنزلة مواجيد بعض الصوفية من العارفين في أحوال المحبة، من احتراقهم وولههم.
والخوف عند العلماء إنما هو اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة، فإذا أعطى عبد حقيقة العلم وصدق اليقين سمي هذا خائفاً، فلذلك كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخوف الخلق، لأنه كان على حقيقة العلم ومن أشدهم حباً لله تعالى، لأنه كان في نهاية القرب، وقد كان حالة السكينة والوقار في المقامين معاً، والتمكين والتثبيت في الأحوال كلها، ولم يكن وصفه القلق والانزعاج، ولا الوله والاستهتار، وقد أعطي أضعاف عقول الخليقة وعلومهم، ووسع قلبه لهم، وشرح صدره للصبر عليهم.
فكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الأعرابي كأنه أعرابي، ومع الصبي بمعناه، ومع المرأة في نحوها، يقاربهم في علومهم، ويخاطبهم بعقولهم، ويظهر منه مثل وجدهم، ليعطيهم نصيبهم من الأنس به، ويوفيهم حقوقهم من الدرك منه، ولئلا تعظم هيبته في صدورهم، فينقطعون عن السؤال له والأنس به حكمة منه، لا يفطنون لها ورحمة منه قد جبل عليها، قد ألبس مواجيدهم لبسة، وأدخل ذلك عليه صبغة، بغير تكلف ولا تصنع، تعلم ذلك من الحكيم العليم، فلذلك وصفه عزّ وجلّ بخلقه، وتعجب من وصفه فقال تعالى: (وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ) القلم: 4 قيل على أخلاق الربوبية، وقرئت بالإضافة ليكون عظم اسم الله سبحانه لا يظهر من حاله ونصيبه شيئاً لقوة التمكين وفضل العقلاء ولا يبخس من نصيبهم منه شيئاً لحقيقة العدل، ولا يتظاهر بشيء لحقيقة الزهد ونهاية الخشوع والتواضع، ولا يظهر عليه شيء لمكانة القوة ورسوخ العلم والحكمة، وعلى منهاجه وسنته وصف العارفين من أهل البلاء الذين هم الأمثل فالأمثل بالأنبياء.
وقال بعض أهل المعرفة: من طالب الخلق بعلمه وخاطبهم بعقله، فقد بخسهم حقوقهم منه، ولم يقم بحق الله تعالى فيهم.
وقال بعض العلماء: لا يكون إماماً من حدث الناس بكل ما علمه وأظهر لهم نصيبه وكان يحيى بن معاذ يقول: لا تخرج أحداً من طريقه ولا تخاطبه بغير علمه فتتعب، ولكن أغرف له من نهره، واسقه بكأسه.
وسئل بعض العلماء عن العارف، هل يستوحش من الخلق؟ قال: لا يستوحش، ولكن قد يكون نفوراً، قيل: فهل يستوحش منه؟ فقال العارف لا يستوحش منه، ولكن قد يهاب.
ومما يدلك أن الخوف اسم لحقيقة العلم أن في قراءة أبي بن كعب في قوله تعالى: (فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا) الكهف: 80 فخاف ربك أن يرهقهما.
وقال يحيى بن زياد النحوي: ومعناه فعلم ربك، وقال: الخوف من أسماء العلم والله أعلم.
بيان آخر في معنى الخوف
والخوف أيضاً من أسماء المعاني، فوجوده بانتفاء ضده فإذا عدم من القلب الأمن من كل وجه من أحوال الدنيا وأمور الآخرة؛ فلم يأمن مكر الله تعالى في كل الأحوال، في تصريف أحكام الدنيا وتقليب حركات القلوب والنفوس، وجواذب الشهوات، وإثارة طبائع العادات، ولم يسكن إلى عرف ولا اعتياد، ولم يقطع بسلامته وبراءته في شيء كان هذا خوفاً، وسمى العبد بفقد الأمن من جميع ذلك خائفاً، فهذا مستعمل فاش في كلام العرب، ومذهبهم، يقول أحدهم: أخاف من كذا إذا لم يأمنه، أو أخاف أن يكون كذا إذا تحقق علمه.
وقيل لبعض العلماء: ما بال العارف يخاف في كل حال؟ فقال: لعلمه أن الله تعالى قد يأخذ في جميع الأحوال.
ثم إن للخائفين بعد هذا طرقاً ووجهة من قبل الخوف المقلق والإشفاق المزعج، والوجل المحرق، وهي مجاوزات للطرق السابلة التي هي محاج للأئمة المختارة الفاضلة، وفيها متاوه ومهالك، نقلت عنها العلماء السادة، والصفوة المختارة، إلا أنه قد سلك ببعض الزهاد والعباد فيها وأريد بعض العارفين بها ليست بمفضلة كل ذلك عن العلماء، ولا بمتنافس فيها مغبوط عليها عند العارفين، لأنها قد تخرج من طرقات المسالك إلى مفاوز المهالك، وإنما أريد ببعضهم التعريف لها والاطلاع عليها، ومنهم من أريد منه التيه والوله فيها إلا أنها أشهر في أسماع العامة وأعجب وأهول عند العموم.
ذكر تفصيل هذه المخاوف
اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من القلب، فإلى أي مفيض فاض من القلب إليه أتلف صاحبه به إلا ما يستثنيه.
قد يفيض الخوف من القلب إلى المرارة وهي أرق صفات الأدمة، وهي باطن البشرة فيحرقها فيقتل العبد، وهؤلاء هم الذين يموتون من الغشى والصعق وبداوة الوجه، وهم ضعفاء العمال.
وقد يطير الخوف من القلب إلى الدماغ فيحرق العقل فيتيه العبد فيذهب الحال ويسقط المقام.
وقد يحل الخوف السحر وهو الرئة فينقبها فيذهب الأكل والشرب حتى يسلّ الجسم وينشف الدم، وهذا لأهل الجوع والطي والاصفرار.
وقد يسكن الخوف الكبد، فيورث الكمد اللازم، والحزن الدائم ويحدث الفكر الطويل والسهر الذاهب، وفي هذا المقام يذهب النوم ويدوخ السهر وهذا من أفضلها، وفي هذا الخوف العلم والمشاهدة وهو من خوف العاملين، وقد يقدح الخوف في الفرائص؛ والفريصة هي اللحمة التي تكون على الكتف، يقال للحمتي الكتفين: الفريصتان وجمعها الفرائص، ومنه الخبر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه الفريصتان من اللحم وهو أرقّ لحم الحيوان وأعذبه، فمن هذا الخوف يكون الاضطراب والارتعاش واختلاف الحركة، وقد يبدو الخوف من القلب فيغشى العقل فيمحي سلطانه لقهر سلطان القدرة ومحو الشمس إذا برزت ضوء القمر للبادي الذي يبدو على السر من خزائن الملكوت فيضعف لحمله العقل فيضطرب لضعفه الجسم فلا يتمكّن العبد من القرار لضعف صفته وذلك أن أجزاء الإنسان وإن كانت متفرقة في البنيان للحكمة والإتقان فهي كشيء واحد يجمعها لطيف القدرة بإظهار المشيئة، فأسفل البنية منوط بأعلاها فإذا اضطراب أعلاها مال أسفلها وإذا وصل الداء أو الدواء إلى عضو منها تداعى له سائرها، وهذه الطائفة أشبه بالفضل وأدخل في وصف العلم وقد سلك في هذا الطريق أكابر العماء وأفاضل أهل القلوب وقد كان هؤلاء في التابعين كثير منهم؛ الربيع بن خيثم وأويس القرني، وزرارة بن أوفى، ونظراؤهم من الأخيار رضي الله عنهم، ولم ينكر هذا عليّة الصحابة مثل عمر وابن مسعود رضي الله عنهم.
وقد كان عمر رضي الله عنه يغشى عليه حتى يضطرب مثل البعير ويسقط من قيام، وقد كان ذلك يلحق سعيد بن جذيم، وكان من زهاد أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أمراء الأجناد بعثه عمر رضي الله عنه واليًا على أهل الشام، وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر في ذلك ويبعث إليه بالمائة دينار وبأربعمائة دينار ليستنفقها على أهله فيفرق ذلك على الغزاة في قصة طويلة، فكتب إليه أهل الشام يذكرون شأنه، وكان يغشى عليه في مجلسه فخشوا عليه من دخيلة في عقله ولم يعرف ذلك أهل الشام فسأله عمر لما لقيه الذي يصيبه إذا تحدث فأخبره بما يجد من مشاهدته وهو وجد الصوفية من أهل الأحوال، فعرف عمر ذلك وعذره، وما زاده ذلك عنده إلا خيرًا فكان يرمه ويعرف له فضله، وكتب إلى أهل الشام أن لا تعنفوا في أمره ودعوه وقد كان أقوى الأقوياء وهادي الهداة رسول رب العالمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يغشى عليه عند نزول الوحي إذا لبسه أزال ترتيب العقل منه ورفع مكان الكون عنه ويغط ويتربد وجهه وينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، إلا أن هذا كان يصيبه في ضرب من الوحي إذا تغشاه ونزل عليه روح القدس في روحه واستبطن قلبه لأن الوحي على أربعة أضرب؛ ضربان متصلان هذا أحدهما، وضربان منفصلان، ومن كل واحد يلحق العلماء بالله تعالى أهل القلوب الناظرة والشهادة الحاضرة، وشرح هذا يطول وليس يعرفه علم يقين إلا من سلك طريقه ولا يشهده شهادة تحقيق إلا من ذاق حقيقته ومن آمن به تصديق تسليم فله منه نصيب، إلا أن هذا في أهل مقامات ثلاث من المقرّبين؛ مقام المعرفة؛ والمحبة والخوف، وكل ضروب الوحي بعد هذه الأربعة وهي عشرة لأهل هذه المقامات الثلاث منه نصيب خواطر أو وجد أوشهادة أوحال أو مقام؛ وهو وصف التمام إلا نوعين من أنواع الوحي فإنهما ممتنع ومخصوص بهما المرسلون؛ أحدهما ظهور الملك في صورته وسمع كلام الله بصفته ونظر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جبريل عليه السلام في صورته بالأبطح فصعق.
وروى حمزة عن حمران بن أعين أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ آية في سورة الحاقة فصعق وقال الله تعالى: (وخَرَّ موسى صَعِقًا) الأعراف: 143 وقد يفيض الخوف من القلب إلى النفس فيحرق الشهوات ويمحو العادات ويخمد الطبع ويُطفئ شعل الهوى وهذا أحد المخاوف وأعلاها عند أهل المعارف، وهؤلاء أفضل الخائفين وأرفعهم مقامًا؛ وهو خوف الأنبياء الصدّيقين وخصوص الشهداء، وليس فوق هذا وصف يغبط عليه الخائف ولا يفرح به عارف، فإن جاوز الخوف هذه الأوصاف فقد خرج من حدّه وجاوز قدره لأنه إذا أحرق الشهوات ومحا الأهواء فلم يترك شهوة ولا هوى ثم إن لم يعصم العبد من مجاوزة حدّ الخوف خرج به الخوف إلى أحد ثلاثة معانٍ خيرها أن يسري إلى النفس فيحرقها فيتلف العبد فتكون له شهادة، وليس هذا محمودًا عند علماء الخائفين من أرباب العلوم والمشاهدات، إلا أنه قد قال بعض العلماء ما شهداء بدر بأعظم أجرًا ممن مات وجدًا؛ وهذه أوصاف ضعاف المريدين إذ للعلماء الموقنين بكلّ شهادة من اليقين أجر شهيد وأوسطها أن يعلو إلى الدماغ فيدنيه فتنحلّ عقدة العقل لذويه فتضطرب الطبائع لانحلال عقدة العقل ثم تختلط المزاجات لاضطرابها فتحترق الصفراء فتحول سوداء فيكون من ذلك الوسواس والهذيان والتوه والوله، وذلك أن الدماغ جامد وهو مكان للعقل هو مركب عليه معقود به فإذا اختلطت المزاجات اشتعلت فتلهب شعلها إلى الدماغ فأحرقه وأذابه، فحل محل العقل الذي مكانه مخ الدماغ وسلطانه صقال القلب الظاهر كصقال الرقعة، وهو بمنزلة الشمس الطالعة، محلها الفلك العلوي، وشعاعها على الأرض، كذلك العقل محله المخ، وسلطانه في القلب، وفي هذا المقام الطيش والهيمان، وهذا مكروه عند العلماء؛ وقد أصاب ذلك بعض المحبين في مقام المحبة فانطبق عليهم فولهوا بوجوده، ومنهم من فزع ذلك عن قلوبهم فسرى عنهم فنطقوا بعلمه.
وقد كان أبو محمد رحمه الل تعالى يقول لأهل التقلل الطاوين المتقشفين: احفظوا عقولكم، فإنه لم يكن ولى الله ناقص العقل.
والمعنى الثالث وهو شرها في مجاوزة الخوف، هو أن يعظم ويقوى، فيذهب الرجاء إذا لم يواجه بعلم الأخلاق من الجود والكرم والإحسان التي تعدل المقام، فتروح كروب الحال فيخرجه ذلك إلى القنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله تعالى، دخلت عليهم هذه المشاهدة من قبل العدل والإنصاف بمعيار العقل فجاوزت بهم علم وصفه بالكرم، وخفى الألطاف، فتعدت بهم الحدود من قبل قوة نظرهم إلى الاكتساب؛ وتمكن تحكم شهادة الأسباب، ورجوعهم إلى أنفسهم في الحول والاستطاعة، وإثباتهم لتحقيق الوعيد عليهم خاصة لا محالة، والحكم علي الحاكم الراحم بعقولهم وعلومهم، من غير تفويض منهم إلى مشيئته، ولا استلام لقدرته، ولا تأميل لأحد معاني صفاته الحسنى التي تعم جميع صفاتهم السوأى، فظهرت سيئاتهم الثواني أمامهم، فحجبتهم عن المحسن الأول، ولم يعلموا أنهم بإحسانه إليهم أساءوا، وبسبق علمه فيهم تعدوا، وإن قلمه لم يكن بأيديهم إذ جرى بما عليهم، وإن قهر قدرته وسلطان جبره أظهر منهم من خزائنه ما فيهم، يدلك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه المخاوف كانت في البصريين، وأهل عبادان والعسكريين، فكان مذهبهم القدر، والقول باللطف، وتفويض المشيئة وتقديم الاستطاعة.
منهم العمرية أصحاب عمرو، والعبادية شيعة عباد، والفوطية والعطوية أصحاب هشام الفوطى، وابن عطاء الغزالي.
ومنهم التيمية نفوا نصف القدر، ومنهم المنازلية أصحاب المنزلة بين المنزلتين، والقول بمقدور من قادرين، وفعل من فاعلين، فابتلوا بالاعتماد على الأسباب، وبالنظر إلى أولية الاكتساب فحجبهم ذلك عن المقدر الوهاب، فهرب هؤلاء من الأمن والاغترار، فوقعوا في أعظم منهما من القنوط والإياس، فصاروا في كبائر المعاصي من خوفهم منها.
فمثلهم مثل الخوارج، خرجوا على الأئمة بالسيف لإنكار المنكر، فوقعوا في أنكر المنكر من تكفير الأئمة، وإنكارهم السلطان، وتكفيرهم الأمة بالصغائر، وهذا من أبدع البدع، وهؤلاء كلاب أهل النار.
ومثلهم أيضاً مثل المعتزلة، هربوا من طريق المرجئة أن الموحدين لا يدخلون النار، فحققوا الوعيد على الموحدين، وخلدوا الفاسقين في النار، فجاوزوا حد المرجئة وزادوا عليهم، كما جاوزت المرجئة طريق أهل السنة وقصرت عنهم.
وكان شيخنا أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: أهل البدعه كلهم يرون الخروج على السلطان، ويرون السيف على الأمة، ويكفرون الأئمة، فهذا أضر الوجوه في مجاورة الخوف عن قدره، وهو من التعدي لحدود الله تعالى وأمره (قد جعل الله لكل شيء قدرا - ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق: 3 فصدق الرجاء واعتدال الخوف به من نحقيقة العلم بالله تعالى، ومجاوزة الشيء كالتقصير عنه، والمؤمن حقا هو المعتدل بين الخوف والرجاء، فالخوف المتلف للنفس بالموت، أو المزيل للعقل بالفوت خير من هذا الوصف الذي هو القنوط، لأن هذا مزيل للعلم؛ ومسقط للمقام، موقع في الكبائر.
على أن هذين المقامين من الخوف، ليس فيهما علم ولا مشاهدة على الكشف، وإنما هو قوة وجد تصطلم مرارته فتوجد إتلاف النفس، ومحو العقل من عبد بمنزلة خوف الكروبيين خاصة من الأملاك أهل الكرب والتمكن، لأنهم لا ينقلون في المقامات التي يعدلون بها كمقربي الروحانيين.
وبلغني أن منهم جيلاً يخرج كل يوم من تحت العرش بعدد البشر، قد أقلقه الشوق وحقره الكرب، يريد النظر إلى وجه العلىّ الأعلى فيحرقهم شعاع سبحات وجهه الكريم سبحانه وتعالى، فيحترقون احتراق الفراش في المصباح، ثم يعود مثلهم من الغد، فهذا دأبهم إلى يوم القيامة، كل ملك لو جمع السموات والأرضين في كفة غابت في قبضته.
ولعمري إن سائر الملائكة لا ينقلون في المقامات كالمؤمنين، بل لكل ملك مقام معلوم لا ينتقل منه إلى غيره، إنما يمدون من ذلك المقام بمدد لا نهاية له إلى يوم القيامة بأكثر ما يزاد جميع البشر، ولكن أولئك يحمل خوفهم قواهم، ويثبت بمشاهدة وصف المخوف خوفهم وصفاتهم، فلا يئودهم ولا يقتلهم، لأنهم يمدون بالقوى، ويعصمون من الموت، بحفظ آجالهم إلى وقتها في الآخر، على أن منهم من يطيش عقله ويتوله قلبه ومنهم من يصبح في تيهه، ومنهم من يتيه فلا يرد وجهه شيء إلى يوم القيامة، ومنهم من يفزع الفزعة فلا يرتد إليه طرفه، ولا يرجع إليه عقله إلى يوم الحشر، ومنهم من يصعق صعقة فلا يزال في صرخة واحدة إلى نفخ الصدور، وكثير منهم يصعقون عند سماع الكلام من الملك الجبار (حتى إذا فزع عن قلوبهم) سبأ: 23 سألوا الروحانيين من المقربين ذوي الحجب القريبة والرتب العلية، منهم جبريل وإسرافيل وميكائيل (ماذا قال ربكم) فهؤلاء الحاضرون من الناظرين والتمكنون من الشاهدين حجبة القدس أولو المحبة والأنس، قالوا: الحق وهو العليّ الكبير، فمثل هؤلاء الخائفني مثل المخلصين من المؤمنين الذين قال الله: (أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ) الصافات: 41 ومثل الأقوياء من العالمين أولي البصائر والتمكين مثل الصابرين الذين يؤتون أجرهم بغير حساب وهعلماء الموقنين ينقلون في مقامات اليقين بمقتضى أحكامها من مقام خوف إلى مقام رجاء مثله، فإذا عملوا في هذه المقامات بما يقتضيهم رفعوا إلى ما فوقها من مقام رجاء إلى مقام رجاء، هو خيرمنه، ومن حال خوف إلى حال خوف أشرف منه، ثم ينتقلون من مقامات الإشفاق إلى حال الإشتياق ومن أحوال الوجل والإحتراق إلى مقام التملّق والطمأنينة، ومن حال الفزع إلى مقام الأنس ومن الإبعاد والوحشة والتهويل إلى الرضا والمحبة والتأميل، فهذا مكن فضلهم على من وقف في مقامه لم يجاوزه من العموم، ومن استتر بحاله وقام في ظلّ فلم يعطعه إلى ظل ممدود فوقه ولم يرفع منه إلى محل رفيع أعلاه ومثل الخائفين من المؤمنين مثل الكروبيين من الملائكة، ومثل الراجين من المحبين؛ كمثل الروحانيين من المقرّبين، وأصل الرجاء وتفضيله أن عند العلماء بالله تعالى من عظيم الرجاء ما يضاهي عظيم الخوف، فيعدل البنية ويحكم بين المقامين بالسوية، فلا يبدو على قلوبهم بادٍ من الخوف عن مشاهدة وصف من الصفات المخوفة تكربهم إلا طلع طالع وراء من عظيم الرجاء أشهد خلقًامن الأخلاق اللطيفة تروحهم ولا يطرأ على قلوبهم طارئ من الخوف، يهربون منه إلا بدا عليهم بادٍ من الرجاء يأنسون به إليه فتعتدل صفاتهم وتستوي مقاماتهم عن معاينة معنى من معاني صفاته لا ستواء كمال ذاته فتكون قلوبهم كلسان الميزان بين الخوف والرجاء، وتكون كالطائر مقوّمًا بين جناحيه عن شهود وصف وخلق اقتضاء ظهور البلاء والنعماء، فيحمل الخوف الرجاء، ويستولي يالرجاء على الخوف ويفيضان معًا في سعة القلب وقوّته، فيغيبان فيه لأنه قوي بقوي ووسع بواسع وقادر بمقتدر، وينفرد الهمّ عن المعنيين فيقف بمشاهدة منفرد فيحكم عليه ما به أفرد، ومن هذا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بك أحول وبك أقول وبك أصول؛ ومن ذلك قوله في علوّ شهادته ونفاذ علمه من كونه بشاهده أعوذ بك منك، ومثله قوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
فهذا نطق عن وجد في مقام البقاء بعد، فقد حال الفناء هنالك سمع قول الباقي المغني: (كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك) الرحمن: 26 - 27 ومن ذلك الأثر المشهور عن الله سبحانه وتعالى: لم تسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن الشاكر اللين الوادع، ولا يصلح تفصيل ما أجملناه ولاشرح ما رمزناه، وقال بعض علماء السف: ما ألبس المؤمن لبسة أحسن من سكينة في خشوع وذلّة في خضوع فهذا حالان من الخوف، وهي لبسة الأنبياء وسيما علماء الأولياء.
وقال لقمان لابنه: يا بني خف الله تعالى خوفًا لا تيأس فيه من رحمته وارجه رجاء لاتأمن فيه مكره، ثم فسّره مجملاً فقال المؤمن: كذي قلبين؛ يخاف بأحدهما ويرجو بالآخر، ومعنى لك أن المؤمن ذو وصفين عن مشاهدتين لأن المؤمن الأوّل والشاهد الأعلى ذو وصف مخوف مثل البطش والسطوة والعزة والنقمة.
فإذا شهد العبد ما آمن به من هذه الصفات خاف إذا عرفه بها وتجلّى له بشاهدها والمعروف أيضًا هو المألوف ذو أخلاق مرجوّة من الكرم والرفق والرحمة واللطف.
فإذا شهد القلب ما آمن به من هذه الأخلاق رجا من شهده بها فصار العبد لوصفيه الرجاء والخوف عن معنى شهادتيه المخوفة والمرجوّة عن وصفي مخوفه ومرجوّة وصار كذي قلبين كأنه يرجو بقلب ويخاف بآخر، وإنما هما شهادتان في قلب واحد لأنهما مقامان لقلب واحد عن شهود مخوف ومرجوّ واحد؛ فهذا تفسير قول لقمان، وهو صفة المؤمن ذي الإيقان، إلا أن الخائف يوصف بما غلب عليه من الحال عما قوي عليه من مشاهدة ويندرج الرجاء في مقامه، ويوصف الراجي بما قوي عليه من الحال عن غلبة شهادته وينطوي الخوف في مقامه ولا كنه للمخوف تعالى وعلا ولا نهاية للمرجوّ عزّ وجلّ سبحانه وتعالى، فأما الشهيد الموقن العالم المقرّب فبالحالين جميعًا يوصف مع اعتدالهما وبالوصفين جميعًا يعرف مع استوائهما، ثم يغلب عليه الوصف التام والحال الكامل.
فإذا عرف به أدرج الوصفان فيه فيقال: صديق لأنه قد تحقق بالصدق فأغنى عن أن يقال مخلص، ثم يقال عارف لأنه قد رسخ في العلم فكفى أن يقال صادق ثم يقال مقرّ ب لأنه قد أشهد القرب فاقترب ولم يحتجّ إلى أن يقال عامل؛ وهذه أسماء الكمال وأحوال التمام لا يفتقر إلى ذكر حال دونها ولايوصف بوصف كوصف خائف أو راجٍ لوجودهما فيه واعتدالهما عنده لأن الخوف والرجاء قد فاضا عليه ثم غاضا فيه فإذا قلت عارف أو مقرب أو صديق، فقد دخل فيه وصف حبّ خائف راجٍ عامل لا محالة كما إذا قلت فلان هاشميّ استغنيت أن تقول قرشيّ أو عربيّ لأن كل هاشمّي يكون عربّيًا قرشيًّا لا محالة ثم تصفه بوصف التمام أيًا فيندرج الوصفات فيه فتقول: فلان حسنيّ أو حسينيّ فاكتفيت أن تقول هاشميّ أو قرشىّ أوعلويّ، وإن كان هاشميّا قرشيًّا علويًّا لأنه قد عرف أن كل حسينيّ فهو هاشميّ قرشىّ علويّ لامحالة، فأما أن تقول: فلان عربيّ أو هاشميّ أو قرشيّ أو علويّ فلا يعرف إلا بما وسمته به لأنه قد يكون علويًّا وهو الغاية في النسب ولا يكون حسينّيًا وقد يكون هاشمياً غير علويّ ويكون قرشيًّا غير هاشميّ ويكون عربياً غير قرشي فيلزمه وصف ما عرفته حسب، فكذلك قولك: عارف أو محبّ أومقرّب أو صديق هي اسم التمام والكمال في المقامات الي تحتوي على جميع الأسباب كقولك: حسنيّ هو اسم التمام وشرف الكمال الذي يفوق على كل الأنساب ولايصح مقام المعرفة إلا بعين اليقين وشاهد التوحيد بعد أن لا يبقى من النفس بقية في مقام اليقين ولا من الخلق رؤية في شاهد التوحيد فيكون روحانيًّا بعد فناء النفس باليقين ربانيهًا عند شهود الخالق سبق منه التوحيد لأن العارف لا يوسم بحال دون حال وقد استغرق الأحوال ولا يوسم بمقام دون مقام إذ قد جاوز المقامات؛ فحقيقة معناه عارف بالمعروف الذي هو بكل نهاية وفضل موصوف وغموض غريبة عند غير أبناء جنسه أن ينكروه فإن تعرف إليهم أوعرفوه فليس بعارف.
وقال بعضهم في وصف العارف: أن يعرف كلّ شيء ولا يتعرّف إلى شيء وقيل: حقيقته أن يعرف ولا يعرف عن مقتضى وصف من أوصاف الربوبية لأنه روحانيّ ربانيّ، وثلاث مقامات لا يقاس عليها ولايتمثّل بها، فمن قاس عليها أخطأ، ومن تمثّل بها ادّعى مقام النبوّة ومقام المعرفة ومقام محبوب، وقد ذكرنا وصفه في شرح مقام المحبة في كتاب المحبين؛ فهذه طرائق الخائفين وجل صفات العارفين لأنهم متفاوتون في القرب والاقتراب متعالون في التقرّب والتقريب مترافعون في التعرّف والتعريف، فالموقنون من الشهداء وهم المقرّبون من الصديقين بشهادتهم قائمون لهم من القرب الاقتراب ومن التقرّب التقريب ومن التعريف التعرّف ومن الإيلاف التأليف لأن مقامهم من القريب العالي الطريق الأقرب والجهة العليا هم السابقون لأهل مقامات اليمين أوّل القرب والتقرب وأوهل الحبّ التحّبب ولهم التألف والتعريف وهؤلاء الأبرار، ومن أفضل طرقات الخائفين ما سرى خوفه إلى النفس قاطعًا شغل الهوى وأخمد نار الشهوات فسقطت له أثقال المجاهدة وخفّت عنده مؤنه المكابدة ووجدت معه حلاوة الطاعة لفقد حلاوة المعصية واجتمع لهم بالحّق عند زوال التشتت بالهوى والخلق وسكنت النفس بالطمأنينة لمعاينة القلب للشهادة وظهر نعيم الزهد والرضا لباطن الصدق والإخلاص ثم سكن الخوف في القلب بعد ذلك ولم يجاوزه فيتعدّى الحدّ إلى بعض المفائض التي ذكرناها بل كان منه الحزن الدائم والهمّ اللازم والخشوع القائم وهذا هو وصف القلب المنكسر وحال العبد المنجبر الذي يوجد عنده الجبار فجبره بعد كسره فصلح له بعد أن عطل من غيره وصار مزيدًا لعالم الخائف من الله تعالى كشوف اليقين وتنقيله لديه في شهادة المقرّبين فكان القريب لدي موجودًا وصار الحبيب عنده مطلوبًا لأنه من المنكسرة قلوبهم من أجله وبأنه صار عنده من أهله، واعلم أن الذي قطع الخلق عن هذه حلاوة الهوي ولا يخرجها إلا أحد كأسين؛ تجرّع مرارة الخوف فيغلب حلاوة الهوى فيخرجه أو غلبة حلاوة المحبة فيستغرق حلاوة الهوى فيغمره، فإن عدم أحد هذين فهو من المذبذبين بن ذلك.
وروينا أن عليّا رضي الله عنه قال لبعض الخائفين، وقد تاه عقله فأخرجه الخوف إلى القنوط: ما أصارك إلى ما أرى؟ فقال: ذنوبي العظيمة، فقال: ويحك إن رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك فقال: إن ذنوبي أعظم من أن يكفّرها شيء فقال: إن قنوطك من رحمة الله تعالى أعظم من ذنوبك والخوف جند من جنود الله تعالى قد يستخرج من قلوب المريدين والعابدين لا يستخرجه الرجاء فتستجيب له القلوب المرادة به بنهايات الزهد وحائق التوبة وشدة المراقبة، وقد يفعل الله تعالى جميع ذلك بأهل الرجاء في المحبة ومقام الرجاء مستخرج منهم الكرم والحياء والخوف اسم جامع لمقامات الخائفين ثم يشتمل على خمس طبقات، في كل طبقة ثلاث مقامات، فالمقام الأوّل من الخوف هو التقوى؛ وفي هذا المقام المتقون والصالحون والعاملون، والمقام الثاني من الخوف هو الحذر؛ وفي هذا المقام الزاهدون والورعون والخاشعون، والمقام الثالث هو الخشية؛ وفي هذا طبقات العالمين والعابدين والمحسنين، والمقام الرابع هو الوجل؛ وهذا للذاكرين والمخبتين والعارفين، والمقام الخامس هو الإشفاق وهو للصديقين وهم الشهداء والمحّبون وخصوص المقرّبين وخوف هؤلاء عن معرفة الصفات لأجل الموصوف لا عن مشاهدة الاكتساب لأجل العقوبات، كما جاء في الخبر: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود خفني كما تخاف السبع الضاري، فالسبع إنما يخاف لوصفه بالبطش والسطوة ولما ألبس وجهه من الهيبة والكبر لا لأجل ذنب كان من الإنسان إليه، وكذلك لهؤلاء من الرجاء العظيم والنصيب الأوفر على معنى خوفهم ما لا يسع للعموم أن يذكر، فطلبهم برجائهم وحسن ظنهم بما هو لهم لا يصفه إلا هم ولا يعرفه سواهم، جمل ذلك أنصبة القرب ونعيم الأنس وروح اللقاء وسرور التملّق وحلاوة الخدمة وفرح المناجاة وروح الخلوة وارتياح المحاورة فلهم منه تجلّي معاني الصفات وظهور معاني محاسن الأوصاف فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين ولأصحاب اليمين إظهار نعيم الأفعال ومواهب العطاء والأفضال، وقد كان يحيى بن معاذ يقول من عبد الله تعالى بالخوف دون الرجاء غرق في بحار الأذكار، ومن عبده بالرجاء دون الخوف تاه في مفاوز الاغترار، ومن عبده بالخوف والرجاء معًا استقام في محجة الأذكار، وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالى في معناه: إلا أنه جاوز فيه الحدّ فقال: من عبد الله تعالى لخوف فهو جروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحّد والله سبحانه وتعالى أعلم.
شرح مقام الزهد
ووصف أحوال الزاهدين وهو المقام السادس من مقامات اليقين
قد سمّى الله تعالى أهل الزهد علماء بقوله تعالى إذ وصف قارون فخرج على قومه في زينته إلى قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذينَ أُوتفوا الْعِلْمَ وَيْلكُمْ ثَوَابُ الله خَيرٌ لِمَنْ آمَنَ) القصص: 80 قيل: هم الزاهدون في الدنيا، وقال عزّ وجلّ: (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أجْرَهُمُ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرَوا) القصص: 54، جاء في التفسير صبروا على الزهد في (الدنيا وقال جلّ وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم) الرعد: 23 - 24 قيل على الفقر، ويشهد للصبرعن الدنيا في هاتين الآيتين قوله عزّ وجلّ في وصف العلماء الزاهدين لما قال: (وَقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعِلْم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لمنْ آمنَ) القصص: 80، قال عقيب ذلك في بقية ثنائه عليهم: (وَلا يُلَقَّاهَا إلا الصَابِرونَ) القصص: 80 أي عن زينة الدنيا، ثم قال في مدحهم بوصف آخر: (يُؤتونَ أجْرَهُمْ مَرَّتيْنِ بِمَا صَبَرُوا) القصص: 54 فقد حصل للزاهدأجران بصبره على الفقر وبوجود زهده، وللفقير المعدم أجر واحد على الغني لوجود فقره وعدم زهده وعلى ذلك تأويل الخبرين عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في أحدهما: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا، وقال في الخبر الآخر يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام لأن الفقير الزاهد يدخل الجنة قبل الغني المصلح بخمسمائة عام، وهؤلاء خصوص الفقراء، وإن الفقير غير الزاهد يدخل الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا لأجل فقره فقط؛ وهم عموم الفقراء، فصار الأغنياء مفضولين في الحالين معًا، وإن جملة الفقراء يدخلون الجنة قبلهم لمكان غناهم في الدنيا، وإن عموم الأغنياء من أهل الدنيا وأبنائها موقوفون للحساب ومطالبون بالإنفاق والاكتساب بالخبر الثالث: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها الأغنياء وفي معناه الخبر الآخر فقلت: أين الأغنياء؟ فقال: حبسهم الجد أي الحظ، وقد سمّى الله تعالى الفقراء الزاهدين محسنين ووضع عنهم السبيل فقال تعالى: (وَلا عَلى الَّذين لا يجدُونَ مَا يُنْفِقونَ حرَجٌ) التوبة: 91، ثم قال: (مَا عَلَى المُحْسِنينَ منْ سَبيل) التوبة: 91 ثم نصّ عى ذكر من عليه الحجة والمطالبة فقال جلّ وعلا: (إنَّمَا السَبيلُ عَلَى الَّذينَ يَسْتَأْذِنونك وَهُمْ أغْنيَاءُ رَضُوا بأن يَكُونوا مَعَ الْخَوَالِفِ) التوبة: 93 يعني النساء.
وعلى هذا المعنى جاء تأويل قوله تعالى: (إنَّا جَعَلنا ما عَلَى الأرْضِ زينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أيُّهُمْ أَحْسَن عَمَلاً) الكهف: 7 قيل: أزهد في الدنيا فصار الإحسان مقام الزاهدين؛ وهو وصف اليقين، كذلك فسرّه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل ماالإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني على اليقين وهو المشاهدة ولعمري أن الزهد حال الموقن لأن مقتضى يقينه، وقد يحتجّ متوهّم بفضل الأغنياء على الفقراء عنده لقوله تعالى مخبرًا عن الفقراء: (تَوَلّوْا وَأَعْيُنُهمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمعِ حَزَنًا ألا يَجدُوا ما يُنْفِقُون) التوبة: 92، يعلم أن هذا عند أهل التدّبر للقرآن مزيدًا للفقراء لتمام حالهم لما كانوا محسنين كما قال سبحانه وتعالى: (وَسَنَزيدُ المُحْسِنينَ) البقرة: 58 فكان مزيدهم الحزن والإشفاق وخوف التقصير لمشاهدة عظم حقّ الربوبية عليهم حتى كأنهم مسيئون حتى بشرهم الله تعالى بأنهم محسنون لما قال عزّ وجلّ: (مَا عَلَى المُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ) التوبة: 91 لأنه ضمّهم إليهم في الوصف وعطفهم عليهم في المعنى، وأيضًا فلم يكن بكاؤهم على فوت الدنيا ولا على طلب الغنى، والله تعالى يمدحهم بصبرهم عن الدنيا ويذم الدنيا إليهم بل حزنهم على طلب المزيد من الفقر ليجدوا الإنفاق فيخرجوه فيفتقروا منه فيزدادون فقرًا ببذله إلى فقرهم فعلى كثرة الإنفاق وحقيقة الفقر من الدنيا كان حزنهم فهذا فضل ثانٍ للفقراء لا على الجمع والادخار والموضع الأعلى الذي فضل الفقراء من هذه الآية عن أهل الاستنباط والتفكّر وهو مشاركتهم لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حاله، ووصف الله تعالى رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حالهم في قوله تعالى: (قُلَت لا أجدُ مَا أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) التوبة: 92 ثم نعتهم بمثله لأنهم هم الأمثل، فالأمثل به فقال تعالى: (ألا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) التوبة: 92 فمن كان برسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمثل فهو أفضل، كيف وقد روينا عن النبي: تحفة المؤمن في الدنيا الفقر فجعل الفقر تحية له من ذي التحيات المباركات مع الخبر المشهور: الفقر على المؤمن أزين من العذار على خد الفرس الجواد، والفقر اختيار رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشعار الأنبياء وطريقة علية الصحابة والأصفياء.
وروينا في الخبر: آخر الأنبياء دخولاً الجنة سليمان بن داود لمكان ملكه وآخر أصحابي دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لأجل غناه في الدنيا وفي الخبر الآخر رأيته يدخل الجنة زحفًا ولا نعلم في الأمة أفضل من طائفتين؛ المهاجرون وأهل الصفة وجميعًا مدح الله تعالى بالفقر، فقال (للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله) البقرة: 372 (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) الحشر: 8 فقدم وصفهم بالفقر على أعمالهم الهجرة والحصر، والله تعالى لا يمدح من يحبّ إلا بما يحبّ ولا يصفه حتى يحبه.
وروينا في قوله تعالى: (وَجَعَلْناهُمْ أَئمَةً يَهْدُونَ بِأمْرِنا) الأنبياء: 73 لما صبروا قيل: عن الدنيا، وفي خبر: العلماء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا فإذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم، وجاء في الأثر لا يزال لا إله إلا اللّّه ترفع عن العباد سخط الله تعالى ما لم ينالوا ما نقص من دنياهم، وفي خبر آخر ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله قال الله عزّ وجلّ: كذبتم لستم بها صادقين.
وقد روينا في خبر عن أهل البيت: إذا أحبّ الله تعالى عبدًا ابتلاه، فإذا أحبه الحبّ البالغ اقتناه، قيل: وما اقتناؤه؟ قال لم يترك له أهلاً ولا مالاً، وفي أخبار أهل الكتب: أوحى الله تعالى إلى بعض أوليائه: احذر إذا مقتك فتسقط من عيني فأصبّ عليك الدنيا صبًّا ويقال: ليس عمل من أعمال البر يجمع الطاعات كلها إلا الزهد في الدنيا، وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم: تابعنا الأعمال كلّها فلم نر أبلغ في أمر الآخرة من زهد في الدنيا وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم أكثر أعمالاً واجتهادًا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهم كانوا خيرًا منكم، قيل ولم ذلك؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا، وفي وصية لقمان لابنه: واعلم أن أعون الأشياء على الدين زهادة في الدنيا، ويقال: من زهدفي الدنيا أربعين يومًا أجرى الله تعالى ينابيع الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، وفي خبر آخر: إذا رأيتم العبد قد أعطى صمتًا وزهدًا في الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة، وقد قال الله تعالى: (مَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فقد أُوتِيَ خَيْرًا كَثيرًا) البقرة: 269
وروينا في الآثار جمل هذه الأخبار: من أصبح وهمه الدنيا شتّت الله تعالى عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم ينل من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وقال الله تعالى في معنى ذلك: (مَنْ كَاَن يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريدُ حرْثَ الدُّنيا نُؤتِه مِنها وَمَا لَهُ في الآخرِةِ منْ نَصيبٍ) الشورى: 20 وقد روينا في خبر قلنا: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: مجموم القلب صدوق اللسان قلنا: يا رسول اللّّه وما مجموم القلب؟ قال التقيّ النقيّ الذي لا غلّ فيه ولا غشّ ولاحسد ولا بغي قيل: يا رسول الله فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحبّ الآخرة والشيء يعرف بضده كما يعرف بمثله وضد الشنئان المحبة وضد الزهد الرغبة، وفي دليل خطابه: إن شرّ الناس الذي يحبه الدنيا وإن الراغب فيها هو المحبّ لها، والإقتناء لها والاستكثار منها علامة الرغبة فيها، كيف وقد جاء أيضًا: إن أردت أن يحبك الله تعالى فازهد في الدنيا فجعل الزهد سبب محبة الله تعالى فصار الزاهد حبيب الله تعالى فينبغي أن يكون الزهد من أفضل الأحوال إذ المحبة أعلى المقامات، وفي دليل الكلام: إن من رغب في الدنيا فقد تعرض لبغض الله تعالى الذي لاشيء أعظم منه وأن المحبّ للدنيا بغيض الله تعالى، وكان أبو محمد رحمه الله تعالى يقول: اجعلوا أعمال البّركلّها في موازين الزهّاد ويكون ثواب زهدهم زيادة لهم، وقال أيضًا: العباد في موازين العلماء والعلماء في موازين الزهاد يوم القيامة فلا يطمعنّ طامع في محبة الله تعالى وهو محبّ للدنيا لأن الله تعالى يمقتها، وفي خبر: ما نظر إليها منذ خلقها، يقول لها: اسكتي يا لاشيء أنت وأهلك إلى النار، وفي الخبر: يقول الله تعالى: يوم القيمة للدنيا ميّزوا ما كان منها لي وألقوا سائرها في النار، وكذلك روينا في الأثر: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وفي لفظ آخر: فمثل الدنيا مثل إبليس خلقه الله تعالى للعبد واللعنة ليبتليه ويبتلي به، ويهلكه ويهلك به، وقد شهد ذلك بعض المكاشفين فقال: رأيت الدنيا في صورة جيفة ورأيت إبليس في صورة كلب وهوجاثم عليها، ومنادٍ ينادي من فوق: أنت كلب من كلابي، وهذه جيفة من خلقي وقد جعلتها نصيبك مني، فمن نازعك شيئاً منها فقد سلطتك عليه فجاء من هذا أنها مكانه فمن تمكّن في شيء منها تسلّط العدو بالمكانة منه بقدر ما أصاب منها وقد كوشف بها بعض الأولياء في صورة امرأة ورأى أكفّ الخلق ممدودة إليها هي تجعل في أيديهم شيئًا، قال: فقلت له ما هو قال قال شيء يلتذ وطائفة تمرّ عليها مكتوفي الأيد تعطيهم شيئاً وكوشف بها مورق العجلي في صورة عجوز شمطاء دندانية مسمجة عليها ألوان المصبغات وأنواع الزينة قال: فقلت أعوذ باللّّه منك فقالت: إن أردت أن يعيذك الله تعالى مني فابغض الدرهم، وكذلك جاء في الخبر: الدنيا موقوفة منذ خلقها الله تعالى بين السماء والأرض لا ينظر إليها فتقول يوم القيامة: ياربّ اجعلني لأدنى أوليائك نصيبًا اليوم فيقول: اسكتي يا لا شيء أنا لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم وقال بعض السلف الدنيا دنيئة وأدنى منها قلب من يحبّها.
وروي عن عليّ كرّم الله وجهه: الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على مزاحمة الكلاب، وفي أخبار موسى عليه السلام: إن لم تلق الفقير بمثل ما تلقى به الغني فاجعل كل علم علمتك تحت التراب وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجلت عقوبته، وقال إمامنا أبومحمد رحمه الله تعالى وروينا عن بعض علمائنا في أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمدًا لأجلي وخلقت آدم لأجل محمد وخلقت ما خلقت لأجل ولد آدم، فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته عني ومن اشتغل منهم بي سقت إليه ما خلقته لأجله، وكان يقول: الصديقون في بداياتهم طلبوا الدنيا من الله تعالى فمنعهم فلما تمكّنوا من أحوالهم عرضها عليهم فامتنعوا منها، وكان عيسى عليه السلام يقول للدنيا: إليك عني ياخنزيرة، وقد روينا هذا القول عن يزيد بن ميسرة، وكان من علماء الشام قال: كان أشياخنا يسمّون الدنيا خنزيرة ولو وجدوا لها اسّماً شرَّا من هذا سموها به قال: وكانت إذا أقبلت على أحدهم الدنيا قال لها: إليك عنّا يا خنزيرة، لا حاجة لنا بك إنّا قد عرفنا إلهنا عزّ وجلّ معناه قد عرفناه بلا ابتلاء بك لينظر كيف نعمل في الزهد فيك والأثرة له سبحانه وتعالى، وعرفناه أيًضا بالمقت لك فوافقناه في ذلك وعرفناه أيضًا فتألهت قلوبنا إليه أعرضنا عمّا سواه، وكذلك كان الحسن رحمه الله تعالى يصف أشياخه كان أحدهم يعرض عليه المال الحلال فيقال: خذه فاستغن به فيقول لا حاجة لي فيه أخاف أن يفسد على قلبي فهذا كان له قلب صالح راعاه فخاف تغيّره كذلك.
روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنه مرّ بجدي ميت أجرب فقال: أترون هذا هان على أهله قلنا: يا رسول الله من هو؟ إنه ألقوه فقال للدنيا أهون على الله تعالى من هذا على أهله، وفي لفظ آخر: أنه قال: أيكم يحبّ أن هذا له بدرهم قلنا: لا أينا وأي شيء يساوي هذا؟ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، وكذلك أخبر بالغاية في قلتها وعدم قيمتها بقوله: ولو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء، وضرب المثل في نتنها وانقلابها على أهلها بقوله للأعرابي: أرأيت ما تأكلون وتشربون ألستم تتغوطون وتبولون؟ قال: بلى، قال: فإلى أي شيء يصير؟ قال: إلى ما علمت يا رسول الله قال أليس يقعد أحدكم خلف بيته فيجعل يده على أنفه من نتن ريحه، قال: نعم قال: فإن الله تعالى جعل الدنيا مثلاً لما يخرج من ابن آدم، وكذلك روينا في تأويل قوله تعالى: (وَفي أَنْفُسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُونَ) الذاريات: 21 قيل: مواضع الغائط والبول، وقال سبحانه وتعالى: (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا في الآخِرَة إلا مَتَاعٌ) الرعد: 26 قال بعض أهل اللغة: متاع أي جيفة، سمعت عن الأصمعي، قال بعض العرب يقول متع اللحم إذا تغير وأنتن، وقد كان الحسن رحمه الله تعالى يقول لما هبط آدم عليه السلام إلى الدنيا كان أوّل شيء عمل فيها أنه أحدث.
وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه نظر إلىما خرج منه فآذاه ريحه فاغتمّ لذلك فقال له جبريل: هذه رائحة خطيئتك فشهد العقلاء عن الله تعالى الدنيا في صورة كنيف فلم يدخلوا فيها إلا ضرورة فكلما استغنيت عن دخولك الكنيف كان أفضل وشهدها بعضهم جيفة فلم ينالوا منها إلا بلغة فكلما تقللت من الجيفة كان خيرًا، وقال وهب بن منبه: قرأت في بعض الكتب: يا بابن آدم إن تردني أترك الدنيا وإن ترد الدنيا طال عناك، وفي بعض كتب الله تعالى: يا ابن آدم أنا بدك اللازم فلا تؤثر على ما منه بد، وقال بعض المخبرين عن الله سبحانه وتعالى: إنه أوحى إلى الدنيا: اخدمي من خدمني واتعبي من خدمك، وقال آخر: وقد روينا مسندًا أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: تمرري لأوليائي حتى تكون رغبتهم فيما عندي واحلولي لأعدائي حتى يكرهوا لقائي، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من أحب ّ لقاء الله تعالى أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه؛ فهذه الآثار كلها، قاصمة لظهر زبناء الدنيا، مسخنة لعين محّبيها ووأضدادها من الأخبار الحسنى في فضل الزهد وشرف الفقر، رافعة لرؤوس الفقراء الصادقين، وقرّة عين الصالحين لله عزّ وجلّ الزاهدين؛ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرهة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأصل الرغبة في الدنيا من ضعف اليقين لأن العبد لو قوي يقينه نظر بنوره إلى الآجل فغاب في نظره العاجل فزهد فيما غاب وأحبّ الحاضر فآثر ما هو أعود عليه وأبقى وأنفع له ولمولاه، أرضى وقدم ما يفنى وينقطع إلى ما يدوم ويتصل؛ وهذا هو صورة الزهد وشهادة الموقن وإن الحاضرلا يحبّ ما غاب وانتقل: ألم تر إلى وصفه عزّ وجلّ لإبراهيم وليكون من الموقنين قال: لا أحبّ الآفلين، والموقن مأمور باتباع ملّة إبراهيم بقوله تعالى: (مِلَّةَ أَبيكُمْ إبْراهيمَ) الحج: 78 أي عليكم ملّة أبيكم إبراهيم واتبعوا ملّته وليس يشهد الوعد والوعيد الآجل بنور العقل إنما يشهد بنور اليقين على أنّا نقول: إن الأنوار أربعة والقلب موجه جهات أربعة إلى الملك والملكوت وإلى العزّ والجبروت؛ فبنور العقل يشهد الملك، وبنورالإيمان يشهد الملكوت وهو الآخرة، وبنور اليقين يشهد العزة وهي الصفات، وبنور المعرفة يشهد الجبروت وهو الوحدانية، والجبار تعالى فوق القلب محيط به يكاشفه بما شاء فيغلب عليه وجد ما أشهده، وضعف اليقين قد يدخل في كلّ شيء، وقوة اليقين تحتاج إليه في كلّ عمل وإلا فهو دنيا يهتدي إلىه بنور العقل، فمن لم يعط نور اليقين لم يرَ الملك الكبير فاستهواه الملك الصغير فأحبّ لا شيء فلم تكن همّته في العلوّ ولا عنده الأعلى شيئًا.
ذكر ماهية الزهد
أيّ شيء هو ليس يمكن عبد أن يعرف الزهد حتى يعرف الدنيا أيّ شيء هي، فقد قال الناس في الزهد أشياء كثيرة ونحن غير محتاجين إلى ذكر أقوالهم بما بيّن الله تعالى وأغنى بكتابه الذي جعل فيه الشفاء والغنى، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هو الحبل المتين والصراط المستقيم من طلب الهدى في غيره أضلّه الله وقال سبحانه تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شيء فحُكْمُهُ إلى الله) الشورى: 10 وقال عزّ وعلاّ: (فَهَدى الله الّذينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بإذْنِه) البقرة: 213 فقد ذكر الله جلّ اسمه في كتابه: إن الدنيا سبعة أشياء وهو قوله تعالى: (زُيَِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشهَوَاتِ مِنَ النِّساء والْبَنينَ والْقنَاطير المُقَنطرةِ من الذَّهبِ والْفَضَّةِ وَالْخيْلِ المُسَوَّمَةِ والأنْعامِ وَالْحرْثِ) آل عمران: 14
ثم قال تعالى في آخرها: (ذلِك مَتَاعُ الْحَياةِ الدُّنيا) آل عمران: 14 ووصف حبّ الشهوات بالتزيّن ثم نسق الأوصاف السبعة على الحبّ لها ثم أشار لها، بقوله تعالى ذلك فذا إشارة إلى الكاف والكاف كناية عن المذكورالمتقدّم المنسوق واللام بين ذا والكاف للتمكين والتوكيد فحصل من تدبر الخطاب أن هذه السبعة جملة الدنيا وأن هذه الدنيا هذه الأوصاف السبعة، وما تفرع من الشهوات ردّ إلى أصل من هذه الجمل، فمن أحبّ جميعها فقد أحبّ جملة الدنيا نهاية الحبّ ومن أحبّ أصلاً منها أو فرعًا من أصل فقد أحبّ بعض الدنيا فعلمنا بنص الكلام أن الشهوة دنيا وفهمنا من دليله أن الحاجات ليست بدنيا لأنه تقع ضرورات فإذا لم تكن الحاجة دنيا دلّ أنه لا تسمّى شهوة، وإن كانت قد تشتهى لأن الشهوة دنيا، ولتفرقة الأسماء لإيقاع الأحكام عليها، واستند ذلك إلى خبر رويناه عن الله سبحانه وتعالى في الإسرائيليات: إن إبراهيم صلوات الله عليه أصابته حاجة فذهب إلى صديق يستقرض منه شيئاً فلم يقرضه فرجع مغمومًاً فأوحى الله تعالى إلىّه: لو سألت خليلك لأعطاك فقال: يا ربّ عرفت مقتك للدنيا فخشيت أن أسألك منها فتمقتني فأوحى الله تعالى إلىه: ليس الحاجة من الدنيا ثم سمعناه تعالى وجلّ قد ردّ هذه السبعة الأوصاف في مكان آخر إلى خمسة معانٍ فقال جلّ من قائل: (اعملوا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر) فهذه الخمسة هي وصف من أحبّ تلك السبعة، ثم اختصر الخمسة في معنيين منها هما جامعان للسبعة فقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ثم ردّ الإثنين إلى وصف واحد وعبّر عنه بمعنيين فصارت الدنيا ترجع إلى شيئين جامعين مختصرين يصلح أن يكون كلّ واحد منهما هو الدنيا، فالوصف الواحد الذي ردّ الاثنين إليه اللذان هما اللعب واللهو هو الهوى اندرجت السبعة فيه.
فقال عزّ وجلّ: (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فإن الجنة هي المأوى) النازعات: 40 - 14 فصارت الدنيا طاعة النفس للهوى بدليل قوله تعالى: (فَأمَّا مَنْ طَغى) (وَآثَرَ الْحيَاةَ الدُّنْيَا) (فإن الْجَحيمَ هِيَ الْمَأْوى) النازعات: 37 - 38 - 39، فلما كانت الجنة ضد الجحيم كان الهوى هو الدنيا لأن النهي عنه صدّ الإيثار له، فمن نهى نفسه عن الهوى فإنه لم يؤثر الدنيا وإذا لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد، كانت له الجنة التي هي ضد الجحيم التي هي لم ينه نفسه عن الهوى بإيثاره الدنيا فصارت الدنيا هي طاعة الهوى وإيثاره في كل شيء فينبغي أن يكون الزهد مخالفة الهوى من كلّ شيء، وأما المعنى الآخر الذي عبّر به عن هذا الوصف الذي هو الهوى فجعله دنيا أيضًا فهو حبّ البقاء لمتعة النفس، استنبطنا ذلك من قوله تعالى: (وَقَالُوا رَبَّنَا لمَ كَتبْتَ عَلَيْنَا القِْتَال لَولا أَخَّرْتَنَا إلى أَجِلٍ قَريبٍ) النساء: 77، فالقتال هو فراق الحياة الدنيا لأنه المشي بالسيف إلى السيف والفناء بين السيفين فقالوا: هلا أبقيتنا إلى وقت آخر وهو أجلنا بالموت لا بالقتل وهذا هو حبّ البقاء ففسر حبِ البقاء بأنه هو الدنيا، فقال تعالى: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَليلٌ والآخرَةُ خَيْرٌ لِمَن اتَّقى) النساء: 77 فانكشف الناس وافتضح المنافقون وابتلى المؤمنون عند فرض القتال وظهر المحبون الذي يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص وعندها ربح الذين هم لأنفسهم وأموالهم بائعون وخسر الذين هم للحياة الدنيا بالآخرة مشترون لما قال الله تعالى: (إنّ الله اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أنُْفسهم وَأمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) التوبة: 111 فلما اشتراها باعوها وقال في المشترين الخاسرين: (اشترُوا الْحَياة الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ) البقرة: 86 يعني رغبوا في البقاء الأدنى لما اشتروه ببيع البقاء الآخرة إذ باعوه، فمن اشترى ثلاثين سنة وأربعين سنة بألف ألف وبأبد الأبد فما ربحت تجارته ولا هدى سبيله؛ فهذه تجارة من رغب في حياة دنياه فاشتراها ببقاء الأبد فقد صار بائعًا للحياة العالية بما استبدل به من اشتراء ضدها فهذا تدبر قوله تعالى: (اشترَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) البقرة: 86 أي باعوا الحياة العليا وذلك الأوّل تجارة من باع حياة نفسه وفرّق مجموع ماله فاشتراه الله تعالى منه وعوضه داره وأسكنه عنده جواره فقد ربحت تجارته واهتدى سبيله؛ لما باع حياة عشرين سنة وثلاثين سنة بحياة أبدالأبد؛ فهذا ربح تجار الآخرة الزاهدين في الدنيا وذلك خسر تجارالدنيا الراغبين في الهوى، فشتان بين التجارتين، فما أعظم حسرة الفوت على من خسر ما ربحه الزاهدون بعد الموت، وقد كان الناس مستورين بإظهار الزهد في البقاء ومظنونًا بهم حبِّ الباقي الأعلى حتى نزلت: (ألَمْ تَرَ إلى الَّذينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أيْديَكُمْ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إذَا فَريقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ الله أوْ أشَدَّ خَشْيَةً) النساء: 77 الآية، وحتى نزل: (يا أيُّهَا الَّذينَ آمنوا لِمَ تَقُولُونَ مَالا تَفْعَلُونَ) الصف: 2، كانوا قالوا: إنّا نحبّ ربنا ولو علمنا في أيّ شيء محبّته لفعلناه، فلذلك قال تعالى: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ الله أنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (إنَّ الله يُحِبُّ الَّذين يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّا) الصف: 3 - 4 ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أحسب أن فينا أحدًا يريد الدنيا حتى نزلت (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) آل عمران: 251، وكذلك قاله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حين نزلت (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم) النساء: 66
قال ابن مسعود قال لي رسول الله عليه السلام: قيل لي: أنت منهم؛ أي من القليل الذي كان يفعل ذلك، فإذا كان حبّ البقاء هو الدنيا فينبغي أن يكون حبّ بقاء الباقي هو الزهد فصار الزهد في الدنيا هو الزهد في البقاء، فمن زهد في الحياة الفانية وفي ماله المجموع بالجهاد للنفس والإنفاق في سبيل الله فقد زهد في الدنيا، ومن زهد في الدنيا أحبّه الله تعالى كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ولذلك صار الجهاد أفضل الأعمال لأنه حقيقة الزهد في الدنيا ولأن الله تعالى يحبّ من زهد في الدنيا ثم كان مخالفة الهوى أفضل الجهاد لأنه هو حقيقة الرغبة في الدنيا، وقد عبّر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الزهد في الدنيا إذ قال في الحديث الأول: ازهد في الدنيا يحبّك الله تعالى، ثم قال في الخبر الثاني بمعناه: اجتنب المحارم يحبك الله تعالى، واجتنابهم زهد في الدنيا، فالزاهد في الدنيا حبيب ربه تعالى، والراغب في حبّ البقاء لنفسه منافق في دين ربّه تعالى، ومنه الخبر الذي جاء: من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، وبه كشف الله تعالى الكاذبين ووصفهم بمرض القلوب.
فقال سبحانه وتعالى: (فَرذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيهَا الْقِيَالُ رَأيْتَ الَّذينَ في قُلُوبِهِم مَرَضٌ) يعني نفاقًا (ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت، فأولى لهم) محمد: 20 تهدد ووعيد أي ولهم العذاب وقرب منهم ثم قال: (طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْروفٌ فَإذا عَزَمَ الأمْر) محمد: 21 وحقّت الحقائق كذبوا ونكثوا، فلو صدقوا الله أي في الوفاء لكان خيًرا لهم، وهذا من الكلام المضمر، فلذلك أشكل والبقاء والحياة اسمان لمعنى، ولذلك جعل الله تعالى الدنيا وصفًا للحياة فتكون الدنيا هي الحياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث لدخول الهاء في الإسم الي هي إحدى علامات التأنيث، فصارت الحياة هي الدنيا وصار قوله الدنيا نعتها بالدناءة، ولو كان الإسم مذكرًا مثل البقاء نعته بمذكر فقال: الأدنى، وقد قال في مثله: (يَأخُذُونَ عَرَض هذا الأدْنى) الأعراف: 169 فالأدنى تذكير الدنيا، والدنيا تأنيث أدنى كالأعين والأقنى والأشعث؛ تذكير عيناء وقنواء وشعثاء، والعرض اسم لما يعرض ويقل بقاؤه فمن أحبّ ذلك فقد أحبّ الدنيا بحبه الأدنى، وهذا يرجع إلى حبّ حياة الأصل لأنه إنما يريد العرض الأدنى لأجل الحياة فصار حبّ البقاء الذي لأجله يريد عرض الأدنى هو الدنيا وصار حبّ العرض لأجل البقاء من الدنيا فجاء من هذا الذي ذكرناه أن حقيقة الدنيا حبّ البقاء لطاعة الهوى وموافقة الهوى في حبّ العرض لأجل البقاء، فدخل أحد هذين في الآخر لأن حبّ البقاء لأجل المتعة، هو من الهوى الذي هو صفة النفس الأمّارة بالسوء وطاعة الهوى الذي هو عيش النفس إنما يكون لحبّ البقاء، لأن العبد لو أيقن بالموت ساعته لآثر الحقّ على الهوى ولو أيس من البقاء لما رغب في العرض الأدنى، فصار حبّ البقاء من الهوى وصار إيثار الهوى إنما هو لحبّ البقاء، فكان ذلك حقيقة الدنيا، وكان أقصر الناس أملا للبقاء أزهدهم في الدنيا حتى لا يدّخر شيئاً لغد لأنه عنده غير باق إلى غد وصار أرغب الناس في الدنيا أطولهم أملاً لأن رغبته اشتدت فيها وحرصه كثر عليها الإمتداد أمله للحياة فيها إذ ولو قصر أمله لغد لاختار الفقر حينئذ واختيار الفقر هو الزهد.
بيان آخر الزهد
أي شيء هو؟ قال الله سبحانه وتعالى: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخسٍ دَرَاِهمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيهِ مِنَ الزَّاهِدينَ) يوسف: 20 فهذه تسمية لهم بالزهد لتحقّقهم بالمعنى نحتاج أن نكشفه ليكون من يتحقق بمعنى ذلك زاهدًا قوله تعالى: وشروه باعوه، العرب تقول: شريت بمعنى بعت لأنهم يقولون: ابتعت بمعنى اشتريت، فلما باعوه وخرج من أيديهم صاروا زاهدين، كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من الله تعالى وخرج من هواه إلى سبيل مولاه فهو من الزاهدين، وكذلك قال المولى عزّ وعلا: (إنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤمِنِنَ أنْفُسَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ بِأنَّ لَهمُ الْجَنَّة) التوبة: 111 كما قال عزّ من قائل: (وَنَهى النَّفْس عَنِ الْهَوَى) (فإنَّ الْجَنَة هِيَ المأوَى) النازعات: 40 - 41 فإذا كان العوض واحدًا وهو الجنة ذكر في المعنيين كان بيع النفس والمال وإخراجهما لله تعالى بمعنى النهي عن الهوى فيهما الذي هوالحياة الدنيا وهو اقتناؤه النفس وحبس النفس عليه أعني المال، فاستبدال ذلك بضدّه من إخراج الهوى من النفس وإدخال الفقر على المال هو الزهد في الدنيا، وليس ذلك من أمر النفس الأمّارة بالسوء لأن هذا نهاية الخير فصار نهيًا لها من الهوى الذي هو اقتناء المال للجمع والمنع، وهذا هو الدنيا بوصف النفس الأمّارة بالسوء لأن هذا حينئذ سوء كلّه، فمن كان بهذا الوصف فنفسه غير مرحومة لأمرها بالسوء، وإذا لم تكن مرحومة لم يكن صاحبها بائعها وإذا لم يبعها لم تكن مشتراة فلا يكون صاحب هذه النفس إلا جامعًا للمال ما نعاً له راغباً في الدنيا محبَّاً لها وليس هذا من صفة المؤمن والله أعلم.
وصف آخر من البيان والتفصيل
لما حقق الله تعالى الزهد بغنى النفس وإخراج المال في ذكر المبيع والمشترى في قوله تعالى: (يُقَاتِلُونَ في سَبيلِ الله فَيَقْتُلُونَ وَيقْتَلُونَ) التوبة: 111 وكان الزهد هو ترك طاعة الهوى وبيع النفس بنهيها عنه من المولى، وكان العوض من ذلك الجنة، كان الزاهد هو الخائف مقام ربه البائع نفسه طوعًا قبل أن يخرج نفسه إليه كرهًا، وكان الله تبارك وتعالى هو المحبوب له القريب منه فصار العبد محبّاً له، فجعله من المقرّبين عنده تعالى، وإذا كانت الدنيا هي طاعة الهوى وحبّ الحياة الدنيّة لمتعة النفس الشهوانية كان الراغب في ذلك آمنًا لمكر الله تعالى مشتريًا للحياة الدنيا بائعاً بذلك الحياة العليا فلم يكن محبَّاً له، وكان من المبعدين عنه بسوء اختياره وحقّ عليه الخسران والجحيم في الآخرة لأنه ضد الزاهد المقرّب الظافر بدار القرب في جوارالحبيب القريب.
ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد
اعلم أن الزهد يكون بمعنيين؛ إن كان الشيء موجودًا فالزهد فيه إخراجه وخروج القلب منه ولا يصحّ الزهد فيه مع تبقيته للنفس لأن ذلك دليل الرغبة فيه؛ وهذا زهد الأغنياء، وإن لم يكن موجودًا وكان العدم هوالحال فالزهد هو الغبطة به والرضا بالفقد؛ وهذا هو زهد الفقراء، وكذلك القول في الزهد في ترك الهوى لا يصحّ إلا بعد الابتلاء به والقدرة عليه، ألم ترَ أن إخوة يوسف عليهم السلام هموا بالزهد فيه بقولهم: ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا لم يسمّهم الله تعالى زاهدين وتكلّموا بالزهد فيه بقولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخلُ لكم وجه أبيكم ولم يسموا زاهدين، وأرادوا الزهد فيه بقولهم: أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب، ولم يتحققوا بالزهد فيه وعزموا على الزهد فيه وأجمعوا عليه ولم يسمّهم الله تعالى زاهدين مع قوله تعالى مخبرًا عنهم: (فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأجْمَعُوا أنْ يَجْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الْجُبِّ) يوسف: 15 لأن هذا كلّه من أسباب الزهد ومقدّماته قد يلتبس ويشكل على من لا يعرف حقيقة الزهد فيظنه زهدًا وليس هو زهدًا لأنه في أيديهم فلما خرج من أيديهم واعتاضوا منه سواه حقّ زهدهم فيه فقال تعالى مخبرًا عن حقيقتهم وشروه أي باعوه: (وَكَانُوا فيهِ مِنَ الزَّاهِدينَ) يوسف: 20 وكذلك الثوب تهمّ ببيعه وتريد بيعه ويغلب عليك بيعه ولا تكون زاهدًا ولكن تكون موصوفًا بالإرادة للزهد حتى تبيعه وتعتاض منه فحينئذ حقّ زهدك فيه، ففي تدبر الخطاب من قوله: وكانوا فيه من الزاهدين أن من أخرج الشيء من يده طوعًا ونفسه تتبعه فله مقام في الزهد بالمجاهدة، ومن أمسك الشيء وأظهرت نفسه الزهد فيه بالإرادة والهمّة فلا مقام له في الزهد لأن الإمساك علامة الرغبة، والرغبة ضدّ الزهد فكيف يوصف بالشيء وضدّه في حال قائمة، فالممسك للشيء المتوّهم للزهد فيه بإظهار نفسه ذلك بأحد وصفين؛ إما أن لا يعرفه الزهد أو لا يعرف خفي شهوة النفس؛ هذا إن لم يموّه على الراغبين والمخرج لقلبه عنه هو المتحقق بالزهد فيه، وهذا هوالذي وصف الله تعالى به إخوة يوسف، والممسك للشيء المغتبط به الذي همّه فيه وقلبه عاكف عليه هو المتحقق بالرغبة فيه؛ وهذا وصف عزيز مصرفي يوسف لما اشتراه فحققه الله تبارك وتعالى بالرغبة فيه لا قتنائه له فقال مخبرًا عنه بعدما اشتراه: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا، وكذلك وصف امرأة فرعون في رغبتها في موسى عليه السلام بقولها قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا، فكذلك كل من أمل شيئًا ادخره لنفسه لا يكون زاهداً فيه حتى يخرجه عن يده وقلبه إذ لم يكن ذلك وصف إخوة يوسف الزاهدين فيه إلا بعد أن أخرجوه استصغاراً له وتعوّضوا منه.
بيان آخرمستنبط من الكتاب
اعلم أن زهد إخوة يوسف عليهم السلام في أخيهم قد كان يقارب زهدهم في يوسف عليه السلام لأنه كان نظيره عند أبيه وقد كانوا همّوا بالزهد فيه أيضًا ليخلو لهم وجه أبيهم منهما، ألم تسمع إلى قولهم: ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منّا، وكذلك جاء في الخبر: إنهم أرادوا أن يلقوا أخاه معه في الجب حتى ألقى نفسه عليه يهوذا فشِفع فيه فرحمه ومنعهم منه وكان شديداً منهم منيعاً مهيباً فيهم، وقد قيل إنه استوهبه منهم وقال: دعوه يكون فيه سلوة للشيخ الكبير لا تفجعوه بهما ولا تفقدوه إياهما معاً فوهبوه له ثم إنّ الله تعالى لم يقل مع إرادتهم لذلك وهمّهم به وكانوا فيهما من الزاهدين من قبل أنهم لم يتحققوا بالزهد فيه كالزهد في أخيه لأنه كان في أيديهم لم يخرجوه فكذلك أنت إذا كان الشيء موجوداً عندك وأنت ممسكه لنفسك ثم توهمت أنك زاهد فيه لخواطر الإرادة أو لإرادة الزهد فقد كذبت علي نفسك بتمسكك إياها زاهدًا وكذبتك نفسك بوجودها جهلاً منها بالعلم زهدًا أو كذب وجدك على العلم جهلاً منك بربك عزّ وجلّ أو موّهت على نفس غيرك ممن لا يعرف الزهد؛ وهذا زهد منك في الزهد ورغبة منك أيضًا في الدنيا حتى يخرج الشيء الذي تظنّ أنك زهدت فيه وتعتاض منه محبة الله تعالى وطلب مرضاته تبارك وتعالى أو ما عنده من ثوابه، فحينئذ يصحّ زهدك فيه على العلم، وعند العلماء فتكون صادقًا، فهناك وصفك الزاهد بالزهد وسمّاك الزاهدون زاهدًا، فأما إذا لم يكن الشيء موجودًا لك فإن زهدك فيما لا تملك لا يصحّ والزهد في معدوم باطل من قبل أن تصرفك لا يصحّ فيما لا تملك، فكذلك لايصحّ زهدك فيه، ولعلّه لو كان موجودًا تغير قلبك به وتقلّب فيه إذ ليس الخبر كالمعاينة لأن الخبر قد يشتبه ويوهم والمعاينة تكشف الحقيقة وتحكم على الخلقة ولأن النفس ذات بدوات لما طبعت عليه من حب المتعة بالرفاهية فكذلك لا يجعل ظنَّاً معدومًا كيقين موجود إذ لو كان كيف كان الأمر ولكن قد يكون لك مقام من الزهد في المعدوم بقيامك بشرطه وهو أن لا تحب وجود الشيء ولا تأسى على فقده أو تكون مغتبطًا بعدمك مسروًرا بفقرك يعلم الله تعالى ذلك من غيبك ويطلع على سرّك أنك لا تفرح بوجوده لو وجدته وتخرجه إن دخل عليك وإن قلبك قانع بالله سبحانه وتعالى راضٍ عن الله تعالى بحالك التي هي العدم من الدنيا غير محبّ للاستبدال بها من الغنى بصدق يقينك بفضيلة الزهد، فإذا كنت بهذا الوصف حسب لك جميع ذلك زهداً وكان لك بأحد هذه المعاني ثواب الزاهدين وإن لم تكن للدنيا واجدًا وهذا زهد الفقراء الصادقين وهو التحقق بالفقر.
وقد قال بعضهم: حقيقة الفقير أن يكون مغبتطاً بفقره خائفًا أن يسلب الفقر كما يكون الغني مغتبطًا بغناه يخاف الفقر، وقد كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إذا قيل له إنك زاهد قال: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا وملكها فزهد فيها، فأما أنا ففي أي شيء زهدت؟ وقد يصحّ الزهد للعارف في الشيء مع وجحّه عنده إذا لم يقتنيه لمتعة نفسه ولم يتملكه ويسكن إلىه بل كان موقوفًا في خزانة الله سبحانه وتعالى، التي هي يده منتظرًا حكم الله تعالى فيه ومحنة ذلك استواء وجوده وعدمه والمسارعة إذا رأى حكم الله تعالى إلى تنفيذه فيكون في ذلك كأنه لغيره من عيلته أو إخوانه أوسبيل من سبيل الله تعالى، وهذا المقام زائد على الزهد فكذلك لم يخرج منه بل كان مخصوصًا فيه بخصوص وهو أيضًا مقام من التوكل وبيان آخر مستنبط من السنّة في ماهية الزهد أي شيء هو الزهد أيضًا تقليل الدنيا وتقريبها واحتقارها بالقلب واستصغارها، من ذلك الخبر الذي جاء في ساعة يوم الجمعة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: هي في آخر ساعة قال: وجعل يزهدها يقللها أي يقرب وقتها ويدينه من الغروب، والمعنى الآخر في الخبر الثاني من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعليّ رضي الله عنه لما نزلت آية الأمر بالصدقة لمناجاة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: كم ترى أن نجعل عليهم من الصدقة مقدمة للمناجاة فقال شعيرة من ذهب قال إنك لزهيد أي مقلّل مصغر للدنيا ولكن نجعل عليهم دينارًا وزهيدكأنه معدول من زاهد للمبالغة في الوصف بالزهد كما عدل شهيد من شاهد ومجيد من ماجد وكما عدل عليم وقدير ورحيم من عالم وقادر وراحم للمبالغة في العلم والقدرة والرحمة.
ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد
قوت الزهد الذي لابدّ منه وبه تظهر صفة الزاهد وينفصل به عن الراغب هو أن لا يفرح بعاجل موجود من حظّ النفس ولا يحزن على مفقود من ذلك وأن يأخذ الحاجة من كلّ شيء عند الحاجة إلى الشيء ولا يتناول عند الحاجة إلا سدّ الفاقة ولا يطلب الشيء قبل الحاجة، وأوّل الزهد دخول غمّ الآخرة في القلب ثم وجود حلاوة المعاملة لله تعالى ولا يدخل غمّ الآخرة حتى يخرج همّ الدنيا ولا تدخل حلاوة المعاملة حتى تخرج حلاوة الهوى، وكلّ من تاب من ذنب ولم يجد حلاوة الطاعة لم يؤمن عليه الرجوع فيه وكلّ من ترك الدنيا ولم يذق حلاوة الزهد رجع في الدنيا ولا يدخل حلاوة المعاملة حتى يخرج حلاوة الهوى وخالص الزهد إخراج الموجود من القلب، ثم إخراج ما خرج من القلب عن اليد وهو عدم الموجود على الاستصغار له والاحتقار والتقالل لهوان الدنيا عنده وصغرها في عينه فبهذا يتم الزهد، ثم ينسى زهده في زهده فيكون حينئذ زاهداً في زهده لرغبته في مزهده، وبهذا يكمل الزهد؛ وهذا لبّه وحقيقته؛ وهو أعزّ الأحوال في مقامات اليقين، وهوالزهد في النفس لا الزهد لأجل النفس ولا للرغبة في الزهد للزهد؛ وهذه مشاهدة الصديقين، وزهد المقربين عند وجد عين اليقين، ودون هذا مقامات إخراج المرغوب فيه عن اليد مع نظره إليه وعلى مجاهدة النفس فيه؛ وهو زهد المؤمنين، وذلك العمل بالزهد عقد وعمل إذ كان الزهد عن الإيمان، والإيمان قول وعمل، وكذلك الزهد عقد وعمل، فعقده خروج حبّ الدنيا من القلب بدخول حبّ الآخرة في القلب، والعمل بالزهد إخراج المحبوب من اليد في سبيل الله تعالى معتاضًا منه ما عنده سبحانه وتعالى من وجهه الكريم جلّ وتعالى أو قرب جواره في داره وإن لم تكن الدنيا موجودة فإن ترك الأسف عليها وقلة الحرص فيها، وترك الطلب والتمنّي لها، وسكون القلب مع العدم ورضاه بيسير القسم بحسب للعبد زهدًا لأن ذلك حال الفقير، فإذا قام بحكمه لم يجب عليه أكثر من القيام به، والورع هو من الزهد كما الزهد من الإيمان والحياء والإيمان في قرن واحد، كما جاء في الخبر إذا نزع أحدهما تبعه الآخر.
وروينا في ذلك حديثًا من طرق أهل البيت: الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة، فإن صادفًا قلبًا فيه الإيمان والحياء أقاما فيه وإلا ارتحلا، والقناعة باب من الزهد أيضا، والرضا باليسير من الأشياء حال من الزهد والتقلّل في الأشياء مفتاح الزهد، وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أعطية فلن يكشف للعبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح، فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص والحريص محروم، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط والساخط معذب، وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل، وقال الله تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتاكُمْ) الحديد: 23 أي منها وهذان الوصفان هما أتمّ حال في الزهد من أعطي أحدهما تبعه الآخرة لأن الذي لايأسى على ما فاته من الدنيا، هو الذي لا يفرح بما أتاه منها لأنه مثله والذي لا يفرح بما أتاه منها هو الذي لا يحزن على ما فاته، وهذا وصف عبد غير متملك لملك وسيما عبد قائم بحكم ربّ ونعت عبد موقن محبّ قد شغلته مشاهدة الآخرة عن التفرّغ لمتعة الدنيا وقد فرغته معاينة الآخرة من الاشتغال بما يغني، وفي أحد الوجوه من قوله تعالى: (وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنَى) النجم: 48 قيل: أغنى أهل الآخرة بالله سبحانه وتعالى وأغناهم عن الدنيا بالآخرة وأقنى أهل الدنيا من الدنيا أيّ جعل لهم قنية ومدّخراً وعدة كما وصف من ذمه من قوله تعالى: (جَمَعَ مَالاً وَعَدّدَهُ) الهمزة: 2 أي قال هذا عدّة لكذا وهذه عدّة لكذا فهدّده بالويل فحصل من ذلك أن الزاهد في المال عدّته الله تعالى في كل الأحوال وكنزه وذخره وطوبى له وحسن مآب.
وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه قال: كفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلاً وكفى بالموت واعظاً؛ وهذا جملة وصف الزاهد الموقن، الذي هو للموت مرتقب مع الخبر المشهور، ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، وقد جعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزهد في الدنيا علمًا لحقيقة الإيمان وقربه بمشاهدة الإيقان في قوله عليه الصلاة والسلام لحارثة: عرفت فالزم عبد نوّر الله قلبه لما قال أنا مؤمن حقًّا قال: وما حقيقة إيمانك، فابتدأ بالزهد فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها وكأني بالجنة والنار وكأني بعرش ربيّ بارزًا، وأشدّ من هذا الخبر الآخر الذي جعل النبي الزهد من علامة شرح الصدر بالنور، وهو نور التصديق الذي هو عموم وصف المؤمنين لأنه هو في التحقيق الإسلام، ففسّر قوله تعالى: (فَمَنْ يُرِدِ الله أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسْلام) الأنعام: 521 قيل: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: إن النو إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفتح، قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله؛ فهذا هو الزهد جعله شرطًا لحقيقة الإسلام.
وأشد من هذين الخبرين الخبر الثالث الذي فسرّ الحياء من الله تعالى بالزهد في الدنيا فقال: استحيوا من الله تعالى حقّ الحياء قلنا: إنّا لنستحي قال: تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون، وبمعنى هذا تمّم إيمان الوفد الذي سألهم ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون، قال: وما علامة إيمانكم؟ فذكروا الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمواقع القضاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما عنه ترحلون؛ فهذا هو الزهدجعله تكملة إيمانهم وعلوّ مقامهم وتمامًا على إحسانهم وأعظم من هذه كلّها الخبر الرابع الذي جعل فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزهد من شرط إخلاص التوحيد في حديث رويناه عن ابن المنكدر عن جابر قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: من جاء بلا إله إلا الله لا يخلط معها غيرها وجبت له الجنة، فقام إليه عليّ كرّم الله وجهه فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما لا يخلط بها غيرها صفه لنا فسّر هـ لنا فقال: حبّ الدنيا وطلبًا لها واتباعاً لها وقوم يقولون قول الأنبياء، ويعملون أعمال الجبابرة، فمن جاء بلا إله إلا الله ليس شيء فيها من هذا وجبت له الجنة، فلذلك كان علي رضي الله عنه يجعل الزهد مقاماً في الصبر، ويجعل الصبر عمدة الإيمان في حديثين رويناهما عنه؛ أوّلهما قوله في الحديث الطويل الذي رواه عكرمة وعتبة بن حميد والحرث الأعور وقبيصة بن جابر الأسدي في مباني الإيمان أنه قال: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر، واليقين، والعدل، والجهاد، ثم قال فيه: والصبر منها على أربع شعب؛ على الشوق، والشفق، والزهادة، والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ترقّب الموت سارع في الخيرات.
والخبر الآخر في الصبر الذي جعله عمود الإيمان ينهدم الإيمان بهدمه هو قوله: والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لا جسد لمن لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له، وروينا في خبر مقطوع: السخاء من اليقين ولا يدخل النار موقن، والبخل من الشك ولا يدخل الجنة من شك، فكان هذا الحديث مفسّرًا للخبر المجمل السخيّ، قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، قريب من النار، فسرّ في ذلك الخبر بأيّ معنى يكون السخيّ قريباً من الله تعالى، قريباً من الجنة لأن السخاء من اليقين وبأيّ معنى يكون البخيل بعيدًا من الله تعالى، قريبًا من النار لأن البخل من الشك، فالسخاء وصف الزاهد ولا يكون الزاهد إلا سخيّاً، والبخل وصف الراغب، ولا يكون الحريص إلا بخيلاً ولايكون البخيل زاهدًا لأن الزهد يدعو إلى إخراج الشيء، والبخل يدعو إلى إمساكه، فنفس السخاء زهد، فلذلك ذمّ البخل لأنه رغبة في الدنيا، ثم إن الحرص علامة البخل لأنه دليل الرغبة، والقناعة علامة السخاء لأنها باب الزهد، فلذلك قيل: سخاء النفس عمّا في أيدي النفس أفضل من سخاء البذل، ثم يفترقان في الحكم بعد اجتماعهما في الإسم، فمن جاد بملكه لله تعالى كان زاهداً فيه لله تعالى ووقع أجره على الله، ومن جاد بما له لأجل الناس كان أيضاً زاهدًا في ذلك موصوفاً بالسخاء، ولكن ذلك لنفسه ولأجل هواه ولا أجر له عند الله تعالى إذ لم يكن من عمّال الله تعالى فبطل أجره لأنه عمل لنفسه وحصل شكره وذكره في الدنيا لأنه عمل لأجل الناس.
كما قال ابن المبارك رحمه الله: ما رأيت بين الفتوة والقراءة فرقاً إلا في شيء واحد ماحظرت القراءة شيئاً إلا قبحته الفتوة وإنما يفترقان في أن القراءة يراد بها وجه الله تعالى، والفتوة يراد بها وجوه الناس ومدحهم وقد كان أستاذه سفيان الثوري رحمه الله يقول: من لم يحسن يتفتى لم يحسن يقترّى أيّ من لم يعرف أحكام التفتي فيقوم بها حتى يستحق وصف فتى لم يحكم أوصاف التقري حتى يوصف بأنه قارئ، ثم إن العبد قد يجاهد نفسه على الزهد كما يجاهدها على مخالفة الهوى وكما يجاهدها بالصبر على الحقّ بأن يهرج المرغوب وينفق المحبوب على كراهة من النفس وجمل بالزهدعليها فيكون له مقام في الزهد ينال البرّ ويستوجب مدحًا من البرّ، والمتزهد غير الزاهد، وهو الذي يتصنْع للزهد ويعمل في أسبابه من التقلّل ورثاثة الحال في كل شيء، فمثله مثل المتصّبرين من الصابر الذي يجهل على نفسه بالصبر ويصابرها على العلم، فيكون له مقام من الصبر، وصفوة الزهد انتظارالموت وقصر الأمل لأن فيهما ترك الادخار وتحسين الأعمال.
وقال ابن عيينة: حدّ الزهد أن يكون شاكراً عند الرخاء صابراً عند البلاء.
وقال بشر بن الحارث رحمه الله: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، من زهد فيهم فقد زهد في الدنيا، وكذلك قال بعض الحكماء: إذا طلب الزاهد الناس فاهرب منه، وإذا هرب من الناس فاطلبه، وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يكون الرجل زاهدًا؟ فقال: إذا بلغ حرصه في ترك الدنيا حرص الطالب لها كان زاهدًا، وقال قاسم الجوعي: الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف بقدر ما تملك من بطنك، كذلك تملك من الزهد فكانت الدنيا عنده الشبع وأكل الشهوات، وقال فضيل بن عياض رحمه الله: الزهد هو القناعة فكانت الدنيا عنده هو الحرص والشره، وقال الثوري: الزهد هو قصر الأمل فكانت الدنيا عنده طول الأمل، وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: الدنيا كلّ ما يشغلك عن الله تعالى فكان الزهد عنده التفرغ لله تعالى، وقد قال: إنما الزاهد من تخلى عن الدنيا واشتغل بالعبادة والاجتهاد، فأما من تركها وتبطل فإنما طلب الراحة لنفسه، وكان داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: كلّ ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو مال فهوعليك شؤم.
وقال أبو سليمان: من تزوّج أو كتب الحديث أو طلب معاشًا فقد ركن إلى الدنيا وقرأ قوله تعالى: (إلامَنْ أَتى الله بَقَلْبٍ سليمٍ) الشعراء: 89 قال: هو القلب الذي ليس فيه غير اللّّه تعالى، وقال: إنما زهدوا في الدنيا لتفرّغ قلوبهم من همومها للآخرة، وقد قال أويس القرني رحمه الله تعالى: إذا خرج يطلب ذهب الزهد وكان إمامنا وشيخ شيخنا أبومحمد سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: أوّل الزهد التوكّل وأوسطه إظهار القدرة وقال: لا يزهدالعبد زهدًا حقيقيًا لا رجعة بعده إلابعد مشاهدة قدرة، فإن أوّل القدرة عندي أن يشهد ما سمع من كلام القادر المزهد إذ يقول تبارك وتعالى: (ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله) الرعد: 71، فالحلية الذهب والفضة؛ وهما قيم الأشياء اللذان ملكا النفوس ونكسا الرؤوس فالمتاع ما سواهما من معادن الأرض، فإذا شهد العبد الذهب الذي هو سبب الدنيا ولأجله أشرك من أشرك وبحبائله ارتبك من ارتبك ولوقوع حلاوته في القلب وقع من وقع، فإذا شهد جوهر الذهب والفضة زبداً طافيًا على وجه الماء لا نفع فيه ولا غنية به ولا قيمة له زهد فيه حينئذ زهدا صادقًا فكان زهده معاينة لا خبرًا وكان من المؤمنين حقًّا الذين وصفهم الحقّ بالحقّ في قوله تعالى: (اِذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوُبُهُمْ وَإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًاَ) الأنفال: 2 فالزهد مزيد الإيمان ثم قال: وعلى ربّهم يتوكّلون، فالزهد يدخل في التوكّل ثم قال: فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون، فالتوكل يوقف على الصبر، وكان هذا قد سمع من كلام الله تعالى ففعله فأبلغه الله تعالى مأمنه في المقام الأمين في جنات وعيون، واستحق وصف الله تعالى بالإيمان إذا تلا القرآن بحقيقة الإيقان فقال عزّ وجلّ: (الّذينَ آتَيْنَاهمُ الكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تلاوَته أولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) البقرة: 121 وذلك أن هذا الزبد تشبيه من الله تعالى لمثل ضربه للحّق والباطل، فالمثل هو الماء والزبد فمثل الحقّ في نفعه وبقائه بالماء، ومثل الباطل في ذهابه وقلة نفعه بالزبد، ثم شبّه الذهب لذهابه عن الحقيقة بالزبد تشبيه مماثلة لا تشبيه مجاز لقوله: زبد مثله، والمماثلة مستقصاة، ثم قال: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى أي الجنة والبقاء.
وقال تعالى: (لِلَّذين لايُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السّوْء) النحل: 06 هم المريدون للحياة الدنيا وزينتها، الراضون المطمئنون بها، ليس لهم في الآخرة إلا النار، فسبحان من نفد بصره الأبصار وسبحان مقلب الليل والنهار، وسبحان من كلّ شيء عنده بمقدار، يبصر ما لا نبصر، كما يقدر على ما لا نقدر، خصّ المشاهدين بمعنى مشاهدته كما خصّهم بالإحاطة بشيء من علمه فأحاط عليهم بما شاء، لما أحاط لهم ما شاء فكان الذهب والفضة زبداً طافياً تفرّقه الرياح فيكون فوق الماء متجافياً؛ وهما من معادن الجبال فكانت الجبال عندهم أمواجاً ثابتة بإثبات وساكنة بتسكين تحسبها جامدة، وهي تمر مرّ السحاب صنع الله الذي أتقن كلّ شيء وصارت الأرض بحراً عجاجاً يضرب بالأمواج فيظهر بينهما من المدن والقفار للاستواء والاعوجاج وصار الأنام يسبحون في الأسراب يدبون بين المناكب والأحداب، أظهر فيهما من كل شيء موزون بمقدار، كتنفس النهار في اللّيل وكالغشاء على السيل، ذلك لظهور حكمته وخفيّ قدرته ولطيف صنعه ودقيق صنعته ذلك لشهود نعمته من القيام بشكره وجعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهم من كلّ حدب ينسلون، إن ربّي لطيف لما يشاء فاجتمع الفرق وارتتق الفتق وغاب كل متفرّق ونطق وكان عرشه على الماء ليبلوكم، فهذه مشاهدة أبناء الآخرة هي أعلى من زهدهم في الدنيا، وافترق الجمع وافتتق الرتق وظهر من الماء كلّ شيء حيّ ظاهر واتسع الفضاء واستتر الغطاء ووجد التفصيل وحكم الحسبان بالتحصيل، كانتا رتقًا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيّ، أفلايؤمنون هذه مشاهدة أبناء الدنيا هي أعظم عليهم إذا تيقظوا من غيبهم وجاءت سكرة الموت بالحقّ، ذلك ماكنت منه تحيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد، والنازعات غرقًا والناشطات نشطًا والسابحات سبحاً؛ هذه مشاهدة العموم عند الموت فيعظمه عليهم بالحسرة والفوت، وقد فرغ الخصوص من نصيبهم لمشاهدته فهم ناظرون إلى مستقبل المزيد مشغولون به عن العبيد قائمون بشاهد الحق لهم متصرفون بإشهاده إياهم ظاهرًا وباطنًا ولطيفاً ومستتراً ومعروفًا ومنكراً واللّّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فما غلب عليه لا يظهر وما غلبه عليهم إيامهم قهر، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصدق كلمة قالها الشاعر:
ألا كل شيء ماخلا الله باطل
وقال: فالحقّ والحقّ أقول: خلق سبع سموات ومن الأرض مثهنّ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله علي كلّ شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكلّ شيء علماً، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو فسّرت لكم هذه لآية لكفرتم قيل: وكيف؟ قال: كنتم تنكرونها وإنكاركم له كفر بها، وفي لفظ آخر: لو فسّرت الآية التي في سورة النساء القصري لرجمتموني بالحجارة معناه لكفرتموني لأنهم لا يقتلون إلا كافرًا عندهم، وروينا عنه قي قوله تعالى جميعاً منه قال: في كل شيء اسم حرف من أسمائه، فاسم كل شيء من اسمه فإنما أنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله ناطقاً بقدرته وظاهراً بحكمته وبمعناه، كان أبو محمد رحمه الله تعالى يتأوّل قوله: ما نزل من السماء أعزّ من اليقين فغابت السبع سبعاً في السبع العلي والسبع السفلي لما طوى نفس الهوى وغابت العليا والسفلى في ملكوت العرش والثرى لما طوي طيّ النفس وغاب العرض والثرى في جبروت الأعلى لما محي طيّ الطي وحضر الأزلي الأول إذا غاب الحدثان الثاني وظهرالباطن الآخير حين بطن الظاهر الساتر فصار العبد شهيداً لقول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألا كل شيء ماخلا الله باطل، وأراه الآيات في الأفاق فتبين الحقّ بقول الحقّ سبحانه وتعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنفسِهمْ حتى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ الحَقُّ أَوَلمْ ىَكْفِ بِرَبِّك أنَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ شَهيدٌ) فصلت: 53، (ألا إنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاء رَبِّهِمْ ألا إنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحيطٌ) فصلت: 54
وكذلك قال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل الذي قال: اللهم أرني الدنيا كما تراها فقال: لا تقل هكذا فإن الله تعالى لايرى الدنيا كما تراها ولكن قل أرني الدنيا كما يراها الصالح من عبادك؛ وهذه شهادة أهل الله تعالى، وغابت فيه الشهادة الأولى كما غيبت تلك الأولى مشاهدة أهل الدنيا فكشف هذا المقام وإظهار هذه الشهادة لا تحلّ إلا لشهيد ذي مقام في الصديقين عتيد، وقال الحكيم: لقد عزّت معانيه فغابت عن الأبصار: إلا الشهيد وهم أولو المطلع في القرآن الذين سلموا من هول المطلع في العيان، وإفشاء سرّ الربوبية معصية وإعلان سر السر كفر ولكن يحتاج هذا الزاهد أن يشهد المزهود بمنزلة الزبد إن لم يبلغ نظره شهادة المزهد الأحد ليكون من أهل السمع والشهادة فينسى بذكر قلبه معارفه والعادة يكون عند الله شهيدًا له أجره ونوره كما قال الشاهد الأعلى والشهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم فكيف يكون شهيداً من لم يشهد بشهادته بل كيف يشهد وصف الأولية بغير نورها أم كيف يقوم بشهادته من لم يشهد قيوميته بل كيف يرى قيوميته بغير نور وحدانيته؟ فإن لم يقرب في هذا المكان فكما قال أو ألقى السمع وهو شهيد فيسمع من مكان هو إلى جنب القرب بعيد ويكون من أهل البيان والفكر كقول الحقّ المبين: (كذلك يبّين لكم الآيات لعلكم تتفكّرون في الدنيا والآخرة) البقرة 219 - 220 أيّ تتفكّرون في فناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة ودوامها فتؤثرون الباقي الدائم وترغبون فيه على الزائل الفاني وتزهدون فيه لأن ما يكون آخره فناء يشبه آخره أوّل أمره وأوّله لم يكن ومايكون آخره بفاء فكأنه لم يزل فأشبه أوّله آخره في البقاء، وكذلك قال العليم الحكيم: (والآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبْقى) الأعلى: 17 فوصفها لبقائها في المآل بوصفين من صفاته.
كما قال تعالى: (وَالله خَيْرٌ وَأبْقى) طه: 73، ولأنه قال تعالى: (مَا عِنْدَكمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ) النحل: 96 فنسب الدنيا إلينا ليذلنا بها لأنّا أهل الغناء وليزهدنا فيها، وأضاف الآخرة إليه ليعزها به لأنه أهل البقاء وليرغبنا فيها، فإذا شهد العبد بعين قلبه ويقين إيمانه ما صدّق به مما عقله الذي هو فهم سمعه وإدراك خبره ما يفنى آخره كأنه لم يكن وما يبقى آخره كأنه لم يزل كان من المتفكّرين في هذه الآية المشاهدين لها، وممن تلاها حقّ تلاوتها فآمن حقيقة الإيمان وزهد في الدنيا حقيقة الزهد ورغب في الآخرة حق الرغبة وكان من أولي الأيدي والأبصار أي من ذويّ القوى في الدين والبصائر في اليقين، فلما أبصر بقواه عبر الدنيا إلى اللّّه تعالى وكان زاده تقواه، كما قال تعالى: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) الذاريات: 49 أي تذكرون الفرد ففرّوا إلى الله أي من الأشكال والأضداد، وكما قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار فعبر لما أبصر معه عندها كان ممن أخذ الكتاب بقوّة قيل: بعمل فيه وقيل: بيقين فيه ويقال: بجدّ واجتهاد، فكان من المحسنين الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وتلا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذين يذكرون الله قياماً وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السموات والأرض) آل عمران: 191 الآية، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها ويل لمن تلاها ومسبّح بها سبلنه وذلك أن السموات والأرض عبّر بهما عما وراءهما من درجات الجنات ودركات النيران، وهو الملكوت إلى الملك الباطن والملك الكبير فكشف هذان عمّا علا وسفل وأحاط بهما من العرش والثرى لمن تفكّر فيهما ثم كشف ذلك له ورآه من العزة وجاوز الأفكار الملكوت لما شرحت القلوب بأنوار اليقين إلى الأفق الأعلى والجبروت فنفذت أبصار المتفكرين بقواها إلى مشاهدة ذلك وبقيت أنوار يقنيهم معاينة ما أحاط بذلك وهو ما قدمنا ذكره آنفاً مما لم يظهر كشفه كنحوما نبّه الله تعالى العباد بما يشهدون إلى ما وراءه ممّا به أيقنوا وللمؤمنين مشاهدة للدنيا قريبة دون هذه من طريق العقول يشهدون أنها عقوبة كما قيل: ما فتحت الدنيا على عبد إلا مكرًا به ولا زويت عنه إلا نظرًا له.
وسمعنا في أخبار داود عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه: تدري لم ابتليت آدم بأكل الشجرة لأني جعلت معصيته سبباً لعمارة الدنيا فينبغي في دليل لخطاب أن تكون الطاعة سبب خرابها وهو الزهد فيها، فصحّ بذلك الخبر المشهور: حبّ الدنيا رأس كلّ خطئة لأنه كان أساسها ولكن لايسع ذلك العامة لأنهم مرادون بالعمارة وصلح لنفرمن الخاصة لأن نقصان عددهم من الكافة لا ينقص عمارة الدنيا إذ المراد عمارتها بأهلها، ويقال عن آدم عليه السلام: لما أكل الشجرة تحرّكت معدته لخروج الثفل ولم يكن ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة، فلذلك نهيا عن أكلها قال: فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال له: أيّ شيء تريد؟ فقال آدم عليه السلام: أريد أن أضع ما في بطني من أذى فقيل للملك: قل له في أيّ مكان تضعه علي الفرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا موضعاً يصلح لذلك ولكن اهبط إلى الدنيا، قال: وتلطف الله تعالى له بهذا المعنى فأهبطه إلى الأرض وقد نغص اللّّه تعالى فاكهة الدنيا وغيرها بحشو العجم والثفل ليزهد فيها وأخبر أنها مقطوعة ممنوعة ليرغب في الدائم الموهوب.
وكان بعض العلماء يقول: ما سطع لي زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لي باطنه فظهر لي عزوف عنه فهذه عناية من الله تعالى بمن وليه من أوليائه المقرّبين منه، فمن شهد الدنيا بأوّل وصفها لم يغتّر بآخره، ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرها، ومن كوشف بعاقتبها لم يستهوه زخرفها، وكان عيسى عليه السلام يقول: ويلكم علماء السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها جص وباطنها نتن، وقال مالك بن دينار رحمه الله: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعني الدنيا، فمن حرص على الدنيا بالباطل فقد قتل نفسه، فإن قوى حرصه عليها واشتد عشقه لها قتل غيره، قال الله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِل وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) النساء: 29 وقال في قتل غيره بصده إياه عن سبيل الله: (إن كثيرًا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله) التوبة: 43 وروينا في أخبار عيسى عليه السلام: إنه مرّ في سياحته ومعه طائفة من الحواريين بذهب مصبوب في الأرض فوقف عليه ثم قال: هذا القاتول فاحذروه، ثم عبروا أصحابه فتخلف ثلاثة لأجل الذهب فأقام اثنان ودفعا إلى واحد شيئاً منه يشتري لهم من الطيّبات من أقرب الأمصار إليهم فوسوس إليهما العدوّ: ترضيان أن يكون هذا المال بينكم أثلاثاً اقتلوا هذا فيكون المال بينكم نصفين، فأجمعا على قتله إذارجع إليهما، قال: وجاء الشيطان إلى الثالث فوسوس إليه أرضيت لنفسك أن تأخذ ثلث المال اقتلهما فيكون المال كلّه لك قال: فاشترى سمّاً فجعله في الطعام فلما جاءهما به وثبا عليه فقتلاه ثم قعدا يأكلان الطعام فلما فرغا ماتا، فرجع عيسى عليه السلام من سياحته فنظر إليهم حول الذهب صرعى والذهب بحاله فعجب أصحابه وقالوا: ما شأن هؤلاء فأخبرهم بهذه القصة، وقيل لابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء؟ قيل: فمن الملوك؟ قال: الزاهدون، وروينا عن ابن المسيب عن أبي ذر قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من زهد في الدنيا أدخل الله تبارك وتعالى الحكمة قلبه وأنطق بها لسلانه وبصره داء الدنيا ودواِءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام.
وروينا في الخبر: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: رأيت سبعين بدريًا كانوا والله فيما أحلّ تعالى لهم أزهد منكم فيماحرّم اللّّه تعالى عليكم، وفي حديث آخر: كانوا بالبلاء والشدة تصيبهم أشد فرحاً منكم بالخصب والرخاء لو رأيتموهم قلتم مجانين، ولو رأوا خياركم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا أشراركم قالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب قال: وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يفسد على قلبي، فمن كان له قلب حفظه من فساده وخاف من تغيرّه وإبعاده وعمل في صلاحه وإرشاده، ومن لم يكن له قلب فهو يتقلّب في ظلمات الهوى فربما انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، أو يكون من أهل الرضا بالدنيا وأهل الغفلة عن آيات الله تعالى فيكون قد رضي بلاشيء وآثره على من ليس كمثله شيء كوصف من أخبر الله تعالى عنه قي قوله تعالى: (ورَضُوا بالحَياة الدُّنْيَا وَاطمَأَنُّوا بِها وَالْذينَ هُمْ عَنْ آَيَاتِنا غَافِلُونَ) يونس: 7 فيستحق الإعراض من الحبيب ويستوجب المقت من القريب كمثل من أمر الله تعالى بالإعراض عنهم وترك القبول منهم إذ يقول عزّ من قائل: (فَأعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلا الْحَيَاة الدُنْيا) (ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) النجم: 29 - 30 وقال عزّ وجلّ: (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلَبهُ عِنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِع هَواهُ وَكانَ أْمرُهُ فرُطًا) الكهف: 28 أي مجاوزاً لما نهي عنه مقصرا عمّا أمر به وقيل: مقدماً إلى الهلاك، وقد نهى الله تعالى رسوله أن يوسع نظره إلى أهل الدنيا مقتاً لهم وأخبر أن ما أظهره من زهرة الدنيا فتنة لهم وأعلمه أن القناعة والزهد خير وأبقى، تنتظم هذه المعاني في قوله تعالى: (وَلاتُمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى ما مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتَنهُمْ فيهِ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَيْرٌ وأبْقى) طه: 131، قيل: القناعة وقيل: فوت يوم بيوم ويقال: الزهد في الدنيا وهذا الوجه أشبه بكتاب الله تعالى بدليل قوله تعالى: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبْقى) الأعلى: 17 وكذلك قوله تعالى: (وَرِزْقُ رَبِّكَ خىْرٌ وَأبْقى) طه: 131 يعني الزهد في الدنيا، وقال أيضًا في مثله: (بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لكُمُ) هود: 86 يعني القناعة وقيل: الحلال، وفي خبر: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر في أصحابه بعشار من النوق حفل وهي الحوامل وكانت من أحبّ أموالهم إليهم وأنفسه عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والولد والوبر؛ وهي الرواحل من الإبل التي ضرب النبي عليه السلام بها مثل خيار الناس فقال عليه السلام الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة أي الإبل كثيرة والراحلة التي تجمع هذه الأوصاف الخمسة من الإبل قليل وهي العشار التي ذكر الله تعالى في قوله: (وَإذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) التكوير: 4 أي تركها أهلها وهربوا لهول قيام الساعة شغلاً بنفوسهم عنها قال: فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغض بصره فقيل له: يا رسول الله هذه أنفس أموالنا لما تنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله تعالى عن ذلك، ثم تلا هذه الاية: (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك) الحجر: 88، وفي حديث عمر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: (والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ) االتوبة: 43، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تباً للدينار والدرهم قال: فقلنا نهانا الله تعالى عن كنز الذهب والفضة فأي شيء ندخر فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليتخذ أحدكم لسانًا ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة وفي حديث حذيفة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله تعالى بثلاث همّاً لا يفارق قلبه أبداً وفقراً لا يستغنى أبداً وحرصاً لا يشبع أبداً.
وروينا حديثًا مرسلاً عن علي بن معبد عن علي بن أبي طلحة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحبّ إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحبّ إليه من كثرة الشيء، وروينا عن عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة خلقت يعبر عليها إلى الآخرة فاعبروها ولا تعمروها، وقال له رجل: احملني معك في ساحتك فقال: أخرج مالك والحقني قال: لا أستطيع فقال عيسى عليه السلام بشدة: يدخل الغني الجنة أو قال بعجب: وقالوا له: لو أمرتنا يا نبي الله أن نبني بيتًا نعبد الله فيه فقال: اذهبوا فابنوا بيتًا على الماء قالوا: كيف يستقيم بنيان على الماء قال: فكيف تستقيم عبادة على حبّ الدنيا وقال: لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى لا يحبّ أن يحمد بعبادة اللّّّه تعالى ولايبالي من أكل الدنيا، وكان بشر بن الحارث يقول: لا تحسن التقوى إلا بزهد وقال مرة: العبادة لا تليق بالأغنياء مثل العبادة على الغني مثل روضة على المزبلة، ومثل العبادة على الفقير مثل عقد الجوهر في جيد الحسناء، وقد استنبطنا ذلك من كتاب الله تعالى فمعنى وصف الفقراء في العبادة في قوله سبحانه وتعالى: (للِْفُقَرَاء الَّذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ الله) البقرة: 273 ثم قال: (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) الفتح: 29 فحسنت لبسة العبادة عليهم لحسن سيماهم بالفقر، وروينا في وصية لقمان لابنه وهو يحذّره مداخل العدو قال: وإذا جاءك من قبل الفقر فأخبره أن الغني من أطاع اللّّه تعالى والفقير من انتهك معصيته وإذا شهى إليك الغني فأخبره أنه لا يحسن جمع الغنى والقراءة، وقال بعض السلف: أبي أهل العلم بالله تعالى أن يسمعوا الحكمة والوعظ إلا من الزاهدين في الدنيا وقالوا: ليس أهل الدنيا لذلك أهلاً ولا يليق بهم.
وروينا عن عيسى عليه السلام فيما أوحى الله تعالى إليه: يا ابن آدم ابك أيام الحياة بكاء من ودّع الدنيا وارتفعت رغبته إلى ما عند الله تعالى، اكتف بالبلغة من الدنيا ليكفك منها الجشب والخشن بحقّ أقول لك ما أنت إلا بيومك وساعتك مكتوب عليك ما أخذت الدنيا وفيما أنفقته فاعمل على حسب هذا، فإنك مسوؤل عنه، لو رأيت ما وعدت الصالحين لزهقت نفسك، فكان عيسى عليه السلام يقول: حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وجودة الثياب خيلاء القلب يعني إعجابه وكبره وملء البطن جمام النفس يعني قوتها واجتماعها، بحقّ أقول لكم: لكما لا يلذ المريض بطيب الطعام كذلك لا يجد حلاوة العبادة من أحبّ الدنيا، ومن الزهد في الدنيا ترك الملبس الناعم والمنظور إلىه المرتفع واجتناب النزهات من لطائف الطعام والتفتق في الشهوات التي يرغب فيها المتنعمون وترك الزينة والمفاخر من الآلة والأثاث الذي يستأنس فيه المترفون، ومن الزهد أن يكون الشيء الواحد يستعمل في أشياء كثيرة، كذلك كان سيرة السلف في الأثاث وهو التقلّل، كما أن أبناء الدنيا يستعملون للشيء الواحد أشياء كثيرة؛ وهو وصف من التكاثر وذلك من أبواب الدنيا، وقال بعض السلف: أول النسك الزي، وقال بعض العلماء: من رقّ ثوبه رقّ دينه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يشبه الزيّ الزيّ حتى يشبه القلب القلب.
وفي الخبر المشهور: البذاذة من الإيمان قيل: هو التقارب في اللباس، والحديث المفسر من ترك ثوب جمال وهو يقدر عليه تواضعًا لله تعالى خيّره الله تعالى من حلل الإيمان أيها شاء، وفي لفظ آخر: من ترك زينة لله تعالى ووضع ثيابًا حسنة تواضعًا لله تعالى وابتغاء وجهه كان حقًا على اللّّه تعالى أن يدّّخر له من عبقريّ الجنة في تخات الياقوت، ولما أتى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل قباء أتوه بشربة من لبن مشوبة بعسل، فوضع القدح من يده قال أما أني لست أحرمه ولكني أتركه تواضعاً لله تعالى وأتى عمر رضي اللّّه عنه بشربة من ماء بارد وعسل في يوم صائف فقال: اعزلوا عني حسابها، وأوحى الله تعالى إلى نبّي من أنبيائه: قل لأوليائي: لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تدخلوا مداخل أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، ولما خطب بشر بن مروان على منبر الكوفة قال بعض الصحابة: انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثياب لفساق قلت: وما كان عليه، ثياب رقاق، وجاء عامر بن عبد الله بن ربيعة إلى أبي ذر رضي الله عنه في بزتّه فجعل يتكلم في الزهد فوضع أبو ذر راحته على فيه وجعل يضرط به فغضب عامر فأتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ألم ترَ ما لقيت من أخيك أبي ذر قال وما ذاك؟ قال: جعلت أقول في الزهد فأخذ يهزأ بي فقال ابن عمر: أنت صنعت بنفسك تأتي أبا ذر في هذه البزة وتتكلم في الزهد.
وقال عليّ كرّم الله وجهه: إن الله تعالى أخذ على أئمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم الغنيّ ولا يزري بالفقير فقره، وقد عوتب عمر رضي الله في لباسه وكان يلبس الخشن من القطن قيمة قميصه ثلاثة دراهم وخمسة دراهم ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه وقال هذا أدنى إلى التواضع وأجدر أن يقتدي بي المسلم، وأتت برود من اليمن إلى عمر رضي الله عنه فقسمها على أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردًا بردًا، ثم صعد المنير بوم الجمعة فخطب الناس في حلّة منها والحلّة عند العرب ثوبان من جنس واحد، وكان ذلك من أحسن زيّهم فقال: ألا اسمعوا ألا اسمعوا، ثم وعظ فقام سلمان فقال: والله لا نسمع والله لا نسمع قال: وما ذاك؟ قال: لأنك قد أعطيتنا ثوبًا ثوبًا ورحت في حلّة فقد تفضّلت علينا بالدنيا، فتبسم ثم قال: عجلت يا أبا عبد الله رحمك الله إني كنت غسلت ثوبي الحلق فاستعرت برد عبد الله بن عمر فلبسته مع بردي: فقال سلمان: قل الآن حتى نسمع ونهى وسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التنعّم وقال: إن عباد الله تعالى ليسوا بالمتنعمين ورؤي فضالة بن عبي وهو والي مصر أشعث حافيًا فقيل له: أنت الأمير وأنت هكذا فقال: نهانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأرفاه وأمرنا أن نحتفي أحيانًا.
وروينا أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أنشد الله رجلاً علم فيّ عيباً لا أخبرني به، فقام شابّ فقال: فيك عيبان اثنان قال: وما هما رحمك اللّّه؟ قال: تذيل بين البردين وتجمع بين الأدمين قال: فما أذال بين البردين وما جمع بين الأدمين حتى لقي الله تعالى، هكذا حدثنا به قال الشيخ: بإسناده يذيل بالذال فمعناه تجمع بين ذيليهما فيتفق ذيل الأعلى على ذيل الأسفل من طول البرد الأعلى وأنا أحسب أن معناه تديل بالدال أي تبدّل أحدهما بآخر دولة ذا ودولة ذا ويصلح أن يكون بالذال من الإذالة أي الوضع يقال: أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إذالة العلم أن يجيب العالم عن كلّ ما يسأل عنه كأنه: أراد تضعهما عندك معًا وهو راجع إلى معنى تديل من الدولة، وقال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما: إن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس الأزرار واخصف النعل وكل دون الشبع، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اخلولقوا واخشوشنوا وتمعددوا وإياكم وزيّ العجم كسرى وقيصر، وقال علي رضي الله تعالى عنه: من تزيّا بزيّ قوم فهو منهم.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أشدّ من هذا أن من شرار أمتي الذي غذوا بالنعيم الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، ولما قدم عمير بن سعد أمير حمص على عمر رضي الله عنه قال له: ما معك من الدنيا يا عمير؟ قال: معي عصاي أتوكأ عليها وأقتل بها حية إن لقيتها ومعي جرابي أحمل فيه طعامي ومعي قصعتي آكل فيها وأعسل فيها رأسي وثوبي ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي ووضوئي للصلاة يعني السطيحة، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي فقال له عمر صدقت رحمك اللّّه وكان عمر رضي الله عنه قد كتب إلى أهل حمص أن عدوا لي فقراءكم فسمّوا له في الكتاب نفراً وذكروا فيهم سعيد بن جذيم ويقال: بل عمير بن سعد فقال عمر: من سعيد بن جذيم؟ فقالوا أميرنا يا أمير المؤمنين، قال: أو فقير هو؟ قالوا: نعم ما فينا أفقر منه، قال: فما فعل عطاؤه قالوا: يخرجه كلّه لا يترك لنفسه ولا لأهله شيئاً منه، فوجه إليه عمر رضي الله عنه بأربعمائة دينار وسأله أن ينفقها على نفسه وأهله، فلما وصلت إليه دخل على زوجته وهو يبكي فقالت له ما شأنك؟ مات أمير المؤمنين؟ قال: أعظم من ذلك قالت: فتق فتق في المسلمين؟ قال: أشدّ من ذلك، قالت: فما هو؟ قال: أتتني الدنيا قد كنت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم تفتح الدنيا عليّ وكنت في أيام أبي بكر رضي الله عنه فلم تفتح الدنيا عليّ وخلفت إلى أيام عمر رضي الله عنه ألا وشّر أيامي أيام عمر، ثم حدثها فقالت: نفسي فداؤك فاصنع بها ما بدا لك فقال: أو تساعديني على ما أريد؟ قال: نعم، قال: أعطيني خلق ذلك البرد قال: فجعل يمزقه ويصرها فيه صررًا ما بين العشرة والخمسة والثلاثة حتى أفناها ثم جعلها في مخلاة وتأبطها وخرج فاعترض جيشًا من المسلمين يريدون الغزو فجعل يدفع إليهم صرّة صرّة على نحو ما يرى من حالهم ثم رجع ولم يترك لأهله منها ديناراً؛ فهذه كانت شمائل جملة أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم.
وروينا في حديث عياض بن غنم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف الأخيار: إن من خيار أمتي فيما أنبأني الملأ الأعلى قوم يضحكون جهراً من سعة رحمة ربهم ويبكون سرّاً من خوف عذابه مؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يلبسون الخلقان ويتبعون الرهبان، أجسامهم في الأرض وأفئدتهم عند العرش، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما وصف الأبدال قال: فقلت له: فكيف لي أن أكون بهذا الوصف وأنّى لي أن أكون مثلهم؟ فقال: يا ابن أخي ما بينك وبين أن تكون في أوّل ذلك وأوسطه إلا أن تزهد في الدنيا فتعاين الآخرة بقلبك فتعمل لها.
وروينا في الخبر: أن الله تعالى يحبّ المبتذل الذي لا يبالي ما لبس، وقال الثوري وفضيل رحمهما الله تعالى: جعل الشر كلّه في بيت وجعل مفتاحه الرغبة في الدنيا، وجعل الخيركله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا، وسئل يوسف بن أسباط وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى: أي الأعمال أفضل؟ فقالا: الزهد في الدنيا وهذا موجود في ظاهر الخبر المنقول عن عيسى عليه السلام، ورويناه عن نبيّنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حبّ الدنيا رأس كل خطيئة ففي تدبرّه أن بعضها رأس كل طاعة، كذلك كان بعض السلف يقول: كفى به ذنبًا لا يستغفر منه حبّ الدنيا، وأشدّ من ذلك ما رواه سفيان عن يحيي بن سليم الطائفي رفعه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو أن عبدًا عبد الله تعالى عبادة أهل السموات والأرض ولقيه محبًّا للدنيا لأقامه الله تعالى في الموقف مقاماً شهره فيه بين الخلائٍق، ألا أن فلان بن فلان قد أحبّ ما أبغض الله تعالى، وقال يحيى بن جابر الطائي: قال عمرو بن الأسود العنسي: لا ألبس مشهوراً أبداً ولا أنام بليل على دثار أبدًا ولا أركب على مابور أبدًا ولا أملأ جوفي من طعام أبدًا.
فقال عمر رضي الله عنه: من سرّه أن ينظر إلى هدى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلينظر إلى عمرو ابن الأسود، وجاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سفر فدخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها فرأى على بابها سترًا وفي يديها قلبين من فضة فرجع، فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي، فأخبرته برجوع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله فقال: من أجل الستر والسوارين، فهتكت الستر ونزعت السوارين فأرسلت بهما بلالاً إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: قد تصدّقت به فضعه حيث ترى فقال: اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصفة فباع القلبين بدرهمين ونصف وتصدّق به عليهم فدخل عليها وقال: بأبي أنت قد أحسنت، وفي الخبر ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله تعالى عنه حتى ينزعه وإن كان عنده حبيبًا، وقال سفيان الثوري وغيره: البس من الثياب ما لم يشهرك عند العلماء ولايحقرك عند الجهال وكان يقول: إن الفقير ليمرّ بي وأنا أصلّي فأدعه يجوز ويمرّ، بعض هؤلاء من أبناء الدنيا وعليه هذه البزة فأمقته فلا أدعه يجوز، قال بعضهم: ما رأيت الغنيّ في مجلس قطّ أذلّ منه في مجلس الثوري رحمه الله تعالى ولا رأيت الفقير أعز منه في مجلس الثوري، وقال آخر: كنا إذا جلسنا إلي سفيان تمينا أنّا كنا فقراء لما نرى من إقباله عليهم وإعظامه لهم وقال بعضهم: إنما العالم هو الذي يقوم الفقير من عنده غنيِّاً والغنيّ من عنده فقيرًا، وقال بعضهم قومت ثوبي سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوانيق، وقال ابن شبرمة: خير الثياب ما خدمني وشرّها ما خدمته.
وقال بعض السلف: أحبّ الثياب إليّ ما لا يستخدمني وأحبّ الطعام إليّ ما لا أغسل يديّ منه، وقال بعض العلماء: البس من الثياب ما يخلطك بالسوقة ولا تلبس منها ما يشهرك فينظر إليك قال: وعددنا في قميص عمر رضي الله عنه أربعة عشر رقعة بعضها من أدم، وكان بعض العلماء يقول: كثرة الثياب على ظهر ابن آدم عقوبة من الله تعالى له وكان الخواص رحمه الله تعالى لا يلبس أكثر من قطعتين؛ إزارين أو قميص ومئزر تحته ويعطف ذيل قميصه على رأسه ويحلّه في وسطه فيغطي به رأسه، وكذلك استحب للفقير وهو حدّ اللباس، وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: الثياب ثلاثة، ثوب لله تعالى، وثوب للنفس، وثوب للناس، فالذي لله تعالى ما ستر العورة وأديت فيه الفريضة، والذي للنفس ما طلبت لينه ونقاءه، والذي للناس ما طلبت جوهره وحسنه، ثم قال: وقد يكون الثوب الواحد للّّه تعالى وللنفس.
وقد كان بعض العلماء يكره أن يكون على الرجل من الثياب ما يجاوز قيمة أربعين درهمًا وبعضهم يقول: إلى المائة ويعدّ سرفًا فيما جاوزها، وكان جمهور العلماء وخيار التابعين قيمة ثيابهم ما بين العشرين إلى الثلاثين، وكان المتقدّمون من الصحابة أثمان إزارهم اثنا عشر درهمًا، فكانوا يلبسون ثوبين قيمة نيف وعشرين درهماً، واشترى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثوباً بأربعة دراهم وكان قيمة ثوبيه عشرة إلى دينار، وكان طول إزاره أربعة أذرع ونصف، واشترى سراويل بثلاثة دراهم وكان يلبس شملتين بيضاوين من صوف وكانت تسمّى حلّة لأنها ثوبان من جنس واحد وربما لبس ثوبين من جنس واحد وربما لبس بردتين يمانيين أو سحوليين من هذه الغلاظ، وفي الخبر: كان قميص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأنه قميص زيات وقد لبس عليه السلام يوماً واحداً ثوب سيراء من سندس قيمته مائتا درهم فكان أصحابه يلمسون ويقولون: أنزل عليك هذا من الجنة تعجّباً منه وكان قد أهداه إليه المقوقس ملك الإسكندرية فأراد أن يكرمه بقبول هديته ويلبسه ثم نزعه، وأرسل به إلى رجل من المشركين وصله به ثم حرم لبس الحرير والديباج، وقد يكون لبسه إياه توكيدًا للتحريم بعده كما لبس خاتمًا من ذهب يوماً واحداً، ثم نزعه فحرم لبسه على الرجال، وكما قال لعائشة رضي الله عنها في شأن بريرة: اشترطي لأهلها الولاء، فلما اشترطته صعد المنبر فحرمه فهذا يكون مؤكدًا للتحريم، وكما أباح المتعة ثلاثًا ثم حرمها لتوكيد أمر النكاح، وقد يحتج بمثل هذا علماء الدنيا ويطرقون به لنفوسهم ويدعون الناس منه إليهم ويظهرون الدعوة إلى الله تعالى تأولاً بمتشابه الحديث كما تأوّل أهل الزيغ متشابه القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطلبًا للدنيا لأن حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على معاني كلام اللّّه تعالى فيه: ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاصّ وعام، وعدل علماء الدنيا وأهل الأهواء عن المحكم السائر من فعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله إلى ما ذكرناه وقد صلّى رسو ل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خميصة لها علم، فلما سلم قال: شغلني النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بانبجانيته يعني كساءه فاختار لبس الكساء على الثوب الناعم.
ورأى على باب عائشة رضي الله عنها ستراً فهتكه وقال: كلما رأيته ذكرت الدنيا: أرسلي به إلى آل فلان، وفرشت له عائشة رضي الله عنها ذات ليلة فراشًا جديدًا وكان ينام على عباءة مثنية، فما زال يتقلّب ليلته فلما أصبح قال: أعيدي العباءة الخلقة ونحّي هذا الفراش عني قد أسهرني الليلة، وكذلك أتته دنانير خمسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليلته حتى آخرجها من آخر الليل، قالت عائشة: فنام حينئذ حتى سمعت غطيطه ثم قال: ما ظنّ محمد بربه لو لقي الله تعالى وهذه عنده، وكان شراك نعله العربيّ قد أخلق فأبدل بسير جديد، فصلّى فيه فلما سلم قال: أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد فإني نظرت إليه في الصلاة ولبس خاتماً فنظر إليه وهو على المنبر بنظرة فرمى به وقال: شغلني هذا عنكم نظرة إليه ونظرة إليكم، وقد قال تعالى: (قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَِّبعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللهُ) آل عمران: 31 وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أحبني فليستن بسنتي، وقال في الخبر المشهور: عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: من علامة حبّ الله تعالى حبّ النبي عليه السلام، ومن علامة حبّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبّ السنّة ومن علامة حبّ السنّة بغض الدنيا، وعلامة بغضها أن لا يأخذ منها إلا زاداً وبلغة
وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رضي الله عنها: إن أردت اللحوق بي فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي ثوبًا حتى ترقعيه، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد احتذى نعلين جديدتين فأعجبه حسنهما فخرّ ساجدًا وقال: أعجبني حسنهما فتواضعت لربي خشية أن يمقتني، ثم خرج بهم فدفعهما إلى أول مسكين رآه وأمر عليًّا رضي الله عنه فاحتذى له نعلين سنديتين قال: فرأيته وقد لبسهما يعني جرداوين أي معطوفتين وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة من كان على مثل ما أنا عليه من الدنيا، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا، وقال عليه السلام: لا يعذّب الله عبدًا جعل رزقه في الدنيا قوت يوم بيوم، وقال عليه السلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه في الدنيا قوتًا وقنع به، وفي لفظ آخر: وصبر عليه، وقال عليه السلام: أحد غنيّ ولا فقير إلا ودّ يوم القيامة أن رزقه كان في الدنيا قوتًا.
وروينا عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهم من أحبّني وأجاب دعوتي فأقلّل ماله وولده، من أبغضني ولم يجب دعوتي فأكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة الأتباع، وكانت هذه دعوة الصحابة على من مقتوه، وروينا في الخبر: نقصان الدنيا زيادة الآخرة وزيادة الدنيا نقصان الآخرة وفي الأثر: ما من أحد أعطي من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجته وإن كان على الله تعالى كريماً. وقال إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله في وصف المدّعين: وقوم ادّعوا الزهد ولبسوا الفاخر من الثياب يموّهون بذلك على الناس ليهدوا إليهم مثل لباسهم ولئلا ينظر إليهم بالعين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقرون فيعطون كما يعطى المساكين ويحتجون لنفوسهم باتساع العلم وإنهم على السنّة وإن الأشياء داخلة عليهم وهم خارجون منها، وإنما يأخذون بعلّة غيرهم، هذا إذا طولبوا بالحقائق وألجئوا إلى المضايق، وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولا بتهذيب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادّعوا حالاً لهم مائلون إلى الدنيا متبعون الهوى، وكان الخواص رحمه الله تعالى لا يلبس أكثر من قطعتين إزارين وقميص ومئزر تحته، ويعطف ذيل قميصه على رأسه ويغطّي به رأسه، وكذلك استحبّ للفقير هذا اللباس والأخبار في فضائل الفقر وفضل الفقراء وفي ذمّ الدنيا ونقص الأغنياء أكثرمن أن تذكر ولم نقصد جمعها ولا كثرة الاستدلال بها، ومن الزهد ترك فضول للبنيان وأن لايبنى عاليًا ولا مشيدًا ولا من الطين إلا ما يحتاج إليه وقيل: أوّل بدعة حدثت بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المناخل والموائد، وأوّل شيء ظهر من طول الأمل التدريز والتشييد يعني دروز الثياب وإنما كانت تشلّ شلاً والبنيان الجص والآجر وهو التشييد، وإنما كانوا يبنون بالسعف والجريد.
وقد جاء في الأثر: يأتي على الناس زمان يوشّون بينانهم كما توشّى البرود اليمانية، ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قد بني بجصّ وآجر فكبر وقال: ما كنت أظنّ أن في هذه الأمة من يبني بنيان هامان لفرعون يعني قول فرعون فأوقد لي يا هامان على الطين يعني به الآجر، يقال: أوّل من بنى بالجصّ والآجر فرعون وأوّل من عمله هامان ثم تبعهما الجبابرة، فهذا هو الزخرف، وذكر بعض السلف جامعًا في بعض الأمصار فقال: أدركت هذا المسجد مبنيّاً من الجريد والسعف ثم رأيته مبنيّاً من رهوص ثم رأيته الآن مبنيّاً باللّبن، فكان أصحاب السعف خيرًا من أصحاب الرهوص، وكان أصحاب الرهوص خيرًا من أصحاب اللبن، وقد كان في السلف من يبني داره مراراً في مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله ولزهده في إتقان البنيان وكان منهم من إذا حجّ أو غزا نزع بيته أو وهبه لجيرانه فإذا رجع أعاده، وكانت بيوتهم من الحشيش والثمام والجلود وعلى ذلك العرب ببلاد اليمن إلى اليوم، وأمر رسول اللهّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العباس رضي الله عنه أن يهدم علية كان قد علا بها، ومرّ عليه السلام بجنبذة معلاة فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان، فلما جاءه الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغيّر وجه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبروه فرجع فهدمها، فمرّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالموضع فلم يرها فسأل عنها فأخبر أنه هدمها فدعا له بخير، وكان سمك بناء السلف قامة بسطة وقال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضربت بيدي إلى السقف، وقال عمرو بن دينار: إذا أعلى العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إلى أين يا فاسق الفاسقين؟ وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من بنى فوق ما يكفيه كلّف أن يحمله يوم القيامة ومرّ عمر رضي اللّّه عنه ببيت عال فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج رؤوسها ومرّ بعامل له فرآه قد علي وشيد فقال لي: على كل خائن أمينان الماء والطين ثم شاطره ماله فجعله في بيت المال، وفي الخبر: كل نفقة يؤجر عليها العبد إلا ما أنفعه على الماء والطين.
وقد روينا عن بعض السلف: إذا مقت الله تعالى مال عبد سلّط عليه الماء والطين، وقال يحيى بن يمان رحمه اللّّه: كنت أمشي مع الثوري رحمه الله في طريق فنظرت إلى باب مشيّد قال: لا تنظر إليه فقلت يا أبا عبد الله ما تكره من النظر قال إذا نظرت إليه كنت عوناً له على بنائه لأنه إنمّا بناه لينظر إليه ولو كان كلّ من مرّ به لم ينظر إليه ما عمله وقد قال بعض السلف قبله: ولا تنظر إلى بنيانهم فإنهم إنما زخرفوه لأجلكم وفي قول الله تعالى: (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًَّا في الأرض وَلا فَسَادًَا) القصص: 83 قيل: حبّ الكثرة والرياسة والتطاول في البنيان، وكذلك قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كلّ بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكن من حرّ أو برد، وقال للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله اتسع في السماء أي في الجنة وهذا أحد التأويلين، والثاني اتسع في المعرفة ولا تطلب اتساع المكان واعلم أن الزهد لا ينقص من الرزق ولكنه يزيد في الصبر ويديم الجوع والفقر فيكون هذا رزقاً للزاهد من الآخرة على هذا الوصف من حرمان نصيبه من الدنيا وحمايته عن التكثر منها والتوسّع فيها ويكون الزهد سببه فيكون ما صرفه عنه ومنعه من الغني والتوسع رزقه من الآخرة والدجات العلى بحسن اختيار من الله تعالى وحيطة نظركما.
حدثنا عن بعض العلماء: أن بقّالاً جاءه فقال: إني كنت أبيع في محلة لا بقّال فيها غيري، فكنت أبيع الكثير ثم قد فتح عليّ بقّال آخر فهل ينقص ذلك من رزقي شيئاً فقال: لا ولكن يزيد في بطالتك عن البيع، فلعله بطّالاً لاعباً يحتجّ لتوسّعه وهواه ويموّه على أبناء الدنيا ممن يتولاه فيقول بأن الزهد في الدنيا لما لم ينقص من رزقي شيئاً قد صح مقاماً لي مع التوسّع والاستكثار وعلى التنعّم والرفاهية والاستئثار لأنّي إنما آكل رزقي وآخذ قسمي فلي في الزهد مقام ومن الرضا والتوكل حال أو يقول: إن الزهد قد يصبح مع التكاثر والزينة يزخرف بقوله على من لا يعرف الزهد ويغرّ بمقالته من لايعرف طريق الزاهدين ولعلّه ممن يأكل الدنيا بالدين أو يزخرف القول ويشبه العلم على الغافلين، فمثله كما قال علي رضي الله عنه للخوارج حين قالوا: لا حكم إلا الله فقال: كلمة حقّ أريد بها باطل وصدق رضوان الله عليه لأنهم أرادوا بذلك إسقاط حكم الأئمة وترك الطاعة للإمام العادل.
كما أراد القائل: إنما آكل رزقي وآخذ من الأشياء قسمي، الاحتجاج لنفسه بهواه والاعتذار عند الجاهلين خيفة لومهم إياه ولا يعلم المغرور بداء الغرور أنه وإن كان يأكل رزقه من الدنيا ويأخذ قسمه من العطاء فبحكم النقص والبعد وبوصف الرغبة والحرص لأن السارق والغاصب أيضًا يأكل رزقه ويأخذ قسمه ولكن بحكم المقت وسوء الاختيار إذا كان الله سبحانه وتعالى يرزق الحرام للظالمين كما يرزق الحلال للمتقين وإنما بينهما سوء القضاء ودرك الشقاء للأعداء وحسن التوفيق والاختيار بالسعادة للأولياء من المولى الكريم فقد حرم المدعي لذلك رزقه من الزهد وبخس نصيبه الأوفر من حبّ الفقر ونقص حظّه الأفضل من الآخرة إذ كانت الدنيا ضدّها وجعل ما صرف فيه وما صرف إليه سبباً لنقصان مرتبته من طرائق الزاهدين، وأنه قد اختبر بالدنيا وبما فتح عليه من السرّاء ليظهر صدقه من كذبه فوقع في الفتنة ولم يفطن للابتلاء وصارت مشاهدته هذه إذا كان صادقاً فيها غير كاذب على وجده حجابًا له عن علوم العارفين المعصومين، واستدرج بعلمه هذا لأنه علم من علوم الدنيا يفنى بفنائها لا ثمرة له في الباقية مكر به فيه وعدل به إليه عن علوم الخائفين ومشاهدة الورعين الزاهدين الذين نظروا من الحلال في الدقيق وصدقوا القول في ترك الرغبة بالعمل بالزهد للتحقيق وإن كان كاذباً في مشاهدته ظالماً لنفسه بما ادّعاه من وجده فهو من أولياء الشياطين ومن أئمة المضلين قيض للاعبين وسيق إليهم فتنة لهم ليس إماماً للمتقين بل من الأئمة المضلّين المحرومين أبناء الدنيا الغافلين رغبة في الدنيا وزهداً في طرائق السلف لوجود الطمع وعدم اليقين فقد مكر بهذا المعدول به عن علوم الموقنين وحقائق مشاهدتهم على هذا الوصف الذي أريد به بالذي تقلّب فيه وهولا يشعر بالمكر ولا يعرف الاستدراج بالنِّعم وأنَّى له بعلم ذلك والله تبارك وتعالى يقول: (سنستدرجهم من حيث لا يعملون) الأعراف: 182
قال تعالى: (ومكروا مكراً ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون) النمل: 50 فهيهات هيهات أن يفطن الممكور لما مكر به أو يعلم المستدرج ما درج فيه لأن الماكر ألطف الماكرين والمدرج أحكم الحاكمين نعوذ بالله تعالى من الاغترار بعلم الإظهار ونسأله الصلاة على نبّيه محمد وآله أجمعين وحسن التوفيق لمشاهدة علم التحقيق، وبمثل ما قلناه جاءت الآثار وكثرت الأخبار إن مثل الدنيا والآخرة كضرتين رضا إحداهما في سخط الأخرى وأنهما بمنزلة المشرق والمغرب من استقبل أحدهما استدبر الآخر، وأنهما بمنزلة كفتّي الميزان رجحان إحداهما بنقصان الأخرى وكان عمر رضي الله عنه يقول: والله إن هما إلا بمنزلة قد حين لك ملئ أحدهما فما هو إلا أن تفرغ أحدهما في الآخر يعني أنك إن امتلأت من الدنيا تفرّغت من الآخرة وإن امتلأت من الآخرة تفرّغت من الدنيا، وإن كان لك ثلث قدح الآخرة أدركت ثلثي قدح الدنيا وإن كان لك ثلثا قدح الآخرة يكون لك ثلث قدح الدنيا، وهذا تمثيل حسن إلا أن فيه شدّة وتدقيقاً، وقال بعض السلف: مثل من زهدفي الدنيا مع التنعم فيها كمثل من يغسل يديه من الغمر بسمك، وقال آخر: مثل من زهد وهو يطلب الدنيا مثل يطفئ النار بالحلفاء، وكان بعض الزاهدين من أهل الشام يتكلم عليهم؛ فكان رجاء بن حيوة فقيه أهل الشام يحضر مجلسه، فاحتبس يومًا عنهم وقد اجتمعوا فتكلم عليهم مؤذن الجامع فأنكر صوته رجاء بن حيوة فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان فقال: اسكت عافاك الله إنّا نكره أن نسمع الزهد إلا من أهله، وفي لفظ آخر: إنّا نكره أن نسمع الوعظ إلا من أهل الزهد، وقال عيسى عليه السلام: لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيا فإن بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم وقال بعض العلماء: تقليب الأموال يمصّ حلاوة الإيمان.
وروينا في الخبر: لكلّ أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم؛ وكان أصل العجل من الحلية، وقال عزّ وجلّ: (ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) الرعد: 17 فكان فهم هذه السنّة عن سمع هذه الآية يقال: مامن يوم ذي شارقة إلا وأربعة أملاك ينادون في الآفاق بأربعة أصوات؛ ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب، يقول أحدهما من المشرق: يا باغي الخير هلمّ ويا باغي الشرّ أقصر، ويقول الآخر: اللهم أعط منفعاً خلفاً واعط ممسكاً تلفاً، ويقول أحد اللذين في المغرب: لدوا للموت وابنوا للخراب، ويقول الآخر: كلوا وتمتعوا لطول الحساب، وقال بعض العلماء: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس المطيعين به وبلغنا أن من دعاء أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الذلّ عند النصف من نفسي والزهد فيما جاوز الكفاف.
وقال بعض العارفين: ما من شيء إلا وهومطروح في الخزائن إلا الفقر مع المعرفة فإنه مخزوم مختوم عليه لا يعطاه إلا من طبع بطابع الشهداء، وقد يحتجّ بعض علماء الدنيا لأنفسهم بتفضيل الغنى على الفقر بتأويل الخبر من قوله تعالى: (ذلِكَ فَضْلُ الله يُوْتيِه مَنْ يَشَاءُ) الجمعة: 4 وهذا عند أولي الألباب في تدبّر الخطاب معنيّ به الفقراء لأنه قيل لهم في أوّل الكلام: إن فعلتم كذا لم يسبقكم أحد قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم فثبت هذا القول من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصحّ لأنه معصوم في قوله كما هو معصوم في فعله، فلا ينبغي أن ينقض أول الكلام آخره، فما جاء بعده محمول عليه ولم يصلح أن ينقلب لأنه إخبارعن شيء فلا يجوز الرجوع عنه، ولما فعل الأغنياء ما أمر به الفقراء وقف الفقراء في نظر الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمنظرهم إلى مزيد الأغنياء عليهم بالقول فرجعوا إليه يستفتون منه ما أخبر به قال: لاتعلجوا فإن الذي قلت لكم كما قلت هو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء وأنتم ممن شاء أن يؤتيه فضله، فصحّ تأويلنا هذا وبطل تأويلهم بدليل قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأوّل، فكان قوله الثاني بالآخر مواطئاً لقوله الأوّل ولم يناقض الأوّل بالآخر، كيف وقد جاء دليل ما قلنا مكشوفاً في الحديث المفسّر الذي رويناه عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بعث الفقراء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولاً فقال: إن رسول الفقراء إليك فقال: مرحبًا بك وبمن جئت من عندهم من عند قوم أحبّهم قال: قالوا: يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجّون ولا نقدر عليه ويعتمرون ولانقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبلغ عني الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء، أما خصلة واحدة فإن في الجنة غرفًا ينظر إلها أهل الجنة كما ينظر أهل الأرض إلى نجوم السماء لا يدخلها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير، والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام، والثالثة إذا قال الغني: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغني الفقير، وإن أنفق فيها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البرّ كلها فرجع إليهم فقالوا: رضينا فهذا يدل على صحة تأويلنا.
وقد روينا معنى هذا مجملاً في الخبر الذي رويناه عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه: أي الناس خير؟ قالوا: موسر من المال يعطي حقّ الله في نفسه وماله فقال: نعم الرجل هذا وليس به قالوا: فمن خير الناس؟ مؤمن فقير يعطي جهده، فذهب القوم إلى علم العقل فردّهم الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى علم اليقين فكذلك من فضل حال الغنى على حال الفقر فإنه ينظر في العلم بعين العقل وإنما يشهد الآخرة والحقيقة بعين اليقين وهذا نصّ في تفضيل حال الفقر، فمن فضّل الغنى بعده فقد عاند السنّة إن كان عالماً فأحسن حاله الجهل بالآثار وإن كان جاهلاً فمقامه في الجهل أضرّ عليه من نطقه بالعلم بهوى، وفي الخبر الآخر: خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجّعاً في الجنة ضعفاؤها، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبلال: إلق الله تعالى فقيرًا ولا تلقه غنيّاً قال: وكيف لي بذلك؟ قال: إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأ أفتراه كان يأمر بلالاً بأدنى الحالين فكيف وهو من أعلى الصحابة فأشبه الفقر في الأحوال اليقين في الإيمان، كما قال لابن عمر: اعمل لله بالرضا واليقين فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً فرفعه إلى اليقين لفضله كما رفع بلالاً إلى الفقر لشرفه في الأحوال فلم يكن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرضى لبلال إلا ما يرضاه لنفسه فصار الفقر حال الموقن لأنه يكشف الآخرة، وصار الشكر في الغنى حال المؤمن لأنه يوجد الدنيا ففضل الفقير الزاهد على الغني الشاكر كفضل الموقن الشاهد على الموقن المجاهد.
وكذلك روينا في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهم توفّني فقيرًا ولا توفّني غنيّاً ولم يكن ليأمر بلالاً بأدنى الحالين فيقول: إلق الله تعالى فقيرًا كما لم يندب ابن عمر إلى أخفض المقامين لقوله: اعمل لله تعالى بالرضا في اليقين، وكذلك جاء في الخبر المشهور الذي دعا فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنفسه أن يحييه الله تعالى مسكيناً ويتوفّاه مسكيناً ويحشره في زمرة المساكين، كلّ ذلك لتفضيل الفقر وتشريف الفقراء مع قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم يعني خمسمائة عام، وروينا عن عيسى عليه السلام أنه قال: إني لأحبّ المسكنة وأبغض المال للغني وإن في المال داء كثيرًا قيل: ياروح الله وإن كان يكتسبه من حلال قال يشغله كسبه عن ذكر الله تعالى قال وهب بن منبه لابن عباس: إنّا نجد في التوراة أن الفقير المصلح خير من الغني المصلح، قال ابن عباس: أما علمت أنه لا شيء أحبّ إلى الله تعالى من الفقير إذا كان صالحًا وقيل: كان أحبّ الأسماء إلى عيسى عليه السلام أن يدعى به أن يقال له يا مسكين وكان يقول: من شرّ الغنى أن العبد يعصي ليستغني ولا يعصي ليفتقر، وقد قال بعض حكمائنا في كلام منظوم:
يا عائباً للفقر تبغي الغنى ... عيب الغنى أعظم لو تعتبر
إنك تعصي لتنال الغنى ... ولست تعصي الله كي تفتقر
وروينا في حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري: يا أيها الناس لا تحملنّكم العسرة والفاقة على أن تطلبوا الرزق من غير حلّه فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهم توفّني فقيرًا ولا توفّني غنيّاً واحشرني في زمرة المساكين، وقال لقمان لابنه: يا بني إن من أعون الأخلاق على صلاح الدين زهداً في الدنيا، من يزهد في الدنيا يرغب فيما عند الله تعالى، ومن يرغب فيما عند الله تعالى يعمل لله تعالى، ومن يعمل الله تعالى يأجره الله تعالى، وقال الحواريون: يا روح الله نحن نصلّي كما تصلي ونصوم كما تصوم ونذكر الله تعالى كما أمرتنا ولا نقدر نمشي على الماء كما تمشي أنت، فقال: أخبروني كيف حبّكم للدنيا قالوا: إنّا لنحبها فقال: إن حبّها يفسد الدين لكنها عندي بمنزلة الحجر والمدر، وفي خبر آخر: إنه رفع حجراً فقال: أيهما أحبّ إليكم هذا أو الدنيار والدرهم؟ قالوا الدنيار، قال: فإنهما عندي سواء ويقال إن من صحّ زهده في الدنيا حتى يستوي عنده الذهب والحجر مشى على الماء وقد اشتهر ذلك في العامة حتى قال الشاعر:
لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في ... وصلي مشيت بلا شكّ على الماء
وروينا أن عيسى عليه السلام مرّ في سياحته برجل نائم ملتفّ في عباءة فأيقظه وقال: قم يا نائم فاذكر الله تعالى فقال: ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها فقال له عيسى عليه السلام: نم حبيبي إذًا نم، وروينا عن موسى عليه السلام أنه مرّ برجل نائم على التراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته في التراب وهو متّزر بشمل عباءة فقال: يا ربّ عبدك هذا في الدنيا ضائع، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى أما علمت أني إذا نظرت إلى عبدي بوجهي كله زويت عنه الدنيا كلّها، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيّه إسماعيل عليه السلام: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم قال يا ربّ ومن هم قال الفقراء الصادقون، فهذا كأنه مفسّر لخبر موسى عليه السلام في وقوله أين أجدك قال: عند المنكسرة قلوبهم وقد كان أحمد بن عطاء وهو من المتأخرين يفضّل حال الغنى على الفقر لشبهة دخلت عليه، وهو أن بعض الشيوخ سأله عن الوصفين أيهما أفضل؟ قال: الغني لأنه صفة الحقّ فقال له الشيخ: فالله غني بالإعراض والأسباب فانقطع ولم ينطق بحرف، وهذا كما قال الشيخ لأن الله تعالى غني بوصفه، فالفقير أحقّ بهذا المعنى لأنه غنيّ بوصفه بالإيمان لا بالأسباب لانفرادها عنه، فهو الأفضل فأما الغنيّ فإنه مشتّت مجتمع بالأسباب فهو مفضول بالارتياب وقد خالفه الخوّاص فوفق للصواب وكان فوقه في المعرفة فقال في كتاب شرف الفقر والفقر صفة الحقّ أي صفة منه يصف به الفقراء فوافقنا في التأويل يعني أنه تعالى متخلٍّ عن الأشياء منفرد عنها، ووجه آخر من الغلط الذي دخل عليه من جهة الغنى الذي ذكره لأنه إن كان فضل الغنى على الفقر لأنه صفة الحقّ فينبغي أن يفضّل المتكّبر الجبّار ومن أحبّ المدح والعزّ والحمد لأن ذلك كله صفة الحقّ فما أجمع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه كان من وصفه الغنى في معناه لأن وصف الغنى صفة الحقّ مقترن بالعزّ والكبر، وينبغي أن يسلّم صفات الحقّ للحقّ ولا ينازع إياها ولا يشارك فيها، فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقول الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي من نازعني أحدهما قصمته في النار، وقد خالفه أيضًا ووافقنا من لا يشك الخاص والعام في فضل معرفته عليه أبو محمد سهل بن عبد الله فقال: من أحبّ الغنى والبقاء والعزّ فقد نازع الله تعالى صفاته وهذه صفات الربوبية يخاف عليه الهلكة فإذا ثبت ذلك كان الفقر أفضل لأنه وصف العبودية، فمن جعله وصفه فقد تحقق بالعبودية وأوصاف العبودية هي أخلاق الإيمان وهي التي أحبّها اللّّه تعالى من المؤمنين مثل الخوف والذلّ والتواضع والفقر مضاف إليها وأوصاف الربوبية ابتلى به قلوب أعدائه الجبارين والمتكبرين مثل العزّ والكبر والبقاء والغنى مضموم إليها.
وكان الحسن رحمه الله يقول: مارأيت الله تعالى جعل البقاء إلا لأبغض خلقه إليه وهو إبليس، وكذلك كان العلماء يقولون: لا ترغبوا في البقاء في هذه الدنيا فإن شرار الخلق أطولهم بقاء وهم الشياطين، والغنى إنما يراد للبقاء ويقال: إن الجنيد رحمه الله تعالى باهل بن عطاء في هذه المسألة ودعا عليه لأنه أنكر قوله أشد الإنكار وكان يقول: الفقير الصابر أفضل من الغنيّ الشاكر وإن تساويا في القيام بحكم حالهما لأن الغنيّ التقيّ يمتّع نفسه وينعم صفته والفقير الصابر قد أدخل على صفته الآلام والمكاره فقد زاد عليه بذلك، وهذا كما قال وكذلك كان أحمد بن حنبل يقول: ما أعدل بالفقر شيئاً وكان يفضّل حال الفقر يعظم شأن الفقير الصابر وقال المروزي وذكر بعض الفقراء فجعل يمجّده ويكثر السؤال عنه قال: فقلت له يحتاج إلى علم فقال ويحك اسكت صبره على الفقر ومقاساته للضرّ فيه خير من كثير من العلم ثم قال هؤلاء خير منا بكثير وأقول إن من فضل حال الغنى على الفقر فإنه لم يذق مرارة الفقر ولا حلاوته فهو غرّ بشدته فاقد لحلاوته لأنه لو ذاق مرارته من الضرّ والهمّ لفضله ولوأذيق حلاوته من الزهد والرضا لما فضل عليه.
وقد روينا في الخبر: يقول إبليس لم ينج الغني مني من إحدى ثلاث خصال؛ أن أحبب إليه المال فيكتسبه من غير حقّه أو يضعه في غير حقّه أو يمنعه من حقّه، فلولم يعلم العدو أن الفقر من أفضل الأحوال ما قعد على طرقه وقد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم فأخبر الخبر عنه فقال: الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم به، فجاء الفقير الصادق فسلك الطريق المستقيم إلى الآخرة واطرح تخويف العدّو بحول الله وقوّته وقيل: الأغنياء المغتبطون بغناهم تخويف العدوّ فجاء بنو الفقر فحلق بهم مثل السوء، من ذلك قوله: (إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون) آل عمران: 175 فقبلوا تخويف الشيطان وخالفوا ندب الرحمن فكانوا كمن قيل فيهم: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه) الحج: 11، الآية فلو لم يكن من فضل الزاهدين إلا أنهم توسطوا الطريق الذي هرب الناس منه وأمنوا بالتوكّل على الله والرضا عنه ماخافه أبناء الدنيا لكفاهم.
ذكر ماهية الدنيا
وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد في مقاماتهم،
ثم إن الدنيا هي نصيب كل عبد من الهوى وما دنا من قلبه من الشهوات، فمن زهد في نصيبه وملكه من هواه المذموم فهذا هو الزهد المفترض، ومن زهد في نصيبه من المباح وهو فضول الحاجة من كّل شيء، فهذا هو الزهد المفضل يرجع ذلك إلى حظوظ جوارحه التي هي أبواب الدنيا منه وطرقها إليه، فالزهد في محرّماتها هو زهد المسلمين به يحسن إسلامهم، والزهد في شبهاتها هو زهد الورعين به يكمل إيمانهم، والزهد في حلالها من فضل حاجات النفس هو زهد الزاهدين به يصفو يقنيهم، وروينا في حديث عمرو بن ميمون عن الزبير بن العوّام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: يازبير اجهد نفسك عند نزول الشهوات والشبهات بالورع الصادق عن محارم الله عزّ وجلّ تدخل الجنة بغير حساب، وكان سهل يقول في فضائل الزهد وأعلى مقاماته: لا يتمّ زهد عبد حتى يزهد في هذه الثلاث؛ في الدرهم الذي يريد أن ينفقه في أبواب البّر يتقرب بذلك إلى الله تعالى، ويزهد في الثياب التي تستر بدنه في الطاعات، ويزهد في قوته الذي يستعين به على العبادة، وإنما قال هذا لأن عنده حقيقة الزهد من أفضل المقامات كلاً لأنه كان يقول: يعطى الزاهد جميع ثواب العلماء والعباد، ثم يقسم على المؤمنين ثواب أعماله، وقال: لا يوافي القيامة أحد أفضل من ذي زهد وعلم ورع، وقال أيضاً: لا ينال الزهد إلا بالخوف لأن من خاف ترك فجعل الزهد مقاماً في الخوف رفعه مزيداً لهم عليه.
وقد روى مسروق عن ابن مسعود: ركعتان من زاهد قلبه خير له وأحبّ إلى اللّّه تعالى من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبدِاً سرمداً ولانهاية للزهد عند طائفة من العارفين لأنه يقع عن نهاية معارفهم بدقائق أبواب لدنيا وخفايا لوائح الهوى، وقال بعضهم: نهاية الزهد أن تزهد في كل شيء وتتورع عن كلّ شيء للنفس فيه متعة وبه راحة فهذا كما روى عن عيسى عليه السلام أنه وضع تحت رأسه حجرًا فكأنه لما ارتفع رأسه عن الأرض استراح بذلك فعارضه إبليس فقال: يا ابن مريم ألست تزعم أنك قد زهدت في الدنيا قال: نعم، قال: فهذا الذي وطأته تحت رأسك من أي شيء هو؟ قال: فرمى عيسى عليه السلام بالحجر، وقال: هذا لك مع ما تركت ومثله.
روينا عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه لبس المسوح حتى نقب جلده فسألته أمه أن ينزع مدرعته الشعر ويلبس مكانها جبة من صوف ففعل فأوحى الله تعالى إليه: يا يحىى آثرت عليّ الدنيا قال: فبكى ونزع الصوف ورد مدرعته الشعر على جسده، وكان الحسن يقول: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبًا قطّ، كان إذا أراد النوم باشر الأرض بجسمه وجعل ثوبه فوقه واعلم أنّي رأيت جمل النعم ثلاثًا وتمامها بالزهد، وذلك أن أصل النّعم كلّها الإسلام، لأن من ورائه مقامات كثيرة أخطأوا فيها حقيقة التوحيد، ثم النعمة الثانية السنّة، إذ من ورائها بدع كثيرة كلّهم أخطأوا حقيقة السنة، والنعمة الثالثة العلم بالله تعالى لأن من ورائه جهلاً كثيراً بعظمة الله تعالى وقدرته، ثم الزهد في الدنيا فمن أعطيه مع الثلاث تمّت عليه النّعم فكان مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي تمّت نعمة الله عليهم لأن من ورائه حرصًا كثيرًا على الشبهات ورغبة عظيمة في الشهوات.
وقد كان سهل رحمه الله تعالى يجعل الزهد من شرط السنّة والاتباع لقوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتِبِعُوني) آل عمران: 31 قال: فمن السنّة اتّباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان زاهداً ثم تفاوت الزاهدون لأيّ شيء زهدوا مقامات على نحو علوّ المشاهدات، فمنهم من زهد إجلالاً لله تعالى، ومنهم من زهد حياءً من اللّّه تعالى، ومنهم من زهد خوفاً من الله تعالى ومنهم من زهد رجاء موعود الله تعالى ومنهم من زهد مسارعة منه لأمر الله تعالى ومنهم من زهد حبّاً لله تعالى وهو أعلاهم وأدناهم من زهد مخافة طول الوقوف ومناقشة الحساب كما قيل: ذو الدرهمين أشدّ حسابًا يوم القيامة من ذي الدرهم ولأن طريق المتقين لا يسلكه من ملك في الدنيا زوجين من شيء، ما أحد يعطي من الدنيا شيئًا إلا قيل: خذه على ثلاثة أثلاث؛ ثلث همّ، وثلث شغل، وثلث حساب، وأن الرجل من الأغنياء ليوقف للحساب ما لو ورد مائة بعير عطاش على عرقه لصدرن رواء وإنه ليرى منازله من الجنة فلما وقر هذا في قلوب الورعين أشفقوا من طول الحساب فزهدوا في الجمع والمنع وفارقوا فضول الآمال طلبًا لخفة السؤال وسرعة الوقوف في الأهوال، ومن الزهد في الدنيا حبّ الفقر وأهله ومجالسة المساكين في أوطانهم والتذلّل لهم كما كان مطرف رحمه الله تعالى يجالس المساكين في بزّته يتقرّب بذلك إلى ربه، وكان محمد بن يوسف الأصفهاني عالماً زاهدًا ومن الناس من كان يفضّله على الثوري رحمها الله تعالى، إلا أنه كان يؤثر الخمول فلم يكن يعرفه إلا العلماء، وكان من حسن رهعايته وشدة يقظته يعمل في كلّ وقت أفضل ما يقدر عليه في ذلك الوقت، فلما طلبه ابن المبارك بالمصيصة قال له بعض من يعرف حاله: إن ذاك لا يكون في المصر إلا في أفضل موضع فيه قال: فهو إذا في الجامع فطلبه فقيل له: إنه لا يقعد إلا في أفضل مكان قال: فطلبه عند الفقراء فإذا هو دسّ رأسه وأخمل نفسه مع المساكين فكان عنده أن أفضل وطن في المصر الجامع لأنه يقال: إن الصلاة فيه بخمسين صلاة وإن أفضل الأماكن موضع الفقراء من الجامع وإن أفضل الأحوال الخمول، فلذلك أخمل نفسه فيما بين الفقراء في الجامع ليحوز فواضل الأعمال، ومن الزهد أن يكون بفقره مغتبطاً مشاهداً لعظيم نعمة الله تعالى عليه به يخاف أن يسلب فقره ويحول عن زهده، كما يكون الغني مغتبطاً بغناه يخاف الفقر ثم وجودحلاوة الزهد حتى يعلم الله تعالى من قلبه أن القلّة أحبّ إليه من الكثرة وأن الذلّ أحبّ إليه من العزّ وأن الوحدة آثر عنده من الجماعة وأن الخمول أعجب إليه من الاشتهار فهذا من إخلاصه في زهده.
وروينا عن عيسى عليه السلام وعن نبيّنا عليه السلام: أربع لا يدركن إلا بعجب الصمت، وهو أوّل العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشيء، وقال الثوري رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل عالماً حتى يعد البلاء نعمة والرخاء عقوبة، وقال بعض السلف: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يكون الفقر أحبّ إليه من الغنى والذل آثر عنده من العزّ، وقد روينا خبراً مقطوعاً: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا يعرف أحبّ إليه من أن يعرف وحتى يكون قلّة الشيء أحبّ إليه من كثرته، وكان السلف الصالح يقولون: نعمة الله علينا فيما صرف عنّا من الدنيا أعظم من نعمته فيما صرف إلينا، وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول الدنيا دار التواء لا دار استواء ودار ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء، وكان سهل بن عبد الله رحمه الله يقول: لا يصحّ التعبّد لأحد ولايخلص له عمل حتى لا يجزع ولا يفرّ من أربعة أشياء: الجوع، والعرى، والفقر، والذل.
كما روينا أن إبراهيم التميمي رحمه الله تعالى دفع إليه خمسون ألف درهم فردّها فقيل له: لم رددتها فقال: أكره أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء بخمسين ألفاً، ومن الزهد عند الزاهدين ترك فضول العلوم التي معلوماتها تؤول إلى الدنيا وتدعو إلى الجاه والمنزلة عند أبنائها وفيما لا نفع فيه في الآخرة ولا قربة به عند الله تعالى وقد تشغل عن عبادة الله تعالى وتفرق الهمّ عن اجتماعه بين يدي الله تعالى وتقسي القلب عن ذكر الله تعالى وتحجب عن التفكّر في آلائه وعظمته، وقد أحدثت علوم كثيرة لم تكن تعرف فيما سلف اتخذها الغافلون علماً وجعلها البطالون شغلاً انقطعوا بها عن الله تعالى وحجبوا بها عن مشاهدة علم الحقيقة لا نستطيع ذكرها لكثرة أهلها إلا أن نسأل عن شيء منها أعلم هو أم كلام أم حقّ أو تشبيه أو صدق وحكمة أو زخرف وغرور أم سنّة، هو عتيق أو محدث وتشديق، فحينئذ نخبر بصواب ذلك، ومن أفضل الزهد: الزهد في الرياسة على الناس، وفي المنزلة والجاه عندهم، والزهد في حبّ الثناء والمدح منهم لأن هذه المعاني هي من أكثر أبواب الدنيا عند العلماء، فالزهد فيها هو زهد العلماء، كان الثوري رحمه الله تعالى يقول: الزهد في الرياسة ومدح الخلق أشدّ من الزهد في الدنيار والدرهم قال: لأن الدنيار والدرهم قد يبذلان في طلب ذلك وكان يقول: هذا باب غامض لا يبصره إلا سماسرة العلماء.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: نقل الصخور من الجبال أيسر من إزالة رياسة قد ثبتت في قلب جاهل، وذهب أويس القرني رحمه الله تعالى إلى أن الزهد هو ترك الطلب للمضمون، قال هرم بن حبان: لقيته على شاطئ الفرات يغسل كسراً وخرقاً قد التقطها من المنبوذ وكان ذلك أكله ولباسه قال: فسألته عن الزهد أيّ شيء هو؟ فقال: في أيّ شيء خرجت قلت: أطلب المعاش فقال: إذا وقع الطلب ذهب الزهد وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: لا زهد إلا زهد أويس بلغ به العري حتى قعد في قوصرة، وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: الزهد في النساء أن تختار المرأة الدون أو اليتيمة على المرأة الجميلة والمرأة الشريفة، وذهب إلى هذا مالك بن دينار، وقال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: لا يصحّ الزهد في النساء لأنهن قد حبّبن إلى سيد الزاهدين ووافقه ابن عيينة فقال: ليس في كثرة النساء ذنب لأن أزهد الصحابة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أربع نسوة وبضعة عشر سرية، وكان الجنيد يقول: أحبّ للمريد المبتدي أن لا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغيّر حاله التكسب وطلب الحديث والتزوّج، وقال: أحبّ للصوفيّ أن لا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع لهمّه، وفي الخبر: إنما الزهد أن تكون بما في يد الله سبحانه وتعالى أوثق منك بما في يديك، فهذا مقام التوكّل، وذهب قوم إلى أن الزهد ترك الادخار وكانت الدنيا عندهم هو الجمع.
وقال بعضهم: الدنيا هو ما شغل القلب واهتم به فجعلوا الزهد ترك الاهتمام وطرح النفس تحت تصريف الأحكام، وهذا هو التفويض والرضا، وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني: إن مالك بن دينار قال للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الركوة التي كنت أهديتها لي فإن العدوّ يوسوس إلي أن اللّص قد أخذها، فقال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفيين هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها، فأراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا بجريان الأحكام وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد بأن يصرف عن قلبه الاهتمام.
وقال بعض العلماء: الدنيا هو العمل بالرأي والمعقول، والزهد إنما هو اتباع العلم ولزوم السنّة، وهذه طريقة أهل الحديث، وهذا القول من الظواهر يشبه قول علماء الظاهر، كما روينا عن سفيان قال: قالوا للزهري: ما الزهد؟ قال: ما لا يغلب الحرام صبره ولا يمنع الحلال شكره يعني أين يكون العبد صابراً عن الحرام حتى لا تغلبه شهوة الحرام ويكون شاكراً في الحلال حتى لا يغلبه الحلال فيشغله عن الشكر، وأما الحسن فإنه قال: الزاهد هو الذي إذا رأى أحداً قال: هذا أفضل مني، فذهب إلى أن الزهد هو التواضع، وكان الفضيل يقول: القناعة هو الزهد، وقال أبو سليمان: الورع هو أوّل الزهد، وقال أحمد ابن أبي الحواري قلت: لأبي هشام المغازلي أيّ شيء الزهد قال: قطع الآمال وإعطاء المجهود وخلع الراحة، وكان يوسف بن أسباط يقول: من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز من حلاله فقد أخذ بأصل الزهد، وقال أحمد: قلت لأبي صفوان الرعيني: ما الدنيا التي ذمّها الله تعالى في القرآن وينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ قال: كلّ ما عملت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها، فحدثت به مروان فقال: الفقه ما قال أبو صفوان إنما قال ذلك لأن الدنيا كل ّ شيء إلا الإخلاص، فما وافق العلم فهو مباح وما خلفه فهوى، والهوى حظّ النفس، الإخلاص حظّ الربّ عزّ وجلّ فالمخلصون بيّنة الله عزّ وجلّ من عباده على عدوّه، وهم أهل الآخرة في الدنيا، وكان ابن السماك يقول: الزاهد قد خرجت الأفراح والأحزان من قلبه، فهو لا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يحزن على شيء منها، فإنه لا يبالي على عسر أصبح أم على يسر.
وقال أبو سعيد بن الأعرابي عن أشياخه الصوفية: إنما الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب إذ هي لا شيء ولا يكون في نفسه زاهداً لأنه لم يترك شيئاً إذ كانت لا شيء، وهذا لعمري هو الزهد في الزهد لأنه زهد، ثم لم ينظر إلى زهده فزهده إذ لم يرَ شيئاًً لأنه زهد في لا شيء وهذا يشبه ما نقول: إن حقيقة الزهد هو الزهد في النفس لأنه قد يزهد في الدنيا لنفسه طلباً للعوض فيكون ذلك رغبة على صفة، فإذا زهد في النفس التي يريد لها الأعواض على الزهد فهو حقيقة الزهد وهذا يشبه قول من قال: إن حقيقة الزهد في الفناء هو الزهد في البقاء لأن العبد ربما زهد في الفناء فلم يزهد في البقاء فيكون فيه بقية من الرغبة فإذا زهد في البقاء فهو حقيقة الزهد في الفناء إذ كان الفناء يراد للبقاء.
فصل آخر إن الرغبة في الهوى حقيقة الدنيا وإن كان العبد زاهداً في المال من قبل أنه يعطي الزهد في شيء دون شيء، كما يزهد في الثناء ولا يزهد في المال، ولا يعطي الزهد في الأطعمة وقد يعطى الزهد في المال، ولايعطى الزهد في منصبه لغلبة الهوى، فإذا أعطي الزهد في الهوى كائناً ما فقد أعطي حقيقة الزهد في الدنيا، وهذا هو الزهد في النفس، لأن النفس عين الرغبة والهوى روح النفس، فاعرف هذا، وكان يونس بن ميسرة الجيلاني يقول: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يديك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون ذامّك ومادحك في الحقّ سواء، وقال سلام ابن أبي مطيع رحمهما الله: الزهد على ثلاثة أوجه، واحد أن تخلص العمل لله عزّ وجلّ والقول فلا يراد بشيء منه الدنيا، والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح، والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو تطوّع.
وكان إمامنا في هذا العلم إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: الزهد ثلاثة أصناف: زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة، فالزهد الفرض في الحرام، والزهد الفضل والسلامة الزهد في الشبهات، وأما أيوب السختياني رحمه الله فكان يقول: الزهد أن يقعد أحدكم في منزله فإن كان قعوده لله تعالى رضا وإلا خرج، وإن يخرج فإن كان خروجه لله تعالى رضا وإلا رجع، فإن كان رجوعه لله تعالى رضا وإلا ساح ويخرج درهمه، فإن كان إخراجه لله رضا وإلا حبسه ويحبسه، فإن كان حبسه لله تعالى رضا وإلا رمى به ويتكلم، فإن كان كلامه لله تعالى رضا وإلا سكت، فإن كان سكوته لله تعالى رضا وإلا تكلم فقيل: هذا صعب فقال: هذا الطريق إلى الله عزّ وجلّ وإلا فلا تلعبوا فقد ذهب إلى أن الزهد هو المراقبة، والمراقبة هي الإخلاص، وسئل حاتم الأصم صاحب شقيق البلخي رحمهما الله تعالى عن الزهد فقال: أوّله الثقة وأوسطه الصبر وآخره الإخلاص، فإذا كان الإخلاص عندهم هو آخر الزهد فكيف يصحّ لعبد آخر الزهد قبل أوّله أم كيف يجاوز الإخلاص إلى مقامات المعرفة فقد صار آخر الزهد عندهم أوّل المعرفة وذهبت طائفة إلى أن الزهد في الدنيا فريضة على المؤمنين لأن حقيقة الإخلاص هو الزهد عندهم فأوجبوه من حيث أوجبوا على المؤمنين الإخلاص ومال إلى هذا القول عبد الرحيم بن يحيى الأسود.
وقد روينا معناه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قيل لأحمد: بأيّ شيء ذكر القوم وصاروا أئمة فقال: بالصدق، قالوا: وما الصدق؟ قال: الإخلاص، قيل: وما الإخلاص؟ قال: هو الزهد قيل: وما الزهد يا أبا عبد الله فأطرق ثم قال: سلوا الزهاد سلوا بشر بن الحارث، وقال قوم الزهد في الدنيا طلب الحلال وإنه واجب مفترض في مثل زماننا هذا لاختلاط الأشياء وغلبة الشبهات قالوا: فقد تعين فرض الزهد وهذا مذهب إبراهيم ابن أدهم ووهيب بن الورد وسليمان الخواص وجماعة من أهل الشام، وقد كان سهل يقول: أزهد الناس في الدنيا أصفاهم مطعماً، وقال أقصى مقام في الورع أدنى مقام من الزهد.
وقد روينا عن يوسف بن أسباط ووكيع رحمهما الله قالا: لو زهد عبد في زماننا هذا حتى يكون كأبي ذر وأبي الدرداء ما سميناه زاهداً لأن الزهد عندنا إنما هو في الحلال المحض، ولا نعرف الحلال المحض اليوم، وكذلك كان الحسن البصري رحمه الله إمام الأئمة يقول لا شيء أفضل من رفض الدنيا، وقال الفضيل بن ثور قلت للحسن: يا أبا سعيد رجلان يطلب أحدهما الدنيا بحلالها فأصابها فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه ورجل رفض الدنيا، قال: أحبّهما إليّ الذي رفض الدنيا قلت: يا أبا سعيد هذا طلبها بحلالها فأصابها فوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه قال: أحبّهما إليّ الذي جانب الدنيا وإنما شرف الحسن الذي رفض الدنيا لأن مقام الزهد يجمع التوكل والرضا ألا تسمع إلى الخبر الذي جاء: الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك فهذا هو التوكّل، ثم قال: وأن تكون بثواب المصيبة أفرح منك ولو أنها بقيت لك وهذا هو الرضا، ثم إن المعرفة والمحبة بعد الزهد داخلان عليه فأي مقام أعلى من مقام جمع هذه الأربعة وهي غاية الطالبين، ولعمري أنه هكذا لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث فيه شدة قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوّه خلقها فتشرف على الخلائق فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله تعالى من معرفة هذه، فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي أي ربّ أتباعي وأشياعي فيقول الله: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها.
وقد روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً أشد من هذا حدثنا عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار قالوا: يا رسول الله مصلّين قال: نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنّة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، وكذلك كان الحرث بن أسد المحاسبي رحمه الله يقول: إنما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب وأن لا يكون لشيء عاجل في القلب وزن، فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت في القلب فهو الزهد، فأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فإنه كان يقول ليس الزاهد من لا يملك شيئاً إنما الزاهد من لا يملكه شيء وقال عالم مثله في معناه: الزاهد من لا يتملك الأشياء ولم يسكن إليها، وكان يقول: الزاهد قوته ما وجد وثوبه ما ستر وبيته ما أواه وحاله وقته.
وقال بعض العارفين: الزهد إنما هو ترك التدبير والاختيار والرضا والتسليم لاختياره شدة كان أو رخاء، وهذا طريق الخواص والثوري وذي النون رحمهم الله تعالى، وقال أبو يزيد رحمه الله مرة: إنما الزاهد من لا يملك شيئاً ولا يملكه شيء، وقال: حقيقة الزهد لا يكون إلا عند ظهور القدرة والعاجز لا يصحّ زهده هو أن يعطيه كن ويطلبه على الاسم ويقدره على الأشياء بإظهار الكون فيزهد في ذلك حياءً من الله تعالى ويتركه حبّاً له، وكان يستعيذ بالله من أربعة وعشرين مقاماً من إظهار القدرة وقال لأبي موسى عبد الرحيم في أي شيء تتكلم؟ قلت: في الزهد قال: في أيّ شيء قلت: في الدنيا قال: فنفض يده وقال: ظننت أنه يتكلم في الزهد في شيء الدنيا لا شيء أيش تزهد فيه، وذهب إلى هذا المعنى سهل وغيره، وقال سبعة عشر مقاماً في المعرفة أدناها المشي على الماء وفي الهواء وظهور كنوز الأرض وهذا كله من زخرف الدنيا.
وقد حكي لنا معنى هذا عن الجنيد قال: اجتمع أربعة من الأبدال في جامع المنصور ليلة العيد فلما أسحروا قال أحدهم: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد في بيت المقدس، وقال الآخر: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد بطرسوس، وقال الثالث: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد بمكة، وسكت الرابع وكان أعرفهم فقيل له: أنت أيّ شيء نويت فقال: أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات لا أصلي إلا في هذا المسجد الذي بتّ فيه فقالوا: أنت أعلمنا فقعدوا عنده فصار عند هؤلاء كما ذكرناه آنفاً أن هذه الآيات هي من الشهوات إذ ليست حاجات مقامات والشهوة من الدنيا لأنها من الهوى وأيضاً ففيها تدبير واختيار، وعند الزهاد العارفين والمحبين أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون إذاً ابتلاء كل عبد على قدر مرتبته وحاله فيلزمه الزهد فيه ويقال: هي في المقام السابع عشر من المعرفة فمن سلك به الطريق رآها فيه وفوقها نيف وسبعون مقاماً أفضل من ذلك.
وقد سئل الجنيد عن الزهد فقال معنيان: ظاهر وباطن، فالظاهر بغض ما في الأيدي من الأملاك وترك طلب المفقود، والباطن زوال الرغبة عن القلب ووجود العزوف والانصراف عن ذكر ذلك، فإذا تحقق بذلك رزقه الله تعالى الإشراف على الآخرة والنظر إليها بقلبه، فحينئذ يحد في العلم بتقصير الأمل وتقريب الأجل لأن الأسباب عن قلبه منقطعة والقلب منفرد الآخرة، وحقيقة الزهد قد خلصت إلى قلبه فامتلأ من الذكر الخالص لربّه سبحانه وتعالى، فالزهد عن حقيقة الإيمان والمشاهدة للآخرة تكون بعد الزهد واستواء الأشياء، فيكون عدمها كوجودها بعد المشاهدة لاستواء القلب ومعه يستوي المدح والذّم لسقوط النفس وذهاب رؤية الخلق فعندها خلص الإخلاص إلى قلبه لصفاء الزهد وثبت الزهد لسقوط النفس دليل ذلك: الخبر الذي رويناه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: هل استويت؟ قال: وكيف أستوي؟ قال: يستوي عندك المدح والذم؟ وقول حارثة لما سأله عن حقيقة الإيمان: عزفت نفسي عن الدنيا فابتدأ بالزهد ثم ذكر الاستواء لحجرها وذهبها ثم ذكر المشاهدة بعد ذلك الحديث، وهذه كلها مقامات في الزهد وكل من جعل شيئاً الدنيا مبلغ علمه وعلوّ مشاهدته جعل الزهد ضده.
وقد نوّع أهل المعرفة الإيمان في القلب على مقامين فجعل لهما زهدين فقال: إذا تعلّق الإيمان بطاهر القلب أحبّ العبد الدنيا وأحبّ الآخرة وعمل لهما، فإذا بطن الإيمان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها ولم يعمل لها، وقد كان أبو سليمان يقول: من شغل بنفسه شغل عن الناس؛ وهذا مقام العاملين، ومن شغل بربه سبحانه وتعالى شغل عن نفسه؛ وهذا مقام العارفين، ولهذين المقامين دليل من السنّة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أيّ الناس خير؟ فقال: من يشنأ الدنيا ويحبّ الآخرة فأوقع الشنآن للدنيا لوقوع ضدّه من حبّ الآخرة والمقام الأعلى دليله من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله تعالى أمر آخرته ودنياه والهم الواحد بوجد واحد لربّ واحد هو وصف عبد متوحد لواحد مقاله إلى واحد، وقد وهب له خلقاً من أخلاقه فهو الأحد بوحدانية صفته، وعبد متوحدّ بوجده بين خلقه، فهو منفرد الهمّ مجتمع القلب وانفراد الهمّ يكون بعد محو الهوى ومحوه بعد امتحان القلب للتقوى، واجتماع القلب يكون مع طيب النفس وطمأنينتها بالإيمان أو فلاحها بالتزكية والرضا، ما قال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طيب النفس من النعيم، وقال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكّاها) الشمس: 9 وقال تعالى: (رَاضِيَّةً مَرْضِيَّة) الفجر: 28 فيكون متوحّداً بالروح مخلقة بأخلاق الإيمان مواطئة للقلب بمشاهدة اليقين، وقال وهب بن منبه: وجدت فيما أنزل الله تعالى على موسى عليه السلام: من أحبّ الدنيا أبغضه الله تعالى، ومن أبغضها أحبه الله تعالى، ومن أكرم الدنيا أهانه الله تعالى، ومن أهانها أكرمه الله تعالى، وأما علماء الظاهر فقالوا: الزهد في الدنيا هو موافقة العلم والقيام بأحكام الشرع وأخذ الشيء من وجهه ووضعه في حقّه، وما خالف العلم فهو هوى كلّه فذكروا فرض الزهد وظاهره ولم يعرفوا دقائقه وبواطنه.
وقد روينا عن سفيان بن عيينة والثوري معنى هذا أنهما سئلا: أيكون الرجل زاهدًا وله مال؟ قالا: نعم إذا كان إذا ابتلى فصبر، وإذا أنعم عليه شكر، قال ابن أبي الحواري فقلت له: يا أبا محمد يعني ابن عيينة قد أنعم عليه فشكر وابتلى فصبر وحبس النعمة كيف يكون زاهدًا؟ فضربني بيده وقال: اسكت، من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلوى عن الصبر فذلك الزاهد، ووافقهما الزهري فقال كذلك، وقد فصل ذلك أبو سليمان فقال ابن أبي الحواري: قلت له: أكان داود الطائي رحمه الله تعالى زاهداً؟ قال: نعم، قلت: بلغني أنه ورث من أبيه عشرين دينارًا فأنفقها في عشرين سنة فكيف يكون زاهداً وهو يمسك الدنانير؟ فقال: أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد ولعمري أنّا روينا عن رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعماً بالمال الصالح للمرء الصالح والمال الصالح هو الحلال والمرء الصالح المنفق ماله بالليل والنهار سرًّا وعلانية في سبيل اللّّه ابتغاء مرضاته كما وصفه الله تعالى ومدحه.
وقد روينا عن رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحبّ ومن لا يحبّ ولا يعطي الدين إلا من يحبّ والذي يحبّه الله تعالى ممن أعطاه الدنيا لا يخالف حبيبه إلى هواه ولا يؤثر نفسه على محبة مولاه تبارك وتعالى إذ قد تولاه فيما أعطاه.
وقد روينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر والطاعم الشاكر هو الذي يستعين بطعمته على خدمة مولاه ويعبده شكراً لما أولاه، وقد قالوا في الزهد وصفان جامعان لأحوال القلوب، قال مضاء بن عيسى: قلت للسباع الموصلي: يا أبا محمد إلى أيّ شيء أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس باللّّه تعالى، وقال عثمان بن عمارة: كان يقال: الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد والزهد يبلغ به حبّ الله تعالى؛ فهذان الحالان غاية الطالبين الحبّ للجليل والأنس باللطيف، فمن لم يتحقق بالزهد لم يبلغ مقام الحبّ ولم يدرك حال الأنس ثم إن سرائر الغيوب في مقام الحبّ والخلّة، وفي حال الأنس والقربة وفّقنا الله وإياكم لما يحبّ وبلغنا ما نؤمل بفضله ورحمته ولا حول ولاقوّة إلا باللّّه العليّ العظيم وهذا آخر كتاب الزهد.
تم الجزء الأوّل من قوت القلوب ويليه الجزء الثاني أوّله
شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين.
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين
وهو المقام السابع من مقامات اليقين
التوكّل من أعلى مقامات اليقين وأشرف أحوال المقرّبين قال الله الحق المبين: (إن الله يحبّ المتوكلين) آل عمران 159فجعل المتوكل حبيبه وألقى عليه محبّته وقال الله عزّ وجلّ: (وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) إبراهيم 12يرفع المتوكلين إليه وجعل مزيدهم منه، وقال جلت قدرته: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الطلاق: 3 أي كافيه مما سواه فمن كان الله تعالى كافيه فهو شافيه ومعافيه ولا يسأل عمّا هو فيه، فقد صار المتوكل على الله تعالى من عباد الرحمن الذين أضافهم إلى وصف الرحمة، ومن عباد التخصيص الذين ضمن لهم الكفاية، وهم الذين وصفهم في الكتاب بقوله سبحانه: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) الفرقان: 63إلى آخر أوصافهم، وهم الذين كفاهم في هذه الدار المهمّات ووقاهم بتفويضهم إليه السيِّئات بقوله تعالى: (ألَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ) الزمر: 36 وقوله تعالى: (وَأُفَوِّضُ أَمْري إلَى الله إنَّ الله بَصيرٌ بِالْعِبَادِ) (فَوَقاهُ الله سيِّئاتِ مَا مَكَرُوا) غافر: 44 - 45 وليس هؤلاء من عباد العدد فقط الذين قال الله عزّ وجلّ: (إنْ كُلُّ مَنْ في السَّمَواتِ وَالأرْضِ إلاّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً) (لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَداً) مريم 93 - 94.
وقال بعض الصحابة وغيره من التابعين: التوكل نظام التوحيد وجماع الأمر، وحدثونا عن بعض السلف قال: رأيت بعض العباد من أهل البصرة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة، قلت: فأي الأعمال وجدت هناك أفضل؟ قال: التوكّل وقصر الأمل فعليك بهما وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان والإخلاص والتوكل والاستسلام للربّ عزّ وجلّ، وكان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: ليس في المقامات أعزّ مِن التوكّل وقد ذهب الأنبياء بحقيقته وبقي منه صبابة انتشقها الصدّيقون والشهداء فمن تعلّق بشيء منه فهو صديق أو شهيد.
وقال بعض العارفين وهو أبو سليمان الداراني: في كلّ المقامات لي قدم إلاّ هذا التوكّل المبارك فما لي منه إلا مشام الريح، وقال لقمان في وصيته لابنه: ومن الإيمان بالله عزّ وجلّ التوكّل على الله، فإن التوكل على الله يحبّب العبد، وإن التفويض إلى الله من هدي الله، وبهدي الله يوافق العبد رضوان ا، وبموافقة رضوان الله يستوجب العبد كرامة الله، وقال لقمان أيضاً: ومن يتوكّل على الله، ويسلّم لقضاء الله، ويفوّض إلى الله، ويرضى بقدر الله، فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره.
وقال بعض علماء الأبدال، وهو أبو محمد سهل: العلم كلّه باب من التعبّد، والتعبّد كلّه باب من الورع، والورع كلّه باب من الزهد، والزهد كلّه باب من التوكّل، قال: فليس للتوكلّ حدّ ولا غاية تنتهي إليه، وقال أيضاً في قول الله عزّ وجلّ: (لِيَبْلُوَكُمْ أيٍُّكُمْ أحْسَنُ عَمَلاً) هود: 7، قال أصدق توكلاً، وقال: التقوى واليقين مثل كفّتي الميزان والتوكل لسانه، به تعرف الزيادة والنقصان، وسئل عن قول الله عزّ وجلّ: (فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن: 16 قال: بإظهار الفقر والفاقة إليه، وسئل عن قوله تعالى: (اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ) آل عمران102 فقال: اعبدوه بالتوكّل، وقال أبو يعقوب السوسي: لا تطعنوا على أهل التوكّل فإنهم خاصّة الله الذين خصّوا بالخصوصية فسكنوا إلى الله، واكتفوا به، واستراحوا من هموم الدنيا والآخرة، وقال: من طعن في التوكّل، فقد طعن في الإيمان لأنه مقرون به، ومن أحبّ أهل التوكّل فقد أحبّ الله تعالى، فأوّل التوكّل المعرفة بالوكيل وأنه عزيز حكيم، يعطي لعزّه، ويمنع لحكمه، فيعتزّ العبد بعزّه ويرضى بحكمه، وكذلك أخبر عن نفسه ونبّه المتوكّلين عليه فقال سبحانه: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ) الأنفال: 49 عزّ من أعزّ بعطيته ونظر لمن منعه بحكمته، فإذا شهد العبد الذليل الملك الجليل قائماً بالقسط والتدبير والتقدير، عنده خزائن كلّ شيء، وكلّ شيء عنده بمقدار لاينزله إلا بقدر معلوم، وشهد الوكيل قابضاً على نواصي المماليك له خزائن السموات من الأحكام والأقدار الغائبات، وله خزائن الأرض من الأيدي والقلوب والأسباب المشاهدات، فخزائن السموات ماقسمه من الرزق، وخزائن الأرض ما جعله على أيدي الخلق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، ولكن المنافقين لا يفقهون فأيقن العبد أن في يده ملكوت كلّ شيء وأنه يملك السمع والأبصار ويقلب القلوب والأيدي تقليب الليل والنهار، وأنه حسن التدبير والأحكام للموقنين، وأنه أحكم الحاكمين وخير الرازقين، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، ثم استوى على العرش يدبّر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، عندها نظر العبد الذليل إلى سيده العزيز، فقوي بنظره إليه، وعزّ بقوّته به، واستغنى بقربه منه، وشرّف بحضوره عنده.
وكذلك جاء في الخبر: كفى باليقين غنى، حينئذ نظر إليه في كل شيء، ووثق به، واعتمد عليه دون كل شيء، وقنع منه بأدنى شيء، وصبر عليه، ورضي عنه، إذ لا بدّ له منه، فثمّ لا يطمع في سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يشهد في العطاء إلا يده، ولا يرى في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته، هناك حقّت عبادته وخلص توحيده فعرف الخلق من معرفة خالقه، وطلب الرزق عند معبوده ورازقه، وقام بشهادة ما قال تعالى: (إِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ) الأعراف: 194قال: (إِنَّ الَّذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دَونِ الله لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَاً فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ) العنكبوت: 17. فعندها لم يحمد خلقاً ولم يذمّه ولم يمدحه لأجل أنه منعه أو أنه أعطاه إن كان الله هو الأوّل المعطي، ولم يشكره إلا لأن مولاه مدحه وأمره بالشكر له تخلقاً بأخلاقه، واتّباعاً لسنّة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن ذمه أو مقته فلأجل مخالفته لمولاه بموافقته هواه، لأنه تعالى قد مدح المنفقين وذمّ الباخلين، والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد مفرد لا ينبغي إلا وهو الاعتراف بأن النعمة من الله عزّ وجلّ، وحسن المعاملة بها لوجه الله لاشريك له فيه، ولذلك قال: الحمد لله ربّ العالمين، أي الحمد كلّه لا يكون ولا ينبغي إلا، لأنه ربّ العالمين، وفي الخبر: الحمد رداء الرحمن عزّ وجلّ، والشكر إظهار الثناء، وأسرار الدعاء للأواسط، فهذا مشترك يدخل فيه الوالدان، وهو أيضاً مخصوص لمن هو أهل أن يشكر من الناس، حدثونا عن يوسف بن أسباط قال: قال لي الثوري: لا تشكر إلا من عرف موضع الشكر، قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أوليتك معروفاً، فكنتُ به أسرّ منك، وكنتُ منك أشد استحياء فاشكر وإلا فلا، وسأل إبراهيم رجلاً من أصحابه درهمين فلم يكن معه، فأخرج فتى في مجلسه كيساً فيه مائتا درهم، فعرضه عليه فلم يقبله وقال: أو كل مَنْ بذل لنا شيئاً قبلناه منه؟ لا نقبل إلا ممن نرى نعمة الله عليه فيما أعطى أعظم من نعمته علينا فيما نأخذ، وحدثونا عن الحسن في قصة طويلة أن رجلاً بذل له جملة من المال فردّه، فلما انصرف قال له هاشم الأوقص: عجبت منك يا أبا سعيد رددت على الرجل كرامته، فانصرف حزيناً، وأنت تأخذ من مالك بن دينار ومحمد بن واسع الشيء بعد الشيء، فقال له الحسن: ويحك إن مالكاً وابن واسع ينظران إلى الله فيما نأخذ منهما، فعلينا أن نقبل، وإن هذا المسكين ينظر إلينا فيما يعطي، فرددنا عليه صلته، وعندها لاتذم أحداً ولا تبغضه لأجل أنه كان سبباً لمنعه إذ كان الله هو المانع الأوّل، وإذ له في المنع من الحكمة مثل ما له من العطاء من النعمة، ولكن نذمّه وننقصه ونبغضه إن كان استوجب ذلك من مولاه، فيكون موافقاً له، والله تعالى يشهد يده في العطاء، ويمدح المنفقين نهاية في كرمه، ويشهد في المنع والمكروه مشيئته، ويذمّ الباخلين والعاصين قدرة من حكمته وحكماً من تقديره لإظهار الأحكام وتفصيل الحلال والحرام وعود الثواب والعقاب على الأنام، فقد أظهر الأمر واستأثر بسرّ القدر فعمل المؤمن بما أمر وسلم له ما استأثر.
وروى بعض العلماء عن الله تعالى: لو أن ابن آدم لم يخف غيري ماأخفته من غيري، ولو أن ابن آدم لم يرج غيري ما وكلته إلى غيري، وروى أعظم من هذا قال: وضع العبد في قبره مثل له كل شيء كان يخافه من دون الله عزّ وجلّ يفزعه في قبره إلى يوم القيامة، وقال الفضيل بن عياض: من خاف الله خاف منه كل شيء، ويقال: إن الخوف من المخلوقات عقوبة نقصان الخوف من الخالق، وإن ذلك من قلة الفقه عن الله تعالى وقد قال الله أحسن القائلين في معناه: (لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً في صُدُورِهِمْ مِنَ الله ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ) الحشر: 13 فكان العبد إذا تمّ خوفه من الله تعالى، أزال ذلك الخوف خوف المخلوقين عن قلبه، وحوّل ذلك في قلوب المخلوقات فصارت هي تخافه إن لم يخفها هو، كما إذا كملت مشاهدة العبد وقام بشهادته وغيّبت تلك المشاهدة وجود الكون مع الله عزّ وجلّ فلم يرها، وقام له القيوم بنصيبه من الملك لما تفرّغ قلبه لمعاينة الملك، وقال سنيد عن يحيى بن أبي كثير: مكتوب في التوراة ملعون من ثقته مخلوق مثله، وقال سنيد: يعني أن يقول: لولا فلان هلكت، ولولا كذا ما كان كذا، ويقال: إن قول العبد لولا كذا ماكان كذا من الشرك، وقال في الخبر: إياكم ولو فإنه يفتح عمل الشيطان.
وقال بعض العلماء: سوف جند من جنود إبليس، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَى الْبِّر إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) العنكبوت: 65 قالوا: كان الملاح فارهاً، ومثله في قوله تعالى: (ومَا يُؤْمِنُ أكْثَرُهُمْ بِالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) يوسف106، قيل قالوا: لولا نباح الكلاب وزقاء الديكة لأخذنا السرق، وروينا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من اعتزّ بالعبيد أذلّه الله، وقد جاء في الخبر: لو توكّلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً، ولزالت بدعائكم الجبال، وقد كان عيسى عليه السلام يقول: انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر والله يرزقها يوماً بيوم، فإن قلتم نحن أكبر بطوناً من الطير فانظروا إلى الأنعام كيف قيّض الله لها هذا الخلق، ويقال: لا يدّخر من الدواب إلا ثلاثة: النملة والفأرة وابن آدم، وقال أبو يعقوب السوسي: المتوكّلون على الله تجري أرزاقهم بعلم الله واختياره على يد خصوص عباده بلا شغل ولا تعب، وغيرهم مكدودون مشغولون، وقال أيضاً: المتوكّل إذا رأى السبب أو ذم أو مدح فهو مّدعٍِ لا يصحّ له التوكّل، وأوّل التوكّل ترك الاختيار والمتوكّل على صحة قد رفع أذاه عن الخلق، لا يشكو ما به إليهم، ولا يذمّ أحداً منهم لأنه يرى المنع والعطاء من واحد، فقد شغله عمّا سواه، وقيل لسهل: ما أدنى التوكّل؟ قال: ترك الأماني، وأوسطه ترك الاختيار، قيل: فما أعلاه؟ قال: لا يعرفه إلا من توسّط التوكّل وترك الاختيار، أعطى فذكر كلاماً طويلاً.
وقال بعض هذه الطائفة: العبيد كلّهم يأكلون أرزاقهم من المولى، ثم يفترقون في المشاهدات، فمنهم من يأكل رزقه بذلّ، ومنهم من يأكل رزقه بامتهان، ومنهم من يأكل رزقه بانتظار، ومنهم من يأكل رزقه بعزّ لا مهنة ولا انتظار ولا ذلّة، فأما الذي يأكلون أرزاقهم بذلّ، فالسؤال يشهدون أيد الخلق فيذلّون لهم، والذين يأكلون بامتهان، فالصناع يأكل أحدهم رزقه بمهنة وكره، والذين يأكلون أرزاقهم بانتظار، فالتجار ينتظر أحدهم نفاق سلعته فهو متعوب القلب معذّب بانتظاره، والذين يأكلون أرزاقهم بعزّ من غير مهنة ولا انتظار ولا ذل فالصوفية، يشهدون العزيز فيأخذون قسمهم من يده بعزة، فأمّا الذين يأكلون من أرباب السلاطين فباعوا أرواحهم فتلك قسمة خاسرة وقعوا في الذلّ الواضح.
وسئل بعض العلماء عن معنى الخبر المأثور: الخلق عيال الله فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله فقال: هذا مخصوص وعيال الله خاصته، قيل: كيف؟ قال: لأن الناس أربعة أقسام: تجار وتجارة وصناع وزراعة، فمن لم يكن منهم فهو من عيال الله، فأحبّ الخلق إلى الله أنفعهم لهؤلاء، وهذا كما قال: لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الحقوق وفرض الزكاة في الأموال لهؤلاء لأنه جعل من عياله من لا تجارة له ولا صنعة فجعل معاشهم على التجّار والصنّاع، ألا ترى أن الزكاة لا تجوز على تاجر ولا صانع لقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لقويّ مكتسب، فأقام الاكتساب مقام الغنيّ.
وقال الله تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقينَ) الحجر20 فكان من تدبّر الخطاب أن من ليسوا له برازقين هو من ليس له فيها معيشة في الأرض، وقال عامر بن عبد الله: قرأت ثلاث آيات من كتاب الله عزّ وجلّ استعنت بهنّ على ما أنا فيه فاستعنت قوله تعالى: (وَإنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إلاَّ هو وَإنْ يُرِدْكَ بَخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ) يونس: 107 فقلت: إن أراد أن يضرّني لم يقدر أحد أن ينفعني، وإن أعطاني لم يقدر أحد أن يمنعني، وقوله: (فَاذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ) البقرة: 152 فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه، وقوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابِّةٍ في الأرْضِ إلاّ عَلَى الله رِزْقُهَا) هود: 6، فوالله ما اهتممت برزقي منذ قرأتها فاسترحت، وقد كان سهل بن عبد الله يقول: المتوكّل إذا رأى السبب فهو مدّع، وقال: ليس مع الإيمان أسباب، إنما الأسباب في الإسلام؛ معناه ليس في حقيقة الإيمان رؤية الأسباب والسكون إليها، إنما رؤيتها والطمع في الخلق يوجد في مقام الإسلام.
ومن ذلك ما قال لقمان لابنه: للإيمان أربعة أركان: لا يصلح إلا بهنّ كما لا يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: التوكّل على الله، والتسليم لقضائه، والتفويض إلى الله، والرضا بقدر الله، فحال المتوكّل سكون القلب عن الاستشراف إلى العبيد والتطلّع وقطع الهمّ عن الفكرة فيما بأيديهم من التطمّع، عاكف القلب علّي المقلب المدبر، مشغول الفكر بقدرة المصرف المقدر، لا يحمله عدم الأسباب على ماحظرّه العلم عليه وذمّه، ولا يمنعه أن يقول الحق وأن يعمل به أو يوالي في الله ويعادي فيه جريان الأسباب على أيدي الخلق، فيترك الحق حياءً منهم أو طمعاً فيهم أو خشيةَ قطع المنافع المعتادة، ولا تدخله نوازل الحاجات وطوارق الفاقات في الانحطاط في أهواء الناس والميل إلى الباطل أو الصمت عن حقّ لزمه، أو يوالي في الله عدوَّاً أو يعادي ولياً، ليرب بذلك حاله عندهم، أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه بالكفّ عنهم، ولا يرب الصنعة التي قد عرف بها لنظره إلى الصانع، ولا يتصنّع لمصنوع دخله لعلمه بسبق الصنع لدوام مشاهدته، ولا يسكن إلى عادة من خلق، ولا يثق بمعتاد من مخلوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضرّه من واحد، فهذه المعاني من فرض التوكّل، فإن وجدت في عبد خرج بها عن حدّ التوكّل دون فضائله وتدخّله في ضعف اليقين، وقد كان الأقوياء إذا دخل عليهم شيء من هذه الأهواء المفسدة لتوكّلهم، قطعوا تلك الاسباب، وحسموا أصولها واعتقدوا تركها، وعملوا في مفارقة الأمصار والتغرّب عن الأوطان وترك الآلاف والإيلاف، فأخرجوا ذلك من حيث دخل عليهم، ووضعوا عليه دواءه وضده من حيث تطرق إليهم، حتى ربما فارقوا ظاهر العلم وخالفوا علم أهل الظاهر إلى علوم الباطن وحكم مشاهدتهم وقيامهم بحقّ أحوالهم، إذ ليس أهل الظاهر حجة عليهم في شيء إلا وهم عليه حجة في مثله، لأن الإيمان ظاهر وباطن، والعلم محكم ومتشابه، ولأن أهل الحق أقرب إلى التوفيق وأوفق لإصابة الحقيقة، كل ذلك رعاية لصحة توكّلهم ووفاء بحسن عهدهم وعملاً بأحكام حالهم لئلا تسكن قلوبهم لغير الله، ولا تقف هممهم مع سوى الله، ولا تطمئن نفوسهم إلى غيره، ولا يتخذوا سكناً سواه، ولا يسكنوا إلى أهواء النفوس وينخدعوا لسكونها عن سكون القلب، فيسيء ذلك يقينهم ويوهن إيمانهم الذي هو الأصل، ويستأسر قلوبهم التي هي المكان للكشف والشهادة، فيخسروا رأس المال فتفوتهم حقيقة الحال، فماذا يرتجون وبأي شيء يقومون؟ وهذا لا يفطن له إلا العاقلون ولا تشهده العيون.
وقد قال بعض المقرّبين في حقيقة التوكّل لما سئل عنه فقال: هو الفرار من التوكّل يعني ترك السكون إلى المقام من التوكّل؛ أي يتوكّل ولا ينظر إلى توكّلهم إنه لأجله يكفى أو يعافى أو يوقى، فجعل نظره إلى توكله علّة في توكّله يلزمه الفرار منها حتى يدوم نظره إلى الوكيل وحده بلا خلل، ويقوم له بشهادة منه بلا ملل، فلا يكون بينه وبين الوكيل شيء ينظر إليه، أو يعوّل عليه، أو يدلّ به، حتى التوكّل أيضاً الذي هو طريقه.
وكذلك قال قبله بعض العارفين في معنى قوله عزّ وجلّ: (أَمّنْ يُجِيبُ المُضْطَّرَ إذا دَعاهُ) النمل: 26، فقال: المضطّر الذي يقف بين يدي مولاه فيرفع إليه يديه بالمسألة فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق بها شيئاً، فيقول: هب لي مولاي بلا شيء فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس، ويصير حاله مع كل الأعمال الإفلاس، فهذا هو المضطر، فهؤلاء القوم من الذين وصفهم الله عزّ وجلّ بالتقوى والمخافة، وجعلهم أهلاً للدعوة والنذارة، وأخبر أنهم لا يرون بينه وبينهم سبباً يليهم ولا شفاعة فقال تعالى يأمر رسوله بإنذارهم بكلامه فجعلهم وجهة لخلقه ومكاناً لكلمه، كما جعل رسوله وجهة لهم ومكاناً لتكليمهم، فقال تعالى: (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذينَ يَخَاْفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) الانعام: 51 ثم قال تعالى في وصف أمثالنا من أهل اللعب واللهو والغرّة والسهوة متهددّاً لنا متوعداً: (وَذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحيَاة الدُّنْيا) الانعام: 70 وقيل لبعض علمائنا: ماالتوكل؟ قال: التبرّي من الحول والقوّة؛ والحول أشدّ من القوّة، يعني بالحول الحركة، والقوّة الثبات على الحركة، وهو أوّل الفعل، يعني بهذا لا ينظر إلى حركتك مع المحرّك إذ هو الأول ولا إلى ثباتك أيضاً بعد الحركة في تثبيته إذ هو المثبت الآخر فتكون الأولية والآخرية حقيقة شهادتك له به أنه الأوّل الآخر بعين اليقين؛ أي فعندها صحّ توكّلك بشهادة الوكيل، وقال مرة: التوكّل ترك التدبير، وأصل كل تدبير من الرغبة، وأصل كل رغبة من طول الأمل، وطول الأمل من حبّ البقاء؛ وهذا هو الشرك يعني أنك شاركت الربوبية في وصف البقاء، وقال: الله سبحانه خلق الخلق ولم يحجبهم عن نفسه، وإنما جعل حجابهم تدبيرهم، وقد كثر قوله رحمه الله في ترك التدبير، وينبغي أن يعرف مامعناه، ليس يعني بترك التدبير ترك التّصرّف فيما وجّه العبد فيه وأبيح له، كيف وهو يقول: من طعن على التكسّب فقد طعن على السنّة، ومن طعن في ترك التكسّب فقد طعن على التوحيد، إنما يعني بترك التدبير ترك الأماني، وقوله: لمَ كان كذا؟ إذا وقع وِلِمَ لا يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما لايقع، لأن ذلك اعتراض وجهل بسبق العلم، وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة، وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان الحكم بها، ويعني ترك التدبير فيما بقي وما يأتي بعد أي لا تشتغل بالفكر فيه بعقلك وعلمك فيقطعك عن حالك في الوقت الذي هو ألزم لك وأوجب عليك حتى قطعك فيما يأتي من الأحكام.
والتصريف في ترك التدبير والتقدير لها بالزيادة والنقصان، أو نقلها من وقت إلى غيره أو من عبد أي آخر، بالتقديم والتأخير، تكون في ذلك كما كنت فيما قد مضى، ألا ترى أن الإنسان لا يدبّر ما قد مضى؟ قال: فينبغي أن يكون فيما يستقبل تاركاً للتدبير له، تاركاً للأماني فيه بمعاني ما ذكرناه، كتركه إياه فيما مضى، فيستوي عنده الحالان، لأن الله أحكم الحاكمين، ولأن العبد مسلّم للأحكام والأفعال، راضٍ عن مولاه في الأقدار، مع جهله بعواقب المآل، وترك التدبير بهذه المعاني هو اليقين، واليقين هو مكان المعرفة، إذ جعل الله تعالى قلب الموقن مكاناً يمكن فيه على قدر المكان ما يليق به، وكان يقول: يا مسكين كان ولم تكن ويكون ولا تكون، فلما كنت اليوم قلت أنا وأنا كن فيما أنت الآن كما لم تكن، فإنه هو اليوم كما كان، وكان يقول أيضاً: الزهد إنما هو ترك التدبير، فهذا يعني به ترك الأسباب التي توجب التدبير، وإخراج السبب الذي يجب تدبيره لا أنه يكون مسبباً متيقناً للأسباب وهو ترك تدبيرها، لأن التدبير في هذا الموضع إنما هو التمييز والقيام بالأحكام ووضع الأشياء مواضعها، فكيف لا يكون العبد كذلك مع وجود الأشياء وهو عاقل ممّيز متعبّد بالعلم مطالب بالأحكام؟ وإنما يقول: اترك الأشياء المدبّرة وازهد في الأسباب المميّزة حتى يسقط عنك التدبير والتقدير، فيكون بتركها تاركاً للتدبير بسقوط أحكامها عنك، واستراحتك من القيام بها، والنظر فيها؛ فهذا هو تفصيل جملة قوله في ترك التدبير، وهذا هو حال المتوكّلين، والمتوكّل لا يهتمّ بما قد كفي كما لا يهتمّ الصحيح بالدواء إذا عوفي، ولكن قد يحتمي قبل النزال كما يحتمي المعافى قبل ورود العلل.
قال الله سبحانه: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى الله رِزْقُِهَا) هود: 6 (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ) العنكبوت: 60 فالمتوكل قد علم بيقينه، إذ كل ما يناله من العطاء من ذرّة فما فوقها، أن ذلك رزقه من خالقه، وأن رزقه هو له وأن ما له واصل إليه لامحالة على أيّ حال كان، وإن ما له لا يكون لغيره أبداً، وكذلك ما لغيره من القسم والعطاء لا يكون لهذا أبداً، فقد نظر إلى قسمه ونصيبه من مولاه بعين يقينه الذي به تولاّه من إحدى ثلاث مشاهدات، وإن دنت مشاهدته نظر إلى قسمه من العطاء في الصحيفة التي كتبت له عند تصوير خلقه، فكتب فيها رزقه وأجله وأثره، وشقيّ أو سعيد، فكما لايقدر أحد من الخلق أن يجعله سعيداً إن كان قسمه شقيّاً، فلا يقدر أحد أن يجعله شقيّاً إن كان قسمه سعيداً، كذلك لا يقدر أحد أن يمنعه ما أعطاه مولاه من القسم، فيجعله محروماً، ولا يعطيه ما منعه من الحكم فيجعله مرزوقاً، لأن ذلك قد كتب كتباً واحداً وجعل مجعلاً سواء، فإن ارتفعت مشاهدته نظر إلى هذا في اللوح المحفوظ مفروغاً له منه، وهو أم الكتاب الذي استنسخ منه هذه الصحيفة، فكان يقينه يكتب رزقه في اللوح، وأنه لا يزاد فيه بحول ولا حيلة ولا ينقص منه لعجز ولا سكينة، كيقينه بما كتب فيه من أنه من أهل الجنة فهو داخلها لامحالة، وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب اسمه في اللوح وجعل له فيها أثر كقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِْثُهَا عِبَاديَ الصَّالِحُونَ) الأنبياء: 105 فقد كتبت الآثار والأرزاق من كل شيء كتباً واحداً في ثلاث مواضع، توكيداً للعلم وتسكيناً للقلب في القسم، كتب ذلك في الذّكر الأول وهو اللوح المحفوظ ثم في الزبر الأولى وهي الصحف، ثم أنزل ذلك في كتابنا هذا الذي به عرفنا ما سلف من ذلك، وإن علت مشاهدة كل عبد عن مقامه ومن معبوده ومن مكانه في دنوّه وعلوّه يشهد هذا الذي ذكرناه معلوماً في علم الله تعالى قبل خلق اللوح، فسكن قلبه واطمأن إلى علم الله سبحانه وتعالى وما سبق له منه، ولهذا جاء في الأثر أن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون ثواب المصيبة أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك، أي فيقلّ حرصك لنفاذ شهادتك ويذهب في الخلق طمعك؛ فهذا هو الرضا والزهد، فقد جمع التوكّل المقامين معاً، فما في يد الله سبحانه وتعالى هو رزقك الواصل إليك، لا شكّ فيه على أي حال، وهو الذي لك عند الله، وهو معلوم علم الله تعالى الذي لا ينقلب، وذلك أحد ثلاثة أشياء: ماأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فهذا هو الذي لك في الدنيا والآخرة.
ولذلك قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقول ابن آدم مالي تعجّب من جهل ابن آدم وغفلته، ثم قال: إنما لك من مالك، فذكر هذه الثلاث واشترط مع كل واحدة آخر غايتها فقال: ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فاشترط الإفناء والإبلاء والإمضاء، ثم قال بعد ذلك: وما سوى ذلك فهو مال الوارث، فهذه الثلاث على هذه الأوصاف هي رزق العبد، وهي التي في يد الله عزّ وجلّ له، الواصلة إليه، فأما ما جعله في يد العبد فقد لا لايكون له، وإنما هو مستودع إياه ومستخلف فيه، وإن تملّكه وحازه خمسين سنة وإنما للعبد ما فرغ منه العبد وهو الذي فرغ له منه لما سبق له به، فإن تملّك سوى هذا وادّعاه لأجل أنه في خزانته، أو قبض يده فذلك لجهله بالله تعالى وقلة فقهه عن الله سبحانه وغفلته عن حكمة الله تعالى في أرضه، يودعها من يشاء إلى الوقت الذي يشاء، حتى يستقرّ إلى كيف يشاء، فقد قال تعالى: (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَودَعٌ) الأنعام: 98 وقال: (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ) الأنعام: 67 وقال سبحانه: (وَخَزَائِنُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ) الأنعام: 7 وهكذا روينا عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وإن لكل عبد رزقاً هو آتيه لا محالة، فمن قنع به ورضي بورك له فيه، ومن لم يقنع به ولم يرضَ لم يبارك له فيه ولم يسعه.
ويقال: لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأدركه، وفي وصية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلائق لو جهدوا أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا على ذلك، ولو جهدوا أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله سبحانه لك لم يقدروا على ذلك، طويت الصحف وجفّت الأقلام، فمن كانت هذه مشاهدته في القسم المعلوم سقط عنه جملة من الهموم واستراح من النظر إلى الخلق واستراح الخلق، ومن أذاه، وشغل عنهم بخدمة مولاه، وكان قد فهم شيئاً من الخطاب، وممّن أقبل على الله الكريم بصالح ما دعاه إليه واستجاب، كما روي أن رجلاً لزم باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل غداة فشهد عمر منه مجيئه لأجل الطلب فقال له: ياهذا هاجرت إلى عمر، أو إلى الله، إذهب فتعلّم القرآن، فإنه سيغنيك عن باب عمر، فذهب الرجل فغاب زماناً حتى افتقده عمر، فسأل عنه فدلّ عليه فأتاه، فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة فقال له عمر رضي الله عنه: إني قد افتقدتك حتى اشتقت إليك، فما الذي شغلك عنا؟ فقال: إني قد قرأت القرآن فأغناني عن عمر وعن آل عمر، فقال له عمر: رحمك الله فما الذي وجدت فيه؟ فقال: وجدت فيه وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت: رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فبكى عمر، وكانت موعظة له منه، فكان عمر بعد ذلك يشابه في الأحايين فيجلس إليه ويستمع منه.
وجاء رجل إلى بشر بن الحارث فقال: إني قد عزمت على سفر إلى الشام وليس عندي زاد فما ترى؟ فقال: ياهذا أخرج فيما قصدت له، فإن لم يعطك ما ليس لك لم يمنعك ما لك، وشكا رجل إلى فضيل حاله فقال ياهذا مدبّر غير الله تريد؟ وكان الحسن يقول: التوكّل هو الرضا، وفي تفسير قوله عزّ وجلّ: (وَقَدَّرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا) فصلت: 10 قال: خلق الأرزاق قبل الأجسام بألفي عام فالمتوكّل لا يطالب مولاه برزق غد كما لا يطالبه مولاه بعمل غد، فأما المتوكّل في المضمون من الرزق المعلوم من القسم فهو توكّل العموم يستحي الخصوص من ذكره، ويتكرمون عن نشره إذا كان الله تعالى قد أقسم بنفسه أن الرزق في السماء حقّ، كما أقسم بنفسه أن كلامه حق، فجمع بينهما في الحقيقة بالقسم بالذات دون سائر الأفعال لتسكن بذلك نفوس الخليقة عن النظر إلى الأدوات، ليرتفع الشكّ فيهما ويحصل اليقين بحقيقتهما، فقال سبحانه: (فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالأَرْضِ إنَّهُ لَحَقٌّ) الذاريات: 23 كما قال تعالى: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَرَبِّي إنَّهُ لَحَقٌّ) يونس: 53 وليس في القرآن قسم بالذات فيما سبرناه إلا خمسة: القسم الذي في سورة النساء على تسليم الأحكام (فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ) النساء: 65 الآية، وفي سورة التغابن على بعث الكافرين وأبنائهم (زَعَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَن لَنْ يِبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبّي لَتُبْعَثُنَّ) التغابن: 7 وفي سورة المعارج من (سَأَلَ سَائِلٌ) المعارج: 1 في تبديل الخلق خلقاًِ خيراً منهم (فَلاَ أُقسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) المعارج: 40 إلى قوله: (بِمَسْبُوقِينَ) المعارج: 41 وهذان القسمان المتقدمان وسائر الأقسام بالأفعال، ولأن العبد قد وكل برزقه من يقوم له به من الخلق، فإن لم يرزق من كسبه وعن يده رزق من كسب غيره ويده، ولكن شغل الخصوص بأعمال الآخرة، وما يفوتهم من القربات إلى الله عزّ وجلّ، وبالخدمة للمولى الذي وكلّ إليهم، فإن لم يقوموا به لم يقم به غيرهم لهم، ولم ينب غيره من الدنيا منابه، لقوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إلاَ مَا سَعى) النجم: 93، وقوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ) (لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ) الغاشية: 8 - 9 ولقوله تعالى: (وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى) الأعلى: 71، وقوله تعالى: (وَالله يُريدُ الآخِرَةَ) الانفال: 76 ولقوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ) الشورى:، 2، ولم يقل هذا في أرزاق الدنيا، ومعنى الزيادة أن لا يحاسبه على مايعطيه من الدنيا إذ لا زيادة في القسم.
وقد قيل: إن الله تعالى يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا، وهذا لعلوّ الآخرة ودناءة الدنيا، وكان عليّ رضي الله عنه يقول: إلا أن حرث الدنيا المال، وحرث الآخرة العمل الصالح، وقد قيل: إن الزيادة في الآخرة رفعة الدرجات لمن كانت نيّته وقصده ولها يعمل، فشغل الخصوص بما وكلّ إليهم وبما لا يعمله غيرهم لهم عمّا تكفّل به لهم، فأقيم غيرهم فيه مقامهم وناب أيضاً عنه مثله من أسباب دنياهم، كما روي في أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمداً لأجلي، وخلق آدم لأجل محمد، وخلقت ما خلقت لأجل آدم، فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته عني، ومن اشتغل منهم بي سقت إليه ماخلقته لأجله، وتوكّل الخصوص أيضاً في الصبر على الأذى من القول والفعل، إذ كان أمر بذلك الرسول في قوله تعالى: (فَاتَّخَذَهُ وَكيلاًِ) (وَاصْبِرْ عَلى مَا يَقُولُونَ) المزمل: 9 - 1 مع قول الرسل عليهم السلام: ولنصبرنّ على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكّل المتوكّلون، وكذلك أمر نبيّه عليه السلام لما قال تعالى: (أُولئِكَ الَّذينَ هَدَى الله فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) الأنعام: 90 فأمره باتباعهم وقال: (ودع أذاهم وتوكّل على الله) إلى قوله: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَهُمْ) الاحقاف35.
وقال بعض العارفين: لا يثبت لأحد مقام في التوكّل حتى يستوي عنده المدح والذم من الخلق فيسقطان، وحتى يؤذى فيصبر على الأذى، يستخرج بذلك منه رفع السكون إلى الخلق، والنظر إلى علم الخالق الذي سبق، ثم التوكّل في الصبر على حسن المعاملة، وترك الطلب للمعارضة حياء من الله وإجلالاً له وتخوّفاً منه وحبَّاًِ له، فقد وصفهم بذلك ظاهراً وباطناً، فالظاهر قوله تعالى: (نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلينَ) (الذَّينَ صَبَرُوا وَعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) العنكبوت: 58 - 59، فلما علموا صبروا على علمهم، ثم توكّلوا عليه في جميع ذلك، فأنعم أجرهم وأجزل ذخرهم، والباطن فيما أخبر عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً فقطعهم الخوف عن الطلب، ففي قوله: منكم، وجه حسن غريب، وهو باطن الآية قد يكون بمعنى لا نريد بدلاً منكم، كقوله تعالى: (وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ) الزخرف: 60 ليس أنه جعل من البشر ومنكم ملائكة، ولكن المعنى بدلاً، هذا أحد الوجهين في الآية وهو أعلاهما، والوجه الظاهر أن يكون الكاف والميم أسماء المطعمين أي لا نريد من عندكم جزاء أي مكافأة ولا شكوراً أي حسن ثناء، فلما لم يطلبوا العوض من أجلهم ولا المكافأة من عندهم وقالوا: إنّا نخاف من ربّنا، جزاهم أفضل الجزء، وأحسن لهم غاية العطاء فقال تعالى: (وَسَقَاْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاْباً طَهُوراً) (إِنَّ هذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً) الدهر: 21 - 22، إذ لم يطلبوا جزاءً ولا شكوراً جعل جزاءهم شراباً طهوراً، وجعل سعيهم لديه مشكوراً، ثم التوكّل عليه في تسليم الحكم والرضا به، ومنه قول يعقوب عليه السلام حين سلم الحكم توكلاً على الوكيل الحاكم: إن الحكم إلا للهِ، عليه توكّلت، لأن العبد إذا كان مريد المراد نفسه من الأشياء قد لا يوجد في كل شيء إرادته، ثم هو على يقين من إرادة مولاه لكلّ شيء، وأن كل شيء مراد لوكيله فينبغي أن يريد ما يريد مولاه إذا لم يتفق له مايريد بل ينبغي أن يكون مراد مولاه أحبّ إليه وأبر عنده لأن ما أراده مولاه مما لاعقوبة على العبد فيه، ولا مسخطة لمولاه فإنه محبوب لله مختار له، فلتكن محبة الله عزّ وجلّ مقدمة لديه على محبته هو واختياره، إذ لله عاقبة الأمور وقد شرّف المتقين ونزّههم عن أمور العاجلة الدنية بقوله عزّ وجلّ: (وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ) القصص: 83، وكما روي في أخبار موسى عليه السلام إذا لم يكن ما تريد فرد ما يكون، فإن أبيت إلا ما تريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد.
وروي عن الحسن: وددت أن أهل البصرة في عيالي وأن حبة بدينار، وهذا من نهاية التوكّل، وليس ذلك إلا في تسليم الأحكام والرضا بها كيف جرت بهم، لأن هذا كلام قد جاوز المعقول، وقد كان وهيب بن الورد المكي يقول: لو كانت السماء نحاساً، والأرض رصاصاً، ثم اهتممت برزقي لظننت أني مشرك، ويقال: من اهتمّ برزق غد وعنده اليوم قوت غد فهي خطيئة تكتب عليه، وقال سفيان: الصائم إذا اهتم في أوّل النهار بعشائه كتب عليه خطيئة، وكان سهل يقول: إن ذلك ينقص من صومه، وقال أعرف في البصرة مقبرة عظيمة يغدو على موتاهم برزقهم من الجنة بكرة وعشية يرون منازلهم من الجنان وعليهم من الغموم والكروب ما لو قسم على أهل البصرة لماتوا أجمعين، قيل: ولِمَ؟ قال: كانوا إذا تغدوا قالوا بأي شيء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا بأي شيء نتغدى؟ وقال مرة أخرى: لم يكن لهم من التوكّل نصيب، وهذه المقامات من فضائل التوكّل وفوقها ما لا يصلح رسمه في كتاب من مكاشفات الصدّيقين ومشاهدات العارفين، منها أنه أعطاهم كن بإطلاعه إياهم على الاسم فزهدوا في كون كن لأجل كان، توكلاً عليه وحياءً منه أن يعارضوه في قدرته، ويرغبوا عن تقديره، أو يضاهوه في تكوينه، لأن تدبيره عندهم أحكم وأيقن، وهم بالعواقب أعلم، وأخبروهم له أشد إجلالاً وإعظاماً مما نقدر نحن ونعلم، فأما التوكّل عليه في القوت فإنه عندهم فرض التوكّل يستحيون من ذكره مع الوكيل، وكذلك التوكّل عليه في تسليم الأقدار حلوها ومرّها خيرها وشرها من الله حكمة وعدلاً، كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، وكما قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وكذلك قال الله عزّ وجلّ: (وَكُلُّ صغَيرٍ وَكَبير مُسْتَطَرٌ) القمر: 53، فالعلم بهذه الأشياء، وطمأنينة القلب بها، وسكينة العقل عند ورودها، وأن لا يضطرب بالرأي والمعقول، ولا ينازع بالتشبيه والتمثيل، فإن هذا عندهم من فرائض الإيمان، لا يصحّ إيمان عبد حتى يسلم ذلك كله، وليس هذا من التوكّل في شيء، ومنه قول ابن عباس: القدر نظام التوحيد فمن وحِد الله وكذّب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقصاً لتوحيده، فجعل الإيبمان بالأقدار كلّها أنها من الله مشيئة وحكماً بمنزلة الخيط الذي ينتظم عليه الحبّ، وأن التوحيد منتظم فيه، يقول: إذا انقطع الخيط سقط الحبّ، قال: كذلك إذا كذب بالقدر ذهب الإيمان، فالتوكلّ فرض وفضل، ففرضه منوط بالإيمان وهو تسليم الأقدار كلّها للقادر واعتقاد أن جميعها قضاؤه وقدره، ألم ترَ إلى ربك كيف أقسم بنفسه في نفي الإيمان عمّن لم يحكّم الرسول فيما اختلف عليه من حاله فقال تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنَونَ حَتى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسِلِّمُوا تَسلْيماً) النساء: 65، فكيف بالحاكم الأوّل والقاضي الأجلّ؟ فأما فضل التوكّل فإنه يكون عن مشاهدة الوكيل فإنه في مقام المعرفة ينظر عين اليقين، كما قال العبد الصالح: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، فظهرت منه قوّة عظيمة بقوي، وأخبر عن عزيز بعزّ فكأنه قيل: ولمَ ذاك وأنت بشر مثلنا ضعيف؟ فقال: إني توكّلت على الله ربي وربكم، فكأنه سئل عن تفسير توكّله كيف سببه فأخبر بمشاهدة يد الوكيل آخذة بنواصي دواب الأرض، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم أخبر عن عدله في ذلك وقيام حكمته، وإنه وإن كان آخذاً بنواصي العباد في الخير والشر والنفع والضرّ، فإن ذلك مستقيم في عدله، فقال: إن ربي على صراط مستقيم، وقال تعالى في فرض التوكل: (وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَن) المائدة: 23، وقال تعالى في مثله: (إنْ كُنْتمْ آمَنْتُمْ بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَْلُوا إنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ) يونس: 84، وقال تعالى في فضله: (وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) إبراهيم: 12، وقال تعالى: (إنَّ الله يُحبُّ الْمُتَوَكلِّينَ) آل عمران: 159.
ذكر إثبات الأسباب والأواسط لمعاني الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبوت الحكم والقدرة:
اعلم أن الله عزّ وجلّ ذو قدرة وحكمة، فأظهر أشياء عن وصف القدرة، وأجرى أشياء عن معاني الحكمة، فلا يسقط المتوكّل ما أثبت من حكمته لأجل ما شهد هو من قدرته من قبل أن الله تعالى حكيم، فالحكمة صفته، ولا يثبت المتوكّل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضارة، فيشرك في توحيده من قبل أن الله قادر والقدرة صفته، وأنه حاكم جاعل ضارّ نافع، لا شريك له في أسمائه، ولا ظهير له في أحكامه، كما قال عزّ وجلّ: (إن الحكم إلا لله) يوسف: 40 وقوله: (وَلاَ يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَداً) الكهف: 26، وكما قال تعالى: (وَمَا لَهُمْ فيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ منهم منْ ظَهيرٍ) سبأ: 22 الظهير المعين على الشيء، فالمتوكل مع مشاهدته قدرة الله على الأشياء وأنه منفرد بالتقدير والتدبير قائم بالملك والمملوك هو أيضاً عالم بوجوه الحكمة في التصريف والتقليب بإظهار الأسباب الأواسط لإظهار الأشخاص والأشباح لإيقاع الأحكام على المحكوم وعود الثواب والعقاب على المرسوم، من حيث كان المتوكل قائماً بأحكام الشريعة ملتزماً لمطالبات العلم مع تسليمه الحكم الأوّل لله، واعترافه أن كلاً بقدر الله إذ سمع الله تعالى يقول: لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون، وأن الله تعالى في جميع ما أظهر أخفى قدرته في حكمه فظهرت حكمته في الأشياء لعود الأحكام على المظهرين لها، وبطنت قدرته في الأشياء لرجوع الأمر كله إليه ولإتقان الصنعة الظاهرة لصنع الباطن.
فلذلك قال عزّ وجلّ: (صُنْعَ الله الَّذي أَتْقَنْ كُلَّ شَيء) النمل: 88، أي صنعه الباطن أتقن صنعه الظاهر، ثم قال تعالى: (وَإلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ) هود: 123، من الظاهر والباطن فاعبده وتوكّل عليه في جميع ذلك، فللعارف المتوكّل من الصنع الباطن شهادة هو قائم بها، وله في الحكمة الظاهرة علم شرع وتسليم اسم ورسم هو عامل به، وهذا هو شهادة التوحيد في عبادة التفضيل، وهو مقام العلماء الربانيين، وكل مؤمن بالله متوكّل على اللَّه، ولكن توكّل كل عبد على قدر يقينه، فتوكّل الخصوص ما قدمناه من ذكر المشاهدة ومعاني الرضا، وتوكّل العموم ما عقبناه من الإيمان بالأقدار خيرها وشرها، وقد أخبر الله تعالى أنه هو الرزاق، كما هو الخالق، كما هو المحيي المميت، فقرن بين هذه الأربع في قرن واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة، فكيف يختلف حكمها أو يتبعّض وصفها لظهور الأسباب ووجود الأواسط.
فقال سبحانه وتعالى: (الله الَّذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ) الروم: 4،، فكما ليس في الثلاث الأخر جاعل ومظهر إلا الواحد، فكذا ليس في الرابعة من الرزق إلا هو، ألا ترى أنك لا تقول: خلقني أبي وإن كان هو سبب خلقك؟ ولا تقول أحياني وأماتني فلان وإن كان أواسط في الإحياء والقتل، لأن هذا شرك ظاهر اشتهر قبحه فترك؟ ولذلك قال الله تعالى: (أَفرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ) (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَم نَحْنُ الخَالِقُونَ) الواقعة: 58 - 59، وكذلك قال تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ) (أأَنْتُمْ تَزْرَعُوَنهُ أمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) الواقعة: 63 - 64، فأضاف الإمناء والحرث إلينا، لأنها أعمال ونحن عبيد عمال، ولأنها صفاتنا وأحكامها عائدة علينا، وأضاف الخلق والزرع إليه لأنها آيات عن قدرته، وحكمته واللَّه هو القادر الحكيم، وكذلك كل ما ذكر في الكتاب من الأعمال والاكتساب أضيف إلى الجوارح المجترحة، ونسب إلى الأدوات المكتسبة، وما كان من القدرة والإرادة وصف نفسه به، لأنه المريد الأوّل والقادر الأعلى، فافهم عن الله خطابه كيلا يزيغ قلبك فيما تشابه، ثم قد يقول العبد أعطاني ومنعني فلان لأن هذا شرك خفي، ولأن الأسباب تظهر على أىديهم، وتجري بأواسطهم، فحجبوا بها عن المسبّب واستتر عنهم المعطي المانع، فقبح هذا أيضاً عند الموقنين كقبح ذاك، لأن الله تعالى نفى الرزق عن سواه كما نفى الخلق، فقال تعالى: (هَلْ مِنْ خَاِلقٍ غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ) فاطر: 3، ولم يرد اللفظ على اللفظ وإن حسن فيقول: يخلقكم لأنه أراد سبحانه أن يفيدنا فضل بيان ويعلمنا اقتران الرزق بالخلقة، وأنهما مسببان عن القدرة، فالمتوكّل قد أيقن أنه لم يكن على الله أن يخلقه، فلما خلقه كان عليه أن يرزقه، وهكذا روي عن الله تعالى: أأخلق خلقاً ولا أرزقه؟ وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ردًّا عليهم حين قالوا: جدي في كذا وجدي في كذا، يعنون صنوف الأسباب، فنفى ذلك بقوله هذا في صلاته وأسمعهم إياه خشية دخول الشرك عليهم، أي جد العبد لا ينفعه منك شيئاً فهذا كما قال الله تعالى: (إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيْئاً) النجم: 28.
قال بعض العلماء في معنى ذلك: من جدّ في الطلب وحرص وجد منك المنع لم ينفعه جده في طلبه وحرصه شيئاً، وقال أيضاً في معنى قول الله عزّ وجلّ: (وَيَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ) الرعد: 39، قال: يمحو الأسباب من قلوب العارفين ويثبت القدرة ويمحو المشاهدة من قلوب الغافلين ويثبت الأسباب في صدورهم، وقال هذا أيضاً: خلق الله النفس متحركة ثم أمرها بالسكون، وهذا هو الابتلاء، فإن تداركها بالعصمة سكنت وهذا خصوص، وإن تركها تحرّكت بطبعها وجبلتها وهذا هو الخذلان، وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اردد رغبتك إلى الله إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، فإن حيلتك لن تزيديك ولن تنقصك من قسمة الله التي قسم لك، واعتبر رزقك بخلقك، فإن استطعت أن تزيد في خلقك بحيلتك فإنك إذاً تزيد في رزقك، وإلافاعلم أن الله هو الذي عدل الخلق وقسم الرزق، فلن تستطيع أن تزيد في أحد منها، فإن منهم المحتال الجلد البطوش ولا يزداد إلا فقراً، ومنهم المعيي الواهن المهين ولا يزداد ماله إلا كثرة، ولو كان من الحيلة لسبق القوي الضعيف إلى كل شيء، ولكن الله يخلق ويرزق ولا يملك العباد من ذلك شيئاً، وهكذا حكى أن بعض الأكاسرة سأل حكيماً في زمانه فقال: ما بالي أرى العاقل محروماً والأحمق مرزوقاً؟ فقال: أراد الصانع أن يدل على نفسه، ولو كان كل عاقل مرزوقاً، وكل أحمق محروماً، لوقع في العقول، إن العاقل يرزق نفسه والأحمق حرم نفسه فلما رأوا الأمر بخلاف هذا علموا أن الصانع هو الرازق.
وروينا عن ابن مسعود في إعطاء هذا المال فتنة، وفي منعه فتنة، إن أعطيه عبد مدح غير الذي أعطاه، وإن منعه عبد ذم غير الذي منعه، وقد روينا معناه في حديث مطرف عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه خطب فقال: ألا إن في إعطاء هذا المال فتنة،، وفي منعه فتنة، يغدو الرجل إلى ابن عمه فيسأله الحاجة التي قد كتبها الله له فلا يملك منعه فيعطيه ما كتب له فيظل يشكره ويثني عليه بها خيراً، ثم يعود إليه العام المقبل فيسأله الحاجة التي لم يكتبها الله له فلا يملك أن يعطيه كما لم يعطه في العام الأول أن يمنعه فيمنعه ما لم يكتب له، فيرجع فيحتقبها عليه ذنباً، ويثني عليه بها شرَّا، إلا أن في إعطاء هذا المال فتنة وفي منعه فتنة، واللفظ للخبر ولم آل يعني بالفتنة الاختبار وصدق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يختبر بذلك الموقنون للخير والغافلون لينظر كيف يعملون، فأما أهل اليقين فيعتبرون بالأسباب ويعجبون من التسبب فيزدادون بذلك هدى وإيماناً لشهودهم المعطي المانع واحداً في العطاء والمنع، ولمعرفتهم بجريان الحكمة فيما جادت به الشريعة ثبت لهم مقامان: الشكر له والصبر عليه، وأما الغافلون فيضطربون لذلك ويثبتون بنظرهم إلى الأسباب والأيدي، فيمدحون المعطين ويذمون المانعين عندهم فينقصون ذلك، فقد صار المال فتنة للفريقين يكشف إيمانهم وتمتحن للتقوى قلوبهم، وكذلك جاء في الخبر: إن العبد ليهمّ من الليل بالأمر من أمور الدنيا من التجارة وغيرها الذي لو فعله كان فيه هلكته، فينظر الله إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كئيباً حزيناً يتطير بجاره وبابن عمه من سبقني من دهاني وما هو إلا رحمة رحمه الله بها، وعن ابن مسعود أنه قال: من الإخلاص أن لا تحبّ أن يحمدك الناس على عبادة اللَّه وأن لا تمدحهم على ما رزقك الله.
وقد روينا عن عيسى عليه السلام وعن ابن مسعود وغيره: أن من اليقين أن لا تحمد أحداً على ما أعطاك الله ولا تذمه على ما لم يؤتك الله، وقال: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله، وفي حديث الإفك الذي رواه معمر بن أبان عن حمدان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقام إلّي أبواي فقبلاني في صدورهما فقلت بغير حمدكما ولا حمد صاحبكما، أحمد الله تعالى الذي عززني وبرأني، وفي حديث غيره فقال لها أبو بكر: قومي فقبّلي رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعها يا أبا بكر، فهذه المعاني التي قدمناها تكون من ضعف اليقين، ونقصان المعرفة، فإذا انطوت في سرّ العبد وخلده وكثرت من قوله وفعله أذهبت حقيقة الإيمان، كما قال عبد وأن العبد ليخرج من منزله ومعه إيمانه فيرجع إلى منزله وليس معه من إيمانه شيء يلقى الرجل لا يملك له ضرَّا ولا نفعاً، فيقول إنك لذيت وذيت، ويلقى الآخر كذلك حتى يرجع إلى منزله، ولعله لم يخل منه بشيء وقد أسخط الله عليه.
وسئل بعض علمائنا عن معنى الخبر المنقول من التوراة: من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه، فقال: لأن الإيمان عقد وفعل وقول، فإذا تواضع للغني لأجل دنياه بالثناء والحركة إليه، ذهب ثلثا إيمانه وبقي الثلث وهو العقد، فإن جعلت الأواسط في الرزق أوائل في الجعل لثبوتها فإن الله تعالى قد أظهرها أسباباً وأثبت نفسه فيها فقال تعالى: (قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكَّلَ بِكُمْ) السجدة: 11، ثم رفعه وأظهر نفسه فقال تعالى: (اللَّه يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حينَ مَوْتِهَا) الزمر: 42، وكذلك قال: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ) الواقعة: 63، فذكر الأواسط ثم قال: (أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا) (ثُمَّ شَقَقْنَا الأرَْضَ شَقًّا) عبس 25 - 26، وقال في التفصيل: (فَأَرْسَلْنا إلَيْها رُوحَنَا) مريم: 17، ثم قال تعالى في التوحيد: (فَنَفَخْنَا فيهَا مِنْ رُوحِنَا) الانبياء: 91، وكان النافخ جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: (فَإذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبعْ قُرْآنَهُ) القيامة: 18.
قال أهل التفسير: فإذا قرأه عليك جبريل فخذه عنه بعد قوله تعالى: (لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) القيامة: 16 وكذلك قال جبريل: لأهب لك غلاماً ذكياً لأن الله تعالى وهب له أن يهب لها، فذكر نفسه وهو يشهد ربه ثم قال في الحرف الآخر: ليهب لك يعني الله تعالى، ومثله قول موسى عليه السلام: لا أملك إلا نفسي وأخي لأجل أن الله تعالى قال: (وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ) مريم: 53، وهو في الحقيقة لا يملك نفسه ولا آخاه إذ لا مالك أصلاً إلا الله عزّ وجلّ، وهذا على أحد الوجهين إذا كان وأخي في موضع نصب والوجه الآخر أن يكون قوله وأخي في موضع رفع فيكون المعنى وأخي أيضاً لا يملك إلا نفسه وكذلك قال سبحانه في التفصيل والأمر: (اقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ) التوبة: 5، وقال في مثله من ذكر واسطة الأمر: (قَاِتلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ الله بأَيْديكمْ) التوبة: 14 ثم قال في التوحيد: (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ الله قَتَلَهُمْ) الأنفال: 71، وقال في إثبات الأسباب ورفع حقائقها: (وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولَكِنَ اللهَ رَمَى) الأنفال: 17، وقال تعالى في ذكر الأواسط: (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمُ ولاَ أَوْلاَدُهُمْ إنَّمَا يُريدُ الله لِيْعَذّبَهُمْ بهَا) التوبة: 55، وقال في مثله: (الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) العلق: 4، ثم قال تعالى: (الرَّحْمنُ) (عَلَّمَ الْقُرْآنَ) الرحمن: 1 - 2 وقال تعالى: (عَلَّمَهُ الَبَيانَ) الرحمن: 4، ثم قال: إن علينا بيانه، وقال في تثبيت الأملاك وبيعها منه بالأعواض كرماً منه وفضلاً: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فجاز ذلك لما ملكهم ما له كقوله تعالى: (إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيمانكم) النساء: 24، وعند أهل المعرفة أن لا فاعل حقيقة إلا الله عزّ وجلّ، لأن حقيقة الفاعل هو الذي لا يستعين بغيره بآلة ولا سبب، وعندهم إن فعلاً لا يتأتى من فاعلين وإلا كان شركا، لأن الفاعل الثاني المظهر الذي فعل بيده وأجرى الفعل بواسطته هو ثان ومحدث، والأوّل القديم هو الفاعل الأصلي، كما أن عندهم أن حقيقة المالك هو خالق الشيء، ومن جعل في يده فهو مملك، لأنه لم يخلق مابيده كما المجري على يده الفعل مفعول، لأن الله تعالى هو الأول القيوم بنفسه لا يستعين بغيره، وقد جعل الله أيضاً بحكمته وعزته للخلقة والحياة واسطة وهوملك الأرحام، في الخبر أنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة في يده ثم يصوّرها جسداً فيقول يا رب أذكر أم أنثى؟ أسويّ أم معوج؟ فيقول الله ما شاء ويصوّر الملك، وفي لفظ آخر: يخلق الملك ثم ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة، ويقال: إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد، ويقال: إنه يتنفس بوصفه، فيكون كلّ نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم، ولذلك سمّي الروح.
وقد قال الله تعالى في وصف نفسه: (الْبَارئ الْمُصَوِّرُ) الحشر: 24، كما قال الخالق، وقال تعالى: (خَلَقَ الْموْتَ وَالْحَياة) الملك: 2، وقد جعل للإحياء واسطة كما جعل للموت وهو إسرافيل صاحب الصور ينفخ في النفخة الثانية فيحيا كل ميت ثم يرفعه الله تعالى، فقال: يوم ينفخ في الصور، ووصف نفسه بأنه المحيي المميت، وفي بعض الأخبار أن ملك الموت وملك الحياة تناظرا، فقال ملك الموت: أنا أميت الأحياء، وقال ملك الحياة: أنا أحيي كل ميت، فأوحى الله إليهما كونا على عملكما وما سخرتما له من الصنع، فأنا المميت وأنا المحيي ولا مميت ولا محيي سواي، وكذلك أيضاً قيل عن الله تعالى: أنا الدليل على نفسي ولا دليل عليّ أدل مني، ولم يمنع وجود هذه الأواسط أن يكون الله سبحانه هو الأول في كل شيء، وهو الفاعل لكل شيء، وحده لا شريك له في شيء، ولم يقل أحد من المسلمين: الملك خلقني ولا عزرائيل أماتني ولا إسرافيل قد أحياني كذلك، أيضاً لا يصلح أن يقول الموقن المشاهد للتوحيد، فلان أعطاني أو منعني، كما لا يقول فلان رزقني ولا فلان قدر عليّ، وإن جعل واسطة في ذلك وأجرى على يديه ذلك لأن العطاء هوالرزق والمنع هو القدر، ولا كان عندهم شركاء في أسماء الله غيره إذ كان الله هو المعطي المانع الضار النافع كما هو المحيي المميت، لا شريك له في ملكه ولا ظهير له من عباده في خلقه ورزقه، وهذا عندهم يقدح في حقيقة التوحيد للعبد وهو من الشرك الخفي الذي جاء في الأثر: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة.
وقال بعضهم في معنى قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إلاّ وَهُمْ مُشركُون) يوسف: 106 قال مؤمن بالإقرار: إن الله هو المقدّر المدبّر، ومشرك في الاعتماد على الأسباب وردّ الأفعال إليها، ومن الإخلاص عند المخلصين بلا إله إلا الله، ولامعطي ولا مانع إلا الله ولا هادي ولا مضلّ إلا الله، كما لا إله إلا الله، هذا عندهم في قرن واحد ومشاهدة واحدة، وهو أوّل التوحيد، وإن كان قد جعل هادين ومضلين ومعطين ومانعين ولكن بعد إذنه ومن بعد مشيئته وحكمه، كما قال تعالى: (أَحْسَنُ الْخَاِلقينَ) المؤمنون: 14 (خَيْرُ الرَّازِقينَ) المؤمنون: 72، لأنه خلقهم وخلق خلقهم ورزقهم ورزق رزقهم، وكذلك هو هداهم وهدى بهم، وأضلهم وأضلّ بهم، فعن هدايته هدوا به، وعن إضلاله ضلّوا بعد إرادته، كما عن خلقه خلقوا، ومن رزقه رزقوا، وكيف وقد فسر ماذكرناه بقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وبقوله تعالى: (لَوْ هَدانَا الله لَهَدَيْنَاكُمْ) إبراهيم: 21، وقال في مثله: (فَأَغْوَيْناكُمْ إنَّا كُنّا غَاوِينَ) الصافات: 32، فبمشاهدة ما ذكرناه يخرج العبد من الشرك الخفي وهو تحقيق قوله: لا إله إلا الله بعد التصديق، أي ليس من تأله، القلوب وتأله إليه إلا الله، ثم يقول معها: وحده لاشريك له، أي وحده في قدرته وتوحيده لا شريك له في ملكه من خلقه، ثم وكدّ ذلك بقوله: له الملك، أي جميع ما أظهر، وله الحمد في جميع ما أعطى ومنع، يستحق الحمد كله، فهو لا يستحقه غيره، وهوعلى كل شيء قدير أي من الخلق والأمر، فالقدرة كلها له والخلق كله له يحكم في خلقه بأمره ما شاء كيف شاء، ومثل الأواسط مثل الآلة بيد الصانع، ألا ترى أنه لا يقال: الشفرة حذت النعل ولا السوط ضرب العبد، إنما يقال: الحذاء حذ النعل وفلان ضرب عبده بالسوط، وإن كانت هذه الأواسط مباشرة للأفعال إلا أنها آلة بيد صانعها، وكذلك الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر العيان، والله من ورائهم محيط، القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة، ألم ترَ إلى قولهم: الأمير أعطاني كذا وخلع عليّ كذا؟ وإن لم يناوله بيده ولا يصلح أن يقول: خادم الأمير أعطاني لأجل أنه جرى على يده، وإن كان باشر العطاء بنفسه، إذ قد علم أن الخادم لا يملك ولا يتصرف في ملك الأمير إلا أن يسأل الإنسان: بيد من أعطاك الأمير؟ أو على يد من وجه إليك بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل في معرفة أي عبد جاء به، فيجوز أن يقول حينئذ: بيد عبده فلان فإما أن يبتدئ المعطي من غير أن يسأل إذا أراد أن يظهر العطاء فيقول الأمير أعطاني على يد عبده فلان، فإن هذا لغو لا يحتاج إلى ذكر العبدمع ذكر الملك، لأن البغية إظهار العطاء من الملك المعطي، فلا معنى لذكر العبد الذي جرى العطاء على يده فافهم، ومن ذلك قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل الذي ناوله التمرة: خذها، لو لم تأتها لأتتك، والتمرة لا تأتي، ولم يقل: لجاءك بها رجل إذ لا بغية في ذكر ذلك، ومن هذا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل الذي قال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد فقال: عرف الحق لأهله، وإنما ذكرالله تعالى الأسباب لأن الأسماء متعلقة بها والأحكام عائدة على الأسماء بالثواب والعقاب، فلم يصلح أن لا تذكر فتعود الأحكام على الحاكم تعالى، عن هذا أنه هو يبدىء ويعيد، يبدئ الأحكام من الحاكم ويعيدها على المحكوم، وهذا هو سبب إظهار المكان من الموات والحيوان لئلا يكون تعالى محكوماً وهو الحاكم ولا يكون مأموراً وهو العزيز الآمر، فعادت على المحكومات المأمورات، ومن هذا قوله تعالى: (مَا عِنْدَكمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ) النحل: 96، فجميعاً عنده، وفي خزائنه، إلا أنه أضاف الدنيا إلينا لرجوع الأحام علينا وليزهدنا فيها وأضاف الآخرة إليه تخصيصاً لها، وتفضيلاً ليرغبنا فيها، وكما أخبر عن عيسى: وإذ تخلق من الطين، ومثله: فارزقوهم فيها، فسماه خالقاً، إذ خلق الله على يده وسماهم رازقين لما أجرى على أيديهم رزق أهليهم، فهو عندي كقوله لمريم: (وَهُزِّي إلَيْكِ بِجِذْعِ الَّنخِلةِ تُساقِطْ عَليْكَ رُطَباً جَنِيَّا) مريم: 25، وقد علمت أن الرطب لم يتساقط بهزّها ولا جعل ولا فعل لهزّها في الرطب، ولكن أراد أن يظهر كرامتها ويجعل الآلة منه بيدها، ومثله: (ارْكُضْ بِرِجِلْكَ هَذا مُغْتَسَلٌ
بارِدٌُ وَشَرَابٌ) ص: 42، فنبعت عينان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى ولا فعل لرجله في إظهار اليعنين، وقد نفى لبيد ما سوى الله في قوله: دٌُ وَشَرَابٌ) ص: 42، فنبعت عينان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى ولا فعل لرجله في إظهار اليعنين، وقد نفى لبيد ما سوى الله في قوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أنشد ذلك صدق، وفي لفظ آخر إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أصدق بيت قاله الشاعر:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل
وهو يعلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ في الأشياء أواسط حقّ وأسباب صدق، ثم لم يمنعه ذلك أن قال أصدق بيت قاله الشاعر: كذا، إيثاراً منه للتوحيد وتوحيداً للمتوحد، هذا مع قرب عهدهم بتكذيب الرسل وإبطال الكتب، ولكن لما كانت الأشياء بعد أن لم تكن ولا تكون، بعد أن كانت أشبهت الباطل الذي لا حقيقة له أولية، ولا ثبات له آخرية، وكان الله تعالى الأوّل الأزلي، الآخر الأبدي، فهو الحق ولا هكذا سواه، ومثله الأسباب أيضاً في ثوانيها وأواسطها إلى جنب الأوّل المسبّب مثل ما يقول في القرآن: قال الله كذا، ولك أن تقول قال نوح، وقال يوسف كذا، فكل صواب، فإذا قلت قال الله سبحانه وتعالى فهو القائل الأوّل قبل القائلين، متكلماً بوصفه مخبراً عن علمه بغير وقت لموقت ولا حدّ لمحدود ولا حدثان، وإن قلت قال صالح وقال شعيب فقد قالوه بأنهم ثوان في القول وأواسط به، وقالوا ذلك عنه بحدوث أوقات وظهور أسباب، كذلك الأسباب في أواسطها فهي ثوان عن الأوّل المبدئ، ومن ههنا، وفي مثله دخلت الشبهة على المبتدعين فقالوا بخلق القرآن، فلو لم يدخل عليهم إلا إنهم جعلوا قول القائلين قبل قول الله أحكم الحاكمين، فأثبتوا قبل قوله قيلاً وهو القول منهم لنفيهم قدم الكلام، فوقعوا بجهلهم في أعظم مما هربوا منه لأنهم هربوا من إثبات قديم آخر بزعمهم، فوقعوا في إثبات حدث أوّلاً وإحداث قدم ثانياً، تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً وسبحانه بكرة ً وأصيلاً، ولم يعلموا بجهلهم أنهم إنما قالوا بعد قوله، فصار قولهم عن قوله، وكان هو الأوّل في القول من حيث كان هو الأوّل بالقدم والسابق بالعلم، وصاروا هم ثوان في المقال من حيث كانوا حوادث من الأفعال، فكذلك أيضاً تدخل الشبهة على الغافلين من ضعف اليقين لشهود المانعين والمنفقين أوائل في الفعل من قبل أنّ الله تعالى أظهر العطاء والمنع بأيديهم، فشهدوهم معطين مانعين لنقصان توحيدهم فأشركوا في أسماء الله كما أشركت المبتدعة في صفات الله عزّ وجلّ أن حجبوا عن شهادة سبق علم الله كما حجب الزائغون عن حقيقة توحيد الله تعالى، إلا إنّ شرك الزائغين ضلال ينقل عن الملة وهو شرك جلي وشرك ضعفاء اليقين غفلة وجهل لا ينقل عن الملة لأنه شرك خفي، وحكي أنّ بعض العلماء صلّى خلف رجل، فلما انفتل الإمام نظر إليه في زي غير مكتسب فقال: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها خلفك ثم أجيبك، وحدثونا في معناه عن آخر أنه لزم العكوف في المسجد ولم يكن ذا معلوم من عيش فقال له الإمام: الذي يصلّي بالناس لوتكسّبت وتعبّست كان أفضل لك فلم يجبه، فأعاد عليه وقتاً آخر نحو ذلك، فقال يهوديّ في جوار المسجد: قد ضمن لي كل يوم رغيفين فقنعت بذلك وتركت التكسّب، فقال الإمام: إن كان صادقاً في ضمانه فإن عكوفك في المسجد خير لك، فقال له الرجل: يا هذا أنت لو لم تكن إماماً للمسليمن تقوم بينهم وبين الله لنقص توحيدك كان خيراً لك.
وحدثت أنّ الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين: أدرك لي لطف الفطنة وخفيّ اللطف فإني أحبّ ذلك، قال: يا رب وما لطف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أني أوقعتها فسلني أرفعها، قال وماخفيّ اللطف؟ قال: إن أتتك فولة مسوّسة فاعلم أني قد ذكرتك بها، وهذاالذي ذكرناه من أنّ الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع الضارّ النافع حيث كان، هو الخالق الرازق كيف شاء، ومتى شاء، وبمن شاء، هو في عقود عموم المؤمنين وفي علمهم، ألا إنّ فيهم جهلاً بالحكمة وغفلةً عن الحاكم، يحيلون ذلك إلى عاداتهم ويريدون أن يكون رزقهم من حيث معتادهم، أو من حيث معقولهم باختيارهم ومعقولهم بالعزّ والفخر والتطاول والأنفة، لا على الذلّ والتواضع والفقر والمسكنة، ولا يكلون أمورهم إلى الله ويرضون بتدبيره وتقديره أن يرزقهم كيف شاء وبيد مم شاء فيؤثرون أخلاق الجبابرة على أخلاق المؤمنين، لبعدهم من مشاهدة اليقين ولاستيلاء أخلاق النفس عليهم، ثم إنّ نفوسهم مع علمهم أنّ الخلق والأرض كله لله عزّ وجله، وأنّ الحمد والملك له، قد تطمع في غير الله وترجو سواه، وقد تضطرب بجبلتها عن أثقال الحقائق، وقلوبهم لا تطمئن بل تنزعج عند الابتلاء بالمصائب والفاقات، ولاتصبر للخالق، وإنّ ألسنتهم قد تسبق بالمدح والفرح مع رؤية الأواسط أو بالذم والأسى على فوت العطاء لوجود الغفلة وذهابهم عن مشاهدة ما يعلمون، فهذا دليل نقص توحيدهم وضعف يقينهم، وإن معرفتهم معرفة سمع وخبر لامعرفة شهادة وخبر، وقد شركهم الموقنون بتسليم ذلك لله في العلم والقدرة وإثبات الأواسط والأسباب لمجاري الحكمة وعود الثواب والعقاب على الخليقة، ولكن زادوا عليهم بحسن اليقين وقوة المشاهدة وجميل الصبر وحقيقة الرضا، فسكنت القلوب واطمأنت النفوس عند النوازل والبؤس، وثبتوا في الإبتلاء لشهود المبلي يدبر الخلائق كيف شاء، فحصل لهم في اليقين وحال من التوكل ونصيب من الرضا، وخرج أولئك من حقائق هذه المعاني ودخلوا في عمومها، ودخل عموم المؤمنين مع الموقنين في فرض التوكل، قد جاوزهم الموقنون فارتفعوا عليهم وعلوا في فضله ووقف العموم ونكصوا عن العلوّ لقعود اليقين بهم وحجب الأسباب لهم، وسبق المقربون إلى الفضل، ويؤت كل ذي فضل فضله، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، وقال بعض العلماء: احتجب عن العموم بالأسباب فهم يرونها، وحجب الأسباب بنفسه عن الخصوص فهم يرونها ولا يرونها، وحدثونا عن سري السقطي قال: ثلاث يستبين بهن اليقين، القيام بالحق في مواطن الهلكة، والتسليم لأمر الله عند نزول البلاء، والرضا بالقضاء عن زوال النعمة، وقال يوسف بن أسباط قبله: كان يقال: ثلاث من كنّ فيه استكمل إيمانه، من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.
ذكر التكسب والتصرف في المعايش
ولا
يضرّالتصرف
والتكسب لمن صحّ توكله ولايقدح في مقامه ولا ينقص من حاله قال الله سبحانه: (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً) النبأ: 11، وقال تعالى: (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايِشَ قَليلاً مَا تَشْكُرُونَ) الأعراف: 10 وروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحلّ ما أكل العبد من كسب يده وكل بيع مبرور، وقد كان الصانع بيده أحبّ إليهم من التاجر، والتاجر أحبّ إليهم من البطال، وقال ابن مسعود: إني لأكره أن يكون الرجل بطالاً ليس في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة، ولأن التوكل من شرط الإيمان ووصف الإسلام، قال الله تعالى: (إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ) يونس: 84، فاشترط في الإيمان به والإسلام له التوكّل عليه، فإن كان حال المتوكل التصرف فيما قد وجه فيه ودخل في الأسباب وهو ناظر إلى المسبّب في تصريفه، معتمد عليه واثق به في حركته، متسبب فيما يقلبه فيه مولاه، متعيش فيما يسببه له ويوجهه فيه، عالم بأن الله تعالى قد أودع الأشياء منافع خلقه وجعلها خزائن حكمته ومفاتح رزقه، ويكون أيضاً متبعاً للسنة والأثر تاركاً الترفه والتنعم، فهو في تكسبه وتصرفه أفضل ممن دخلت عليه العلل في توكله فساكنها، وقد ذكر لنا عن بعض العلماء أنه رؤي يطحن برجله، وكان قد ترك العمل أربعين سنة فقيل له: دخلت في التكسب بعد أن كنت قد تركته؟ فقال: يا هذا، إذا عدمنا عزّ التوكل لم نصبر على ذل الاستشراف، فكذلك الأمر فيمن دخلت عليه الآفة في ترك التكسب، فليخرج منها إلى الاحتراف، ومن دخل عليه اليقين فاقتطعه فليقعد عن الاكتساب، فالتكسب خير من التشرف إلى الخلق واعتياد المسألة، وسالك على طريق فهو يصل وإن كان في طريقه بعد، والتوكل لمن أقعد به ناظر إلى الوكيل أفضل لمن صح له لفراغ قلبه من الخلق وشغله بالخالق، وهو طريق قريب فصاحبه مقرب، والتارك للتكسب طمعاً في الخلق وترفّهاً للنفس وحبَّا للمسألة واتباعاً للهوى، سالك على غير طريق لا قريب ولا بعيد هو عن المحجة جائر، كما روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأن يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك يعني بمضغه، وقال: من يضمن لي خصلة واحدة، أضمن له الجنة، لا يسأل الناس شيئاً، وقال بعض علمائنا: من أنكر التكسب فقد طعن في السنّة، ومن أنكرالقعود عن التكسب فقد طعن في التوحيد، وقال: بعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الخلق وهم أصناف كما هم اليوم، منهم التاجر، والصانع، والقاعد، ومن يسأل الناس، ومن لم يسأل الناس، فما قال للتاجر اترك تجارتك ولا قال للقاعد: اكتسب واصنع، بل جاءهم بالإيمان واليقين في جميع أحوالهم وتركهم مع الله في التدبير، فعمل كل واحد بعمله في حاله، وقد كان بعض المتوكلين يقول: من لم يصبر على جوع ثلاثة أيام أخاف أن لا يسعه ترك العمل إذا وجده، وقال أيضاً: من فقد الأسباب فضعف قلبه، أو كان وجودها أسكن لقلبه من عدمها، لم يصح له القعود عن المكاسب لأن فيه انتظار لغير الله، وقال بعض العلماء: من طرقته فاقة تسعة أيام، فتصور في قلبه طمع في خلق أو استشراف إلى عبد، فالسوق أفضل له من المسجد، وقال أبو سليمان الداراني: لا خير في عبد لزم القعود في البيت وقلبه معلق بقرع الباب متى يطرق بسبب، وقال بعض علمائنا: إذا استوى عنده وجود السبب وعدمه، وكان قلبه ساكناً مطمئناً عند العدم، لم يشغله ذلك عن الله تعالى، ولم يتفرق همّه، فترك التكسب والقعود لهذا، أفضل لشغله بحاله وتزودّه لمعاده، وقد صح له مقام في التوكل، وقال سهل وقد سئل: متى يصح للعبد التوكل؟ فقال: إذا دخل عليه الضرّ في جسده، والنقص في ماله، فلم يلتفت إليه ولم يحزن عليه شغلاً بحاله وينظر إلى قيام الله عليه، وقال إبراهيم الخوّاص وهو إمام المتوكلين: من المتأخرين: ثلاثة مواطن حمل الزاد فيهن من آداب التوكل: القعود في المسجد والركوب في سفينة وصحبه القافلة، وقال سفيان الثوري: العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلاً للظلمة، والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة كان سفيراً للفساق، وقال بعض أهل المعرفة: الناس ثلاثة، رجل شغله معاده عن معاشه فهذه درجة
الفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك حال الناجين، وآخر شغله معاشه عن معاده فهذه صفة الهالكين. لفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك حال الناجين، وآخر شغله معاشه عن معاده فهذه صفة الهالكين.
وروينا عن عليّ رضي الله عنه الرزق رزقان: رزق يطلبك ورزق تطلبه، ففسره بعض العلماء فقال: الرزق الذي يطلبك هو رزق الغذاء، والرزق الذي تطلبه رزق التمليك، وهو طلب فضول القوت، وقال أبو يعقوب السوسي وقد كان له مقام مكين في التوكل: التوكل على ثلاثة مقامات، عام وخاص عام وخاص خاص، فمن دخل في الأسباب واستعمل العلم وتوكل على الله تعالى ولم يتحقق باليقين فهو عام، ومن ترك الأسباب وتوكل على الله وحقق في اليقين فهو خاص عام، ومن خرج من الأسباب على حقيقته لوجود اليقين، ثم دخل في الأسباب فتصرف لغيره فهذا خاص خاص، وهذا وصف الطبقة العليا من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشرة وغيرهم، جودهم اليقين من الدنيا فأدخلهم العلم في الأسباب لغيرهم ردت عليهم أحوال الغير، واتسعوا بالعلم على حقيقة اليقين، ولذلك كان الخواص رحمه الله تعالى يقول: دخول الخصوص في الأسباب لغيرهم ردت عليهم أحوال الغير وجعلوا رازقين لهم، فتصرفوا فيها لأجلهم وهم بريئون من التعلق بها، وقد كان أبو جعفر الحداد شيخ الجنيد أحد المتوكلين وقال: أخفيت التوكل عشرين سنة ولا فارقت السوق، أكتسب في كل يوم ديناراً وعشرة دراهم، أبيت منه دانقاً ولا أستريح فيه إلى قيراط، أدخل به الحمام بل أخرجه كله قبل الليل، وكان الجنيد لا يتكلم في التوكل بحضرة أبي جعفر يقول: أستحي من الله أن أتكلم في مقامه وهو حاضر، وقد شرط النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للعطاء ترك المسألة والاستشراف تنزيهاً للفقراء ورداً لهم إلى الله تعالى، لأن في مسألة العبد الفقير ذلاً ذليلاً وحرصاً على الدنيا جليلاً، وفي الاستشراف إلى العبيد طمع في غير مطمع، ونظر إلى غير الله، وإتيان البيوت من غير أبوابها، ومنه ماروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن فتح علىه نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، فكان الفقراء الصادقين جعل لهم أخذ العطاء، بل ندبوا إلى قبوله عوضاً لهم من ذلك لما منعوا من الاستشراف والسؤال تنزيهاً لهم وتفضيلاً، فمثلهم في ذلك مثل أهل البيت جعل لهم خمس الخمس من الغنائم لما حرمت عليهم الصدقة تفضيلاً لهم وتشريفاً، وقد كان أحمد بن حنبل رحمه الله أمر أبا بكر المروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئاً فيه فضل عمّا كان استأجره عليه فرده، فلما ولّي قال له أحمد: ألحقه فادفعه فإنه يأخذه قال: فلحقه المروزي فدفعه إليه فأخذ، فسأل أحمد عن ذلك: كيف رد في الأوّل وأخذ في الثاني؟ فقال: إنه كان قد استشرف لذلك فرده، وقد أحسن فلما انصرف أيست نفسه منه فلذلك قبل، وقد كان الخوّاص إذا نظر إلى عبد في العطاء أو خاف اعتياد النفس له، لم يقبل منه شيئاً، وكان يقول: صوفي لا يكون بحريف، وهذا كله يحسن في حال المنفرد، فأما ذو العيال فالأمر عليه واسع من ذلك، ولابأس أن يأخذ لعياله كما أخذ لأجل غيره من الناس، لأن عياله عيال الله عنده، قد وكله بهم وأجرى أرزاقهم على يده، فإن طلب لهم وحث على استخراج حقهم ممّا أوجب الله لهم لم ينقص ذلك من حاله، وآخى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد: أشاطرك مالي وأهلي، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فعمل يومه ذلك فراح بشيء من سمن وأقط، فلو كان التكسب في الأسواق ينقص التوكل لم يختر عبد الرحمن وهو إمام الأئمة ما ينقص توكله، ولكنه أحب إدخال المشقة على نفسه وكره التنعم، كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: إياك والتنعم؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، ورؤي فضالة بن عبيد أشعث أغبر جافياً وهو أمير مصر، فقيل له: لِمَ أنت هكذا؟ فقال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهانا عن الإرفاه وأمرنا أن نحتفي أحياناً، ثم اختار عبد الرحمن أيضاً إيثار أخيه بما أبره به رعاية لحق إخوته ولأن الله تعالى قد ندب إلى الإيثار ووصف به الأحباب، وأعلى من عبد الرحمن مقاماً إمام الأئمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما بويع بالخلافة أخذ الأثواب تحت حضنه ودخل السوق ينادي: هذا في أتم أحواله، حين أهل للخلافة وأقيم مقام النبوّة، حتى اجتمع المسلمون فكرهوا له ذلك فقال: لا
تشغلوني عن عيالي، فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع، حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين، لا وكس ولا شطط فلما رضوا جميعاً بذلك وأنفقوا عليه، ترك السوق لشغله بهم وبأمورهم؛ ألا تراه كيف آثر القيام بحقه وما أوجب الله عليه لأهله، وتواضع لله في حال رفعته، وأسقط الخلق عن عينه، حتى كره المسلمون ذلك فتركه بحكم ثان، فكذلك التوكل لا يزال مع الحكم الأوّل، حتى ينهج الله له طريقاً آخر فيسلكه بطريق ثان، وقد كان بعض علماء السلف يجمع إليه الناس للكلام عليهم فكان يقول: لو أعلم أنّ أهلي يحتاجون إلى باقة بقل ما تكلمت عليكم، ففي هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء في إنكار التكسب على أهل التوكل احتجاجاً لنفسه واعتذاراً من بطالته، ولا يسع العلماء في الدين إلاّ البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان، فالتكسب والأسباب طرق أودعها الله العطاء والأرزاق لا هي تعطى وترزق بمنزلة الأواسط من الأشخاص، فالمتوكل المتسبب موقن أنّ الله سبحانه هو المعطي والمانع، وأنه هو المسبب الرازق، وأنّه هو الأوّل في التصريف والآخر في التقليب، فقلته ناظر إلى القسام، ونفسه ساكنة إلى القسم، وقلبه قانع راضٍ بالمقسوم، وجسمه متحرك في المعلوم الذي وجه فيه وسبب له، وهو عارف بمقامه، وبالمراد منه، راضٍ بحاله وما قد استسعى فيه وألزم إياه، والذي ينقص المتوكل، ويخرجه من حد التوكل، اكتساب الشبهات للاستكثار، أو السعي بالتكسب للجمع والافتخار، أو الحرص على طلب ما حظره العلم عليه أو لطلب ما يكره المنال منه، أو التسخط للأقدار إذا لم تؤاته على ماقدر، أو ترك لنصح لمن عامله بأن يحتال عليه، أو يدبر أو التشرف إلى الخلق أو الطمع في سبب؛ فهذا كله لا يصح معه التوكل، وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل السوق للتكسب فكان درهمه أحب إليه من درهم غيره، لم ينصح للمسلمين في المبايعة، وهذا عنده يخرجه من التوكل ودخول الآفات ومساكنتها، لقصور علم أو غلبة هوى يخرج العبد من التوكل، وهو أن يكون متوكلاً على الناس بأن يطمع فيهم، أو يتصدى لهم بالتعرض والتصنع، أو يكون متوكلاً على صحة جسمه ودوام عوافيه وأنه لا يرزق إلاّ من كدّه، أو يكون متوكلاً على ماله بأن يثق به ويطمئن إليه ويحسب أنه إن افتقر انقطع رزقه، وعلامة ذلك ضنته به وإعداده له؛ عدة لكذا وعدة لكذا، فهذه المعاني تخرج من التوكل، فقد تخفي دقائقها وتدق حقائقها إلاّ على جهابذة العلماء الرابحين في العلم، المتضلعين باليقين، القائمين على الدوام بالشهادة؛ فمن نظر إلى هذه المعاني من الأسباب والأشخاص أو سكن إليها سكون أنس، فيقوى قلبه بوجودها فإنه يضطرب ويستوحش أو يضعف قلبه لفقدها فهي علة في توكله. عن عيالي، فإني إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع، حتى فرضوا له قوت أهل بيت من المسلمين، لا وكس ولا شطط فلما رضوا جميعاً بذلك وأنفقوا عليه، ترك السوق لشغله بهم وبأمورهم؛ ألا تراه كيف آثر القيام بحقه وما أوجب الله عليه لأهله، وتواضع لله في حال رفعته، وأسقط الخلق عن عينه، حتى كره المسلمون ذلك فتركه بحكم ثان، فكذلك التوكل لا يزال مع الحكم الأوّل، حتى ينهج الله له طريقاً آخر فيسلكه بطريق ثان، وقد كان بعض علماء السلف يجمع إليه الناس للكلام عليهم فكان يقول: لو أعلم أنّ أهلي يحتاجون إلى باقة بقل ما تكلمت عليكم، ففي هذا بيان وبرهان لمن لم تستهوه الأهواء في إنكار التكسب على أهل التوكل احتجاجاً لنفسه واعتذاراً من بطالته، ولا يسع العلماء في الدين إلاّ البيان وكشف حقيقة العلم بالبرهان، فالتكسب والأسباب طرق أودعها الله العطاء والأرزاق لا هي تعطى وترزق بمنزلة الأواسط من الأشخاص، فالمتوكل المتسبب موقن أنّ الله سبحانه هو المعطي والمانع، وأنه هو المسبب الرازق، وأنّه هو الأوّل في التصريف والآخر في التقليب، فقلته ناظر إلى القسام، ونفسه ساكنة إلى القسم، وقلبه قانع راضٍ بالمقسوم، وجسمه متحرك في المعلوم الذي وجه فيه وسبب له، وهو عارف بمقامه، وبالمراد منه، راضٍ بحاله وما قد استسعى فيه وألزم إياه، والذي ينقص المتوكل، ويخرجه من حد التوكل، اكتساب الشبهات للاستكثار، أو السعي بالتكسب للجمع والافتخار، أو الحرص على طلب ما حظره العلم عليه أو لطلب ما يكره المنال منه، أو التسخط للأقدار إذا لم تؤاته على ماقدر، أو ترك لنصح لمن عامله بأن يحتال عليه، أو يدبر أو التشرف إلى الخلق أو الطمع في سبب؛ فهذا كله لا يصح معه التوكل، وقد قال بعض العلماء: إن العبد إذا دخل السوق للتكسب فكان درهمه أحب إليه من درهم غيره، لم ينصح للمسلمين في المبايعة، وهذا عنده يخرجه من التوكل ودخول الآفات ومساكنتها، لقصور علم أو غلبة هوى يخرج العبد من التوكل، وهو أن يكون متوكلاً على الناس بأن يطمع فيهم، أو يتصدى لهم بالتعرض والتصنع، أو يكون متوكلاً على صحة جسمه ودوام عوافيه وأنه لا يرزق إلاّ من كدّه، أو يكون متوكلاً على ماله بأن يثق به ويطمئن إليه ويحسب أنه إن افتقر انقطع رزقه، وعلامة ذلك ضنته به وإعداده له؛ عدة لكذا وعدة لكذا، فهذه المعاني تخرج من التوكل، فقد تخفي دقائقها وتدق حقائقها إلاّ على جهابذة العلماء الرابحين في العلم، المتضلعين باليقين، القائمين على الدوام بالشهادة؛ فمن نظر إلى هذه المعاني من الأسباب والأشخاص أو سكن إليها سكون أنس، فيقوى قلبه بوجودها فإنه يضطرب ويستوحش أو يضعف قلبه لفقدها فهي علة في توكله.
وروينا عن بشر بن الحرث قال: إنّ العبد ليقرأ، إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله تعالى: كذبت، ما إياي تعبد ولا بي تستعين؛ لو كنت تعبد إياي لم تؤثر هواك على رضاي، ولو كنت بي تستعين لم تسكن إلى حولك ولا قوتك ولا إلى مالك ونفسك، وإنّ التارك للتكسب والتصرف في الأسواق إذا كان في أدنى كفاية وأعين بالصبر والقناعة، في مثل زماننا هذا أفضل وأتم حالاً من المتكسب إذا خاف أن لا ينال المعيشة إلاّ بمعصية الله من دخوله في شبهة عياناً أو خيانة لإخوانه المسلمين، ولأنه قد تعذر القيام بشرائط العلم مع مباشرة الأسباب وكثرة دخول الآفات والفساد في الاكتساب، فترك ملابسة أهل الأسواق ومخالطتهم على هذا الوصف المكروه أقرب إلى السلامة لبعده من رؤية الأشياء، وفقده مباشرتها، لأن الحكم متعلق بالرؤية، ومثل الحرام مثل المنكر إذا لم تره سقط عنك حكمه، وليس الخبر كالمعاينة ولا المجاورة كالمباشرة ولا المعاين كالمخبر، وذلك كخبر من زلّ عن حقيقة الكعبة على البعد إلا أنّه متوجه إلى الشطر، فصلاته جائزة ولو زلّ عنه أنملة مع المعاينة لها بطلت صلاته، والتكسب ليس بفرض وقد يفترض بأحد معنيين بوجود العيال وعدم كفايتهم من وجه من الوجوه المباحة، أو بأن يقطع عدمه عن فرض ويضعف عنه مع فقد ما يقام به الفرض مما لابدّ منه، وقد كان بشر بن الحرث ترك التكسب، وكان يتكلم في الحلال ويشدد فيه فقيل له: ياأبا نصر، فأنت من أين تأكل؟ فقال: من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل وهو يضحك، وقال مرة: ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، وقد كان للثوري خمسون ديناراً يتجر له بها، ثم أخذها في آخر أمره ففرقها على إخوانه وترك التكسب، ويقال إنّه فعل ذلك لمّا مات عياله، وليس للعبد أن يحمل حال عياله على حاله إلاّ أن يكون اختيارهم كاختياره، وصبرهم على فقرهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته، فجائز حينئذٍ أن يسير بهم سيريه، ويسقط عنه التكسب لأجلهم، لأنهم كهو في الحال مع سقوط المطالبة منهم بحقوقهم عليه، وقد فعل ذلك جماعة من السلف، وبعض العارفين يفضلون من لا معلوم له على من له معلوم، وهم لا يرون ترك التكسب أفضل لأنه معلوم، ويعد هؤلاء سكون القلب مع وجود المعلوم علة، ولكن إذا سكن قلبه مع غير معلوم، واجتمع همه وانقطع طمعه في حال المعدوم؛ فهذا هو المقام وتفصيل هذا في التوسط من المقال عندي والله أعلم أنّ العبد لا يفضل بنفس عدم المعلوم، كما لا يفضل بنفس القعود عن المكاسب، وإنما يفضل بحاله من مقامه؛ فإذا كان ذو المعلوم أحسن معرفةً وأقوى يقيناً، فضل على من لامعلوم له، ولا يكون سكون القلب وطمأنينة النفس أيضاً مع وجود المعلوم علة في الحال على قدر المقام، ولكن لا يكون مقاماً يرفع به ولا حالاً يفضل فيه، إلا أنّ الطمع في الخلق وتشتت القلب مع وجود معلوم الكفاءة نقصان عند الكل وعندي، وقطع الطمع في الخلق واجتماع القلب مع العدم أفضل وأعلى درجة عند الجماعة.
وفي حديث حية وسوار ابني خالد أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهما: لاتيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإنّ ابن آدم تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله بعد، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للرجل الذي ناوله التمرة لو لم تأتها لأتتك، ويقال إنّ العبد لو هرب من رزقه لأدركه كما لو هرب من الموت لأدركه الموت، وأنّ الرزق لا ينقطع عن العبد حتى يظهر له ملك الموت، فحينئذٍ ينقطع عنه رزق الدنيا ويدخل في رزق الآخرة، فيكون أوّل رزق الآخرة آخر رزق الدنيا ولا آخر لهذا الرزق، وقال سهل بن عبد الله الدستوائي: لو أن العبد سأل الله أن لا يرزقه لم يستجب له ولقال له: ياجاهل، أنا خلقتك ولا بدّ من أن أرزقك أبداً، وقال وقد سئل عن القوت فقال: هو الحي الذي لا يموت فقيل: إنما سألتك عن القوام، فقال: القوام هو العلم، قيل: سألناك عن الغذاء، فقال: الغذاء هو الذكر، قيل: سألناك عن طعمة الجسد، فقال: مالك وللجسد، دع من تولاه أولاً يتولاه آخراً، إذا دخل عليه علّة فرده إلى صانعه؛ أما رأيت الصنعة إذا عابت ردوها إلى صانعها حتى يصلحها، وقال الخوّاص وقد روينا عن سهل: إن الله تعالى يلقي على الخصوص الفاقة ويحوجهم إلى الخلق بالطمع فيهم، ويلقي في قلوب الخلق المنع لهم فيحرمهم ما في أيديهم ليردهم إليه فإذا رجعوا إليه آيسين منقادين رزقهم من حيث لا يحتسبون، ومن علامة الخصوص أنهم إذا استشرفوا إلى شيء حرموا ذلك الشيء وإذا سكنوا إلى عبد سلّط عليهم ليرفع سكونهم إليه، وقد كان بعضهم إذا جاءه السبب بعد تطلعٍ إليه ردّه، ومنهم من كان يخرجه ولا يتناول منه عقوبةً لنفسه، وكان ذو النون المصري يتكلم على إخوانه في علم التوحيد والمعرفة فسأله غلام شاب عن الخبز: من أين هو؟ فقال: خذوا بيده واذهبوا به إلى الصوفية حتى يعلّموه الأدب، وقد حكي عن معروف أبي محفوظ الكرخي أنه ذكر له انقباض بشر عن الأسباب التي تفتتح له فقال: إنّ أخي بشراً قبضه الورع، وأنا نشطتني المعرفة، إلاّ أن معروفاً كان لا يأخذ السبب إلا عند الحاجة، ويأخذ منه ما لا بدّ له منه، وكان لايدّخر، وكان قصير الأمل لم يكن يأمل البقاء من وقت صلاة إلى صلاة أخرى؛ كان إذا صلى الظهر يقول للجيران: اطلبوا؟ لكم من يصلّي صلاة العصر، وكان يقول: إنما أنا ضيف في دار مولاي إن أطعمني أكلت متى أطعمني، وإن أجاعني صبرت حتى يطعمني، وقد كان أبو محمد سهل يقول: المتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يحتكر.
ذكر الادخار مع التوكّل
ولا يضرّ الادخار مع صحة التوكل إذا كان مدخراً لله وفيه، وكان ماله موقوفاً على رضا مولاه لا مدخراً لحظوظ نفسه وهواه، فهو حينئذ مدخراً لحقوق الله التي أوجبها عليه، فإذا رآها بذل ماله فيها، والقيام بحقوق الله لا ينقص مقامات العبد بل يزيدها علوّاً، وحدثونا عن بعض أصحاب بشر بن الحرث قال: كنت عنده ضحوة من النهار، فدخل عليه كهل أسمر خفيف العارضين، فقام إليه بشر قال: وما رأيته قام لأحد غيره قال: ودفع إليّ كفّاً من دراهم فقال: اشتر لنا من أطيب ما تقدر عليه من الطعام والطيب، قال: وما قال لي قط مثل ذلك، قال: فجئت بالطعام فوضعته بين يديه، فأكل معه، وما رأيته أكل مع غيره، قال: فأكلنا حاجتنا وبقي من الطعام شيء كثير، فأخذه الرجل فجمعه في ثوبه فجعله تحت يده وانصرف قال: فعجبت من فعله ذلك وكرهته له إذ لم يأمره بشر بذلك ولا هو استأذنه فيه، فقال لي بشر بعد ذلك: لعلك أنكرت فعله ذلك، قلت: نعم، أخذ بقية الطعام من غير إذن، فقال: تعرفه؟ قلت لا، قال: ذلك أخونا فتح الموصلي، زارنا اليوم من الموصل، وإنما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا صح لم يضر معه الادخار، وترك الادخار إنما هو حال من مقامه قصر الأمل، وقد يصح التوكل مع تأميل البقاء، فإن كان أمله للحياة لطاعة مولاه وخدمته والجهاد في سبيل الله فضل ذلك، وهذا طريق طائفة من الراجين والمستأنسين، وإن كان أمله للحياة لأجل متعة نفسه، وأخذ حظوظها من دنياه، نقص ذلك من زهده في الدنيا، فسرى النقص إلى توكله، وما نقص من الزهد نقص من التوكل بحسابه، وليس ما زاد في الزهد يزيد في التوكل بحسابه، لأنّ الزهد من شرط خصوص التوكل، وليس التوكل من شرط عموم الزهد، فكل متوكل ذي مقام زاهد لا محالة، وليس كل زاهد في مقام متوكلاً لأن التوكل مقام والزهد حال، والمقامات للمقربين والأحوال في أصحاب اليمين إلاّ أنّ من أعطى حقيقة الزهد فإنه يعطي التوكل لا محالة، لأنّ حقائق الأحوال وثبوتها، ودوام استقامة أهلها فيها، ولزومها لقلوبهم هي مقامات؛ فإذا جاز للمتوكل تأميل البقاء لشهر أو شهرين جاز له الادخار لذلك، إلاّ أنّ طول الأمل يخرج من حقيقة التوكل عند الخواص ولا يخرجه من حده عندي، وأكره للمتوكل الادخار لأكثر من أربعين يوماً، كما يكره تأميل البقاء لأكثر من أربعين، ومن ادّخر لصلاح قلبه وتسكين نفسه وقطع تشرفه إلى الناس؛ إن كان مقامه السكون مع المعلوم، فالادخار له أفضل، فأما من ادّخر لعياله لتسكن قلوبهم ولوجود رضاهم عن الله، ولسقوط حكمهم عنه ليتفرغ لعبادة ربه، فهو فاضل في ادخاره اتفقوا عليه، ولأنّه في ذلك قائم بحكم ربه راعٍ لرعيته التي هو مسؤول عنها، وقد ادّخر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعياله قوت سنة ليسن ذلك، وقد نهي أم أيمن وغيرها أن تدّخر شيئاً لغد، ونهى بلالاً أيضاً عن الادخار ليقتدي به أهل المقامات في ذلك، كما روي أنه قبض صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وله بردان في الحف ينسحبان، وقد كان عليه السلام أقصر أملاً من ذلك، كان يبول فيتيمم قبل أن يصل إلى الماء، فيقال له في ذلك إنّ الماء منك قريب، فقال: وما يدريني لعلّي لا أبلغه، ولكن فعله لئلا يهلك من طال أمله من أمته، فجعل فعله نجاة له، فهذا يدلك أن الادخار يتسع ويضيق على قدر مشاهدات العارفين، من قبل أن الشريعة جاءت بالرخصة والعزيمة؛ فالعزائم من الدين للأقوياء الحاملين، والرخص من الدنيا للضعفاء المخمولين، وقد كان الخوّاص يدقق في أحوال التوكل ويذكر أن الادخار يخرج من حد التوكل، ولم يكن يفارقه أربعة أشياء، وكان يقول: ادخارها من تمام حال المتوكل لأنها من أمور الدين؛ الركوة والحبل والإبرة والخيوط والمقراض، وكان سهل يضرب لمدّخر مثلاً في قصر الأمل وطوله فيقول: مثل من يترك الادخار مثل رجل يقول: أريد أن أخرج إلى الأيلة فيقال له: خذ رغيفاً فإن قال: أريد أن أخرج إلى عبادان قيل له خذ رغيفين فإن قال: أريد أن أخرج إلى العسكر قيل له: خذ أربعة أرغفة قال: فكذلك ترك الادخار على قدر قصر الأمل وطوله، وأعجب ما سمعت في انقطاع الأمل ما حكي أنّ موسى والخضر اجتمعا، فشكا موسى إلى الخضر الجوع فقال: أقعد فقعد، فتكلم الخضر بشيء فأقبل ظبي مخيض حتى وقف بينهما، فوقع نصفين نصفه إلى الخضر مشويّاً ونصفه إلى موسى نيّئاً، فقال له الخضر: قم فاقدح
ناراً واشوِ نصيبك، وأخذ الخضر يأكل، ففعل ذلك موسى ثم سأله: لِمَ وقع نصفه إليك مشويّاً؟ فقال: إنه لم يبقَ لي في الدنيا أمل، وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقدار ما يمنع من حقيقة الزهد، وفي حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة في ذكر الفقير الذي أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليّاً وأسامة، فغسلاه وكفنه ببردته فلما دفنه قال لأصحابه: إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولولا خصلة كانت فيه لبعث وجهه كالشمس الضاحية فقلنا: وما هي يا رسول الله قال: إنه كان صوّاماً قوّاماً كثير الذكر لله، غير أنّه كان إذا جاءه الشتاء ادّخر حلّة الصيف لصيفه، وإذا جاءه الصيف ادّخر حلة الشتاء لشتائه من قابل، ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطى حظه منها لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار، وحدثونا عن بعض العارفين قال: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وكان الناس يساقون زمرة زمرة إلى الجنة على طبقات، قال: فنظرت إلى طبقة أحسن الناس هيئة، وأعلاهم مرتقى، وأسرعهم سبقاً، فقلت هذه أفضلهم، أكون فيهم قال: فذهبت لأخطو إليهم، وأدخل معهم في طريقهم، فإذا بملائكة حولهم قد منعوني، وقالوا: قف مكانك حتى يجيء أصحابك فتدخل معهم فقلت: تمنعوني أن أكون مع هؤلاء السابقين، فقالوا: هذا طريق لايسلكه إلاّ مَنْ لم يكن له إلاّ قميص واحد، ومن كل شيء واحد، وأنت لك قميصان ومن الأشياء زوجان، قال: فانتبهت باكياً حزيناً فجعلت على نفسي أن لا أملك من كل شيء إلا واحداً، وقد كان حذيفة المرعشي يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قيمصاً واحداً، وكان كثير من السلف إذا استجد ثوباً أو شيئاً أخرج الأوّل منهما، وكانوا يستعملون الشيء الواحد من الأشياء الكثيرة؛ وهذا كله داخل في التحقق بالزهد وهو من فضائل المتوكلين، والخبر المشهور أن رجلاً من أهل الصفة توفي فما وجدوا له كفناً، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فتشوا ثوبه قال فوجدنا داخل أزاره دينارين، فقال: كيتان، وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف عدة، فلا يقول له ذلك لأنّ هذا كان حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه الادخار. اً واشوِ نصيبك، وأخذ الخضر يأكل، ففعل ذلك موسى ثم سأله: لِمَ وقع نصفه إليك مشويّاً؟ فقال: إنه لم يبقَ لي في الدنيا أمل، وعلى ذلك فإن الادخار ينقص من فضائل الزاهدين بمقدار ما يمنع من حقيقة الزهد، وفي حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة في ذكر الفقير الذي أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليّاً وأسامة، فغسلاه وكفنه ببردته فلما دفنه قال لأصحابه: إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولولا خصلة كانت فيه لبعث وجهه كالشمس الضاحية فقلنا: وما هي يا رسول الله قال: إنه كان صوّاماً قوّاماً كثير الذكر لله، غير أنّه كان إذا جاءه الشتاء ادّخر حلّة الصيف لصيفه، وإذا جاءه الصيف ادّخر حلة الشتاء لشتائه من قابل، ثم قال: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطى حظه منها لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار، وحدثونا عن بعض العارفين قال: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وكان الناس يساقون زمرة زمرة إلى الجنة على طبقات، قال: فنظرت إلى طبقة أحسن الناس هيئة، وأعلاهم مرتقى، وأسرعهم سبقاً، فقلت هذه أفضلهم، أكون فيهم قال: فذهبت لأخطو إليهم، وأدخل معهم في طريقهم، فإذا بملائكة حولهم قد منعوني، وقالوا: قف مكانك حتى يجيء أصحابك فتدخل معهم فقلت: تمنعوني أن أكون مع هؤلاء السابقين، فقالوا: هذا طريق لايسلكه إلاّ مَنْ لم يكن له إلاّ قميص واحد، ومن كل شيء واحد، وأنت لك قميصان ومن الأشياء زوجان، قال: فانتبهت باكياً حزيناً فجعلت على نفسي أن لا أملك من كل شيء إلا واحداً، وقد كان حذيفة المرعشي يقول: منذ أربعين سنة لم أملك إلا قيمصاً واحداً، وكان كثير من السلف إذا استجد ثوباً أو شيئاً أخرج الأوّل منهما، وكانوا يستعملون الشيء الواحد من الأشياء الكثيرة؛ وهذا كله داخل في التحقق بالزهد وهو من فضائل المتوكلين، والخبر المشهور أن رجلاً من أهل الصفة توفي فما وجدوا له كفناً، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فتشوا ثوبه قال فوجدنا داخل أزاره دينارين، فقال: كيتان، وقد كان غيره من المسلمين يموت ويخلف عدة، فلا يقول له ذلك لأنّ هذا كان حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه الادخار.
ذكر التداوي وتركه للمتوكّل
وتفصيل ذلك ولا ينقص التداوي أيضاً توكل العبد لأنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به، وأخبر عن حكمة الله تعالى فيه فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما من داء إلاّ وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلاّ السأم يعني الموت، وقال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، وسئل عن الدواء والرقي، هل يرد من قدر؟ فقال: هي من قدر الله، وفي الخبر المشهور: ما مررت بملأ من الملائكة إلاّ قالوا: أمُرْ أمتك بالحجامة، وفي الحديث أنّه أمر بها فقال: احتجموا السبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، ولا يبيغ بكم الدم فيقتلكم، وفي ذكر تبيغ الدم دليل على توقيت هذا العدد من الأيام للحجامة، إلاّ أنّه أريد به هذه الأيام من الشهر، وأحسبه لأهل الحجاز خاصة لشدة حرّ البلد، كقول عمر رضي الله عنه في الماء المشمس أنه يورث البرص، سمعت أن ذلك في أرض الحجاز خاصة، وكان من سيرة السلف أن يحتجموا في كل شهر مرة إلى أن يجاوز الرجل الأربعين وكانوا يستحبون الحجامة في آخر الشهر، وقد يروى في خبر منقطع: من احتجم يوم الثلاِثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة، وقد روينا من طريق أهل البيت أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب دواء كل سنة، والتداوي رخصة وسعة، وتركه ضيق وعزيمة، والله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج: 78 أي ضيق، وربما كان المتداوي فاضلاً في ذلك لمعنيين: أحدهما أن ينوي اتباع السنة، والأخذ برخصة الله، وقبول ما جاءت به الحنيفية السمحة، وقد أمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير واحد من الصحابة بالتداوي والحمية، وقطع لبعضهم عرقاً، وكوى آخر، وقال لعلي رضي الله عنه، وكان رمد العين: لا تأكل من هذا يعني الرطب، وكل من هذا فإنه أوفق لك، يعني سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعير، وقد تداوى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير حديث من العقرب وغيرها، وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه فكان يغلفه بالحناء، وفي الخبر أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء: وهو أعلى المتوكلين، وأقوى الأقوياء، فإن قيل إنما تداوى لغيره، وليسن ذلك، قلنا: فلا نرغب عن سنّته، ولا نزهد في بغيته، إذا كان فعل ذلك لنا، لئلا يكون فعلاً لغواً، وتكون الرغبة عن سنته إلى توهم حقيقة التوكل طعناً في الشرع، وقد كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظاهرة للخلق ليقتفوا آثاره، من ذلك أنه صام في السفر في شدة الحرّ، فكان يصب على رأسه الماء، ويستظل بالشجر، ليسن بذلك الرخصة في التبرد بالماء للصائم، فقيل له: إن قوماً صاموا وقد شق عليهم، فدعا بقدح فيه ماء فشرب، فأفطر الناس فترك حاله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأجلهم، فقيل له: إنّ قوماً لم يفطروا فقال: أولئك العصاة، والمعنى الثاني الذي يفضل به المتداوي، أنّه يحب سرعة البرء للطاعة ولخدمة مولاه، والسعي في أوامره، إذ كانت العلل قاطعة عن التصرف في العمل ومشغلة للنفس عن الشغل بالآخرة، وذكر بعض علمائنا أنّ موسى عليه السلام اعتلّ علّة، فدخل عليه بنو إسرائيل، فعرفوا علّته، فقالوا: لو تداويت بكذا لبرأت، فقال: لا أتداوى حتى يعافيني هو من غير دواء، قال: فطالت علّته، فقالوا له: إنّ دواء هذه العلّة معروف مجرب وإن تتداوَ به تبرأ، فقال: لا أتداوى، فدامت علتّه، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: وعزّتي لا أبرأتك حتى تتداوى بما ذكروه لك، فقال لهم: داووني بما ذكرتم فداووه، فبرأ فأوجس في نفسه من ذلك، فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمتي لتوكلك على من أودع العقاقير منافع الأشياء، وفي بعض الأخبار: شكا نبي من الأنبياء إلى الله علّة يجدها، فأوحى الله إليه: كل البيض، وفي خبر آخر إنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الضعف فأوحى الله إليه: كل اللحم باللبن فإنّ فيهما القوّة، قال الشيخ أحسبه الضعف عن الجماع، وذكر وهب بن منبه أنّ ملكاً من الملوك اعتلّ علّة وكان حسن السيرة في أهل مملكته، فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قل له: اشرب ماء التين فإنه شفاء من علّتك، وقد روينا أعجب من ذلك أنّ قوماً شكوا إلى نبيهم قبح أولادهم، فأوحى الله تعالى إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل، فإنه يحسن الولد
فقد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء الرطب، وهذا والله أعلم يكون في الشهر الثالث والرابع من حملها، وعلى ذلك كله فإنّ ترك التداوي أفضل للأقوياء، وهو من عزائم الدين، وطريقة أولي العزم من الصدّيقين، لأن في الدين طريقين: طريق تبتل وعزيمة، وطريق توسع ورخصة، فمن قوي سلك الطريق الأشد فهو أقرب وأعلى، وهذه للمقربين وهم السابقون، ومن ضعف سلك الطريق الأرفه وهو الأوسط إلا أنه أبعد، وهو لأصحاب اليمين وهم المقتصدون، وفي المؤمنين أقوياء وضعفاء ولينون وأشداء. قد كانوا يطعمون الحبالى السفرجل والنفساء الرطب، وهذا والله أعلم يكون في الشهر الثالث والرابع من حملها، وعلى ذلك كله فإنّ ترك التداوي أفضل للأقوياء، وهو من عزائم الدين، وطريقة أولي العزم من الصدّيقين، لأن في الدين طريقين: طريق تبتل وعزيمة، وطريق توسع ورخصة، فمن قوي سلك الطريق الأشد فهو أقرب وأعلى، وهذه للمقربين وهم السابقون، ومن ضعف سلك الطريق الأرفه وهو الأوسط إلا أنه أبعد، وهو لأصحاب اليمين وهم المقتصدون، وفي المؤمنين أقوياء وضعفاء ولينون وأشداء.
وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وروي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في المؤمنين من هو أشدّ في الله عزّ وجلّ من الحجارة، وفيهم من هو ألين من اللبن، وقال في وصف الأقوياء: مثل المؤمن كمثل النخلة لايسقط ورقها، وقال الله تعالى في معنى ذلك: (أصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَهَا فِي السَّماء) إبراهيم: 24 وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مثل المؤمن كمثل السنبلة تفيئها الرياح يميناً وشمالاً، وقال عليه السلام في وصفة المؤمن المطعم مثل المؤمن؛ كمثل النخلة أكلت طيباً ووضعت طيباً، وقال في وصف المستطعم: مثل المؤمن كمثل النملة تجمع في صيفها لشتائها، فأوصاف المؤمنين متفاوتة في الضعف والقوّة، وفي الجبن والشجاعة، وفي الصبر والجزع فشتان بين من شبه في القوّة والعلو بالنخلة؛ قلبه ثابت، وهمه في السماء، يطعم جناه ولا يدّخر، إلى من شبه بالنملة في الضعف والذي يستطعم ويحتكر، وقد فضل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوماً ومدحهم أنهم لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، وذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب، فعلل بالتوكل وأخبر أنهم تركوا ذلك توكلاً، ثم سأله عكاشة أن يدعو الله أن يجعله منهم، ففعل، لأنه رأى ذلك طريقه ورأى معه زاده، وشهد فيه القوّة فأهله لذلك، فلما قال له الآخر: ادع الله أن يجعلني منهم، والمقامات لا يقتدى بها ولا يتمثل فيها، كما لا تدعى، لأنها مواجيد قلوب باتحاد قريب ومشاهدات غيوب بإشهاد حبيب، فلما لم يرَ ذلك طريقه ولم يشهد معه زاده لم يؤهله لذلك، فأوقفه على حده وحكم عليه بضعفه، فرده ردَّاً جميلاً، لأنه كان حبيباً كريماً، فقال: سبقك بها عكاشة، فهذا كما يقول الحاكم الحكيم: إذا ضعف أحد الشاهدين زدني شاهداً آخر، ولا يصرح بجرح الشاهد ولو عدله لقبله، ولم يطلب الزيادة، وإلاّ فالمقامات لا تضيق لمن سبق إليها، والرسول غير بخيل مع قوله تعالى شاهداً له: (وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) التكوير: 42، ولكن لم يرَ فيه شاهد ذلك من القوّة، وتبين فيه الضعف عن الحمل فلم يخاطر به، وقد نهى عن الكي في غير حديث وقال لرجل أراد أن يداوي أخاه إلاّ أنه مات من علّته، فقال: أما لو برأ لقلت برأته لعلمه بما يهجس في بعض النفوس أنّ الشفاء والنفع من فعل الدواء، وذلك من الشرك فكره المحققون بالتوحيد التداوي خشية دخول ذلك عليهم.
وروي عن موسى عليه السلام: يارب ممن الدواء والشفاء؟ قال: مني، قال: فما يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم، ويطيبون نفوس عبادي، حتى يأتي شفائي أو قبضي، وقد كان ابن حنبل يقول: أحبّ لمن اعتقد التوكل، وسلك هذا الطريق ترك التداوي من الأشربة وغيرها، واعتلّ عمران بن حصين فأشاروا عليه أن يكتوي فامتنع، فلم يزالوا به، وعزم عليه زياد بذلك، وكان أميراً حتى اكتوى، فكان يقول: كنت أرى نوراً، وأسمع صوتاً، وأسمع تسليم الملائكة عليّ، فلما اكتويت انقطع ذلك عني، وفي خبر كانت الملائكة تزوره فيأنس بها حتى اكتوى، فكان يقول: اكتوينا كيات، فوالله ما أفلحنا ولا أنجحنا، ثم ناب من ذلك، وأناب إلى الله تعالى، فرد الله عليه ما كان يجد من أمر الملائكة، وقال لمطرف بن عبد الله: ألم ترَ أنّ الكرامة التي كان أكرمني الله بها قد ردها علّي؟ بعد أن كان أخبره بفقدها، فلولا أنّ ذلك كان عنده ذنباً له، لما ندم عليه وتاب منه، ولولا أنّ ذلك كان نقصاً ما صرفت الملائكة عنه، ومرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقيل له: لودعونا لك طبيباً، فقال: قد نظر إليّ الطبيب، فقال: إني فعال لما أريد، وقيل لأبي الدرداء في مرضه: ما تشتكي؟ قال ذنوبي، قيل: فما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي، قيل: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني، وقيل لأبي ذر وقد رمدت عيناه: لو داويتهما، فقال: إني عنهما لمشغول، قيل: فلو سألت الله أن يعافيك، فقال: أسأله فيما هو أهم إليّ منهما، وقيل لأبي محمد: متى يصح لعبد التوكل؟ قال: إذا دخل عليه الضر في جسمه، والنقص في ماله، فلم يلتفت إليه شغلاً بحاله للنظر إلى قيام الله عليه، وقد كان أصاب الربيع بن خيتم الفالج، فقيل له: لو تداويت فقال: قد هممت، ثم ذكرت عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم الأوجاع، وكانت فيهم الأطباء، فهلك المداوي والمداوى ولم تغن الرقي شيئاً، وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج فعطل عن القيام، فسأل الله أن يطلقه في أوقات الصلاة ثم يرده إلى حاله بعد ذلك، فكان إذا جاء وقت الصلاة فكأنما أنشط من عقال، فإذا قضى الصلاة رجع إليه الفالج وكما كان قبل ذلك، ومن لم يتداوَ من الصدّيقين والسلف الصالح أكثر من أن يحصى، إلا أنه مخصوص لمخصوصين؛ ألم ترَ أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكر السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ثم وصفهم بأنهم لا يكتوون، ولا يسترقون، فقام إليه عكاشة بن محصن الأسدي فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا له، فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة، فلم يمنعه من الدعاء بخلاً عليه، إلاّ أنّ طريق الخصوص الأقوياء لا يسلكه العموم الضعفاء، كما أنّ طريق العموم قد زهد فيه الخصوص.
وأعجب ماسمعت قال بعض العارفين: أصفى ما أكون قلباً إذا كنت محموماً، أو من مواجيد العارفين ما حكي لنا أن موسى والخضر عليهما السلام اجتمعا في فلاة من الأرض، فشكا موسى إلى الخضر الجوع فقال له الخضر: اجلس بنا حتى ندعو، فتكلم الخضر بشيء، فأقبل ظبي حتى وقع بينهما نصفين: نصفه إلى الخضر مشويّاً ونصفه إلى موسى نيّئاً، فقال له الخضر: قم فاحمل هموماً كما حملت همومها، فأوقد ناراً واشو نصيبك وكل، قال: فقدح موسى ناراً وأشعل حطباً وسوّى نصيبه، فلما فرغ قال للخضر: كيف وقع نصفه إليك مشويّاً؟ قال: إنه لم يبقَ لي في الدنيا أمل، وقيل عنه أيضاً مرة أخرى: إنه ليس لي في هذه الخلق حاجة، وقد كان مذهب سهل أن ترك التداوي، وأن أضعف عن الطاعات، وقصر عن الفرائض أفضل من التداوي لأجل الطاعات، وكانت به علّة فلم يكن يتداوى منها، وقد كان يداوي الناس منها، وكان إذا رأى العبد يصلّي من قعود، أو لا يستطيع أعمال البرّ من الأمراض، فيتداوى للقيام في الصلاة، والنهوض إلى الطاعة، يعجب من ذلك ويقول: صلاته من قعود مع رضاه بحاله أفضل له من التداوي للقوة، ويصلّي من قيام، وسئل عن شرب الدواء فقال: كلّ من دخل إلى شيء من الدواء فإنما هو سعة من الله لأهل الضعف، ومن لم يدخل في شيء منه فهو أفضل، لأنه إن أخذ شيئاً من الدواء ولو كان الماء البارد سئل عنه: لِمَ أخذت؟ ومن لم يأخذ فليس عليه سؤال، وقال: مَنْ لم يأخذ الماء البارد فليس عليه سؤال، وقال: مَنْ يأخذ الماء البارد على سبيل الدواء سئل، وأصله في هذا أنّ عنده من أفضل الأعمال أن يضعف العبد قوّته، حتى لا يكون لنفسه حراك لأجل الله تعالى، وإنّ ذرّة من أعمال القلوب؛ مثل التوكل والرضا والصبر أفضل من أعمال جبال من عمل الجوارح، وهذا مذهب البصريين في إسقاط القوّة بالتجوع الطويل والطي الكثير لتضعف النفس، لأنّ عندهم أن في قوة النفس قوة الشهوات وغلبة الصفات، وفي ذلك وجود المعاصي وكثرة الهوى وطول الرغبة والحرص على الدنيا وحب البقاء، يقول: إذا أدخل الله عليها الأمراض من حيث لا تحتسب، فلا يتعالج لرفع الأمراض عنها، فإنّ لامرض من نهاية الضعف ومن أبلغ ما ينقص به الشهوة، وقد كان يقول: علل الأحسام رحمة وعلل القلوب عقوبة، وقال مرة: أمراض الجسم للصدّيقين، وقد كان ابن مسعود يقول: تجد المؤمن أصح شيء قلباً وأمرضه جسماً، وتجد المنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباً، وعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تحبون أن تكونوا كالحمر الصيالة؛ لا تمرضون ولا تسقمون، وقد قيل: لا يخلوا المؤمن من علّة في جسمه أو قلة في ماله، وقيل: لا يخلو من غلبة أو ذلة، وللعبد إن لم يتداوَ أعمال حسنة؛ منها أن ينوي الصبر على بلاء الله تعالى، والرضا بقضائه والتسليم لحكمه إذ قد حسن عنده لأنه موقن وإذ قد عرف الحكمة في ذلك والخيرة في العاقبة، لأنه حكيم، ومنها أنّ مولاه أعلم به منه وأحسن نظراً واختياراً، وقد حبسه وقيده بالأمراض عن المعاصي، كما روي عن الله تعالى: الفقر سجني والمرض قيدي، أحبس بذلك من أحبّ من خلقي، فلا يأمن إن تداوى فعوفي أن تقوى النفس فيفسده هواها، لأنّ المعاصي في العوافي، وعلّة سنة خير من معصية واحدة، لقي بعض الناس بعض العارفين، فقال له والعارف: كيف كنت بعدي؟ قال: في عافية فقال: إن كنت لم تعص الله فأنت في عافية، وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوى من المعصية ماعوفي من عصى، وقال عليّ رضي الله عنه لما رأى زينة النبط بالعراق يوم عيدهم: ماهذا الذي أظهروه؟ قالوا: ياأمير المؤمنين، هذا يوم عيد لهم، فقال: كل يوم لايعصى الله فيه فهو عيد لنا.
وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أراكُمْ مَا تُحِبُّونَ) آل عمران 125قيل: العوافي والغنى، وقال بعضهم: إنما حمل فرعون أن قال: أنا ربكم الأعلى طول العوافي، لبث أربعمائة سنة لم يصدع له رأس، ولم يحمِ له جسم، ولم يضرب عليه عرق، فادّعى الربوبية، ولو أخذته الشقيقة والمليلة في كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية واعلم أنّ الإنسان قد يطغى بالعوافي كما يطغى بالمال، لأنه قد يستغني بالعافية كما يستغني بالمال، وكل فيه فتنة، وقد قال الله تعالى: (كَلاّ إنَّ الإنْسَانَ لَيَطْغى) (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) العلق: 6 - 7، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة والفراغ، والعصمة في حال العافية نعمة ثانية، كالعصمة في الغنى نعمة النعمة، وهذا أحد الوجوه في قوله عزّ وجلّ: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمُ في حَيَاتِكُمُ) الأحقاف: 20 ومنها أنّ الأمراض مكفرة للسّيئات؛ فإذا كره الأمراض بقيت ذنوبه عليه موفورة، وفي الخبر: لاتزال الحمى والمليلة بالعبد حتي يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة، وفي خبر: حمى يوم كفّارة سنة، وأحسن ما سمعت في معناه، قال: لأنّ حمى يوم تهد قوة سنة، وقيل: في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً، يدخل حمى يوم في جميع المفاصل فيكون له بكل مفصل كفّارة يوم، ولما ذكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كفّارة الذنوب بالحمى، سأل زيد بن ثابت ربّه أن لا يزال محموماً، قال: فلم تكن الحمى تفارقه في كل يوم حتى مات، وسأل ذلك طائفة من الأنصار، وكذلك لما ذكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أذهب الله كريمته لم يرضَ له ثواباً دون الجنة، قال: فقد رأيت الأنصار يتمنّون العمى، ولما جاءت الحمى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستأذن عليه قال: اذهبي إلى أهل قباء، وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: (فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) التوبة: 108 أي بالأمراض من الذنوب، وعن عيسى عليه السلام يقول: لا يكون عالماً من لم يفرح بدخول المصائب على جسده، وما له لما يرجو في ذلك من كفّارة خطاياه، والصدّيقون يبتلون بعلل الجوارح، والمنافقون يبتلون بأمراض القلوب، لأن في أمراض الأجسام ضعفها عن الآثام والطغيان، وفي أمراض القلوب ضعفها عن أعمال الآخرة والإيقان وفي معنى قوله عزّ وجلّ: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) لقمان:، 2، قيل ظاهرة العوافي وباطنة البلاوي لأنها نعم الآخرة، وروي أنّ موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال: ياربّ ارحمه، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: كيف أرحمه؟ ممّا به أرحمه؟ وقد قال الله وهو أصدق القائلين في تصديق هذا المعنى: (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرّ لَلَجُّوا في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) المؤمنون: 75 فأخبر أنّ في ترك الرحمة لهم لطفاً ورحمة.
وروينا عن عبد الواحد أنه خرج في نفر من إخوانه إلى بعض نواحي البصرة، فأواهم المسير إلى كهف جبل، فإذا فيه عبد مقطع بالجذام يسيل جسده قيحاً وصديد الأطباخ به، فقالوا: ياهذا، لو دخلت البصرة فتعالجت من هذا الداء الذي بك، فرفع طرفه إلى السماء، وقال: سيدي، بأي ذنب سلطت هؤلاء عليّ يسخطوني عليك، ويكرهون إلي قضاءك، سيدي أستغفرك من ذلك الذنب، لك العتبى إني لا أعود فيه أبداً، قال ثم أعرض بوجهه فانصرفنا وتركناه، وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي العبد على قدر إيمانه؛ فإن كان صلب الإيمان شدّد عليه البلاء، وإن كان في إيمانه ضعف خفف عليه البلاء، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار؛ فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز، ومنهم دون ذلك، ومنهم من يخرج أسود محترقاً، وقد روينا حديثاً من طريق أهل البيت: إذا أحب الله عبداً ابتلاه؛ فإن صبر اجتباه، وإنْ رضي اصطفاه، ومنها أنّ الملك يكتب له مثل أعماله الصالحة التي كان يعملها في صحته، وأنه يجري له الحسنات، مثل ما كان يجري له على أعمالهم، فيكتب الملك له أعمالاً صالحة خيراً له من أعماله، لأنّه قد يدخلها الفساد، واختيار الله له أن يستعمله بالأوجاع، خير له من اختياره لنفسه أن يستقل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهذا أحد المعنيين، في معنى الخبر: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، قيل: هو ما دخل عليها من المصائب في الأنفس والأموال، فهي تكره ذلك وهو خير لها، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) البقرة: 216 قد يكره العبد الفقر والعيلة والضر والخملة، وهو خير له في الآخرة وأحمد عاقبة، وقد يحب الغنى والعوافي والشهرة وهو شرّ له عند الله وأسوأ عاقبة.
وفي الخبر أيضاً يقول الله تعالى لملائكته: اكتبوا العبدي صالح ما كان يعمل فإنه في وثاق؛ إن أطلقته أبدلته لحماً خيراً من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وإن توفّيته توفّيته إلى رحمتي، فإبدال صفة لحسن اختيار الله له، خير له من الدنيا والآخرة ومن شهوته، والأصل في التوكل وتركه، أنّ المتوكل على الله قد علم في توكله أنّ للعلّة وقتاً إذا انتهت إليه برأ العليل بإذن الله لا محالة، ولكن الله عزّ وجلّ قد يحكم أنه إن تداوى شفاه في عشرة أيام، وإن لم يتداوَ أبرأه في عشرين يوماً، ليترخص العليل بما أباحه الله له، فيطمع في تعجيل البرء في عشرة أيام، ليكون أسرع لشفائه، وأقرب إلى عاقبته، على أنه معتقد أنّ الدواء ولا يشفى وإنّ التداوي لا ينفع لعينه، لأنّ الله هو الشافي وهو النافع فالشفاء والنفع فعله لعبده وجعله في الدواء من لطائف حكمته، لا يجعله سواه ولا يفعله إلا إياه، إذ كانت العقاقير مطبوعة مجبولة على خلقها، فجاعل الأسباب فيها هو جابلها، لأن الجعل فيها والخاصية منها ليس من عمل المتطبب، وإن كان يعمل بها ويجمع بينها وبين العليل لأنّه ظهر على يديه سبباً لرزقه، فالله خالق جميع ذلك وفاعله، وكذلك قال الله تعالى: (والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) الصافات: 96 وكذلك أيضاً عند العارفين أنّ الخبز لا يشبع وأنّ الماء لا يروي كما أنّ المال لا يغني، والعدم لا يفقر، لأن الله هو المطعم المسقي وهو المشبع والمروي، كما هو المغني المفقر بما شاء، كيف شاء وهو جاعل الشبع والري في المطعوم والمشروب، وفي النفس بالغنى والفقر لحكمته ورحمته، كما أنّ الله تعالى هو المجيع المظمئ، فيدخل الطعام والشراب على الجوع والعطش الذين جعلهما فيذهبهما بما أدخل عليهما، كما يدخل الليل على النهار، ويدخل النهار على الليل، فيغلب سلطان كل واحد على الآخر فيذهبه، فسواء هذا عند الموحدين من وصف الليل والنهار، ومن العلل والأدوية يتسلط الشيء على ضده فيزيله بقلبه، فهذه بإذن الله، والشرك في هذه الأشياء في العموم أخفى من دبيب النمل على الصفا، والموقنون الصحيحو التوحيد من جميع ذلك برآء، وعلى هذه المعاني أحد الوجهين في قوله تعالى: (الَّذي أَعْطى كُلَّ شَيءْ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) طه: 50 أي أعطى كل لون وجنس خلقته وطبعه أي صورة الشيء، ووصفه للضر والنفع، فإن تعجل العليل البرء بالتداوي فبرأ، كان ذلك بقضاء الله وقدره، على وصف السرعة من المعافاة، فإن كان ناوياً في تداويه واستعجاله شفاءه الطاعة لمولاه، والقيام بين يديه للخدمة، كان مثاباً على ذلك فاضلاً فيه غير منقوص في مقام توكله، وإن أراد بذلك صحة جسمه لنفسه والنعيم بالعوافي كان ذلك باباً من أبواب الدنيا، ودخولاً فيما أبيح له منها، وهو يخرجه من فضيلة التوكّل، وحقيقته بمقدار ما نقصه من الزهد في الحياة والنعيم، وإن أراد باستعجال العوافي قوة النفس لأجل الهوى، وليسعى في مخالفة المولى، كان مأزور السوء نيّته ووجود عزيمته وخرج من المباح إلى المحظور، وذلك يخرجه من حد التوكل وأوله، وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوتها، وإن كانت نيته في تعجيل العوافي التصرف في المعايش والتكسب للإنفاق والجمع، نظر في شأنه؛ فإن كان يسعى في كفاف وعلى عيلة ضعاف، وعن حاجة وإجحاف لحق هذا بالطبقة الأولى، وهذا باب من أبواب الآخرة وهو مأجور عليه، ولا يخرجه من التوكل، وإن كان يسعى في تكاثره، وتفاخر، ولا يبالي من أين كسب، وفيما أنفق، لحق هذا في الطبقة الثالثة من العاصين، وهذا من أكبر الدنيا المبعدة عن الله عزّ وجلّ، فهذه نيات الناس في التداوي المحمودة والمذمومة، فإن لم يتداوَ المتوكل تسليماً للوكيل وسكوناً تحت حكمه ورضاً باختياره وصنعه، إذ قد أيقن أن للعلّة وقتاً إذا جاء برئ بإذن الله تعالى، إلاّ أنها بعد عشرين يوماً، فيصبر ويرضى ويحمل على نفسه ألم عشرة أيام رضاً بقضاء الله، وصبراً على بلائه، وحسن ظن باختياره له، ولا يتهمه في قضاءه عليه، فهذا هو أحد الوجوه في حسن الظن باختيار الله أن لا يتهم الله في فضيلة كيف، وقد روي فيه نص أنّ رجلاً قال: يارسول الله، أوصني، فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه عليك.
وقد روي في معنى هذا خبر فيه شدة، يقول اللّّه تعالى: مَنْ لم يصبر على بلائي ويرضَ بقضائي ويشكر نعمائي فليتخذ ربًا سواي، وهذا باب من الزهد في الدنيا بمقدار ما نقص من الرغبة في نعيم النفس، لأنّ الجسم من الملك فما نقص منه نقص من الدنيا، والقلب من الملكوت فما زاد فيه زاد في الآخرة وهو باب من الصبر بقدر ما صبر عليه من النقص، كما قال تعالى: (وَنَقْصٍ مِنَ الأموال وَالأْنفُس) البقرة: 155 يعني أمراضها وأسقامها، وبشر الصابرين ونقص الأموال إقلالها وإذهابها، فكذلك جعلناه زهداً لاقترانه بالمال، ومع هذا فهو لا يأمن في تعجيل العوافي من المعاصي، فإذا انتهى وقت العلّة، برئ من غير دواء بإذن الله، وله في الأمراض تجديد التوبة، والحزن على الذنوب، وكثرة الاستغفار، وحسن التذكرة، وقصر الأمل، وكثرة ذكر الموت، وفي الخبر: أكثروا من ذكر هادمّ اللذات: ومن أبلغ ما يذكر به الموت وتوقع نزوله الأمراض فقد قيل: الحمى بريد الموت، وفي قوله عزّ وجلّ: (أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ في كُلِّ عَامٍ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ) التوبة: 126 الآية، قيل: بالأمراض والأسقام يختبرون بها، ويقال: إنّ العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يتب قال ملك الموت: يا غافل، جاءك مني رسول بعد رسول فلم تقبل، وقد كانوا يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يصابوا فيه بنقص أو مال، ويقال: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوماً أن يروع بروعة أو يصاب بنكبة، فكانوا يكرهون فقد ذلك في ذهاب هذا العدد من غير أن يصابوا فيه بشيء، وروي أن عماراً تزوّج امرأة فلم تكن تمرض فطلقها، وأنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى همّ أن يتزوجها، فقيل له: إنها ما مرضت قط فقال: لا حاجة لي فيها، وذكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأوجاع من الصداع وغيره، فقال رجل: وما الصداع؟ ما أعرفه فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إليك عني، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأنّ في الخبر أنّ الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، وفي حديث أنس وعائشة: يا رسول الله، هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ فقال: نعم، من ذكر الموت في كل يوم عشرين مرة، وفي لفظ الحديث الآخر: الذي يذكر ذنوبه فتحزنه، وإن ترك التداوي وبرئ بغير دواء، كان هذا من قضاء اللّّه وقدره على وصف الإبطاء، وقد اختلف رأي الصحابة في مثل هذا المعنى، عام خرج عمر رضي اللّّه عنه إلى الشام، فلما بلغوا الجابية انتهي إليهم خبر الشام أنّ به وباءً عظيماً وموتاً ذريعاً، فوقف الناس وافترقوا فرقتين، فمنهم من قال: لا ندخل على الوباء نلقي بأيدينا إلى التهلكة فنكون سبباً لإهلاك أنفسنا، وقالت طائفة أخرى: بل ندخل ونتوكل على الله ولا نهرب من قدره، ولا نفر من الموت فنكون كمن قال اللّّه تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلَى الذين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ) البقرة: 243، فرجع الجميع إلى عمر فسألوه عن رأيه، فوافق عمر الذين قالوا نرجع ولا ندخل على الوباء، فقال له آخرون: أنفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر إلى قدر الله، ثم ضرب لهم مثلاً فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم غنم وله شعبتان، إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله، وإن رعى المجدبة رعاها بقدر الله؟ فسكتوا، ثم دعا عمر بعبد الرحمن بن عوف يسأله عن رأيه فقيل: هو غائب، قد تأخر في المنزل الذي نزلنا فيه، فثبت عمر وأصحابه على ذلك الرأي، وعلى أن يسأل عبد الرحمن عن رأيه فيه، فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن بن عوف فسأله عمر عن ذلك، فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين، شيء سمعته من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر يقول: إذا سمعتم بالوباء في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، ففرح عمر بذلك إذ وافق رأيه فرجع بالناس من الجابية.
بيان آخر من التمثيل في التداوي وتركه
ومثل التداوي وتركه في أنهما مباحان، وأنّ أحدهما طريق الأقوياء الصابرين وهو تركه، مثل التكسب وتركه أنّ التكسب عند الجوع الذي هو علّة الجسم ليستعجل العبد الدواء بالخبز جائز له، لا يقدح في توكله لأنه مباح له مأمور به، فإن نوي بالتكسب القوّة على الطاعة والسعي في سبيل الله والمعاونة على البرّ والتقوى، كان فاضلاً فيه، وإن نوى بالتكسب الأكل للشهوات والقيام بحظوظ النفس من الرفاهية نقص ذلك من توكله وأخرجه من حقيقته، فكان طريقاً من طرقات الدنيا إلاّ أنّه مباح، وإن قصد بتكسبه التكاثر والحرص للجمع والمنع كان عاصياً بكسبه مخالفاً لربّه، وهذا من أكبر طرق الهوى، ثم إن لم يتكسب وصبر على الجوع ورضي بالقلة والفقر، فإن رزقه يأتيه لا محالة لمجيء وقته، وإن كان قليلاً دون سعة، ولكنه يحتاج إلى فضل صبر، وحسن رضاً، وسكون نفس، وطمأنينة قلب، فإن وجد هذه المعاني فهذا هو التوكل، وكان فاضلاً في ترك التكسب بحسن يقينه وثقته برازقه وشغله بما هو أفضل وأنفع له في عاقبته، وإن تشتت همته، واضطربت نفسه، وتكره قضاء ربه، فأخرجه ذلك إلى الجزع والهلع والتبرم والشكوى، فالتكسب لهذا أفضل وهو منقوص بتركه، كذلك أيضاً من أكبر الشكوى من علّته وتسخط حكم ربّه وتبرم وضجر وسطاً على الناس، وساء خلقه بمرضه فإن الأفضل لهذا أن يتداوى وهو ناقص بتركه.
وروينا عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنّ من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق اللّّه، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إنّ رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كره كاره، إنّ الله بحلمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط.
ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختلاف ظهور الأسباب
ويستوي عند الخصوص بعين يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم، وأسباب كسبهم وما جاءهم بأيدي غيرهم وبغير كسبهم إذا كان المعطي عندهم واحداً والعطاء كله رزقاً إذ كانت الأيدي ظروف العطاء فيستوي وكأن الظرف يدك أو يد غيرك، وسواء كان الكسب كسبك أو كسب غيرك لك إذ جميعه رزقك، ولأنّ لكل شيء حكماً وفي كل شيء حكمة وبكل شيء نعمة، قال الله تعالى: (إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (الَّتي لَمْ يُخْلَقْ منِثْلُهَا في الِبْلاَدِ) الفجر: 7 - 8 فأضافها إليه في الخلق بعد أن بنوها بأيديهم وفرغوا منها، ومثل هذين أيضاً يستوي عندهم ما ظهر بيد القدرة لا خلق فيه ولا واسطة به، وما ظهر بأيديهم عن الحكمة وترتيب العرف، لأن القدرة أيضاً بمنزلة ظرف للعطاء ظهر العطاء بها، فهي كأيدي العباد من يد الإنسان نفسه أو يد غيره، إذ القدرة والحكمة خزانتان من خزائن الملكوت والملك، فهذه المعاني الثلاث أعني ما ظهر عن يدك وتكسبك، وما ظهر بيد غيرك، وعن كسبه لك، وما أظهرته القدرة عن غير عرف معتاد ولا واسطة مرت به، هذا كله عند الموقنين سواء، لا يترجح بعضه على بعض لرجحان إيمانهم وقوّة يقينهم ونفاذ مشاهدهم، إذ كله حكمة بالغة وقدرة نافذة عن حكيم واحد وقادر واحد.
وممّا يدلك على استواء ما ظهر بيد الأواسط وما أظهرته القدرة عند العلماء أنّ كلّ من جمع كرامات الأولياء واجبات الصدّيقين ذكر فيها ما ظهر لهم عن القدرة، وما ظهر لهم على أيدي الخلق من الإنفاق عند وقت الفاقات عن غير مسألة ولا استشراف نفس، فسووا بينهما في الكرامات وجعلوهما واحد من الإجابات، وحسبوا كل ذلك من الآيات، على أنّ العارفين يشهدون ما يوصل العبيد إليهم من أقسام رزقهم، إنها ودائع لهم عندهم وإنه حق لهم بأيديهم يؤدونه إليهم قليلاً قليلاً، ويوفونهم إياه شيئاً فشيئاً إلاّ أنهم لا يسألونهم إياه ولا يطالبونهم به، وإن كان لهم عندهم حسن أدب فيهم وحسن اقتضاء لأنّ من حسن الاقتضاء ترك الطلب، ولقوّة يقينهم برازقهم أنّه يوفيهم نصيبهم غير منقوص، فقد سكنوا إلى قديم وعده كما نظروا إلى بسط يده، وكذلك مشاهدة العالمين الموصلين إليهم قسمهم الدافعين إليهم حقوقهم، يشهدون أنهم قد خرجوا إليهم من حقهم وأدوا إليهم ودائعهم، فيستريحون إلى إخراج ذلك، ويفرحون بأدائه إلى أربابه ويشكرون الله على حسن توفيقه وإعانتهم على سقوط ذلك عنهم، كما يفرح من عليه الدين الثقيل إذا أداه فسقط عنه حكمه وقضاؤه، وهذا مقام للموصلين في المعرفة وحال لهم من اليقين حسنة، وهو مشاهدة عالية للآخذين من المتوكلين.
ذكر تشبيه التوكل بالزهد
اعلم أنّ التوكل لا ينقص من الرزق شيئاً، ولكنه يزيد في الفقر ويزيد في الجوع والفاقة، فيكون هذا رزق المتوكّل ورزق الزاهد من الآخرة، على هذا الوصف الخصوص من حرمان نصيب الدنيا وحمايته عن التكاثر منها، والتوسع فيها فيكون التوكل والزهد سبب ذلك، فيكون ما صرفه عنه من الدنيا زيادة له في الآخرة من الدرجات العلى، وكذلك روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نقصان الدنيا زيادة الآخرة، وزيادة الدنيا نقصان الآخرة، ومن أعطى من الدنيا شيئاً نقص ذلك من منزلته في الآخرة، وإن كان على الله كريماً، وقيل إنّ الدنيا والآخرة مثل ضرتين، من أرضى إحداهما أسخط الأخرى، وقال رجل لبعض العلماء: كنت في محلة ليس فيها بقال غيري، ففتح إلى جنبي بقال آخر فأخاف أن ينقص ذلك من رزقي شيئاً، فقال: ليس ينقص من رزقك شيئاً ولكن يزيد في بطالتك، تقعد كثيراً لا تبيع شيئاً، وقد غلط في هذا الطريق قوم ادّعوا التوكل والزهد واتسعوا في المآكل والملابس، على أنّ ذلك لا ينقصهم من رزقهم شيئاً، فموهوا على دونهم ممن لا يعرف طريق الزهد والتوكل.
ذكر كتم الأمراض وجواز إظهارها
الأفضل لمن لم يتداوَ أن يخفي علله لأنّ ذلك من كنوز البرّ ولأنها معاملات بينه وبين خالقه، فسترها أفضل وأسلم له إلاّ أن يكون له نية في الإظهار أو يكون إماماً يستمع إليه ويقتبس منه الآثار، ويكون مكيناً في المعرفة يخبر بعلته وقلبه راض عن الله فيما قدره، أو يكون ممن يشهد البلاء نعمة فيكون إخباره بمثابة التحدّث بنعمة الله، وإلاّ فإظهار العلل لمن لا يتداوى نقص لحاله، وداخل في الشكاية لمولاه، لأنّ في الشكوى استراحة النفس من البلوى كالاستراحة بالدواء، وهذا لا يفعله عالم لأنّ الاستراحة بالدواء الذي أباحه له المولي خير من استراحته إلى العبيد بالشكوى، على أنّه لا يأمن دخول الآفات عليه في الأخبار من التصنع أو التزيد في العلّة وغير ذلك، وقيل في قوله عزّ وجلّ: (فَصَبْرٌ جَميلٌ) يوسف: 18، قال: لا شكوى فيه، وقال بعضهم: من بث شكواه فلم يصبر، وقيل ليعقوب عليه السلام: ما الذي أذهب بصرك؟ فقال: من الزمان وطول الأحزان، فأوحى الله إليه: تفرغت تشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا رب، أتوب إليك، وعن طاووس ومجاهد: يكتب على المريض أنينه في مرضه، قال: وكانوا يكرهون أنين المريض لأنّه إظهار معنى يدل على شكوى، قيل: ما أصاب إبليس من أيوب إلاّ أنينه في مرضه، فجعل الأنين حظه منه، وفي الخبر: إذا مرض العبد أوحى الله تعالى إلى الملكين: انظرا إلى عبدي ما يقول لعواده فإن حمد الله وأنثى عليه بخير، ادعوا له وإن شكا وذكر شراً قالا: لا، كذلك يكون، وإنما كره بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيارة في القول أن يخبر عن العلّة بأكثر منها فيكون في ذلك كفراً لنعمة بين بلاءين، وكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ، فيخرج إليهم، منهم فضيل ووهيب، وبشر كان يقول: أشتهي أن أمرض بلا عواد، وقال فضيل: ما أكره العلّة إلا لأجل العواد، وقد رأينا من الصالحين من فعل ذلك ممن هو إمام وقدوة، ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعلته على معنى التحدث بها مع فقد آفات النفوس، إذا كان قلبه شاكراً لله راضياً بقضائه، ويكون بذلك مظهراً للافتقار والعجز بين يدي مولاه أو راغباً في دعاء إخوانه المؤمنين، أو يشهد ذلك نعمة فيحدث بها شكراً، وقد حكي أنّ بشر بن الحرث كان يخبر عبد الرحمن المتطبب بأوجاعه، فيصف له أشياء، وقيل عن أحمد بن حنبل أنّه كان يخبر بأمراضه ويقول: إنما أصف قدرة الله تعالى فيّ. وروي عن الحسن البصري: إذا حمد المريض الله عزّ وجلّ وشكره ثم ذكر علّته، لم يكن ذلك شكوى، وقد كان أحمد بن حنبل لا يخبر بأمراضه إذا سئل عنها، ثم رجع إلى قول الحسن هذا، فكان بعد ذلك يحمد الله ويثني عليه ويقول: أجد كذا وأجد كذا، وروي أنه قيل لعلّي رضي الله عنه في مرضه: كيف أنت؟ فقال: بشر، فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك فقال: أتجلد على الله، كأنّه أحبّ أن يظهر افتقاره إلى الله، وأراد أيضاً أنّ يعلمهم أنّه لا بأس بذلك لأن من يقول: بخير إذا سئل كثير، كما قال الثوري: إنما العلم الرخصة من ثقة، فأما التشديد فكل أحد يحسنه، فكان عليّ رضي اللّّه عنه أراد أن يتحقق بتأديب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ونهيه إياه عن إظهار القوى، لأنه روي أنه مرض فسمعه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهم، صبرني على البلاء فقال: لقد سألت الله البلاء ولكن سل الله العافية، ومن هنا قال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إليّ من أن أبتلي فأصبر، لأن البلاء طريق الأقوياء، وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجلد والقوّة بين يدي القوي العزيز، وقد حكي أنّ الشافعي مرض مرضة شديدة بمصر فكان يقول: اللهم، إن كان في هذا رضاك فزدني منه، فكتب إليه بعض العلماء وهو إدريس بن يحيي المعافري، يا أبا عبد الله، لست من رجال البلاء فسل الله العافية، فرجع عن قوله هذا واستغفر منه، فبعد هذا واللّّه أعلم، لعلّه ما حكي عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إجعل خيرتي فيما أحببت.
ذكر فضل التارك للتكسب
قد يفضل التارك للتكسب شغلاً بالعبادة عن المتكسب، من حيث فضل المتقدّمون الزاهد في الدنيا على كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل الله، وسئل الحسن عن رجلين، أحدهما محترف والآخر مشغول بالتعبد: أيهما أفضل؟ فقال سبحان الله ما اعتدل الرجلان المتفرغ لعبادة أفضلهما، وقد روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كفى بالموت واعطاً وبالتقوى غنى وبالعبادة شغلاً، وقد علم التارك للتكسب توكلاً على الله وثقة به ورعاية لمقامه وصبراً على فقره وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة، إنّ مولاه قد تكلّل له برزقه في الدنيا وقد وكل إليه عمل الآخرة، وأنه إن شغل بما وكله إليه من عمل آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه، فلو لم يتصرف المتوكل تصرف له غيره، وإنّ عمل آخرته الذي وكّله إليه هذا فلم إن لم يعمله لم يقم غيره مقامه، وإنّ الله تكفل له بعمل الدنيا، فإن لم يعمل لعمل له سواه كيف شاء، فهذا هو الفرق بين ماتكفل له به من عمل الدنيا وبين ما وكّله به من عمل الآخرة، قال الله سبحانه في رزق الدنيا الذي تكفل به: (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزِقْهَا الله يرزقها وَإيَّاكُمْ) العنكبوت: 60 وقال تعالى في رزق الآخرة الذي وكل به: (وأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلاّ مَا سَعى) النجم: 39، ثم قد علم المتوكل بعدتوحيده أنّ هذه الأربعة الأشياء منتظمة في سلك واحد، كشيء واحد يقع وقعة واحدة رزق مقسوم لا يزاد فيه في وقت معلوم ولا يتقدم ولايتأخر بسبب محكوم، لا ينقلب عند أثر مكتوب ولايتغير، فالرزق بفضل الرازق والوقت الذي يظهر فضل العطاء لا يقع إلاّ في ظرف، والسبب حكمة القاسم والأثر حدّ المرزوق، فلما أيقن المتوكل بهذا كان إن تصرف بحكم، وإن قعد قعد بعلم، فاستوى تصرفه وقعوده لأنه قائم بحكم ما يقتضي منه في علم حاله عالم بحكم مصرفه ومقعده، فإن شغله مولاه بخدمته عن خدمة من سواه، فصرفه في معاملته دون معاملة العبيد ساق إليه رزقه كيف شاء من الوجوه وبيد من شاء من العبيد، يحفظه له عن مجاوزة الحدود، كما قال تعالى: (حَاِفظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله) النساء: 34، وبتوليه له وعصمته إياه عن التورط في محظور، كما أخبر عن أوليائه في قوله عزّ وجلّ: (وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّاِلحينَ) الأعراف: 196، وكان العبد فاضلاً في قعوده لشغله عن العبيد بمعبوده، بانقطاعه إلى معاملة الملك دون ما يقطعه من معاملة الملوك، وبهمة الآخرة عن الدنيا، وكان داخلاً في وصف ما أخبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أهل كفاية الله، فيما روي عنه من جعل الهموم همَّا واحداً، كفاه الله آخرته، وخارجاً عن وصف من قطعه عن الله بهمة غيره وعرضه للهلكة في أودية الهموم، في قوله عليه السلام: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، وفي قوله: ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أوديتها هلك، فإن كان حال المتوكل أن يجري رزقه على يد نفسه وكسب جارحته فهو خزانة من خزائن الملك وهو عبد من عبيد الملك، يوصل إليه عن يد نفسه بما يوصله إليه عن يد غيره وسواه، ساق إليه الرزق أو ساقه إلى الرزق بعد أن يرزقه، لأن ما لقيته فقد لقيك، والعبد متوكل على الله في الحالين، ناظر إليه بالمعنيين، قائم بحكم حاله في الأمرين، عارف بحسن اختيار الله له في الحكمين، ومن ترك التكسب لأجل الله ثقة به وسكوناً إليه أو لدخول الآثام وتعذر القيام بالأحكام، فحسنهُ كحسن من عمل شيئاً لأجل الله لأن الترك عمل يحتاج إلى نية صالحة وأفضل الناس عندالله أتقاهم له وأتقاهم له أعرفهم به متصرفاً كان أو قاعداً، هذا هو فصل الخطاب.
وروينا في حديث عبد الله بن دينار عن عمرو بن ميمون عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: حين استوى على عرشه ونظر إلى خلقه: عبادي، أنتم خلقي وأنا ربكم أرزاقكم بيدي فلا تتعبوا أنفسكم فيما تكفلت لكم به، واطلبوا أرزاقكم مني وانصبوا أنفسكم لي، وارفعوا حوائجكم إلي أصبّ عليكم أرزاقكم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: عبدي أنفق أنفق عليك ووسع أوسع عليك، ولا تضيق فأضيق عليك، إنّ أبواب الرزق بالعرش لا تغلق ليلاً ولا نهاراً، فأنزل الرزق منها لكل عبد على قدر نيته وعالته وصدقته ونفقته، فمن أكثر أكثر له ومن أقلل أقلل له، ومن أمسك أمسك عليه، يا زبير إنّ الله يحب الإنفاق ويبغض الإقتار، فكل وأطعم ولاتقترّ فيقترّ الله عليك ولا تعسر فيعسر عليك، أطعم الإخوان ووقرالأخبار وصل الجار ولاتماش الفجار تدخل الجنة بغير حساب، فهذه وصبة الله لي ووصيتي لك يا زبير بن العوام: والأسواق موائد الآباق يطعم المولى منها من أبق من خدمته وهرب من مجالسته ووهن عن معاملته وجبن في متاجرته، قال الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ) (مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ وَما أَريدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) الذاريات: 56 - 57، وقال بعض أهل العربية من القدماء: ما أريد أن يرزقوا خلقي إنّ الله هو الرزاق، أي لهم لا يطالبهم أن يرزقوا نفوسهم إذا خدموه، فذكر الله الوجوه الثلاثة واختار لنفسه أحدها وهي الخدمة، وعليه الكفاية، واختار من العبيد أحدهم فجعله عابده وتنزه عن أحدهما وتعالى عنه وهو الإطعام من العبيد له، وصرف عموم العبيد في الوجه الثالث من الإطعام لأنفسهم وهو التكسب، وضرب هذا مثلاً بينه وبين خلقه في الأرض وله المثل الأعلى في السموات والأرض، فبقي العبيد مع الله تعالى بحكمين، أحدهما ما اختاره لنفسه من العبادة وهي المعاملة وعليه الرزق كيف شاء ومتى شاء وهؤلاء عباد الرحمن لا عبيد الدنيا، والثاني ماصرف العبيد فيه من التكسب لأنفسهم وجعل ذلك رزقاً منه لهم بجوارحهم ومدحهم على هذا الوصف، وهؤلاء عموم العبيد منهم عبيد الدنيا وعبيد الهوى وبقي المولى مع العبيد على الأحكام الثلاثة التي أباحها الله تعالى لهم وضرب بها المثل بينه وبينهم، أيها اختاره كان ذلك لهم، وتفسير ذلك أن للمولى من الخلق أن يقول لعبده: اذهب فأطعمني لأنك عبدي وملك يدي، فأنا أملك كسبك كما أملك نفسك، وهذا هو الوجه الذي ذكرناه أنّ الله تنزه عنه وتعالى علواً كبيراً فقال تعالى: (مَا أُريدُ أَنْ يُطْعِمُونِ) الذاريات: 57، كما يريد الموالي من عبيدهم هذا ثم يقول المولى منا لعبده: اذهب فأطعم نفسك واسعَ في قوتك فقد أبحت لك ذلك، ووهبت لك كسبك فهو رزق مني لك وتفضّل مني عليك، وبهذا صار المكاتب لعبده في فكاك عتقه كالمعتق بأن كان له الولاء وقد يكون له الميراث في حال، لأنه منعم عليه بالكتابة له كالمعتق، وإن كان العبد هو الذي سعى في فكاك رقبة نفسه بكسبه من قبل أنّ المولى يستحق عليه كسبه ويملك رقبته، فلما ملك عبده ذلك صار محسناً إليه فهذا حال عموم العبيد مع الله تعالى، لأنه مولاهم الحق وهم عبيده، قنٌّ فقال: اذهبوا فتكسبوا، وأطعموا أنفسكم فقد رزقتكم ذلك ووهبته لكم، وهذا هو الوجه الثاني الذي نزه الخصوص عنه تفضيلاً لهم، فلم يستسعهم وقطعهم فشغلهم بخدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته، وتوكل لهم بكفايتهم ولم يوكلهم فيها كما وكلّ غيرهم، بل وكل بأرزاقهم من يشاء من عباده وهو معنى قوله تعالى (مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) الذاريات: 57 لنفوسهم بدليل قوله تعالى (إنّ الله هُوَ الرَّزَّاقُ) الذاريات: 58، أي لهم بإقامة غيرهم وبإظهاره في قوله: وما أريد أن يطعمون، فكانت هذه الياء اسمه مكنّى بها وهذه إرداة مخصوصة لا عامة لكل مراد، فهي إرادة ابتلاء ومحبة بمعنى ما أحبّ: ومخصوصة بمخصوصين من عباده، كما كان قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجّنَّ وَالإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ) الذاريات: 56، كانت هذه الآية مخصوصة لمن عبده منهم معناها: مؤمني الجن والإنس لا عامة لجميع خلقه، والوجه الثالث أن يقول المولى منا لعبده: اخدمني وعليّ طعمتك، تقوم خدمتك لي مقام كسبك لنفسك، وهذا هو الوجه الأعلى الذي اختاره الله
تعالى، وأحبه لمن يحبه واختار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له، وهم العالمون به دون من صرفه في رزق نفسه بنفسه، وهو قوله تعالى: (إلاّ لِيَعْبُدُونِ) (مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) الذاريات: 56 - 57، أي أن يرزقوا نفوسهم بكسبهم الذي أبحته لهم، فيكونوا كغيرهم ممن قلت له: اذهب فتكسب، فقد أردت منك الرزق لنفسك بكسبك وقد وهبته لك، أي أنا أُريد من هؤلاء العبادة ولها خلقتهم فكل ميسر لما خلق له، فمن كانت صنعته العبادة وخلق لها، يسرت له، ومن كانت صنعته الدنيا وخلق لها، يسرت له، وفي الخبر أنّ الله تعالى خلق كل صانع وصنعته، ويقال إنّ الله تعالى لما أظهرالخلق في العدم أظهر لهم الصنائع كلها، ثم خيّرهم فاختار كل واحد صنعته، فلما أبداهم في الوجود أجرى على كل واحد ما اختار لنفسه قال: وانفردت طائفة فلم تختر شيئاً، فقال لها: اختاري فقالت: ما أعجبنا شيء رأيناه فنختاره قال: فأظهر مقامات العبادات فقالت: قد اخترنا خدمتك فقال: وعزّتي وجلالي لأخدمنّكم إياهم ولأسخرنّهم لكم، وفي الخبر: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: اخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك فالعبادة هي الخدمة، ومن ذلك قولهم: إياك نعيد ولك نصلِي ونسجد، وإليك نسعي ونحفد، أي إليك نعمل ونخدم مثل قوله تعالى: (بَنِينَ وَحَفَدَةً) النحل: 72 أي خدماً في أحد الوجوه والعبادة هي الخدمة بذلّ وتواضع، والعرب تقول: طريق معبّدٍ إذا كان مذللاً ممهداً وموطوءًا بالأقدام، ويقولون: بعير معبد إذا كان ممتهناً بالكد نضواً من السير والحمل عليه، ومنه قول القبط: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعنون بني إسرائيل، خدمنا نستذلّهم ونمتهنهم بالكدّ والعمل، وقال بعض العارفين: إنّ الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعاً لمشاهدته، فرحمها فوهب لها العبادات والأعمال الصالحات، ثم إطلع على قلوب طائفة أخرى من خلقه فلم يرَ جوارحهم تصلح لخدمته ولا موضعاً لمعاملته، فاستعملهم للدنيا وعبّدهم لأهلها، ومن هذا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الخميصة؛ أي الذين يذلون لهذه الأشياء ويسعون لها، وفي أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمداً لأجلي وخلقت آدم لأجل محمد، وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم، فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته عني، ومن اشتغل منهم بي سقت له ما خلقته لأجله. وأحبه لمن يحبه واختار له من عبده من العبيد من خصوص العاملين له، وهم العالمون به دون من صرفه في رزق نفسه بنفسه، وهو قوله تعالى: (إلاّ لِيَعْبُدُونِ) (مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ) الذاريات: 56 - 57، أي أن يرزقوا نفوسهم بكسبهم الذي أبحته لهم، فيكونوا كغيرهم ممن قلت له: اذهب فتكسب، فقد أردت منك الرزق لنفسك بكسبك وقد وهبته لك، أي أنا أُريد من هؤلاء العبادة ولها خلقتهم فكل ميسر لما خلق له، فمن كانت صنعته العبادة وخلق لها، يسرت له، ومن كانت صنعته الدنيا وخلق لها، يسرت له، وفي الخبر أنّ الله تعالى خلق كل صانع وصنعته، ويقال إنّ الله تعالى لما أظهرالخلق في العدم أظهر لهم الصنائع كلها، ثم خيّرهم فاختار كل واحد صنعته، فلما أبداهم في الوجود أجرى على كل واحد ما اختار لنفسه قال: وانفردت طائفة فلم تختر شيئاً، فقال لها: اختاري فقالت: ما أعجبنا شيء رأيناه فنختاره قال: فأظهر مقامات العبادات فقالت: قد اخترنا خدمتك فقال: وعزّتي وجلالي لأخدمنّكم إياهم ولأسخرنّهم لكم، وفي الخبر: أوحى الله تعالى إلى الدنيا: اخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك فالعبادة هي الخدمة، ومن ذلك قولهم: إياك نعيد ولك نصلِي ونسجد، وإليك نسعي ونحفد، أي إليك نعمل ونخدم مثل قوله تعالى: (بَنِينَ وَحَفَدَةً) النحل: 72 أي خدماً في أحد الوجوه والعبادة هي الخدمة بذلّ وتواضع، والعرب تقول: طريق معبّدٍ إذا كان مذللاً ممهداً وموطوءًا بالأقدام، ويقولون: بعير معبد إذا كان ممتهناً بالكد نضواً من السير والحمل عليه، ومنه قول القبط: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعنون بني إسرائيل، خدمنا نستذلّهم ونمتهنهم بالكدّ والعمل، وقال بعض العارفين: إنّ الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعاً لمشاهدته، فرحمها فوهب لها العبادات والأعمال الصالحات، ثم إطلع على قلوب طائفة أخرى من خلقه فلم يرَ جوارحهم تصلح لخدمته ولا موضعاً لمعاملته، فاستعملهم للدنيا وعبّدهم لأهلها، ومن هذا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الخميصة؛ أي الذين يذلون لهذه الأشياء ويسعون لها، وفي أخبار داود عليه السلام: إني خلقت محمداً لأجلي وخلقت آدم لأجل محمد، وخلقت جميع ما خلقت لأجل ولد آدم، فمن اشتغل منهم بما خلقته لأجله حجبته عني، ومن اشتغل منهم بي سقت له ما خلقته لأجله.
ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت
فإن كان المتوكل ذا بيت فليغلقه إذا خرج، إحرازاً له لأجل الأمر بالحذر ولإتّباع السنّة والأثر قال الله تعالى: (يَا أيُّهَا الَّذينَ آمنُواخُذُوا حِذْرَكُمْ) النساء: 71، وقال تعالى: (واحْذَرْهُم أنْ يَفْتنوك) المائدة: 49، وقد يروي في خبر اعقلها وتوكل ولاينقص ذلك توكله إذا كان ساكن القلب إلى الله لا إلى خلقه، ناظراً إلى حسن تدبيره في تبقية رحله أو إذهابه لا إلى إحرازه، غير مختار لبقاء ما في بيته على اختيار الله له لحسن أحكامه عنده، لأن الله تعالى إذا رفع عبداً إلى مقام التوكّل عليه في شيء أعطاه التوكل في كل شيء، كما لا يكون توّاباً يحبه الله حتى يتوب إلى اللّّه بكل شيء وفي كل شيء أي يرجع إليه بالأشياء وفيها، فلذلك قال الله تعالى: (إنَّ الله يُحِبُّ الُْمُتَوَكلَّينَ) آل عمران: 159، كما قال: (إنَّ اللّّه يُحِبُّ التَّوَّابينَ) البقرة: 222، مع قوله: (وَعَلَى الله فَلْيَتوَكَّلَ الْمُتَوكِّلُونَ) إبراهيم: 12، أي ليتوكل عليه في كل شيء، من توكل عليه في شيء، هذا أحسن وجوهه، والوجه الآخر وعليه فليتوكل في كل توكّله من توكل عليه في الأشياء لأن الوكيل في شيء واحد، فينبغي أن يكون التوكّل عليه واحداً في كل شيء، فالتوكل مقام رفيع من مقامات الأنبياء ومن أعالي درج الصدّيقين والشهداء؛ من تحقّق به فقد تحقّق بالتوحيد وكمل إيمانه وكان على مزيد، وانتفى عنه دقائق الشرك وخفايا تولي العدو فانقطع سلطانه عنه، قال الله سبحانه وتعالى: (إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِهُّم ْ يَتَوَكَّلُون) (إنَّما سُلْطَاُنهُ عَلى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) النحل: 99 - 100 يعني العدو، والذين هم به مشركون يعني الله سبحانه، فلم يشترط نفي سلطان العدو بالإيمان مجرّداً حتى يقيمه في مقام التوكّل في اليقين، فلذلك فصلنا شرحه وأطلقنا تفصيله لأنّ من أعطى مقاماً من التوكّل على حقيقة مشاهدة الوكيل انتظم له جمل مقامات اليقين وأحوال المتقّين، كما قال عبد الله بن مسعود: التوكل جماع الإيمان وقد يبتلى المتوكل في توكّله بالأسباب والأشخاص والأغراض وضروب المعاني، كما يبتلى سائر أهل المقامات ويبقى عليه من العدو نزغ وطيف لا غير دون الاقتران والاستحواذ، يختبر بذلك صدقه في توكّله حتى يرد في جميع ذلك نظره إلى وكيله ليجزى جزاء الصادقين المقرّبين، أو ليكشف له دعواه فيعلم كذب نفسه، فيكون مردوداً إلى التوبة، كما قال تعالى: (لِيَجْزِيَ الله الصَّادِقينَ بصدْقِهِمْ) الأحزاب: 24، وحسب جزاء المتوكلّين أن يكون الصادق حسبهم وأن يكون خلعة الصدق شعارهم ثم قال تعالى: (وَيُعَذِّب الْمنافِقينَ إنْ شَاءَ أوْ يَتوبَ عَلَيْهِمْ) الأحزاب: 24، فأحسن حال المدّعين التوبة بها يخرجون من ظلمهم، وقال تعالى: (أحَسِبَ النَّاسُ أنْ يتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ) العنكبوت: 2، ثم أخبر بسنته التي قد خلت في عباده فقال: ولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولن تجد لسنّة الله تبديلاً، فليقل المتوكّل عند خروجه من منزله معتقداً لذلك بعد غلق بابه للأمر والسنّة: اللهم إنّ جميع ما في منزلي إن سلطت عليه من يأخذه فهو في سبيلك صدقة منّي على من أخذه، فإن أخذ ما في منزله كان له في ذلك سبع معاملات: إحداهما قبول توكله على الله بتدبير الله أمره كيف شاء، واختيار الله له نقصان الدنيا، وإذهاب ما لعله يفتتن بتبقيته، والثانية اختيار الله تعالى لعبده وابتلاؤه إياه بفقد محبوبه ليظهر صدقه ومسألته، أو ليستيبن للعبد كذبه، فإن حمد الله وشكره على حسن بلائه ولم تضطرب نفسه أعطي ثواب الشاكرين الراضين، كما جاء في العلم المكنون عن بعض أنبيائه قال: يا رب من أولياؤك؟ قال: الذين إذا أخذت منه المحبوب سالمني، والثانية إن اضطربت نفسه وجزعت جاهدها بالصبر والصمت وحسن الثناء على الله وترك الشكاية إلى عبيده، فأعطي ثواب الصابرين المجاهدين، والرابعة إن لم يكن في هذا المقام ولا في المقام الأوّل انكشف له بطلان دعواه وظهر له خفيّ كذبه في حياته، فاعترف بذلك واعتذر إلى الله واستكان وخضع، فيكون هذا أيضاً مزيد مثله على معنى الإعلام والبيان، فيعلم إنه كذاب لكراهية ما قضى الله وقلّة صبره أو
بسخطه ما حوّله الله من خزانته التي هي في يده إلى خزانته الأخرى التي هي في يد غيره، إذ قد علم أن يده خزانة مولاه، وأنّ ما حوله منها لم يكن له وإنما كان قد استودعه، فحزن وساءه حين استرجع منه ما أودعه وأعاره وأودعها غيره أو دفعها إلى من هي رزقه، وكانت له من قبل، أنّ المتوكل قد علم أن الله تعالى، إذا وهب شيئاً من الدنيا للأجسام من الملك وشيئاً من الآخرة من الملكوت وصار ذلك رزقاً للمتوكّل في آخرته، فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته لنقصان زهده، ليس ذلك، إلا للطمع فيه، وفضل الرغبة والشره إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره عنده، فهذه كلها ذنوب عند المتوكّلين موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنين، من قبل أن المتوكّل قد علم أن الله إذا وهب شيئاً من الملك في الدنيا للأجسام أو شيئاً من ملكوت الآخرة في القلوب، لم يأخذه أبداً؛ فما كان في الدنيا بقي لصاحبه إلى آخر أثره حتى يفنيه ويبليه، وما وهبه من الآخرة من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه أبداً بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد في دار الأبد، ولكن قد يعير ويستودع من أمور الدنيا وأمور الآخرة، فهذا النوع لا بدّ أن يسترده ويسترجعه في الدنيا لأن حكمته أوجبت ردّه كما أوجب كرمه تبقية ما وهبه، فلا ينبغي للمتوكّل الموقن ما ذكرناه أن يحزنه ما حول الله من خزانته التي في يده مما أعاره واستودعه إلى خزانته الأخرى التي هي يد غيره، ممن لعلّه يهبه له أو يبتليه بأحكامه فيه، فيخرج أيضاً من يده إلى يد غيره لأنه ما خرج من الدار شيء، ولله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزن والأسف على فوت مثل هذا عند العارفين جناية، ومن المؤمنين خيانة، يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصي، لأنهم قد شهدوا ما بيّناه ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنيا وقلة الفرح بما أتى منها، إذ لا بدّ من كونهما لأنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به، فكشف لهم اليقين عن الكتاب المستبين؛ أنّ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما ظهر من المصائب في الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق، وهذا قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا) الحديد: 22، قيل: من قبل أن نخلق الخليقة وقبل أن نبرأ الأرض وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس، وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة، ثم قال تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) الحديد: 32، فالأسى على فقد الشيء على قدر الفرح بوجوده، أفلا يستحي العبد أن يكون على ضدّ ما أمر به أو بخلاف ما يحبّه منه مولاه؟ فيأسى على ماليس له ويحزن على ما أخذ منه واستودعه، أو يفرح بما ليس له لأنه لا يعلم أنه قد وهب له، فيبقي عليه، أو قد أعيره فيؤخذ منه، فلما استرجعه من يده التي هي يده تعالى قبضه، أيقن أنه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة عنده فحزن وساء، فهذا لما أيقن شك، ولما علم جهل ورغب فيما ينبغي أن يزهد فيه، فأي شكّ مع ذلك يتوهم المتوكّل على الله ويدعي منازل الأقوياء الأغنياء بالله، الشاهدين لمجاري قدر الله في تصاريف حكمه، فإذا علم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابين وتاب توبة المدعين، ولم ينطق بكلام الصادقين ولا يدل إدلال المحبوبين، فيكون تعريف الله إياه هذه المعاني تأديباً له ومزيد مثله، وهذا مزيد الناقصين. ما حوّله الله من خزانته التي هي في يده إلى خزانته الأخرى التي هي في يد غيره، إذ قد علم أن يده خزانة مولاه، وأنّ ما حوله منها لم يكن له وإنما كان قد استودعه، فحزن وساءه حين استرجع منه ما أودعه وأعاره وأودعها غيره أو دفعها إلى من هي رزقه، وكانت له من قبل، أنّ المتوكل قد علم أن الله تعالى، إذا وهب شيئاً من الدنيا للأجسام من الملك وشيئاً من الآخرة من الملكوت وصار ذلك رزقاً للمتوكّل في آخرته، فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق آخرته لنقصان زهده، ليس ذلك، إلا للطمع فيه، وفضل الرغبة والشره إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغيره عنده، فهذه كلها ذنوب عند المتوكّلين موجبات للتوبة والاستغفار عند الموقنين، من قبل أن المتوكّل قد علم أن الله إذا وهب شيئاً من الملك في الدنيا للأجسام أو شيئاً من ملكوت الآخرة في القلوب، لم يأخذه أبداً؛ فما كان في الدنيا بقي لصاحبه إلى آخر أثره حتى يفنيه ويبليه، وما وهبه من الآخرة من الإيمان والعلم والعمل لم يأخذه أبداً بل ينميه ويزيده فيه إلى أبد الأبد في دار الأبد، ولكن قد يعير ويستودع من أمور الدنيا وأمور الآخرة، فهذا النوع لا بدّ أن يسترده ويسترجعه في الدنيا لأن حكمته أوجبت ردّه كما أوجب كرمه تبقية ما وهبه، فلا ينبغي للمتوكّل الموقن ما ذكرناه أن يحزنه ما حول الله من خزانته التي في يده مما أعاره واستودعه إلى خزانته الأخرى التي هي يد غيره، ممن لعلّه يهبه له أو يبتليه بأحكامه فيه، فيخرج أيضاً من يده إلى يد غيره لأنه ما خرج من الدار شيء، ولله حكمة وابتلاء في كل شيء؛ فالحزن والأسف على فوت مثل هذا عند العارفين جناية، ومن المؤمنين خيانة، يستغفرون الله ويتوبون إليه كما يتوبون من المعاصي، لأنهم قد شهدوا ما بيّناه ولأنه قد أمرهم بترك الأسى على فائت الدنيا وقلة الفرح بما أتى منها، إذ لا بدّ من كونهما لأنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به، فكشف لهم اليقين عن الكتاب المستبين؛ أنّ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما ظهر من المصائب في الأموال والأنفس فقد سبق قبل خلق الخلق، وهذا قوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا) الحديد: 22، قيل: من قبل أن نخلق الخليقة وقبل أن نبرأ الأرض وقيل: من قبل أن نبرأ الأنفس، وقيل: من قبل أن نبرأ المصيبة، ثم قال تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) الحديد: 32، فالأسى على فقد الشيء على قدر الفرح بوجوده، أفلا يستحي العبد أن يكون على ضدّ ما أمر به أو بخلاف ما يحبّه منه مولاه؟ فيأسى على ماليس له ويحزن على ما أخذ منه واستودعه، أو يفرح بما ليس له لأنه لا يعلم أنه قد وهب له، فيبقي عليه، أو قد أعيره فيؤخذ منه، فلما استرجعه من يده التي هي يده تعالى قبضه، أيقن أنه لم يكن له وأنه إنما كان وديعة عنده فحزن وساء، فهذا لما أيقن شك، ولما علم جهل ورغب فيما ينبغي أن يزهد فيه، فأي شكّ مع ذلك يتوهم المتوكّل على الله ويدعي منازل الأقوياء الأغنياء بالله، الشاهدين لمجاري قدر الله في تصاريف حكمه، فإذا علم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابين وتاب توبة المدعين، ولم ينطق بكلام الصادقين ولا يدل إدلال المحبوبين، فيكون تعريف الله إياه هذه المعاني تأديباً له ومزيد مثله، وهذا مزيد الناقصين.
والمعاملة الخامسة أن يكون له بكل درهم تلف سبعمائة درهم، كأنه قد أنفقه في سبيل الله، حسب له ذلك لأنه قد كان نواه، وكذلك إن لم يؤخذ ما في بيته استنباطاً من قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها: إنّ له أجر غلام ولد، له من ذلك الجماع وعاش فقتل في سبيل الله، وإن كان لم يولد له فقال: أنت تخلقه، وأنت ترزقه إليك، محياه إليك، مماته أقرها قرارها ولك ذلك.
والمعاملة السادسة أن لا يأثم أخوه الذي أخذ رحله إن كان قد جعله صدقة عليه، فيؤجر أجراً ثانياً لإشفاقه على أخيه، وحسن نظره للعصا من حيث لا يعلمون تخلقاً بأخلاق مولاه، وينال بعفوه عن ظالمه درجة المحسنين، ويتحقّق بمقام المتّقين ويكون ممّن وقع أجره على الله، فيخفي له ما لا تعلم نفس من قرة العين ولأنه قد علم كيف جرى الأمر وأنّ الآخذ مبتلي بسوء القضاء، وأنّه قد عوفي إذ لم يكن هو ذلك العبد فيرحم أهل البلاء حينئذ، ويحمد الله على ماعافاه فيشغله الشكر لله عن الدعاء على ظالمه، قال بعض العارفين لبعض أصحابه: لم أسقط أهل المعرفة اللأئمة عن الظالمين لهم فقلت: لاأدري قال: لعلمهم أنّ الله قصدهم بذلك وابتلى الظالمين بهم فرحموهم، وذلك داخل في نصر أخيه الظالم لنفسه، وطاعة لأمر رسوله في قوله: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؛ أي تمنعه عن الظلم فإذا عفا عنه فقد منعه من الظلم، لأنه لو رآه منعه من أخذه أو وهبه له فيقوم عفوه عنه مقام رؤيته.
والمعاملة السابعة تحقّقه في الزهد فيما ذهب، وقال أبو سليمان الداراني لما بلغه عن مالك بن دينار أنه قال للمغيرة: اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فلا حاجة لي بها، وكان قد أهداها إليه وقبلها منه فقال: ولِمَ؟ قال يوسوس إلى العدوّ أنّ اللص قد أخذها وكان مالك لا يغلق بابه إنما كان يشدّه بشريط وكان يقول: لولا الكلاب ما شددته أيضاً، فقال أبو سليمان: هذا من ضعف قلوب الصوفيين، هو قد زهد مني الدنيا فما عليه بمن أخذها، وهذا كما قال أبو سليمان: لأن الزهد إذا صحّ دخل الرضا فيه، ولقول مالك أيضاً وجه كأنه كره أن يعصي الله به، فيكون هو سبب معصية الله، ولكن قول أبي سليمان أعلى لأجل التوكّل والرضا، وهذا الذي ذكرناه من ذهاب ما في البيت هو لكل من ذهب له مال في سفر أو حضر، ولكل من أصيب بمصيبة في نفس أو أهل هذه المعاملات كلها إذا اعتقدها بقلبه وكانت في خلده ووجده، وإن لم ينطق بها أو يظهرها: فأكثر الناس إيماناً وأحسنهم يقيناً أقلهم غمّاً وأيسرهم أسى على ما فات من الدنيا، وأحسنهم رضا وأنفذهم شهادة من رأى أن ذلك نعمة أوجبت عليهم شكراً، وأقل الناس إيماناً وأضعفهم يقيناً أشدهم أسى وأكثرهم غمّاً على ما فات، وأطولهم شكوى وأقلّهم شكراً، فالمصائب محنة تكشف الزهد في الدنيا والرغبة، ألم تسمع إلى الحديث الذي جاء فيه هذا الدعاء: وأسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، فشدة الغمّ على فوت الدنيا دليل على حبّها وعلامة ضعف اليقين بمحبوبه وسهوله الغمّ على فوتها دليل على الزهد فيها وقوة اليقين بربّه، فإن وجد المتوكل رحله بحاله لم يضرّه بتبقيته شيء وكان له أحر ما قد نوى من المعاملات، ولا أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من منزله أو تركه لرحله أو خروجه في سفر ينفعه شيئاً ولا يضرّه، ولا يقدم ضياع شيء حكم الله ببقائه له ولا يؤخر ترك العقد لهذا تبقية ما حكم الله بذهابه، ومع ذلك فيكون له حال من التوكل ومقامات في المعاملات إلاّ شيئاً واحداً من باب نقصان الدنيا من طريق الورع، فإنه ينقصه وهو أنّه إن أخذ ما توكّل على الله فيه، وفوّض إليه أمره به، ثم ردّ عليه، لم يستحبّ له في الورع أن يتملّكه، ولا أن يرجع فيه في حسن الأدب، لأنه قد كان جعله صدقة في سبيل الله، فإن رجع فيه لم ينقص ذلك توكله، لأنه قد صحّ تفويضه إلى الوكيل في الخالين معاً، فيكون ردّه عليه لأنه قد كان وهبه له بمنزلته ابتداء عطاء منه.
وقد روينا أنّ ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا، ثم قال: في سبيل الله، فدخل المسجد وصلّى ركعتين فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنّ ناقتك في مكان كذا، فلبس نعله وقام ثم نزعها، ثم قال: أستغفر الله، وجلس فقيل له: ألا تذهب فتأخذها فقال: إني قد كنت قلت: في سبيل الله، وحدثت عن بعضهم قال: رأيت بعض إخواني في النوم بعد موته فقلت: مافعل الله بك؟ فقال: غفر لي وأدخلني الجنة، وعرضت على منازلي فيها فرأيتها، قال وهو في ذلك كئيب حزين فقلت: قد دخلت الجنة وغفر لك وأنت حزين، فتنفّس الصعداء ثم قال: نعم إني لاأزال حزيناً إلى يوم القيامة، قلت: ولم ذلك؟ قال: إني لما رأيت منازلي من الجنة رفعت لي مقامات في عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت، ففرحت بها، فلما هممت بدخولها، نادى منادٍ من فوقها: اصرفوه عنها فليست هذه له، إنما هذه لمن أمضى السبيل فقلت: وما أمضى السبيل؟ قيل لي: قد كنت تقول للشيء إذا ذهب منك: في سبيل الله، ثم ترجع فيه فلو كنت أمضيت السبيل لأمضيناها لك، وقد حدّثونا أن الربيع بن خيتم سرق فرسه وكان ثمنه عشرين ألفاً، وكان قائماً يصلّي فلم يقطع صلاته ولم ينزعج لطلبه فجاءه الناس يعزونه فقال: أما إني قد كنت رأيته وهو يحلّه، قيل: وما منعك أن تزجره؟ قال: كنت فيما هو أحبّ إليّ من ذاك يعني الصلاة قال: فجعلوا يدعون عليه فقال: لا تفعلوا وقولوا خيراً فإني قد جعلتها صدقة عليه، وقيل لبعضهم في شيء قد كان سرق له: ألا تدعو على ظالمك؟ فقال: ما أحب أن أكون عوناً للشيطان عليه، قيل: أفرأيت لو ردّت إليك سرقتك أكنت تأخذها؟ قال: ولا كنت أنظر إليها إني قد كنت أحللته منها، وقيل لآخر: أدع الله على من ظلمك، قال: ماظلمني أحد ثم قال: إنما ظلم نفسه فلا يكفيه المسكين ظلمه لنفسه حتى أزيده شرّاً، وذهب لبعض المسلمين مال فجاء قوم يعزونه عليه فقال: ما تعزوني على أمر الدنيا، فوالله ما حزنت على ذهابها فكيف على ذهاب شيء منها قيل: ولِمَ؟ قال: شغلني الشكر عليه عن الحزن، وقد كانوا يقولون: إذا ظلموا من الغصب والسرقة وغير ذلك، هذه نعمة الله علينا إذ لم يجعلنا ظالمين مظلومين وجعلنا أعظم مما فاتنا من الظلامة، وقد كان السلف يخافون أن يذكروا الظالم بالسبّ له والدعاء عليه فيكون ذلك زيادة على مظلمتهم.
وقد روينا: من دعا على ظالمه فقد انتصر، وأكثر بعضهم بشتم الحجاج عند بعض السلف فقال له: لا تغرق في شتمته فإن الله ينتصف للحجاج ممن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أخذ ماله، وفي الخبر أن العبد ليظلم المظلمة، فلا يزال يشتم ظالمه ويسبّه حتى يكون بمقدار ماظلمه، ثم يبقى للظالم عليه مطالبة بما زاد عليه يقتصّ له من المظلوم، وقال بعض العلماء لرجل وقد كان شكا إليه قطع الطريق وأخذ ماله فقال له: إن لم يكن غمك أنّه قد صار في المسلمين من يستحلّ هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت للمسلمين، وسرقت من علي بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يبكي ويحزن فقال: أعلى الدنانير تبكي؟ فقال: لا والله، ولكن على المسكين، أنه يسأل يوم القيامة بهم ولا يكون له حجة، وقيل لبعضهم في معنى هذا: أدع على من ظلمك، فقال: إني مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه؛ فإن ردّ عليّ المتوكّل كلّ ما أخذ منه فالأفضل له أن لا يتملّكه، إن كان قد جعله في سبيل الله ليمضي السبيل، فإن كان قد جعله صدقة على الآخذ نظر في ذلك فإن كان فقيراً حمله فقره على السرقة والخيانة والحاجة أمضى صدقته عليه، وإن كان غير ذلك صرفها إلى فقير، وقد كان بعضهم إذا أخذ له الشيء يشترط فيقول: إن كان فقيراً فهو صدقة عليه، وإن كان محتاجاً فهو في حلّ، وقد أخبرني بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العباد أنّه اتهم بعض الحجاج بسرقة هميانه لأنه كان قائماً إلى جانبه، فقال له: كم كان فيه فأخبره، فحمله إلى منزله فوزن له من المال، ثم إنّ أصحابه أعلموه أنهم مزحوا معه وحلّوا هميانه وهو نائم، فجاء هو وأصحابه إليه فردّوا عليه ماله، فقال: ما كانت لتعود إليّ بعد إذ خرجت هي لكم، فقلنا: لاحاجة لنا فيها فقال: خذوها، قال: فأبينا، فقال: يابني، ودعا ابناً له وجعل يصرّها صرراً ويبعث بها إلى قوم حتى فرغ منها، وهذا كانت نيته إخراجها لله سبحانه فلم يعد فيما أخرجه، كما نقول فيمن أخرج رغيفاً إلى سائل أو أعدّ درهماً لفقير فلم يصادفه: إنّا نستحب أن لا يرجع إلى ملكه بل يعزله لسائل آخر أو فقير غيره، لم يزل هذا من أخلاق المؤمنين، وقد رأينا من كان بهذا الوصف وهذا طريق قد عفا أثره ودرس خبره، فمن عمل به فقد أحياه وأظهره وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالى عليه السابلة من الأولياء.
ذكر بيان آخر من أحكام المتوكّل
اعلم أنّ التوكّل على الله في الأسباب لا يوجب بقاءها للعبد ولا إيثاره بها ولا حفظها عليه، ولا يقدم شيئاً عن شيء ولا يؤخّره لصلاح دنيا أو اختيارعبد، بل هو إلى الإذهاب والإتلاف أقرب لأن التوكّل قرين الزهد، هكذا هو عند الخصوص ولأجل اختيار العبد وتحقيق صدقه محنة له، ولأجل مَنْ نفي الشيء من الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: (فَمَا أُوتيتُمْ مِنْ شَيءٍ فَمَتَاعُ الْحَياةِ) الشورى: 36 فإن ذهب ماله فصبر أو شكر أو رضي، كان صادقاً في توكله، وهذه أحوال المتوكلين في التوكّل إن كانوا صادقين، وإن عجز واضطرب كان كاذباً في توهّمه للتوكّل ويلزمه من مجاهدة النفس عند اضطرابها بعد عدم الأشياء ما يلزمه من مجاهداتها ونفي الآفات في سائر الأعمال، فإن حفظ عليه ماله فقد رفق به في ذ لك وستر عليه عن كشف حقيقة حاله بتلف ذلك، وجعلت كرامة من الدنيا له ليطمئن بذلك في حاله ويسكن به قلبه في طريقه، وهذا مقام الضعفاء، وإن نقص من الدنيا فقد أقيم مقام أهل البلاء، الأمثل فالأمثل بالأنبياء، ولولا الامتحان لكثر الصادقون وكذلك التوكل على الله في ترك الدواء لا يجلب العوافي ولا يعجلها، ولا ينقص من الأمراض ولا يذهبها، بل هو إلى الازدياد منها أقرب للتمحيص والابتلاء، ومنه قوله عزّ وجلّ: (وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ) آل عمران: 141، فمن لم يشهد نقصان الدنيا من النفس والمال نعمة توجب عليه الشكر، ويرى المنع عطاء فقد جهل تلك النعمة بإضاعة شكرها، فما فاته من جهل النعمة، وترك الشكر، أعظم مما يترك من جميع الدنيا، وأخاف عليه لطيفة من المحق، والمحق نقصان الشيء إلى ذهاب جملته عند الكفر بنعمته لقوله تعالى: ويمحق الكافرين فالله أعلم أي شيء يمحقه وينقصه، بمقدار ما كفر شكر نعمته، وقد قال سبحانه: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيءْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرينَ) البقرة: 155 فهذا النقص من هذه الخمس التي المزيد منها هو جملة الدنيا، هو المزيد من الآخرة لا ضد الدنيا كما قال تعالى: (وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّّلُونَ) الشورى: 36 فصبروا على مصائبهم توكّلاً على ربّهم، ثم توكّلوا رهم لشهادة وكيلهم ولحسن ظنّهم به، ثم صبروا على توكّلهم لتمام حالهم، ويعلو بذلك فيه مقامهم: فالصبر أول مقام في التوكّل وهو عند مشاهدة القضاء بلاء، والشكر أعلى من ذلك هو شهود البلاء نعمة، والرضا فوق ذلك كلّه وهو أعلى التوكّل وهو مقام المحبين من المتوكّلين، قال الله عزّ وجلّ في وصف عموم المتوكلين: (وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ) القصص: 60، فمن اتّقى الله وعقل خطابه توكّل عليه فيما أصابه، فلم ييأس على ما فات ولم يفرح من الدنيا بما هو آت وهذا أوسط الزهد وأوّل التوكّل، وقال تعالى في وصف الخصوص: (وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) الشورى: 36 فأهل العقل عن الله والمتقون له هم المتوكلون عليه، وقد زهدهم فيما يفنى برغبته إياهم فيما يبقى حين فهموا الخطاب، إذ هم أولو الألباب وذلك أنه أضاف ما عنده إليه ووصفه بالبقاء ليرغبوا فيه، لأنهم قد توكّلوا عليه وأضاف ما عندهم إليهم ليزهدوا فيه، ووصفه بالفناء لأنهم قد زهدوا في نفوسهم، إذ قد باعوها منه، فكيف يتملكون ماعندها؟ والعبد وماله لسيده وهو تعالى قد اشتراها منهم لرغبتهم فيه، وعوّضهم منها ما يبقى لهم فقال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ) النحل: 96
ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكّل
اعلم يقيناً أن الله تعالى لوجعل الخلائق كلّهم من أهل السموات والأرضين على علم أعلمهم به، وعقل أعقلهم عنه وحكمة أحكمهم عنده، ثم زاد كلّ واحد من الخلائق مثل عدد جميعهم وأضعافه علماً وحكمة وعقلاً، ثم كشف لهم العواقب وأطلعهم على السرائر وأعلمهم بواطن النَّعم، وعرّفهم دقائق العقوبات وأوقفهم على خفايا اللطف في الدنيا والآخرة، ثم قال لهم: دبّروا الملك بما أعطيتكم من العلوم والعقول عن مشاهدتكم عواقب الأمور، ثم أعانهم على ذلك وقواهم له، لما زاد تدبيرهم على ما يراه من تدبير الله تعالى من الخير والشر والنفع والضرّ جناح بعوضة، ولا نقص جناح بعوضة ولا أوجبت العقول المكاشفات ولا العلوم المشاهدات غير هذا التدبير، ولا قضت بغير هذا التقدير الذي يعاينه ويقلب فيه، ولكن لا يبصرون لأنه أجراه على ترتيب العقول وعلى معاني العرف والمعتاد من الأمور، بالأسباب المعروفة والأواسط المشهورة على معيار ما طبع العقول فيه وجبل العقول عليه، ثم غيّب مع ذلك العواقب وحجب السرائر وأخفى المثاوب، فغاب بعينها حسن التدبير وجميل التقدير فجهل أكثر الناس الحكم إلا المتوكلين وما يعقلها إلا العالمون، ويقال: أصغر ماخلق الله من الحيوان والموات البعوضة والخردلة، وفي كل واحدة منها ثلاثمائة وستون حكمة، ثم يتزايد الحكم في المخلوقات على قدر تفاوتها في العظم والمنافع ومزيد آخر من الهدى، والبيان لو تمنّى أهل النهي من أولي الألباب الذين كشف عن قلوبهم الحجاب نهاية أمانيهم، فكوّنت أمانيهم على ما تمنوا لكان رضاهم عن الله في تدبيره ومعرفتهم بحسن تقديره لهم، خير لهم من كون أمانيهم، وأفضل لهم عند الله من قبل إن الله، أحكم الحاكمين، وقال تعالى موبخاً للإنسان مجهلاً للتمني لقلة الإيقان: (أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنّى) (فَلِلّهِ الآخِرَةُ وَالأُولى) النجم: 24 - 25 أي يحكم فيهما بترك الأماني لأنه قال تعالى: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ ومَنْ فيهِنَّ) المؤمنون: 71 فالمتوكّل محبّ لله تعالى مسرور بربّه فرح له بملكه، بأنّ له الآخرة والأولى يحكم فيهما كيف شاء، والعبد عاجز لا يقدر على شيء، فهذا أوّل مقام في المحبة، فقد كفى الخلائق هذا كله بحسن تدبير الخالق العليم الخبير البصير، وإنما يحتاجون إلى معرفة بالحكمة ومشاهدة للحكم والرحمة، وإلى بصيرة ويقين يسكن عندها قلوبهم ولا يضطرب، هذا الذي ذكرناه عند الموقنين وستطلع العموم على سرّ ما ذكرناه من لطيف التدبير وباطن التقدير، وهو سرّ القدر ولطائف المقدّر في الآخرة عند المعاينة، وقد كشف الغطاء وظهر ما تحته من عجائب الخبء في السموات والأرض، وقد أطلع الله على ذلك العلماء به في الدنيا وهو محمود مشكور على ما أظهر وأخفى، ففي كلّ واحد منهما نعمة، ومع كل واصف منها حكمة ورحمة، ولكن قد خلق الله العلماء بأخلاقه فليس يكشفون من علمه إلا بقدر ما كشف، وليس يعرفون من سرّ قدره إلا بمعيار ما عرف، وقال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاّ عندنا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِّلَهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) الحجر: 21 فقد تأدبوا بهذا الخطاب ووقفوا عنده، وقال أبو سليمان الداراني: إذا لاحظت الأشياء من فوق وجدت لها طعماً آخر، وقال بعض العارفين: إذا رأيت الأشياء كلها كشيء واحد من معدن واحد، رأيت ما لم تسمع وفهمت ما لم تفهم الخلق، وقال بعضهم: لا ترى العجب حتى ترى عجباً فإن لم ترَ عجباً رأيت العجب.
ذكر بيان آخر من وصف المتوكّلين
اعلم أن العلماء بالله سبحانه؛ لم يتوكّلوا عليه لأجل أن يحفظ لهم دنياهم، ولا لأجل تبليغهم مرادهم، ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء بما يحبّون، ولا ليبدّل لهم جريان أحكامه عمّا يكرهون ولا ليغيّر لهم سابق مشيئته إلى ما يعقلون، ولا ليحوّل عنهم سنّته التي خلت في عباده من الابتلاء والاختبار، هو أجلّ في قلوبهم من ذلك وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا، لو اعتقد عارف بالله أحد هذه المعاني مع الله في توكّله كان كبيرة توجب عليه التوبة وكان توكّله معصية، وإنما أخذوا نفوسهم بالصبر على أحكامه كيف جرت، فطالبوا قلوبهم بالرضا عنه كيف جرت، وقال رجل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إني تعلقت بأستار الكعبة فتبت من كلّ ذنب وحلفت أن لا أعصي الله فيما أستقبل، فقال له: ويحك، ومن أعظم معصية منك تتألى على الله أن لا ينفذ حكمه فيك، وأنشدنا بعض العلماء لبعض الحكماء: لما رأيت القضا جارياً ... لا شك فيه ولا مرية
توكلت حقّاً على خالقي ... وألقيت نفسي مع الجرية
وإنما كرهو ما كره الله طاعة لله، فذلك كراهة ما كره حبّاً للّّه واكتراماً لحكمه عليهم، لاكراهة ما قضى إذ ليس لهم أن يقولوا: فلم قضيت ما تكره ولِمَ كرهت ما قضيت؟ هو أجلّ وأعظم، وفي نفوسهم أخوف وأهيب أن يواجهوه بهذا الخطاب في قول أو عقد، بل عرفوا حكمته فيه وصبروا على حكمه به، وإنّما توكّل العلماء به عليه لأجل أنه يحبّ المتوكّلين ولأجل أنه يستحقّ التفويض إليه ويستوجب التسليم له، إذ كان هو الوكيل الأوّل والكفيل الآجلّ حين سمعوه يقول: والله على شيء وكيل، ثم استوى على العرش يدبّر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وحين فقهوا قوله: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، ولما عقلوا من خطابه: أليس الله بأحكم الحاكمين أو لأجل أنه أمر بالتوكّل، وندب إليه وحقق الإيمان به؛ إذ سمعوه تعالى يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أمن يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم، وما توعدون، ثم أقسم عليه بنفسه أنه حقّ فتوكّلوا عليه إستحياءً، منه ولوجود اليقين الذي رفع خفايا الشكّ وحذّر من التهمة له وتوثقة بالاعتقاد عليه؛ فمنهم من توكّل عليه لأجل هذه المعاني كلها، ومنهم من توكل عليه لمشاهدة بعضها فكل عبد توكّله عن الوصف الذي به عرفه، وكلّ عرفه عن العذر المتجلي الذي عرفه؛ فكلّ يطيعه على قدر قربه منه، وكلّ يقرب على قدر علمه بقربه منه بقدر مايعرف من كينونية في مكنون كأنه، وكلّ بعلمه على قدر عنايته به ومن ورائه سرّ القدر، فمشاهدة كلّ عبد من مقامه وحاله عن وجد شهادته وجزاؤه نحو معاملته، والله يضاعف لمن يشاء هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليّهم بما كانوا يعملون، فدار السلام جامعة لهم وهم متفاوتون في درجاتها كدار الدنيا تجمعهم، وهو يرفعهم لديه في ملكوتها بتخصيص التولي وحسن الولايات عن تحسين المعاملات، الله يجيبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ومن الخصوص من توكّل عليه تعظيماً له وإجلالاً، ومنهم من توكّل عليه يقيناً بوعده ليحقّق صدقه كأنه قد أخذ الموعود بيده إذ يقول تعالى: ومن أوفى بعهده من الله أنّه كان وعده مأتياً، ومنهم من توكّل عليه استسلاماً لما شهد من قهر عزّه وعظيم قدره، ومنهم من توكّل عليه ليحفظ عليه ماله فيه، ومنهم من توكّل عليه ليحفظ له ما استحفظه ويعصمه في ماله عليه، ومنهم من توكّل عليه لقيامه بشهادته عن حسن معرفته، ومنهم من توكّل عليه تسليماً له عن جميل معاملته، ومنهم من فوّض إليه لحسن تدبيره عنده وبحكم تقديره، ومنهم من توكّل عليه لأن توحيده له وشهادة قيوميته، ذلك يقتضيه، فهذه كانت مواجيد أوليائه ومناهج أحبابه عن مشاهدة القرب ومعرفة القريب، وبعضهم أعلى مقاماً من بعض، وبعض هذه المشاهدات أقرب وأرفع فأعلاها من توكّل عليه للإجلال والتعظيم، وأوسطها من توكّل عليه للمحبة والخوف، وأدناها من توكّل عليه تسليماً له وتحبباً إليه، وقد ذكرنا أيضاً من توكّل العموم ما يستحي العارفون من ذكره، وينزّهون قلوبهم عن فكره، وهو التوكّل عليه في القلوب، وقد طوينا ذكر توكل خصوص الخصوص من صديقي المقربين لأنه لا يحتمله عقل عاقل ولا يسع أن يستودع في كتاب الناقل إذ ربما نظر فيه منكر جاهل، والله المستعان فدخل من عرفه فيما يحبّ لأجله، ورغبوا فيما مدح لوصفه ليحصل لهم وصف يعطيهم به الولي حسن ثناء، ينالون بذلك قربة منه ومحبة لديه.
ذكر بيان آخر في التوكّل
وما لا ينقص المتوكل ولا ينقص المتوكل على الله سبحانه مسألة مولاه فيما أحب من صالح الدنيا ومزيد الآخرة، إذ لم يقصد غير مطلوب، وكان مفوضاً إلى الله الأمور، ولكن يحتاج إلى معرفة الإجابة؛ فقد يكون المنع إجابة وقرباً إذا كان العطاء شغلاً عنه، وبعد الآن الخيرة فيما لا يعلم العبد، وقد يكون فيما يكره مما يعلم الله سبحانه حسن عاقبته، لا فيما يعقل العبد عاجل منفعته، فعليه التسليم لحكم الحاكم والرضا بقسم القاسم، فإن سأل تكاثراً من الدنيا، أو مالاً يحتاج إليه، وما ليس فيه صلاح قلبه، ولا قربة إلى ربّه، أخرجه من حقيقة التوكل بمقدار ما يخرجه من الزهد؛ وإن انقطع بالذكر عن المسألة أعطاه فوق عطاء من سأله، وإن سكت حياء من الوكيل إذ هو حسبه فشهد الكفاية ورضي بجميع التصرف، فهذا مقام من المواجهة عن مشاهدة القيومية وهو حال المقربين، ولا يقدح في التوكل تشرّف المتوكل إلى رزقه لأنه خلق ضعيفاً ذا فاقة، ورزقه معلوم لا بدّ منه، والمعلوم مقسوم فتشرّفه إلى القسم تشرّف منه إلى القاسم، ومن تشرّف إلى مولاه شرّفه وتولاه، ولكن إن تشرّف إلى الزيادة، وخرج من القناعة، وطلب العادة، وأراد الشيء قبل وقته، أو كره تأخره عنه إلى وقت مقدوره، فإنّ هذا يقدح في توكله وينقص من زهده، ولو كان الشرف إلى الرزق منها والتطلع إلى الرزق مجملاً ينقص التوكل لعللنا من باع واشترى وجهلنا من تعالج من علله بالدواء، لأن في ذلك تشرّفاً إلى الرزق وتطلعاً إلى البرء، فجاء من ذلك تضعيف التابعين وطعن على المتداوين من الصحابة والسلف الصالح، وأخرجهم ذلك من التوكل والزهد، فلهم منها مقامات، ولا يخرجه من التوكل مطالعته للعوض على معاملته من جزاء الآخرة، لأنّه قد شوّق إلى ذلك وندب إليه، ولكن لا يدخله ذلك في حقيقة الإخلاص ولا يرفعه إلى علو درجة الصدّيقين من المتوكلين، وقد يكون مزيداً على قدر حاله، إلاّ أنه لا يدخله في إخلاص المحبين، ولايرفعه في درجات المقربين، ولا يصح التوكل إلاّ بزهده في الدنيا، وأول الزهد ترك الرغبة في الحرام، وأول أحوال المتوكل في القوت ثم الصبر على حكم الحيّ الذي لا يموت، وأعلى التوكل التوكل عليه في الاستسلام للأحكام والرضا عنه في المسابقة بين الأقدام، وهو إطراح النفس ونسيانها شغلاً منه عنها بنفسها وحبّاً له، وحقيقة التوكل بعد مشاهدة يد الوكيل، فإذا ظهرت يده غابت الأيدي فيها، فعندها توكلت عليه بتدلل فقبل توكلك، واستسلمت إليه فسلمك، فإنه يتجلّى لك بوصف يلزمك حكماً، يضطرك الحكم إلى الحاكم ويوقفك الوصف على الوكيل، كما يضطرك الحاكم إلى الحكم ويجري لك وعليك ماشاء من القسم، فأعلى توكلك عليه حياءً منه، وإشهاده إياك توكله لك بحسن التدبير، لم يكلك إلى سواه ولم يولك إلا إياه: فإمّا أن يقتضيك تصبراً له، وإما أن يقتضيك تفويضاً إليه، وأما أن يقتضيك رضا عنه أو تسليماً له أو استراحة من تدبيرك لنفسك، أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحسب أي الحسب يجعله ما شاء كيف شاء، فقد قيل: حسبه أي التوكل، وقد قيل: التوكل حسبه من سائر المقامات، وقيل: الله حسبه أي يكفيه ممن سواه، قال تعالى معرفاً للكافة مسلياً للجماعة: (إنَّ اللَّّه بَالِغُ أمْرِهِ) الطلاق: 3؛ أي منفذ حكمه فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه، إلاّ أنّ من توكل عليه يكون الله حسبه أي يكفيه أيضاً مهم الآخرة والدنيا، ولا يزيد من لم يتوكل عليه جناح بعوضة في قسمه، كما لا ينقص من توكل عليه ذرة من رزقه، لكن يزيد من توكل عليه هدى إلى هداه ويرفعه مقاماً في اليقين على تقواه، ويعزه بعزه وينقص من لم يتوكل عليه من اليقين، ويزيده من التعب والهم ما يشتت قلبه ويشغل فكره، والمتوكل عليه يوجب له بذلك تكفير سيّئاته، ويلقي عليه رضاه ومحباته، والكفاية فقد ضمنها تعالى لمن صدق في توكله عليه، والوقاية فقد وهبها لمن أحسن تفويضه إليه، إلا أن الاختيار وعلم الاستئثار إليه والكفاية والوقاية يجعل ذلك ما شاء كيف شاء وأين شاء ومتى شاء من أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن حيث لا يعلم لأنّ العبد موجود، فجرى عليه الأحكام في الدارين، وفقير محتاج إلى اللطف والرحمة والرفق في المكانين، والله هو الغني الحميد المبدئ المعيد، وقيل لأبي محمد سهل: متى يصح للعبد
التوكل؟ فقال: إذا علم أن تدبير مولاه له خير من تدبيره لنفسه، فإن نظر مولاه له أحسن من نظره لنفسه، فيترك التفكر فيما كان والتمني لما يكون، فيترك التدبير ولله عاقبة الأمور وهو على كل حال محمود شكور. كل؟ فقال: إذا علم أن تدبير مولاه له خير من تدبيره لنفسه، فإن نظر مولاه له أحسن من نظره لنفسه، فيترك التفكر فيما كان والتمني لما يكون، فيترك التدبير ولله عاقبة الأمور وهو على كل حال محمود شكور.
ذكر أحكام مقام الرضا
الرضا عن الله سبحانه وتعالى من أعلى مقامات اليقين بالله، وقد قال تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاّ الإحْسَانُ) الرحمن: 60، فمن أحسن الرضا عن الله جازاه الله بالرضا عنه، فقابل الرضا بالرضا، وهذا غاية الجزاء ونهاية العطاء، وهو قوله عزّ وجلّ: (رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) التوبة100 وقد رفع الله الرضا على جنات عدن، وهي من أعلى الجنات، كما فضل الذكر على الصلاة فقال تعالى: (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) التوبة: 27 كما قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أكْبَرُ) العنكبوت: 45 والذكر عند الذاكرين المشاهدة، فمشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة وهو أحد الوجهين من الآية، والوجه الثاني ذكر الله للعبد أكبر من ذكر العبد لله، وقال أبو عبد الله الساجي: من خلق الله عباد يستحيون من الصبي يتلقفون مواقع أقداره بالرضا تلقّفاً، وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء، فالراضون عن الله عزّ وجلّ هم الذاكرون لله بما يحب ويرضى، فالراضون الأكبر جزاء أهل الذكر الأكبر، وهذا أحد المعاني في قوله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛ أي الرضا عنه، لأن السائلين يسألونه لهم فأعطاهم العفو، والذاكرون ذكروه فأعطاهم الرضا عنه عزّ وجلّ، ويكون أيضاً معناه: أعطيته النظر إليّ لأن الذكر يدخل في المشاهدة، فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غداً كما قابل الوصف بالوصف في قوله عزّ وجلّ: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) (ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) عبس: 38 - 39 وقال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يتجلى لنا ربنا ضاحكاً، والذكر قرب السمع.
والسمع يخرج إلى النظر، والرضا هو حال الموفق، واليقين هو حقيقة الإيمان، وإلى هذا ندب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عباس في وصيته له فقال: إعمل لله باليقين في الرضا، فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، فرفعه إلى أعلى المقامات ثم ردّه إلى أوسطها، كذلك قال لابن عمرو: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فند المشاهدة وهو الإحسان لأنه سُأل: ما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه، ثم ردّه إلى الصبر والمجاهدة وهو الإيمان، وهذا مكان العلم بأنّ الله يراه، وليس بعد هذا مكان يوصف، وقد رفع الله تعالى الرضا منه فوق ما أعطي من النظر، ففي الخبر أنّ الله تعالى يتجلّى للمؤمنين فيقول: سلوني، فيقولون: رضاك، فسؤالهم الرضا بعد النظر تفضيل عظيم للرضا، ولأن بالرضا دام لهم النظر لما كان الرضا موجب النظر، سألوا دوام الرضا ليدوم القرب والنظر، فسألوه تمام النعمة من حيث بدايتها، ولا يصلح أن يظهر في معنى قولهم: رضاك أكبر من هذا، ولا يرسم في كتاب حقيقة الأمر لأنّه على كشف وصف من صفات الذات، يوجب على العبد هيبة الربوبية، وخوف هذا عن القلوب محجوب وحكمة من سرائر الغيوب، وهذا في الدنيا ثواب لأهل الخشية عن معرفة خاصية، قال الله سبحانه: (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) البينة: 8، وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: (وَلَدَيْنَا مَزيدٌ) ق: 35 قال: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين: أحدها هدية من عند الله ليس عندهم في الجنان مثلها، وذلك قوله تعالى: (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) السجدة: 17والثانية السلام عليهم من ربّهم فيزيد ذلك على الهداية، فهو قوله تعالى: (سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ) يس: 58 والثالثة يقول الله تعالى إني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من الهدية ومن التسليم، فذلك قوله تعالى: (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) التوبة: 72 من النعيم الذي هم فيه، وروي أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لطائفة من المؤ منين: ماأنتم؟ قالوا نحن المؤمنون، فقال: ماعلامة إيمانكم قالوا: نصبر عند البلاء ونشكر عند الرضا ونرضى بمواقع القضاء، فقال: مؤمنون ورب الكعبة، وفي خبر آخر أنّه قال: حلماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، فشهد لهم بالإيمان بعد وصف الرضا، وكذلك جعل لقمان الحكيم الرضا من شرط الإيمان لايصلح إلا به، فقال في وصيته: للإيمان أربعة أركان لا يصلح إلا بهنّ، كما لا يصلح الجسد إلاّ باليدين والرجلين: ذكر منها الرضا بقدر الله وحدثونا في الإسرائيليات أنّ عابداً عبد الله دهراً طويلاً، فرأي في المنام فلانة الراعية رفيقتك في الجنة، فسأل عنها إلى أن وجدها، فاستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها فكان يبيت قائماً وتبيت نائمة، ويظل صائماً وتظل مفطرة، فقال: أما لك عمل غير مارأيت؟ قالت: ما هو والله إلاّ مارأيت، لا أعرف غيره، فلم يزل يقول: تذكري حتى قالت: خصيلة واحدة هي فيَّ، إن كنت في شدة لم أتمنَّ في رخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنَّ أني في صحة، وإن كنت في الشمس لم أتمنَّ أني في الظل قال: فوضع العابد يده على رأسه فقال: أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العبد، وقد روينا عن ابن مسعود: من رضي بما ينزل من السماء إلى الأرض غفر له، وقال أبو الدرداد: ذروة الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر.
وروي عن محمد بن حويطب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له، وفي الخبر المشهور: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافاً ورضي به، وفي مثله أيضاَ من رضي من الله عزّ وجلّ بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل، وقد روينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثاً: من طرق أهل البيت إذا أحب الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه، فالرضا عن الله عزّ وجلّ والرحمة للخلق وسلامة القلب والنصيحة للمسلمين وسخاوة النفس مقام الأبدال من الصدّيقين، وقد روينا في أخبار موسى عليه السلام أنّ بني إسرائيل قالوا: سل ربّك أمراً إذا فعلناه يرضى به عنا، قال موسى: إلهي قد سمعت ما يقولون، فقال: يا موسي قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم، ويشهد لهذا الخبر المروي عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد منه بحيث أنزله من نفسه، وقد روينا حديثاً حسناً كالمسند عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائقة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان، يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا قال: فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم الحساب؟ فيقولون: ما رأينا حساباً فيقولون: هل جزتم الصراط فيقولون: ما رأينا الصراط فيقال لهم: رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً فتقول الملائكة: من أمة مَنْ أنتم؟ فيقولون مِنْ أمة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقولون: نشدناكم الله، حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته فيقولون: وما هما؟ فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم الله لنا، فتقول الملائكة: يحقّ لكم هذا، هكذا كان في كتاب شيخنا عن أنس، وقال فيه لطائفة من أمتي ففيه دليل على المسند، وقد جاء الأثر: من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، وقال بعض علمائنا: أعرف في الموتى عالماً ينظرون إلى منازلهم من الجنان، في قبورهم بغدى عليهم ويراح من الجنة بكرة وعشيًّا، وهم في غموم وكروب في البرزخ، لو قسمت على أهل البصرة لماتوا أجمعين، قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين، إلا أنهم لم يكن لهم التوكل ولا من الرضا نصيب، وقد جاء في فرض الرضا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أعطوا اللّّه الرضا من قلوبكم تطفروا بثواب فقركم، وإلا فلا، وقرن لقمان الرضا بالتوحيد فقال في وصيته لابنه: أوصيك بخصال تقرّبك إلى الله وتباعدك من سخطه: الأولى تعبد الله لا تشرك به شيئاً، والثانية الرضا بقدر الله فيما أحببت وكرهت، وقال في وصيته: ومن يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يده ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره، فمن الرضا سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وقناعة العبد بكل شيء، واغتباطه بقسمة ربه وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلام العبد للمولى في كل شيء ورضاه منه بأدنى شيء وتسليمه له الأحكام والقضايا باعتقاد حسن التدبير وكمال التقدير فيها، ولتسليم العبد إلى مولاه ما في يديه رضا بحكمه عليه، وإن لا يشكو الملك السيد إلى العبد المملوك ولا يتبرّم بفعل الحبيب، ولا يفقد في كل شيء حسن صنع القريب، ومن الرضا أن عند أهل الرضا لا يقول العبد: هذا يوم شديد الحرّ ولا هذا يوم شديد البرد، ولا يقول: الفقر بلاء، ومحنة والعيال همّ وتعب، والاحتراف كدّ ومشقّة، ولا يفقد بقلبه من ذلك ما لا يغرّه به بل يرضي القلب ويسلم ويسكن العقل، ويستسلم بوجود حلاوة التدبير واستحسان حكم التقدير، كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في انتظار مواقع القدر، وقال ابن مسعود: الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أيّهما ركبت، إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البدل، وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: إنّ فلاناً قال: وددت أنّ الليل أطول مما هو فقال: قد أحسن، وقد أساء، أحسن حيث تمنى طوله للعبادة وأساء إذا لم يحبّ ما لم يحب الله.
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء، وقال ذات يوم لامرأته عاتكة وقد غضب: والله لأسوءنك: فقالت أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد أن هداني الله له؟ قال: لا، قالت: فأي شيء تسوءني إذاً، وقال جعفر بن سليمان الصنعي قال سفيان الثوري يوماً عند رابعة: اللهم ارضَ عنا، فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضا وأنك غير راضٍ عنه؟ فقال: أستغفر الله، قال جعفر فقلت لها: متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة، وقال فضيل بن عياض: إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي، وفي أخبار داود: ما لأوليائي والهمّ بالدنيا، إنّ الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم، وفي بعضها: يا داود، إياك والاهتمام بالدنيا، محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمّون، إياك والغم ّولاتهتم للخير وأنت تريدني، ويقال: أكثر الناس همًّا في الدنيا أكثرهم همًّا في الآخرة، وأقلّهم همًّا في الدنيا أقلّهم همًّا في الآخرة، وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإيمان بالقدر يذهب الهمّ والحزن، واعلم أنّ الفرح بالدنيا يخرج همّ الآخرة من القلب، والغمّ على الدنيا يحجب عن الحزن على فوت الآخرة، وذكر عند رابعة عابد له عند الله منزلة، وكان قوته ما يقمم من منزلة لبعض ملوكهم فقال رجل عندها: فما يضر هذا إذا كانت له عند الله منزلة أن يسأله، فيجعل قوته في غير هذا فقالت له: اسكت يا بطال، أماعلمت أنّ أولياء الله هم أرضى عنه أن يتخيروا عليه إن ينقلهم من معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم، وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان: إنّ الله تعالى من كرمه قد رضي من عبيده بما رضي العبيد من مواليهم قلت: وكيف ذلك؟ قال: أليس مراد العبد من الخلق أن يرضى عنه مولاه؟ قلت: نعم قال: فإن محبة الله من عبيده أن يرضوا عنه، وقال الأعمش: قال لي أبو وائل: يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، وقال الله عزّ وجلّ في معناه: (وَيَسْتَجيبُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِلحَاتِ) الشورى: 26، أي يعطيهم ويستجيب لهم، والاستجابة الطاعة كقوله تعالى: (فَلْيَسْتَجيبُوا لي) البقرة: 186، فلما استجابوا له استجاب لهم، أطاعوه فيما أحبّ فأطاعهم فيما يحبون، وهذا أحد وجهي الآية كقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) البقرة: 40 وهو على تأويل من قرأ: هل يستطيع ربك أن يطيعك؟ قال ابن عباس: كان الحواريون أعلم بالله أن يشكوا أنّ اللّّه يقدر على ذلك، وإنّما معناه: هل يستطيع أن يطيعك؟ وروينا أيضاً عن عائشة مثله، وقال الفضيل: من أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء، ومن خاف من الله خاف منه كل شيء، وفي أخبار موسى عليه السلام يا رب دلّني على أمر فيه رضاك حتى أعمله، فأوحى الله تعالى إليه إنّ رضاي في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره، قال: يا رب دلني عليه قال: فإن رضاي في رضاك بقضائي، وقد يروى على وجه آخر أن بني إسرائيل سألوا موسى فقالوا: لو علمنا في أي شيء رضا ربنا لفعلناه، فأوحى الله إليه قل لهم: رضاي في رضاهم بقضائي وفي مناجاة موسى عليه السلام يا رب أي خلقك أحبّ إليك؟ قال: من إذا أخذت منه المحبوب سالمني قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في الأمر فإذا قضيت له سخط قضائي، وقد ورد أشد من هذا كله أن الله تعالى قال: (أَنَا اللهُ لاَ إلّهَ إلاّ أَنَا) طه: 14، من لم يصبر على بلائي ويرضَ بقضائي ويشكر نعمائي فليتخذ ربًّا سواي، وقد رويناه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق ومثله في الشدة يقول الله تعالى: قدّرت المقادير ودّبرت التدبير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حين يلقاني ومن سخط فله السخط مني حين يلقاني، وفي الخبر: أوّل ما كتب لموسى عليه السلام: (إنَّني أنَا اللهُ لاَ إلَهَ إلاّ أنَا) طه: 14، من رضي بحكمي واستسلم لقضائي وصبر على بلائي كتبته صديقاً وحشرته مع الصدّيقين يوم القيامة.
وروينا في الخبر المشهور بمعناه يقول الله جل جلاله: قدرت الخير والشرّ وأجريتهما على أيدي عبادي، فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشرّ وأجريت الشرّ على يديه، وويل ثم ويل لمن قال: لِمَ وكيف؟ وفي الأخبار السالفة أن نبيًّا من الأنبياء شكا إلى الله الجوع والفقر عشر سنين، كل ذلك لا ينظر في مسألته فأوحى الله إليه: لِمَ تشكو؟ هكذا كان بدوّك عندي في أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض، وهكذا سبق لك مني وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل ما قدرت عليك، فيكون ما تحبّ فوق ما أحب ويكون ما تريد فوق ما أريد، وعزّتي وجلالي لن تخالج في صدرك مرة أخرى لأمحونّك من ديوان النبوّة، وروينا أنّ آدم عليه السلام كان بعض أولاده الصغار يصعدون على جسمه وينزلون، يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه، كذلك قال وهو مطرق إلى الأرض ولا ينطق ولا يرفع رأسه فقال له بعض ولده يا أبت، ألا ترى مايصنع هذا بك لو نهيته عن هذا فقال: يا بني، إني رأيت ما لم تروا، وعلمت ما لم تعلموا، إني تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان، ومن دار النعيم إلى دار الشقاء، فأخاف أن أتحرك حركة أخرى فيصيبني ما لا أعلم، روينا في بعض الأخبار أنّه قال: إنّ الله ضمن لي إن حفظت لساني أن يردّني إلى الدار التي أخرجني منها، وقال أبو محمد سهل: حظّ الخلق من اليقين على قدر حظّهم من الرضا، وحظّهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله، وروى عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغمّ والحزن في الشك والسخط، ومن الرضا أن لا تذمّ شيئاً مباحاً ولا تعيبه إذا كان بقضاء مولاه، شاهداً للصانع في جميع الصنعة ناظراً إلى إتقان الصنع والحكمة وإن لم يخرج ذلك عن معتاد المعقول والعادة، وبعض العارفين يجعل هذه الأشياء في باب الحياء من الله عزّ وجلّ، ومنهم من يقول: هي من حسن الخلق مع الله تعالى، ومنهم من جعله من باب الأدب بين يدي الله، فإذا كان هذا كذلك كان ذم الأشياء التي أبيحت وعيبها من سوء الخلق مع الله، وكانت من سوء الأدب بين يدي الله، وأعظم من ذلك أنها تدخل في باب قلة الحياء من الله، ويصلح أن يكون هذا أحد معاني الخبر الذي جاء: قلّة الحياء كفر، يعني كفر النعمة بأن يذم ويعيب بعض ما أنعم الله به عليه من الإرفاق والإلطاف، إذ كان فيها تقصير عن تمام ملها أو كانت مخالفة لهواه منها، فيكون ذلك كفراً للنعمة وقلّة حياء العبد من المنعم، إذ قد أمره بالشكر على ذلك، فبدل الشكر كفراً لأنّ أحداً لو اصطنع لك طعاماً فعبته وذممته كره ذلك منك، فكذلك تعالى يكره ذلك منك، وهذا داخل في معرفة معاني الصفات، وفي معنى ما قيل أعرفكم بربّه أعرفكم بنفسه، لأنّك إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق عرفت منها صفات خالقك، وبعض الراضين يجعل ذم الأشياء وعيبها بمنزلة الغيبة لصانعها لأنها صنعته ونتاج حكمته، ونفاد علمه وحكم تدبيره وتدبير مقاديره، لأنه أحكم الحاكمين وخير الرازقين وأحسن الخاقين، له في كل شيء حكمة بالغة وفي كل صنعة صنع متقن، ولأنّك إذا عبت صنعة أحد وذممتها سرى ذلك إلى الصانع، لأنّه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها، إذ كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقتها، وكان الورعون لا يعيبون صنعة عند كراهة الغيبة له وذلك أنّ الراضي عن الله متأدب بين يدي الله يستحي أن يعارضه في داره أو يعترض عليه في حكمه، فصاحب الدار يصنع في حكمه ما شاء والحاكم يحكم بأمره كيف شاء، والعبد راضٍ بصنع سيده مسلم لحكمة حاكمه
وروي في الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام مرّ مع نفر من أصحابه بجيفة كلب فغطوا آنافهم وقالوا: أف أف، ما أنتن ريحه فلم يخمر عيسى عليه السلام أنفه وقال: ما أشد بياض أسنانه، أراد أن ينهاهم بذلك عن الغيبة ويعلمهم ترك عيب الأشياء، كيف هو يرى بعين نفسه أنّ الصنعة من صانعها، فهو يقلبها ويصرفها على معاني نظره، وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ما عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، وقال أنس: خدمت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشر سنين، ليس كل امرئ كما يريد صاحبي، ما قال لي لشيء فعلته: لما فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته، ولا قال في شيء كان: ليته لم يكن ولا لشيء لم يكن: ليته كان، وكان يقول: لو قضى شيء لكان، وهذا وصف الراضي الموقن القائم بشهادته، فبالنظر في هذه الدقائق والوقوف عندها رفع القوم عند الله إلى مقام المقربين، وبالتهاون بها والغفلة عنها نغلت القلوب ففسدت حتى لم تصلح للمحبة والرضا، وهذه المعاني من الاعتراضات، والتخير هو تقدم بين يدي الله وذاك التدبير الذي يشير إليه سهل ويقول: إنّ تدبير الخلق حجبهم عن الله عزّ وجلّ، وحكي لنا أنّ بعضهم صحب بعض العارفين في طريق فعبث بشيء فنحاه من مكان إلى مكان آخر فقال له العارف: ماذا صنعت؟ أحدثت في الملك حدثاً عن غير ضرورة ولا سنّة، ولا تصحبني أبداً فلو لم يكن لنا من الذنوب إلا هذه الأشياء لقد كان كافياً، وفوق ذلك تهاوننا بها وأعظم من ذلك ترك التوبة والاستغفار منها، وأعمال طلاب الرضا من الله مضاعفة على أعمال المجاهدين في سبيل الله لأن أعمال المجاهدين تضاعف إلى سبعمائة ضعف، وتضعيف طالبي الرضا لا تحصى، قال الله تعالى: (وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) البقرة: 261، وقال تعالى: (فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثيَرةً) البقرة: 245، قيل: الحسنة إلى ألفي ألف حسنة، وقد قال سبحانه: (وَمَثَلُ الَّذينَ يُنِفْقُونَ أَمَوالَهُمُ ابِتْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبيتاً مِنَ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ) البقرة: 265، فكم في هذه الحنة من سنبلة وحبة، فهؤلاء الذين قال: والله يضاعف لمن يشاء هم أهل الرضا عنه، وهم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً لأجله لمضاعفته لهم أضعافاً كثيرة، فمن عقل عن الله حكمته كان مع الله تعالى فيما حكم مسلماً له ما شهد، لأنه سبحانه باختياره أنشأ الأشياء، وبمشيئته أبداها وعنه يتصرف المقدور وإليه عواقب الأمور، لا يكون مع نفسه فيما يهواه ولا مع معتاده وعرفه فيما يعقل، وقال بعض العارفين: قد نلت من كل مقام حالاً إلاّ الرضا، فما لي منه إلا مشام الريح، وعلى ذلك لو أدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلني النار لكنت بذلك راضياً، وقيل لعارف فوقه: نلت غاية الرضا عنه فقال: الغاية لا، ولكن مقام من الرضا قد نلته حتى لو جعلني جسراً على جهنم يعبر الخلائق علي إلى الجنة، ثم ملأ بي جهنم تحلة لقسمه وبدلاً من خليقته لأحببت ذلك من حكمه، ورضيت به من قسمه، وحدثونا عن الروذباري قال: قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقي قول فلان: وددت أنّ جسدي قرض بالمقاريض، وأنّ هذا الخلق أطاعوه، مامعناه قال: يا هذا، إن كان من طريق الإشفاق على الخلق والنصح فأعرف، وإن كان من طريق التعظيم والإجلال فلا أعرف، قال ثم غشى عليه، وقد كان عمران بن حصين استسقى بطنه فلبث ملقى على ظهره ثلاثين سنة سطحياً، لا يقوم ولا يقعد، قد نقب له في سرير من جريد كان تحته موضعاً لغائطه وبوله، فدخل عليه مطرف أو أخوه العلاء فجعل يبكي لما يرى من حاله، فقال: لِمَ تبكي؟ فقال لأني أراك على هذه الحال العظيمة فقال: لا تبكي فإنّ أحبه إليَّ أحبه إلى الله ثم قال: أحدثك شيئاً لعل الله أن ينفعك به، واكتم عني حتى أموت أنّ الملائكة تزورني فآنس بها، وتسلّم علّي فأسمع تسليمها، أراد عمران رحمه الله بذلك أن يعلم أنّ هذا البلاء ليس بعقوبة: لأن مثل هذه الآية إنما هو درجة ورحمة، وبلاء العقوبات لا يكون معه الآيات ولا يوجد عنده الحلاوات، ولا مزيد القلوب من نسيم ريحان الغيوب ولأنه كان حزن عليه فأراد أن يبشره: فلا تذكر الحبيب ولا حب لقاء الطبيب، كما أنشد بعض المحبين:
با حبيباً بذكره نتداوى ... وصفوه لكل داءٍ عجيب
من أراد الطبيب سرّ إذا ... اعتلّ اشتياقاً إلى لقاء الطبيب
من أراد الحبيب سار إليه ... وجفاً الأهل دونه والقريب
ليس داء المحب داء يداوى ... إنما برؤه لقاء الحبيب
قال: ودخلنا على سويد بن شعبة نعوده، فرأينا ثوباً ملقى فما ظننّا أَنَّ تحته شيئاً حتى كشف، فقالت له امرأته: أهلي فداؤك ما نطعمك ما نسقيك فقال: طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضواً لا أطعم طعاماً ولا أسيغ شراباً منذ كذا، فذكر أياماً ثم قال: وما يسرني أني نقصت من هذا قلامة ظفر، واعتلّ حذيفة علّة الموت فجعل يقول: أخنق خناقك فوعزتك أنك لتعلم أنّي أحبك، فلما حضره الموت جعل يقول: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، وروى أيضاً مثل هذا عن أبي هريرة، ولما قدم سعد إلى مكة وكان قد كفّ بصره جاءه الناس يهرعون، كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة، دعا له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم، فذكر قصة قال في آخرها فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فردّ الله عليك بصرك، فتبسم ثم قال: يابني، قضاء الله عندي أحسن من بصري، وقال إنّ بعض هذه الطائفة ضاع ولده وكان صغيراً ثلاثة أيام لا يعرف له خبراً فقيل له: لو سألت الله أن يرده عليك فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشدّ من ذهاب ولدي، وقد روينا عن بعض العباد أنه قال: أذنبت ذنباً فأنا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة، وكان قد اجتهد في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب قيل له: وما هو قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن، وقال بعض السف: لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحبّ إليّ من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم يقضه، وحدثونا عن بشر الحافي قال: رأيت بعبادان رجلاً قد قطعه البلاء وقد سالت حدقتاه على خديه، وهو في ذلك كثير الذكر عظيم الشكر لله، قال وإذا هو قد صرع من حبه به قال: فوضعت رأسه في حجري وجعلت أسأل الله عزّ وجلّ كشف مابه، وأدعو له، فأفاق فسمع دعائي فقال: من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي ويعترض عليه في نعمه عليّ؟ قال ونحى رأسه، قال بشر فاعتقدت أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء، وقيل لعبد الواحد ابن زيد: ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة فقصده فقال: حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به قال: لا قال: هل أنست به قال: لا قال: فهل رضيت عنه قال: لا قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة قال: نعم قال: لولا أني أستحي منك لأخبرتك أنّ معاملتك خمسين سنة مدخوله، أراد بذلك أنه لم يقربك فيجعلك في المقربين فيكون مزيدك لديه من أعمال القلوب، وكذلك يصنع بأوليائه، إنما أنت عنده في طبقة أصحاب اليمين، فمزيد العموم من أعمال الجوارح، وقد يكون الرجل مخلصاً في مقامه وإن كان فوقه فوق، وقد روينا عن ابن محيريز، وكان من عباد أهل الشام وعلمائهم، كلمة غريبة المعنى دقيقة في معنى المخالفة لله عزّ وجلّ، وإن كان قد فسرها فإنه لم يكشف معناها لفهم السامعين منه والحاضرين عنده فيحتاج تفسيرها إلى تفسير، روينا عنه أنه قال: كلكم يلقى الله تعالى، ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشير بها، ولو كان به شلل ظل يواريها، يعني بذلك أن الذهب من زينة الدنيا، وقد ذم الله تعالى الدنيا وأنّ البلاء زينة أهل الآخرة وقدّ مدح الله الآخرة، أي فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرتها وفخرت بها وإذا أعطاك زينة الاخرة وهي المصائب والبلاء كرهتها وأخفيتها لئلا تعاب بذلك، فحسب عليه حب الدنيا والتزين بها وكراهة البلاء تكذيباً لله ورداً عليه ما وصفه، وهذا يدخل في باب الزهد وفي باب الرضا، ويدخل على من أخفى الفقر والبلاء حياء من الناس لئلا يعاب بذلك، فهو من ضعف يقينه بقوّة شاهد الخلق، ويدخل فيه من أظهر الغنى من غير نية ولا تحدث بنعمة الله، فذلك أيضاً من قوّة شاهد حب الدنيا، وكذلك قال أبو سليمان الداراني: ثلاث مقامات لا حدّ لها، الزهد والورع والرضا، وخالفه سليمان ابنه، وكان عارفاً، ومن الناس من كان يقدمه على أبيه فقال: بلى، من تورع في كل شيء فقد بلغ حدّ الورع، ومن زهد في كل شيء فقد بلغ حدّ الزهد، ومن رضي عن الله في كل شيء فقد بلغ حدّ الرضا، ولا ينقص الراضي من مقام الرضا مسألة مولاه مزيد الآخرة وصلاح الدنيا، تعبداً بذلك وافتقاراً إليه في كل شيء لأن في ذلك رضاه ومقتضى تمدحه بمسألة الخلائق له، فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى وابتغاء القرب
منه حبًّا له وآثره على ما سواه كان فاضلاً في ذلك، لأنه قد ردّ قلبه إليه وجمع همه بذلك، وهذا على قدر مشاهدة الراضي عن معرفته، وهو مقام المقربين ومقتضى حاله، لأنه يسأل عن عمله بعلمه في وقت من أحواله كما يسأل عن جملة عماله بعلومه في جملة عمره، وهذا أصل فاعرفه، فهو طريق الصوفيين وعليه عمل العارفين من السلف، فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف، وإن كان دعاؤه تمجيد السيدة وثناء عليه شغلاً بذكره ونسياناً لغيره وولهًا بحبه، لأنه مستوجب لذلك بوصفه، ولأنه واجب عليه، فقد استغرقه وجوب ما عليه عماله، فهذا أفضل وهو مقام المحبين، وهو من القيام بشهادته، وقد دخل فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعمله في وقته، وللعلماء مسألة قد اختلفوا فيها: في أهل المقامات ثلاث، أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله، وعبد يحب البقاء للكد والخدمة للمولى، وعبد قال: لا أختار شيئاً بل أرضى مايختار لي مولاي، إن شاء أحياني أبداً وإن شاء أماتني غداً، قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم لأنه أقلّهم فضولاً، وهذا كما قاله في الاعتبار بترك الاعتراض والاختبار، لأنه دخل في الدار بغير اختيار، وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا اختيار، لأنّ مقام الرضا أعلى من مقام التشوق، ثم الذي يليه في الفضل الذي يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله، وهذا مقام في المحبة وفي حقيقة الزهد في الحياة. هـ حبًّا له وآثره على ما سواه كان فاضلاً في ذلك، لأنه قد ردّ قلبه إليه وجمع همه بذلك، وهذا على قدر مشاهدة الراضي عن معرفته، وهو مقام المقربين ومقتضى حاله، لأنه يسأل عن عمله بعلمه في وقت من أحواله كما يسأل عن جملة عماله بعلومه في جملة عمره، وهذا أصل فاعرفه، فهو طريق الصوفيين وعليه عمل العارفين من السلف، فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف، وإن كان دعاؤه تمجيد السيدة وثناء عليه شغلاً بذكره ونسياناً لغيره وولهًا بحبه، لأنه مستوجب لذلك بوصفه، ولأنه واجب عليه، فقد استغرقه وجوب ما عليه عماله، فهذا أفضل وهو مقام المحبين، وهو من القيام بشهادته، وقد دخل فيما ذكرناه من مقتضى حاله بالعمل بعمله في وقته، وللعلماء مسألة قد اختلفوا فيها: في أهل المقامات ثلاث، أيهم أفضل؟ عبد يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله، وعبد يحب البقاء للكد والخدمة للمولى، وعبد قال: لا أختار شيئاً بل أرضى مايختار لي مولاي، إن شاء أحياني أبداً وإن شاء أماتني غداً، قال: فتحاكموا إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرضى أفضلهم لأنه أقلّهم فضولاً، وهذا كما قاله في الاعتبار بترك الاعتراض والاختبار، لأنه دخل في الدار بغير اختيار، وكذلك يكون خروجه منها على معنى دخوله بلا اختيار، لأنّ مقام الرضا أعلى من مقام التشوق، ثم الذي يليه في الفضل الذي يحب الموت شوقاً إلى لقاء الله، وهذا مقام في المحبة وفي حقيقة الزهد في الحياة.
وفي الخبر: من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، والذي يحب البقاء للخدمة وكثرة المعاملة هو فاضل، بعد هذين مقامهُ قوّة الرجاء وحسن الظن في العصمة، وله أيصاَ مطالعات من الأنس وملاحظات في القرب، به طاب مقامه وعنده سكنت نفسه وقصرت أيامه، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفضل المؤمنين إيماناً أو قال: أكمل المؤمنين إيماناً من طال عمره وحسن عمله، هذا لأن الأعمال مقتضى الإيمان إذ حقيقة الإيمان إنما هو قول وعمل، وليس بعد هؤلاء مقام يفرح به ولا يغبط صاحبه عليه، ولا يوصف بمدح إنما هو حب البقاء لمتعة النفس وموافقة الهوى، وقد تشرف النفس على الضعفاء من أهل هذا الطريق ويختفي فيها علة، وهو أن يحب البقاء لأجل النفس وللمتعة بروح الدنيا وما طبعت عليه من حب الحياة، وتكره الموت لمنافرة الطبع ولطول الأمل، فيتوهم أنه ممن يحب البقاء لأجل الله وطاعته، وهذا هو من الشهوة الخفية التي لا يخرجها إلا حقيقة الزهد في الدنيا، ولا يفضل في هذا الطريق االثالث إلا عارف زاهد دائم المشاهدة باليقين، فأما المعتل بوصفه وهواه فليس يقع به اعتبار في طريق ولا مقام، واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أني مت فقال له يوسف: ولِمَ؟ قال لما أتخوف من الفتنة فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء فقال الثوري: ولِمَ تكره الموت قال: لعلي أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً فقيل لوهيب: أي شيء تقول أنت فقال: أنا لا أختار شيئاً أحبّ ذلك إليّ أحبه إلى الله قال: فقبّل الثوري ما بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة، يعني مقام الروحانيين وهم المقربون أهل الروح والريحان، وأولو المحبة والرضوان، كما قال تعالي (فَرَوْحٌُ وَرَيَحانٌ) الواقعة: 89، يعني لهم ريح من نسيم القرب وريحان من طيب الحب، وأيضاً أنّه تعالى لما ذكر أنّ، لأصحاب اليمين في كل شدة وهول سلامة، وكان المقربون هم الأعلون، كان أيضاً فيما دلّ الفهم عليه، أنّ للمقربين من كل هول روحاً به لشهادتهم القريب، وفي كل قرب منه ريحان لقرب الحبيب فبذلك علوا وبذلك فضلوا، وهكذا قال بعض الصوفية: سرّ العارف في الأشياء واقف مثل الماء في البئر لا يختار المقام وإن أخرج خرج، فإن ذم هذا الراضي ما ذمه الله، وكره ما كرهه الله لم ينقص ذلك رضاه، وكان محسناً في فعله لموافقته مولاه، وإن لم يرضَ بحاله نقص في الدين والآخرة أو كره مزيد الدنيا من الكثرة والجمع والادخار لم يقدح ذلك في رضاه لأنه من التحقق بالزهد، وهو في جميع ذلك موافق للعلم، والله تعالى أعلم بأحكامه من العبد وأغير على نفسه من الغير، وأعلى مشاهدة من الخلق، له المثل الأعلى، فهو على ذلك يشهد أحكامه ويذم المحكوم عليه إذ تعدى حدود أمره، وينفذ علمه بمشيئته ويمقت العاصين له باجتراح نهيه، حكمة منه وعدلاً، كما أنه يشهد يده في العطاء ويمدح المنفقين، ويمضي إرادته بالقضاء بتوفيقه، ويشكر العاملين كرماً منه وفضلاً، كذلك الراضي عنه موافق فيما حكم ومتبع له فيما رسم، ومسلم له فيما قدر وعالم منه راض بما دبر، ومستعمل لما شرع ومواطئ لرسوله، يذم ما ذمه مولاه ويمدح ما مدحه لأجل مولاه لا لأجل نفعه إياه، والتحدث بالأوجاع والإخبار عن المصائب لا ينقص حال الراضي إذا رآها نعمة من الله عليه، وكان القلب مسلماً راضياً غير متسخط ولا متبرم بمر القضاء، وأوّل الرضا الصبر ثم القناعة، ثم الزهد ثم المحبة، ثم التوكل، فالرضا حينئذ حال المتوكل والتوكل مقام الرضا، وقال فضيل: إذا استوى العطاء والمنع عند العبد فهو الرضا، وقال غيره: إذا لم يختلف قلبه في العدم والوجود وفي الصحة والسقم فقد رضي، وقال الثوري: منع الله عطاءه لأنه يمنع من غير بخل ولا عدم، فمنعه اختبار وحسن نظر، وهذا كما قال لأن حقيقة المنع إنما يكون لمن لك عنده شيء فمنعك أو تستحق عليه شيئاً فلم يعطك، فأما من لا تستحق عليه شيئاً، ولا لك معه شيء لأنه الأول قبل كل شيء، والمظهر لكل شيء، والمالك لما أظهر، والمختار لما خلق وليس لأحد من خلقه اختيار، ولا في حكمه اشتراك، له الخلق والأمر ولا يشرك في حكمه أحداً، والعبد لم يكن شيئاً مذكوراً، فكل شيء اختاره فهو عطاء منه على تفاوت مقادير وضروب أحكام، وتصاريف تدبير حلو
ومر ولطف وعنف وشدة ورخاء، وموافقة للنفس ومرفق ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق، فالصبر على الأحكام مقام المؤمنين والرضا بها مقام الموقنين، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واعلم أنّ الرضا في مقامات اليقين وأحوال المحبين، ومشاهدة المتوكلين وهو داخل في كل أفعال الله سبحانه لأنها عن قضائه، لا يكون في ملكه إلاّ ما قضاه فعلى العارفين به الرضا بالقضاء، ثم يرد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الأحكام، فما كان من خير وبرّ أمر به أو ندب إليه، رضي به العبد وأحبه شرعاً وفعلاً ووجب عليه الشكر، وماكان من شرّ نهى عنه وتهدد عليه، فعلى العبد أن يرضى به عدلاً وقدراً ويسلمه لمولاه حكمة وحكماً، وعليه أن يصبر عنه ويقر به ذنباً ويعترف به لنفسه ظلماً، ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب، وأنه اجترحه بجوارحه اكتساباً ورضاً بأنّ لله الحجة البالغة عليه، وأنّ لا عذر له فيه، ويرضى بأنّه في مشيئة الله عزّ وجلّ من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاء، أو عقوبة له بعدله وحقّه إن شاء، وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقد إلا من نفسه فعلاً، ويرضى به عن الله ولا يرضى به من نفسه لأنّ الموقنين والمحبين لا يسقطون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينكرون إنكار المعاصي وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل أنّ الإيمان فرضها، والشرع ورد بها ولأنّ الحبيب كرهها، فكانوا معه فيما كره كما كانوا معه فيما أحبّ، ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان، ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع الرسول ولا تسقط أتباعه، فمن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله، وكذب على الموقنين والمحبين، ألم ترَ أنّ الله تعالى ذم قوماً رضوا بالدنيا ورضوا بالمعاصي ورضوا بالتخلف عن السوابق، فقال سبحانه: (رَضُوا بالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا) يونس: 7، فذمهم بذلك وقال تعالى: (وَلِتَصْغى إلَيْهِ أفْئِدَةُ الَْذينَ لاَيُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ وَلِيرْضَوْهُ وَلِيَقْترِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ) الأنعام: 113، فعابهم به وقال تعالى: (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) التوبة: 87، يعني النساء، وهذا جمع التأنيث وطبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون، فمن رضي بالمعاصي والمناكير منه أو من غيره، وأحب لأجلها ووالى ونصر عليها أو ادّعى أنّ ذلك في مقام الرضا الذي يجازى عليه بالرضا أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم، فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. ومر ولطف وعنف وشدة ورخاء، وموافقة للنفس ومرفق ومخالفة لما يهوى مما لطبعها لا يوافق، فالصبر على الأحكام مقام المؤمنين والرضا بها مقام الموقنين، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، واعلم أنّ الرضا في مقامات اليقين وأحوال المحبين، ومشاهدة المتوكلين وهو داخل في كل أفعال الله سبحانه لأنها عن قضائه، لا يكون في ملكه إلاّ ما قضاه فعلى العارفين به الرضا بالقضاء، ثم يرد ذلك إلى تفصيل العلم وترتيب الأحكام، فما كان من خير وبرّ أمر به أو ندب إليه، رضي به العبد وأحبه شرعاً وفعلاً ووجب عليه الشكر، وماكان من شرّ نهى عنه وتهدد عليه، فعلى العبد أن يرضى به عدلاً وقدراً ويسلمه لمولاه حكمة وحكماً، وعليه أن يصبر عنه ويقر به ذنباً ويعترف به لنفسه ظلماً، ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب، وأنه اجترحه بجوارحه اكتساباً ورضاً بأنّ لله الحجة البالغة عليه، وأنّ لا عذر له فيه، ويرضى بأنّه في مشيئة الله عزّ وجلّ من عفو عنه برحمته وكرمه إن شاء، أو عقوبة له بعدله وحقّه إن شاء، وفصل الخطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقد إلا من نفسه فعلاً، ويرضى به عن الله ولا يرضى به من نفسه لأنّ الموقنين والمحبين لا يسقطون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينكرون إنكار المعاصي وكراهتها بالألسنة والقلوب من قبل أنّ الإيمان فرضها، والشرع ورد بها ولأنّ الحبيب كرهها، فكانوا معه فيما كره كما كانوا معه فيما أحبّ، ومقام اليقين لا يسقط فرائض الإيمان، ومشاهدة التوحيد لا تبطل شرائع الرسول ولا تسقط أتباعه، فمن زعم ذلك فقد افترى على الله ورسوله، وكذب على الموقنين والمحبين، ألم ترَ أنّ الله تعالى ذم قوماً رضوا بالدنيا ورضوا بالمعاصي ورضوا بالتخلف عن السوابق، فقال سبحانه: (رَضُوا بالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا) يونس: 7، فذمهم بذلك وقال تعالى: (وَلِتَصْغى إلَيْهِ أفْئِدَةُ الَْذينَ لاَيُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ وَلِيرْضَوْهُ وَلِيَقْترِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ) الأنعام: 113، فعابهم به وقال تعالى: (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) التوبة: 87، يعني النساء، وهذا جمع التأنيث وطبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون، فمن رضي بالمعاصي والمناكير منه أو من غيره، وأحب لأجلها ووالى ونصر عليها أو ادّعى أنّ ذلك في مقام الرضا الذي يجازى عليه بالرضا أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم، فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت.
وفي الخبر الدال على الشرّ كفاعله، وعن ابن مسعود أنّ العبد ليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر فاعله، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به، وقد جاء في الحديث لو أنّ عبداً قيل بالمشرق ورضي بقتله آخر بالمغرب، كان شريكه في قتله، وقد روينا حديثاً حسناً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق مرسل: من نظر إلى مَنْ فوقه في الدين وإلى مَنْ دونه في الدنيا كتبه الله صابراً شاكراً، ومَنْ نظر إلى مَنْ دونه في الدين وَمنْ فوقه في الدنيا لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراً، وقد غلط في باب الرضا بعض البطالين من المتأخرين، ممن لا علم له ولا يقين، فحمل الرضا على جميع ما يكون منه من معصية وهوى لجهله بالتفضيل وقلة فهمه بعلم التأويل، ولاتباعه ما تشابه من التنزيل طلباً للفتنة وغربة الحال وابتداعاً في القول والفعال، لأن أوقاته قد ذهبت فلا يذهب وقت غيره بذكرها، وبطلان قول هذا عند العلماء أظهر من أن يدل على فساده، والاشتغال بالبطال بطالة، وإنما الرضا فيما كان غير مخالفة لله ولا معصية مثل مايكون من نقص الدنيا ونقص الأموال والأنفس من الأهل والولد، وفيما على النفس فيه مشقة ولها منه كراهة، وفيما كان مزيداً في الآخرة لا عقوبة فيه من الله ولا وعيد عليه ولا ذم لفاعليه، وقد يحتج أيضاً بطال لبخله وقلّة مواساته وبذله أو يعتل لاتساعه في أمر الدنيا واستئثاره على الفقر، إنّ الذي يمنعه من البذل والإيثار والزهد فيما في يديه والإخراج رضاه بحاله وقلّة اعتراضه على مجريه فيه، وإنّ هذا مقام من مقامات الرضا خص به عند نفسه، وهذا قول لاعب ذي هوى، وهو من خدع النفوس وأمانيها ومن غرور العدوّ ومكايده، لأنّ الرضا لا يمنع من اختيار الفقر والضيقة لمعرفة الراضي بفضل الزهد وأوصافه كيف يكون، فالراضي لا يأمر بالاستيثار والاتساع لما كره من النعمة والاستكثار، لأنّ الرضا لا يوقف عما ندب العبد إليه ولا يحمل على ما كره له، وهذا اعتذار من النفس وتمويه على الخلق ليسلم منهم، ولا عذر بهذا عند مالكه ولا سلامة له فيه من خالقه، ومجمل ما ذكرناه أنّ الرضا لا يصح إلا فيما يحسن الصبر عليه والشكر عليه، لأنّ الرضا مقام فوق الصبر والشكر ومزيد الصابرين والشاكرين، فأما إن كان العبدعلى نقصان من الدين وفي مزيد من الدنيا ثم رضي بحاله، فرضاه بحاله شرّ من أعماله لمخالفة الأمر، قال الله عزّ وجلّ: (اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إلَيْه ِالْوَسيلَةَ) المائدة: 35، وقال تعالى: (يَبْتغُونَ إلى رَبِّهِمُ الوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ) الإسراء: 57، وقال تعالى: (سَابقُوا إلى مَغِفْرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) الحديد: 21 وقال تعالى: (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ رَبِّكُمْ) آل عمران: 133، وقال تعالى: (وَفي ذِلكَ فلْيَتَنَافَسِ الْمَتَنَافِسُونَ) المطففين: 26، وقال تعالى: (يُسَارِعُونَ في الُخَيَراتِ وِهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) المؤمنون: 61، فندب إلى المسارعة والسوابق وذم التخلف عنها والتتثبط بالعوائق، فعلى هذا طريق المؤمنين وفيه مقامات الموقنين، وإنما كان سبب ترك سري السقطي السوق وزهده في الدنيا قوله: الحمد لله لأنها كلمة رضا ظهرت منه في موضع الاسترجاع للمصيبة وذلك أنه بلغه أنّ الحريق وقع في سوقه فأحرق دكانه، فخرج في قطع من الليل فاستقبله قوم فقالوا: يا أبا الحسن، احترقت دكاكين الناس إلا دكانك فقال: الحمد لله: ثم تفكر في ذلك فقال: قلت الحمد لله في سلامة مالي وهلك أموال إخواني المسلمين، فتصدق بجميع ما كان في دكانه من السقط والآلة كفارة لكلمته هذه، وخرج من السوق فشكر الله له فعله، فزهد في الدنيا ورفعه إلى مقام المحبة فأوصله ترك الرضا إلى الرضا، وبلغني عنه أنه كان يقول: قلت كلمة فأنا أستغفر الله منه ثلاثين سنة يعني قوله الحمد لله.
وقد جاء في الخبر: من لم يهتم بأمر المسليمن فليس من المسلمين، وفي الخبر المشهور: أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض فيه، فجعل ذلك من أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان، لا يستطيع الشيطان حلّه ولا سلطان له عليه كما لا سبيل له على حل الإيمان لأنّ الله يحول بينه وبينه، وقد تولى تأبيد الإيمان بروحه بعد كتبه في القلوب برحمته وفي الحبّ في الله الولاة والنصرة بالنفس والمال والفعل والمقال، وفي البغض في الله ترك ذلك فبغض المبتدع والفاجر المجاهر والظالم المعتدي، وترك موالاتهم ونصرتهم واجب على المؤمنين، فلأجل ذلك صارت الموالاة لأولياء الّله والمعاداة لأعدائه من أوثق عرى الإيمان لأنك قد تعصي وتخالف مولاك تسليط العدوّ وغلبة هواك، إلاّ أنّك تبغض العاصين ولا تواليهم على المعاصي، ولا تحبهم لأجلها من قبل أنّ العدو لم يسلط على حل عقد إيمانك، كما سلط على فعله من نفسك، كما أنه لم يسلط على حل عقد إيمانك كما سلط على حل المراقبة والخوف منك، ولم يسلط أيضاً عليك في استحلال المحارم ولا استحسانها ولا التدين بها، ولا في ترك التوبة منها ولا بالرضا بها كما سلط عليك بافتراقها، فإن سلط على مثل هذا منك العدو حتى تحب الفساق وتواليهم وتنصرهم على فسقهم، أو تستحل ما ارتكب من الحرام أو ترضى به أو تدين به، فقد انسلخ منك الإيمان كما انسلخ النهار من الليل، فلست منه في كثير ولا قليل لأنّ هذه العقود منوطة بعرى الإيمان، وهي وهو في قرن واحد مقترنان، ألم تسمع الله تعالى يقول: (لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذِلكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيءْ) آل عمران: 28، أو ما سمعته تعالى يقول: (لاَتَتّخِذُوا الْيَهُودِ وَالنَّصَارى أَولِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِىَاءُ بَعْضٍ وَمنْ يَتَولَّهُمْ مِنْكُمْ فَإنَّهُ مِنْهُمْ) المائدة: 51، ومثله: (لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ) آل عمران: 28، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً أي حجة قاطعة، أن يجمعكم وإياهم في النار، وكذلك قال الله تعالى: (وَإنَّ الظَّالمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقين) الجاثية: 19، وقال تعالى: (وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمينَ بَعْضاً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) الأنعام: 921، ثم قال تعالى: (وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيلِ المُؤُمِنينَ نُوَلِّه مَا تَولّى وَنُصِلْهِ جَهَنَّمَ) النساء: 115، وقد روينا في خبر أنّ الله تعالى أخذ على كل مؤمن في الميثاق أن يبغض كل منافق، وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن، وفي الخبر المشهور: المرء مع من أحبّ وله ما احتسب.
وفي حديث آخر: من أحب قوماً ووالاهم في الدنيا جاء معهم يوم القيامة، وفي معنى قوله: أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض فيه، وجه خفيّ هو أن يحبك المؤمنون ويبغضك المنافقون، فيكون ذلك علامة وثيقة عرى إيمانك لأنّ قوله الحبّ في الله، يصلح أنّ يبغضك المنافقون كما تبغضهم أنت، فكأنك تتحبب إلى المؤمنين حتى يحبوك وتتبغض إلى المنافقين حتى يبغضوك بإظهار التباعد عنه وبترك الممالاة له وبنصحك إياهم، فيدل ذلك على قوة إيمانك، لم تأخذك في الله لومة لائم منهم، كما وصف تعالى بذلك من يحبهم ويحبونه، ويكون ذلك أبعد لك من المداهنة والنفاق، وأقرب إلى الورع والإخلاص فإذا فعلت ذلك بهم أبغضوك أو مقتوك، فهذا على معنى ما قال الله سبحانه: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءَ بَيْنَهُمْ) الفتح: 29، وقال: (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرينَ) المائدة: 54، وكما أمر نبيه عليه السلام في قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجدوا فيكْمْ غِلْظَةً) التوبة: 123 وروي عن عيسى عليه السلام أنّ الله عزّ وجلّ قال: أحبّ عبادي إليّ الذين يذكروني بالأسحار ويبغضون إلى الفجار، معناه أن يظهرلهم البغض وينابذهم العداوة حتى يبغضوه، فإذا أبغضوه أبغضهم الله، فيكون بغضهم إليه بهذا المعنى أي كان سبب عقوبة لهم بالبغض والمقت، وقد كان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل محبّباً إلى جيرانه فاعلم أنه منافق، وقال كعب الأحبار لأبي إدريس الخولاني وكان من علماء الشام: كيف أنت في قومك؟ قال يحبوني ويكرموني قال كعب: ما صدقتني التوراة إذن قال: وما في التوراة؟ قال أجد في التوراة أنّ الرجل العالم لا يحبه جيرانه، وقال بعض المريدين: قلت لبعض أهل المعرفة: أني كثير الغفلة عن الله قليل المسارعة إلى مرضاته، أوصني بشيء أعمله أدرك به ما يفوتني من هذا، قال: يا أخي، إن استطعت أن تتحبب إلى أولياء الله وتتقرب من قلوبهم فافعل، لعلهم يحبونك فإنّ الله عزّ وجلّ ينظر إلى قلوب أوليائه في كل يوم سبعين نظرة، فلعله أن ينظر إليك في قلوبهم لمحبتهم لك فيجيرك جيرة الدنيا والآخرة، إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاحاً، وكذلك يقال: إنّ الله تعالى عزّ وجلّ ينظر إلى قلوب الصدّيقين والشهداء مواجهة، ثم ينظر إلى قلوب قوم في قلوب قوم وإلى قلوب قوم من قلوب آخرين، فهكذا عندي من عزائم الدين وسبيل الورعين أن تتبغض إلى أعدائه وتتمقت إليهم من المبتدعين والظالمين، ليبغضوك ويمقتوك، فيكون لك من القربة كحبّ أوليائه لك وحبك لهم، فهذا من أسباب ولاية الله.
وقد روينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهم، لا تجعل لفاجر عندي يداً فيحبه قلبي، ووصل بعض الأمراء أبا هريرة بألف دينار وعشرة أثواب فردها عليه وقال، ما كنت لأقبل منه يأخذ المال من غير حله ويضعه في غير حقه، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ردوا هدية الفاجر عليه لا يرى أنكم ترضون عمله، وأقلّ مالك في هذا الزهد وهو باب كبير من أبواب الدين، إذا كانت المداهنة والممالأة من أكبر أبواب الدنيا، لأنّ بذلك يستوي عيش أهل الدنيا وتتم سلامتها لهم، فهذا هوالطرف الآخر من معنى قوله: الحبّ في الله والبغض في الله، وهو وجه غامض، ومعناه إذا كشف جلي ظاهر موجود عند علماء الآخرة، وقد جعل الله منْ أراد أن يحبه الفاسقون ويأمن فيهم، وجعل من يسارع بالأدهان وإظهار المتابعة للظالمين خشية دور الدوائر عليه علمين من أعلام النفاق، فقال سبحانه: (سَتَجِدُونَ آخَرينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْمَُنوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فيهَا) النساء: 91، وقال تعالى في المعنى الثاني: (فَتَرَىَ الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) المائدة: 52، يعني المافقين: (يُسَارعُونَ فيهِمْ) المائدة: 52، يعني يواطئون الكافرين سراً: (يَقُولُونَ نَخْشى أَن تُصيَبنَا دَائِرةٌ) المائدة: 52، أي نخاف أن تكون الدولة للكافرين على المؤمنين، قال تعالى: (فَعَسَى اللهُ أنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أو أَمْر مِنْ عِنْدِهِ) المائدة: 52، فينبغي لمن آمن في المؤمنين وأهل السنّة وأحبوه أن يخاف في المنافقين وأهل البدع أن يبغضوه، وينبغي لمن سارع في مواطأة المؤمنين أن ينئ ويبطئ في مداهنة الظالمين ومتابعتهم، حتى يخلص له إيمانه من النفاق وتستقيم طريقه من الضلال، وقد نفى الله الإيمان عمن أحبّ من حادّه، وأثبت الإيمان والتأييد باليقين لمن أبغض فيه أعداءه، فقال تعالى: (لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوَلهُ) المجادلة: 22 الآية، فأمّا من قال من الجاهلين بأنَّ الرضا قد يكون بالمعاصي منه أو من سواه، كما يكون في الطاعات، فقد جعل المعاصي والمخالفات من القربات وسوّى بينهما، وفي هذا هدم شرائع الأنبياء وإبطال تفصيل الله ما أحل لنا مما حرم علينا، وما أمرنا به مما نهانا، وقد روي في خبر: من شرّ الناس منزلة عند الله من يقتدي بسيّئة المؤمن ويترك حسنته، وقال بعض العلماء: من حمل شاذ العلماء فقد حمل شرًّا كثيراً، ومن حسن الأدب في المعالمة إذا عملت صالحًا فقل: يا سيدي، أنت استعملتني وبحولك وقوتك وحسن توفيقك أطعتك، لأنّ جوارحي جنودك، وإذا عملت شيئاً ظلمت نفسي، وبهواي وشهوتي اجترحت جوارحي وهي صفاتي، ثم يعتقد في ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاه، فتكون بالمعنيين قد وافقت مرضاة مولاك وتكون في الحالين عاملاً بما يرضيه بالقول والعقود، وينتفي عنك العجب في أعمال برك ويصح منك المقت لنفسك واعترافك بظلمك، وقد ثقلت هذه المشاهدة على الجاهل، فإذا عمل حسناً شهد نفسه ونظر إلى حوله وقوّته، فهلك بالكبر وبطل عمله بالعجب، وإذا عمل سيئّاً لم يعترف بالذنب ولم يقرّ على نفسه بالظلم، ولم تصح له توبة ولم يرض له عملاً، نعوذ بالله من مشاهدة الضلال، وقال أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: إذا عمل العبد حسنة فقال: يا رب أنت استعملتني، شكر الله له ذلك فقال: أنت عملت، فإذا نظر إلى نفسه فقال أنا عملت، يقول الله بل أنا استعملت، قال وإذا عمل سيئّة فقال: أنت قدّرت وأنت أردت، يقول الله تعالى: أنت ظلمت وأنت عصيت بشهوتك وهواك، فإن قال العبد: ظلمت نفسي وعصيت بجهلي استحيا الله منه فقال: بل أنا قدرت وأنا قضيت، قد غفر لك باعترافك بالظلم على نفسك، فهذه آداب العاملين ومشاهدة العالمين، وهذا داخل قي قوله: أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه، فكذلك يحب ابن آدم ممن عامله الاعتراف والتواضع، وهذا أيضاً أحد المعاني في قوله تعالى: (وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوِبهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحَا وآخرَ سيًّئاً) التوبة: 1، 2، قيل: هو الاعتراف عقيب العمل السيّئ لأنه قد تقدم ذكره فكان الصالح بعده اعترافه.
وفي الحديث الذي رويناه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنفاً أنّه قال: من نظر إلى من فوقه في الدين وإلى من دونه في الدنيا، كتبه الله صابراً شاكراً، ومن نظر إلى من دونه في الدين ومن فوقه في الدنيا، لم يكتبه صابراً ولا شاكراً، فيه أربعة معان حسان إذا تدبرها العبد وتفكّر فيها لم يعدم أن يرى أهلها، لأنه لا يخلو أن يرى بعينه أو بقلبه لسيرة المتقدمين، فيرى من فوقه في باب الدنيا فيشكر الله على حاله ويقنع منه برزقه فيكون صابراً شاكراً بمعرفة ما قنع به، ورضي باختيار ما صرف عنه من الفضول، وروي عنه من الحساب الطويل، ولا يخلو أن يرى من فوقه في أمر الدين يسارع إليه ويسابقه إذ قد ندب إلى ذلك، فيكون حضَّاً له وحثَاً على افتعال الخيرات وأعمال الصالحات، وأقل ما يفيده ذلك الإزراء على نفسه والمقيت لها في تقصيره، ثم ينظر في الأمرين الآخرين من وجه آخر، فلا يخلو أن يرى من هو دونه في الدنيا من ذوي الفاقات والحاجات، فيحمد الله على تفضيله عليه وحس صونه له ويشكر نعمته لفضل إحسانه وكفايته له، ويجد أيضاً في المعنى الآخر من هو دونه في أمر الدين من الفجرة والظالمين وأهل البدع والزائغين، فيفرح بفضل الله ورحمته ويشكر الله على حسن إسلامه وجميل معافاته مما ابتلي به غيره، فيكون أيضاً صابراً شاكراً، فيكون للعبد في هذه الطبقات من الناس أربع معاملات بما وهب الله من البصيرة والاعتبار، ويشهد لما ذكرناه قوله: لا حسد إلاّ في اثنين؛ رجل آتاه الله حكمة فهو يبثها في الناس ويعملها، ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، وفي لفظ حديث آخر: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الرجل: لو آتاني الله ما آتى هذا فعلت كما يفعل، فندب إلى الحسد على أعمال البرّ وفضل الحاسد لما ندب الله إليه من المنافسة في أعمال الخير، فمن حسد على هذه المعاني من أعمال الخير، كان ذلك مزيداً له في مقام الرضا للغبطة به والطلب له، فأما من قلبت عليه هذه المعاني فجهل عواقب الأمور، وغلبت عليه الغفلة واستحوذت عليه الجهالة، فجعل ينظر إلى من فوقه في الدنيا فيغبطه على حاله، أو يتمنى مكانه أو يدخله نظره إليه في استصغار نعمة الله عليه ويزدري يسير ما قسمه الله له، ثم ينظر إلى من دونه في الدين من عموم المسلمين فيرضى بنقصان مقامه ويجعل ذلك معذرة له وتأسّياً به، ويثبطه عن المسارعة إلى القربات ولعله أن يداخله العجب والكبر حتى يتفضّل عليه بحاله، أو ينظر إلى نفسه بأعماله، لتقصير غيره عن مثل فعاله، فهذا إذاً يكتب جزوعاً عن الصبر كفور النعمة بإضاعة الشكر، لأنه ليس بصابر ولا شاكر، وهذا وصف من أوصاف المنافقين، وهو مقام الهالكين، إذ الصبر والشكر من صفات المؤمنين، وقد وصف هذا البلد بمثل هذا المعنى: فالله المستعان، وقد حدثونا عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: طفت الشرق والغرب فما رأيت بلداً شرّاً من بغداد، قيل: وكيف ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو بلد تزدري فيه النعمة وتستصغر فيه المعصية، وحدثونا عنه أنه قيل له حين قدم خراسان: كيف رأيت الناس ببغداد؟ قال: ما رأيت بها إلا شرطياً غضبان أو تاجراً لهفان أو قارئاً حيران، وقيل إنّه كان يتصدق كل يوم بدينار لأجل مقامه ببغداد، إلى أن يخرج إلى مكة، فبلغني أنه كان يتصدّق بستة عشر ديناراً، وقد وصفها الشافعي أنها هي الدنيا، فروينا عنه أنّه قال: الدنيا كلها بادية وبغداد حاضرتها.
وروينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: يايونس، رأيت بغداد؟ قلت: لا قال: ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس، وقد ذم العراق جماعة منهم عمر بن عبد العزيز وكعب الأحبار، فروينا عن عمر أنّه قال لمولى له: أين تسكن؟ قال: العراق، فقال له: ما تصنع هناك بلغني أنّه ما من أحد سكن العراق إلاّ قيض له قرين من البلاء، وذكر كعب الأحبار العراق يوماً فقال: فيه تسعة أعشار الشر، وفيه الداء العضال، ومن سكن بلداً كثير المنكر ظاهر المعاصي، فكان منزعجاً فيه غير مطمئن إليه يرغب إلى الله عزّ وجلّ في إخراجه منه لحسن اختياره له، وكان مضطرّاً في المقام فيه لعيلة ثقيلة أو قلّة ذات يد حقيقة، لا يستطيع حيلة في الخروج ولا يعرف طريقاً، وهو على يقين من سلامة دينه فيه، فإنه معذور عند الله لحسن تفضل من الله، وهو أقرب إلى العفو والسلامة ممن اغتبط بمقامه واطمأن ورضي بحاله، أو كان مقامه على هوى أو لاختلاف أسباب الفتنة والدنيا، قال الله تعالى: (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهَا) النساء: 97 في التفسير: إذا كنت في بلد يعمل فيه بالمعاصي فتحول منه إلى غيره، وقيل: إذا كان العبد في بلد من يعمل فيه بالمنكر والمعاصي أضعف أو أقل من أهل الدين والمعروف، ثم لم ينكر ذلك فقد وجب الخروج منه، ثم قال عزّ وجلّ في قوم من المستضعفين عذرهم وأرجى إلى العفو أمرهم: (وَالْمُستَضعَفينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِلْدَانِ الَّذينَ يَقُولُون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا) النساء: 75 وقال تعالى في تمام وصفهم واستثنائهم من غيرهم: (ولاَ يَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبيلاً) (فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) النساء98 - 99 ولا يصح الرضا إلا بالعصمة من جميع الهوى، وأوّل الرضا القناعة، وقال بعض أهل المعرفة: لا يكون العبد قانعاً حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة، فعرض عليه لم ينظر إلى ذلك ولم يفتح بابه قناعة منه بحاله، والعصمة حال الراضي عن الله عزّ وجلّ، وهي ظاهر الرحمة، والرحمة أول الرضا من الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: (إنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاّ مَارَحِمَ رَبِّي) يوسف: 53 وقال تعالى: (لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلاّ منْ رَحِمَ) هود: 43 فالعصمة من الله لعبده دليل على الرحمة منه، ثم تدخله في مقام المحبة وهي رحمة المحبوبين، ثم ترفعه إلى الرضا فتكون المحبة مقامه عن شهادة محبوب، ويكون الرضا حاله في جميع تصريف البقية والمطلوب، وهذا آخر كتاب الرضا.
ذكر أحكام المحبة ووصف أهلها وهو المقام التاسع من مقامات اليقين
المحبة من أعلى مقامات العارفين، وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين ومعها نهاية الفضل العظيم، قال الله جلت قدرته: (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ) المائدة: 54 ثم قال تعالى: (ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشاءُ) الحديد: 21 وهذا الخبر متصل بالابتداء في المعنى لأنّ الله تعالى وصف المؤمنين المحبين بفضله عليهم، وما اعترض بينهما من الكلام فهو نعت المحبوبين، وروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما كان الله ليعذب حبيبه بالنار، وقال الله عزّ وجلّ مصداق قول نبيه عليه السلام، ردّاً على من ادعى محبته واحتجاجاً عليهم: (قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ) المائدة: 18 وقال زيد بن أسلم: إنّ الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اصنع ماشئت فقد غفرت لك، وروينا عن إسماعيل بن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم تلا: إنّ الله يحب التوّابين ويحب المتطهرين، وقد اشترط الله للمحبة غفران الذنوب بقوله تعالى: (يُحْبِبْكُمْ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) آل عمران: 31 فكل مؤمن بالله فهو محب لله، ولكن محبته على قدر إيمانه، وكشف مشاهدته وتجلي المحبوب له على وصف من أوصافه، دليل ذلك استجابتهم له بالتوحيد والتزام أمره وتسليم حكمه، ثم تفاوتهم في مشاهدات التوحيد، وفي دوام الالتزام للأوامر وفي تسليم الأحكام، فليس ذلك يكون إلا عن محبة، وإنّ تفاوت المحبون على حسب أقسامهم من المحبوب، وليس يقصر عن المحبة صغير كما لا يصغر عن المعرفة من عرف، ولا يكبر عن التوبة كبير ولو كان على كل العلوم قد أوقف، لأنّ الله تعالى وصف المؤمنين بشدة الحبّ له فقال تعالى: (وَالَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لله) البقرة: 165 وفي قوله أشدّ دليل على تفاوتهم في المحبة لأنّ المعنى أشدّ فأشدّ ولم يقل شديد، والحب لله، فأشبه هذا الخطاب قوله تعالى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) الحجرات: 13 فدلّ على تفاوتهم في الإكرام على قدر تفاضلهم في التقوى ولم يقل: إنّ الكرام المتقون.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ الله يعطي الدنيا من يحبّ ومن لا يحبّ، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فالمؤمنون متزايدون في الحبّ لله عزّ وجلّ عن تزايدهم في المعرفة به والمشاهدة له، وقد جعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحبّ لله من شرط الإيمان قال: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وفي حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وفي خبر آخر أشدّ توكيداً وأبلغ من هذين قوله: والله، لا يؤمن العبد حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي خبر آخر: ومن نفسك، وقد أمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمحبة لله فيما شرعه من الأحكام فقال أحبّوا الله لما أسدى إليكم من نعمه، وأحبّوني لحبّ الله، فدلّ ذلك على فرض الحبّ لله وإنّ تفاضل المؤمنون في نهايات فضائله، ومن أفضل ما أسدى إلينا من نعمه المعرفة به، فأفضل الحبّ له ما كان عن المشاهدة، والمحبون لله على مراتب من المحبة؛ بعضها أعلى من بعض، فأشدهم حبّاً لله أحسنهم تخلقاً بأخلاقه مثل العلم والحلم والعفو وحسن الخلق، والستر على الخلق، وأعرفهم بمعاني صفاته وأتركهم منازعة له في معاني الصفات كي لا يشركوه فيها، مثل الكبر والحمد وحب المدح وحب الغنى والعز وطلب الذكر، ثم أشدهم حبّاً لرسوله إذ كان حبيب الحبيب وأتبعهم لآثاره أشبعهم هدياً لشمائله، وقد روي أنّ رجلاً قال: يا رسول الله إني أحبك فقال: استعد للفقر فقال: إني أحبّ الله فقال: استعد للبلاء، والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي وهو الله تعالى المبتلي، فلما ذكر محبته أخبره بالبلاء ليصبر على أخلاقه، كما قال تعالى: (ولِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) المدثر: 7 فدل على أحكامه وبلائه، والفقر من أوصاف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما ذكر محبته دله على اتباع أوصافه ليقتفي آثاره لقوله عليه السلام: أحيني مسكيناً وأْتِني مسكيناً واحشرني في جملة المساكين، ومن علامة المحبة كثرة ذكر الحبيب، وهو دليل محبة المولى لعبده وهو من أفضل مننه على خلقه، وفي الخبر أنّ لله في كل يوم صدقة يمنّ بها على خلقه، وما تصدق على عبد بصدقة أفضل من أن يلهمه ذكره.
وفي حديث سفيان عن مالك بن معول قيل: يارسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: احتناب المحارم، ولا يزال فوك رطباً من ذكر الله، وقد أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكثرة الذكر لله كما أمر بمحبة الله، لأن الذكر مقتضى المحبة فقال: أكثر من ذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، وقد روينا: أكثروا من ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون، وفي حديث أبي سلمة المدني عن أبيه عن جده: أتانا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم إلى مسجد قباء، فذكر حديثاً فيه طول قال في آخر: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله، وقد أخبر أنّ الذاكرين هم السابقون المفردون، ورفعهم إلى مقام النبوّة في وضع الوزر، ورفع الذكر إن كان الذكر موجب الحبّ في قوله: سيروا سبق المفردون، قيل: مَنْ المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله، وضع الذكر عنهم أوزارهم يردون القيامة خفافاً، ومن أعلام المحبة: حبّ لقاء الحبيب على العيان، والكشف في دار السلام ومحل القرب وهو الاشتياق إلى الموت، لأنه مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المعاينة، وفي الحديث: من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، وقال حذيفة عند الموت: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، وقال بعض السلف ما من خصلة أحبّ إلى الله تكون فيّ لعبد بعد حبّ لقائه من كثرة السجود، فقدم حبّ لقاء الله وقد شرط الله لحقيقة الصدق القتل في سبيله، وأخبر أنه يحب قتل محبوبه في قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَأنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) الصف: 4، بعد قوله تقريراً لهم: لِمَ تقولون ما لا تفعلون؟ حيث قالوا: إنّا نحبّ الله، فجعل القتل محنة محبته وعلامة أخذ مال محبوبه ونفسه، إذ يقول تعالى: (يُقَاتِلُونَ في سَبيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) التوبة: 111، وفي وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، والباطل خفيف وهو مع خفته وبيء؛ فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحبّ إليك من الموت وهو مدرك، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه، وكان الثوري وبشر بن الحرث يقولان: لا يكره الموت إلا مريب، وهو كما قالا: لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء الحبيب، وهذا لا يجده إلا عبد يحبّ الله بكل قلبه، عندها يشتاق إليه مولاه فينزعج القلب لشوق الغيب، فيحبّ لقاءه، وروي أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن زمعة لما تبنى سالماً مولاه، عاتبته قريش في ذلك وقالوا: أنكحت عقيلة من عقائل قريش بمولى فقال: والله، لقد أنكحته إياها وأني لأعلم أنه خير منها، فكان قوله أشد عليهم قالوا: وكيف؟ وهي أختك وهو مولاك فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم، فمن الدليل أنّ من المؤمنين من يحبّ الله ببعض قلبه فيؤثره بعض الإيثار، ويوجد فيه محبة الاعتبار، ومنهم من يحبه بكل قلبه فيؤثره على ما سواه، فهذا عابده ومألوهه الذي لا معبود له ولا إله إياه، وفيه دليل على أنهم على مقامات المحبة عن معاني مشاهدات الصفات ما بين البعض في القلوب والكلية، وقد كان نعيمان يؤتي به رسوله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيجده في معصية يرتكبها إلى أن أتى به يوماً فحده فلعنه رجل وقال: ماأكثر ما يؤتى به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تفتعل فإنّه يحب الله ورسوله، فلم يخرجه من المحبة مع المخالفة، وقد قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب يعني على الفؤاد كان المؤمن يحب الله حبّاً متوسطاً، فإذا دخل الإيمان باطن القلب فكان في سويدائه أحبه الحب البالغ، ومحبة ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر الله على جميع هواه ويغلب محبته على هوى العبد، حتى تصير محبة الله هي محبة العبد من كل شيء، فهو محب لله حقّاً، كما أنه مؤمن به حقّاً، وإن رأيت قلبك دون ذلك فلك من المحبة بقدر ذلك، فأدلّ علامات المحبة الإيثار للمحبوب على ذخائر القلوب، ولذلك وصف الله المحبين بالإيثار، ووصفه العارفون بذلك، فقال تعالى في وصفه المحبين: (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَيَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً) الحشر: 9، ثم قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ) الحشر: 9، وقال في
وصفه: تالله لقد آثرك الله علينا، وقال بعض العلماء: إنّ ظاهر القلب محل الإسلام، وإن باطنه مكان الإيمان، فمن ههنا تفاوت المحبون في المحبة لفضل الإيمان على الإسلام، وفضل الباطن على الظاهر، وفرّق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤاد، فقال: الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه، والقلب أصله وما اتسع منه، وقال مرة: في القلب تجويفان، فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل، والتجويف الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر وعنه يكون الفهم والمشاهدة، وهو محل الإيمان، وقد قال الله: (كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ) المجادلة: 22 وقال: إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فمحبة الإسلام مفترضة على الخلق وهي متصلة بأداء الفرائض واجتناب المحارم طاعة لله ومحبة له، فأما محبة المقربين فعن مشاهدة معاني الصفات وبعد معرفة أخلاق الذات، وهي مخصوصة بمخصوصين، والأصل في هذا أنّ المحبة، إذا كانت عن المعرفة فإنّ المعرفة عموم وخصوص؛ فلخصوص العارفين خاصة المحبة، ولعمومهم عموم المحبة. صفه: تالله لقد آثرك الله علينا، وقال بعض العلماء: إنّ ظاهر القلب محل الإسلام، وإن باطنه مكان الإيمان، فمن ههنا تفاوت المحبون في المحبة لفضل الإيمان على الإسلام، وفضل الباطن على الظاهر، وفرّق بعض علمائنا البصريين بين القلب والفؤاد، فقال: الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه، والقلب أصله وما اتسع منه، وقال مرة: في القلب تجويفان، فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل، والتجويف الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر وعنه يكون الفهم والمشاهدة، وهو محل الإيمان، وقد قال الله: (كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ) المجادلة: 22 وقال: إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فمحبة الإسلام مفترضة على الخلق وهي متصلة بأداء الفرائض واجتناب المحارم طاعة لله ومحبة له، فأما محبة المقربين فعن مشاهدة معاني الصفات وبعد معرفة أخلاق الذات، وهي مخصوصة بمخصوصين، والأصل في هذا أنّ المحبة، إذا كانت عن المعرفة فإنّ المعرفة عموم وخصوص؛ فلخصوص العارفين خاصة المحبة، ولعمومهم عموم المحبة.
ويروى في الأخبار السالفة: أنّ زليخا لما آمنت وتزوّج بها يوسف عليه السلام، انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت، فكان يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدافعه إلى الليل، فإذا دعاها ليلاً سوّفته نهاراً فقالت: يا يوسف إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه، فأما إذ عرفته فما أبقت محبته محبة لسواه، وما أريد به بدلاً حتى قال لها: فإنّ الله أمرني بذلك، وأخبرني أنّه مخرج منك ولدين وجاعلهما نبيين فقالت: أما إذا كان الله أمرك بذلك وجعلني طريقاً إليه فطاعة لأمر الله، فعندها سكنت إليه، وقال بعض العلماء بالله: إذا تم التوحيد تمت المحبة، وإذا جاءت المحبة تم التوكّل، فتم إيمانه وخلص فرضه وسمّي ذلك يقيناً، وقال الفضيل بن عياض في فرض المحبة: إذا قيل لك: تحبّ الله؟ فاسكت فإن قلت: لا، كفرت وإن قلت: نعم، فلس وصفك وصف المحبين، فاحذر المقت، وقال بعض علمائنا: ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة، ولا في جهنم عذاب أشدّ من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة، ولم يتحقق بشيء من ذلك، وقال عالم فوقه: كل أهل المقامات يرجى أن يعفى عنهم ويسمح لهم إلا من ادعى المعرفة والمحبة، فإنهم يطالبون بكل شعرة مطالبة، وبكل حركة وسكون وكل نظرة وخطرة لله وفي الله ومع الله، واعلم أنّ المحبة من الله لعبده ليست كمحبة الخلق، إذ محبة الخلق تكون حادثة لأحد سبع معان؛ لطبع أو لجنس أو لنفع أو لوصف أو لهوى أو لرحم ماسة أو لتقرب بذلك إلى اللّّه، فهذه حدود الشيء الذي يشبهه الشيء، والله يتعالى عن جميع ذلك لا يوصف بشيء منه إذ ليس كمثله شيء في كل شيء ولأن هذه أسباب محدثة في الخلق لمعان حادثة ومتولدة من المحبين لأسباب عليهم داخلة، وقد تتغير الأوقات وتنقلب لانقلاب الأوصاف، ومحبة الله سابقة للأسباب عن كلمته الحسنى، قديمة قبل الحادثات عن عنايته العليا، لا تتغير أبداً ولا تنقلب لأجل مابدا لقوله تعالى: إنّ الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني الكلمة الحسنى، وقيل المنزلة الحسنى فلا يجوز أن يسبقها سابق منهم بل قد سبقت كل سابقة، تكون: كقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمينَ) الأنبياء51 فكذلك قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال تعالى: (لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) يونس: 2، وقال تعالى في آخر آياتهم: (في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ) القمر: 55، ولا يصلح أن يكون قبل قدمه الصدق منهم قدم، كما لا يصلح أن يكون قبل علمه بهم منهم عمل بهم منهم، لأنّ عمله سبق المعلوم ومحبته لأوليائه سبقت محبتهم إياه ومعاملتهم له، ثم هي مع ذلك خاصية حكم من أحكامه ومزيد من فضل أقسامه وتتمة من سابغ إنعامه، خالصة لمخلصين، ومؤثرة لمؤثرين بقدم صدق سابق لخالصين، يؤول لي مقعد صدق عند صادق لسابقين، ليس لذلك سبب معقول ولا لأجل عمل معمول، بل يجري مجرى سرّ القدر ولطف القادر، وإفشاء سرّ القدر كفر، ولا يعلمه إلا نبي أو صديق ولا يطلع عليه إلا من يظهره، وما ظهر في الأخبار من الأسباب، فإنما هو طريق الأحباب ومقامات أهل القرب من أولي الألباب، وإنما تستبين المحبة وتظهر للعبد لحسن توفيقه وكلاءة عصمته، ولطائف تعليمه من غرائب علمه وخفايا لطفه، في سرعة ردهم إليه في كل شيء ووقوفهم عنده، ونظرهم إليه دون كل شيء وقربه منهم أقرب من كل شيء، وكثرة استعمالهم لحسن مرضاته وكشف اطلاعهم على معاني صفاته، ولطيف تعريفه لهم مكنون أسراره وفتوحه لأفكارهم من بواطن إنعامه واستخراجه منهم خالص شكره وحقيقة ذكره، فهذه طريقات المحبين له عن كشوف اطلاعه لهم من عين اليقين، يقال: إذا أحب الله عبداً استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه، وقيل إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه، وروي بعض هذا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروينا في الخبر: إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه، وإذا أحبه الحبّ البالغ اقتناه، قيل: وما اقتناؤه؟ قيل: لم يترك له أهلاً ولا مالاً، فالمحبة مزيد إيثار من المحب الأوّل وهو الله، لعبده وأحكام تظهر من المحبوب وهو العبد، في حسن معاملته، أوحقيقة علم يهبه له، كما قال إخوة يوسف عرفوا محبة الله ليوسف عليهم: تالله، لقد آثرك الله علينا، ثم قالوا: وإن كنا لخاطئين؟ فذكروا سالف خطاياهم وأنه آثره بما لم يؤثرهم به، فقال الله تعالى في وصفه إياه: (قَالَ اجْعَلْني عَلى خَزَائِنِ الأرْضِ إنّي حَفيظٌ عَليمٌ) يوسف: 55، وقال في موهبته له: آتيناه حكماً وعلماً، وكذلك نجزي المحسنين، فذكر ما سلف من إحسانه لما آثره به، وقالت الرسل: إن نحن إلاّ بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده، وقال تعالى: (اللهُ يَصْطَفي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) الحج: 75 وفي الخبر: إذا أحب الله عبداً ابتلاه يعني اختبره؛ فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه، وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك، وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بشيء من المحبة فقال: يا بني هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ فقال: لا فقال: فلا تطمع في المحبة، فإنه لا يعطيها عبداً حتى يبلوه، ومن دلائل المحبة حبّ: كلام الحبيب وتكريره على الأسماع والقلوب، وحدثونا عن بعض المريدين قال: كنت وجدت حلاوة المناجاة في سوء الإرادة، فأدمنت على قراءة القرآن ليلاً ونهاراً، ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة، قال: فسمعت قائلاً يقول لي في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي، أما ترى ما فيه من لطيف عتابي، قال: فانتبهت، وقد أشرب في قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالي الأوّل، وقد قال بعض العارفين: لا يكون العبد مريداً حتى يجد في القرآن كل مايريد، وقد كان ابن مسعود يقول: لا على أحدكم أن يسأل على نفسه إلا القرآن فإن كان يحبّ القرآن فهو يحبّ الله، وإن لم يكن يحبّ القرآن فليس يحبّ الله، ومن علامة حبّ القرآن حب أهل القرآن وكثرة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وقال سهل بن عبد الله: علامة حبّ الله حبّ القرآن وعلامة حبّ القرآن وحبّ الله حبّ النبيّ عليه السلام وعلامة حبّ النبيّ عليه السلام حبّ السنّة، وعلامة حبّ السنّة حبّ الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً وبلغة إلى الآخرةوقال تعالى وهو أحسن القائلين: (يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتي اللهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) المائدة: 54 أي لا يرتدون لأنهم أبدال المرتدين، ولا ينبغي أن يكونوا أمثالهم، كما قال: يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومن علامة محبة المولى تقديم أمور الآخرة من كل ما يقرَّب من الحبيب على أمور الدنيا من كل ما تهوى النفس، والمبادرة بأوامر المحبوب وبواديه قبل عاجل حظوظ النفس، ثم إيثار محبته على هواك واتباع رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما أمرك به ونهاك، والذل لأوليائه من العلماء به والعاملين، ثم التعزز على أبناء الدنيا الموصوفين بها المؤثرين لها، كما قيل لابن المبارك: ما التوضع؟ فقال: التكبر على المتكبرين، وقال الفتح بن شحرف، رأيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم فقلت: أنبئني بحرف خير فقال: ماأحسن تواضع الأغنياء للفقراء رجاء ثواب الله، وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله، وإنما وصف الله أحباءه بالذل للأولياء والعزّ على الأعداء لأنه يصف من يحبه بأحسن الأوصاف، فالذل للحبيب حسن، والعزّ على العدو في حسنه مثل العزّ على الذليل، فلذلك وصف الله محبه بالذل للولي وبالعزّ على العدو، وقبح العزّ على الحبيب كقبح الذلّ للعدو، والله لا يصف أولياءه بقبيح، ومن علامات الحبّ: المجاهدة في طريق المحبوب بالمال والنفس، ليقرب منه ويبلغ مرضاته ويقطع كل قاطع يقطعه عنه بالمسارعة إلى قربه، كما قال تعالى: (وَعَجِلْتُ إِلّيْكَ رَبِّ لِتَرْضى) طه84 وكما أمر حبيبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: وتبتل إليه تبتيلاً فيه معنيان: أحدهما انقطع إليه انقطاعاً عمّا سواه بالإخلاص له والأثرة على غيره، والأخرى: اقطع كل ما قطعك عنه
إليه أي اقطع كل قاطع حتى تصل إليه، فهذان من أدل الدليل على المحبة، ثم أن لا يخاف في حبه لومة لائم كمن الخلق لأمه على محبته أو على السلوك إليه بشق النفس وهجران الدار ورفض المال، ولا يرجو في محبته مدح مادح ولا يرغب في حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال، ثم وجود الأنس في الوحدة والروح بالخلوة، ولطف التملق في المناجاة والتنعم بكلامه والتنعم بمرّ أحكامه ووجد حلاوة الخدمة ورؤية البلاء منه نعمة، وقال ثابت البناني: كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة، ومن المحبة ترك السكون إلى غير محبوبه إذ هو السكن، وقال أبو محمد: خيانة المحب عند الله أشدّ من معصية العامة، وهو أن يسكن إلى غير الله ويستأنس بسواه، وفي قصة برخ، العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام أنّ الله تعالى قال لموسى: إنّ برخاً نعم العبد هو لي إلا أنّ فيه عيباً، قال: يارب، وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه، ومن أحبني لم يسكن إلى شيء، فالسكون في هذا الموضع الاستراحة إلى الشيء والأنس به، والسكون في غير هذا الموضع النظر إلى الشيء والإدلال به والطمأنينة والقطع به، ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخاً إنما أراد به موسى، لأنه أقامه مقام المحبة فاستحى أن يواجهه بذلك، فعرض له ببرخ وكان هذا جواباً منه: إنّي سألته، لم أخبر موسى بعيبه وهو يحبه دون أن يخبره هو بعيب نفسه، فأجاب بهذا: فالمقربون من المحبين إنما نعيمهم بالله وروحهم وراحتهم إليه من حيث كان بلاؤهم منه، فإذا وجدوا ذلك في سواه كانت ذنوباً لهم عن غفلة أدخلت عليهم ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم، وروينا أن عابداً عبد الله في غيضة دهراً، فنظر إلى طير قد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها فقال: لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر قال: ففعل فأوحى الله إلى النبي عليه السلام: قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبداً فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود الأنس به، ومصادفة الاستراحة والروح عنده بمحادثة في المجالسة، ومناجاة في الخلوة وذوق حلاوة النعيم في ترك المخالفة لغلبة حب الموافقة، كما أنشدني بعضهم عن بعض المحبين: إليه أي اقطع كل قاطع حتى تصل إليه، فهذان من أدل الدليل على المحبة، ثم أن لا يخاف في حبه لومة لائم كمن الخلق لأمه على محبته أو على السلوك إليه بشق النفس وهجران الدار ورفض المال، ولا يرجو في محبته مدح مادح ولا يرغب في حسن ثناء العباد بإيثارك له على الأهل والمال، ثم وجود الأنس في الوحدة والروح بالخلوة، ولطف التملق في المناجاة والتنعم بكلامه والتنعم بمرّ أحكامه ووجد حلاوة الخدمة ورؤية البلاء منه نعمة، وقال ثابت البناني: كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة، ومن المحبة ترك السكون إلى غير محبوبه إذ هو السكن، وقال أبو محمد: خيانة المحب عند الله أشدّ من معصية العامة، وهو أن يسكن إلى غير الله ويستأنس بسواه، وفي قصة برخ، العبد الأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام أنّ الله تعالى قال لموسى: إنّ برخاً نعم العبد هو لي إلا أنّ فيه عيباً، قال: يارب، وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه، ومن أحبني لم يسكن إلى شيء، فالسكون في هذا الموضع الاستراحة إلى الشيء والأنس به، والسكون في غير هذا الموضع النظر إلى الشيء والإدلال به والطمأنينة والقطع به، ذكرت هذه الحكاية لبعض أهل المعرفة فقال: لم يرد بهذا برخاً إنما أراد به موسى، لأنه أقامه مقام المحبة فاستحى أن يواجهه بذلك، فعرض له ببرخ وكان هذا جواباً منه: إنّي سألته، لم أخبر موسى بعيبه وهو يحبه دون أن يخبره هو بعيب نفسه، فأجاب بهذا: فالمقربون من المحبين إنما نعيمهم بالله وروحهم وراحتهم إليه من حيث كان بلاؤهم منه، فإذا وجدوا ذلك في سواه كانت ذنوباً لهم عن غفلة أدخلت عليهم ليتوبوا منها إليه فيغفر لهم، وروينا أن عابداً عبد الله في غيضة دهراً، فنظر إلى طير قد عشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندها فقال: لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر قال: ففعل فأوحى الله إلى النبي عليه السلام: قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها بشيء من عملك أبداً فمن صدق المحبة وخالصها الانقطاع إلى الحبيب بوجود الأنس به، ومصادفة الاستراحة والروح عنده بمحادثة في المجالسة، ومناجاة في الخلوة وذوق حلاوة النعيم في ترك المخالفة لغلبة حب الموافقة، كما أنشدني بعضهم عن بعض المحبين:
ألذّ جميل الصبر عمّا ألذه ... وأهوى لما أهواه تركاً فاتركه وقال نظيره في مثله: وأترك ما أهوى لمن قد هويته، وأرضى بما يرضى وإن سخطت نفسي، ثم الطمأنينة إلى الحبيب وعكوف الهم على القريب ودوام النظر، وسياحة الفكر لأن من عرفه أحبه، ومن أحبه نظر إليه، ومن نظر إليه عكف عليه، أما فهمت هذا من قوله تعالى: (وَانْظُرْ إِلى إلهِكَ الَّذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً) طه: 97 ومن فرائض المحبة وفضائلها؛ موافقة الحبيب فيما أحب حبّ الله، كما قال عمر رضي الله عنه لصهيب رحم الله صهيباً: لو لم يخف الله لم يعصه؛ أي أنّ محبته له تمنعه من مخالفته عن غير خيفة، فهو يطيعه حبّاً له، وكان صهيب يقول إنّه يستخرج من حبي لربي شيئاً لا يستخرجه غيره؛ يعني من معاني الصفات المخوفة والأفعال المرجوة، وقال بعض علمائنا: الإيثار يشهد للحب، فعلامة حبه إيثاره على نفسك، وقال: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيباً لله، ولكن كل من اجتنب ما نهاه صار حبيباً وهذا كما قال: إنَّ المحبة تستبين بترك المخالفة، ولا تبين بكثرة الأعمال، كما قيل: أعمال البرّ يعملها البرّ والفاجر والمعاصي لا يتركها إلا صديق، وقيل: أفضل منازل الطاعات الصبر على الطاعات، وإن الصبر على الطاعة يضاعف إلى سبعين، والصبر عن المعصية يضاعف إلى سبعمائة كأنه أقيم مقام المجاهد في سبيل الله، لأنه يقع اختباراً من الله وضرورة من كلية النفس، فإذا ترك هواه فقد ترك نفسه، فأقلّ ما له في ذلك الزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله، ومن أجل ذلك ضوعفت حسناته إلى سبعمائة، ومن أجله ثبتت له المحبة بترك المخالفة، قال الله تعالى: (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ) الرحمن: 46 تفضله على غيره بحبه، وأعجب ما سمعت في هذا أنّ موسى سأل الخضر: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: بترك المعاصي كلها، وقد كان أبو محمد يقول في قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفَسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) التوبة: 111، قال: عيش نفوسهم الفاني وهو عاجل حظوظهم من الشهوات، ومن المحبة وجود الروح بالشكوى إليه والاستراحة إلى علمه به وحده، وإخلاص المعاملة لوجهه وحسن الأدب فيها، وهو الإخفاء لها وكتم ما يحكم به من الضيق والشدائد، وإظهار ما ينعم به من الإلطاف والفوائد وكثرة التفكر في نعمائه وخفيّ ألطافه، وغرائب صنعه وعجائب قدرته وحسن الثناء عليه في كل حال، ونشر الآلاء منه والأفضال والصبر على بلائه، لأنه قد صار من أهله وأوليائه، وقد يعسف بأوليائه ويعنف بأحبابه لتمكنه منهم ومكانتهم عنده، ولعلمه أنهم لا يريدون له بدلاً ولا يبغون عنه حولاً، إذ ليست لهم راحة لسواه ولا بغية في سواه ولا لهم همّة إلاّ إياه، كما قال بعض المحبين: ويلي منك وويلي عليك، أفزع منك وأشتاق إليك، إن طلبتك أتعبتني وإن هربت منك طلبتني، فليس لي معك راحة ولا لي في غيرك استراحة، ثم المسارعة إلى ما ندب إليه من أنواع البرّ بوجود الحلاوة وبشرح الصدر كما جاء في الأثر، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، ثم الرضا بقضائه لأنه مستحسن لأفعاله، ثم اللهج بذكره ومحبة من يذكره ومجالسة من يذكره، ودوام التشكي والحنين إليه وخلو القلب من الخلق، وسبق النظر إلى الخالق في كل شيء، وسرعة الرجوع إليه بكل شيء، ووجد الأنس به عند كل شيء، وكثرة الذكر له والتذكر بكل شيء، ومن علامة المحبة طول التهجد، وروي عن الله سبحانه: كذب من ادّعى محبتي إذا جنه الليل نام عني، إلاّ أنّ بعضهم جعل سهر الليل في مقام بعينه، ذكر له هذا الخبر فقال: ذاك إذا أقامه مقام الشوق فأما إذا أنزل عليه السكينة وأواه بالأنس في القرب، استوى نومه وسهره، ثم قال: رأيت جماعة من المحبين، نومهم بالليل أكثر من سهرهم، وإمام المحبين وسيد المحبوبين رسوله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينام مثل ما يقوم، وقد يكون نومه أكثر من قيامه ولم يكن تأتي عليه ليلة حتى ينام فيها، ومن المحبة الخروج إلى الحبيب من المال بالزهد في الدنيا، والخروج إليه من النفس بإيثار الحق على جميع الأهواء، وقال الجنيد: علامة المحبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه ولا يفتر قلبه، وقد قال بعض السلف: العمل عن المحبة لا يداخله الفتور، وقال بعض العلماء: والله ما استسقي محب لله من طاعته ولو حل بعظيم الوسائل، ومن المحبة التناصح بالحق والتواصي به والصبر
على ذلك، كما وصف تعالى الرابحين من الصالحين، فقال تعالى: (إِنَّ الإنْسَانَ لَفي خُسْرٍ) (إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ) العصر: 2 - 3، لأن المحبين ليسوا كمن وصفه في قوله تعالى: (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْألَكُمْ أَمْوَالَكُمْ) (إِنْ يَسْألكُموهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ) محمد: 36 - 37 يعني أن يسألكم محبوبكم من الأموال ويستقصي عليكم يخرج أحقادكم عليه. على ذلك، كما وصف تعالى الرابحين من الصالحين، فقال تعالى: (إِنَّ الإنْسَانَ لَفي خُسْرٍ) (إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ) العصر: 2 - 3، لأن المحبين ليسوا كمن وصفه في قوله تعالى: (يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلاَ يَسْألَكُمْ أَمْوَالَكُمْ) (إِنْ يَسْألكُموهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ) محمد: 36 - 37 يعني أن يسألكم محبوبكم من الأموال ويستقصي عليكم يخرج أحقادكم عليه.
وروينا في مقرأ ابن عباس: ويخرج أضغانكم؛ يعني الأموال، فلو لم يدخل على هؤلاء الضعفاء إلا الشرك في محبة الأموال والشغل بها عن ذكر ذي الجلال، فخسروا ما ربح المخلصون من الأحباب، وفاتهم ما أدرك الصالحون من طوبى وحسن مآب، فالله تعالى يسأل أحبابه أموالهم وأنفسهم حتى لا يبقى لهم محبوب سواه ولئلا يعبدوا إلاّ إيّاه محبة منه وكشفاً لمحبتهم واختباراً لأخبارهم في صدقهم وصبرهم، ولأنه جواد ملك لايسأل إلا كلية الشيء وجملته، وهو غيور لا يحب أن يشركه سواه في محبته، فلا يصبر عليه إلاّ من عرفه ولا يحبه إلا من صبر عليه، ولا يرضى بحكمه فيه إلاّ من أيقن به، إلاّ أنه لا يسأل الجملة كلها إلا لمن أحبه المحبة الخاصة، وذلك كله من نظام حكمته، وقيل لبعض المحبوبين وكان قد بذل المجهود في بذل ماله ونفسه، حتي لم يبقَ عليه منها بقية: ما كان سبب حالك هذه من المحبة؟ فقال: كلمة سمعتها من خلق لخلق عملت بي هذا البلاء، قيل: وما هي؟ قال: سمعت محبّاً قد خلا بمحبوبه وهو يقول: أنا والله أحبك بقلبي كله، وأنت معرض عني بوجهك كله، فقال له المحبوب: إن كنت تحبني فأي شيء تنفق عليّ فقال: ياسيدي، أملّكك ما أملك، ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك، فقلت: هذا خلق لخلق وعبد لعبد، فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود، فكان ذلك سببه فقد دخلت الأموال في الأنفس تحت الشراء، وقد باعوه نفوسهم فما دونها لمحبتهم إياه، وقد اشتراها منهم لنفاستها عنده، فعلامة محبته لها اشتراؤها منهم، وعلامة شرائها طيّها عنهم؛ فإذا طواها فلم يكن عليهم منها بقية هوى في سواه، فقد اشتراها، واعلم أنّ آفات النفوس هي أدواؤها، وطهرة النفوس من الأدواء هو داؤها، كما قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاهَا) الشمس: 9، فإذا صفاها من الآفات فقد صافاها، وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد اشتراها، ولكل داء من النفس دواء على قدر صغره وعظمه، فضع الدواء على الداء من حيث دخل عليك، بإدخال ضده عليه وبقطع أصله عنه، فعلامة النفوس المشتراة وهي المحبوبة المجتباة، التوبة إلى الحبيب بالخدمة له وكثرة الحمد له بالسياحة إليه ودوام الصلاة، بحسن الأدب بين يديه والأمر بما يحب والنهي عمّا يكره والحفظ بحدوده التي حدّها وترتيب العلم على مدارج العقل، بإخفاء علم التوحيد وأسرار قيومية القدرة من المحافظة، لأنّ العقل حدّ، وذلك من كتمان علم المحبة، فهو عند المحبين كحفظ حدوده على الجوارح التي شرعها بألسنة الرسل، ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إنّ الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهرين، والله يحب المتّقين، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من أراد أن يحبه الله فليزهد في الدنيا، فلا يطمعن طامع في محبة الله قبل الزهد في الدنيا، فهذه جمل أوصاف المحبين، ومن المحبة أن لا يطلب خدمة سواه وأن يجتمع في محبته همه وهواه، ولا يهوي إلا ما فيه رضا المولى، ولا يقضي عليه مولاه إلا بما يهواه.
وروي عن بعض العلماء إذا رأيته يوحشك من خلقه، فاعمل أنّه يريد أن يؤنسك به وفي أخبار داود عليه السلام أنّ الله تعالى أوحى إليه: إنّ أودّ الأودّاء إليّ من عبدني لغير نوال، لكن ليعطي الربوبية حقها، وفيما نقل وهب من الزبور، ومن أظلم ممن عبدني لجنة أونار لو لم أخلق جنة ولا ناراً لم أكن أهلاً أن أطاع، أو كما قال، وفي أخبار عيسى: إذا رأيت التقيّ مشغوفاً في طلب الربّ فقد ألهاه ذلك عمّا سواه، وعن عيسى عليه السلام: المحب لله يحب النصب، وروي عنه أنّه مرّ على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية فقال: ماأنتم؟ فقالوا: نحن عبّاد قال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوّفنا الله من النار فخفنا منها فقال: وحق على الله أن يؤمنكم ما خفتم، ثم جاوزهم فمرّ بآخرين أشدّ عبادة منهم فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شوّقنا الله إلى الجنان وما أعدّ فيها لأوليائه فنحن نرجو ذلك، فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوتم، ثم جاوزهم فمرّ بآخرين يتعبدّون فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله، لم نعبده خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنة ولكن حبّاً له وتعظيماً لجلاله فقال: أنتم أولياء الله حقّاً، معكم أمرت أن أقيم فأقام بين أظهرهم، وفي لفظ آخر أنه قال للأوّلين: مخلوقاً خفتم ومخلوقاً أحببتم، وقال لهؤلاء: أنتم المقربون، وممن روى عنه هذا القول وأقيم في هذا المقام جماعة من التابعين بإحسان منهم: أبو حازم المدني كان يقول إني لأستحي من ربّي أن أعبده خوفاً من العقاب، فأكون مثل العبد السوء إن لم يعطَ أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبده محبة له، وقد روينا معنى هذا الكلام عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يكون أحدكم كالعبد السوء؛ إن خاف عمل، ولا كالأجير السوء إن لم يعطَ أجراً لم يعمل، وقال بعض إخوان معروف له: أخبرني عنك أي شيء أحاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر والبرزخ فقال: وأي شيء القبر؟ فقلت: خوف النار ورجاء الجنة فقال: وأيّ شيء هذا؟ إنّ واحداً بيده هذا كله إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا.
وحدثت عن عليّ بن الموفق قال: رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة، فرأيت رجلاً قاعداً على مائدة وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل، ورأيت رجلاً قائماً على باب الجنة يتصفّح وجوه قوم، فيدخل بعضاً ويرد بعضاً، قال: ثم جاوزتها إلى حظيرة القدس، فرأيت في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله عزّ وجلّ لا يطرف، فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: معروف الكرخي عبد الله لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته بل حبّاً له، فقد أباحه النظر إليه إلى يوم القيامة، قلت: فمن الآخران قال: أخواك بشر بن الحرث وأحمد بن حنبل، وهذا مقام الأبدال من الصدّيقين، لا يقامون مقام أبدال الأنبياء ولا يعطون منازل الشهداء، حتى تغلب محبة الله على قلوبهم في كل حال فيتألهون إليه، ويذهلون به عن غيره وينسون في ذكره من سواه، فيعبدونه لأجله صرفاً، وهم، المقربون ونعيمهم في الجنان صرف، ويمزج لأهل المزج وهم أصحاب اليمين، كما قال تعالى في وصف نعيمهم: (إِنَّ الأَبْرَارَ لَفي نَعيمٍ) (عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ) (تَعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعيمِ) (يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْتُومٍ) المطففين: 22 - 23 - 24 - 25 ثم قال في نعت شراب المقربين ومزاجه، يعني مزاج شراب الأبرار: من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون؛ أيّ يشربها المقرّبون صرفاً، ويمزج لأصحاب اليمين، فما طال شراب الأبرار إلا بمزاج شراب المقربين، فعبّر عن جمع نعيم الجنان بالشراب، كما عبّر عن العلوم والأعمال بالكتاب، فقال في نعت الأبرار مثله؛ إنّ كتاب الأبرار لفي عليين، ثم قال: يشهده المقربون؛ فما حسن علمهم ولا صفت أعمالهم، ولا علا كتابهم إلاّ بشهادة المقربين لما قرب منهم وحضروه، كذلك كانوا في الدنيا تحسن علومهم بعلمهم وترتفع أعمالهم بمشاهدتهم، ويجدون المزيد في نفوسهم بقربهم منهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، وقلا تعالى: (جَزَاءً وِفَاقَاً) النبأ: 26 أي وافق أعمالهم، وقال تعالى: (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) الأنعام: 139 أي كوصفهم في الدنيا إنّه حكيم عليم؛ فمن كان في هذه الدار نعيمه طيبات الملك، فكذلك غداً يكون الملك نعيمه، ومن كان فيها نعيمه وروحه بالطيب الملك، فهو غداً في مقعد صدق عند مليكه، كما قال أبو سليمان الداراني: مَنْ كَان اليوم مشغولاً بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه ومَنْ كان اليوم مشغولاً بربه فهو غداً مشغول بربّه، وقد روينا عن رابعة العدوية وكانت إحدى المحبين، وكان الثوري يقعد بين يديها ويقول: علّمينا مما أفادك الله من ظرائف الحكمة، وكانت تقول: نعم الرجل أنت لولا أنّك تحب الدنيا، وقد كان رحمه الله زاهداً في الدنيا عالماً، إلاّ إنّها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس من أبواب الدنيا، وقال لها الثوري يوماً: لكل عبد شريطة ولكل إيمان حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ماعبدت الله خوفاً من الله، فأكون كالأمة السوء إن خافت عملت، ولا حبًّا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت، ولكني عبدته حبًّا له وشوقاً إليه، وروى عنهاحمّاد بن زيد أنها قالت: إني لأستحي إن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها، وكان هذا جواباً لأنّه قال لها: اذكري لي حوائجك حتى أقضيها، وخطبها عبد الواحد بن زيد فقالت: يا شهواني اطلب شهوانية مثلك، أي شيء رأيت فيَّ من آلة الشهوة؟ وخطبها محمد بن سليمان أمير البصرة على مائة ألف وقال لي: غلة عشرة آلاف في كل شهر أدفعها إليك، فكتبت إليه: ما يسرني أنك لي عبد وأنّ كل ما تملكه لي وأنك شغلتني عن اللهّ طرفة عين، وقدقالت: في معنى المحبة أبياتاً تحتاج إلى شرح، حملها عنها أهل البصرة وغيرهم، منهم جعفر بن سليمان الضبعي وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبد الواحد بن زيد:
أحبُّك حبين: حب الهوى ... وحبُّا لأنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى ... فشغلي بذكرك عمن سواكا
وأما الذي أنت أهل له ... فكشفك للحجب حتى أراكا
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ... ولكن لك الحمد في ذا وذاكا فأما قولها: حبّ لهوى وقولها حب أنت أهل له، وتفريقها بين الحبين فإنّه يحتاج إلى تفصيل حتى يقف عليه من لا يعرفه، ويخبره من لم يشهده، وفي تسميته ونعت وصفه إنكار من ذوي العقول، ممن لا ذوق له ولا قدم فيه، ولكنّا نحمل ذلك وندّل عليه من عرفه يعني حب الهوى، إني رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين، لا عن خبر وسمع تصديق من طريق النعم والإحسان، فتختلف محبتي إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك عليّ، ولكن محبتي من طريق العيان، فقربت منك وهربت إليك واشتغلت بك وانقطعت عمّن سواك، وقد كانت لي قبل ذلك أهواء متفرقة فلما رأيتك اجتمعت كلّها فصرت أنت كلية القلب وجملة المحبة فأنسيتني ما سواك ثم إني مع ذلك لا أستحق على هذا الحب، ولا أستأهل أن أنظر إليك في الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان، لأن حبي لك لا يوجب عليك جزاء عليه بل يوجب على كل شيء لك مني كل شيء مما لا أطيقه ولا أقوم بحقك فيه أبداً، إذ كنت قد أحببتك فلزمني خوف التقصير، ووجب علّي الحياء من قلة الوفاء، فتفضلت علّي بفضل كرمك، وما أنت له أهل من تفضلك، فأريتني وجهك عندك آخراً كما أريتنيه اليوم عندي أولاً، فلك الحمد على ما تفضلت به ذا عندي في الدنيا ولك الحمد على ما تفضلت به في ذاك عندك في الآخرة، ولا حمد لي في ذا ههنا ولا حمد لي في ذاك هناك، إذ كنت وصلت إليهما بك فأنت المحمود فيهما لأنك وصلتني بهما، فهذا الذي فسّرناه هو وجد المحبين المحقين ظنَّاً بقولها ذلك، إذا كان لها في المحبة قدم صدق، والله أعلم ولايسعنا أن نشرح في كتاب كشف حقيقة ما أجملناه ولا أن نفصل وصف ما ذكرناه ومَنْ لم يكن من المحبين كذلك حتى يدلّ بمحبته ويقتضي الجزاء عليها من محبوبه ويوجب على حبيبه شيئاً لأجل محبته، فهو مخدوع بالمحبة ومحجوب بالنظر إليها، وإنما ذاك مقام الرجاء الذي ضده الخوف، وليس من المحبة في شيء ولا تصح المحبة إلاّ بخوف المقت في المحبة، وقال بعض العارفين: ماعرفه من ظن أنه عرفه، ولا أحبّه من توهمّ أنّه أحبه.
ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم في الخوف
وللمحب سبع مخاوف ليست بشيء من أهل المقامات، بعضها أشدّ من بعض: أولها خوف الإعراض، وأشد منه خوف الحجاب، وأعظم من هذا خوف البعد، وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شيّب الحبيب إذ سمع المحبوب يقول: ألا بعداً لثمود ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود فذكر البعد في البعد، يشيب أهل القرب في القرب، ثم خوف السلب للمريد والإيقاف مع التحديد، وهذا يكون للخصوص في الإظهار والاختيار منهم، فيسلبونه حقيقة ذلك عقوبة لهم، وقد يكون عند الدعوى للمحبة ووصف النفس لحقيقتها، وينقصون معه ولا يقنطون لذلك وهو لطيف من المكر الخفي، ثم خوف الفوت الذي لا درك له، سمع إبراهيم بن أدهم وهو أحد المحبين قائلاً يقول في سياحته نظماً: كل شيء لك مغفور ... سوى الإعراض عني
قد وهبنا منك ما فا ... ت بقي ما فات مني
فاضطرب وغشي عليه فلم يفق يوماً وليلة، وهذا في قصة طويلة كانت له بعد مقامات أقيم نقل عنها إلى هذا المكان، حتى قال في آخر ذلك: فسمعت النداء من الجب: يا إبراهيم كن عبداً قال: فكنت عبداً، فاسترحت، معناه لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حرًّا مما سواه، ولا تملك شيئاً فإنّ الأشياء في خزانة مليكها فلا تتملكها فتحجبك عن مالك، وتأسرك بمقدار ما ملكتها، وقد ضرب الله مثلاً بينه وبين خلقه أنّ رجلين أحدهما فيه شركاء متشاكسون علىه من أهل ومال وشهوات، وآخر مسالماً خالصاً لواحد، إنهما لا يستويان في قوله تعالى: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاَ رَجُلاً فيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للهّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ) الزمر: 29، أي الأكثر ليسوا علماء، هكذا الواحد وأشد من الفوت خوف السلو وهذا أخوف ما يخافون، لأن حبَّا له كان به لا بهم وهو نعمة عظيمة لا يعرف قدرها، فكيف يشكره عليها ولا يقوم لها شيء؟ فكذلك سلوهم عنه يكون به كما حبهم له به، فيدخل عليهم السلو عنه من حيث لا يشعرون، من مكان ما دخل عليهم الحبّ له من حيث لا يعلمو، فتجد السلو به كماوجدت الحبّ له، فتكون به قد سلوت عنه وأنت لا تدري كيف سلوت، لأنه يدرجك في ذلك إدراجاً بلطائف الحكمة، كما أنك أحببته وأنت لا تدري لأنه أشهدك وصفه باطلاع القدرة عن جنان الرحمة، فوجدت نفسك محبًّا له، كذلك ترجع المحبة كما جاءت تحجبك عنه عن وصف المكر والجبرية، فتجد قلبك سالياً عنه بلا حول منه ولا قوّة ولا اجتلاب ولا حيلة، وهذا لا يصفه إلا عارف بدقيق بلائه، ولا يحذره إلا خائف من خفي مكره وابتلائه فإذا سلوت عنه به كان ذلك دليلاً منه أنه قد رفضك وأطرحك كما أنت إذا كنت تحبه إنما أحببته به، وهذا هو تحقيق المكر السريع بسرعة تقليب القدرة لقلوب الذي تحقق بالمكور، وهو درك الشقاء الذي أدرك المغرور بما لا يدركه الطرف لسرعته، ولا يحول في الوهم لخفيته، كقوله تعالى: (إَذَاَ لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاِتَنا) يونس: 21، أي معصية بالنعم، قل الله أسرع مكراً أي أخفى تقليباً قد أظهر لهم نعماً أحبوها، وكانت عقوبة ونقاماً باطنة في لبس النعم الظاهرة يدر جوابها إلى درجة درجة من حيث لا يعلمون، وأشد من هذا كله خوف الاستبدال لأنه لا مشوبة فيه، وهذا حقيقة الاستدارج يقع عن نهاية المقت من المحبوب، وغاية البغض منه والبعد، والسلو مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب بداية ذلك كله، والقبض عن الذكر وضيق الصدر بالبر أسباب هذه المعاني المبعدة والمدارج المدرجة، إذا قويت وتزايدت أخرجت إلى هذا كله، وإذا تناقصت وبدل بها الصالحات والحسنات أدخلت في مقامات المحبة والقربات، كما جاء في الأثر الثابت عن حبيب الله، وكذلك في تدبر الخطاب أنّ العاكف على هواه مقيت الله، فوجد هذه الأوصاف منك دلائل ما عاد عنك من الاستبدال بك والإسقاط لك، والخوف من هذه المعاني علامة المعرفة بأخلاقه الملوئة، ولا يصلح شرح هذه المقامات في كتاب ولا تفصيلها برسم خطاب، إنما يشرح في قلبه بيقينه قد شرح وبفضل العبد من نفسه قد فصل، فأما قلبه مشترك وعبد في هواه مرتبك، فليس لذلك أهلاً والله المستعان، وثم خوف ثامن عن شهادة حب عال يغرب اسمه فيلتبس، ويخفي وصفه لقلة اشتهاره في الاستماع فيجهل، لم نسمه لأنه خوف عن مقام له اسم من المحبة، فيشتبه على كثير من سامعيه فينكرونه ويتشنج في أوهام غير مشاهديه بالخلق فيمثلونه، لأن أسماء صفات الخلق ملتبسة بمعنى صفات الخالق، وإنما لهم من ذلك مايعلمون وهم بعلومهم محجوبون، فكيف بها يشهدون، فإن ذكرنا خوفه ثم على ذكر مقامه فظهر بإظهاره، فكان طيه أفضل من نشره إلى أن يسأل عنه من ابتلي بمصدره عنه، بعد أن نشرت منه لأن مقامات المحبة كلها إلى جنب مقامه، كنهر ضيف إلى بحر مثله، كمثل مشاهدات اليقين كلها إلى جنب شهادة التوحيد بالتوحيد، وهو وصف من المحبة يعرف لأنّه من شوق الحبيب إلى المحب، وهو من معنى قول رابعة آنفاً: حبّ الهوى، ومن معنى قول عائشة رضي الله عنها للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرى ربّك يسارع إلى هواك، ومن صدر عن مقام محبّ بعد وروده رفع إلى هذا المقام لأنه في مقام محبوب لجميل مشاهدات اليقين، وقد كان الجنيد رحمه الله ينشد هذين
البيتين كثيراً: تين كثيراً:
ومن بعد هذا ما تدق صفاته ... وما كتمه أحظى لديه وأعدل
ألا أنَّ للرحمن سرًّا يسرّه ... إلى أهله في السرّ والستر أجمل
وقد ذكرنا معناه بعض المحبوبين في كلام منظوم في بيتين وهما:
فمنك بدا حبّ بعز تمازجا ... بماء وصال كنت أنت وصلته
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه ... فكان بلا كون لأنك كنته
وقال بعض العلماء: مَنْ عرف الله من طريق المحبة بغير خوف هلك بالبسط والإدلال، ومن عرفه من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش، ومَنْ عرف الله من طريق المحبة والخوف أحبّه الله فقرّبه وعلّمه ومكنّه، وليس العجب من خوف الخائفين إذ لا يعرفون إلا الصفات المخوفات والأفعال القاصمات، وإنما العجب من خوف المحبين مع ما عرفوا من أخلاقه وحنانه وشهدوا من تعطفه وألطافه مالم يعرف الخائفون، ثم هم مع حبهم يهابونه وعلى أنفسهم به يحابونه، وفي فزعهم منه يشتاقون إليه، وفي بسطه لهم ينقبضون بين يديه، وفي إعزازه لهم يذلون له، لأن من قبض فانقبض فليس بعجب، ولكن من أعزّ وأكرم فتواضع وذلّ فهو العجب، فللمحبين الانقباض في البسط، وللخائفين الانقباض في القبض، وللمحبين الذلّ مع العزّ والكرامة، وللخائفين الذلة مع الهيبة والمهنة، فهذا يدل على أنّ معرفة المحبين به أعظم المعارف إذ كانت أوائل أحوالهم المخاوف، فكل محبّ لله خائف وليس كل خائف محبًّا يعني محبة المقربين، لأنّه لم يذق طعم الحبّ لأنّ طعم محبة المسلمين المفترضة لا يقع بها اعتبار في مقامات الخصوص، لأنّه لا يوجد عنها مواجيد الأحوال، ولا يعلى بها في مشاهدات الأنتفال، لأنها قوت الإيمان، منوطة بصحته وموجودة بوجوده، والمحبة لا ترفع الهيبة، فلذلك كان محبّاً خائفاً لأنّ المحبوب مهوب، والخوف قد يقبض عن المحبة لشغل الخائف بوصفه السالف، وهذا كشف الأبرار وهو حجاب المقرب من المحبة قوت، وهذا كما يقول في الرجاء والخوف لأنهما وصفا الإيمان، إلا إنّ الخائف يتدرج الرجاء في حاله والراجي ينطوي الخوف في رجائه، وفي سبق ترتيب المقامات من الله تعالى حكم غريب وحكمة لطيفة لا يعرفها إلا من أعطى يقين شهادتها، إن سبق إلى العبد بمقام الخوف كان محبًّا حبّ المقربين العارفين، وإن سبق إليه بمقام المحبة كان محبًّا محبة أصحاب اليمين، ولم يكن له مقامات المحبين المستأنسين ولا المشتاقين في مقامات المقربين، وكل هؤلاء موقنون صالحون وإن خرجت أحوالهم عن ترتيب علوم أهل الظاهر، لأن المنكر له أكثر من المقرّ، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وربما كانت المحبة ثواباً للخوف ومزيداً له وهذا في مقام العاملين، وربما كان الخوف مزيد المحبة وثوابها وهذا في مقام العالمين، فمن كانت المحبة مزيده بعد الخوف فهو من المقربين المحبوبين، ومَنْ كان الخوف مزيد محبتّه فهذا من الأبرار المحبين، وهم أصحاب اليمين.
وسئل بعض علمائنا البصريين: الحبّ أفضل أو الحياء؟ فقال: الحب الذي يورث منه الخوف، الحياء أفضل من، والحبّ الذي يورث الحياء منه أفضل من الحياء وهو الشوق، وقال الجنيد: المحبة نفسها قرب القلب من الله بالاستنارة والفرح، فأما حبّ تجلي الصفات عن الأسماء الباطنة فإنّا لم نذكر منها شيئاً، وإنما ذكرنا محبة الأخلاق عن الأسماء الظاهرة، ولا أحسب أنه يحل رسمه في كتاب ولا كشفه لعموم الناس لأنّه من سرّ المحبة لا يكاشف به إلا مَنْ اطلع عليه ولا يتحدث به إلا مَنْ أعطيه، وما رأيت أحداً رسمه في كتاب لأنّه لا يؤخذ من كتاب، وإنما يتلقى من أفواه العلماء، وينسخ من قلب إلى قلب، وهو يشبه ماكتبنا عنه آنفاً من الخوف الثامن الذي لم نصفه لمن لا يعرفه، ومما نقل في الأثر من وصف من أذيق منه ولم يفصح بذكر وصفه أنّا روينا في الأخبار: أنّ بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله أن يرزقه ذرة من محبته ففعل ذلك، فهام في الجبال وحار عقله، ووله قلبه، وبقي شاخصاً سبعة أيام لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به شيء، فسأل له الصدّيق ربه فقال: يارب انقصه من الذرة نصفها، فأوحى الله إليه إنما أعطنياه جزءاً من مائة ألف جزء من ذرة من المعرفة، وذلك أنّ مائة ألف عبد سألوني شيئاً من المحبة في الوقت الذي سألني هذا فأخّرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا، فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته، فقسمت ذرة من المحبة بين مائة ألف عبد فهذا ما أصابه من ذلك، فقلت: سبحانك أحكم الحاكمين انقصه مما أعطيته، قال: فأذهب الله عنه جملة ذلك الجزء وبقي فيه عشر معشاره وهو جزء من ألف جزء، فاعتدل خوفه وحبه وعلمه ورجاؤه، وصار كسائر العارفين، ومن علم المحبة سهر الليل بمناجاة الجليل، والحنين إلى الغروب شوقاً إلى الخلوة بالمحبوب، ومناجاة القلب سرائر الوجد، ومطالعة الغيب والمناجاة عند أهل المصافاة، إنما هي بالقلوب وهي مطالعاتها بواطن الغيوب، وجولانها في سرّ الملكوت وعلوّها في معاني الجبروت بأنوار أرواحها، يحملها شعاع أنواره فيوقعها على خزائن أسراره، والمناجاة دليل رؤية القرب وشاهد وجود الأنس، وفيما أخبرنا عن الله تعالى أنه قال: كذب من ادّعى محبتي إذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحبّ الخلوة بحبيبه، فها أنا ذا قريب من أحبابي أسمع سرّهم ونجواهم وأشهد حنينهم وشكواهم.
وروينا عن بعض العلماء القدماء أنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى بعض الصدّيقين: أنّ لي عباداً من عبادي يحبوني وأحبّهم، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم، يذكروني وأذكرهم، وينظرون إليّ وأنظر إليهم، فإن حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتّك، قال: يارب: وماعلامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحنّ الطير إلى أوكارها عند الغروب، فإذا جنهم الليل، واختلط الظلام، وفرشت الفرش، ونصبت الأسرّة، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا لي أقدامهم، وافترشوا لي وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملّقوا لي بأنعامي، فبين صارخ وباك، وبين متأوّه وشاكٍ، وبين قائم وقاعد، وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون من حبي، فأول ما أعطيهم ثلاثاً أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثانية لو كانت السموات والأرض ومافيهما في موازينهم لاستقللتها لهم، والثالثة أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه، وأما الشوق فإنه مقام رفيع من مقامات المحبة، وليس يبقى الشوق للعبد راحة ولا نعيماً في غير مشوقه، والمشتاقون مقرّبون بما أشهدوا من الشوق إليه، وهم المأمور بطلبهم، الموجود الحبيب عندهم مثوبة منه لهم لما شوقهم إليه في قوله لموسى عليه السلام: اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، هم المشتاقون من المحبين والله أعلم، وذلك أن الحبيب قرب منهم بوصفه تكرّماً، ففرحوا بقربه، وعاشوا بمشاهدته، ونعموا لحضورهم عنده، ثم احتجب عنهم غيرة على نفسه لعزّه فانكسرت قلوبهم لأجله، فاشتاقوا إلى ما عودهم منه، فثبتت لديه حرمتهم، فأمر أولياءه بطلبهم، وأوجد نفسه عندهم لمكانتهم عنده، ففرح هؤلاء من المحبين بقربه لا يوصف، وانكسارهم، وحزنهم لأجله لا يعرف، والله سبحانه قد يعرض عن محبيه تعزّزاً ليزعجهم الشوق إليه، ويقلقهم الأسف عليه، وينظر إليه في إعراضه عنهم من حيث لا يعلمون لينظروا إليه من حيث يعلمون، فسيكنون بالأدب بين يديه، وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم، وكان أحد المشتاقين وهو من أبدال هؤلاء الذين نتكلم في علمهم ونكشف طريقهم، وكانت له رحمه الله أماكن من المحبة رفيعة، وكاشفات في القرب عليه، قال: قلت ذات يوم يا رب إن كنت أعطيت أحداً من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك، فقد أضرّ بي القلق، قال: فرأيت في المنام أنه أوقفني بين يديه، فقال: يا إبراهيم، أما استحيت مني أن تسألني ما يسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه أم هل يستروح المحبُّ إلى غير مشوقه؟ قال: قلت: يا رب تهت في حبك فلم أدرِ ما أقول فاغفر لي وعلمني كيف أقول، فقال: قل اللهم رضني بقضائك، وصبّرني على بلائك، وأوزعني شكر نعمائك.
وقد حدثونا بمعنى ذلك عن أحمد بن عيسى الخراز، وكان مشتهراً بالسماع كثير الحركة والصعق عنده، ذكر بعض أصحاب سهل قال: رأيته في المنام بعد موته فقلت: ما فعل الله بك فقال: أوقفني بين يديه، فقال لي: يا أحمد حملت وصفي على ليلي وسعدي لولا أني نظرت إليك في مقام واحد أردتني به خالصاً لعذبتك، قال: وأقامني من وراء حجاب الخوف فأرعدت وفزعت ما شاء الله، ثم أقامني من وراء حجاب الرضا فقلت: يا سيدي لم أجد من يحملني غيرك، فطرحت نفسي فقال: فقل: صدقت من أين تجد من يحملك غيري؟ قال: وأمر بي إلى الجنة، وفي هذا تخويف للسامعين على التشبيه، الحائدين عن سمع أهل الفهم والتنبيه، لأنّ السماع علم لا يصلح إلا لأهل الصفاء، فمن سمعه على كدر فذاك له محنة وضرر، ويدخل من الآفات على نقصان المشاهدات إذا سمع من قبل النغمة والصوت مايدخل على من نظر إلى الأيدي في العطاء، لأنّ الصوت ظرف للمعاني بمنزلة اليد ظرفاً للأرزاق، فالنظر الموقن يأخذ رزقه من اليد، ويترك النظر والسامع المحق، يأخذ المعاني من الصوت ولا يلتفت إلى التنغيم بها، فمن سمع على التشبيه والتمثيل ألحد، ومن سمع على الهوى والشهوة فهو لعب ولها، ومن سمع باستخراج الفهم ومشاهدة العلم على معاني صفات حقّ ونظر وتطرق ودليل على آيات صدق، كان سامعاً على مزيد، وهذه طرائق أهل التوحيد، وفي السماع حرام وحلال وشبهة، فمن سمعه بنفس بمشاهدة هوى وشهوة فهو حرام، وَمنْ سمعه بمعقوله على صفة مباح من جارية وزوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه، وفعل هذا بعض السلف من التابعين، ومن سمعه بقلب بمشاهدة معان تدله على الدليل وتشهده طرقات الجليل فهذا مباح، لا يصحّ إلاّ لأهله ممن كان له نصيب منه، ووجد في قلبه مكاناً له لعبد أقيم مقام حزن، أو شوق أو في مقام خوف، أو محبة، فيحركه السمع ويخرجه إلى الشهادة، فيكون ذلك مزيده من السمع، فأمّا من سمعه على نغمة، أو لأجل صوت، أو ليلهو به، أو ليستروح إليه، فهذا لاعب لاه لا يحلّ له إذ ليس مراداً به، وكان الجنيد يقول: تنزل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن، عند الطعام لأنهم لا يأكلون إلاّ عن فاقة، وعند المذاكرة لأنهم يتذاكرون أحوال النبيين، ومقامات الصدِيقين، وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقّاً، وكان بعض العارفين يقول: تعرف مواجيد أصحابنا في ثلاثة أشياء، عند المسائل وعند الغضب، وعند السماع، وإنما ذكرنا هذا لأنّه كان طريقاً لبعض المحبين وحالاً لبعض المشتاقين، فإن أنكرناه مجملاً فقد أنكرنا على تسعين صادقاً من خيار الأمة، وقد دخل فيه غير أهله فأحالوه عن وجهته، وعدلوا به عن قصده، وقد كان بعض السامعين يقتات السماع فيجعله قوته، ويتقوى به على زيادة طيه، وأحدهم يطوي اليومين والثلاثة، فإذا تاقت نفسه إلى القوت عدل بها إلى السماع، فأثار منه مواجيده، وأهاج فيه أذكاره، فحمله ذلك عن الطعام، وأغناه عن الأنام، فهذا لا يصلح إلا لقلب صاف من الأكدار، نقيّ نظيف من الآثام، ومن شهد فيه خلقاً فذلك علامة كدر قلبه، ومن أحدث فيه لعباً ولهواً فهو دليل نقص لبه.
حدثني بعض الشيوخ عن شيخ له قال: رأيت أبا العباس الخضر فقلت: ماتقول في هذا السماع الذي يختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هو الصفا الزلال لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء، وقد صدق في قوله: لأنّا روينا عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة الخفية والنغمة الملهية، وأنّ حماد روى عن إبراهيم: الغناء ينبت النفاق في القلب، وعن مجاهد: ومن الناس من يشتري لهو الحدث ليضلّ عن سبيل اللّّه قال: الغناء وهداكما، قالاه: لأنّ سماع الغناء حرام وأجور المغنيات وأثمانهن حرام، والفرق بين الأغاني والقصائد أنّ الأغاني ما شّبب به النساء وذكر فيه الغزل، ووصفن به، وشهدن منه، ودعا إلى الهوى، وشوّق إلى اللهو، فمن سمع من حيث قال القائلون بهذه المعاني فالسماع عليه حرام، والقصائد ماذكر بالله، ودلّ عليه، وشوّق إليه، وأهاج مواجيد الإيمان، وأثار مشاهدات العلوم، وذكر به طرقات الآخرة ومقامات الصادقين، فمَنْ سمع من حيث شهد بهذه الشهادة فهو من أهله إذ له نصيب منه، وقال الله سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فالكلام روحان، منثور ومنظوم، فالمنثور كلام العلاّمة، والمنظوم كلام الشعراء، فما ذكر به الله ويذكر منه فهو طريق إليه، ولم يزل الحجازيون عندنا يسمعون السماع في أفضل أيام السنة وهي الأيام التي أمر الله عباده أن يذكروه فيها، أيام التشريق من وقت عطاء بن أبي رباح إلى يومنا، هذا ما أنكره عالم، وقد كان لعطاء جاريتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهما، ويحمل القول في السماع أنّ من سمع فظهرت عليه صفات نفسه وذكرته حظوظ دنياه فالسماع عليه حرام، ومَنْ سمع فظهر له به ذكر ربّه، وتذكر به أجل ما شوّقه الله إليه وأعده لأوليائه، فهو له ذكر من الأذكار، وسئل عالمنا رحمه الله فقيل له: بلغنا أنك تنكر السماع، وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون يسمعون فقال: كيف أنكر السماع وقد سمعه عبد الله بن جعفر الطيار، يعني ابن أبي طالب، وإنما أنكر اللهو وأنكر اللعب في السماع، ولعمري أنّ هؤلاء الأشياخ الذين ذكروا قد كانوا يسمعون، ولكن كان منهم مَنْ سمع السرّ دون العلانية، ومنهم مَنْ كان يسمع مع إخوانه ونظرائه دون الأتباع والأصحاب، وكانوا يقولون: لا يصحّ السماع إلا لعارف مكين، ولا يصلح لمريد مبتدىء وكان بعض العلماء قد ترك السماع فقيل له، فقال: ممن؟ فقيل له: فأنت، فقال: مع مَنْ كانوا لا يسمعون إلا من أهله ومع أهله.
وحدثونا عن يحيى بن معاذ قال: فقدنا ثلاثاً فما نراها ولاأراها تزداد إلا عزة، حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الديانة، وحسن الأخاء مع الوفاء، وقد سمع من الصحابة غير عبد الله بن جعفر أربعة منهم: ابن الزبير والمغيرة بن شعبة وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم قال: طفت ذات ليلة بالبيت، وكانت ليلة مظلمة ذات مطر ورعد، فخلا الطواف، فلما انتهيت إلى الباب قلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك أبداً، قال: فسمعت قائلاً يقول: من جوف البيت يا إبراهيم أنت تسألني أن أعصمك وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى مَنْ أتفضل ولمن َأغفر؟ وفي خبر وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أنك تكثر مسألتي ولا تسألني أن أهب لك الشوق، قال: يا رب وما الشوق؟ قال: إني خلقت قلوب المشتاقين من رضواني، وأتممتها بنور وجهي، فجعلت أسرارهم موضع نظري إلى الأرض، وقطعت من قلوبهم طرقاً ينظرون به إلى عجائب قدرتي فيزدادون في كل يوم شوقاً إليّ، ثم أدعو نجباء ملائكتي فإذا أتوني خرّوا لي سجّداً فأقول: إني لم أدعكم لعبادتي، ارفعوا روؤسكم أُرِكُمْ قلوب المشتاقين إليّ فوعزّتي وجلالي إنّ سمواتي لتضيء من نور قلوبهم كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، معنى قول لداود عليه السلام: ولا تسألني الشوق ليس أنه قد يعطي الأولياء ما لا يعطي الأنبياء كما غلط في هذا بعض الناس، ففضّل العارف على النبي، ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السلام ليسأله إياه فيعطيه، فلما أخبره به أعطاه مقام الشوق إليه، فجاوز مقامات المشتاقين من العارفين، وإنما أراد أن يجعل ذلك على لسانه ليريه فضل مكانه، ويظهر له ذلك عن مسألته ليفضله ويشرفه بسرعة إجابته، كما أنّ قول داود عليه السلام: وماالشوق؟ ليس أنه لم يعرف الشوق وقد اتاه الحكمة والنبؤّة، ولكن سكت بين يديه استحياءً منه، واعترف لديه بالجهل لأنه عند علاّم الغيوب، واراد أن يسمع منه حقيقة وصفه لأنّه أصدق القائلين وأمدح الواصفين.
وأما الغيرة فحال سنية من أحوال المحبين، لأنه قد أظهرهم على معاني نفسه فضنوا بها لما امتلأت بها قلوبهم، وحارت فيها عقولهم، إلا أنّ هؤلاء خصوص أصحاب اليمين، وهم عموم المحبين، إلاّ إنّه إذا رفعهم إلى مقام التوحيد فأشهدهم الإيجاد بالوحدانية والانفراد بالفردانية نظروا، فإذا هو لم يعط منه لسواه شيئاً ولا أظهر من معانيه وصفاً، فانطوت الغيرة من توحيدهم لماعرفوا بيقين التوحيد أنه مانظر إليه سواه، ولا عرفه إلاّ إيّاه، فتسقط هممهم بالغيرة عليه، وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر وأقسام ما ينشر، وأنه في غيب غيبه لايظهر عليه سواه وفي سرّسرّه لا يشهده إلاّ إيّاه، فقام لهم مقام المعرفة بالتوحيد مقام الغيرة عليه، فهذا إذا طولعوا به مقام الموحدين من الصدِيقن، وقد روينا في دلائل المحبّ وأوصافه أبياتاً عن يحي بن معاذ، وأبي تراب النخشبي، وعن أبي سعيد الخراز أي أيضاًَ على قافية واحدة في معان متقاربة، وهي جامعة مختصرة في نعت المحبين من المريدين، وفي وصف السائحين من المرادين بالتقرّب والانقطاع أولى الأحوال والمشاهدات الرفاع، فالذي روينا عن أبي تراب هذه الأبيات:
لا تخدعنّ فللمحبّ دلائل ... ولديه من تحف الحبيب وسائل
منها تنعّمه بمر بلائه ... وسروره في كل ما هو فاعل
فالمنع منه عطية مقبولة ... والفقر إكرام ولطف عاجل
ومن اللطائف أن يرى من عزمه ... طوع الحبيب وإنّ ألحّ العاذل
ومن الدلائل أن يرى متبسّماً ... والقلب فيه من الحبيب بلابل
ومن الدلائل أن يرى متفهّماً ... لكلام من يحظى لديه السائل
ومن الدلائل أن يرى متقشفاً ... متحفظاً من كل ما هو قائل
والذي رويناه عن يحيي بن معاذ:
ومن الدلائل أن تراه مشمراً ... في خرقتين على شطوط الساحل
ومن الدلائل حزنه ونحيبه ... جوف الظلام فما له من عاذل
ومن الدلائل أن تراه مسافراً ... نحو الجهاد وكل فعل فاضل
ومن الدلائل زهده فيما يرى ... من دار ذل والنعيم الزائل
ومن الدلائل أن تراه باكياً ... أن قد رآه على قبيح فاعل
ومن الدلائل أن تراه مسلماً ... كل الأمور إلى المليك العادل
ومن الدلائل أن تراه راضياً ... بمليكه في كل حكم نازل
ومن الدلائل ضحكه بين الورى ... والقلب محزون كقلب الثاكل والذي رويناه عن أبي سعيد الخراز دخل فيما ذكرناه عنهما، وأحسب أنه أخذه منها لأنهما أقدم منه، إلا أنّ قوله كان أحد عشر بيتاً فقط، وجميع ما قدمنا ذكره من العلامات والدلالات هي أوصاف المحبين، وكل محبّ لله فعن محبة اللّّّه، لأنّ وجود العبد لمحبته لله علامة غيب محبة الله له، يبين ذلك الغيب له في هذه الشهادة إلاّ أنّ في المحبة مقامين، مقام تعريف ومقام تعرّف، فمقام التعريف هومعرفة العموم وهذا قبل المحبة الخاصة، ومقام التعرّف معرفة الخصوص وهذا بعد محبة العموم، وهو مزيد الحبِ الأول، وهذا محبة خصوص، وكذلك في المحبة مقامان، مقام محبّ وأعلى منه مقام محبوب، وهذا كما عبروا عن قولهم مريد ومراد، وعلى الحقيقة كل مريد لله فهو مراد بذلك، إلا أنهم جعلوا اسم مراد بوصف مخصوص بعرف به فيمتاز معه المبتدئ من المبادئ، والمنيب من المجتبي، والطالب من المطلوب، والراغب من المرغوب، والحافظ من المحفوظ، فكذلك لعمري ليس الحامل مثل المحمول، ولا الزائر كالمزور ولا الاشتياق كالحضور، ولا المحبّ مثل المحبوب، قال أبو موسى الدبيلي: عرضت على أبي يزيد البسطامي كتاب صاحبنا عبد الرحيم في الإخلاص فما أعجبه منه إلاّ حكاية أبي عاصم الشامي في الشوق، يعني أنّ عبد الرحيم ذكر الإخلاص في كتابه فقال: قيل لأبي عاصم وافد أهل الشام يشتاق إلى الله، فقال: لا، قيل: ولِمَ؟ قال: إنما يشتاق إلى غائب، فإذا كان الغائب حاضراً فإلى مَنْ يشتاق؟ قلت: سقط الشوق، وهذا مقام محبوب، وفي المشاهدة مقامان؟ مقام شوق ومقام أنس، فالشوق حال من القلق والانزعاج عن مطالعة العزة ومعاينة الأوصاف من وراء حجاب الغيب بخفايا الألطاف، وفي هذا المقام الحزن والانكسار، والأنس حال من القرب عن مكاشفة الحضور بلطائف القدرة، ففي هذا المقام السرور والاستبشار، وقال ضيغم: عجيب للخليقة كيف أرادت بك بدلاً، وعجبت لهاكيف أنست بسواك، وقال الجنيد: علامة كمال الحبّ دوام ذكره في القلب بالفرح والسرور والشوق إليه والأنس به، وأثرة محبة نفسه، والرضا بكل ما يصنع وعلامة أنسه بالله استلذاذ الخلوة، وحلاوة المناجاة، واستفراغ كله حتى لا يكاد يعقل الدنيا وما فيها، ولا يحمل هذا على الأنس بالخلق، فيرتب على مدراج المعقول، كما لا يحمل المحبة على محبة الخلق فيكون بمعاني العقول، لأنّه حال منها، أو إنما هو طمأنينة وسكون إليه، ووجد حلاوة منه، واستراحة وروح بما أوجدهم، وقد أنكر الأنس من لا مقام له فيه، كما أنكر المحبة أيضاً من لا معرفة له بها لأنه تخيّل فيه محبة المخلوق، وتمثل لها صفاتهم، فقال: لا يعرف المحبة ولا يعقلها إلاّ لمخلوق وليس إلا الخوف والهيبة، وممن ذهب إلى هذا القول: أحمد بن غالب المعروف بغلام خليل، أنكر على الجنيد وأبي سعيد والثوري كلامهم في المحبة، وليس هذا مذهب السلف ولا طريقة العارفين، كتب عامر بن عبد الله إلى بعض إخوانه: آنسك الله بنفسه، وقيل لإبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ قال: من الأنس بالله وأنشدونا لبعض العارفين:
الأنس بالله لا يحويه بطال ... وليس يدركه بالحول محتال
والآنسون رجال كلهم نجب ... وكلهم صفوة لله عمال
وقد روينا في التفسير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عزّ وجلّ: (الَّذينَ آمَنُوا تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ) الرعد: 28، قال: هشت إليه وأنست به، وفي مقام الأنس يكون التملق والمناجاة، ومعه تكون المحادثة والمجالسة، ومعنى من البسط، ولا يحبّ الله تعالى هذا النوع من الإدلال إلاّ ممن أقامه مقام الأنس، ولا يحسن ذلك إلاّ منهم لنحو قول موسى عليه السلام في مقام الأنس: يا رب لي ماليس لك، قال: وماهو؟ قال: لي مثلك وليس لك مثل نفسك، قال: صدقت، معنى قوله: مثلك أي لي أنت كقوله تعالي: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) الشورى: 11، معناه ليس كهو شيء لأنّه لا مثل له، فيكون لمثله مثل إذ لا يكون لمثله مثل، والعرب تعبر بالمثل عن نفس الشيء وفوق هذا من البسط ما أخبر الله تعالى عنه أنّه قال مواجهاً للجليل العظيم: إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون، وأعظم من هذا قوله: اذهب إلى فرعون، فقال مجيباً له، فأرسل إلى هارون ولهم عليّ ذنب، ومثله قوله: إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري فحسن هذا منه، لأنّه أقامه مقام البسط بين يديه والأنس به، ولأنّ مكانه لديه مكان محبوب، فأدلّ به عليه فحمله ذلك، وهذا من غير موسى في غير هذا المقام من سوء الأدب بين يدي المرسل، ولم يحتمل ليؤنس عليه السلام خاطراً من هذا القول لما أقيم مقام القبض والخوف، حتى عوقب بالسجن في بطن الحوت في البحر، في ظلمات ثلاث، ونودي عليه إلى يوم الحشر، لولا أنْ تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وقيل: عراء القيامة، ونهي الله تعالى حبيبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتدي به في القول والفعل فقال تعالى: (فَاصِبْر لِحُكُمِ رَبِّكَ ولاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذْ نَادي وَهُوَ مَكْظُومٌ) القلم: 48، وقد قال تعالى: (مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ) البقرة: 253، واحتمل لإخوة يوسف ما عزموا عليه واعتقدوه وما فعلوه وما أسروه من قولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم إلى نحو ذلك من الكلام والفعال، ولقد عددت من أول قولهم ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا إلى رأس العشر من أخباره عنهم في قوله، وكانوا فيه من الزاهدين نيفاً وأربعين خطيئة بعضها أكبر من بعض، قد يجتمع في الكلمة الواحدة الأربعة والخمسة من الخطايا، ودون ذلك وفوقه بدقائق الاستخراج ومعرفة خفايا الذنوب، فغفر لهم ذلك إن كانوا في مقام محبوبين، ولم يحتمل لعزير مسألة واحدة سأل عنها في القدر حتى قيل محي من ديوان النبوة، وقد قال الله تعالى فوق ذلك كله: (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ) البقرة: 92، ما جاءتكم البّينات فعفونا عن ذلك، فإن شاء أن يعفو عفا عن العظائم فلم يعظم عليه شيء، وإن شاء طالب وناقش على الصغائر، ولا تصغر الذرة والخردلة عن مطالبته، وكيف يصغر ذنب ممن واجه به الملك الجبّار؟ ألا ترى من كشف عورته بين يدي نبي كفر لانتهاك حرمة النبوّة فكيف بالعظيم الأكبر لولا فضله ورحمته؟ وفي قوله سبحانه: (يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ) آل عمران: 129، قيل: يغفر لمن يشاء على الذنب العظيم، ويعذّب من يشاء على الذنب الصغير، وقيل: يشترك الجماعة في المعصية فيغفرها لبعضهم ويبدلها حسنات، فلا تضرّه بل تكون عاقبتها ما يسرّه، ويعذّب البعض بذنبه ولا يغفر له، وقد لا ينفعه معه عمل لا يسأل عمّا يفعل، وهم يسألون له الخلق والأمر، يحكم بأمره في خلقه ما يشاء، كيف شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واحتمل لآصف بن برخيا فوق ذلك كله، يقال: إنه كان أحد المسرفين، ولا يصلح أن تذكر ذنوبه لمكان علمه ولحسن عطف الله عليه، ثم تداركه مولاه، واجتباه، وأعطاه العلم والفضل، وأيد به نبيه وخليفته، وجعله وزيره، وأطلعه على الاسم الأعظم بعد ما كان منه ما يتعاظم لئلاّ ييأس محبّ من عطفه، ولكيلا يقنط متحجّب من لطفه، ولم يسمح لبلعم بن باعوارء بذنب واحد من ذنوب آصف بن برخيا إلاّ إنّ بلعم أكل دنياه بدينه وأدخل الهوى على العلم فضلّ بذلك وهلك واشتدّ مقت الله له، وآصف كانت معاصيه في جوارحه بينه وبين خالقه، فكان آصف مستبدلاً به من بلعم لما أري تلك الآيات، فانسلخ منها بعد العبادات، إذ لم يرد بحقائقها والنيات فيه، ويقال: إنه أوتي الاسم الأعظم المتصل بكل المتصلة
بكان، وقد قيل: كان أوتي فوق ذلك ثم انسلخ من الآيات فسكن إلى الدنيا وهوى في الهالكات، ولم ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة كي لا يأمن عامل من عماله مكره، ولئلا يدل عالم عليه بما أظهره، وكان آصف في كبائر المخالفات فاستنقذ منها ثم أوتي بعدها الآيات لأنّه بوصف مراد وفي مقام محبوب، هذا بحضرة نبي الله وخليفته في الأرض سليمان عليه السلام.، وقد قيل: كان أوتي فوق ذلك ثم انسلخ من الآيات فسكن إلى الدنيا وهوى في الهالكات، ولم ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة كي لا يأمن عامل من عماله مكره، ولئلا يدل عالم عليه بما أظهره، وكان آصف في كبائر المخالفات فاستنقذ منها ثم أوتي بعدها الآيات لأنّه بوصف مراد وفي مقام محبوب، هذا بحضرة نبي الله وخليفته في الأرض سليمان عليه السلام.
فأمّا قصة بلعم فهي أشهر من أن نذكرها، ولها مقدمات فيها قصص وإطالة لا نشتغل بذكره، ولكن نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف، وليس كل أحد على قصته يقف، حدثونا أنّ الله تعالى أوحى إلى سليمان عليه السلام: يا ابن رأس العابدين ويا ابن محجة الزاهدين، إلى كم يعصيني ابن خالتك آصف وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة، فوعزتي وجلالي لئن أخذته عطفة من عطفاتي عليه لأتركنّه مثلة لمن معه ونكالاً لمن بعده، قال: فلما دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله إليه، فخرج حتى علا كثيباً من رمل، ثم رفع يديه نحو السماء وهو يقول: إلهي وسيدي أنت أنت وأنا أنا فكيف أتوب إن لم تتب عليّ وكيف أستعصم إن لم تعصمني لأعودنّ فأوحى الله إليه: صدقت أنت أنت وأنا أنا أستقبل التوبة إليّ فقد تبت عليك وأنا التوّاب الرحيم، وهذا كلام مدّل به عليه، وهارب منه إليه، ومتملّق له منه ومن إدلال المحبوبين من المستأمنين مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله كليمه أن يسأله أن يستسقي لبني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين، واستسقي لهم موسى في سبعين ألفاً، فأوحى الله إلى موسى كيف أستجيب لهم، وقد أظلمت عليهم ذنوبهم وسرائرهم خبيثة يدعونني على غير يقين، ويأمنون مكري، ارجع فإن عبداً من عبادي يقال له برخ قل له يخرج حتى أستجيب له، فسأل عنه موسى فلم يعرف، فبينا موسى عليه السلام ذات يوم يمشي في طريق فإذا بعبد أسود استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه، فعرفه موسى بنور الله فسلم عليه وقال: ما اسمك؟ فقال: اسمي برخ قال: فأنت طلبتنا منذ حين، اخرج فاستسق لنا، قال: فخرج فقال في كلامه: ماهذا من فعالك وما هذا من حلمك، فما هذا الذي بدا لك؟ أنقصت عليك غيوثك، أم عاندت عن طاعتك الرياح، أم نفد ما عندك، أم اشتد غضبك على المذنبين، ألست كنت غفاراً قبل خلق الخاطئين خلقت الرحمة، وأمرت بالعطفة فتكون لما تأمر من المخالفين، أم ترينا إنك ممتنع، أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال فما برح حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب، قال: فرجع برخ، قال: ففي هذا ذكري الراجين، وأنس المشتاقين، وطمع للعالمين، وتحبّب إلى المطيعين؛ هذا كما قال بعض العارفين: الحبيب لا يحاسب والعدو لا يحسب.
وروي عن الله سبحانه أنه أوحى إلى عبد تداركه بعد أن كان أشفى على الهلكة: كم من ذنب واجهتني به غفرته لك قد أهلكت في دونه أمة من الأمم، وقد اشترك عبدان في اسم المعصية ثم تباينا في الاجتباء والعصمة؛ آدم عليه السلام وإبليس لعنة الله عليه، ثم اجتبى آدم وهذا لما سبق له من الاصطفاء والكلمة الحسنى، وإبليس أبلس من رحمته وأغوى لما سبق له من الشقوة والكلمة السوء، وقد عاتب الله نبيه على الإعراض عن عبد، وكره له الإقبال على عبد فقال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى) عبس 8 - 9 - 10 وقال تعالى في الأخرى: (أَمَا مَنِ اسْتَغْنى) (فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّى) (وَمَا عَلَيْكَ أَلاّ يَزَّكَّى) عبس: 5 - 6 - 7، وربهما واحد، وبمثله أمره بالإقبال والسلام على طائفة، وأمره بالإعراض وترك القعود مع طائفة فقال تعالى: (وَإذَا جَاءَكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) الأنعام: 45، (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الكهف: 82، (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) الأنعام: 68 (وإما ينسيّنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) الأنعام: 68 وكلهم عبيد لواحد ومثل المحبوب من المحبّ مثل مقام المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مقام موسى عليه السلام، قال موسى: ربّ اشرح لي صدري، وقال لمحمد: ألم نشرح لك صدرك؟ وقال موسى: واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي، وقال لمحمد: ورفعنا لك ذكرك، أيّ تقرن بي في الشهادة والآذان، لا أوازرك بغيري لأنك من أهلي، والوزير القرين والظهير، أي فأنت من أهلي فقد وزرتك وقرنتك بذكري، فأنا ظهيرك ومعينك لا أشد أزرك بغيري، فأشبه هذا ما رويناه عن ليث عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ: (عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) الإسراء: 79 قال يقعده على العرش فكان العرش مكان الربوبية بمشيئته في الدنيا وهو مستغني عنه بقدرته، فوهبه لحبيبه في الآخرة فجعله مكانه تفضّلاً له وتشريفاً، ليكون هناك فوق المرسلين في الجلالة، كما كان ههنا آخرهم في الرسالة، وقال لموسى عليه السلام بعد المقام: قد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد منّنا عليك مرة أخرى، ففي هذا تحديد، وقال لمحمد عليه السلام بعد المقامات وقل: ربّ زدني علماً فلم يحد له حدّاً، فهذا غاية المزيد.
وقال موسى عليه السلام ربّ أرني أنظر إليك أي في محل العبودية، وقال لمحمد عليه السلام: ما زاغ البصر وما طغى، فكان قاب قوسين أو أدنى؛ أي مكان الربوبية، فبين المحبّ والمحبوب في التقليب، كما بين موسى ومحمد عليهما السلام في التقريب، كم بين من رأى ما رأى عند نفسه في مكانه وبين من رأى ربّه في علوه، كم بين من عجل إليه شوقاً منه ليرضى عنه وبين من عجل به شوقاً إليه ليرضاه إليه لرضاه عنه، كم بين من رأى ما رأى فلم يثبت، ففاضت عليه الأنوار لضيقه، وبين من رأى ما رأى فثبت له وغاضت فيه الأنوار لسعته، فقد جاوز المحبوب مقام المحبّ في التمكين، كما جاوز محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقام موسى عليه السلام في المكان أدخل بينه وبين موسى لام الملك وأقام محمداً مقامه في الملك
وقال تعالى لموسى: (وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسي) طه: 41 وقال لمحمد: (إنّ الذَّينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله) الفتح:، 1، فكم بين من صنعه لنفسه وبين من جعله بدلاً من نفسه تفضلاً وتعظيماً، كم بين من فصل مدحه من وصفه وبين من وصل مدحه بوصفه، فقال تعالى في الفصل: (وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً منّي وَلِتَصْنَعَ عَلى عَيْني) طه: 39 وقال في الوصل: (لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) الفتح: 9 الآية، وقال في مثله: والله ورسوله أحق أن ترضوه، وقد قيل في قوله تعالى: (يَا مُوسى إِنّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتي وَبكَلامي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرينَ) الاعراف: 144 أي خذ ما آتيتك من الكلام فتلا: واصطفيتك به على الناس، فاشكر عليه والنظر فقد خصصت به محمداً، وعن ابن عباس وكعب أنّ الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد فأعطى موسى الكلام وخصّ محمداً بالرؤية، ومما يؤيد هذا القول أنّ الذي آتاه الكلام هو الذي ثبت له فدلّ أنه هو الذي أريد به لأنّ الله تعالى إذا أراد عبداً بشيء ثبته فيه وقواه عليه، وقد ثبت محمداً لما آتاه من الرؤية وقواه لها ومكنه فيه، لأنه أراد بها، ومن وصف مقام المحبوب ما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا أصحابك، فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: عن سلمان، قال: أدرك علم الأول والآخر، قالوا: فعمار، قال: مليء إيماناً إلى مشاشه، قالوا: حذيفة، قال: صاحب السرّ أعطى علم المنافقين، قالوا: فأخبرنا عن نفسك فقال: إياي أردتم بهذا كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدأت؛ فهذا مقام محبوب، لأنه إذا سأل سمع منه فاستجيب له، وإذا سكت نظر إليه فعطف عليه، وقد روينا عنه من أحبّ من لا يعرف فإنما يمازح نفسه، أي من لا يعرف صفات حبيبه وأخلاقه وأفعاله وأحكامه فيحبه بعد خبره فيسارع إلى مرضاته ويجانب مكارهه فإنما يمازح نفسه؛ أي يلهو بها ويلعب ليس فيه شيء من حد المحبين ولا حقيقة العارفين إذا لا يأمن انقلاب محبته لتقليب أفعال محبوبه، ولا يأمن تغيير حبه لابتلاء حبيبه واختلاف أحكامه فكأنه كان مازحاً بحبه لا محقّاً به، وفي مثل هذا المقام من جهل المحبين بأفعال المحبوب اغترار عظيم.
ومن المحبة كتمان المحبة إجلالاً للحبيب وهيبة له وتعزيزاً وتعظيماً له وحياء منه؛ وهذا وصف المخصوصين من عقلاء المحبين وهو من الوفاء عند أهل الصفاء، إذ كانت المحبة سرّ المحبوب في غاية القلوب؛ فإظهارها وابتذالها من الخيانة فيها وليس من الأدب ولا الحياء النسبة إليها ولا الإشارة بها، لأنّ في ذلك اشتهاراً فتدخل عليه دقائق الدعوى والاستكبار، وقد قال بعض العارفين: أبعد الناس من الله أكثرهم إشارة به هو الذي يكثر التعريض به في كل شيء ويظهر التزيّن والتصنّع بذكره عند كل أحد هذا ممقوت عند المحبين لله والعلماء به.
دخل ذو النون المصري على بعض إخوانه ممن كان يذكر المحبة فرآه مبتلي ببلاء يجلّ عن الوصف فقال ذو النون، لا يحبه من وجد ألم ضربه، فقال الرجل: لكني أقول لا يحبه من لم يتنعم بضربه، فقال ذو النون: لكني أقول: لا يحبه من شهر نفسه بحبه، فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه؛ وهذا كما قال ذو النون هو من علامة الإخلاص في المحبة إذ كانت أعمال القلوب، فوجود الإشفاق والحذر من إظهارها خشية السلب والاستبدال، وخوف المكر والاستدراج علامة التحقق بها ودفعها عن النفس، وسترها عن أبناء الجنس، وترك التظاهر بها علامة الظفر بها، لأنّ المحبوب غيور، وغيرته على نفسه وعلى ظهور محبته أشد من غيرته على إظهار محبته، وغيرته على إظهارهم لغير أبناء جنسهم أشد من غيرة جميع محبيه عليه؛ وهذا كلام على عالم صاح في مقام صحو مكين، فأما السكرن بحاله والولهان بوجده فمغلوب، والمغلوب معذور، قال رجل لأبي محفوظ، وقد رأى من بعض المحبين شيئاً استجهله فيه فأخبر معروفاً بذلك فتبسّم ثم قال: ياأخي له محبون صغار وكبار ومجانين وعقلاء، فهذا الذي رأيته من مجانينهم ومن المحبة كتمان بلاء الحبيب بعد الرضا به لأنّ ذلك من السرّ عنده وحسن الأدب لديه، وعوتب سهل في العلة التي كانت به علة مهولة كان يداوي الناس منها ولا يداوي نفسه فقيل له في ذلك فقال: ضرب الحبيب لا يوجع، وكان حينئذ يقول: من علامة المحبّ في المكاره والأسقام هيجان المحبة وذكرها عند نزول البلاء، إذ هو لطف من مولاه وفيه الغربة إلى محبوبه وقلة التأذي بكل بلاء يصيبه لغلبة الحب على قلبه، وقد كان بعض المحبين يقول: أصفى ما أكون ذكراً إذا ما كنت محموماً، وذكر بعض من ينتمي إلى المحبة مقامه في المحبة عند بعض المحبين فقال له المحبّ: أرأيت هذا الذي تذكر محبته أهممت بسواه قط؟ قال: نعم، قال: فهل رأيته في ليلة مرتين وثلاثاً؟ قال: لا، قال: لولا أني أستحي لأخبرتك أنّ محبتك معلولة تهتم بسوى حبيبك ولا تراه في ليلتك، ثم قال: لكني لا أدعي محبته وعلى ذلك ما اهتممت بسواه مذ عرفته، وربما رأيته في ليلة سبع مرار، وذكر بعض المحبين ممن كان بدلاً عن إبراهيم بن أدهم ممن تكلم في علم طريقه ووصفه حاله وذكر القصة بطولها قال: رأيت الله عزّ وجلّ مائة وعشرين مرة وسألته عن سبعين مسألة أظهرت منها أربعة فأنكرها الناس فأخفيت الباقي، وفيما ذكر من وصف المحبّ كفاية وغيبة عن وصف المحبوب وليس يمكننا وصف المحبوب إذ كان حاله يجلّ عن الوصف، وكيف يوصف من يسمع ويبصر من يحبه ويبطش ويعقل عن محبوبه فيكون هو سمعه وبصره وقلبه ويده ومؤيده، كما جاء في الخبر: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقلبه الذي يعقل به، وإن سألني أعطيته وإن سكت ادّخرت له، لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم؛ فهذا كله في مقام محبوب، ويقال: إنّ هذه الآيات والقدر من سرائر الغيوب وخفايا الملكوت التي تسميها العامة المعجزات والآيات وتسمّيها العلماء الكرامات والإجابات؛ وهي آيات الله في أرضه مودعة وقدرته في عباده جارية، وعنايات له في ملكه مستقرة، ليس للعباد منها إلاّ كشفها ونظرهم إليها إذا أقيموا مقام الأنس من مقام محبوب، ويقال: إنّها توجد في المقام السابع عشر من مقامات المعرفة، إذا أقيم العبد هذا المقام في المعرفة يؤدي بها ظهرت له وفوقها ثلاثة وثمانون مقاماً من مقامات العارفين، أفضل من ذلك، ويقال: إنها لا تكون لأبدال المرسلين من الصدّيقين، وإنّما يعطاها أبدال النبيين من الصالحين، فأبدال المرسلين فضّلهم على أبدال النبيين كفضل المرسلين على النبيين وكفضل الصدّيقين على من دونهم من الصالحين، كيف وقد قال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات أظهرت إلا على أيدي البله من الصادقين.
وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من يدخل الجنة من أمتي البله، وعليون لذوي الألباب، فأولو الألباب هم المواجهون بالخطاب، الشهداء عليه، المستحفظون للكتاب، كما قال تعالى: (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاْءَ) المائدة: 44، والعامة يحسبون أنها من أعلى مقامات المعرفة فجميع تلك الأسرار من الغيوب التي تكنّها الحجب والأستار لا يظهر عليه إلا مطلوب، والمطلوب عن نفسه مسلوب، فمن بقيت عليه من نفسه بقية، أو نظر إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية فسترها عليه رحمة له، لأنه لو كوشف هلك في حيرة الهوى، وغرق في بحر الدنيا، ونفس حبه لها، وعين طلبه إياها هو حجابها عنه واستثارها منه، حتى يكون كارهاً لظهورها كراهته لظهور الخلق عليه في معصيته، وخائفاً منها خيفته من نفسه في تظاهرها عليه بهلكته، فإذا بقي بباق وحيّ بحياة حي صرفاً منه وصرفاً عنه بلا طلب ولا نظر ولا سبب ولا فكر، أدّى لعجائبه، وفتح له كنوز غرائبه، ويفعل الله ما يشاء.
وقال بعض العارفين ممن يكشف عن مشاهدته: عبدت الله ثلاثين سنة بأعمال القلوب والجوارح على بذل المجهود، واستفراغ الطاقة، حتى ظننت أنّ لي عند الله شيئاً، فذكر أشياء من مكاشفات السموات في قصة طويلة قال في آخرها: فبلغت صفاً من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء فقلت: ما أنتم؟ قالوا: نحن المحبوب لله نعبده ههنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط طلب لسواه ولا ذكرنا غيره، قال: فاستحييت من أعمالي فوهبتها لمن حقّ عليه الوعيد تخفيفاً عنهم في جهنم، وقال بعض العلماء: كل مقام أعبر عنه إلا مقام المحبة، قيل: ولم؟ قال: لأن الشيء يعبر عنه بألطف منه ولا شيء ألطف من المحبة، وقيل لمعروف: أخبرنا عن المحبة أي شيء هي؟ قال: ياأخي ليس المحبة من تعليم الناس، المحبة من تعليم الحبيب، وقد كان الحذاق من العلماء لا يخبرون بحقائق أربع مقامات؛ حقيقة التوحيد، وحقيقة المعرفة، وحقيقة المحبة، وحقيقة الإخلاص، وقال بعض العارفين: كل المقامات عن أنوار الأفعال والصفات، إلا المحبة فإنّها عن نور حقيقة الذات، فلذلك عزّ وصفها، وعزب علمها، وقلّ من المؤمنين المتحقق بها؛ وذلك أنّها سرّ كالمعرفة إذا ظهر المحبوب أحببته كما إذا رأيت المعروف عرفته؛ وذلك متعلّق به وهو الظاهر لظاهر المعرفة والمحبة الباطن لباطن المحبة، والمعرفة عن وصف باطن، ومن أدرك مقام المحبة لله لم يضره فوت شيء من المقامات، ومن فاته المحبة لم يغبط بدرك شيء، وقد قيل في قوله عزّ وجلّ: (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ) الطلاق: 3، إن الهاء عائدة على التوكل أي فالتوكل حسبه من جميع المقامات والتوكّل حال من مقام المحبة.
وقد قال الله تعالى: (وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أكْبَرُ) ، والرضا مقام من المحبة فقد جلّت المحبة أن توصف ودقت عن العلوم بالعقول أن يعرف مثلها مثل العلم باللّّه؛ فكذلك أي قلب أجلّ من قلب يكون محبوبه الله، ولا أعلم من معلومه الله، وقيل: إن للقلب حبة هي باطنه عليها يتعلق، المحبة، ومنه سمّيت محبة؛ كان اشتقاقه من حبة القلب وهي التي يقال لها سويداؤه، والميم في الأسماء قد تزاد للمبالغة في الوصف، ومن هذا قول الله عزّ وجلّ: (قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً) يوسف:، 3 لما وصفها بنهاية الوصف في الحبّ؛ أي قد خرق حبه شغاف قلبها فوصل إلى حبة القلب، وخرق الشغاف وهو حجاب القلب، وحبّاً منصوب على التفسير كأنّه قيل: قد شغفها أي خرق شغافها، فقيل: ماذا؟ فقيل: حبّاً، فالحب إذا وصل إلى هذا الموضع من العبد لم يملك المحبّ نفسه، ففرغ قلبه له، وامتلأ به، ولم يجر على ترتيب ما رسمناه، وربّما خرج إلى الوله والاستهتار وجاوز معيار العقل في التصريف والأذكار، والعرب تقول: قد دمغه وأرأسه وقاده وركبته، كذلك قولهم أشغفه إذا أصاب شغاف قلبه فهتك حجابه وقد قرئت بالعين، ومعنى قد شغفها بلغ أعلى القلب ونهايته لأن الشغف أعلى كل شيء وأبعده، فالمعنى ذهب به الحبّ أقصى المذاهب وغايته، فحينئذ يملكه الحبّ فيكون أسيره، ويغلب عليه الحبيب فيصبر مأسوره فيحكم عليه ولا يجاوز، ويفرغ له قلبه من كل شيء رسمه، ويمتلئ به فلا يبقى فيه شيء رسمه، ولا يقدر على الكذب لظهور سلطان قهر الحبّ، فحينئ يكشف قناعه ويرسل عذاره فيه ويصفه الحبّ بالحبّ وهو صامت بخيفة المحبّ إلا لمن أحبّ، وهو ظاهر، وليس يكون هذا إلا في مقام شكر وحال عليه، فمن لم يعرف هذا المقام أنكر هذا الكلام إلا أن يربط قلبه بتأبيده ويحفظ سرّه بتمكينه كما قال تعالى: (وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ) القصص: 10 أي من المصدقين إنّا نرده إليها ولا تظهر أنه ابنها فيقتل، وكما لطف للفتية الذين آمنوا وهم أصحاب الكهف لما غلب حبّ الإيمان على قلوبهم، إذ قاموا فقالوا: ربّنا ربّ السموات والأرض لئلا يظهروا إيمانهم لما غلب حبه عليهم فيقتلوا؛ فهذه لطائف الحكيم وخفي صنع العليم، فالمحبون له حافظون للغيب بما حفظ، وقال سمنون لبعض الفقراء في قصة ذكرها يفرح بحبه ويذكر المحبة، وقال بعض الناس في وصف المحبين أقامهم مقام المحبة فلم يزن الملك في قلوبهم حبة فمحبة غير الله في محبة الله شرك عند المحبين؛ وهي خيانة عند بعضهم، وهو من نقض العهد وقلة الوفاء بالعقد.
وقال سهل: من أحبّ الدرهم لا يحبّ الآخرة، ومن أحبّ الخبز لم يحبّ الله عزّ وجلّ، ولا يخرج حبّ الوالد والولد المحبين من المحبة، لأنّ ذلك جعل الله في القلوب نصيباً لهم ولا يخرجه أيضاً حبّ الزوجة بمعنى الرفق بها والرحمة لها، ولا يخرجه أيضاً حبّ مصالح الدنيا من حاجات الأقسام والقلوب ممّا لا بدّ منه، وليس ذلك كله يكون في مكان محبة الله، لأنّ محبة الله في أنوار الإيمان، ومحبّة هذه الأشياء في مكان العقل، هكذا عندي في الفرق بين محبة الله ومحبة المخلوق، ويخرجه جميع ذلك عند بعض المحبين من السلف، فأما الاشتغال بهده الأشياء بالإيثار لها على التفرغ لمرضاة الله والإنحطاط في أهوائها دون محبة الله فإنّ ذلك يخرجه عند الكل وعندي يخرج العبد من حقيقة المحبة السكون إلى غير الله، والفرح بسواه، والحزن على فوت غيره إياه، وقيل لبعض العارفين من الأبدال: الناس يقولون إنك محبّ فقال لست محبّاً المحب متعوب ولكني محبوب وقيل له أيضاً الناس يقولون إنك واحد من السبعة، فقال: أنا كل السبعة، وقال هذا إذا رأيتموني فقد رأيتم أربعين بدلاً، قيل: كيف وأنت شخص واحد؟ قال: لأني قد رأيت أربعين بدلاً فأخذت من كل بدل خلقاً من أخلاقه، وقيل له: بلغنا أنك ترى الخضر فتبسم ثم قال: ليس العجب ممّن يرى الخضر ولكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحجب عنه فلا يقدر عليه ولعمري أن من كان عند الله لم يره بشر ولا ملك.
حدثونا أنّ الحسن رحمه الله اختفى عند حبيب العجمي من الحجاج، فسعى به فدخل عليه الشرط، ففزع الحسن وذهب ليتسور الحائط ويهرب، فقال له حبيب أبو محمد: اقعد حتى نبصر، فقال: فدخل عليه الشرط فقالوا: أين الحسن؟ قيل لنا إنه عندك، فقال: هل ترون شيئاً؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم لا يرونه، فقال له الحسن: كيف لم ينظروا إليّ؟ قال لأنك كنت عند الله فلم يروك، ولو كنت عندي لأبصروك، قال له الحسن: إني قد رأيتك لما دخلوا هممت بشيء، فهل ذكرت اسم الله الأعظم؟ قال: لا، ولكن قلت اللهم اجعله عندك حتى لا يبصروه، وهذا هو واحد من أصحاب الحسن، وقد كان الحسن فوقه بدرجات أحوجه الله إليه، وقيل لأبي يزيد بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره قريب الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد، قال: وما هذا؟ قال: هذه جبال محيطة بالأرضين السفلى، حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف محيط بهده الدنيا، وهو أصغرها، وهذه أصغرالأرضين، وقد كان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف، ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه، وكان يصفه ويصفها، وقال لله عبد بالبصرة يرفع رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف، وقد قيل: الدنيا كلها خطوة للولي، وإنّ وليَّا لله خطا خطوة واحدة خمسمائة عام، ورفع رجله على جبل قاف والأخرى على جانب الجبل الآخر، فعبر الأرض كلها، وقيل لأبي يزيد: دخلت إرم ذات العماد فقال: قد دخلت ألف مدينة لله في ملكه، أدناها ذات العماد، ثم عدد كلها؛ البيت وتأويل وباريس وجايلق وجابرس ومسك، ولعلّ قائلاً يقول: فقد قال الله في وصفها: (الَّتي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي البلادِ) الفجر: 8، قيل: فإن معناه في بلاد اليمن لأنهم خوطبوا بما في بلادهم، كما قال تعالى: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ) المائدة: 33، يعني أرض بلادهم، فذات العماد مدينة عاد في اليمن بين إبتر والشحر، يقال: لها سور له ألف باب ما بين البابين، فرسخ مركبة على أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد، فيها مائة ألف عمود من ذلك، كانت الجن اصطنعتها لعاد بن شدّاد بن سام بن نوح، استخرجت الجن هذه العمد من قعور البحار والقفار، وكانت سخرت الجن له قبل سليمان بن داود بأربعة آلاف عام، تجتمع في يهذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وفي الأعياد، يقال: فيها صناديق من حجارة، طول كل صندوق عشرة أذرع، فيها قبور الأنبياء؛ أجسادهم صحيحة باقية إلى يومنا هذا، وهي محجوبة عن أبصار العباد، وقد كان سهل رحمه الله يزورها في كل جمعة، وهذا واحد من المحبوبين وهذه آيات يسيرة من قدرة الله الكبيرة.
وقيل لهذا العبد: حدثنا عن مشاهدتك من الله، فطاح ثم قال: ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك، قيل: فحدثنا بأشد مجاهدتك لنفسك في الله، فقال: وهذا أيضاً لا يجوز أن أطلعكم عليه، قيل: فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتها، قال: نعم، دعوت نفسي إلى الله في بعض الأمور فتلكعت عليّ، فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنة ولا أذوق الغمض سنة، فوفت لي بذلك، وحكى عنه بجير بن معاذ في بعض مشاهداته أنه رآه من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر مستوفزاً على صدور قدميه، رافعاً أخمصها وعقبيه على الأرض ضارباً بذقنه على صدره شاخصاً بعينيه لا يطرف، قال: ثم سجد عند السحر ثم قعد فقال: اللهم، إن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك، وإني أعوذ بك من ذلك، وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والهوى فرضوا بذلك، وإني أعوذ بك من ذلك، وإنّ قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان فرضوا بذلك، وإني أعوذ بك من ذلك، حتى عد نيفاً وعشرين مقاماً من كرامات الأولياء، قال: ثم التفت فرآني، فقال يحيى: قلت نعم ياسيدي، قال: منذ متى أنت ههنا؟ قلت: من صلاة العشاء، فسكت فقلت: ياسيدي، حدثني بشيء فقال: أخبرك بما يصلح لك، أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي، فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السموات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم أوقفني بين يديه فقال لي: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك، فقلت: ياسيدي، مارأيت شيئاً أستحسنته فأسألك إياه، فقال: أنت عبدي حقّاً، تعبدني لأجلي صدقاً لأفعلن بك ذكر أشياء، قال يحيى بن معاذ: فهالني ذلك وامتلأت به وعجبت منه، فقلت: ياسيدي، ولم لاسألته المعرفة به، وقد قال: سلني ماشئت، فصاح فيَّ صيحة وقال: اسكت، ويلك غرت عليه مني، وقد كان أبو تراب النخشبي رحمه الله معجباً ببعض المريدين، فكان يؤويه ويقوم بمصالحه، والمريد مشغول بعبادته ومواجيده، فقال له أبو تراب يوماً: لو رأيت أبا يزيد، فقال المريد: إني عنه مشغول، فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: لو رأيت أبا يزيد، هاج وجد المريد فقال: ويحك ماأصنع بأبي يزيد، قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد، قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت له: ويلك لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة، كان أنفع لك من أن ترى الله عزّ وجلّ سبعين مرة، فبهت المريد من قولي وأنكره وقال: وكيف ذلك؟ فقلت له: ويلك، إنما ترى الله عندك فيظهر لك على مقدارك، وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره، قال: فعرف ما أقول فقال: احملني إليه، فذكر قصة قال في آخرها: فوقفنا على تل ننتظره يخرج إلينا من النهر، قال: فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره، فقلت للفتى: هذا أبو يزيد فانظر إليه قال: فنظر إليه الفتى فصعق، فحركناه فإذا هو ميت، قال: فتعاونا على دفنه فقلت لأبي يزيد: ياسيدي، نظره إليك قتله؟ قال: لا ولكن كان صاحبك صادقاً وأسكن قلبه سرّ لم يكن ينكشف له بوصفه، فلمّا رآنا كشف له سرّ قلبه فضاق عن حمله لأنّه في مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك، فهذه جمل من أوصاف المحبوب المزاد، ورزق بغير حساب من المحب الجواد، بتيسير من الطالب للمطلوب وعناية من المحب للمحبوب، ومقام الحبيب أعز من أن يظهر وأخفى من أن يعرف، غيرة من عليهم سترهم بأفعالهم وضناً منه بهم حجبهم بأوصافهم، أهل المقامات يشتاقون إليه وهو يشتاق إليهم، وأهل القرب ينظرون إليه وهو ينظر إليهم، وأهل المحبة يحبون أن يسمعوا كلامه وهو يحب أن يسمع كلامهم، وأهل الأحوال يسألونه وهو حسبهم ويحب أن يسألوه، وأهل المشاهدات يزورنه وهو في قلوبهم يزورهم، وأهل الآخرة ينظرون إليه في الآخرة وهو ينظر إليهم في الدنيا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما ذكرنا في قصة داود الملك الرسول؛ إذ أرسله الملك الجليل إلى أحبائه الأربعة عشر الأولياء أن يسألهم أن يسألوه حاجة، فلما رأوه نفروا منه لئلا يشغلهم عنه، فذكرناها قبل هذا فلا تنكرن من هذا شيئاً فإنه يعطي المحبوب في الدنيا أول عطاء أهل الجنة في الآخرة؛ وهو: كن، فيزهدون في ذلك لأجل بقائه ويكرهون ذلك لحبه، قد جاوزوا معارف من سواهم، فإذا أعطاهم كن أمرهم أن يقولوا: كن في أمر الساعة ولا يقولوا: كن في كشف الغطاء عن النيران والجنان، وما وراءها من الكون
والمكان للعيان قبل اللقاء، وإن كانت ظاهرة لباطن إلا أنها مستورة بالصنع للإيقان، مقطوع عنها الوهم راجع عنها الفكر والهم، وسألهم أن لا يظهروا ما في الحكمة والعقل إخفاؤه، لأن إظهاره لا يصلح للخلائق ولا يستقيم عليه أمر المملكة، ولا ينتظم به التدبير لما سبق من التقدير، وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة للأنام، فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منها استجابوا له أحسن استجابة، وردوها إليه أسرع مرد وأبلغه في مرضاته، وهو أن يتركوا إظهار شيء لإظهاره ويزهدوا في كل معنى منها لوجهه، ورضوا بتصريف قدرته في مجاري حكمته. ن للعيان قبل اللقاء، وإن كانت ظاهرة لباطن إلا أنها مستورة بالصنع للإيقان، مقطوع عنها الوهم راجع عنها الفكر والهم، وسألهم أن لا يظهروا ما في الحكمة والعقل إخفاؤه، لأن إظهاره لا يصلح للخلائق ولا يستقيم عليه أمر المملكة، ولا ينتظم به التدبير لما سبق من التقدير، وفيه سقوط الأحكام ووقوع الهلكة للأنام، فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منها استجابوا له أحسن استجابة، وردوها إليه أسرع مرد وأبلغه في مرضاته، وهو أن يتركوا إظهار شيء لإظهاره ويزهدوا في كل معنى منها لوجهه، ورضوا بتصريف قدرته في مجاري حكمته.
وهذا غاية الجهد ونهاية الزهد والحب، فيشكر لهم ذلك أحسن شكر ويدخر لهم عنده أفضل ذخر، ولما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال، اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله عزّ وجلّ في هذا الأمر، ولو دعوت، فسكت ثم قال: لله تعالى عباد في هذه البلدة، لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة، ولكن لا يفعلون، قيل: ولم؟ قال: لأنهم لايحبون ما لا يحب، ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا نستطيع ذكرها، حتى قال: لو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها، واعلم أن العبد إذا بلغ من الله تعالى هذا المكانة حتى يعطيه كن اقتضته الحال أن يقول: وفقني لما تحب واعصمني مما تكره، فإني بشر جاهل لا أحسن التدبير ولا أعرف المقادير ولا علم لي بعواقب الأمور، وأخاف أن يكون في قولي تفاوت وفي إرادتي اضطراب، وإذا أجابه تعالى إلى ذلك، سكت فلم ينطق وسلم، ورضي بالتدبير فأطرق لأن الذي يحب الله تعالى يحب أن تكون الأمور على ماهي عليه، لأنها عن تدبير يظهر بمعاني الخير والشر لأنه تولى التدبير بنفسه كما استوى على العرش بوصفه، ولم يجعل على العباد تدبير الملك إنما جعل عليهم الصبر والرضا للملك، فمرجع العبد إلى الصمت والأدب في نفوذ المراد كما كان، وترك العبد الفضول والاعتراض وحصل له مقام التوكل والرضا، ولذلك كان أبو محمد رحمه الله تعالى إذا قيل له: مامراد الله تعالى من الخلق؟ يقول: ماهم عليه، فكيف تريد ما لا يريد وهو محب لصفاته التي عنها تظهر المرادات، ومنها تبدو الأحكام، ولا بدّ ممّا يكون كما لابد ممّا كان، وكن منطوٍ تحت كان ولولا كان لم يكن، فكان أحب إليهم من كن لأنّ له ولهم مثل كن أمثال وليس لهم ولا له مثل كان مثل، فهؤلاء هم الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهم المحبون لله من عباده الزاهدون في ملكوته لوداده، وكذلك صنعوا مثل هذا فيما استخلفهم فيه من الأموال لما سمعوه يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأخرجوا الكل لأجله، فكان هو خلفاً لهم بعد أن كانوا وكلاء؛ فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل يقول الله تعالى لهم فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم عملوا بما قالوا، فتحققوا بالإيمان، وقيل: إنّ الإيمان قول وعمل، ولا ينوب القول عن العمل، وإذا قالوا: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: صدقتم لأنهم لا يخدمون ولا يذلون لسواه، ولا يعدون للنوائب إلا إياه، ولا يستعينون بغيره، ولذلك صاروا صدّيقين لتصديق الصادق لهم، كما بلغنا أنّ العبد ليقرأ قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله تعالى: كذبت ولو كنت إياي تعبد لم تخف ولم ترج سواي، ولو كنت بي تستعين لم تسكن إلى مالك وأهلك، وكذلك بلغنا أنّ العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلي عليه حتى يفرغ منها، إذا عمل بها فهذا صديق، وأن العبد ليقرأ السورة من القرآن فتلعنه إلى أن يختمها، إذا لم يعمل بما يقول فهذا كذاب، فأين الإيمان؟ ولا إيمان إلا بعمل فليس هذا مؤمناً حقّاً، فالأولياء حققوا القول بالعمل، وشهدوا الإيمان باليقين، فإذا قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر توكلوا عليه ورضوا عنه وتألهوا إليه، ولم يكن في صدورهم غيره فيقول الله تعالى: صدقتم، فيكونون صدّيقين كما يقول للشيء: كن فيكون، فتدبروا فإذا قال: ونعم الوكيل، قاموا مقام التوكل فصار لهم في الصدق مقامات، يقول الصادق: صدقتم، فيكونون صدّيقين، فيقول: عبادي، أنتم خيرتي من ذوي ودادي، وأنا وكيلكم رضيتم بي وأنا حسبكم، فهؤلاء الذين انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله فأعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة والفضل والتوكّل عليه وصرف السوء واتباع الرضا برضاهم عنه رضي الله عنهم، فالحبيب يعتذر له، والعدو لا يقبل عذره، والمحبوب لا يحاسب، والمبغض لا يحسب له، وقد قال بعض الأدباء في معناه:
من لم يكن للوصال أهلاً ... فكل إحسانه ذنوب
وقال آخر في وصف آخر:
في وجهه شافع يمحو إساءته ... من القلوب ويأتي بالمعاذير
وأنشدت لبعض المريدين المتحققين:
أني جعلت منظري في مهجتي ... وجعلت ودك لي إليك شفاعة
ولو إن وقتاً منك بالدهر كله ... لكان قليلاً ألف عام بساعة
فليتق الله تعالى عبد لم يطلعه الله عزّ وجلّ على ماذكرناه، فيزهد فيه ويعلو همه عنه بمشاهدة قدرة عظيمة، ومعاينة آيات كثيرة ظاهراً وباطناً، أن يدعى المعرفة أو يتوهم المحبة فما عنده منها إلا أماني وغرور وظنون وزور، والله تعالى يعطي قوماً الظنون كما يعطي أولياءه اليقين، ويعطي قوماً المزورات لعلل القلوب كما يعطي أحباءه المحققات في مقام محبوب، بآيات بينات وشواهد من اليقين، بإثبات آيات في القرآن وآيات الرسول، ولا يظهرهم على كن حتى ينكشف الكون عن قلوبهم، وفي الكون ما فيه من نفيس الملكوت وعظيم الرغبوت، مما لا يصلح ذكره، واعلم أنّ آفات النفوس وزينة الملك: حجب قلوب العموم وحظوظ العقل وشهوات الأرواح من رغبوت الملكوت، حجب قلوب الخصوص وسمو القلب إلى معاني الدرجات التي يشاهدها، ووقوفها مع خصائص الرحموت والرغبوت التي يطالع بها، حجب قلوب المحبوبين لأنهم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت بحبهم عنه حجب العقول وقعوا في شهوات الأرواح، فلا يواجهون بالوجه ولا ينظرون إلى الوصف حتى يجاوزوا أيضاً شهوات الأرواح وينكشف عنهم أيضاً، حجب الأنوار فيخلفوا الرسم ويغيروا الوسم، فإذا انكشفت المقامات وانقطعت الفضائل وحققت المطالعات وسقطت المنازل والدرجات، اصطلم الطالب وغلب المطلوب وفنى الراغب وبقي المرغوب، أظهر لهم التعلق بالاسم وهو آخر الحجب وأول القرب، يبتليهم به لينظر كيف يعملون في الوسم، فعندها حقت كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك الآية، وهناك صح له هذا المقام وفي معناه:
ظهرت لمن أفنيت بعد بقائه ... فصار بلا كون لأنك كنته
فهذا مكان وجده بموجوده وقيامه بقيوميته بعد أن كان واجداً بكونه وقائماً بقيامه، وقد كان أبو يزيد يقول: إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهيم صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين، فاطلب ما وراء ذلك، فإنّ عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة، فإن سكنت إلى ذلك حجبك به، وهذا هو بلاء مثلهم في مثل حالهم لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء، فإذا لم ينظر العبد إلى جميع المطلوب ولم يقف على كون مرغوب أقامه حينئذ مقام محبوب، فآواه في ظلة وعطف عليه بحنانه، ونظر إليه بعينه وواجهه بوجهه فتوجّه إليه ولم ينتنِ، وسارع إلى قربه ولم ين فلم يشهد في وجهه وجهاً، ولا رأى في يده يداً، وقام بشهادته لقيوميته مشاهداً فهذا غاية الطالبين من العارفين، وقد قال بعض العارفين المحبين: كوشفت بأربعين حوراء، رأيتهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن، وتنثني معهن، فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماً، قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء؛ فوقهن في الحسن والجمال، وقيل: انظر إليهن قال: فسجدت وغمضت عيني في سجودي لئلا أنظر، وقلت: أعوذ بك ممّا سواك، لاحاجة لي بهذا، فلم أزل أتضرع حتى صرفن عني، ولله عزّ وجلّ مثل هذا العبد في كل قرن وزمان ما يكثر عدده، متفرقين في أرضه ومنتشرين في بلاده ومخمولين مختبين تحت ستره في عباده، لا تستطيع العقول حمل وصفهم لضعفها، ولا يثبت في القلوب حق نعتهم لوصفها أقل مايوصفون به الإخلاص في الحركة والسكون، وهو أجلّ ماعندنا، والإخلاص عند المخلصين خراج الخلق من معاملة الخالق، فإذا لم يدخلوا كيف يخرجون؟ وأول الخلق النفس، فإذا لم يتكدر القلب بها كيف يصفى منها؟ والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل نفس، ولا دخل عليه مطالعة العرض والتشرف إلى حظ طبع، بل للتعظيم، ولا يشرك محبوباً في حب ذي الجلال والإكرام ولا يعلق قلبه بما يروق نظره من جمال لما ملاه من نهاية الحسن وغاية الجمال، ولا سبيل إلى هذا إلا بعد معرفته، ولا معرفة قبل معاينته إذ ليس الخبر كالمعاينة، ولا معاينة إلا بنور اليقين، ولا حق يقين بوجود هوى نفس، فإذا انكشف الحجاب وهوى الهوى طلعت عين اليقين، فأنوار الصفات من الحسن والجمال والبهاء والكمال، في عين اليقين عيناً بعد عين كنور فوق نور، إلى نور النور، والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر إليهم في الأفعال وترك السكون والاستراحة بهم في الأحوال، ومن الإخلاص في الصدق عند الصديقين سؤال الحجبة في قلوب الناس، كما قال بشر وقد سئل: بأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فقال: كنت أكاتم الله تعالى حالي: معناه أسأله أن يكتم علي ويخفي أمري، وحدثت أنه رأى الخضر عليه السلام فقال: ادع الله تعالى لي فقال: يسر الله تعالى عليك طاعته، قال، قلت: زدني فقال: وسترها عليك، فقيل في تأويل ذلك معنيان؛ منهم من قال: وسترها عليك أي يسترك حتى لا تعرف بها كما ذكرنا آنفاً.
وقال بعضهم: أراد سترها عنك حتى لا تنظر أنت إليها، وقال بعضهم: قلقني الشوق إلى الخضر، فسألت الله تعالى مرة أن يريني إياه، ليعلمني شيئاً كان أهم الأشياء علي، قال: فرأيته، فما غلب على قلبي ولا همني إلا أن قلت له: يا أبا العباس، علمني شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب الخليقة، فلم يكن لي فيها قدر، ولم يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة، فقال: قل: اللهم أسبل عليّ كثيف سترك وحط عليّ سرادقات حجبك، واجعلني في مكنون غيبك واحجبني في قلوب خليقتك، قال ثم غاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك، قال فما تركت أن أقول هذه الكلمات في كل يوم، فحدثت أنّ هذا كان يستذل ويمتهن حتى كان أهل الذمة يسخرون به في الطريق، يحملونه الأشياء في الطريق لسقوطه عندهم، وكان الصبيان يولعون به، وكانت راحته في ذلك ووجود قلبه به واستقامة حاله عليه، وهذا طريق جماعة من السلف وحال طبقة من صادقي الخلف، أخفوا أنفسهم وأسقطوا منازلهم فسموا عقلاء المجانين، وهذا من الزهد في النفس وحقيقة التواضع، إلا أنه زهد مجانين الأولياء وتواضع موقني الضعفاء؛ فالتكبّر يكون بثلاثة معان: تكبّر على الناس عجباً بالنفس، وتكبّر في قلوب الناس عزّة من النفس، أي يحب أن يكبر في قلوبهم فيكون ذلك تكبّراً منه، وتكبّر في القلب عن نظره إلى صلاحه ودينه فيكبر ذلك عنده فيدل به، ولذلك رآه من نفسه لقصور علم اليقين منه، وهذا أدق معاني التكبر ولا يتخلص منه إلا صحيحو التوحيد، صادقو اليقين مخلصو الصالحين، وأما التكبّر الظاهر الذي هو التطاول والفخر والتظاهر، فذاك جلي وهو من أكثف حجب القلب وأقوى صفات النفس، فلذلك فزع العلماء من دقائقه لما عرفوه، فطلبوا القلّة والذلّة للنفس ليمتهنوها بخفايا التواضع، لينتفي عنهم دقائق الكبر لتخلص لهم الأعمال، والتواضع عند المتواضعين هو حقيقة أن يكون العبد ذليلاً صفة لا متذللاً متعمّداً للذلّة، وأن يكون عند نفسه في نفسه وحيداً حقيراً معتقداً لصغره وحقارته في نفسه، لا متواضعاً متكلفاً، وعلامة ذلك أن لا يغضب إذا عابه ونقصه عائب، ولا يكره أن يذمه ويقذفه بالكبائر ذام، وبيان ذلك في وجده أن لا يجد طعم الذل في ذلة ولا يشهد الضعة في تواضعه، إذ قد صار ذلك له صفة، فمن ذلّ ووجد ذوق ذله فهو متعمل للتواضع، ومن تواضع وشهد تواضعه وضعته فهذا متعذر؛ وهي علامة بقية الأنفة في نفسه لنفسه، ومتى غضب أو كره ذمه من غيره فهو يفرح ويرضى بمدحه، فإذا كانت فيه هذه العلامات فهو محجوب عن جميع ما ذكرناه من المقامات، ومتى ذل نفسه وتواضع عند نفسه فلم يجد لذله ذوقاً ولا لضعته حسّاً فقد صار الذل والتواضع كونه، فهذا لا يكره الذم من الخلق لوجد النقص في نفسه، ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمنزلة من نفسه، فصارت الذلة والضعة صفته لا تفارقه، لا زمة له لزوم الزبالة للزبال والكساحة للكساح؛ هما صنعتان لهما كسائر الصنائع، وربما فخروا بهما لعدم النظر إلى نقصهما، فهذه ولاية عظيمة له من نفسه، قد ولاه على نفسه وملكه عليها فقهرها بعزه، وهذا مقام محبوب وبعده المكاشفات بسائر العيوب، أول ذلك دخول نور الحكمة في القلب وينبوع الحكم من قلبه، كما روينا أنّ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: يابني إسرائيل، أين ينبت الزرع؟ قالوا: في التراب فقال: بحق أقول لكم: لا تنبع الحكمة إلا في قلب مثل التراب، ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه، كما يطلب المتكبّر العز ويستحليه إذا وجده، فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله، كما أن المتعزز إن فارقه العز ساعة تكدر عليه عيشه لأن ذلك عيش نفسه، وممن روينا عنه اختيار الذل وإسقاط المنزلة والقدر عند الناس ومحو جاهه وموضعه من قلوبهم، وأظهر على نفسه ألوان معاني الذم أكثر من أن يحصى، وذكرهم يطول، وذاك أنّ حالهم الصدق فتقتضيهم القيام بحكمها فلا بد من قيامهم بمقتضى حالهم.
حدثني بعض الأشياخ عن أبي الحسن الكريني أستاذ الجنيد، أن رجلاً دعاه ثلاث مرات إلى طعامه ثم يرده، فرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله المنزل في المرة الرابعة، فسأله عن ذلك، فقال: قد رضيت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمي له عظم فيجيء وزاد غيره، وقال: لو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت، وحدثني شيخ آخر عن أستاذه قال: نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح، فتشتت قلبي فدخلت حماماً في جوف المحلة وعنيت على ثياب فاخر فسرقتها ولبستها، ثم لبست مرقعتي فوقها، وخرجت وجعلت أمشي قليلاً قليلاً ليفطن بي فلحقوني فنزعوا مرقعتي واستخرجوا الثياب، وصفعوني وأوجعوني ضرباً، فصرت أعرف في الناحية بلص الحمام فسكنت نفسي، وحدثت عن بعض الصوفية أنّه وقف على رجل يأكل، فمد يده إليه فقال: إن كان ثم شيء لله فقال له: اجلس فكُلْ، فقال: أعطني في كفي، فأعطاه في كفه فقعد في مكانه يأكله، فسأله عن امتناعه من الجلوس معه، فقال: إن حالي مع الله عزّ وجلّ الذل، فكرهت أن أفارق حالي، وكان هذا ربما مديده إلى الهراس فيضع فيها هريسته والعرب تأنف أن يوضع الشيء في أكفها لعزة نفوسها، حتى روينا عن بعض الصحابة من المهاجرين؛ الأول في أول النبوة فقال جعت ثلاثاً لم أطعم شيئاً، فبلغني أن إنساناً يتصدق بزبيب، فسألته فقال: هات كفك فقلت: إني رجل من العرب ولا آخذ في كفي فاجعله لي في شيء، قال فجعله في كيل ثم ناولنيه، فلما فرغته رددته إليه، فكانت فيه عزة نفس، لا جرم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: أنت رجل فيك جاهلية فقال: على ما أنا عليه من كبر السن؟ قال: نعم، وكان قدخاصم رجلاً فأرى عليه تعززاً، وإنما نبهنا ببعض ما ذكرناه له: العقول المستيقظة وحركنا بما بيّنا القلوب الحية، ليحيا من حي عن بينة بذكر أوصاف الصادقين وطرقات المخلصين ليستدل على الكثير باليسير، وقد كان شاهد من شهود بسطام عظيم القدر فيهم لا يفارق مجلس أبي يزيد فقال له يوماً: ياأبا يزيد، أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر، وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي شيئاً من هذا العلم الذي تذكر، وأنا أصدق به وأحبه، فقال له أبو يزيد: لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة، قال: ولم؟ لأنك محجوب بنفسك، قال: أفلهذا دواء؟ قال: نعم، قال: قل لي حتى أعلمه قال: لا تقبل، قال: فاذكره لي، قال: اذهب الساعة إلى المزين واحلق رأسك ولحيتك، وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك مخلاة مملوءة جوزاً، واجمع الصبيان حولك وقل: كل من صفعني صفعة أعطيته جوزة، وادخل الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك قال: كيف؟ قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها قال: هذا لا أفعله، ولكن دلني على غيره قال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء فقال: لا أطيقه فقال: قد قلت لك إنك لا تقبل، فهذا لما قال سبحان الله كان مشركاً عنده لأنه سبحه برسم النفس، وقد كان أبو يزيد يقول: سبحاني ما أعظم شأني وهو موحد لأنه وحد بأولية بدت.
وهذا الذي ذكره دواء من اعتلّ بنظره إلى نفسه، ثم سقم بنظر الناس إليه لزمه سد نظره إلى نظرهم، ليس لها من دون الله كاشفة إلا إن هذا من طبّ المجانين، يصلح لضعفاء اليقين، ولو أدخل الطبيب الأعلى ذرة من عين اليقين، أخرج بها من قلبه كل نظرة فاستراح من كل دواء، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينّة بشواهد الحق، ويحيا من حي عن بينة بشاهد الحق، ويتلوه شاهد منه فلا تنكرنّ من جميع ما ذكرناه شيئاً، فتخسر أقل أنصبة المؤمنين من علم القدرة واليقين، لأن للمؤمنين أنصبة من هذا العلم؛ منها المشاهدة لما وصفناه، والإدراك لما رمزناه، ومنها الوجد والحال، ومنها المعاملة، والمنازلة، ومنها الذوق والشمّ، منه وآخرها التصديق والقبول، فأقل النصيب من علم المعرفة إن لم يشهد فلا يجحد، وإن لم يعرف فليتعرّف، ويكون معقله التسليم وليس وراء هذا مكان، وهذه المقامات التي شرحناها وهي مقامات اليقين؛ أولها التوبة إلى هذا المقام من المحبة، منوط بعضها ببعض، إن أعطي العبد حقيقة من أحدها أعطي من كل مقام حاله ومع كل حال مشاهدة، ولكل مشاهدة علم، إلا من شهد بالحق، وهم يعلمون وكلها مجموعة في حقيقة الإيمان، إن أعطي العبد حقيقة من إيمان ويقين حتى يكون مؤمناً حقّاً، غير مرتدّ عنه ولا مستبدل به في علم الله تعالى، وكان إيمانه منة وهبة لا عارية ولا وديعة، فيسترد ويرتد على إظهار لبس أو إدراج مكر، محنة من الله تعالى وخبرة، ويكون مستبدلاً لا بدلاً، فإذا لم يكن كذلك وكان بدلاً من مستبدل به أعطي من جميعها حالاً فحالاً، وشهادة شهادة، وإن تفاوتوا في العلوم وتعالوا في القرب وذاك هو كمال الإيمان، وقد روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف كمال الإيمان، ثلاثة أحاديث من أصول هذه الأحوال وأساس هذه الأفعال منها؛ أنه قال: لا يستكمل العبد إيمانه حتى يكون قلة الشيء أحبّ إليه من كثرة الشيء، وحتى لا يعرف أحبّ إليه من أن يعرف، فهذان حالا الصادق الزاهد، وهما أول الطريق المؤدي إلى التحقيق وأس البنيان الرافع، إلى أنه ألا يخاف في الله لومة لائم ولا يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، آثر أمر الآخرة على أمر الدنيا، فهذه أحوال المحبّ لله تعالى، المخلص بمعاملة الله عزّ وجلّ، الراغب فيما عند الله تبارك وتعالى، والحديث الثالث قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون فيه ثلاث خصال؛ من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا قدر لم يتناول ماليس له، فهذه تجمع أحوال العدل والفضل والمراقبة والزهد، وهي أصول المقامات ويشبه هذا الحديث قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الحديث الرابع: ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى، والفقر وخشية الله تعالى في السرّ والعلانية، وتفسير ما ذكرناه قبل، من أن هذه المقامات مرتبطة بعضها ببعض، وأنّ من أعطي حقيقة من أحدها أعطي جميعها حالاً، إذ يجمع ذلك كله الإيمان بالله تعالى ليتوب العبد إلى من آمن به، وإلى ما آمن به من الوعد وما آمن به من الوعيد، ليحقّ إيمانه ويصحّ يقينه، وليستقيم توحيده، كما قال تعالى: إنَّ الذين قالوا: ربنا الله، ثم استقاموا، وقال تعالى: (فَاسْتَقِيمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ) هود: 112 وقال: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي فذهب إليه لما آمن به، وهو الرجوع وهي التوبة، ثم يزهد فيما تاب منه من هواه لتصحّ توبته وتخلص نيته، فيكون نصوحاً، كما قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقُ) النحل: 96، وقال: والآخرة خير وأبقى، وقال: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين لما أخرجوه من أيديهم وتركوه، وتابوا إلى أبيهم، وزهدوا فيه، ثم يصبر عما زهد فيه ليحق زهده، كما قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال عزوجل: (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرَ) المدثر: 7، ثم يشكر على ما صبر عنه ليكمل صبره، كما قال: (لاَ قُوَّةَ إلاَّ بالله) الكهف: 39، (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله) النحل: 53، (وَاذْكُرُوا نِعمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) البقرة: 231، ثم يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله بحسن ظنه به، كما قال تعالى:
(وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) الزمر: 9، وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، إنه ليؤس كفور، ثم يخاف فوت ما رجا ويخاف من تقصيره في الشكر لما أولى، لتحق غبطته برجائه ويتم إشفاقه من تبديل الآية ويخاف نقصان المزيد كما قال سبحانه: (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وطَمَعاً) السجدة: 16، وقال مخبراً عن أوليائه: إنّا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا وقد عاب الله من فرح بما أظهر له وفخر بما أوتي ومن عود البلاء ونسي أنه كان مبتلي، في قوله تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ: ذهب السيّئات عني إنه لفرح فخور، ثم يتوكل على من خافه فيسلم نفسه إليه ويستسلم بين يديه، أن يحكم فيه ما أحبّ لقوله تعالى: (وَعَلَى الله فَتَوَكَّلوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ) المائدة: 23، وقوله: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ثم يرضى بمن توكل عليه وعمّن توكل له لعلمه بحكمته البالغة وتدبيره الحسن لقوله تعالى: (رِضِيَ الله عَنْهُمْ رَضُوا عَنْهُ) المائدة: 119، ولقوله تعالى: ( وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله) البقرة: 2، 7، ثم يحب من رضي به ورضي عنه، إذ كان قد اختاره على ما سواه وإذ صار حسبه لما رآه، فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحد، بعضها منوط ببعض، ودليلها كتاب الله تبارك وتعالى الحقّ اليقين النور المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من طريق الهوى، ولا من خلفه من خيل الأعداء، فأشبهت دعائم الإسلام الخمس في مقام العموم من طريق الإسلام، إذ بعضها مرتبط ببعض كهذه في مقام الخصوص من طريق المقرّبين، ثم يرجع بعد مقام المحبة إلى حال الرضا قوة فقوة، ثم يتردد في مقام المحبة رتبة رتبة، وليس فوق حال الرضا مقام يعرف، ولا فوق مقام المحبة حال يوصف، وهما موجب المعرفة ومنتهاها المعروف وقرارها المألوف، وإن إلى ربّك المنتهى، إلى ربّك يومئذ المستقر، فليس للرضا نهاية إذ ليس للمحبوب غاية، وإنّ الرضا مزيد أهل الجنة، في الجنة وليس للحب نهاية لأنه عن الوصف ولا غاية للصفات وليس لطلب المحبّ حدّ لأنه عن القرب، ولا غاية للقرب لأنه عن وصف قريب، ولا حدّ لقرب فيترافع المؤمنون في الحبّ مقامات على تجلّي الحبيب بمعاني الصفات، ويتزايد الرضوان في الرضا درجات حسب تعاليمهم في علو المشاهدات، ويتعالى أهل عليّين في العلوّ غايات على قدر أنصبتهم من قوة الإيمان وصفاء اليقين. َيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) الزمر: 9، وقد ذم من أيس من رحمته بقوله: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، إنه ليؤس كفور، ثم يخاف فوت ما رجا ويخاف من تقصيره في الشكر لما أولى، لتحق غبطته برجائه ويتم إشفاقه من تبديل الآية ويخاف نقصان المزيد كما قال سبحانه: (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وطَمَعاً) السجدة: 16، وقال مخبراً عن أوليائه: إنّا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنّ الله علينا وقد عاب الله من فرح بما أظهر له وفخر بما أوتي ومن عود البلاء ونسي أنه كان مبتلي، في قوله تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ: ذهب السيّئات عني إنه لفرح فخور، ثم يتوكل على من خافه فيسلم نفسه إليه ويستسلم بين يديه، أن يحكم فيه ما أحبّ لقوله تعالى: (وَعَلَى الله فَتَوَكَّلوا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ) المائدة: 23، وقوله: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ثم يرضى بمن توكل عليه وعمّن توكل له لعلمه بحكمته البالغة وتدبيره الحسن لقوله تعالى: (رِضِيَ الله عَنْهُمْ رَضُوا عَنْهُ) المائدة: 119، ولقوله تعالى: (وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله) البقرة: 2، 7، ثم يحب من رضي به ورضي عنه، إذ كان قد اختاره على ما سواه وإذ صار حسبه لما رآه، فصارت هذه المقامات التسع كمقام واحد، بعضها منوط ببعض، ودليلها كتاب الله تبارك وتعالى الحقّ اليقين النور المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه من طريق الهوى، ولا من خلفه من خيل الأعداء، فأشبهت دعائم الإسلام الخمس في مقام العموم من طريق الإسلام، إذ بعضها مرتبط ببعض كهذه في مقام الخصوص من طريق المقرّبين، ثم يرجع بعد مقام المحبة إلى حال الرضا قوة فقوة، ثم يتردد في مقام المحبة رتبة رتبة، وليس فوق حال الرضا مقام يعرف، ولا فوق مقام المحبة حال يوصف، وهما موجب المعرفة ومنتهاها المعروف وقرارها المألوف، وإن إلى ربّك المنتهى، إلى ربّك يومئذ المستقر، فليس للرضا نهاية إذ ليس للمحبوب غاية، وإنّ الرضا مزيد أهل الجنة، في الجنة وليس للحب نهاية لأنه عن الوصف ولا غاية للصفات وليس لطلب المحبّ حدّ لأنه عن القرب، ولا غاية للقرب لأنه عن وصف قريب، ولا حدّ لقرب فيترافع المؤمنون في الحبّ مقامات على تجلّي الحبيب بمعاني الصفات، ويتزايد الرضوان في الرضا درجات حسب تعاليمهم في علو المشاهدات، ويتعالى أهل عليّين في العلوّ غايات على قدر أنصبتهم من قوة الإيمان وصفاء اليقين.
قال الله تعالى: (وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين) آل عمران: 139، فأعطاهم من معاني وصفه العلو، ثم وصف نصيبهم بوصفهم فقال: إنّ كتاب الأبرار لفي علّيين، وما أدراك ما عليّون، فعليّون لانهاية له في العلوّ إذ هو من أسماء المبالغة في الوصف، وقيل: إنه اسم لا واحد له من جنسه، فهو عليّ في علوّهم يعلو بهم أبداً في علوّ علوّهم في دار الأبد، وهم أعلون لأن الأعلى معهم، فهم يعلون به، وعليّون يلعو بهم هذا كله لأنه معهم، كما قال: وأنتم الأعلون والله معكم، فالرضا الأول الذي هو قبل المحبة مقام التوكّل، وحال المحبّ المحبوب حاله، والرضا الثاني الذي يكون بعد المحبة مقام المعرفة، وحال المحبوب التوكل حاله، والمحبة من أشرف المقامات ليس فوقها إلا مقام الخلّة، وهو مقام في المعرفة الخاصة وهي تخلّل أسرار الغيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب باب يعطي حيطة بشيء من علمه بمشيئته على مشيئته التي لا تنقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغيرّ، وفي هذا المقام الإشراف على بحار الغيوب وسرائر ما كان في القديم، وعواقب ما يؤت، ومنه مكاشفة العبد بحاله وإشهاده من المحبة مقامه، والإشراف على مقامات العباد من المآل والإطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد حالاً فحالاً، وقد ذكر أبو يزيد البسطامي وأبو محمد سهل أنهما أقيما في هذا المقام، ووصفا حاليهما منه، وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيين مطالعات في هذه المعاني، وقد سلك بابي الفيض في هذا الطريق، فظهر على ما فيه مما يبهر من رأى انقلاب الأعيان وتبصرة بعظيم العيان، وهذا محجوب عن أوهام القلوب بعقولها، ومستقرّ في جبّ غاية القلوب بأرواحها، فإذا خرجت النفس من الروح فكان روحانيًّا خروج الليل من النهار تنفس المكروب، وإذا خلا العقل عن القلب فكان ربّانيًّا انفرجت الكروب، كما قال العارف:
بحياتي يا حياتي ... لا تبعد قرباتي
أخرج النفس من الرو ... ح وروّح كرباتي
وقد قال أحسن القائلين: (وَلاَيُحِيطُونَ بِشَيءِ مِنْ عِلْمِهِ إلاَ بِما شاءَ) البقرة: 255، والاستثناء واقع على إعطاء الحيطة بشيء من شهادة علمه، بنور ثاقب من وصفه وشعاع لائح من سبحته إذ شاء، وهذا معنى من سرّ التوحيد لا يكشفه إلا عين اليقين، ولا نظهره حتى يظهر لنا منه عارف ما عليه قد أوقف، وما منه به قد كوشف، فحينئذ يقع العين على العين ويضيء الكوكب الدرّي في جوهر مشكاة القلب، وقد كان للشيخ أبي الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق، مشاهدات ومطالعات وسياحات في الغيوب، وجريان في الآخريات، وانقلبت له الأعيان وظهر له العيان، وطوى له المكان ورأى ألف وليّ لله تعالى، وحمل عن كل واحد علماً، ثم انقطع الطريق بعد فقده وعفا الأثر ودرس الخبر، ثم الله تعالى أعلم بما هو صانع بهذا الطريق وأهله، هل ينشئ له أهلاً وينهج له غامضات الطريق طريقاً أم يطويهم في طيّ طريقهم ويخفي طريقهم في خفاء الموج الغامض في غامضات العلم السابق؟ نقول في ذلك كا قال إمام الأئمة علي بن أبي طالب، كرّم الله وجهه، بعد إذ ذكر في خطبته قيام الساعة واسقرار أهل الدارين فيهما قال: ثم الله أعلم بما هو صانع بالدنيا بعد ذلك، فهذا من سرّ السرّ الذي أودعه صاحب الأمر، وليس فوق الخلة مقام إلا درجة النبوة، وهو محجوب عن القلوب كحجاب هذا المقام من الخلّة عن قلوب العموم، فهذا لا فوت فيه لأنه درك منه، ولا حزن عليه لأنه لا نصيب عنه، ولكن مقام الخلّة لا يكون إلا مقام محبوب على كل حال.
وما سمعت من أحد من أهل العلم الباطن والمعرفة الثاقبة رسماً من علم الخلّة ولا من وصف محبوبه شيئاً في كتاب الله تعالى، ولا إشاراته إلا نكتاً في الأخبار ولمعاً من الآثار، أعلم أنه كلام محبوب من مقام خلّة، ولكنه مستودع في كتاب الله تعالى المكنون، وغامض من خطابه المصون، ومخبوّ في سرّ آياته عن القلوب والعيون، وكاشف به الساجدين، وأظهر عليه أهل السرّ من العارفين، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض، وقوله تعالى: (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذي يَعْلَمُ السِّرَّ في السَّمَواتِ وَالأرْض) الفرقان: 6، وقد كان الحسن رحمه الله يروي في الخلّة أخبار، منها أن الله عزّ وجلّ أوحى إلى بعض أوليائه: إنما أتخذ لخلّتي من لا يفتر عن ذكري ولا يكون له غيري ولا يؤثر علّي شيئاً من خلقي، وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجعاً، وإن قطع بالمناشير لم يجد للمس الحديد ألماً، وقد روينا عن الخليل الحبيب عليه السلام أنه قال: تحابوا في الله وتصافوا وتباذلوا وتخاللوا فيها، وليس من كرم الله تعالى أن اتخذ عبداً من عباده خليلاً فنبه أن الخلّة من الله تعالى كانت لأوليائه عن فرط كرمه وفضل آلائه، ألحقهم بكرامته وأهلهم بفضله لها وعظمهم عن نصيب تعظيمه فيها، والله الواسع الكريم ذو الفضل العظيم، إذا رفع عبداً جاوز به الحدود، وإذا خفضه وضعه تحت المحدود، وقد تكلم الجنيد رحمه الله تعالى في مقام من هذا وقد سئل عنه فقال: هو غاية الحبّ وهو مقام عزيز يستغرق العقول وينسي النفوس، وهو من أعلى علم المعرفة بالله تعالى، وقال: في هذا المقام يعلم العبد أنّ الله عزّ وجلّ يحبه ويقول العبد: بحقي عليك وبجاهي عندك ويقول: بحبك لي، قال: وهؤلاء هم المدلون على الله تبارك وتعالى، والمستأنسون بالله تعالي، وهم جلساء الله تعالى، قد رفع الحشمة بينه وبينهم وزالت الوحشة بينهم وبينه، فهم يتكلمون بأشياء هي عند العامة كفر بالله لما قد علموا أن الله تعالى يحبهم، وأنّ لهم عند الله جاهاً ومنزلة، ثم قال عن بعض العلماء: أما أهل الأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم سبل، هذا من كلام الجنيد ونحو معناه حدثني به الخاقاني المقري، ولولا أنّا روينا عنه ما ذكرناه لا ما كنا نشرح حال هؤلاء إشفاقاً على الألباب كما قال المجلى:
وأن أشرح ثناءك غير أني ... أجلك عن كتاب في كتاب
وقد كان شيخنا أبو بكر بن الجلاء رحمه الله كتب إلى شيخنا أبي الحسن بن سالم رحمه الله تعالى، يسأله عن مسائل من معاني السرائر في كتاب، فحدثني من رآه: رمى بالكتاب وقال: أين صاحب هذه المسائل؟ فقيل: هو غائب بمكة فقال: أنا لا أجيب عن هذا في كتاب، قولوا له: يحضر إن أراد، وقد حدثني ابن الجلاء بهدا لأن مقام الخلّة هو الذي أخفيناه وعظمناه، لا يعطاه العبد إلاّ في مقام مع مقام، فالمقام الأوّل هو المعرفة الخاصية بظهور تعرف كشفاً عن وصف الباطن، ثم يدخل عليه المحبة المخصوصة وهو مقام محبوب، ثم يرفع من هذا المقام إلى مقام الخلة وهو الإشراف على سرائر غيوب من شرفات العرش وسرادقات القدس وغير ذلك، والأصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطي مقامات المعرفة في مقام عارف، ولا يعطي فيه مقام محبوب، وقد يعطي مقامات من المحبة في مقام محبّ ولا يعطي شهادته خلّة لغير خليل عارف، فإذا جمع مقام معرفة تعرّف إلى مقام محبة محبوب أعطي مقاماً من الخلّة الذي وصفناه، وهذا من أعز ما أظهر في الكون لمظهر مكنون، وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه خطب الناس قبل موته بثلاث فقال: إن الله تعالى قد اتخذ صاحبكم خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، فرفع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مقام محبوب إلى درجة خليل كما نقل من مقام محبّ إلى حال محبوب، كما زيد بالمحبة في مقام محبوب الصفوة، وقال أيضاً في المقام الأول: إنّ الله عزّ وجلّ اتخذ موسى صفياً واتخذني حبيباً، فأول العطاء هو الصفاء من الهوى ثم المحبة بعد الصفاء، ثم الزيادة بوصف محبوب فوق المحبة، ثم ارتفع فعلا بعد القوّة والاستواء إلى العلي الأعلى، فدنا لما علا فتدلّى حتى دنا فكان قاب قوسين أو أدنى وكانت البلد من ورائه والوجه مواجها لوجهه:
وكان ما كان مما لست أذكره ... فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر
إذ من العلوم علم لا ينبغي أن يسأل عنه حتى يبدي العالم ذكره، فهذا منها فلا يبدي إلا بقدر معلوم بمقدار ما أبدى المبدئ، ويعيد منه بقدر ما أعاد المعيد، وكان لديه خليلاً كما كان عنده قريباً، فصارت الخلّة مقاماً في محبوب وهو نهاية المزيد، كما كان مقام محبوب وزيادة على مقام محب كما رفعه إلى المحبة بعد الصفوة من كدر الهوى، وكذلك أنت أيها السامع الشاهد، يجعل لك بعد الصفاء نصيباً من نصيب وشهادة على شهادة، ووجداً من وجد وفقداً للنفس من فقد، فلا يذهب كثير النبوّة منه صغير العطية لك لأنّه تعالى رفع الطائعين له ولرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقاماً إلى مقام النبّيين والصدّيقين، والصدّيقون باقون إلى نزول الروح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهم الأبدال عددهم في كل الدنيا ثلاثمائة، وما شاء الله منهم الشهداء والصالحون، فهم ثلاث طبقات وكلهم مقرّبون سابقون، إيمان صدّيق منهم كإيمان جميع الشهداء، وإيمان شهيد كإيمان كل الصالحين، وإيمان كل صالح بمقدار إيمان ألف مؤمن من عموم المسلمين، وليس في الخلّة شريك لغير الخليل على خليله، ولأنها حال مفردة لفرده موحدة لواحد، ولو كان يصلح لها نظير ويوزر بها وزير كان أحق الأمة بذلك الصدّيق، فقد أعطاه تعالى ثلاثاً لم يعطها غيره منها: إنا روينا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: إنّ الله عزّ وجلّ أعطاك مثل إيمان، كل من آمن بي من أمتي، وأعطاني مثل إيمان كل من آمن بي من ولد آدم، والحديث الثاني أنّ لله تعالى ثلاثمائة خلق، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل فيّ منها خلق واحد؟ فقال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله عزّ وجلّ السخاء، والحديث الثالث هو المستفيض، رأيت ميزاناً دليّ من السماء فوضعت في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة، وجيء بأمتي فوضعت في كفة، فرجح بهم وليس بين الصدّيق وبين الرسول إلا درجة النبوّة والقطب اليوم الذي هو إمام لأثافي الثلاثة، والأوتاد السبعة، والأبدال الأربعين والسبعين إلى ثلاثمائة، كلهّم في ميزانه، وإيمان جميعهم كإيمانه، إنما هو بدل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه والأثافي الثلاثة بعده، إنما هم أبدال الثلاثة الخلفاء بعده والسبعة هم أبدال السبعة إلى العشرة، ثم الأبدال الثلاثمائة وثلاثة عشر، إنما هم أبدال البدريين من الأنصار والمهاجرين أهل الرحمة والرضوان، فمع هذا الفضل العظيم لأبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرّب الخليل في مقام الخلّة، كما صلح أن يشرك في مقام الأخوة، وهو المقام الذي شرك فيه عليًّا كرّم الله وجهه، فقال عليّ مني بمنزلة هارون من موسى، فهذا مقام أخوة، كذلك في التفرّد بمقام الخلّة: لو كنت متّخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله تبارك وتعالى يعني نفسه صلوات الله عليه، لأنه واحد لواحد، مفرد لفرد، فاعتبروا يا أولي الألباب بتدبر فهم الخطاب، فمن أعطي من الصفاء نصيباً أعطي من الحب نصيباً، وكان له من المعرفة بقوة محبته، ومن المعرفة بقدر معرفته، فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومكان المشاهدات، فهي عندهم واحدة، لأن المعروف بها واحد والمتعرّف عنها واحد، إلا أن لها أعلى وأول، فخصوص المؤمنين في أعلاها وهي مقامات المقرّبين، وعمومهم في أولها وهي مقامات الأبرار، وهم أصحاب اليمين، ولكل منهم وجهة من الصفات المخوفة عنها كانوا خائفين، أو الأخلاق المرجوّة منها كانوا راجين، أو الأفعال والأملاك عندها كانوا صابرين شاكرين، أو معاني أوصاف ذات منها كانوا محبين متوكّلين، قال الله سبحانه وتعالى: (وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا فَاسْتِبَقُوا الْخَيْرَاتِ) البقرة: 148، ويقال من أحب شيئاً حشر معه.
وفي الخبر: المرء مع من أحبّ وله ما احتسب، وفي الخبر: من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة، فأماجمل مقامات المحبين فمذكورة في الكتاب العزيز، من الحبيب اثني عشر مقاماً: خميس في دليل الخطاب وتدبّر الألباب، وسبعة في صريح الكلام بظاهر الأفهام، فأمّا السبع المصرحة فقوله عزّ وجلّ: (إنَ الله يُحبُ التَوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتُطَهِّرينَ) البقرة: 222، (وَالله يُحِبُ الصَّابِرينَ) آل عمران: 146، (وَالله يُحِبُّ الشَّاكِرينَ) آل عمران: 144، (واللهُ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ) آل عمران: 76، (وَالله يُحِبُّ الْمُحْسِنين) آل عمران: 134، (وَاللهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكّلينَ) آل عمران: 159 وأما الخمسة المتدبرة فهم الموحدون لقوله: لا يحبّ الكافرين والعادلون، لقوله: لا يحب الظالمين والمستقيمون، لقوله: لا يحب الفاسقين والمتواضعون، لقوله: لا يحبّ المستكبرين والموفون، لقوله: لا يحبّ الخائنين وهؤلاء طبقات المحبوبين تعريضاً وتصريحاً، وشرح هذه الأوصاف هي مقامات اليقين، وفي كل مقام من هذه أحوال يكثر عددها، كل حال منها طريق إلى الله عزّ وجلّ، في كل طريق طائفة من المحبين، محبتهم على قدر معرفتهم ومعرفتهم على زنة تعرف المعروف إليهم، وعن نحو تعريف المعروف لهم، وذلك معنى من معارفهم، فهم على زنة يقينهم، ويقينهم على حسب صفاء إيمانهم، وإيمانهم على نحو عناية الله بهم وتفضّله عليهم وإيثاره لهم، ومن وراء ذلك سرّ القدر المختزن المستأثر، وليس فوق المحبة مقام مشهور، ولا دون التوبة حال مذكور، فأول المقامات التوبة، يخرج بها من الظلم والظلم حال من الشرك، قال الله تعالى: (إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ) لقمان: 13، وقال الله تعالى: (الَّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَاَنهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ في الدُنْيَا) الأنعام: 82، وهذا فصل الخطاب لأضدادهم، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم أحق بالأمن غداً في المقام الأمين وقال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) الحجرات: 11، فآخر الظلم أول التوبة وآخر التوبة أول المحبة، وآخر المحبة أول المعرفة وهي معرفة متعرف، وهي الخاصية مزيد المحبة الأولى وآخر نصيب العبد من المعرفة وأول التوحيد، وهو توحيد الشاهدين ولا آخر له، وأوسط المقامات الزهد وأول الزهد آخر الهوى، وآخر الزهد أول العلم وآخر العلم أول الخوف وآخر الخوف، أول الحبّ وهذا حبّ محبوب، والظالم لامقام له ولاجاه، ومن لا جاه له فلا شفاعة ومن لا شفاعة فلا شهادة، ومن لاشهادة فلا يقين، فلو أعطي مثقالاًِ من الإيمان لم يتجه لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في وصف الداخلين: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم قال في الخبر الآخر: السخاء من اليقين، ولا يدخل في النار موقن، وقال سبحانه وتعالى في تقصيل ماوصلنا مما عنه شهدناه: (لاَ يَنَالُ عَهْدي الظَّالِمينَ) البقرة: 124، ثم قال في البيان الثاني من الخطاب: (لاَيَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحَمنِ عَهْداً) مريم: 87، وقال في البيان الثالث: (وَلاَيَمِلْكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمْونَ) الزخرف: 86، وقال في وجد اليقين بعد شهادة العين في الرواية بعد المكاشفة: (وَكَذلِكَ نُرِي إبْراهيمَ مَلَكُوتَ الَّسمواتِ وَالأَرَِْض ولِيَكُونَ مِنَ المْوقِنينَ) الانعام: 75، ثم قال بنبأ يقين: إني وجدت، وكما أن اليقين بعد المشاهدة كذلك الوجد بعد اليقين، واليقين هو حقيقة الإيمان وكماله، كما جاء في الأثر: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله.
وقد روينا في تفسير قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، قيل: الجاه وقيل: الشفاعة ويقال: الولاية، وقيل: الإمامة، لا يكون الظالم إماماً للمتقين لأن من تبعه أمة من المؤمنين فهو إمام للمتقين، والظالم متهدد بالنار متوعّد بسوء المنقلب، مشفوع فيه فكيف يكون شفيعاً محجوب عنه؟ فكيف يكون شهيداً؟ ألم تسمع إلى قول الشاهد: ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون وإلى قوله تعالى: (وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمْوا أيَّ مُنْقَلبِ يَنْقلبُونَ) الشعراء: 227، مع قوله تعالى: (فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذِلكَ جَزَاؤُا الظَّالِمينَ) المائدة: 29، ثم أجمل ذلك بقوله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فصغير التوبة لصغير الظلم عن صغائر المظالم، وكبير التوبة لكبير الظلم عن كبائر المظالم، والظلم ظلمة اليوم في القلب، وظلمة غداً في القيامة، فالتوبة تخرج العبد من الظلم، وبخروجه من الظلم يدخل في منازل العهد، وبرعاية العهد يعمل في الإصلاح، والله لا يضيع أجر المصلحين، كما لا يصلح عمل المفسدين، فإذا كان مصلحاً بالتوبة ما أفسد بالهوى استعمل بالصالحات لأنه قد صلح، َفإذا عمل بالصالحات أدخل في الصالحين لأنه قد فضل، قال الله تعالى: (وَيُؤْتِ كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ) هود: 3، وقال في البيان الأول: (وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ في الصَّالِحينَ) العنكبوت: 9، فمن صلح له تولاّه ومن تولاه علمه وحباه وكاشفه من نفسه وعافاه وأحبه، فكان هو حسبه وكفاه وجعله تحت كنفه وآواه، فيكون ظاهر حاله العصمة من الهوى، وأعلاه مشاهدة عين اليقين من المولى، ومن اكتسب من المظالم ظلم، ومن ظلم ولاّه مثله ومن ولاّه مثله تولى عنه، ومن تولى عنه أفسد ومن أفسد قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن قطع بعد فانقطع ومن انقطع فبعد لعن وطرد ومن طرد عمي وصمّ تحت الهوى المعمي المصمّ، ومن عمي لم يشهد البصير ومن صمّ لم يسمع من السميع، فكيف يتدبر الخطاب وقلبه مقفل وهمه على هواه مقبل؟ والفتاح العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل القول بمطلع المقول من قوله تعالى: (نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ) الأنعام: 129 ومن قوله تعالى: (إنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا في الأَرْضِ) محمد: 22 الآية، فبينوا وللتائب حال من أول المحبة، وللتواب مقام من حقيقة الحبّ، وللناس في التوبة مقامات حسب كونهم في الهوى طبقات، وهم في الحب درجات نحو مشاهدتهم لمحاسن الصفات، فتجلّى لكل وجه بمعنى، حسن وجهه هذا في القلوب عن محاسن الإيمان، وفي الآخرة على معاني محاسن الوجوه في العيان، فتحكم عليهم المشيئة منه لهم بما يوجدهم به منه على معاني ما أوجدهم منه به اليوم، فسبحان من هذه قدرته عن إرادته وسع كل شيء رحمة وعلماً، ويلزم كل عبد من المجاهدة على قدر ما ابتلى به من الهوى، ويثبت له من المحبة بقدر ما صح له من التوبة، ويسقط عنه من المجاهدة بقوة ما يكشف له من المشاهدة، فيحمل الإشهاد عنه آلام الجهاد، فيكون العبد في البلاء محمولاً، ويكون يقينه بالشهادة واليقين موصولاً، وهذا من سوابغ العوافي وتمام من النعماء، وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصدِّيقين والشهداء وهم الذين جاء الخبر فيهم.
إنّ لله عباداً ضنائن من خلقه، يغذوهم برحمته ويجعلهم في ظل عافيته، يضن بهم عن القتل والبلاء ويحييهم في عافية، ويدخلهم الجنة في عافية أولئك الذين تمرّ عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية، فالأفضل بعد هذا لكلّ عبد معرفته بعلم حاله، ووقوفه على حده ولزوم الصدق في مقامه، وترك التكلّف والدعوي في جميع سكونه وحركته، فإنه هذا أبلغ فيما يريد، وأوصل في طلب ما يرجو، فإنّ علم العلماء لا يغني عنه من علمه بنفسه شيئاً لا يسأل عن علومهم كما لا يسألون عن علمه، وهذا طريق رأس ماله الصدق، وزاده الصبر وقوته التقوى، فمن عدم الصدق لم يربح، ومن لم يتزود الصبر انقطع، ومن لم يقتت التقوى هلك، فذرة من صدق أنفع من مثقال عمل، وذرة من صبر خير من مثقال من عمل، وذرة من تقوى أنفع من مثقال إيمان، فإنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئاً، ويعطي الله تعالى العبد بأداء الفرائض واجتناب المحارم مقاماً من مقامات اليقين، يرفع به إلى عليين، وربما أعطاه بهما مثل ثواب الأبدال بعد أن يريد بالفعل والترك وجه الله تعالى وحده، وإن لم يسلك به طريق الأبدال قط ولم يعرف منهم أحداً أبداً، ومن نقله مولاه باليقين الذي به تولاه لم يخف عليه التنقيل، لأن النقل يضطره إلى التنقل في الأحوال، والمشاهدة تحكم علىه بالأفعال، وربما بلغ الله تعالى العبد بحسن الظن به، وقوة الأمل والطمع فيه جميع ما ذكرناه، بعد أن يكون حسن اليقين، وقد يعطيه مقام الصدِيقين بخلق من أخلاقه إذا خلقه به، وربّما بلغه منازل الشهداء بشيء واحد يتركه له، أو شيء يؤثره به لأنه غفور شكور، وأضرّ شيء على العبد قلة معرفته به، فلربما كان العبد على تسع كبائر فيترك العاشرة لوجه الله تعالى، فتكون تلك الخصلة ذرة إلى جنب تسعة أجبل، فينظر الله تعالى إليه بوجهه لوجهه الذي تركه له نظرة، فتمحو تلك النظرة الجبال التسعة فتصبر هباءً منثوراً، وربما حسن الله تعالى وصفاً واحداً من العبد يصفه به فيحبط عنه مائة وصف قبيح يصفه الناس به، فتدبروا، فلا ييأس عبد من فضل مولاه ولا يقطعن من حبله رجاه بعد إذ عرفه، فإن السيد كريم رحيم، ولا ينقطعن عبد عن بابه وأن يقطع بخلافه ولا يبعدن عن فنائه وإن بعد بأوصافه، ولا يستوحش من التقرّب إليه بما يحب بعد ما توحش، تفحش لديه بما يكره، فهكذا يحب الله تعالى من عباده فتبينوا، ونحو هذا يحبّ الله تعالى منهم أن يعرفوا فيفعلوا بعد المعرفة، فإنّ المعروف مفرط الكرم واسع الرحمة فاضل الفضل، فإن أعطي المعرفة لم يمنع شيئاً ولا يضرّ ما منع وإن منع المعرفة لم يعط شيئاً ولم ينفع منه ما أعطي، وقد تلتبس المحاب فتدخل محبة النعم في محبة المنعم، وتدخل محبة النفس على محبة خالق، ويشتبه ذلك عند عموم المحبين ممن لم يكشف له عين اليقين، فيكون العبد محبَّا للنعم، وهو يظن بوهمه أنه محب للمنعم، ويكون محبّاً لنفسه ويحسب أنه محبّ لمولاه، وعلامة ذلك سكونه إلى الأشياء وفرحه بالموجودات، ووجود راحته ولذته في هواه، فربما اختار الله تعالى أن يكشف له حاله قبل موته، وربما ستر عليه حاله ولم يفضحه حتى يلقاه، فيثيبه ثواب مثله وجزاءه، وليس يظهر فرقان هذا إلا في قلب موقن مراد بنورثاقب، وعلم نافذ ويقين صاف من عين التوحيد وشاهد القيومية لأنه من باب مشاهدة الصفات الغيبية ومشاهدة الأفعال الملكوتية، وهو الفرقان الذي وعده الله تعالى المتقين من المؤمنين فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً) الأنفال: 29، قيل: نوراً أتفرقون به بين الشبهات وهو المخرج الذي ضمنه الله تعالى لأهل التقوى، والمنهج في قوله تعالى: (وَمنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق: 2، قيل: من كل أمر ضاق على الناس به فتفصيل معاني التوحيد من شواهد الناظرين أضيق الضيق، وشهادة الجمع في التفرقة والبقاء في الفناء أخفى، وشرح غريب عن الأسماع ينكر أكثره أكثر من سمعه، غير أنّ من له نصيب منه يشهد ما رمزناه، فيكشف له به ما غطيناه، إلا أنه استولى على القلب أحد وجهين، فالخصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات، فحب هؤلاء بقلب ووجد لا يتغير أبداً، وهم مثبتون فيه إلى لقاء الحبيب، وهؤلاء عبدوه على التعظيم والمحبة والإجلال والكبرياء، وفي هؤلاء المقرّبون والمحبوبون
والخائفون والعاملون والمتوكلون والراضون، وهو المقام الأعلى وهم الأعلون عنده في المنتهى، والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال، وهي النعم والإحسان والأيادي والأفضال، وعما أظهر من العوافي ومما أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاجة، أحبوه لمنافعة ومرافقه ولأجل ما في يده من ملكه، وحبّ هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام، وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهد، وقد بقي عليهم من نفوسهم هوى، حجبهم ذلك عن مخالصته وبعدهم عن مضافاته، وهذه هي أوصافهم عائدة لهم وعليهم، فحبّ هؤلاء حول قلب لأن الأفعال التي أحبوه لأجلها تحول فيحولون، وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر فيختلفون، وفي هؤلاء المريدون والعاملون والراجون والطامعون والتائبون وأصحاب اليمين من هؤلاء. ائفون والعاملون والمتوكلون والراضون، وهو المقام الأعلى وهم الأعلون عنده في المنتهى، والعموم أحبوه من طريق مواجيد الأفعال، وهي النعم والإحسان والأيادي والأفضال، وعما أظهر من العوافي ومما أخبر عنه بما أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاجة، أحبوه لمنافعة ومرافقه ولأجل ما في يده من ملكه، وحبّ هؤلاء يتغير لانقلاب الأحكام، وهؤلاء لم يتحققوا بالإخلاص ولا الزهد، وقد بقي عليهم من نفوسهم هوى، حجبهم ذلك عن مخالصته وبعدهم عن مضافاته، وهذه هي أوصافهم عائدة لهم وعليهم، فحبّ هؤلاء حول قلب لأن الأفعال التي أحبوه لأجلها تحول فيحولون، وتختلف عليهم بالمكاره والمرائر فيختلفون، وفي هؤلاء المريدون والعاملون والراجون والطامعون والتائبون وأصحاب اليمين من هؤلاء.
وقد قال بعض العارفين: كل محبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت المحبة فمنهم من عرف حاله في مقامه، فاعترف بنقصان محبته وتقصير شهادته واستغفر منها وأناب، ومنهم من ليس عليه ذلك لنقصان مزيده وضعف يقينه، فكانت محبته عن صفات متصلة بذات، ويخاف على مثل هذا الانقلاب عندكشف الغطاء، لأنه في اغترار وفتنة والتباس ومحنة، وفي طريق مكر وهلكة إلا أن تداركه رحمة من ربّه، فيوقف في حده في مقامه ويرده إلى حاله من مكانه، فيتوب من محبته ويستغفر من شهادته، فحينئذ يرحمه الله تعالى فيدخله في أهل العفو، ويستر عليه في الآخرة كما ستر عليه في الدنيا، فلقيه تحت الستر في الدارين، وهذه بعض مخاوف الصادقين من المحبين لأنها محبة إظهار لا ظهور، فصاحبها في تقلّب وغرور، إلا أنّ أهل محبة الأفعال ينقسمون قسمين: منهم من أحبه لأجل أفعاله إلا أن يشهدها منه فيراه فيها، فهو يتبصر له ويتعمل في المجاهدة ويجتهد في تنقية محلبه لبقاء حاله، فهذا أعلاهما وهذه محبة عموم أهل الآخرة الذين لا يشهدون سواها، ولايطلبون إلا إياها، ومنهم من تتغير عليه الأفعال وتخرجه من الاعتياد، ويتابع عليه البلاء وينقصه من العوافي في المال والنفس، فيخرج صفته ويظهر من تسخطه وتبرمه به، فهذا قد افتضح بدعوى المحبة وقد كشفه بعد ستره، فلم يزن في المحبين حبة، وهذه محبة أهل الدنيا الذين هم لها يكدحون وإياها يطلبون وقد سئل الجنيد رحمه الله تعالى عن المحبة فقال: الناس في محبة الله خاص وعام: فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه، فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على قدر النعم والإحسان، فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظيم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك، فلما عرفوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسنى، لم يمتنعوا أن أحبوه إذا استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها، ولو زال عنه جميع النعم، ومن الناس من يكون محباً لهواه أو لعدوّ الله إبليس، وهو يدعي لعظيم جهله وطول غرته المحبة لله تعالى.
قال بعض علمائنا: عوتب أبو محمد في قوله: لكل أحد يادوست قال: وقلت له: قد لا يكون حبيباً كما تقول فقال في أذني سرًّا لا يخلو: إما أن يكون مؤمناً أو منافقاً، فإن كان مؤمناً فهو حبيب الله عزّ وجلّ، وإن كان منافقاً فهو حبيب إبليس، ومن محبة الهوى إيثار عاجل حظ النفس على آجل ما وعدت به ويقدم محبتها على محبة الله عزّ وجلّ، وهي مطبوعة على محبة الهوى، وكراهة الحق أمارة بالسوء فيما تسرّ كذابة فيما تظهر من الخير، قال الله سبحانه تعالى: (وَعسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أنَ تُحِبُّوا شىْئاً وَهُوَ شرٌّ لَكُمْ) البقرة: 216، فقرن محبتها بالشر وقرن كراهتها بالخير، والعرب تسمي النفس كذبة أي التي يكثر منها الكذب، يصفونها بالمبالغة فيه على معنى قوله: ويل لكل همرة لمزة، أي الذي يكثر همز الناس ولمزهم، وكذلك وصفها الله تعالى بالمبالغة بالأمر بالسوء فقال: أمارة بالسوء أي فعالة، التي يكثر منها الأمر يتكرر مرة بعد مرة، من وصفها الفعل ومن محبة العدو طاعته وموافقته لأن فيها كراهة الله تعالى ومخالفته وهو مجبول على ضد ما يحب الله تعالى، والله تعالى يحب ضد ما جعله عليه وذلك ابتلاء من الله تعالى له، وابتلاء منه به لنا، واعلم أنّ قليل ما أعطاك الله عزّ وجل ّمن الإيمان به وصحة التوحيد له، ويسير ما قسم الله تعالى لك من الإخلاص والصدق وحسن المعاملة، خير لك وأنفع من كثير ما أظهر لك وعرفك، وإنما لك مما رأيته ما طلبته ونلته بيدك، وما ملكته وسلطت عليه من منازلتك، فأما ما لم تطلبه ولم تنله فهو لغيرك، لأنك قد ترى السماء ولا تنالها، فهي أرض لمن سخرت له، وترى ما جعل لغيرك فلا ينفعك ولا يغني عنك، وهو نافع مغن لمن سلط عليه فلكه، ومن الناس من يتوهم أنّ الإظهار هبة له، وأنّ ما رآه وعرفه ملكه وحازه وتحقق به، واعلم أنّ ألف خاطر لا يجيء منها حال، وألف حال يكون منها مقام، والمقام إنما هو ما ثبت ودام فمثل الخواطر في ممرها كالسحاب في سيرها، وقيل في المثل: سحابة صيف عن قليل تقشع، ومثل الأحوال في حيلولتها كمثل الأزمنة في أحوالها، في كل سنة أربعة مشتاً ومصيف ومربع وخريف، وإنما الهبة من الله تعالى ما وقر في القلوب من المشاهدات، وما حققته الأعمال من المنازلات، فيورث ذلك علماً خاصياً أو خلقاً مرضاً أو حالاً سنياً أو وصفاً زكياً من أخلاق الصالحين، وسيما المتقين وعلوم العارفين وملاحظات المقربين، ولا يصلح الكلام بهذا العلم إلاّ لمن له مشاهدته منه، إن كان من علوم القدرة والتوحيد أو منازلة لمن كان له من مواريث الأعمال، وعن تنقيل الأحوال وعن زهد في الدنيا، وسعي في طلب الأخرى، إن كان من علم الوعظ والندب إلى الفضل، فذل كله بعد التوبة ومع حالك الاستقامة، وعن كمال علم السنة والجماعة، بعد معرفة بعلم الأصول والسنن من آثار الرسول، وإلا كان متكلّفاً، وفي الدعوى داخلاً إلا أن يحكي شيئاً سمعه فيكون به لقائله محاكياً، ويضف حاله إلى صاحبه فيكون عنه راوياً، فأما التحلي وهو اللبس الظاهر والتصنع المفتعل بالإشارة الفارعة، فهو من حلية الدنيا وزينة الهوى، وكذلك التمني، وهو ما يظنه العقل أو توهمته النفس وقدره الوهم، أو من وسوسة العدو الخناس لعنه الله تعالي، فليس هذا كله من الإيمان ولا من علم اليقين في شيء، بل هو من همزات الشياطين وخطراتهم وقرب محضرهم، لأن هذا داء القلوب من أدواء الذنوب، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من تطبب ولم يعلم الطب فقتل، هو ضامن، فالمتكلم للناس بقتلهم يكون قاتلاً، والإظهار الذي يقع به الإغترار أكثر من أن يحصى، والظهور الذي يحق به الحقيقة أعز من أن يرى، والله تعالى يظهر من خزائن ملكه ما شاء على الألسنه والجوارح فهي من خزائن الأرض، فيها من التدبير والحكمة كما في ملك الأرض، وعلوم هذه الخزائن هي العلوم الظاهرة وهي حجج اللهّ تعالى في أرضه على عباده، ويظهر من خزائن ملكوته مايحب، وهي القلوب والبصائر والكنوز والذخائر، فهذه كخزائن الملكوت وهي من خزائن السماء وفيها من القدر والآيات كما في السموات وعلوم هذه الخزائن من علم اليقين، وهو العلم الباطن النافع يخص به من يحب، وهم أولياؤه المقربون إنّ الحكم إلا لله، ولا يشرك في حكمه أحداً يختص برحمته من يشاء، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا آخر شرح مقام المحبة وهو آخر شرح مقامات اليقين التسعة.
4hFnTkfUWdo
 |
 |
البحث في نص الكتاب
بعض كتب الشيخ الأكبر
[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]
شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:
[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]
شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:
[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]
بعض الكتب الأخرى:
[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]
بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:
[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]