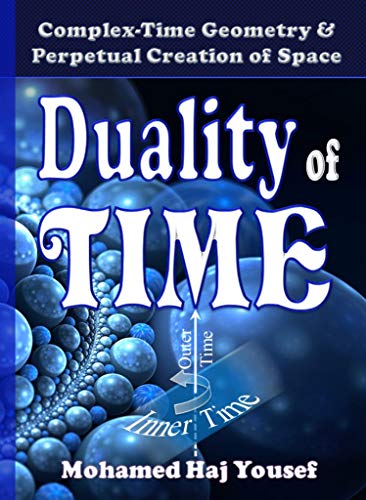المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
أبو طالب المكي (المتوفى: 386هـ)
الفصل الثالث والثلاثون ذكر دعائم الإسلام الخمس التي بني عليها أول ذكر فرض شهادة التوحيد للمؤمنين ووصف فضائلها وهي شهادة المقربين وشهادة الرسول
 |
 |
الفصل الثالث والثلاثون ذكر دعائم الإسلام الخمس التي بني عليها أول ذكر فرض شهادة التوحيد للمؤمنين ووصف فضائلها وهي شهادة المقربين وشهادة الرسول
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضلها للموقنين، قال الله تعالى وصدقت أنبياؤه لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَه إلاَّ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) محمد: 19، وقال لعباده يأمرهم بمثل ذلك: (فَاعْلَمُوا أنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وأنْ لا إلهَ إلاَّ هُوَ) هود: 14، ففرض التوحيد هو اعتقاد القلب أنّ الله تعالى واحد لا من عدد، وأول لا ثاني له، موجود لا شكّ فيه وحاضر لا يغيب، وعالم لا يجهل قادر لا يعجز، حي لا يموت قيوم لا يغفل، حليم لا يسفه سميع بصير، ملك لا يزول ملكه قديم بغير وقت، آخر بغير حد كائن لم يزل ولا تزال الكينونة صفته لم يحدثها لنفسه، دائم أبد الأبد لا نهاية لدوامه، والديمومة وصفه غير محدثها لنفسه، لا بداية لكونه ولا أولية لقدمه ولا غاية لأبديته، آخر في أوليته أول في آخريته، وإنّ أسماءه وصفاته وأنواره غير مخلوقة له ولا منفصلة عنه، وإنه إمام كل شيء، ووراء كل شيء، وفوق كل شيء ومع كل شيء، وأقرب إلى كل شيء من نفس الشيء، وإنه مع ذلك غير محل للأشياء، وإن الأشياء ليست محلاً له، وإنه على العرش استوى كيف شاء بلا تكييف ولا تشبيه، وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط، الجو وجه والفضاء من ورائه، والهواء وجه والمكان من ورائه، والحول وجه والبعد من ورائه، وهذه كلها حجب مخلوقات من وراء الأرضين والسموات متصلات بالأجرام اللطاف ومنفصلات عن الأجسام الكثاف، وهي أماكن لما شاء داخلة في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين داخلة في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، والله جلّ وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه لا يمتزج ولا يزدوج إلى شيء، بائن من جميع خلقه لا يحل الأجسام ولا تحله الأعراض، ليس في ذاته سواه ولا في سواه من ذاته شيء، ليس في الخق إلا الخلق ولا في الذات إلا الخالق، فتبارك الله أحسن الخالقين، وإنه تعالى ذو أسماء وصفات وقدرة وعظمة وكلام ومشيئة وأنوار، كلها غير مخلوقة ولا محدثة، بل لم يزل قائماً موجوداً بجميع أسمائه وصفاته وكلامه وأنواره وإرادته، وإنه ذو الملك والملكوت والعزّة والجبروت، له الخلق والأمر والسلطان والقهر، يحكم بأمره في خلقه وملكه ما شاء كيف شاء، لا معقب لحكمه ولا مشيئة لعبد دون مشيئته، إن شاء شيئاً كان ولا يكون إلا ما شاء، لا حول لعبد عن معصيته إلا برحمته، ولا قوة لعبد على طاعته إلا بمحبته، وهو واحد في جميع ذلك، لا شريك له ولا معين في شيء من ذلك، ولا يلزمه إثبات الوعيد بل المشيئة إليه في العفو، ولا يجب عليه في الأحكام ما أجرى علينا، ولا يختبر بالأفعال ولا يشار بالمقال، حكيم عادل بحكمة وعدل، هما صفتاه لا يشبه حكمته بحكمة خلقه، ولا يقاس عدله بعدل عباده، ولا يلزمه من الأحكام ما ألزمهم، ولا يعود عليه من الأسماء المذمومة كما يعود عليهم، قد جاوز العقول وفات الأفهام والأوهام والعقول، هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه خلقه، نصفه بما ثبتت به الرواية وصحت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه ليس كمثله شيء في كل شيء بإثبات الأسماء والصفات، ونفي التمثيل والأدوات، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل موجوداً بصفاته، كلها لم تزل له، وإنّ صفاته قائمة به لم تزل كذلك، ولا يزال بلا نهاية ولا غاية ولا تكييف ولا تشبيه ولا تثنية، بل بتوحيد هو متوحد به وتفريد هو منفرد به، لا يجري عليه القياس ولا يمثل بالناس، ولا ينعت بجنس ولا يلمس بحس ولا بجنس من شيء، ولا يزدوج إلى شيء، وإنّ ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه من الملك والملكوت محدث كله ومظهر، كان بعد إن لم يكن ولم يكن قديماً ولا أول بل كان بأوقات محدثة وأزمان مؤقتة، والله تعالى هو الأزلي الذي لم يزل، الأبدي الذي لم يحل، القيوم بقيومية هي صفته، الديموم بديمومية هي نعته، أوّل بلا أوّل ولا عن أوّل، آخر لا إلى آخر بكينونة هي حقيقته، أحد صمد لم يلد وبمعناه لم يولد، ومعنى ذلك لم يتولد هو من شيء ولم يتولد منه شيء، ومثل ذلك لم يخلق من ذاته شيء، كما لم تخلق ذاته من شيء، سبحانه وتعالى عمّا يقول الملحدون من ذلك علوّاً كبيراً.
ذكر فرض شهادة الرسول
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال الله تعالى الكبير المتعال: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ ميثَاقَ النَّبيّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) آل عمران: 81، وقال عزّ وجلّ: (مَنْ يُطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) النساء: 80 وقال: (إنَّ الَّذينَ يُبَايُعونَكَ إنَّمَا يُبَايِعُونَ الله) الفتح: 10 ففرض شهادة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تشهد أنّ محمداً رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب لا كتاب بعده، وهو مهيمن على كل كتاب، ومصدق لما سلف من الكتب قبله، وأن شريعته ناسخة للشرائع، قاضية عليها إلا ما أقره كتابه ووافقه، وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها، وأنه هو الذي بشر به عيسى عليه السلام أمته، وهو الذي أخبر به موسى عليه السلام أمته، وهو المذكور في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله عزّ وجلّ المنزلة، وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين أن يؤمنوا به وينصروه لو أدركوه، فأقرّوا بذلك وشهد الله تعالى على شهادتهم، وهو الذي أخذت الأنبياء شهادة الأمم على الإيمان به وأمرتهم بتصديقه وأخبرتهم بظهوره، وأنّ موسى وعيسى عليهما السلام لو أدركاه لزمهما الدخول في شريعته، وأنّ بقية بني إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة بالله لحجودهم رسالته، وأن إيمانهم بكتابه مفترض عليهم مأمور به في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم، وأنّ طاعته ومحبته فريضة واجبة على الكافة كطاعة الله تعالى، واتباع أمره واجتناب نهيه مفترضة على الأمة إيجاباً أوجبه الله تعالى له، وفرضاً افترضه على خلقه متصل بفرائضه.
ذكر فضائل شهادة الرسول
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال الله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ) آل عمران: 31، وقال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو أدركني موسى وعيسى ما وسعهما إلا اتباعي، وروينا في لفظ آخر: ثم لم يؤمنا بي لأكبهما الله في النار، وحدّثونا في الإسرائيليات أنّ رجلاً عصى الله تعالى مائتي سنة، في كلها يتمرد ويجترئ على الله، فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن غسله كفنه وصل عليه في جميع بني إسرائيل، ففعل ما أمر به فعجب بنو إسرائيل من ذلك، وأخبروه أنّه لم يكن في بني إسرائيل أعتى على الله ولا أكثر معاصٍ منه، فقال: قد علمت، ولكن الله تعالى أمرني بذلك، قالوا: فاسأل لنا ربّك، فسأل موسى عليه السلام ربّه فقال: يا ربّ، قد علمت، ما قالوا، فأوحى الله تعالى إليه أن صدقوا أنه عصاني مائتي سنة إلاّ أنه يوماً من الأيام فتح التوراة فنظر إلى اسم حبيبي محمد مكتوباً، فقبله ووضعه على عينه، فشكرت له ذلك، فغفرت له ذنوب مائتي سنة، وحدّثنا في معناه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت مؤاخياً لأبي لهب، مصافياً له، فلما مات وأخبر الله تعالى عنه بما أخبر، حزنت عليه وأهمني أمره، فسألت الله تعالى عليه حولاً أن يريني إياه في المنام، قال: فرأيته يلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال: صرت إلى النار في العذاب، لا يخفف عني ولا يروح إلا ليلة الإثنين في كل الليالي والأيام فإنه يرفع عني العذاب، قلت وكيف ذلك؟ قال: ولد في تلك الليلة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاءتني أميمة فبشرتني بولادة آمنة إيّاه، ففرحت بمولده، فأعتقت وليدة لي فرحاً مني به، فأثابني الله تعالى بذلك أن رفع عني العذاب في كل ليلة إثنين لذلك، وقال الله تعالى في تحقيق المحبة: (يُِحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ) الحشر: 9، ثم قال تعالى: (وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) الحشر: 9، فمن محبة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيثار سننه على الرأي والمعقول، ونصرته بالمال والنفس والقول، وعلامة محبته اتباعه ظاهراً وباطناً، فمن اتباع ظاهره: أَداء الفرائض واجتناب المحارم والتخلق بأخلاقه والتأدب بشمائله وآدابه، والاقتفاء لآثاره والتجسس عن أخباره، والزهد في الدنيا والإعراض عن أبنائها ومجانبة أهل الغفلة والهوى، والترك للتكاثر والتفاخر من الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة، والتقرب من أهلها والحب للفقراء، والتحبب إليهم، وتقريبهم وكثرة مجالستهم، واعتقاد تفضيلهم على أبناء الدنيا، ثم الحب في الله للبعيد المبغض، وهم العلماء والعباد والزهاد، والبغض في الله للقريب المحب، وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المعلنة، ومن اتباع حاله في الباطن مقامات اليقين، ومشاهدات علوم الإيمان، مثل الخوف والرضا والشكر والحياء، والتسليم والتوكل والشوق والمحبة، وإفراغ القلب لله وإفراداً لهم بالله، ووجود الطمأنينة بذكر الله، فهذه معاملات الخصوص وبعض معاني باطن الرسول، وهو من أتباعه ظاهراً وباطناً، فمن تحقق بذلك فله من الآية نصيب موفور أعني قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللهُ) آل عمران: 31 وقد كان سهل يقول: علامة المحبة، إتباع الرسول، وعلامة إتباع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزهد في الدنيا، وقال أيضاً في تفسير قوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ والرَّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) النساء: 69، قال: يطع الله في فرائضه، والرسول في الدخول في سننه، فإذا اجتنب العبد البدع، وتخلق بأخلاق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد اتبعه وقد أحب الله تعالى، وكان معه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غداً موافقاً في منزلته.
ذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين
قال الله تعالى: (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ) آل عمران: 18، وقال سبحانه وتعالى: (وَالَّذينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) المعارج: 33، فشهادة الموقن بيقينه أنّ الله تعالى هو الأوّل في كل شيء، وأقرب من كل شيء، وهو المعطي المانع الهادي المضل، لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله، كما لا إله إلا الله، وقرب الله منه ونظره إليه وقدرته عليه وحيطته به، فيسبق نظره وهمه إلى الله عزّ وجلّ قبل كل شيء، ويذكره في كل شيء ويخلو قلبه من كل شيء، ويرجع إليه في كل شيء، ويتأله إليه دون كل شيء، ويعلم أنّ الله عزّ وجلّ أقرب إلى القلب من وريده، وأقرب إلى الروح من حياته، وأقرب إلى البصر من نظره، وأقرب إلى اللسان من ريقه، بقرب هو وصفه لا بتقريب ولا بتقرب، وأنّه تعالى على العرش في ذلك كله، وأنه رفيع الدرجات من الثرى وهو رفيع الدرجات من العرش، وأنّ قربه من الثرى ومن كل شيء، كقربه من العرش، وأنّ العرش غير ملامس له بحس ولا مفكر فيه بوجس، ولا ناظر إليه بعين ولا محيط به بدرك، لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته، ولا نصيب للعرض منه إلا كنصيب موقن عالم به، واجد بما أوجده منه من أنّ الله تعالى عليه، وأنّ العرش مطمئن به، وأنّ الله تعالى محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق، تحت كل شيء، فهو فوق الفوق وفوق التحت، ولا يوصف بتحت فيكون له فوق، لأنه هو العلي الأعلى أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان، ولا يحد بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد بمكان، فالتحت للأسفل والفوق للأعلى، وهو سبحانه فوق كل فوق وفوق كل تحت في السمو، وهو فوق ملائكة الثرى، وهو فوق ملائكة العرش والأماكن للممكنات ومكانه، مشيئته ووجوده قدرته والعرش والثرى وما بينهما وحد للخلق الأسفل والأعلى، بمنزلة خردلة في قبضته، وهو أعلى من ذلك، ومحيط بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي قدرته، وعلو هو عظمته بما لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم، ولا نهاية لعلوه ولا فوق لسموه ولا بعد في دنوه، ولا حس في وجوده ولا مس في شهوده، ولا إدراك لحضوره ولا حيطة لحيطته، وقد قال الله تعالى للكل: (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) النحل: 50 وقال سبحانه: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) الأعلى: 1، وقال عزّ وجلّ: (أَلاَ إنَّهُ بِكُلِّ شيءِ مُحيطٌ) فصلت: 54، وإنّ الله تعالى لا يحجبه شيء عن شيء، ولا يبعد عليه شيء، قريب من كل شيء بوصفه، وهو القدرة والدرك، والأشياء مبعدة بأوصافها، وهو البعد والحجب، فالبعد والأبعاد حكم مشيئته، والحدود والأقطار حجب بريته، والمسافة والتلقاء مكانة لسواه، والنواحي والجهات موضع للمحدثات، والنهار والليل مسكن للمصرفات، والبعد والفضاء مكان للمخلوقين والتوسعة والهواء محل للعالمين، والأحكام والأقدار واقعة على خلقه.
وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام، وفات العقول والأوهام وسبق الأقدار، واحتجب بعزه عن الأفكار، لا يصوره الفكر ولا يملكه الوهم، حجب عن العقول تشج ذاته ولم تحكم العقول بدرك صفاته، إذ يس كمثله شيء فيعرف بالتمثيل، ولا له جنس فيقاس على التجنيس، وهو الله في السموات وفي الأرض، ثم استوى على العرش، وهو معكم أينما كنتم، غير متصل بالخلق ولا مفارق، وغير مماس لكون ولا متباعد، بل متفرد بنفسه متحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا يقترن به شيء، هو أقرب من كل شيء بقرب هو وصفه، هو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته، وهو مع كل شيء وفوق كل شيء، وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء، بعلو ودنو هو قربه، فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش، وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح، وهو مع ذلك فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، وليس يحيط به شيء وليس هو تعالى في كل هذا مكاناً لشيء، ولا مكاناً له شيء، وليس كمثله في كل هذا شيء، لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه، ولا نظير له من عباده، ولا شبيه له في اتحاده وهو أوّل في آخريته بأوليّة هي صفته، وآخر في أوّليته بآخريتة هي نعته، وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه، وظاهر في باطنيته بظهور هو علوه، لم يزل كذلك أزلاً، ولا يزال كذلك أبداً، لا يتوجه عليه التضاد ولا تجري عليه الحوادث والآباد، ولا ينتقص ولا يزاد، هو على عرشه باختياره لنفسه، فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه تعالى، والعرش محتاج إلى مكان والرب غير محتاج إليه، كما كان الرحمن على العرش استوى، الرحمن اسمه والاستواء نعته، متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى مكان يسعه، ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه، ولا خلق يوجده، هو حامل للعرش وللحملة بخفي لطفه، وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه، وموجد ما أحب لمن يحب من التجلي بمعالي أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه، لاختصاص رحمته، وهو أظهر الكون من وراء الحول، هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول، وهو محيط بالعرش والحول بالقدرة والطول، لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته، ولا يوجد إلا في سعة البسطة، فإذا قبض أخفى ما أبدى، وإذا بسط أعاد ما أخفى، وكذلك جعله في كل رسم كون، وفعله بكل اسم مكان مما جل فظهر، ومما دق فاستتر، لا يسعه غير مشيئته بقربه، ولا يعرف إلا بشهوده، ولا يرى إلا بنوره، هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب، ولهم ذلك غداً في المشاهدة بالأَبصار، ولا يعرف إلا بشيئته إن شاء وسعه أدنى شيء، وإن شاء لم يسعه كل شيء، إن أراد عرفه كل شيء وإن لم يرد لم يعرفه كل شيء، إن أحب وجد عند أي شيء، وإن لم يحب لم يوجد بشيء، وقد جاوز الحدود والمعيار وسبق القبل والأقدار، ذو صفات لا تحصى ولا تتناهى، ليس محبوساً في صورة ولا موقوفاً بصفة، ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم، لا يتجلى بوصف مرتين، ولا يظهر في صورة لإثنين، ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان، بل لكل تجل منه صورة، ولكل عبد عند ظهوره له صفة، وعن كل نظرة كلام وبكل كلمةٍ إفهام، ولا نهاية لتجليه ولا غاية لأوصافه ولا نفاد لكلمه، ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لمعانيه هذه، إذ ليس في التوحيد كيف، ولا للقدرة ماهية، ولا يشبهه بهذه الأوصاف خلق، إذ ليس للذات كفؤ، إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار، فلم يخيله عقل ولم يصوره فكر، لئلا يملكه الوهم، فيكون مربوباً وهو رب، ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهر، لا يعقل بعقل لأنه عاقل العقل، ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة، حتى يتجلى آخراً بإحسانه، كما تجلى أولاً بحنانه، فيشهد بحضوره وينظر بنوره وليس هذا لسواه ولا يعرف بهذا إلا إياه.
وهذا منه لأوليائه اليوم بأنوار اليقين في القلوب، وهو لهم منه غداً بمعاينة الأبصار في دار الحبيب أبد الأبد في الجنان، يتجلّى لهم بعظائم القدرة ولطائف الحنان، ويكلمهم بما لا غاية له من لذيذ المعاني، يتجلّى بصفات الجلال ويظهر بمعاني الحسن والجمال، ويبدو بلبس البهاء والكمال يجمع لهم بأول معنى من معانيه بما يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل والحبور، بكل نظرة أو كلمة أو قرب أو لطف أو عطف أو حنان أو إحسان جميع ما فرقه من نعيم الجنان، وينظر إذا أحب إلى ما يحب اختياراً لا تهجم الأشياء عليه في نظره اخباراً، ويعرض عما شاء اختياراً لا تعترض المنظورات في نظره اضطراراً يعرض في نظره لكبرياء عزه، وينظر في أعراضه بلطائف عطفه، الملك في قبضته والخزائن في كلمته والكون في مشيئته والملكوت كله بيده، والجبروت والعظمة سبحات صفاته وجود الأشياء لا يضطره إلى النظر إليها إن أراد الإعراض عنها لأنه مقتدر قهار وعدمها لا يضطره إلى أن يراها لسبق علمه بها، لأنها معلوم علمه ذي الأخبار، ولأنه هو الجبار إذ الموجود والمعدوم يضطر غيره إلى النظر لضعفه عن الامتناع، والعدم يضطر سواه إلى الفقد لعجزه عن الاختراع، وهو تعالى مباين لسواه بعزه، غير مماثل لغيره بقهره، ولأن المعدوم كالمحجوب وهو تعالى يرى المحجوب، من الذرة من تحت الثرى من وراء السموات والأرضين، ولا يحجبن نفاذ نظره إليها ولا يمنعن قربه منها، ولا يحجزن قدرته عليها ولا يجاوز دون حيطته بها، إذ الحجب واقعة على الخلق غيرمتصلة بالخالق، وبواطن الأشياء وغوامضها منكشفة للخالق وهو أيضاً يشهد المآل والأواخر إلى نهاية نهاياتها في أبد أبدها، كما يشهد ذلك اليوم أعني من غد وبعد غد، وما وراءه إلى يوم القيامة وما فيها، وهذا كله عدم لم يخلقه بعد، لأن علمه بذلك شهادة له لأنه ليس بينه وبين علمه حجاب، فهو يشهد الكون من أوله إلى آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه، ومشاهدة هي نعته، ولأن كلامه بذلك يخبر بأنه قد كان دليلاً على شهوده المآب، لأنه شهد ما علم كما علم ما به تتكلم، فلم يتفاوت كلامه وعلمه ولم يختلف علمه وشهادته، ومع ذلك كله فلا موجود في الأولية ولا المشاهدة سواه، ولا شريك له في القدم ولا يقدم شاهد إلا إياه، قوته كنه قدرته وقدرته دوام بقائه، ونظره سعة علمه وعلمه مدى نظره، يدرك الأشياء كلها على اختلاف أوصافها بصفة من صفاته، ثم يدرك بجميع أوصافه ما أدركه بهذه الصفة، فصح بذلك أنه نظر وعلم وتكلم، لا يدخل الترتيب في صفاته أعني بقبل وبعد، ولا يوصف بوقت وحدّ ولا يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه أعني بثم ولم، وإذا وحتى، ولزم على ذلك أنه يعلم بنظره وينظر بعلمه، فصارت الأوائل والأواخر لديه كشيء واحد، وكانت صفاته كلها آحاداً كاملات تامات، غير محدودة للمحدودات ولا مؤقتة مرتبة للمرتبات المؤقتات، إذ لم يكن لها محدثات لأنها قديمة بقدمه وكائنة موجودة بكونه ووجوده، إذ الترتيب في النعوت من وصف الخلق والأدوات لكونها محدثة مظهرات بحدود وترتيب وأوقات، والله تعالى ليس كمثله شيء في كل الصفات، فصفاته قديمة بقدمه وكائنة موجودة بكائنته ووجوده، والأفعال محدثة مظهرات بحدود وترتيب، وأوقات بترتيب فلا موجود في الأولية ولا المشاهدة سواه ولا شريك له في القدم، ولا قيوم له في الأبد والأزل سواه قبل وجود الوقت، والحدثان ليست صفاته ذوات جهات فيتوجه إلى جهته فيدرك بصفة دون صفة، ولا ذاته ذو ذات فيقبل على مكان دون مكان فيضطره الترتيب للمخلوقات، ولا يدبر الأمور بأفكار فيشغله شأن عن شأن، ولا يدخل عليه الاعتراض فيتغير عمّا كان، ولا يخلق بآلة فيستعين بسواه، ولا يعجزه قدرة فيحتاج إلى مباشرة يديه، يخلق بيده إذا شاء وعن كلمته إن شاء، وبإرادته متى شاء وبمعاني صفاته كيف شاء، لا يضطره التكوين إلى الكلام وكلامه إليه كيف شاء، كان خزائنه في كلمته وقدرته في مشيئته، إذا تكلم أظهر وإن شاء قدر، ومتى أحب ظهر وبأي قدرة شاء استتر، هو عزيز في قربه وقريب في علوّه حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالفعال، كشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركات، وأخفى الصنع بالصنعة وأظهر الصنعة بالأدوات، هو باطن في غيبه وظاهر بحكمه وقدرته، غيب في حكمته، وحكمته شهادة ظاهرة بمحكوماته، وهي مجاري قدرته، وصنع سر في صنعته وهي
علانية مشيئته، ليس كمثله شيء في كل صفة ولا كقوله في ماهية. لانية مشيئته، ليس كمثله شيء في كل صفة ولا كقوله في ماهية.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كلمة مجملة بالغة في وصف التوحيد أنه قال في خطبته: الحمد لله الذي لم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته، وروينا عن أحمد بن أبي الحواري عن بعض علماء أهل المعرفه من أهل الشام أنه قال: رأى عزّ وجلّ خلقه قبل أن يخلقهم كما رآهم بعد ما خلقهم، وروي عن أبي سليمان الداراني أن قال: أدخلهم الجنان قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه.
وقال أيضاً: إنّ الله عزّ وجلّ أعزّ من أن يغضبه أفعال خلقه، لكنه نظر إلى قوم بعين الغضب قبل أن يخلقهم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب فأسكنهم دار الغضب؛ وهو أكبر من أن يرضيه أفعال خلقه، ولكنه نظر إلى قوم بعين الرضا قبل أن يخلقهم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا فأسكنهم دار الرضا، وقد روينا عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: (هَلْ أَتى عَلَى الإِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَىْئاً مَذْكُوراً) الدهر: 1؛ يعني كان في علم اللّّه أنه يكوّنه وكأنه علق قوله، لم يكن بقوله مذكوراً والله تعالى يخبر بما يكون في الدنيا وبما يكون في القيامة وبما بعدها، بلفظ أنه قد كان لاستواء ذلك في عمله آخراً كأول، إذ لا ترتيب في العلم ولا حدّ ولا مسافة ولا بعد في القدرة، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلاً) النساء: 122، أعنده علم الغيب، فهو يرى فنقصه بذلك وذمه، وقال تعالى: (الَّذي يَراكَ حينَ تَقُومُ) (وَتَقَلُّبَكَ في السَّاجِدينَ) الشعراء: 218 - 219؛ أي ويرى تقلبك وبه انتصب التقلب بالعطف على القيام، وجاء في التفسير تقلبك في الأصلاب الزاكية والأرحام الطاهرة، لم يتفق لك أوان على سفاح قط، كذلك روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقيل في أصلاب الأنبياء: يقلبك بالتنقيل في صلب نبي بعد نبي حتى أخرجك من ذرية ورثة إسماعيل.
وقد روينا يعني ذلك عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال تعالى في سمع الأصوات قبل الأشباح وخلقها: (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا) المجادلة: 1، فأخبر أنه سمع الأصوات في القدم في علمه قبل خلق المصوتين في الحديث، فكيف لا يرى الكون عن آخره في القدم بعلمه قبل ظهورهم له متصورين بفعله؟ وقد قال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ) الأعراف: 11، والخلق والتصوير كانا بعد السجود لآدم، فأخبر عنه أولاً لشهوده له واستوائه في علمه إذ لا بدّ من كونه، فأشبه قوله تعالى: (خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) الأعراف: 54، والعرش قبل السموات والأرض والاستواء صفته لم تزل به، ثم أخبر عنه أنه أخر الترتيب، فاللّّه سبحانه وتعالى عالم بالكون قبل الكون وناظر إلى علمه، لا حجاب بينه وبين معلومه، وسامع لما شهد ومتكلم بما علم فقد سبق النظر والسمع والكلام الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة والمشيئة، فهو ناظر سامع متكلم بنفسه من حيث كان عالماً مقتدراً مريداً بنفسه، ثم أظهر الخلق عالماً بعد عالم في وقت بعد وقت، فجاؤوا على نظره وسمعه وكلامه كما كانوا في علمه وقدرته ومشيئته، بغير زيادة ولا نقصان خردلة، ألا ترى أنه بقدرته وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ والآخرة وما يكون منها على حقيقة ما أخبر عنه لا يمنعه عدم الكون ولا يحجبه بعد التأخير؟ كذلك كان يشهد ما قد كان اليوم في قدمه بعلمه به وبقدرته عليه وحيطته به، لا يمنعه عدم كونه ولا يحجبه، فقد ظهوره ولا يجوز أن يدرك سبحانه وتعالى اليوم ما لم يكن أدركه في القدم، كما لا يجوز أن يستفيد الآن علم ما لم يكن علمه فيما لم يزل، فيكون متكلّماً بما لم يشهد وهو معلومه منطوٍ في علمه، أو يكون مستزيداً بما أظهر حين ظهر وهو في قبضته وغيبه، جلّ عن ذلك وصفه وعلا عن هذا جلاله وعزّه لأنّ نظر سعة علمه وعلمه حيطة نظره، فهو ناظر إلى ما علمه بوصفه لا يختلف عليه أوصافه، فالكون موجود له بعلمه لسبق علمه به، ولا بيان له في علمه ولا أثر له في وصفه ولا وجود للكون في وجودكينونته، ولا قدم له في قدم أزليته، ليس محلاً للكون ولا هو حال فيه، ولأن أوليته سبقت الكون والمكان فليس لهما في قدمه قدم، كما أنه تعالى يشهد الآن ما يكون من العاقبة والمآل إلى آخر الأحوال، لا يختلف الأواخر والأول في صفاته ولا تتفاوت صفاته على ترتيبها من نظر وعلم، لأنها معلوم علمه وموجود إرادته، فهو سبحانه وتعالى واجد الأشياء به لا بها، وناظر إليها في علمه لا بوجودها لاقتداره عليها وإحاطة علمه بها، والكون معدوم لنفسه لتلاشيه لأنه سبحانه وتعالى خالق العدم كما هو خالق الوجود، ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون ثانياً معه، ولا الكون كائن موجود بنفسه فيكون أولاً مع أوليته، جلّ الواحد المتحد بنفسه عن ثانٍ معه في الأزل أو شريك له في القدم، ثم ظهرت الأشياء لنفوسها فظهر بعضها لبعض بإظهاره، فوجدت بإيجاده وظهر عليها بإظهاره بحد ووقت لا أول لها ولا قبل بل هو الأول الذي لم يزل بلا أول، والقديم الأبد بلا وقت ولا أمد قائم بصفاته، وصفاته موجودة له قائمة به، فمن شهد ما فصلناه بنور اليقين لم يدخل عليه قدم العالم، إذ لا قديم مع الله في كينونية أزله، ومن لم يهتد بما بيناه ووقف مع العقل ودخلت عليه شبهة قدم العالم، فالحد برؤيته قدم الحدثان أو جحد قدم العلم، ينفي وجود الحدث فيه، وهذا شرك بالصفات بترتيبه إياها بالعقل، ونحن بريئون من شهادته، مبطلون لدعواه منكرون لشركه في القدم، موحدون باليقين ما ألحد بالعقل، لأنّ من قال: إنّ شيئاً قديم مع اللّّه تعالى أو موجود بنفسه لنفسه، فقد أشرك في الصفات، ومن قال: إنّ الله سبحانه نظر بعد أن لم ينظر أو علم بعد أن لم يعلم أو تكلم بعد أن لم يتكلّم، فقد قال بحدوث الصفات وقدم عليها لمعلومات، بل المعلومات منطوية في العلم لا أثر لها فيه، والله قديم بعلمه واجد لمعلومه بنفسه عن علمه به لقدرته عليه يقهره، وناظر إليه بعلمه لا بعدم معلومه والمعلوم معدوم لنفسه غير موجود بنفسه حتى أحدثه وأوجده، فظهر حين أظهره لمن أظهره بعضاً لبعض لا لنفسه، إذ قد فرغ منه لعلمه به
لا أنه قرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه وعلمه صفته لم يزل له وهو قائم بوصفه، ولا يجوز أن يحدث له شيئاً لم يعلمه، كذلك لا ينبغي أن يفقد شيئاً لم يجده، ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة مجمعة على اختلافهم أنّ الله تعالى لا يرى الشيء حتى يكون، واختلفوا في العلم فقالت العبادية من القدرية وهم أصحاب عباد: إنّ الله تعالى لا يرى الشيء، حتى يكون، يضاهون بذلك قول النظام وبشر المريسي في أن الله تعالى لا يرى الأشياء حتى تكون، والجهمية مجمعة على اختلافهم أنّ الله تعالى لم يتكلم بالشيء حتى كان، ثم خلق الكلام فقدموا الكون قبل كلامه، كما قدمه أولئك قبل نظره، وقال الجميع بحدوث النظر، كما قالوا بحدوث الكلام والنظر لأنهم قالوا بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات، وتقدم الاستطاعة من الخلق على الإرادة من الخالق، فاستوى بذلك شركهم خرجوا به من التوحيد، كذلك كذبت العبادية من القدرية أصحاب عباد يضاهون قول النظامية والمريسية، تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه، والمعتزلة أيضاً مجمعة على نفي العلم والقدرة والمشيئة إلاّ أنهم يقولون: عالم ولكن لا يضطر علمه إلى شيء ولا يوجب شيئاً، فجعلوه كالظن من الخلق فقالوا: عالم بلا علم قديم وقادر بلا قدرة ومريد بلا إرادة سابقة، وقدموا الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات وإنّ الإرادة والكلام من نعوت الأفعال مخلوقان. لا أنه قرب له نظره؛ كما لم يحدث به علمه لنفسه وعلمه صفته لم يزل له وهو قائم بوصفه، ولا يجوز أن يحدث له شيئاً لم يعلمه، كذلك لا ينبغي أن يفقد شيئاً لم يجده، ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه مذهب المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة مجمعة على اختلافهم أنّ الله تعالى لا يرى الشيء حتى يكون، واختلفوا في العلم فقالت العبادية من القدرية وهم أصحاب عباد: إنّ الله تعالى لا يرى الشيء، حتى يكون، يضاهون بذلك قول النظام وبشر المريسي في أن الله تعالى لا يرى الأشياء حتى تكون، والجهمية مجمعة على اختلافهم أنّ الله تعالى لم يتكلم بالشيء حتى كان، ثم خلق الكلام فقدموا الكون قبل كلامه، كما قدمه أولئك قبل نظره، وقال الجميع بحدوث النظر، كما قالوا بحدوث الكلام والنظر لأنهم قالوا بحدوث الأسماء بعد حدوث المسميات، وتقدم الاستطاعة من الخلق على الإرادة من الخالق، فاستوى بذلك شركهم خرجوا به من التوحيد، كذلك كذبت العبادية من القدرية أصحاب عباد يضاهون قول النظامية والمريسية، تشابهت قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه، والمعتزلة أيضاً مجمعة على نفي العلم والقدرة والمشيئة إلاّ أنهم يقولون: عالم ولكن لا يضطر علمه إلى شيء ولا يوجب شيئاً، فجعلوه كالظن من الخلق فقالوا: عالم بلا علم قديم وقادر بلا قدرة ومريد بلا إرادة سابقة، وقدموا الاستطاعة من الخلق فقالوا: لئلا يلزمهم سبق المعلومات وإنّ الإرادة والكلام من نعوت الأفعال مخلوقان.
والجهمية أيضاً مجمعة أنّ الله تعالى لا يتكلم بوصفه أصلاً وإنما يظهر في أديم القضاء الكلام بخلق الأعراض في الأجسام، فكان هذا عندهم هو التوحيد لئلا يثبتوا مع الله قديماً، وهذا عند أهل السنة والجماعة هو الإلحاد لنفي قدم الصفات والقول بحدوثها وانفصالها عن الذات، وليس يختلف أهل اليقين بحمد الله تعالى في جميع ما ذكرناه، كما لا يختلفون في صحة التوحيد، وهذه شهادة الموقنين وإيمان المقربين، فلا يتشبهن لك العقل بالمعقول عن شهود ما ذكرناه فيعقلك عن النفاد للشهادة، فليس يشهد ما ذكرناه من صفات الشهيد بنور العقل، وإنما يشهد بنور اليقين، لأنّ خالقاً لا يشبه بمخلوق، ومن ليس كمثله شيء لا يشهد إلا بما ليس كمثله شيء، وهو نور اليقين من نور القادر، ومن لم يجعل الله نوراً له فما له من نور، وما ذكرناه من وصفه تعالى هو ظاهر التوحيد المتصل بفرض الشهادة، لا يجري على ترتيب المعقول، ولا يمثل بقياس العقول، لأن نفي الصفات وإثباتها بالمماثلات موجود في رأي العقول، كما أنّ الكفر والضلال موجود في طبائع النفوس لعدم شهادة الأبصار، ولفقد وجود مشاهدة الإلهية في تخيل الأفكار، ولجريان المعتاد والعرف في ظهور الأسباب، كما حدثنا أنّ بعض الصدّيقين دعا إلى الله سبحانه وتعالى بحقيقة التوحيد فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد، فعجب من ذلك فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعم، قال: احجبني عنهم قال: كيف أحجبك وأنا أدعو إليك؟ قال: تكلم في الأسباب وفي أسباب الأسباب قال: فدعا إلى الله تعالى من هذه الطرق فاستجاب له الجمّ الغفير، فإنما صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات التي جاءت بها السنن وشريعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع نفي الشبه والماهية ونفي الجنس والكيفية، ثم سكون القلب وطمأنينة العقد إلى الإيمان بهذا، والتسليم له لأجل نور اليقين الموهوب لأن هذا إنما يشهد بنور اليقين وعلمه، لا بعلم العقل ونوره، لأن خالقاً لا يرى بمخلوق، فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيها، والإيمان مرآة الآخرة وبه ينظر إليها فيؤمن بما فيها.
والله تعالى إنما يرى بنور اليقين، وفي هذا النور مشاهدة الصفات وهو حقيقة الإيمان، وأعز ما نزل من السماء وهو السكينة المنزلة في قلوب المؤمنين لمزيد الإيمان ولتعريف صفاته المؤمن معها بترك ضرب الأخبار بعضها ببعض، ومعارضة بعضها بعضاً أو ترتيب بعضها على بعض، بل يؤمن بكل خبر ورد في الصفات والقدرة على حدته، كما يسلم جميعها على الجملة بإسلامه وإلا أدّى ذلك إلى نفي بعضها أو إبطال جميعها، لأنّا أخذنا الإيمان بمنة اللّّه تعالى ورحمته من قبل التصديق واليقين والنقل، لا من قبل التقليد وحسن الظن والعقل، وأربعة أشياء تسلم ولا تعارض اعتراضاً: أخبار الصفات وأصول العبادات وفضائل الأصحاب وفضائل الأعمال، ولولا أنّ الله تعالى تولّى قلوب المؤمنين فحبب الإيمان إليها وزينه فيها، وكره الكفر وشأنه عندها، لتاهوا في الظلمات وغرقوا في بحار الهلكات لظهور الأغيار ومعاية الأسباب، ولغيب القدرة عن العيان، ولما ابتلوا به من الحجب والأعيان، ولكن اللّّه تعالى سلم وحبب الإيمان في القلوب، وزين وكره الكفر والعصيان وشين، وكذلك مدح المؤمنين بالغيب المستور، ومن ذلك سبق المقربون بمشاهدة النور فقال سبحانه وتعالى: (اللهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) البقرة: 257، فلولا أنهم كانوا في ظلمة الطبع ما امتنّ عليهم من نور اليقين، وكذلك جاء الخبر أنّ الله تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضلّ، وفي أحد المعاني من قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال: يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه، ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب ولولا أنّ التوحيد لم يرسمه عارف قط في كتاب ولا كشفه علام في خطاب، لعجز علوم العموم عن درك شهادته، ولسبق إنكاره القول لضعفها عن حمل مكاشفته، لذكرنا من ذلك ما يبهر القول ويبهت ذوي المعقول، ولكنا كرهنا أن نبتدع ما لم نسبق إليه، أن نظهر ما يضطرب العقول بالحيرة فيه، خفنا من عدم النصيب مما نذكره، فيعود على السامعين من نفعنا ضرورة، وحقيقة علم التوحيد باطن المعرفة، وهو سبق المعروف إلى من به تعرف بصفة مخصوصة بحبيب مقرب مخصوص لا يسع معرفة ذلك الكافة، وإفشاء سرّ الربوبية كفر.
وقال بعض العارفين: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله، أفضل من إحياء غيره، وقال بعضهم: للربوبية سرّ لو ظهر لبطلت النبوّة وللنبوّة سرّ لو كشف بطل العلم، وللعلماء بالله سرّ لو أظهره الله تعالى لبطلت الأحكام، فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرّ، به وقع التدبير وعليه انتظم الأمر والنهي، الله غالب على أمره، وفوق ذلك علم التوحيد والاسم منه وحداني، فالتوحيد وصفه وفوقه علم الإتحاد، فالوصف منه متحد وفوقهما علم الوحدانية، والاسم منه واحد، وفوق ذلك علم الأحدية والإسم منه أحد وهذه أسماء لها صفات، وأوصاف لها أنوار وأنوار عنها علوم، وعلوم له مشاهدات بعضها فوق بعض، فوق كل ذي علم عليم، ثم علم التوحيد أول هذه العلوم وعموم هذه المشاهدات، وظاهر هذه الأنوار وأقربها إلى الخلق، فالاسم منه موحد وههنا بان الخلق وظهر، فهذا توحيده الذي وحده به الموحدون من جميع خليقته، فعاد ذلك عليهم برحمته، والمشاهدات الأول توحيد الرب تعالى نفسه بنفسه لنفسه، قبل توحيد خلقه، فتوحيدهم إيّاه عن توحيده فيما كتبنا عنه، وأخفينا فيما أظهرناه، فهو محجوب في خزائن الغيوب عن البصائر والفهوم، قد جاوز علم الملكوت كله، فهو من ورائها في خزائن الجبروت، وإنما ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد، وما لا بدّ للإيمان منه من المزيد، وقال عالمنا أبو محمد سهل رحمه الله تعالى: للعالم ثلاثة علوم؛ علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، وعلم باطن لا يسع إظهاره إلاّ لأهله، وعلم هو سرّ بين الله وبين العالم هو حقيقة إيمانه، لا يظهره لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن، وقال بعض السلف قبله: ما من عالم يحدث قوماً بعلم لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم.
شرح ثاني ما بني الإسلام عليه من الخمس: وهو
الصلاة
وأول ذلك وصف الطهارة، أولها فرائض الاستنجاء وسننه، وفرائض الوضوء وسننه وفضائله، وفرائض الصلاة وسننها وأحكام المصلّي في وقت الصلاة وإدراكها، وما يتعلق بها وهيئات الصلاة وآداب المصلّي.
ذكر فرائض الاستنجاء
قال الله جلّ ثناؤه وصدقت أنباؤه: (فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُِحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ) التوبة: 108 وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور نصف الإيمان، وقال: مفتاح الصلاة الطهور، فأول الطهارة الاستنجاء وفيه فرضان وأربع سنن: أحد الفرضين إزالة الحدث، والثاني طهارة المزيل، وهو أن لا يكون رجيع دابة ولا مستعملاً مرة، ولا عظم ميتة، ويكره له الاستنجاء بفحمة لأثر في ذلك، والسنن الأربع: وتر الاستجمار ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، والاستنجاء بالماء، ومباشرة الأذى بالشمال، ومسح اليد بالتراب، فأما كيفية الإستنجاء فأن يأخذ الحجر بشماله ويمره على مقدمته من مقدمها مسحاً إلى مؤخرها، ثم يرمي به، هناك ثم يأخذ الحجر الثاني فيبتدئ من مؤخر المقعدة فيمسحها مداً إلى مقدمها، ثم يرمي به، ثم يأخذ الحجر الثالث، فيديره حول المسربة إدارة فإن احتاج إلى حجر آخر فليجعلها خمساً، وإن اكتفى بحجر واحد فلا بد من ثلاث، وإن استجمر بحجر كبير ذي ثلاث شعب أجزأه عن ثلاثة أحجار، وفي الخبر: من استجمر فليوتر، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد الحاجة أبعد، وكان يتبوأ لحاجته كما يتبوأ الرجل المنزل لأنه كان لا يقعد في فضاء، بل كان ينصب وراءه شيئاً أو يقعد إلى حائط، أو نشز من الأرض يستره أو كوم من حجارة يحجبه، ثم يستدبر ذلك، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستقبل القبلة أيضاً لغائط ولا بول، ولم يكن يرفع ثوبه للغائط حتى يدنو من الأرض، فأما من أراد أن يبول قريباً من صاحبه بحيث يراه ويحسه فلا بأس بذلك، فإنها رخصة من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع الحياء منها بفعله، لأنه كان عليه السلام أشد الناس حياء، وكان يبول وإلى جانبه صاحبه ليسن التوسعة في ذلك، وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه فقال: لا أحسبك تحسن الخراءة فقال: بلى وأبيك إني بها لحاذق، قال فصفها لي قال: أبعد الأثر وأعد المدر واستقبل الشيح واستدبر الريح وأقعي إقعاء الظبي وأجفل إجفال النعام، والشيح نبت طيب الرائحة يكون بالبادية، والإقعاء في هذا الموضع أن يستوفز على صدور قدميه والأجفال أن يرفع عجزه.
وفي حديث سلمان: علمنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل شيء حتى الخراءة، أمرنا أن لا نستجمر بعظم ولا روث، ونهانا أن لا نستقبل القبلة لبول أو غائط، وأن يجلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فأما وصف الاستبراء فهو أن يستفرغ الرجل بوله رويداً، ولا يحرك ذكره فينتشر البول على الحشفة، فإذا انقطع البول على مهل مد ذكره ثلاثاً من أصله إلى الحشفة مداً رفيقاً، لئلا ينتضح البول، ثم ينتثره ثلاثاً ويتنحنح ثلاثاً، وإن فعل ذلك سبعاً سبعاً فقد بالغ، ثم يأخذ الحجر بيمينه ويأخذ ذكره بشماله، ويمده عليه حتى يرى موقعه جافاً، فهناك طهرين انقطعت النداوة، ومن مده إلى الأرض أو إلى حائط حتى يرى الجفوف عن أثره، فمثله وهذا كافيه من الماء ما لم ينتشر البول على الحشفة ويسحب البول في أرض دمثة رخوة، وعلى تراب مهيل، ويكره له أن يبول مستقبل الريح أو على أرض صلبة كيلا ينضح البول عليه، وقد شبه فقهاء المدينة الذكر بالضرع، وقال بعضهم إنه لا يزال يخرج منه الشيء بعد الشيء ما دمت تمده، وقيل: إذا وقع الماء على الذكر انقطع البول، وقد كان أخفهم استبراء وأقلهم استعمالاً للماء في الطهور، أفقههم عندهم، وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر بالماء أنّ ذلك من مرجع الماء يتردد في الإحليل لضيق المسلك وتلاحم انضمامه عليه فإذا خشي الوسواس فلينضح فرجه بعد وضوئه، وهو أن يأخذ كفاً من ماء فليرشه عليه، وفي خبر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله، ويكره مس الذكر باليمين ويخرج من الذكر خمسة أشياء؛ البول والمذي والودي وهو لزوجة تتعقب البول إذا طال حبسه، والريح والمني ثم كلها توجب الوضوء إلا المني، وهو الماء الدافق الذي يفتر عنه الذكر وتنقطع الشهوة، ومنه يخلق الإنسان فإنه يوجبُ الغسل، وما خرج من الذكر من غير ذلك من دودٍ أو حصى ففيه الوضوء، وقد يخفي الريح، فلذلك يستحب الوضوء عند كل صلاة وهو من المرأة أطهر.
ذكر فرائض الوضوء
قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من توضأ كما أمر، وفي لفظ: من توضأ فأسبغ الوضوء وصلّى ركعتين ولم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي لفظ آخر: ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألا أنبئكم بما يكفر الله الخطايا به ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وتوضأ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين فقال: من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم عليه السلام.
ذكر فرائض الطهارة
وهي ثمانية: طهارة الإناء ثم الماء الطاهر والنيّة والترتيب على نسق الكتاب وغسل الأعضاء الثلاثة المأمور بها، ومسح الرس، ولا ينفض يديه بالماء عند غسل وجهه وذراعيه، فإنّ ذلك يكون مسحاً، ولا يلطم وجهه بالماء لطماً فإنه مكروه، ولكن ليحمل الماء بيديه معاً إلى وجهه ثم ليسنه عليه سنّاً، ويغسل وجهه غسلاً من أصول شعر رأسه إلى ما ظهر من لحيته وعلى ما استرسل منها، وليدخل البياض الذي بين أذنه ولحيته في غسل وجهه، وليدخل مرفقيه في غسل ذراعيه، وهذا فرض وينبغي أن يقطر الماء من وجهه وذراعيه قطراً، ويكفيه في مسح الرأس أن يمسحه بماء، جديد يبتدئ بمقدم رأسه ثم يرد يده إلى مؤخره، ثم يردها إلى يافوخه هذه مرة، وليمسح رأسه أجمع وهذه الأربعة الأعضاء هي المنصوص عليها، فأما ذكر الواو في الترتيب، فإني سمعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة بمكة يقول: إنّ الواو وإن كانت للجمع فلا تقتضي الترتيب في الظاهر، فإنه إذا لم يرد به الجمع بين شيئين واستحال أن يجمع بها بين اثنين معاً فإنها تقوم حينئذ مقام ثم، تكون للترتيب لا غير.
ذكر سنن الوضوء
وهي عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، وتخليل اللحية ومسح الأذنين وغسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً، وأن يبدأ بالميامن وتخليل أصابع القدمين.
ذكر فضائل الطهارة
وما يقال عند غسل كل عضو من الأذكار
أول ذلك أن يتوضأ قاعداً مستور العورة، وأن لا يكون الماء مشمساً، وقد كره ذلك وقيل: إنّ كراهيته في أرض الحجاز خاصة وإسباغ الوضوء سيما في الشتاء، فإنه من عزائم الدين، وقال بعض السلف: وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلها، وأن لا يعتدي في الطهور فقد نهي عن ذلك، وهو أن يغسل كل عضو فوق الثلاث، والوضوء على الوضوء نور، وهو أن يتوضأ لكل صلاة عن غير حدث، فإن ذلك مستحب إذا أمكن، وله بكل وضوء عشر حسنات، ويجزيه أن يصلّي الخمس بوضوء واحد، فقد فعل ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والوضوء على حدته قربة إلى الله تعالى، إذا نوى به العبد ذلك من غير أن يصلّي به، وفي الخبر: إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من جميع أعضائه، وتكون الصلاة نافلة، ويستحب أن يتوضأ العبد كلما بال ما لم يشق ذلك عليه، وأن يصلّي ركعتين كلما توضأ، ثم أن لا يتكلم في الوضوء إلا بذكر الله تعالى، وأن يقول عند غسل كل عضو ما يستحب من الدعاء، فيقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق، وحسن فرجي من الفواحش، ويقول عند التسمية: أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربّ أن يحضرون، ويقول عند غسل يديه: اللهم إني أسألك اليمن والبركة، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، ويقول عند الاستنشاق: اللهم صلّ على محمد وأوجد لي رائحة الجنة، وأنت عني راض، ويقول عند الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار، ويقول عند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه وجوه أوليائك، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه وجوه أعدائك، وعند غسل يمينه: اللهم آتني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً، وعند غسل الشمال: اللهم إني أعوذ بك أن تؤتيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري، وعند مسح الرأس: اللهم غشُني برحمتك وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلاّ ظلك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اسمعني منادي الجنة مع الأبرار، ثم يمسح عنقه فيقول: اللهم فك رقبتي من النار، وأعوذ بك من السلاسل والأغلال، ويقول عند غسل قدمه اليمنى: اللهم ثبت قدمي على الصراط مع أقدام المؤمنين، ويقول عند غسل اليسرى: اللهم إني أعوذ بك أن تنزل قدمي عن الصراط يوم تنزل فيه أقدام المنافقين، وأن يبتدئ بغسل الذراعين من أصابع الكفين ويقطع من المرفقين كل غسلة، وأن يرفع في غسل الذراعين إلى إنصاف العضدين، وأن يبتدئ بغسل القدمين من الأصابع ويخللهما في الميامن ويقطع غسلهما من الكعبين، ويرفع في غسل الرجلين إلى إنصاف الساقين ويمين أصابع اليد اليمنى خنصرهما، ويمين اليد اليسرى إبهامها، وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إلى السماء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبده ورسوله، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، عملت سوءاً وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التوّاب الرحيم، اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين، واجعلني شكوراً واجعلني أذكرك كثيراً، وأسبحك بكرة وأصيلاً، هذا جميع ما روي من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة جمعناها، يقال إنّ من قال هذا بعد فراغه من الوضوء ختم على وضوئه بخاتم، ورفع له تحت العرش، فلم يزل يسبح الله ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة، وأكره الوضوء في إناء صفر، سمعت أنّ العبد إذا توضأ احتوشتْه الشياطين توسوس إليه، فإذا ذكر الله خنست عنه وحضرته الملائكة، فإنّ كان وضوءه في إناء صفر أو نحاس لم تحضره الملائكة.
وروي عن ابن عمر وأبي هريرة كراهة ذلك، وقال بعضهم: سألني شعبة أن أخرج له وضوءاً، فأخرجته في إناء صفر فلم يتوضأ به، وقال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء في إناء صفر، وتوضأ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ركوة ومن إداوة ومن مهراس حجر، وقد روينا في حديث زينب بنت جحش أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ واغتسل، في حديث آخر من مخضب لها وهو نحاس وهذه رخصة.
صفة الغسل من الجنابة
يضع الإناء عن يمينه ثم يسمي الله تعالى، ويفرغ الماء على يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ذكره ويستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً إلا غسل قدميه، ثم يدخل يديه في الإناء بما حملتا من الماء فيصب على شقه الأيمن ثلاثاً ظهراً وبطناً إلى فخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك ثلاثاً ظهره وبطنه إلى فخذه وساقه، ويدلك ما أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاً، ثم يدخل يديه بما حملتا من الماء فيفيض على رأسه ثلاثاً ويخلل شعر رأسه بأصابعه ويبل الشعر وينقي البشرة، ثم يتنحي من موضعه قليلاً فيغسل قدميه، فإن فضل من الإناء ماء أفاضه على سائر جسده، وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن قدم غسل رجليه فأدخلهما في أول وضوئه فلا بأس ولا وضوء عليه بعد الغسل، وليتق أن يمس ذكره في تضاعيف ذلك بيديه، فإن مس ذكره فليعد وضوءه وإن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة حتى صلّى أحببت أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، وإن نسيهما في الوضوء فلا إعادة عليه، وكيفما أتى بغسل جسده من الجنابة فجائز بعد أن يعم جميع بدنه غسلاً، ومن لم يتوضأ قبل الغسل أحببت له أن يتوضأ بعده، ومن انغمس في نهر أجزاه عن الغسل وأحب أن يتوضأ وفرض غسل الميت كغسل الجنابة.
كتاب الصلاة
ذكر فرائض الصلاة قبل الدخول فيها
وهي سبع: أول ذلك طهارة الجسد، وطهارة الثوب وطهارة البقعة، وستر العورة وهي من السرّة إلى الركبة، واستقبال القبلة وإصابة الوقت، والقيام إلا من عذر، وفرائض الصلاة في صلبها اثنتا عشر خصلة، روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مفتاح الجنة الصلاة، وروي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تحريمها التكبير وتهليلها التسليم فأول ذلك النية وتكبيرة الإحرام بلفظ التكبير، وليس للعرب في لفظ التكبير بمعنى الإكبار إلا وزن أفعل والأفعل فيقولون: الله أكبر والله الأكبر، وليس يقولون: الله كبير، وهم يريدون معنى أكبر مما سواه، إنما يقولون كبير بمعنى عظيم لأن هذه لفظة أعجمية عربت، وتقول العرب: الله كبار، وليس بمعنى أكبر إنما هو بمعنى كبير، والتفخير للتعظيم، ثم يقرأ سورة الحمد؛ أولها بسم الله الرحمن الرحيم، والركوع، ثم الطمأنينة في السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير، والصلاة على محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتسليم الأول، وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا ينظر الله تعالى إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، وروي عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، ورأى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً يصلي لا يقيم ظهره في ركوعه وسجوده، فقال له: ارجع فصلّ، فإنك لم تصلّ، ثم رآه لا يطمئن إلى الركوع والسجود فأمره أيضاً بإعادة الصلاة، ثم علمه الطمأنينة بينهما والقيام فيهما، فقال: حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي، ورأى حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما رجلاً يصلّي لا يتم ركوعه وسجوده فقالا: لو مات هذا لمات على غير فطرة أبي القاسم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي حديث أحدهما: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة فقال: ما صليت منذ أربعين سنة، وعن كعب الأحبار قسمت الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن نقص أحدهما لم يقبل منه سائرها، ويقال: من لم تقبل صلاته ردت أعماله كلها عليه.
ذكر سنن الصلاة
وهي اثنتا عشرة سنة: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، وصورة الرفع أن يكون كفّاه مع منكبيه وإبهامه عند شحمة أذنية وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه، فيكون بهذا الوصف من الرفع موطئاً للأخبار الثلاثة المروية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه كان يرفع يديه إلى منكبيه وأنّه كان يرفعهما إلى شحمة أذنيه، وأنه رفع إلى فروع أذنيه يعني أعاليهما، ولفظ التكبير أن يضم الهاء من الاسم بتخفيف الضمة من غير بلوغ، واو، ويهمز الألف من أكبر ولا يدخل بين الباء والراء ألفاً، ويجزم الراء، لا يجوز غير هذا فيقول: الله أكبر، ثم لا يرفع يديه إذا كبر إلى قدام دفعاً، ولا يردهما إلى خلف منكبيه وتكون أصابعه تلقاء أذنيه، ثم يكبر ويرسلهما إرسالاً خفيفاً رفيقاً، ويكون إرساله يديه مع آخر التكبير، لا يسلهما قبل انقضاء التكبير ولا يوقفهما بعد الفراغ من التكبير، ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال، روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا كبر أرسل يديه، فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمين على اليسرى، وليقبض على زند كفه الشمال وليجعلهما تحت صدره، ثم التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، ثم يقول: إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، فقد روي جميع ذلك في روايات مختلفة وجمعه حسن، إلا أن يكون خلف الإمام ولا يكون للإمام سكتتان، فلا يمكنه أن يأتي بهذا التوجه كله مع قراءة الحمد، ولا يشتغلن حينئذ إلا بقراءة الحمد، يغتنم قراءتها في سكوت الإمام، واحذر أن تقرأ في قراءة الإمام، أو تركع أو تسجد أو ترفع رأسك قبله، ثم الاستعاذة، ثم قراءة سورة من القرآن أو ثلاث آيات من سورة بعد الحمد، والتأمين بعد قراءة الحمد سنة حسنة، فعله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أمر به ثم رفع اليدين بالتكبير، للركوع أيضاً سنة، ثم التسبيح للركوع وإذا أردت عشراً أو سبعاً ولا أقل من ثلاث، وإنما قيل: إن الثلاث أدنى الكمال لأن الكمال عشرة، قال الله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة: 196، ولتكن الثلاث بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن يرفعهما، لأنه إذا لم يتحفظ في ذلك ويتمهل فيه حصل من التسبيح واحدة بعد الركوع، وتكون الأولى والأخرى في الإنحطاط والرفع، وهذا مكروه، وصورة الركوع أن يفرج بين أصابعه فيملأ بها ركبتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، وليمد عنقه مع ظهره مداً فيكون ظهره ورأسه سواء، ولا يكون مخفوضاً إلى أسفل ولا مقبواً إلى فوق، ثم رفع اليدين بقول: سمع الله لمن حمده، سنة، ويقول: اللهم ربنا، لك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم التسبيح في السجود إن شاء عشراً أو سبعاً وأدناه ثلاث، ولتكن الثلاث بعد حصول جبهته على الأرض وقبل رفعه إياه، وإلا كانت واحدة تذهب الأولى في حال وضع الوجه، والأخرى في حال رفع الرأس، فتحصل تسبيحة واحدة في كل سجدة، وهذا غير مستحب أن ينقص من ثلاث، وقال أنس بن مالك: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من إمامكم، هذا يعني عمر بن عبد العزيز، قال: فكنا نسبح وراءه عشراً في الركوع والسجود عشراً عشراً، ويجعل رأسه بين كفيه في سجوده، فإنهما يسجدان إذا كانتا مفتوحتين فيجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره ويرفع بطنه عن فخذيه، ويستحب أن يباشر الأرض بكفيه، فإنهما يسجدان مع الوجه، ثم التكبير للسجود والرفع بين السجدتين وللقيام بين السجود من غير رفع يديه، ثم يقول: ربّ اغفر لي وارحمني ثلاثاً، روي ذلك عن ابن عمر وإن قال: ربِّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم فجائز، روي ذلك عن ابن مسعود، وإن قال: ربّ اغفر لي وارحمني واهدني وأجبرني وأنعشني، فحسن قد روي ذلك عن عليّ رضي الله تعالى عنه، ثم التشهد الأول ثم السلام الأخير بالألف واللام وضمّ الميم من السلام من غير تنوين، ومد الاسم وجزم الهاء منه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله حتى يتبين خذاه لمن عن يمينه وشماله ويلوي به عنقه إلى منكبيه، كذلك كان تسليم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غير أن يحول جسمه عن القبلة ولا يرفع فخذه عن
الأرض. الأرض.
ذكر أحكام الصلاة في الإدراك
ومن أدرك من صلاة رباعية ركعتين أو الثالثة من صلاة المغرب، فإنّ ما أدرك هو أول الصلاة فليبن على ذلك ومن أدرك مع الإمام بعض القيام افتتح سورة الحمد ولم يركع حتى يتمها، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبله رفع بعده، ومن لم يدرك مع الإمام من القيام شيئاً كبر للإحرام، ثم كبر وركع وهي له ركعة، وإن ركع الإمام وهو في قراءة سورة غير الحمد فليقطع حيث انتهى وليركع بعده، ومن أدركه في التشهد أو في السجود ابتدأ التكبير للإحرام قائماً، ثم جلس وسجد للإتباع، فإذا سلم الإمام قام من غير تكبير يحدثه ثانياً، وابتدأ بقراءة الحمد عند قيامه، ولا يعتد بشيء مما أدرك مع الإمام إلا بالركوع، وهو أن يكون قد وضع يديه على ركبتيه واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهذه له ركعة، ومن دخل في صلاة مكتوبة ثم ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها ثم يصلّي التي ذكر، ثم يعيد هذه الصلاة، ومن وافق الإمام في صلاة العصر ولم يكن صلّى الظهر صلاّها معه، ثم يصلّي الظهر ثم أعاد بعدها صلاة العصر، فعله بعض الصحابة وهو أحب الوجوه إليّ، ومن تكلم في صلاته ناسياً أو سلم من ركعتين من صلاة رباعية، فليسجد سجدتي السهو بعد التشهد، فإن كان قد خرج من المسجد وتطاول ذلك، ثم ذكر أحببت أن يعيد الصلاة، ومن تكلم أو سلم عامداً أو استدبر القبلة، أو انكشفت عورته أو رعف في صلاته أو ذكر أنه نسي مسح رأسه، أو غسل عضو من أعضائه، أعاد الصلاة، ومن فاتته جماعة فتطوع رجل قام يصلّي معه أحببت أن يكون هو المصلّي به فرضه، ولا يخرج من الخلاف ويدخل في فرض الجماعة، ولا أستحب أن يصلّي فرضاً خلف رجل يتطوع، ولا أكره صلاة النوافل جماعة، ولا سجود سهو على العبد فيما جهر فيه مما يخافت فيه مما يجهر، ومن شك في ثلاث ركعات أو اثنتين فليجعلهما اثنتين، ومن شكّ في أربع أو ثلاث حسبها ثلاثاً يبني أبداً على اليقين، وهو الأقل، ثم يسجد سجدتيّ السهو قبل السلام، وعليه أن يتشهد ثانياً لسجدتيّ السهو وصلاته تامة، ومن سها عن سجدتي السهو، فإن ذكر قريباً أو قبل أن يخرج من المسجد فأحب أن يسجدهما ثم يتشهد ويسلم، فإن تطاول الوقت أو كان قد خرج من المسجد سقط عنه، ومن شك في القبلة لدخول ظلمة أو فقد أدلة تحرى جهده، فإن تبين له أنّ القبلة بخلاف ذلك أحببت له أن يعيد ذلك، وأستحب سجود السهو فيما زاد بعد التسليم وفيما نقص قبله، فإن سجدهما في الزيادة والنقصان قبل السلام فحسن كل ذلك، قد رويناه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإن لحقه وهم في الصلاة ليس بشك، أو كثر وهمه في الصلاة أحببت أن يجعل سجوده أبداً بعد السلام، ومن صلّى في حال ضرورة بنقصان طهارة أو نقصان فرض من فرائض الصلاة أحببت أن يعيد متى قدر على ذلك، ومن صلّى في ثوب ثم رأى فيه نجاسة بعد ذلك أعاد ما دام في الوقت قبل أن يدخل وقت صلاة أخرى، فإن خرج جميع الوقت فلا إعادة عليه، ولو أعاد تلك الصلاة متى رأى تلك النجاسة كان أحب إليّ، ومن كان عليه صلوات فرط فيها بإضاعة أو نقصان حدود صلاها أحب إليّ متوالية صلاة يوم في وقت واحد إن أمكن، أو في أوقات متفرقة نسقاً، وأن يكون ذلك في غير الأوقات المنهي فيها عن الصلاة أحب إليّ، ومن علم في صلاته أنّ عليه ثوباً فيه نجاسة وأنه غير مستقبل القبلة، فليلق الثوب وليستقبل القبلة وليتم صلاته، وإن أعاد فهو أحب إليّ،.
ذكر هيئات الصلاة وآدابها
السواك قبل الصلاة من فضائلها، روي في الخبر: صلاة بسواك تفضّل على صلاة بغير سواك سبعين ضعفاً، وأستحب له أن يقرأ، قل: أعوذ بربّ الناس، قبل دخوله في الصلاة، فإنه جنة له من العدو، وأن يستعيذ في كل ركعة قبل قراءة الحمد لأنه يكون قارئاً للقرآن ولأنّ كل ركعة صلاة، وأن يضم أصابع كفيه في التكبير وأن يراوح بين قدميه في القيام، لا يضم كعبيه ولكن يجعل بين قدميه مقدار أربع أصابع، فإنّ ذلك يستحب، قال بعضهم: كانوا يفتقدون الإمام إذا كبر في ضم الأصابع، وإذا قام في تفرقة الأقدام، قال: فيستدلون بذلك على فقهه، ونظر ابن مسعود إلى رجل قد ألزق كعبيه في الصلاة فقال: لو رواح بينهما كان قد أصاب السنة.
وقد يروى في خبر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصفن والصفد في الصلاة، فأما الصفن فرفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: (الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) ص: 31، إذا عطف الفرس طرف سنبكه، وأما الصفد فهو اقتران القدمين معاً ومنه قوله تعالى: (مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ) إبراهيم: 49، واحدها صفد، وقد رأيت بعض العلماء يفرق بين أصابعه في التكبير، وتأول أنّ ذلك معنى الخبر أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان إذا كبر نشر أصابعه نشراً، وذلك محتمل لتوكيده بالمصدر، وهو قوله نشراً، فيصلح أن يكون قوله نشراً، يريد به التفرقة، وقد تسمى التفرقة بثاء ونشراً لأنّ حقيقة النشر البسط، وقد قال الله تعالى: (وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) الغاشية: 16، فهذا هو التفرقة وقال في معنى البث كالفراش المبثوث، ثم قال في مثله: (كأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ) القمر: 7، فإذا كان النشر مثل البث، وكان البث هو التفرقة، كان قوله نشراً بمعنى فرق، إلاّ أنّ إسحاق بن راهويه سئل عن معنى قوله نشر أصابعه في الصلاة نشراً فقال: هو فتحها وضمها، أراد بذلك أن يعلم أنه لم يكن يقبض كفه وهذا وجه حسن، لأن النشر ضد الطي في المعنى، والقبض طي، ورأيت ثلاثة من العلماء يفرقون أصابعهم في التكبير منهم: أبو الحسن صاحب الصلاة في المسجد الحرام وكان فقيهاً، ورأيت ثلاثة يضمون أصابعهم: منهم أبو الحسن بن سالم وأبو بكر الآجري، وأحسب أنّ أبا زيد الفقيه كان يفرق في أكثر ظني إذا تذكرت تكبيره، قول: آمين من فضائل الصلاة، روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع صوته بآمين، وفي لفظ: آمين لغتان: المد والقصر، والميم فيهما مخففة لأنك إذا شددت الميم أحلت المعنى، فيكون معناه قاصدين من قوله ولا آمين البيت الحرام، وأن يترك إحدى يديه على الأخرى قابضاً على الزندين بين السرّة والصدر، فإنّ ذلك من الخشوع، وقال بعض العلماء: ما أحسبه ذل بين يدي عزيز.
وروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه من سنن المرسلين، وفسر عليّ عليه السلام قوله تعالى: فصل لربك وانحر، قال: وضع اليمين على الشمال، وهذا موضع علم علي رضي الله تعالى عنه، ولطيف معرفته، لأنّ تحت الصدر عرقاً، يقال له: الناحر لا يعلمه العلماء، فاشتق عليّ رضي الله عنه قوله: وانحر من لفظ الناحر: أي أوضع يدك على إلا الناحر، وهذا هو العرق، كما يقال ادمغ؛ أي أصب الدماغ ولم يحمله على نحر البدن، لأنه ذكر في الصلاة، ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحر، والنحر هو تحت الحلقوم عنده لمتقي التراقي، واليد لا توضع هناك إلا من قال من أهل اللغة في معناه: وانحر أي وجه القبلة بنحرك، فهذا لعمري وجه لا يقعي في الصلاة، وهو أن يجلس على قدميه وينصب ركبتيه، هذا مذهب أهل اللغة في الإقعاء، أو على ركبتيه جاثياً وأصابع رجليه في الأرض، هذا مذهب أهل الحديث، وليجتنب السدل والكف، فإمّا السدل فهو أن يرخي أطراف ثيابه على الأرض وهو قائم، يقال: سدل وسدن بمعنى واحد، وقد تبدل اللام نوناً لقرب المخرجين إذا أرسل ثيابه، ومنه قيل: سدنة الكعبة أحدهم سادن، وهم قوامها الذين يسلبون عليها كسوتها؛ وسدانة الكعبة ثيابها المسبلة، وهذا قول أهل اللغة ومذهب أهل الحديث في السدل أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك، ولأنّ هذا فعل اليهود في صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم، والقميص في معناه؛ ولا يركع ويسجد ويداه في بدن القميص إن اتسع، فأما أن يدخل يديه في جسد القميص في السجود فمكروه، وقد قال بعض الفقهاء في السدل قولاً ثالثاً قال: هو أن يضع وسط إزاره على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، وهذا قول بعض المتأخرين وليس بشيء عندي، والأولان أعجب إليّ، وهما مذهب القدماء، وأما الكف فقد نهي عنه في الصلاة أيضاً، وهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، وأكره أن يأتزر قوق القميص فإنه من الكف، وقد روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كراهية ذلك، وروينا عن بعض أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرخصة في ذلك صلّى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محتزماً بعمامته فوق القميص، وقد يكون الكف في شعر الرأس، فلا يصلين وهو عاقص شعره، وفي الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعراً ولا ثوباً، ونهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة وعن الصلب، فأما الاختصار فأن يضع يده على خاصرته، وأما الصلب فأن يضع يديه جميعاً على خصريه ويجافي بين عضديه في القيام، ولتقع ركبتاه على الأرض قبل يديه، ويداه قبل وجهه، وأن يسجد على جبهته وأنفه، فإنهما عضو واحد، ولينهض على صدور قدميه وإن ضعف فليعتمد على الأرض بيديه، وأن لا يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلحظ عن يمين وشمال، فإن لحظ فهو أيسر، وليرم ببصره إلى موضع سجوده، فإن لم يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة ولا يعبث بشيء من بدنه في الصلاة.
وروي أنّ سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وقد رويناه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق ونهى عن المواصلة في الصلاة وهي في خمس: اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام، ولا يصل ركوعه بقراءته، واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه، وواحدة بينهما أن لا يصل تسليم الفرض بتسليم التطوع، وليفصل بينهما، وقد قيل: التسليم حزم والتكبير جزم، وقد جاء في الخبر: سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتثاؤب، والحكاك، والالتفات، والعبث بالشيء، وزاد بعضهم: والسهو، والشك، وقال بعض السلف: أربعة أشياء في الصلاة من الجفاء: الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وأن يصلّي بطريق من يمر بين يديه وزاد بعضهم وأن لا يصلّي في الصف الثاني، وفي الصف الأول فرجة وقد نهى عن صلاة الحاقن، والحاقب، والحازق، فالحاقن من البول والحاقب من وجود الغائط والحازق صاحب الخف الضيق فلا يصلّي من كن به هذه الثلاثة لأنها تشغل القلب، وأكره صلاة الغضبان والمهتم بأمر ومن عرضت له حاجة حتى يسري عن قلوبهم ذلك ويطمئن القلب ويتفرّغوا للصلاة ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدم الأكل لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب، وفي الخبر لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مغضب ولا يصلّين أحدكم وهو غضبان، وكان الحسن يقول: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرعز
ذكر فضائل الصلاة وآدابها وماَ يزكو به أهلها ووصف صلاة الخاشعين
قال الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري) طه: 14، وقال: (وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلينَ) الأعراف: 205، وقال تعالى: (لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء: 43، قيل: سكارى من حبّ الدنيا وقيل: من الاهتمام بها، وقال جلّ ثناؤه: (الَّذينَ هُمْ عَلى صَلاَتِهِمْ دَائِمُون) المعارج: 23، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من صلّى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما الصلاة تمسكن، وتواضع، وتضرع وتباؤس، وتنادم، وترفع يديك وتقول: اللهم، فمن لم يفعل فهي خداج أي ناقصة، روينا عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السالفة أنه قال: ليس كل مصلٍّ أتقبّل صلاته إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتكبر عليّ، وأطعم الفقير الجائع لوجهي، فمن الإقبال على الصلاة أن لا تعرف من على يمينك ولا من على شمالك من حسن القيام بين يدي القائم على كل نفس بما كسبت، وكذلك فسّروا قوله تعالى: (هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون: 2، وقال سعيد بن جبير: ما عرفت من على يميني ولا على شمالي في الصلاة منذ أربعين سنة، منذ سمعت ابن عباس يقول: الخشوع في الصلاة أن لا يعرف المصلّي من على يمينه وعن شماله.
وروينا عن بشر بن الحرث قال: قال سفيان: من لم يخشع فسدت صلاته، وروينا عن معاذ بن جبل، من عرف من عن يمينه وشماله في الصلاة متعمّداً فلا صلاة له، وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بن الحرث وغيره وعن الثوري أيضاً: من قرأ كلمة مكتوبة في حائط أو بساط في صلاته فصلاته باطلة، وقال بشر يعني بذلك لأنه عمل في الصلاة، ومن الدوام في الصلاة السكون فيها، وعلى ذلك فسّر قوله تعالى: (الَّذينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ) المعارج: 23، قيل: هو السكون والطمأنينة في الصلاة من قولك: ماء دائم إذا سكن، وقال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئاتهم في الصلاة، من الطمأنينة والهدوء، ومن وجود النعيم بها واللذة، ثم إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع، وسكون الجوارح للهيبة، ثم الترتيل في القراءة والتدبر لمعاني الكلام، وحسن الافتقار إلى المتكلم في الإفهام والإيقاف على المراد، وصدق الرغبة في الطلب للاطلاع على المطلع من السرّ المكنون المستودع في الكتاب، وإن مرّ بآية رحمة سأل ورغب، أو آية عذاب فزع واستعاذ، أو مرّ بتسبيح أو تعظيم حمد وسبّح وعظّم، فإن قال بلسانه فحسن وإن أسره في قلبه ورفع به همّه نابه قصده عن المقال، وكان فقره غاية السؤال، وهذا أحد الوجهين في قوله تعالى: (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) البقرة: 121، هكذا كان وصفهم في التلاوة، وينبغي أن يكون قلبه بوصف على ركن من أركان الصلاة، وهمه معلّق بكل معنى من معاني المناجاة، فإذا قال: الله أكبر أي مما سواه ولا يقال أكبر من صغير، إنما يقال أكبر من كبير، فيقال: هذا كبير وهذا أكبر، فإن كان همّه الملك الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبه فليواطئ قلبه قول مولاه في قوله تعالى: (وَلَذِكْرُ الله أَكْبرُ) العنكبوت: 45، ويواطئ لسانه قلبه في مشاهدة الأكبر فيكون يتلو وينظر، فإن الله تعالى قدّم العين على اللسان في قوله تعالى: (أَلَم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ) البلد: 8 - 9.
فلا يقدّم لسانه ويؤخّر بصره ويكون عقده محقّقاً لمقاله بالوصف حتى يكون عاملاً بما يقول في الحال، فقد أخذ عليه ذلك لما أمر به حجة عليه وتنبيهاً له، ولا يكون بقوله: الله أكبر، حاكياً؛ ذلك عن قول غيره، ولا مخبراً به عن سواه، بل يكون هو المتحقق بالمعنى القائم بالشهادة، وهذا عند أهل المعرفة واجب لأن الإيمان قول وعمل في كل شيء، فإذا قلت: الله أكبر فإن العمل بالقول أن يكون الله أكبر في قلبك من كل شيء، وهو من رعاية العهد، لتدخل تحت الثناء والمدح في قوله تعالى: (وَالَّذينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) المعارج: 32، فالعهد ما أعطيت بلسانك، والرعاية والوفاء بالقلب ليستحق الأجر العظيم كما قال تعالى: (وَمَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً) الفتح: 1،، ومن كان في قلبه الملك الصغير الفاني أكبر من الملك الأكبر فما عمل بقوله تعالى: الله أكبر، وليس هذا حقيقة الإيمان لأنه لم يأتِ بعمل وقول، وإنما جاء بالقول وهذا قائم بنفس من مشاهدته الآخرة، وكانت قرة عينه الآخرة، كما قال تعالى: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ) النحل: 96، يعني الدنيا، (وَمَا عِنْدَ الله بَاقٍ) النحل: 69، يعني الآخرة.
وقد قال: جعلت قرة عيني في الصلاة لأنه كان عند ربه فجعل قرة عينه به، وقد قال سبحانه وتعالى: (وَلِذَكْرُ الله أَكْبَرُ) العنكبوت: 45، فالمذكور أكبر وأكبر، وقد أخبر تعالى أن الصلاة أريد بها الذكر في قوله تعالى: (وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْري) طه: 14، وروي معنى ذلك عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما فرضت الصلاة وأمرت بالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله، فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك؟ وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأنس بن مالك، وإذا صليت صلاة فصلِّ صلاة مودّع لنفسه، مودّع لهواه، مودّع لعمره، سائر إلى مولاه، كما قال: (يَا أَيُّها الإنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً) الإنشقاق: 6، وكقوله تعالى: (وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أنَّكُمْ مُلاقُوهُ) البقرة: 223، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جعلت قرّة عيني في الصلاة، وكان يرى الأكبر فتقرّ عينه به، وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً، كما قال: من لم يترك قول الزور والخيانة فليس لله تعالى حاجة أن يترك طعامه وشابه، فإنما المراد من الصلاة والصيام المخالفة من الآثام، ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبل دخول وقتها لئلا يشغله عن أول وقت غيرها، وينبغي أن يكون قلبه في همّه، وهمّه مع ربّه، وربّه في قلبه، فينظر إليه من كلامه، ويكلمه بخطابه، ويتملقه بمناجاته، ويعرفه من صفاته، فإن كل كلمة عن معنى اسم، أو وصف، أو خلق، أو حكم، أو إرادة، أو فعل؛ لأن الكلم ينبئ عن معاني الأوصاف، ويدل على الموصوف، وكل كلمة من الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف، من كل جهة مقام ومشاهدات؛ أول الجهات الإيمان بها، والتسليم لها، والتوبة إليها، والصبر عليها، والرضا بها والخوف منها، والرجاء لها، والشكر عليها، والمحبة لها، والتوكل فيها، فهذه المقامات العشر هي مقامات اليقين، لأن الكلمة هي حق اليقين، وهذه المعاني كلها منطوية في كل كلمة يشهدها أهل التملّق والمناجاة، ويعرفها أهل العلم والحياة، لأن كلام المحبوب حياة القلوب، لا ينذر به إلا حيّ ولا يحيا به إلا مستجيب، قال الله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيّاً) يس: 69 - 7،، وقال سبحانه: (اسْتَجيبُوا لله وَلِلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ) الأنفال: 42، ولا يشهد هذه العشر مشاهدات إلا من نقل في العشر المقامات المذكورة في سورة الأحزاب؛ أولها مقام المسلمين، وآخرها مقام الذاكرين، وبعد مقام الذكر هذه المشاهدات العشر فعندها لا يملّ المناجاة لوجود المصافاة، ولا يثقل عليه القيام للذاذة والإفهام، ويسهل عليه الوقوف لدنوّ العطوف، ويتنعم بالعتاب بحلاوة الإقتراب، هنالك يندرج طول القيام في التلاوة فلا يجده كاندراج القبلة في الصلاة فلا يشهدها، فيكون من ورائه القبلة وهو أمامها، كذلك القيام يحمله وهو مع حامله.
حدثت أنّ الموقن إذا توضّأ للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرضين خوفاً منه، لأنه يتأهب للدخول على الملك، فإذا كبر حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قال: الله أكبر أطلع الملك في قلبه، فإذا ليس في قلبه أكبر من الله تعالى فيقول: صدقت الله تعالى في قلبك، كما تقول: قال فيتشعشع من قلبه نور يلحق بملكوت العرش، فيكشف له بذلك النور ملكوت السموات والأرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات، قال: وإنّ الغافل الجاهل إذا قام للوضوء احتوشته الشياطين، كما يحتوش الذباب على نقطة العسل، وإذا كبر أطلع الملك في قلبه، فإذا كل شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده، فيقول له: كذبت ليس الله في قلبك كما تقول، قال: فيثور في قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه، قال: فيرد ذلك الحجاب صلاته، ويلتقم الشيطان قلبه، فلا يزال ينفخ فيه، وينفث ويوسوس إليه، ويزين له، حتى ينصرف من صلاته ولا يعقل ما كان فيه، وقد جاء في الخبر: لولا أنّ الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى في القبلة نخامة، فغضب غضباً شديداً، ثم حكّها بعرجون كان في يده، وقال: ائتوني بعبير فلطخ أثرها بزعفران، ثم التفت إلينا فقال: أيكم يحب أن يبزق في وجهه؟ قلنا: لا أينا، قال: فإن أحدكم إذا دخل في صلاته فإن الله عزّ وجلّ بينه وبين القبلة، وفي لفظ آخر واجهه الله تعالى؛ فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه اليسرى، فإن بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا، وذلك بعضه ببعض، وقد روي: إذا قام العبد في صلاته فقال: الله أكبر، قال الله لملائكته: ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي، فإذا التفت يقول اللّّه تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه، ثم إذا قام المقبل على صلاته شهد قلبه قيامه لرب العالمين، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم شهد وقوفه بالحضرة بين يدي الملك الجبار، إذ ليس من الغافلين، فتأخذه غيبة الحضور، ويرهقه إجلال الحاضر، ويستولي عليه تعظيم القريب، وبجمعه خشية الرقيب، فإذا تلا وقف همّه مع المتكلم ماذا أراد، واشتغل قلبه بالفهم عنه والانبساط منه، فإن ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم، فلا يكون في قلبه أعظم من الله تعالى وحده، فإن رفع شهد الحمد للمحمود، فوقف مع الشكر للودود، فاستوجب منه المزيد، وسكن قلبه بالرضا، لأنه حقيقة الحمد، وإن سجد سما قلبه في العلوّ فقرب من الأعلى بقوله تعالى: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) العلق: 19.
وأهل المشاهدة في السجود على ثلاث مقامات؛ منهم من إذا سجد كوشف بالجبروت الأعلى فيعلو إلى القريب ويدنو من القريب، وهذا مقام المقربين من المحبوبين، ومنهم من إذا سجد كوشف بملكوت العزة، فيسجد على الثرى الأسفل عند وصف من أوصاف القادر الأجل، فيكسر قلبه ويخبت تواضعاً وذلاً للعزيز الأعلى، وهذا مقام الخائفين من العابدين، ومنهم من إذا سجد جال قلبه في ملكوت السموات والأرض فآب بظرائف الفوائد وشهد غرائب الزوائد، وهذا مقام الصادقين من الطالبين، وهناك قسم رابع لا يذكر بشيء ليس له وصف فيستحق المدح، وهم الذين يجول همّهم في أعطية الملك وأنصبة المماليك، فهم محجوبون بالهمم الدنية عن الشهادة العلية مأسورون بالهوى عن السياحة إلى الإعلام، فإن دعا هذا المصلّي نظر إلى المدعوّ فكان هو المرجوّ فأخذ في التمجيد والثناء والحمد والآلاء، ونسي حاجته من الدنيا واشتغل عن نفسه بالمولى وعن مسألته بحسن الثناء، وإن استغفر هذا الداعي تفكّر في أوصاف التوبة وأحكام التائب وتفكّر في ما سلف من الذنوب فعمل في تصفية الاستغفار وإخلاص الإنابة والاعتذار، وجدّدَ عقد الاستقامة، فيكون له بهذا الاستغفار من الله عزّ وجلّ تحية وكرامة، ففي مثل صلاة هذا العبد وردت الأخبار أنّ العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه، وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء فيصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه، وأنّ المصلّي لينثر عليه البرّ من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه منادٍ لو علم المناجي من يناجي ما انفتل، وأنّ أبواب السماء، للمصلّين، وأنّ الله تعالى يباهي ملائكته بصفوف المصلّين، وفي التوراة مكتوب: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يديّ مصلّياً باكياً فأنا الله تعالى الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري، قال: وكنا نرى أنّ تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح التي يجدها المصلّي في قلبه من دنوّ الرب تبارك وتعالى من القلب، وقال رجل للنبيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادع الله تعالى أن يرزقني مرافقتك في الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود.
وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحبّ إليه من الصلاة، ولو كان شيء أحبّ إليه من الصلاة لتعبد به ملائكته؛ منهم راكع، وساجد، وقائم، وقاعد، أو كما قال بعض العلماء: الصلاة خدمة الله عزّ وجلّ في أرضه، وقال آخر: المصلون خدام الله عزّ وجلّ على بساطه، إنّ المصلين من الملائكة يسمون في السموات خدام الرحمن ويفخرون بذلك على سائر المرسلين من الملائكة، ويقال: إن المؤمن إذا صلّى ركعتين عجب منه عشر صفوف من الملائكة؛ كل صف منهم عشرة آلاف، وباهى الله تعالى به مائة ألف ملك؛ وذلك أنّ العبد قد جمع فيه أركان الصلاة الأربعة؛ من القيام والقعود والركوع والسجود، وفرق ذلك على أربعين ألف ملك، والقائمون لا يركعون إلى يوم القيامة، والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة، وكذلك الراكعون والساجدون، ثم قد جمع الله له أركان الصلاة الستة؛ من التلاوة والحمد والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفرق ذلك على ستين ألف ملك لأن كل صفّ من الملائكة عبادته ذكر من الأذكار الستة، فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه من الأركان الستة والأذكار في ركعتين عجبت منه وباهاهم الله تعالى به، لأنه قد فرق تلك الأعمال والأركان على مائة ألف ملك؛ وبذلك فضّل المؤمن على الملائكة، وكذلك فضّل الموقن أيضاً في مقامات اليقين من أعمال القلوب على الأملاك بالتنقيل في المقامات بأن جمعت فيه ورفع منها، والملائكة لا ينقلون بل كل ملك موقوف في مقام معلوم لا ينقل عنه إلى غيره مثل: الشكر والخوف والرجاء والشوق والأنين والخشية والمحبة، بل كل ملك له مزيد وعلوّ من المقام الواحد على قدر قواه، وجمع ذلك كلّه في قلب الموقن.
قال الله تعالى، وهو أصدق القائلين في صفات أوليائه المؤمنين: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) المؤمنون: 1 - 2 - 3، فمدحهم بالصلاة كما ذكرهم بالإيمان، ثم مدح صلاتهم بالخشوع كما افتتح بالصلاة أوصافهم، ثم قال في آخرها: (وَالَّذينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) المؤمنون: 9، فختم بها نعوتهم وقال في نعت عباده: المصلّين الذين استثناهم من الجزوعين من المصائب والفقر، المانعين للمال والخير، إلا المصلّين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم نسق النعوت وقال في آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون، فلولا أنها أحبّ الأعمال إليه ما جعلها مفتاح صفات أحبائه وختامها، ولما وصفهم بالدوام والمحافظة عليها، ومدحهم بالخشوع فيها؛ والخشوع هو انكسار القلب وإخباته وتواضعه وذلته ثم لين الجانب وكفّ الجوارح وحسن سمت وإقبال، والمداومة والمواظبة عليها وسكون القلب والجوارح فيها؛ والمحافظة هي حضور القلب وإصغاؤه وصفاء الفهم وإفراده من مراعاة الأوقات وإكمال طهارة الأدوات، ثم قال تعالى في عاقبة المصلّين: (أُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) المؤمنون: 1، - 11، فجعل أول عطائهم الفلاح وهو الظفر والبقاء، وآخره الفردوس وهو خير المستقر والمأوى، وقال في أضدادهم: من أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكُ من المصلّين، وقال موبخاً لآخر منهم فلا صدق ولا صلّى، ونهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن طاعة من نهاه عن الصلاة، ثم أمره بها وأخبره أنّ فيها القرب والزلفى في قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الَّذين يَنْهى عَبْداً إِذَا صَلَّى) العلق: 9 - 1،، ثم قال: (كَلاّ لاَ تَطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) العلق: 19، فالمصلّون بقية من خلقه وورثة جنته من عباده وأهل النجاة من دار غضبه إبعاده جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته.
ذكر الحث على المحافظة على الصلاة وطريقة المصلّين من الموقنين
قال الله سبحانه وتعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) الفتح: 29 الآية، فاختار لنفسه أصحابه صلوات الله عليه ثم اختار لأصحابه الصلاة فجعلها وصفهم في الإنجيل والتوراة، فهذا يدل أنّ الصلاة أفضل الأعمال لأن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل العمال، وسئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها، وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل حافظاً لصلاته فظنّ به خيراً وإذا رأيته مضيعاً لصلاته فهو لا سواها أضيع، وكان الحسن يقول: ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهو على الله تعالى أهون، وعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصلاة عماد الدين من تركها فقد كفر، وفي حديث آخر بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، وفي الخبر: من حافظ على الصلوات الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها، كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة، ومن ضّيعها حشره الله تعالى مع فرعون وهامان، وفي تفسير قوله تعالى: (لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَة إلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمِن عَهْداً) مريم: 87، قال الصلوات الخمس، وعن ابن مسعود وسلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى وفى له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين، وفي الخبر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها، وفي الخبر: إذا صلّى العبد في الملأ فأحسن وأساء صلاته في الخلا فتلك استهانة يستهين بها ربه عزّ وجلّ، وفي الخبر: إذا أحسن العبد صلاته في العلانية وأحسنها في السرّ قال الله تعالى لملائكته: هذا عبدي حقّاً، وعن كعب وغيره: من قبلت صلاته قبلت أعماله كلها، ومن ردّت عليه صلاته ردّت عليه أعماله كلها، ويقال: من تقبلت منه الصلوات الخمس كملاً من غير أن تلفق، ولا يرفع بعضها من بعضِ، أو غيرها من النوافل، أطلع على علم الأبدال وكتب صديقاً، وعلامة قبول الصلوات أن تنهاه في تضاعيفها عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والكبائر، والمنكر ما أنكره العلماء، فمن انتهى رفعت صلاته إلى سدرة المنتهى، ومن تحرقته الأهواء فقد ردّت صلاته لما غوى فهوى، وقال مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم: إني لأرى الرجل يسيء صلاته فأرحم عياله، وقال الفضيل بن عياض: الفرائض رؤوس الأموال والنوافل الأرباح، ولا يصحّ ربح إلا بعد رأس المال، وكان ابن عيينة يقول: إنما جرموا الوصول بتضييع الأصول، وقال عليّ بن الحسين: من اهتم بالصلوات الخمس في مواقيتها وإكمال طهورها لم يكن له في الدنيا عيش وكان عليه السلام إذا توضأ للصلاة تغير لونه واصفرّ وأرعد، فقيل له في ذلك فقال: تدرون بين يدي من أريد أن أقف وعلى من أدخل ولمن أخاطب؟ وقال بعض العارفين: للصلاة أربع فرائض؛ إجلال المقام، وإخلاص السهام، ويقين المقال، وتسليم الأمر، وقال أبو الدرداء: خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلّة لذكر الله تعالى وكان وكيع يقول: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يحافظ عليها ومن تهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه.
وروينا في تفسير قوله تعالى: (سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ) الحديد: 21، قال: تكبيرة الإحرام، وفي حديث أبي كاهل عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من صلّى أربعين يوماً الصلوات في جماعة لا يفوته منها تكبيرة الإحرام كتب له براءتان؛ براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقال سعيد بن المسيب: منذ أربعين سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة، وكان يسمى حمامة المسجد، وقال عبد الرزاق: من عشرين سنة ما سمعت الأذان إلا في المسجد، ويقال: إنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات المصلين إلى الجنة زمراً، قال: فتأتي أول زمرة كان وجههم الكوكب الدري فتستقبلهم الملائكة فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن المصلّون من أمة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيقولون: ما كانت أعمالكم في الدنيا؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها، فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك، ثم تأتي الزمرة الثانية فوق أولئك في الحسن والجمال كأنّ وجوههم الأقمار فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المصلّون، فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها، فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك، ثم تأتي الزمرة الثالثة فوق هؤلاء في المنزلة والجمال كأنّ وجوههم الشمس الضاحية، فتقول الملائكة: أنتم أحسن وجوهاًوأعلى مقاماً فما أنتم؟ فيقولون: نحن المصلّون، فيقولون: وما كانت صلاتكم؟ فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجد، فتقول الملائكة: يحق لكم ذلك.
وقال بعض العلماء رضي الله عنهم: سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله عزّ وجلّ ومواصلة من الله تعالى لعبده، ولا تكون المواصلة والمنال إلا لتقّي، قال الله تعالى: (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَدِمَاؤُهَا وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ) الحج: 37، ولا يكون التقيّ إلا خاشعاً فعندها لا يعظم عليه طول الوقوف ولا يكثر عليه الانتهاء عن المنكر والائتمار بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: (إنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرَ) العنكبوت: 45، والخاشعون من المؤمنين هم الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، الحافظون لحدود الله جزاؤهم البشرى، كما قال: (وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ) الأحزاب: 47 والخاشعون أيضاً الخائفون، الذاكرون، الصابرون، والمقيمون الصلاة، فإذا كملت هذه الأوصاف فيهم كانوا مخبتين، وقد قال سبحانه: (وَبَشِّرِ الْمُخْتِتِينَ) الحج: 34، وكان ابن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خيثم يقول: وبشر المختبين أما والله لو رآك محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفرح بك، وفي لفظ آخر لأحبك، يقال: إنه كان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة لا تحسب جارية ابن مسعود إلا إنه أعمى لشدة غضّ بصره وطول إطراقه إلى الأرض بنظره، وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه إنه أعمى لشدة غضّ بصره وطول طاقه إلى الأرض بنظره، وكان إذا دق الباب عليه تخرج إليه الجارية فإذا رأته قالت لعبد الله صديقك ذاك الأعمى قد جاءك فكان ابن مسعود يضحك ويقول: ويحك ذاك الربيع، ومشى ذات يوم مع ابن مسعود في الحدادين فلما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النيران تلتهب، صعق وسقط مغشياً عليه، وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله ابن مسعود على ظهره إلى منزله، فلم يزل مغشياً عليه إلى الساعة التي صعق فيها حتى فاتته خمس صلوات، وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله الخوف، وكان هذا يقول: ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي، وقد كان عامر بن عبد الله من خاشعي المصلّين، كان إذا صلّى ضربت ابنته بالدف، وتحدث النساء بما يردن في البيت، ولم يكن يعقل ذلك ولا يسمعه وقيل له ذات يوم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله عزّ وجلّ ومنصرفي إلى إحدى الدارين، قيل: فهل تجد شيئاً مما نجده من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف الأسنة فيّ أحبّ إليّ من أن أجد شيئاً في الصلاة مما تجدون، وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً، وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العاملين، كان إذا دخل في الصلاة يقول لأهله: تحدثوا بما تريدون وأفشوا سركم فإني لا أستمع إليكم، وكان يقول: وما يدريكم أين قلبي، وكان يصلّي ذات يوم في مسجد البصرة، فوقعت خلفه أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات، فتسامع بها أهل السوق فدخلوا المسجد وهو يصلي كأنه وتد، وما انفتل من صلاته، فلما فرغ جاءه الناس يهنونه فقال: أي شيء تهنوني؟ قالوا: وقعت هذه الأسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منها، قال: متى وقعت؟ قيل: وأنت تصلّي، قال: ما شعرت بها، وقال بعض المصلّين: الصلاة من الآخرة، فإذا دخلت في الصلاة خرجت من الدنيا، وسئل بعضهم: هل تذكر في صلاتك شيئاً؟ قال: وهل شيء أحبّ إليّ من الصلاة فأذكره فيها؟ وكان أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ.
وفي الخبر: أنّ عمار بن ياسر صلّى صلاة فخففها فقيل له: خففت يا أبا اليقظان، فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئاً؟ قالوا: لا قال: لأني بادرت سهو الشيطان أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إنّ العبد ليصلّي الصلاة لا يكتب له ثلثها ولا نصفها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها، وكان يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها، وقد ذكر هذا عبد الواحد بن زيد أنه إجماع، فروينا عنه أنه قال: أجمعت العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلاّ ما عقل، وقال الحسن: كل صلاة لا يحضرها قلبك فهي إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب، ويقال: إنّ أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم الزبير وطلحة، كانوا أخفّ الناس صلاة، فسئلوا عن ذلك فقالوا: نبادر بها وسوسة العدوّ، وروينا أنّ عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إنّ الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة، قيل: وكيف ذاك: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها؟ وقال الله جلّ ذكره: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَديثاً) النساء: 87، (حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) النساء: 43 وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك، وسئل أبو العالية عن قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ) الماعون: 5، قال: هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف، على شفع أم على وتر؟ سئل الحسن عن ذلك فقال: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى يخرج وقتها، وكان يقول: أما والله لو تركوها لكفروا، ولكن سهوا عن الوقت، وقال بعض السلف فيها: هو الذي إن صلاّها في أوّل الوقت أو في الجماعة لم يفرح وإن صلاّها بعد الوقت لم يحزن، وقيل: هو الذي لا يرى تعجيلها برّاً ولا تأخيرها إثماً ويقال: إنّ الصلوات الخمس يلفق بعضها إلى بعض حتى يتم بها للعبد صلاة واحدة، وقيل: من الناس من يصلّي خمسين صلاة فيكمل له بها خمس صلوات وإن الله تعالى ليستوفي من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإلاّ تممه من سائر أعماله النوافل لأنه ما فرض على العبد إلاّ ما يطيقه بعونه إذ لم يكلفه ما لا طاقة له به برحمته.
وروينا عن عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى: بالفرائض نجا مني عبدي وبالنوافل تقرّب إليّ عبدي وقد جاء مثله عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقول الله: لا ينجو مني عبد إلاّ بأداء ما افترضته عليه، وفي الخبر المفسر: أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن وجدت كاملة وإلا يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي نوافل؟ فنتمّ فرائضه من نوافله؟ ثم يعمل بسائر الفرائض، كذلك يوفي كل فرض من جنسه من النفل؛ فإذا كانت النوافل في السهو والتقصير كالفرائض أو لم يوجد نوافل فكيف يكون حاله في الحساب؟ وكان ابن عباس يفسر قوله تعالى كلا لما يقض ما أمره قال: يعني به الكافر، لأن عنده أنّ كل موضع في القرآن يذكر به الإنسان خاصة أنه يعني به الكافر، وقد قال الله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة: 286 يعني طاقتها، وقال سبحانه وتعالى مخبراً عن المؤمنين: (وَلاَ تُحَمِّلْنا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) البقرة: 286، في التفسير قد فعلت؛ وفي هذه المسألة اختلاف وشبهة، والصواب من ذلك أنّ الله عزّ وجلّ لا يكلف المؤمنين خاصة ما لا طاقة لهم به، فهم مخصوصون بذلك فضلاً من الله تعالى ونعمة آثرهم بها على الكافرين، إذ له أنّ يؤثر بعض عباده على بعض لأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، وهذا مفهوم من دليل الخطاب من قوله: لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أن له تعالى أن يحمل الكافر ما لا طاقة له به عدلاً منه وحكمة، كما قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ) الأنعام: 115، قيل: صدقاً للمؤمنين وعدلاً على الكافرين، قال الله تعالى مخبراً عن إخوة يوسف: (تَالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا) يوسف: 91 فهذا نص في الإيثار لبعض خلقه على بعض، ثم رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن عباس رواها إسماعيل عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: (وَالَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) الأعراف: 42، يعني إلاّ طاقتها من العمل لأن الله تعالى افترض على المؤمنين أعمالاً يطيقونها، ولم يفترض عليهم ما لا يطيقون، هذا نقل لفظ ابن مسعود في تخصيص المؤمنين، كما ذكرناه آنفاً، ويقول أيضاً في تفصيل هذه المسألة: للزائغين فيها تعلق ابتغاء التآويل أنّ الله تعالى كلّف العباد ما لا يطيقونه إلا به لافتقارهم إليه وعدم استغنائهم عنه في كل حركة وسكون، إذ لا مشيئة لهم دون مشيئته ولا استطاعة إلاّ بتوفيقه ولا حول ولا قوة إلاّ به، ألم تسمع إلى قوله تعالى في وصف الكافرين: (مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) هود: 2،، وقال تعالى في مثله: (وَكَانُوا لاَ يَسْتَطيعُونَ سَمْعاً) الكهف: 1، 1، وقال فيمن استطاع به إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت.
وروينا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من صلّى كما أمر غفر له ما تقدّم من ذنبه، وقد يروى في خبر: يقول الله تعالى: ليس كل مصلٍّ أتقبّل صلاته إنما أتقبّل صلاة من تواضع لعظمتي وخشع قلبه لجلالي، وكفّ شهواته عن محارمي، وقطع ليله ونهاره بذكري، ولم يصر على معصيتي، ولم يتكبّر على خلقي، ورحم الضعيف، وواسى الفقير من أجلي، على أن أجعل الجهالة له حلماً، والظلم له نوراً يدعوني فألبّيه، ويسألني فأعطيه، ويقسم عليّ فأبره، أكلؤه بقوّتي وأباهي به ملائكتي، لو قسم نوره عندي على أهل الأرض لوسعهم، مثله كمثل الفردوس لا يتسنّى ثمرها ولم يتغير حالها، وفي الخبر: كم من قائم حظه من قيامه السهر والتعب، ومن صلّى صلاة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأ فهو نهاية السهو، فإنه تارك الأمر للاستماع فيخاف عليه مجانية الرحمة لأن الله تعالى ضمن الرحمة بشرطين: الاستماع والإنصات، وقال سبحانه في المعنيين: (وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ) الأعراف: 204 وقال تعالى: (فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا) الأحقاف: 29، وروينا في خبر: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى صلاة فترك في قراءته، فلما انفتل قال: ماذا قرأت؟ فسكت القوم، فسأل أبيّ بن كعب فقال: قرأت سورة كذا وتركت آية كذا فما أدري أنسخت أم رفعت، فقال: أنت لها يا أبيّ، ثم أقبل على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمّون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم، لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم إلاّ أنّ بني إسرائيل كذلكم فعلوا، فأوحى الله إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني قلوبكم باطلاً ما تذهبون.
وقال بعض علمائنا: إنّ العبد يسجد السجدة عنده أنه يتقرب بهما إلى الله عزّ وجلّ، ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا، قيل: وكيف يكون ذلك يا أبا محمد؟ قال: يكون ساجداً عند الله وقلبه مصغ إلى هوى، ومشاهد لباطل قد استولى عليه، وهذا كما قال لأن فيه انتهاك حرمة القرب وسقوط هيبة الرب تعالى، واعلم أنّ طول الصلاة عليك غفلة وقصرها سهو لأنها إذا طالت عليك دلّ على عدم الحلاوة ووجود الثقل بها وكبرها على جوارحك، وإذا قصرت عليك وخفّت دلّ على نقصان حدودها ودخول الغفلى والسهو فيها، فالنسيان قصرها، والاستقامة في الصلاة أن لا تطول عليك لوجود الحلاوة، ولذة المناجاة، وحسن الفهم، واجتماع الهمّ، ولا تقصر عليك لتيقظك فيها، ورعايتك حدودها، وحسن قيامك بها؛ وهذه مراقبة المصلين ومشاهدة الخاشعين.
ذكر أحكام الخواطر في الصلاة
وما ذكر به العبد في الصلاة من الخير فليسارع إلى فعله فذلك من أحبّ الأشياء إلى الله تعالى لأنه أذكره إياها في أحبّ المواطن إليه، وما ذكر به من المكروه والممقوت إليه من المعتاد والمستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو الذي يبعده من قرب الله سبحانه وتعالى، وتذكيره إياه في محل القرب، توبيخاً له وتقريراً، وقد يكون عتباً وتنبيهاً، فترك ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، ويدل على حسن الاستجابة له؛ وهو مسلك طريقه إلى الله تعالى وما خطر به من خاطر تمنٍّ أو هوى أو ذكر بهمة ما يأتي أو ما قد مضى، فإنّ ذلك وسوسة إليه من عدوه حسداً له ليقطعه بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن من أركان الصلاة ويشغل قلبه عن الوقوف في المناجاة، بما يضرّه عما ينفعه ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصلاة ما يوجبه الذكر من تدبير أو تعظيم أو حمد أو دعاء أو استغفار، وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبير شأنه من المناجاة، فذلك من قبل النفس وفكرها بما توسوس به من أمور الدنيا، فأما إن خطرت همة محظورة أو فكرة في معصية مأزورة؛ فهذا هو الهلاك والبعد، يكون عن وصف النفس الأمارة باستحواذ العدوّ المغوي؛ فهو علامة الإبعاد، والحجاب دليل المقت، والإبعاد والإعراض، فإذا ابتلي في صلاته بهذه المعاني فقد اختبر بذلك فعليه أن يعمل في نفيه مع نفس بدوّه، ولا يمكنه من الظهور من قلبه فيملكه، ولا يصغي إليه بعقله فيستولي عليه، ولا يحادثه ولا يطاوله فيخرجه من حدّ الذكر واليقظة إلى مسامرة الجهل والغفلة، وكل عمل محظور فالهمة به محظورة وفيه نقص، وكل عمل مباح فالهمة به مباحة ونفيها فضيلة، وما خظر على قلبه من الخيرات المتأخر فعلها فليعقد النية بذلك، فإنه قد ذكر به وأريد منه، ثم ليمض في صلاته ولا يشتغل بتدبيره؛ كيف يكون؟ ومتى يكون؟ أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان فيفوته الإقبال في الحال بتدبير شأنه في المآل؛ وهذا هو استراق من العدوّ عليه وإلقاء من خدوعه إليه، فإن جاهد هذا المصلّي نفسه عن مسامرة الفكر وقابل عدوّه في قطع وسوسة الصدر، كان مجاهداً في سبيل الله تعالى، مقاتلاً لمن يليه من أعداء الله تعالى، له أجران: أجر الصلاة للتقرب إلى الكريم، وأجر المصارمة والمحاربة لعدوّه الرجيم.
وقد كان الأقوياء من المؤمنين، أهل الغلظة على الأعداء والتمكين، إذا ابتلوا بداخل يدخل عليهم في الصلاة من الأسباب، يخرجهم عن المشاهدة فيها عملوا في قطع ذلك الشيء وإبعاده من أصله، إذ كان سبب قطعهم وإبعادهم من قربهم، فيستخرج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيها، فيكون ذلك إحساناً من الله إليهم ومريداً منه لهم؛ وهذا أحد ما زهد لأجله الزاهدون في الدنيا لتصفو قلوبهم من الأسباب فتخلص أعمالههم من الوسواس بالاكتساب ومن ذلك ما بلغنا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نزع الجبة التي كانت عليه في الصلاة لما نظر إلى علمها وقال: ألهتني هذه في الصلاة يعني شغلتني، ونظر إلى شراك نعله في الصلاة وكان جديداً، فأمر أن ينزع منها ويعاد لها الشراك الخلق، وكان قد احتذى نعلاً فأعجبه حسنها فسجد وقال: تواضعت لربي كيلا يمقتني، ثم خرج بها فدفعها إلى أوّل سائل لقيه، ثم أمر عليّاً أن يشتري له نعلين سبتيين جرداوين فلبسهما.
وكان الضعفاء من المؤمنين يعملون في نفيه وترك مساكنته ومحادثته في الحال لقوادح اليقين في إيمانهم ولسرعة التيقظ في قلوبهم؛ لأن الآفات تدخل من مكان الهوى وتمكّن الأعداء، ومكان الهوى وقوّة العدوّ لطول الغفلة وعدم حلاوة الطاعة لاتساع النفس في الشهوات وقوة سلطانها على الصفات واتساع النفس وقوة صفتها لضيق القلب، وضعف اليقين إذ لو قوي يقين العبد لانشرح صدره ولأطفأ نور يقينه ظلمة هواه، ولاندرجت النفس في القلب اندراج الليل في النهار، ولأسقط مكانه من الشهادة تمكن أعدائه والعادة، ولعلم يقيناً أنّ ما هو فيه من الذكر والصلاة أنفع له وأحمد عاقبة مما تفكر فيه من عاجل دنياه، فيشتغل حينئذ بما هو فيه له من الذكر عمّا هو عليه من سوء الفكر، وليس بعد هذين المقامين حال ينعت ولا يمدح بشيء، وما قدح في قلبه من فهم الخطاب وتدبر معاني الكلام والإيقان على المقصد والمراد فهو تعليم من الله تعالى وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التلاوة وعلامة الإخلاص في المعاملة وبركة التدبر، دليل القبول والشكر لحسن الخدمة، فليأخذ من ذلك ما عفا ويغترف منه ما صفا، ولا ينتظره ولا يتمناه ولا يتبعه بعد انصرافه بالفكر في معناه، فيسترق العدوّ عليه السمع ويلقي إليه الوسوسة ويطمع فيه بالغرة ويدخل عليه من باب الأمنية، لأنه قد قرن الأماني بالإضلال؛ فهي مواعيد الكذب للإبطال، ألم تسمع إلى ربك تعالى كيف أخبرك عنه في قوله تعالى: (وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمنِّيَنَّهُمْ) النساء: 119، ثم قال في مثله: (وَعِدْهُمْ وَشَارِكْهُمْ في الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً) الإسراء: 64، ثم استثنى عباده المسلطين عليه بسلطانه، الغالبين له بآياته، فلم يصل العدو إليهم لمواصلته لهم وتوكّلهم عليه بوكالته إياهم، تنتظم هذه المعاني في قوله تعالى: (إنَّ عِبَادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكيلاً) الإسراء: 65، وقوله تعالى: (وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُما الغَالِبُونَ) القصص: 35، مع قوله تعالى: (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلى الَّذينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) النحل: 99.
وللعبد في التفكّر والتدّبر لما يستقبل من كل كلمة شغل عمّا فات مما كان عمله، وله في الشغل في الحال اقتطاع بما قد فهمه وما فهمه من غير ما يتلوه فاستدل به على ما سواه مما يعينه ويحتاج إليه؛ فهي أبواب من الفطنة تفتح له فيكون التكلم مفتاحها، ثم يخرج العبد إلى سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب، فليعرف بذلك ما عرف وليقف من ذلك على ما عليه وقف وما تفكر فيه من غير تدبر التلاوة، أو شغل به من غير فهم المتلوّ فهو حجاب له من الفهم وقطع له عن خالص العلم فليقطع ذلك، والتمام في التلاوة أن يتدبر التالي باطن الكلام، ويتفكرّ في غوامض الخطاب، ويوقف قلبه على معاني المراد، ويعمل فكره في تذكر الموصل والترداد، فإن الكلام عزيز من عزيز، ولطيف من لطيف، وحكيم من حكيم، وعلى من على ظاهره سهل قريب، وباطنه بحر عميق، يقول السامع إذا عقله قد فهمته، لتجلي فحواه، فإذا شهده كأنه ما سمعه لدقيق معناه يحسب العاقل أنه قد عرفه لظهور بيانه وتفصيل حكمته، فإذا عرف المتكلم به كأنه ما عقله لعمق بحاره وسعة أقطاره قد اغترّ به قوم لما سمعوا بيانه فادّعوا أنهم يحسنونه، وخدع به آخرون لما عقلوا أمثاله فطلبوا غيره وسألوا أبداله، وأصغى آخرون إلى سمعه فادّعوا فهمه فأكذبهم الصادق، وعزلهم عن سمعه، ثم أخبرنا بجميع ذلك عن جهلهم، وعجبنا من جراءتهم، فقال في وصف الأولين: ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذا) الأنفال: 31، (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ) يونس: 15.
وقال في نعت الآخرين: (يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ) الشعراء: 223، (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) الشعراء: 212، (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ) الأنفال: 21، ثم وصف من أسمعه إياه وأفهمه معناه من الجنّ الذين هم أسد قوة من الأنس وأعظمهم وصفاً فقالوا: (إنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً) الجنّ: 1 (يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ) الجنّ: 2، فهؤلاء ممن عقله فمدحم بفهمه وأخبر عن صاحب التنزيل بمثله فقال: (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسخرُونَ) الصافات: 12، أي عجبت من القرآن وتفصيله وتنزيله، ويسخر منه الجاهون، فإن فتح للتالي بالتلاوة عين نفس المتلّو باب الفكر في معاني العظمة والقدرة، وكشف له بواسطة الكلام مشاهدة ما كان علمه من وعد الآخرة وعيدها فله أجران، من حيث كان منه عملان: الفكرة والصلاة، وهذا كله لعموم المؤمنين مزيد، وهو بذلك للخصوص من المقرّبين دون ذلك إلاّ ما وجهوا به من طوالع الغيوب، وأطلعوا عليه من مطالع سرائر المحبوب، فكوشفوا به من بوادي اليقين من العزة والجبروت والإجلال والرهبوت، فأهجم عليهم من غير تفكّر منهم ولا تدّبر مما استعملهم به، واضطرهم إلى مشاهدته، القدير، فأخرس ألسنتهم عن المقال، وعقم عقولهم عن المجال، وأغنى قلوبهم عن الطلب، ولم يوكل إلى فكرهم بنظر إلى سبب، بل من غير تعمّل منهم لتكييفه ولا روية ولا اختيار لماهيته، ثم يجاوزونه إذا أخذ منهم حقه وأدركوا به نصيبهم إلى العالم الأكبر، فيقفون بين يديه ويحطون عنده، ولا يقفون مع المشاهدة طرفة عين، ولا يسكنون إليها خطرة قلب لئلا يقطعهم البيان عن المبين، ولا يشغلهم الخبر عن اليقين، ولا يحجبهم الشهادة عن الشهيد ولا يحسبهم البادئ العائد عن المبدئ المعيد؛ بل قد أشرف بهم على المراد فأسقط عنهم التشرّف وأذهلهم عن الاعتراف والتعريف بما ناداهم به من التعرّف، واقتطعهم العيان فأغناهم عن الانقطاع، وتقطعوا بالمفصل فأنساهم الانتفاع، وتوصّلوا بالموصل فأطلعهم عليه، وكان لهم حاملاً إليه ودليلاً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة الأقوياء بالقوى، الأغنياء بالغنى، الواجدين للموجد، الفاقدين للموجد، الذاكرين بذاكر، الصابرين بصابر ولا ينبغي للمصلي أن يدخل في صلاته حتى يقضي نهمته، ويفرغ من حاجته، ولا يبقى عليه ما يزعج قلبه ويفرّق همّه ليفرغ قلبه في صلاته، ويجتمع همّه في وقوفه، ويصحو عقله لفهمه، ويواطئ قلبه قيله ويقبل على المقبل عليه بمعقوله؛ وهذا يؤمر به القضاء عن مجاهدة الأعداء والمرضى عن مسابقة الأولياء.
وقد روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المؤمن القويّ أحبّ إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وقد قال الله تعالى: (لاَ يَسْتَوي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولي الضَرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ) النساء: 95، إلى قوله: (فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدينَ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدينَ دَرَجَةً) النساء: 95، مع قوله: (وَكُلاًّ وَعَد اللهُ الحُسْنَى) النساء: 95.
شرح ثالث ما بني الإسلام عليه وهو
الزكاة
كتاب الزكاة
فأما فرائض الزكاة فأربع: الحرية، وصحة الملك، ووجود النصاب؛ وهو مائتا درهم وعشرون ديناراً، واستكمال الحول وهو من شهر إلى مثله.
ذكر فضائل الصدقة
وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المنفقون
روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ليس في المال حقّ سوى الزكاة، وأنّ جماعة من التابعين كانوا يذهبون إلى أنّ في المال حقوقاً غير الزكاة، منهم: إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون أنّ في المال حقوقاً سوى الزكاة؛ ومنهم: الشعبي سئل: أفي المال حقّ سوى الزكاة؟ قال: نعم، أما سمعت قوله تعالى: (وَآتَىْ المَالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُربى) البقرة: 177 الآية، ومنهم: عطاء ومجاهد، وقد كان المسلمون يرون المساواة والفرض والقيام بمؤن العجزة من أنفسهم وأهلهم من المعروف والبرّ والإحسان، وأنّ ذلك واجب على المتّقين وعلى المحسنين من أهل اليسار والمعروف، وكذلك مذهب جماعة من أهل التفسير أنّ قوله عزّ وجلّ: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) البقرة: 3، وقوله: (وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) البقرة: 254، مأمور به، وأنّ ذلك غير منسوخ بآية الزكاة، وأنه داخل في حقّ المسلم على المسلمين، وواجب بحرمة الإسلام ووجود الحاجة، فمن فضائل الزكاة وأن يخرجها في أول ما تجب عليه، وأن يقدمها قبل وجوبها، إذا رأى لها موضعاً يتنافس فيه، ويغتنم خوف فوته من غاز في سبيل الله عزّ وجلّ، أو في دين مطالب، أو جهاد وغزو، أو إلى رجل فقير فاضل طرأً في وقته، أو أنّ سبيل غريب كان تقدمتها إلى هؤلاء وأمثالهم أفضل وأزكى، لأنه من المسارعة إلى الخير، ومن المعاونة على البرّ والتقوى، وداخل في التطوّع بالخير وفعله الذي أمر به، ولا يأمن الحوادث إذ في التأخير آفات، وللدنيا نوائب وعوائق، وللنفس بدوات، وللقلوب تقليب، وإنّ جعل رأس الحول أحد الشهرين كان أفضل، فإنّ في هذين خاصية من الفضائل ليست في غيرهما، فأما شهر رمضان فإن الله تعالى خصّه بتنزيل القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وجعله مكاناً لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام وشرّفه بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام.
وقد كان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان، وقد رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسنداً وأما ذو الحجة فإنّا لا نعلم شهراً جمع خمس فضائل غيره؛ هو شهر حرام وشهر حج وفيه يوم الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات؛ وهي العشرة، والأيام المعدودات: وهي أيام الشريق التي أمر الله تعالى بذكره فيها، وأفضل أيام في شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل أيام في شهر الحجة العشر الأُوَل، وقد استحب بعض أهل الورع أنّ يقدم في كل سنة بشهر لئلا يكون مؤخراً عن رأس الحول، لأنه إذا أخرج في شهر معلوم ثم أخرج القابل في مثله، فإن ذلك الشهر يكون الثالث عشر؛ وهذا تأخير، فقالوا: إنه إذا أخرج في رجب فليخرج من القابل في جمادى الآخرة ليكون آخر سنته بلا زيادة، وإذا أخرج في رمضان فليخرج من قابل في شعبان على هذا لئلا يزيد على السنة شيئاً؛ وهذا أحسن، وليتق أن يكون مخرجاً للفرض في كل شهر، ثم أن يخرجها طيبة بها نفسه، مسروراً بها قلبه، مخلصاً لربه، مبتغياً بها وجهه لغير رياء ولا سمعة ولا تزيّن ولا تصنّع، لا يحبّ أن يطلع عليها غير الله عزّ وجلّ، ولا يرجو في إعطائها ولا يخاف في منعها سواه، وليكن ناظراً إلى الله تعالى، عارفاً بحسن توفيقه له، وأن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه ولا ينتقصه بقلبه ولا يزدريه، وليعلم أنّ الفقير خير منه، لأنه جعل طهرة وزكاة ورفعة ودرجة في دار المقام والحياة، وأنه هو قد جعل سخرة للفقير وعمارة لدنياه، كما حدثنا بعض العارفين قال: أريد مني ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة، فجال في نفسي من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه تنقطع إلينا وتتهمنا فيك علينا، أن نخدمك وليّاً من أوليائنا، أو نسخّرلك منافقاً من أعدائنا، وأن يسرّ ذلك إلى الفقير سرّاً ولا يذكر ذلك، فقد جاء في تفسير قوله تعالى: (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ والأَذَى) البقرة: 264، قال: المنّ أن تذكرها، والأذى أن تظهرها، وحدثت عن بشر بن الحارث قال: قال سفيان: من منّ فسدت صدقته، قيل: كيف المنّ يا أبا نصر؟ قال: أن تذكره أو تحدث به، وبعضهم يقول: المنّ هو أن تستخدمه بالعطاء، والأذى أن تعيّره بالفقر وقيل: المنّ أن يتكبر عليه لأجل أن يعطيه، والأذى أن تنهره أو توبخه بالمسألة، وفي الحديث: أفضل الصدقة جهد المقلّ إلى فقير في سرّ، وقال بعض العلماء: ثلاثة من كنوز البرّ منها: إخفاء الصدقة، وقد روينا مسنداً من طريق؛ وذلك أسلم لدينه وأقلّ لآفاته وأزكى لعمله.
وقد روينا في الخبر: لا يقبل الله من مسمع ولا مراءٍ ولا منّان، فجمع بين المنّة والسمعة، كما جمع بين السمعة والرياء وردّ بهن الأعمال؛ فالمسمع الذي يتحدث بما صنعه من الأعمال ليسمعه من لم يكن رآه، فيقوم ذلك مقام الرؤية، فسوّى بينهما في إبطال العمل لأنهما عن ضعف اليقين، إذ لم يكتف المسمع بعلم مولاه، كما لم يقنع المرائي بنظره فأشرك فيه سواء وألحق المنّان بهما لأن في المنة معناهما من أنه ذكره فقد سمع غيره به، أو رأى نفسه في العطاء ففخر به وأدّاه سرّاً، فإن أظهره نقل من السرّ وكتب في العلانية، فإن تحدث به محي من السرّ والعلانية فكتب رياء، فلو لم يكن في إظهار الصدقة مع الإخلاص بها إلاّ فوت ثواب السرّ لكان فيه نقص عظيم، فقد جاء في الأثر: تفضّل صدقة السرّ على صدقة العلانية سبعين ضعفاً، وفي الحديث المشهور: سبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: أحدهم رجل تصدّق بصدقة فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه، وفي لفظ آخر: فأخفى عن شماله ما تصدّقت به يمينه؛ وهذا من المبالغة في الوصف وفيه مجاوزة الحدّ في الإخفاء، أي يخفي من نفسه فكيف غيره؟ وقد تستعمل العرب المبالغة في الشيء على ضرب المثل والتعجّب وإن كان فيه مجاوزة للحدّ، من ذلك أنّ الله عزّ وجلّ ذّم قوماً ووصفهم بالبخل وبالغ في وصفهم فقال تعالى: (أَمْ لَهَمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ فَإِذاً لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً) النساء: 53، والنقير لا يريده أحد ولا يطلبه ولا يعطاه، لأنه هو النقطة التي تكون على ظهر النواة، منه منبت النخلة وفيه معنى أشدّ من هذا وأغمض أنه لما قال: فأخفى عن شماله، كان لهذا القول حقيقة في الخفاء فهو أن لا يحدّث نفسه بذلك ولا يخطر على قلبه، وليس يكون هذا إلاّ أن لا يرى نفسه في العطاء أصلاً ولا يجري وهم ذلك على قلبه، كما يقول في سرّ الملكوت: إنّ الله تعالى لا يطلع عليه إلاّ من لا يحدّث نفسه به، بمعنى أنه لا يخطر على قلبه، ولا يذكره، ولا يشهد نفسه فيه شغلاً عنه بما اقتطع به، وبأنه لا يباليه؛ فعندها صلح أن يظهر على السرّ، فإن لم يمكنك على الحقيقة أن تخفي صدقتك عن نفسك فاخف نفسك فيها، حتى لا يعلم المعطى أنك أنت المعطي؛ وهذا مقام في الإخلاص، فإن أظهرت يدك في الإعطاء فاخفها سرّاً إلى المعطي؛ هذا حال الصادق، فقد كان بعض المخلصين يلقي الدرهم بين يدي الفقير، أو في طريقه، أو موضع جلوسه، بحيث يراه وهو لا يعلم من صاحبه، وبعضهم كان يصرّ ذلك في ثوبه وهو نائم فلا يعلم من جعله، وقد رأيت من يفعل ذلك، فأما من كان يوصل إلى الفقير على يد غيره ويستكمه شأنه فلا يحصى ذلك من المسلمين.
وفي الخبر: صدقة السرّ، وقيل صدقة الليل، تطفئ غضب الرب تعالى، وقد أخبر الله تعالى أنّ الإخفاء أفضل، ومعه يكون تكفير السيّئات، فقال سبحانه وتعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ) البقرة: 271، فإن أظهر مسكين نفسه، وكشف نفسه للسؤال، وآثر التبذل على الصون والتعفّف؛ فلا بأس أن تظهر معروفك إليه، فإن أظهرت زكاتك إرادة السّنة، والافتداء بك، والتحريض على مثل ذلك من غيرك لينافسك فيه أخوك، فيسرع إلى مثله أمثالك منهم فحسن؛ وذلك من التحاض على إطعام المسكين، وقد ندب الله إليه وقد قيده في قوله تعالى: (وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرَّاً وَعَلانِيَةً) الرعد: 22، قيل سرّاً التطوّع، وعلانية الصدقة المفروضة، وكذلك قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً) المزمل: 2،، القرض الحسن هو التطوّع، وقد قيل الحلال، كما قال: (وَرَزَقَنِي مِنْهُ رزْقاً َحسَناً) هود: 88 أي حلالاً، وقد قال تعالى: (إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) البقرة: 271، فمدح المبدي بنعم إلاّ أنّ ذلك لا يحسن إلاّ إلى من أبدى نفسه كأنه هذا السائل الذي يسأل بلسانه وكفّه، وقوله تعالى: (وَإنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ) البقرة: 271 الآية، كأنها للمستخفف بالمسألة وهي لخصوص الفقراء لا يظهرون نفوسهم بما يمنعهم الحياء والتعفّف، فمن أظهر نفسه فأظهر إليه، ومن أخفاها فأخفي له، ومن ذلك كشف عورة الفاسق: إنما حرم عليك أن تظهر عورة من يخفي عنك نفسه ويستتر، فإذا أظهر نفسه بها وأعلن فلا بأس أن يظهر عليه كما جاء في الخبر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وينبغي أن يجعل صدقته من أفضل ما يحبه من المال، ومن جيد ما يدخر ويقتني وتستأثر به النفوس، فيؤثر مولاه به كما أمره، وضرب المثل له فقال: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة: 267 ثم قال: (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخِبيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) البقرة: 276، وقال في ضرب المثل بالعبيد: ولستم بآخذيه إلاّ أن تغمضوا فيه، أي لا تقصدوا الرديء فتجعلوه لله تعالى، ولو أعطى أحدكم ذلك لم يأخذه إلاّ على أغماض أي كراهية وحياء، ولا يجعل ما لله تعالى دون ما يستجيد لنفسه، أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته أو يأخذه من غيره، أو مالا يستحسن أن يهديه لنبيل من العبيد، فتكون قد آثرت نفسك أو عبداً مثلك على مولاك فإن هذا من سوء الأدب ولا يقوم سوء أدب واحد في معاملة بجميع المعاملات.
وقد روي في معنى قوله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً) البقرة: 245، قال: طيّباً، فإن الله تعالى طيّب لا يقبل إلاّ طيّباً، وفي حديث أبان عن أنس:
طوبى لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية، وفي الخبر: سبق درهم مائة ألف درهم، وقد تهدد الله تعالى قوماً جعلوا له ما يكرهون ووصفت ألسنتهم الكذب أنّ لهم الحسنى لا جرم فأكذبهم في قوله تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لله مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ألسِنَتُهُمُ الكَذِبَ أنَّ لَهُمُ الحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ) النحل: 62، أي حقاً لهم النّار، وفي الآية وقف غريب لا يعلمه إلاّ الحذّاق من أهل العربية تقف على لا فيكون نفياً لوصفهم أنّ لهم الحسنى، ثم يستأنف بجرم أنّ لهم النار، أي كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار، أي بجرمهم واكتسابهم، وإذا دعا لك مسكين عند الصدقة فأردد عليه مثل دعائه حتى يكون ذلك جزاء لقوله: وتخلص لك صدقتك وإلاّ كان دعاؤه مكافأة على معروفك، فقد كان العلماء يتحفظون من ذلك وهو أقرب إلى التواضع، ولا نرى أنك مستحق لذلك منه لما وصلته به، لأنك عامل في واجب عليك لمعبودك أو توفي للمعطي رزقه وما قسم له من تعبدك بذلك، وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفاً إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به ثم يردّان عليه مثل قوله، ويقولان: حتى تخلص لنا صدقتنا، وفعل ذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، ولا ينبغي أن تقتضي من الفقير الدعاء لك، أو تطالبه بذلك، أو تحبّ منه الثناء والمدح على ذلك، فإنه ينقص من الصدقة، وإذا كثر منك وقوي أحبطها، وإن كان عليه أن يدعو لك ويثني به عليك فإنما يعمل فيما تعبده مولاه به، وأمره به فلا يرى ذلك من حقك عليه، وإذا وصلت إلى الفقير معروفاً فبحسن أدب ولين جانب ولطف كلام وتذلل وتواضع.
وقد كان بعض الأدباء إذا أراد أن يدفع إلى فقير شيئاً بسط كفّه بالعطاء لتكون يد الفقير هي العليا، وبعضهم كان يضعها بين يديه على الأرض، ويسأله قبولها منه ليكون هو السائل، ولا يناوله بيده إعظاماً له؛ وهذا يدل على معرفة العبد بربه وحسن أدبه في عبادته، ومن أحبّ الثناء والذكر على معروفه كان ذلك حظه منه وبطل أجره، وربما كان عليه فضل من الوزر لمحبته الذكر والثناء فيما لله تعالى أن يفعله، وفي رزق الله لعبده الذي أجراه على يده، فإن تخلّص سواء بسواء فما أحسن حاله واستحب للفقير أن يخصّ ذا المعروف إليه بدعوات شكراً لما أولاه وتأدّباً وتخلقاً بفعل مولاه، لأنه قد جعله سبباً للخير وواسطة للبرّ إذ الله سبحانه وتعالى يشهد نفسه بالعطاء، ثم قد أثنى على عبده وشكر له في الإعطاء، فليقل طهّر الله قلبك في قلوب الأبرار، وزكّى عملك في عمل الأخيار، وصلّى على روحك في أرواح الشهداء؛ فذلك هو شكر الناس، والدعاء لهم، وحسن الثناء عليهم، ومن شكرهم أيضاًِ أن لا يذمهم في المنع، ولا يعيبهم عند القبض.
فذلك تأويل الخبر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى فإن فيه إثبات حكم الأواسط، واستعمال حسن الأدب في إظهار النعم والتخلّق بأخلاق المنعم، لأنه أنعم عليهم ثم شكر لهم كرماً منه، وكذلك في الخبر: العبد الموقن يشهد يد مولاه في العطاء، فحمد ثم شكر للمتّقين، إذ جعلهم مولاه سبب حمده، وطرقاً لرزقه.
في الخبر: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فأما شكر الله تعالى على العطاء فهو اعتقاد المعرفة أنه من الله تعالى، لا شريك له فيها، والعمل بطاعته بها، ومن فضل الصدقة أن يقصد بها الفقراء الصالحين الصادقين من أهل التصوّف والدين، ممّن يؤثر التستّر والإخفاء، ولا يكثر البث والشكوى، وممّن فيه وصف من أوصاف الكتاب للفقراء، الذين أحصروا في سبيل الله، أي حبسوا في طريق الآخرة لعيلة، أو ضيق معيشة، أو إصلاح قلب، أو قصور يد، لا يستطيعون ضرباً في الأرض، لأنهم مقصوصو الجناح، إذ المال للغني بمنزلة الجناح للطائر بماله حيث شاء من البلاد وينبسط في شهواته كيف شاء من المراد، والفقير محصور عن ذلك لا يستطيعه لقبض يده وقد رزقه، ومن هذا قوله تعالى: (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَاري سَوْءَاتِكُمْ وَريشاً) الأعراف: 26، قيل: المال، وقيل: المعاش، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف، فسمّى الله تعالى من لا يعرفهم بالفقر ولا يشهد وصفهم بالتقلّل، لظهور تعففهم عن المسألة، جاهلاً بوصف المؤمنين، ثم وكّد وصفهم وأظهر للخلق تعريفهم بياناً منه، وكشفاً لحالهم، إذ ستروها بالعفة، فقال: تعرفهم بسيماهم فالسيما هي العلامة اللازمة والخليقة الثابتة دون التحلي واللبسة الظاهرة، لا يسألون الناس إلحافاً، أي بهذه العلامة أيضاً تعرفهم إن أشكلوا عليك، فإنهم لا يسألون عفة وقناعة إلحافاً، لا يلتحفون بالأغنياء ولا يلاحفون أهل الدنيا تملّقاً وضراعة؛ أي هم منفردون بأحوالهم، أغنياء بيقينهم، أعزّة بصبرهم، والإلحاف مشتق من اللّحاف الذي يلتحف به فيلزم الجسم، فقال: ليسوا ممن يفعل ذلك، لا يلتحفون الأغنياء كاللحاف ولا يلتحفون المسألة إلزاماً كالصنعة، كما يلتحف بالثوب، فاحرص أن يكون معروفك فيمن فيه هذه الأوصاف أو بعضها، فيزكو عملك ويشكر فعلك، والأفضل في المعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غيرهم من الأجانب.
فقد روي عن علي رضي الله عنه: لأَن أصلَ أخاً من إخواني بدرهم أَحبّ إلي من أن أتصدّق بعشرين درهماً، ولأَن أصلَه بعشرين درهماً أَحبّ إليّ من أن أتصدّق بمائة درهم، ولأَن أصلَه بمائة درهم أحبّ إليّ من أن أعتق رقبة، ولأنّ الله تعالى ضمّ الأصدقاء إلى الأقارب فكان فضل الصدقة على الأقارب دون البعيد كفضل الصدقة على القربة دون الأباعد، لأنه ليس يعد صلة الرحم في معناها أفضل من صلة الإخوان، وكان بعض السلف يقول: أفضل الأعمال صلة الإخوان وليقصد ببرّه من إذا دفع إليه العطاء حمد الله تعالى وشكره، ورأى النعمة منه، ولم ينظر إلى واسطة في نعمة، فإن هذا أشكر العباد لله تعالى لأن حقيقة الشكر لله بشهود النعمة منه والإخلاص بحسّ المعاملة له، وأن لا يشهد في النعمة بالعطاء والنعمة بالعمل الصالح سواه.
وفي وصية عليّ رضي الله تعالى عنه: لا تجعل بينك وبين الله تعالى منعماً، وأعدد نعمة غيره عليك مغرماً، فليقدم مثل هذا على من لو أعطاه ورزقه أثنى عليه ومدحه وشهده فيه فحمده، فيكون قد حمد غير الذي أعطاه، ونظر إلى سواه، وذكر غير الذي ذكره بالعطاء، لأنّ الذي يحمد الله ويشكره ويثني عليه برزقه ويذكره يرى أنّ الله سبحانه وتعالى هو المنعم المعطي، فينظر إليه من قرب؛ فيقين هذا بالله أنفع لصاحب المعروف عند الله من دعاء الآخر المثنى، لأنه كان سبباً لنفع موقن فيكون واضعاً للشيء في حقيقة موضعه، ومدح الآخرة ودعاؤه له لأجل أنه يراه هو المعطي فينظر إليه فيمدحه، فضعف يقين هذا بربه أشّد على المنفق من دعائه له، إن كان ناصحاً لله تعالى في خلقه ولخلق الله تعالى فيه، إلاّ أن لا ينصح لمولاه لغلبة هواه على تقواه، وجهله بعائد النفع له في عقباه، فنقص هذا حينئذ بمقامه من التوحيد أعظم من زيادته بصدقته، على أنه لا يؤمن الاستشراف من الآخر إليه، والاعتياد منه، والطمع فيه، بكلام يحبط عمله، وأيضاً فإنه إذا رآه في العطاء فإنه يراه عند المنع فيذمه ويقع فيه، فيكون هو سبب حمله عليه، وهو آمن مطمئن لهذا كله مع الموقن المشاهد، وفي الخبر أن الصدقة تقع بيد الله تعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها في يد السائل، فالموقن يأخذ رزقه من يد الله تعالى فهو لا يعبد إلاّ الله تعالى، ولا يطلب منه إلاّ كما أمره في قوله تعالى: (فَابْتَغُوا عِنْدَ الله الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ) العنكبوت: 17، ووجه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بعض الفقراء بمعروف، وقال للرسول: احفظ ما يقول، فلما أوصله إليه قال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره، ثم قال: اللهم إنك لم تنسى فلاناً، يعني نفسه، فاجعل فلاناً لا ينساك، فأخبر الرسول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك فسرّ به وقال قد علمت أنه يقول ذلك.
وقد روي هذا عن عمر وعن أبي الدرداء مع جرير رضي الله عنهم وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل: تب، فقال: أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عرف الحق لأهله، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك: نحمد الله ولا نحمدك، فسرّه ذلك وقال لها أبو بكر لما نزل تحصينها وبراءتها: قومي فقبّلي رأس رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: والله لا أفعل ولا أحمد إلاّ الله، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دعها يا أبا بكر، وفي لفظ آخر أنها قالت لأبي بكر: نحمد الله ولا نحمدك، ولا نحمد صاحبك، فلم ينكر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك بل سرّه وأمر أباها بالكفّ عنها، وقد جعل الله تعالى من وصف الكافرين أنهم إذا ذكر الله وحده في شيء انقبضت قلوبهم، وإذا ذكر غيره فرحوا، وجعل من نعتهم أنهم إذا ذكر توحيده وإفراده عند شيء عصوا ذلك وكرهوه، وإذا أشرك غيره في ذلك صدقوا به فقال تعالى: (وَإذَا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمَأَزّتْ قُلُوبُ الَّذينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دُونِهِ إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) الزمر: 45، وقال أيضاً: (ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) غافر: 12، والكفر: التغطية، (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا) غافر: 12، والشرك: الخلط، أن يخلط بذكره ذكر سواه، ثم قال: (فَالحُكْمُ للهِ العَلِيِّ الكَبيرِ) غافر: 12، يعني لا يشركه في حكمه خلق، لأنه العلي في عظمته، الكبير في سلطانه، لا شريك له في ملكه وعطائه ولا ظهير له من عباده، ففي دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب أنّ المؤمنين إذا ذكر الله تعالى بالتوحيد والإفراد في الشيء انشرحت صدورهم، واتسعت قلوبهم، واستبشروا بذكر الله تعالى وتوحيده، وإذا ذكرت الأواسط والأسباب التي دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم؛ وهذه علامة صحيحة فاعرفها من قلبك ومن قلب غيرك لنستدلّ بها على حقيقة التوحيد في القلب، أو وجود خفيّ الشرك في النفس، إن كنت عارفاً، وينبغي أن يجعل صدقته من أجل ما يقدر عليه وأطيبه في نفسه وجهده، فإنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيباً، وزكاء الصدقة ونماؤها عند الله تعالى على حسب حلّها ووضعها في الأخص الأفضل من أهلها، وينبغي أن يستصغر ما يعطي، فإن الاستكثار من العجب، والعجب يحبط الأعمال، قال الله تعالى: (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) التوبة: 25، ويقال: إنّ الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله تعالى، وإنّ المعصية كلما استعظمت صغرت عند الله تعالى.
وعن بعض العلماء: لا يتمّ المعروف إلاّ بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره، وقد كانوا يدفعون في الزكاة المئين، وفي التطوّع الألوف، وكانوا يصلون الفقير بما يخرجه من حدّ الفقر، ومن الحاجة والضرّ إلى حدّ الكفاية والغنية، ويبقى لهم فضل، وعلى هذا تأويل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خير الصدقة ما أبقت غني؛ أي تكفي الفقير لوقته، ويبقى له غنية واستغناء لوقت ثانٍ تستقلّ به عن المسألة والتشرّف، فيكون كأنه عمل عملاً ثانياً للمعطي غير عمله الأول بالعطاء؛ وهذا أحد تأويل الخبر، وقد وصف الله تعالى أهل الحاجة بأوصاف خمسة فرقها في كتابه فقال سبحانه وتعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُوم) الذاريات: 19، وقال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ) الحج: 36، وقال عزّ وجلّ: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقيرَ) الحج: 28، فأما السائل فهو الذي يسأل بكفه ويظهر السؤال بلسانه، وأما المحروم فهو المحارف الذي حارفه الرزق أي انحرف عنه، فقد حرمه، وقيل: هو الذي لا معلوم له ولا كسب، قد حرم التصرف والتعيش، وأما القانع فهو الذي يقعد في بيته ويقنع بما آتاه الله من غير طلب ولا تعرض، وقيل: إنّ القنوع هو وصف من أوصاف المسألة من غير إلحاف ولا إلحاح، وهو اسم من الأضداد يكون القنوع العفّة والكف ويكون المسألة، وأما المعتّر فهو الذي يعرض بالسؤال ولا يصرح تحمله الحاجة على التعريض، ويوقفه الحياء عن التصريح، وأما البائس فهو الذي به بؤس وشدة من مرض أو برد أو عضب وزمانة، ثم إنّ الله تعالى قد فضل بين الفقراء والمساكين فقال أهل العلم: الفقير الدي لا يسأل، والمسكين السائل، وقيل: الفقير المحارف وهو المحروم، والمسكين الذي به زمانة، واشتقاقه من السكون، أي فقد أسكنه الفقر لما سكنه وأقلّ حركته؛ وهذه أوصاف، يقال: قد تمسكن الرجل وسكن، كما يقال: تمدرع وتدرّع إذا لبس مدرعة، فكذلك الفقير إذا كانت المسألة لبسة له، وأهل اللغة مختلفون فيهما، قال بعضهم: المسكين أسوأ حالاً من الفقير لأن الله تعالى قال: (أَوْ مِسْكيناً ذَا مَتْرَبَةٍ) البلد: 16، فهو الذي لا شيء له، قد لصق بالتراب من الجهد، وذهب إلى هذا القول يعقوب بن السكيت ومال إليه يونس بن حبيب، وقال: قلت مرة لأعرابي: أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين أسوأ حالاً من الفقير، وبعضهم يؤوله على غير هذا فيقول: ذا متربة من الغنى، يقال: أترب الرجل إذا استغنى فهو مترب من المال؛ أي قد كان مترباً غنياً من أهل النعم، ثم افتقر فهذا أفضل من أعطى.
وقال بعض أهل اللغة في قوله تعالى: ذا متربة، دليل أنّ المسكين أسوأ حالاً، قال: إنّ الله تعالى لما نعته بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا النعت، ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت ثوباً ذا علم نعته بهذا النعت، لأنه ليس كل ثوب له علم، فكذلك المسكين الأغلب عليه أن يكون له شيء، فلما كان هذا المسكين مخالفاً لسائر المساكين بين الله تعالى نعته؛ وبهذا المعنى استدل أهل العراق من الفقهاء أنّ اللمس هو الجماع بقوله تعالى: (فَلَمَسُوهُ بِأيْديهمْ) الأنعام: 7، أنّ اللمس يكون بغير اليد وهو الجماع، فلما قال: بأيديهم خصّ به هذا المعنى فردّوه على من احتج به من علماء الحجاز في قولهم: اللمس باليد، وقال آخرون: بل الفقير أسوأ حالاً من المسكين، لأن المسكين، يكون له الشيء والفقير لا شيء له، قال الله تعالى في أصحاب السفينة: (فَكَانَتْ لِمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ) الكهف: 69، فأخبر أنّ لهم سفينة وهي تساوي جملة وقالوا: سمي فقيراً لأنه نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر فهو مأخوذ من فقار الظهر، ومال إلى هذا القول الأصمعي وهو عندي كذلك من قبل أنّ الله تعالى قدمه على الأصناف الثمانية التي جعل لهم الصدقة فبدأ به فدل على أنه هو الأحوج فالأحوج أو الأفضل فالأفضل، وقال قوم: الفقير هو الذي يعرف بفقره لظهور أمره، والمسكين هو الذي لا يفطن له ولا يؤبه به لتخفيه وتستّره، وقد جاءت السنّة بوصف هذا، في الخبر المروي: ليس المسكين الذي ترده الكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه.
وقد قال بعض الحكماء في مثل هذا، وقد سئل: أي الأشياء أشدّ؟ فقال: فقير في صورة غني، وقيل لحكيم آخر: ما أشد الأشياء؟ قال: من ذهب ماله وبقيت عادته، وقال الفقهاء: المسكين الذي له سبب ويحتاج إلى أكثر منه لضيق مكسب أو وجود عيلة؛ فهذا أيضاً قد وردت السنّة بفقره، وذكر فضله في الحديث الذي جاء أنّ الله يحبّ الفقير المتعفف أبا العيال ويبغض السائل الملحف، وفي الخبر الآخر: أنّ الله تعالى يحبّ عبده المؤمن المحترف؛ وكل هذه الأقوال صحيحة، فالأفضل أن توضع الزكاة في الأحوج فالأحوج، والأفضل فالأفضل، من أهل العلم بالله تعالى، وأهل المعاملة وأهل الدين لله، المنقطعين عن أهل الدنيا، المشغولين بتجارة الآخرة عن تجارات الدنيا، ثم في ذي العيال بقدر عياله بمقدار غناه عن حاجاته، فيكون له بعددهم أجور أمثاله من المنفردين إذ هم جماعة، وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها، وكذلك في السنّة، روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يعطي العطاء على قدر العيلة، ويعطي المتأهل ضعف ما يعطي العزب، ويعطي كل رجل على قدر أهل بيته، وحدثنا عن بعض هذه الطائفة قال: صحبنا أقواماً كان برّهم لنا الألوف من الدراهم انقرضوا وجاء آخرون كان برّهم لنا المئين، ونحن بين قوم صلتهم لنا العشرات نخاف أن يجيء قوم شر من هؤلاء، وقال بعض السلف: رأينا قوماً ما كانوا يفعلون، ونخاف أن يجيء قوم يقولون ولا يفعلون، وإن اتفق ذو دين في عيلة من مساكين فذلك غنيمة المتقين، وذخيرة المنفقين، والمعروف في مثله واقع في حقيقته، وسئل ابن عمر عن جهد البلاء ما هو؟ فقال: كثرة العيال وقلة المال.
وقد جاء في الخبر: لا تأكل إلاّ طعام تقيّ ولا يأكل طعامك إلاّ تقيّ، لأن التقي تستعين به على البرّ والتقوى فيشركه في قصده، وفي الخبر أيضاً: أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، وفي لفظ آخر: أضف بطعامك من تحبه لله تعالى، وينبغي للموقن أن يكون يفرح ويُسرُّ بقبول معروفه من الأتقياء، لأن ذلك عمله، إن لم يقبله منه عارف بالله تعالى وأحكامه، وقد ردّت عليه أعماله، فينبغي أن يحزن برّدها عليه إذ كان ذلك ردّاً من الله تعالى له، ومن وصل فقيراً بمعروف فردّه عليه فعظم الفقير في عينه فذلك يدل على جهل المعطي بربه، لأنه لو أخذها فأسقط منزلته عنده ثم أخرجها سرّاً إلى من هو أحوج إليها منه كان بذلك فاضلاً، ومن ردّ عليه فقير برّه فلم يحزنه ذلك أو سرّه، ذلك دل على ضعف نيته في الإخراج وقلة إخلاصه بمعروفه، لأن الصادق يسوءه ردّ معروفه إليه ويحزنه، وينبغي أن لا يتملك ذلك أنْ ردّه عليه بل يدفعه إلى فقير آخر، لأنه قد أخرجه لله تعالى، فلا يرجع فيه، والفقراء شركاء في العطاء يردّ عليهم من بعضهم إلى بعض، وكذلك إن أخرج صدقة باسم فقير بعينه ليعطيه إياها فصادف غيره فذكر من هو أحوج منه أو أفضل ووافق طالباً إليه في حق عليه فلا بأس أن يدفعها إلى من يدفعها إلى الثاني ما لم تخرج عن يده، أو يكون قد وعده بها، وكذلك إن دفعها إلى من يدفعها إلى فقير بعينه ثم رأى من أثر في قلبه فأخرج منه فله أن يسترجعها من المأمور ويدفعها إليه، ما لم يكن قد نفدها أو أعلمه بها، وينبغي أن يستبشر بقبول العارفين معروفه، لأن ذلك قبول من الله تعالى لعلمه، إذ كان العارف بالله تعالى وأيامه يتصرف عن الله تعالى في الأفعال، كما أنه ينطق عنه في المقال، وليس قبوله منه كقبول غيره ولا ردّه عليه كردّ غيره، إذ كان الشاهد فيه من الله سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد في غيره ولما هو إلى التوفيق والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء.
حدثني بعض إخواني: أنّ فقيراً بمكة ردّ على بعض الأغنياء معروفه فأخذ يبكي، فقال: أليس هذا عملي قد ردّ عليّ؟ قيل له: فإن غيره يقبله، فقال: من أين لي مثل هذه العين؟ وهذا كما قال، لأن المؤمن ينظر بعين اليقين ونور الله تعالى، فردّه عن الله تعالى، كما قال تعالى: (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) هود: 17، والجاهل يتصرف بهواه عن نفسه فردّه كقبوله، لأنه يأخذه لنفسه، ويرد بنفسه، والعارف إن أخذ فبرب، وإن ردّ فعن ربّ تعالى، وليزدد في عينه من قبل منه معروفه نبلاً وجلالة، ويعظم في عينه محبة ومهابة، لأنه قد أعانه على برّه وتقواه، وأكرمه بقبول جدواه، فليشهد ذلك نعمة من الله تعالى وإحساناً منه إليه، وعلى العبد أن يجتهد في طلب الأتقياء وذوي الحاجة من الفقراء ويبلغ غاية علمه بذلك، فإن قصر علمه ولم تنفذ فراسته ومعرفته في الخصوص استعان بعلم من هو أعلم منه، وأنفذ نظر، أو أعرف بالصالحين وأهل الخير منه، ممن يوثق بدينه وأمانته من علماء الآخرة، لا من علماء الدنيا، وعلماء الآخرة هم الزاهدون في الدنيا، الورعون عن التكاثر منها، فإن حبّ الدنيا غامض قد هلك فيه خلق كثير لم ينج منه إلا العلماء، ولم يسلم من الدنيا إلاّ المتحققون بالعلم واليقين؛ وهم المتقللون من الدنيا، وقد قال الله تعالى: (وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ) البقرة: 265، أي يقيناً، يعني أنهم يتثبتون في صدقاتهم أن لا يضعوها إلاّ في يقين يستروح إليه القلب وتطمئن به النفس، وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غيرهم فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء؟ فقال: لا أفعل بل أؤثر هؤلاء على غيرهم، قيل: ولم؟ قال: لأن هؤلاء همهم الله سبحانه وتعالى، فإذا طرقتهم فاقة تشتت همّ أحدهم فلأن أردّ همة واحد إلى الله تعالى أحبّ إليّ من أن أعطي ألفاً من غيرهم ممن همّه الدنيا، فذكر هذا الكلام لأبي القاسم الجنيد فاستحسنه، وقال: هذا كلام وليّ من أولياء الله تعالى، ثم قال: ما سمعت منذ زمان كلاماً أحسن من هذا، وبلغني أنّ هذا الرجل اختل حاله في أمر الدنيا حتى همّ بترك الحانوت فوجه إليه الجنيد بمال كان صرف إليه فقال: اجعل هذا في بضاعتك ولا تترك الحانوت، فإنّ التجارة لا تضرّ مثلك، ويقال: إنّ هذا الرجل كان بقّالاً ولم يكن يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه، وأما ابن المبارك رحمه الله تعالى فإنه كان يجعل معروفه في أهل العلم خاصة، فقيل له: لو عممت به غيرهم، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا اشتغل قلب العالم بالحاجة أو العيلة لم يتفرغ للعلم، ولا يقبل على تعليم الناس، فرأيت أن أعينهم وأكفيهم حاجاتهم لتفرغ قلوبهم للعلم، وينشطوا لتعليم الناس؛ هذا طريق السلف الصالح، والتوفيق من اللّّه تعالى للعبد في وضع صدقته في الأفضل كالتوفيق منه إطعام الحلال الذي في غيبه يوفقه لأوليائه ويستخرجه لهم من علمه كيف شاء بقدرته.
شرح رابع ما بني الإسلام عليه: وهو
الصيام
ذكر فرائض الصيام
اعتقاد الصوم إيجاباً لله تعالى عليه وقربة منه إليه، وإخلاصاً به له، وسقوط فرض عنه، وأن يجتنب الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني، وأن يتم الصيام إلى سقوط قرص الشمس، وأن لا ينوي في تضاعيف النهار الخروج من الصوم.
ذكر فضائل الصوم ووصف الصائمين
صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غضّ البصر عن الاتساع في النظر، وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم، أو الوزر، أو القعود، مع أهل الباطل، وحفظ اللسان عن الخوض فيما لا يعني جملة مما إن كتب عنه كان عليه وإن حفظ له لم يكن له، ومراعاة القلب بعكوف الهمّ عليه، وقطع الخواطر والأفكار التي كفّ عن فعلها، وترك التمني الذي لا يجدي، وكفّ اليد عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة، وحبس الرجل عن السعي فيما لم يؤمر به ولم يندب إليه من غير أعمال البرّ، فمن صام تطوّعاً بهذه الجوارح الست وأفطر بجارحتين: الأكل والشرب والجماع؛ فهو عند الله تعالى من الصائمين في الفضل لأنه من الموقنين الحافظين للحدود، ومن أفطر بهذه الست أو ببعضها وصام بجارحتين: البطن والفرج، فما ضيع أكثر مما حفظ؛ فهذا مفطر عند العلماء صائم عند نفسه، وقد قال أبو الدرداء: أيا حبذا نوم الأكياس كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم، ولذرّة من تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، ومثل من صام عن الأكل وأفطر بمخالفة الأمر مثل مسح كل عضو، فصلاته مردودة عليه لجهله، ومثل من أفطر بالأكل والجماع وصام بجوارحه عن النهي مثل من غسل كل عضو مرة واحدة وصلّى، فهو تارك للفضل في العدد إلاّ أنه مكمل للرضى بحسن العمل، فصلاته متقبلة لأحكامه للأصل وهو مفطر للسعة صائم في الفضل، ومثل من صام من الأكل والجماع وصام بجوارحه الست عن الآثام، كمثل من غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً، فقد جمع الفرض والفضل وأكمل الأمر والندب؛ فهو من المحسنين، وعند العلماء من الصائمين، وهذا صوم الممدوحين في الكتاب الموصوفين بالذكر من أولي الألباب، ومن فضائل الصوم أن يجتنب من حظوظ هذه الجوارح الشبهات من الأشياء وفضول الحلال، ويرفض الشهوات الداعية إلى العادات، ولا يفطر إلاّ على حلال متقلّلاً منه، فبذلك يزكو الصيام، ولا يقبل امرأته في صومه ولا يباشرها بظاهر جسمه فإن ذلك إن لم يبطل صومه فإنه ينقصه وتركه أفضل، إلاّ لقوي متمكن مالك لأربه، وليقل نومه بالنهار ليعقل صومه بعمارة الأذكار، وليجد مسّ جوعه وعطشه، وقد كانوا يتسحرون بالتمرتين والثلاث وبالحبات من الزبيب والجرعة من الماء، ومنهم من كان يقضم من شعير دابته التماساً لبركة السحور، وليكثر ذكر الله تعالى، وليقلل ذكر الخلق بلسانه، ويسقط الاهتمام بهم عن قلبه؛ فذلك أزكى لصومه، ولا يجادل ولا يخاصم وإن شتم أو ضرب لم يكافئ على ذلك لأجل حرمة الصوم ولا يهتم لعشائه قبل محل وقته، يقال: إنّ الصائم إذا اهتم بعشائه قبل محل وقته أو من أول النهار كتبت عليه خطيئة وليرض باليسير مما قسم له أن يفطر عليه ويشكر الله تعالى عزّ وجلّ كثيراً عليه.
ومن فضائل الصيام التقلّل من الطعام والشراب، وتعجيل الفطر، وتأخير السحور، وليفطر على رطب إن كان وإلاّ على تمر إن وجد فإنه بركة، أو على شربة من ماء فإنه ظهور.
هكذا روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يفطر على جرعة من ماء، أو مذقة من لبن، أو تمرات قبل أن يصلي، وفي الخبر: كم من صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش قيل: هو الذي يجوع بالنهار ويفطر على حرام، وقيل: هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيل: هو الذي لا يغضّ بصره ولا يحفظ لسانه عن الآثام ويقال: إنّ العبد إذا كذب، أو اغتاب، أو سعى في معصية في ساعة من صومه، خرق صومه، وإنّ صوم يوم يلفق له في صيام أيام حتى يتمّ بها صوم يوم ساعة ساعة، وفي الحديث: الصوم جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، وكانوا يقولون: الغيبة تفطر الصائم، وقد كانوا يتوضؤون من أذى المسلم، وروي عن جماعة في الوضوء مما مسّت النار: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحبّ إليّ من أن أتوضأ من طعام طيّب، وروي عن بشر بن الحرث عن سفيان: من اغتاب فسد صومه، وروينا عن ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب، وروي عن جابر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خمس يفطرن الصائم: الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمين الكاذبة، والنظر بشهوة، ويقال: إنّ من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد في عشر رمضانات، وفي عشرين، مثل سائر الفرائض من الصلاة والزكاة التي يحاسب عليها العبد، فإن وجدت كاملة وإلاّ تممت من سائر تطوعه، ويقال: إنّ العبد يصحّ له صوم في خمسة أيام كما يصحّ له صلاة واحدة بخمس صلوات ترفع له الأوقات، وفي الخبر: من اغتاب خرق صومه فليرقع صومه بالاستغفار، ويقال: إنّ الله تعالى لم يفترض شيئاً فرضي بدونه، وأنه يطالب بما فرضه ويحاسب على ما أوجبه وعفو الله سبحانه وتعالى يأتي على كثير من الذنوب، والمراد من الصيام مجانبة الآثام لا الجوع والعطش، كما ذكرناه من أمر الصلاة أنّ المراد بها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، كما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه.
شرح خامس ما بني الإسلام عليه:
الحج
بالحج كمال الشريعة وتمام الملة
ذكر فرائض الحج
قال الله تعالى: (وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً) آل عمران: 97، وفسّر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإذا وجد العبد زاداً وراحلة لزمه فرض الحج، فإن أخرّه بعد وجود ذلك كان مكروهاً، فإن مات ولم يحج، أو مات على عدم الإمكان بعد وجوده، كان عاصياً لله تعالى من حين أمكنه إلى يوم موته، ولم يكن كامل الإسلام، لأن الله تعالى أكمل الإسلام بالحجّ لما أنزل هذه الآية في الحج يوم عرفة (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً) المائدة: 3، وفي الخبر: من لم يمنعه من الحج مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ولم يحجّ فلا يبالي مات يهوديًّا أو نصرانيّاً، وقال عمر: لقد هممت أن أكتب إلى الأمصار بضرب الجزية على من لم يحجّ ممن يستطيع إليه سبيلاً، وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس: لو علمت رجلاً غنيّاً وجب عليه الحجّ ثم مات قبل أن يحجّ ما صليت عليه، وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن يحجّ فلم يصلِّ عليه، وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج: سأل الرجعة إلى الدنيا، وكان يفسرّه في هذ الآية قال: (رَبِّ أَرْجعُونِ) (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْت) المؤمنون: 99 - 100 قال: أحجّ ومثله فيقول: (رَبِّ لَوْلاَ أخَّرْتَنِي إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) المنافقون: 10 قال: أزكي وأحجّ، وكان يقول هذه الآية، أشد شيء على أهل التوحيد ومن كان ذا قوة على المشي أو ممن يصلح له أن يؤجّر نفسه وأمن التهلكة في خروجه فحجّ على ذلك كان فاضلاً في فعله، وللحاج الماشي بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة، وللراكب بكل خطوة تخطوها دابته سبعون حسنة، والقوّة على المشي من الاستطاعة عند بعض العلماء، فأما فرائض الحجّ عند جملة العلماء فستة اختلفوا منها في ثلاث وهنّ: السعي، والبيتوتة بمزدلفة عند المشعر ليلة النحر، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وأجمعوا على ثلاث وهنّ: الإحرام به، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ولم يختلفوا في أنّ ما سوى هذه سنّة واستحباب، ومذهبي في هذا وهو مذهب الأكثر من العلماء أنّ فرائض الحج أربعة: أولها الإحرام به والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة، وآخر حدّ الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وطواف الزيارة بعد الوقوف بعرفة بعد رمي جمرة العقبة، والسعي بين الصفا والمروة بعد الإحرام بالحج إن شئت قبل الوقوف بعرفة وإن شئت بعده، وما سوى ذلك من المناسك فمسنون ومستحبّ، وبعضه أوكد من بعض، وفي ترك بعضه كفارة وفي بعضه لا حرج فيه، وطواف الحج ثلاثة: واحد فريضة إن تركه بطل حجه وهو طواف الزيارة، وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع، وواحد مستحبّ إن تركه فلا شيء عليه وهو طواف الورود، ولم نذكر من فرائض الحج وأحكامه وهيئاته في هذا الباب إلاّ قوت الأعمال، مثل ما ذكرناه من سائر الأبواب في هذا الكتاب، على ما يليق بيانه للمعنى الذي قصدناه فيه، وقد أشبعنا أحكام الحج وما يقال في المشاعر في كتاب مناسك الحج المفرد.
ذكر فضائل الحج وآدابه
وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف السالكين للمنهاج
قال الله سبحانه وتعالى: (أالحَجُّ أَشْهُرٌ مَعلُومَاتٌ َُمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الحَجَّ) البقرة: 196، يعني من أوجبه على نفسه في هذه الأشهر فأحرم به وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث اسم جامع لكل لغوٍ وخني وفجر من الكلام ومغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث في شأن الجماع، والفسوق جمع فسق وهو اسم جامع لكل خروج من طاعة ولكل تعدّي حدّ من حدود الله تعالى، والجدال وصف مبالغ للخصومة والمراء فيما يورث الضغائن وفيما لا نفع فيه؛ فهذه ثلاثة أسماء جامعة مختصرة لهذه المعاني المثبتة أمر اللّّه تعالى بتنزيه شعائره ومناسكه منها لأنها مشتملة على الآثام وهنّ أصول الخطايا والإجرام، والحجّ في اللغة هو القصد إلى من يعظم، وكانت العرب تقول نحجّ إلى النعمان أي نقصده تعظيماً له وتعزيزاً، فينبغي أن يكون الحاجّ معظّماً لمن قصده بالحجّ ليتحقق بمعنى هذا الاسم، والحجّ أيضاً سلوك الطريق الواضح الذي يخرج إلى البغية ويوقف على المنفعة واشتقاقه من المحجّة بمنزلة النسك، وهو اسم للطريق مشتقّ من المنسك، وهو من أسماء الطريق وإن كان أصله المذيح ومنه سمي الناسك لأنه سالك لطريق الآخرة، فأول فضائل الحجّ حقيقة الإخلاص به لوجه الله تعالى، وأن تكون النفقة حلالاً واليد فارغة من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم، ويكون الهمّ مجرّداً والقلب ساكناً مطمئناً مملوءاً بالذكر فارغاً من الهوى ناظراً أمامه غير ملتفت إلى ورائه، وصحة القصد بحسن الصدق ثم طيب النفس بالبذل والإنفاق والتوسع في النفقة والزاد وبذل ذلك، لأنّ النفقة في الحجّ بمنزلة النفقة في سبيل الله تعالى؛ الدرهم بسبعمائة درهم، والحجّ من سبيل اللّّه، روي ذلك عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال ابن عمر وغيره: من كرم الرجل طيب زاده في سفره، وكان يقول: أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقيناً، وفي حديث ابن المنكدرعن جابر عن رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة، وقال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما برّ الحجّ، قال: طيب الكلام وإطعام الطعام، ويقال: إنّما سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وبعضهم يقول يسفر عن صفات النفس وجوهرها إذ ليس كل من حسنت صحبته في الحضر حسنت صحبته في السفر، وقال رجل لآخر: إنه يعرفه، فقال له: هل صحبته في السفر الذي يستدلّ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، قال: ما أراك تعرفه، ولا يجادل ولا يخاصم ولا يكثر المراء ولا يرفث بلسانه.
وروينا عن بشر بن الحرث قال: قال سفيان: من رفث فسد حجّه، وليتعلّم أحكام المناسك ومعالم الحجّ وهيئاته وآداب المشاهد قبل الخروج، وليكن ذلك أهمّ شيء إليه وليقدّمه على جميع أسباب السفر، فإن هذا هو المقصود والبغية فلا يتأبن عنه، وليعد له رفيقاً صالحاً عالماً محبّاً للخير معيناً عليه، إن نسي ذكره، وإنْ ذكر أعانه، وإن جبن شجعه، وإن عجز قواه، وإن أساء ظنه وضاق صدره وسّع صدره وصبره وحسن ظنه ولا يخالف رفيقه ولا يكثر الاعتراض عليه، وليحسن خلقه مع جميع الناس، ويلين جانبه ويخفض جناحه، ويكف أذاه عن الخلق، ويحتمل أذاهم؛ فبهذه المعاني يفضل الحج وإن يحج على رحْل أو زاملة فإن ذلك حج المتّقين وطريق السلف، يقال: حجّ الأبرار على الرحال، وحدث سفيان الثوري عن أبيه قال: برزت من الكوفة إلى القادسية للحجّ، ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوالقات ورواحل، وما رأيت في جميعهم إلاّ محملين، وقال مجاهد لابن عمر وقد دخلت القوافل: ما أكثر الحجاج، فقال: ما أقلّهم، ولكن قل: ما أكثر الراكب، قال: وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحاج من الزوامل والمحامل يقول: الحاج قليل والركب كثير، ثم نظر إلى رجل مسكين رثّ الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نعم الحاج، فينبغي أن يكون رثّ الهيئة، خفيف المؤونة، متقلّلاً من كل شيء، لا يحمل معه من الزاد إلاّ ما لا بدّ له منه مما يحتاج إليه، ولا يسرف في المبالغة والتناهي فيه، ولا يقتر، ولا يضيق على نفسه ورفيقه، بل يستعمل الاقتصار في كل شيء والكفاية، ويجتنب من الزي الحمرة فإن ذلك مكروه.
وروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان في سفر، فنزل أصحابه منزلاً، فسرحت الإبل، فنظر إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال: أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم، قال: فقمنا نتساعى حتى نزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل، ثم ليجتنب من الزي الشهرة، وكل منظور إليه من الأثاث، ولا يتشبّه بالمترفين ولا بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من المتكبرين، ولا يكثر التنعّم والرفاهة فإن ذلك غير مستحبّ في سبيل الله تعالى، لأن المشقّة والظمأ والمخمصة والأواء كلما كثر في سبيل اللّّه كان أفضل وأثوب، حجّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلة وكان تحته رحل رثّ وقطيفة خلقة قيمته أربعة دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه ويهتدوا بشمائله، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وكان يقول: لبيك اللهم لبيك، حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة، وقال: لبيك، أنّ العيش عيش الآخرة، وأمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشعث والاختفاء، ونهى عن التنعّم والرفاهة، في حديث فضالة بن عبيد، وفي الخبر: إنما الحاج الشعث التفل، يقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى زوّار بيتي قد جاؤوني شعثاً غبراً من كل فجّ عميق، وقال الله عزّ وجلّ: (ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ) الحج: 29، التفث الشعث والأغبار، وقضاؤه حلق الرأس وقص الأظافر، وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد: اخلولقوا واخشوشنوا أي البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة من الأشياء، وبعض أصحاب الحديث يصف هذه الحروف يقول: احلقوا من الحلق، ولا يجوز أن يأمرهم بإسقاط سنة كيف، وقد قال لصبيغ حين توسّم في مذهب الخوارج: اكشف رأسك، فرآه ذا ضفيرتين فقال: لو كنت محلوقاً لضربت عنقك، ولينح مثال أهل اليمن في الزي والأثاث، فإن الاقتداء بهم والاتباع لشمائلهم في الحجّ طريقة السلف على ذلك الهدى والوصف، كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، وما عدا وصفهم وخالف هديهم، فهو محدث ومبتدع، ولهذا المعنى قيل: زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على منهاج الصحابة وطريقة السلف، وقيل في مدحهم بالتقلّل والانفراد: لا يغلون سعراً ولا يضيقون طريقاً، وقد كان العلماء قديماً إذا نظروا إلى المترفين قد خرجوا إلى مكة يقولون: لا تقولوا خرج فلان حاجّاً، ولكن قولوا: خرج مسافراً، ويقال: إنّ هذه المحامل والقباب أحدثها الحجاج بن يوسف، فركب الناس سنتّه، وقد كان العلماء في وقته ينكرونها ويكرهون الركوب فيها، وأخاف أنّ بعض ما يكون من تماوت الإبل يكون ذلك سببه لثقل ما يحمل، ولعله عدل أربعة أنفس وزيادة مع طول الشقة وقلة الطعم، وينبغي أن يقلّل من نومه على الدابة، فإنه يقال: إنّ النائم يثقل على البعير، وقد كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلاّ من قعود يغفون غفوة بعد غفوة، وكانوا أيضاً لا يقفون عليها الوقوف الطويل لأن ذلك يشق عليها.
وفي الحديث: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، ولا يحمل على الدابة المكتراة إلاّ ما قاضى عليه الجمال أو ما أعلمه به، وقال رجل لابن المبارك: احمل لي هذا الكتاب معك، فقال: حتى أستأمر الجمال، فإني قد اكتريت، ولينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك، ففيه سنّة وآثار عن السلف، وقد كان بعض السلف يكتري لازماً ويشترط أن لا ينزل، ثم إنه ينزل للرواح ليكون ما رفه عن الدابة من حسناته محتسباً له في ميزانه، وبعض علماء الظاهر يقول: إنّ الحج راكباً أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤونة، ولأنه أبعد لضجر النفس، وأقل لأذاه وأقرب لسلامته وتمام حجه، فهذا عندي بمنزلة الإفطار يكون أفضل إذا ساء عليه خلقه، وضاق به ذرعه، وكثر عليه ضجره، لأن حسن الخلق وانشراح الصدر أفضل، وقد يكون كذلك لبعض الناس دون بعض ممن يكون حاله الضجر ووصفه التسخط وقلة الصبر، أو لم يمكن المشي، وسألت بعض فقهائنا بمكة وكان ورعاً عن تلك العمر التي تعتمر من مكة إلى التنعيم، وهو الذي يقال له مسجد عائشة، وهو ميقاتنا للعمرة في طول السنة أي ذلك أفضل المشي في العمرة، أو يكتري حماراً بدرهم يعتمر عليه فيقال: يختلف ذلك على قدر شدته على الناس، فإن كان إنفاق الدرهم أشدّ عليه من المشي فالاكتراء أفضل لما فيه من إكراه النفس عليه وشدته عليها، ومن كان المشي عليه أشق فالمشي أفضل لما فيه من المشقة، ثم قال: هذا يختلف لاختلاف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة، فيكون المشي عليهما أشد، وعندي أنّ الاعتمار ماشياً أفضل، وكذلك الحج ماشياً لمن أطاق المشي ولم يتضجر به وكان له همة وقلب، وقد روينا في خبر من طريق أهل البيت: إذا كان في آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أصناف؛ سلاطينهم للنزهة، وأغنياؤهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقرّاؤهم للسمعة، ويكره أخذ الأجرة على الحجّ فيجعل نصيبه وعناه لغيره ملتمساً عرض الدنيا، وقد كره ذلك بعض العلماء، ولأنه من أعمال الآخرة ويتقرّب به إلى الله، يجري مجرى الصلاة والأذان والجهاد فلا يأخذ على ذلك أجراً إلاّ في الآخرة، وقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذناً لا تأخذ على الأذان أجراً، وسئل عن رجل خرج مجاهد فأخذ ثلاثة دنانير فقال: ليس له من دنياه وآخرته إلاّ ما أخذ، فإن كان نية عبد الآخرة أو همته المجاورة واضطر إلى ذلك، فإن الله تعالى قد يعطي الدنيا على نية الآخرة ولا يعطي الآخرة على نية الدنيا، رجوت أن يسعه ذلك، وفي الخبر: يؤجر على الحجة الواحدة ثلاثة ويدخلون الجنة: الموصي بها، والمنفذ للوصية، والحاجّ الذي يقيمها لأنه ينوي خلاص أخيه المسلم والقيام بفرضه، وقد جاء مثل المجاهد الذي يأخذ أجراً على جهاده مثل أم موسى يحلّ أجرها وترضع ولدها، هذا إذا كانت نيته الجهاد واحتاج إلى معونة عليه، كذلك من كانت نيته في حجه الآخرة، والتقرّب إلى الله تعالى بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه، لم يضره أخذ أجرة على حجه إن شاء الله تعالى.
ومن فضائل الحجّ أن لا يقوي أعداء الله الصادين عن المسجد الحرام بالمال، فإن المعونة والتقوية بالمال تضاهي المعونة بالنفس، والصدّ عن المسجد الحرام يكون بالمنع والإحصار، ويكون بطلب المال، فليحتل في التخلص من ذلك فإن بعض علمائنا كان يقول: ترك التنقل بالحجّ الرجوع عنه أفضل من تقوية الظالمين بالمال، لأن ذلك عنده دخيلة في الدين، ووليجة في طريق المؤمنين، وإقامة وإظهار لبدعة أحدثت من الآخذ والمعطي؛ وهذا كما قال لأنه جعل بدعة سنة ودخولاً في صغار وذلة ومعاونة على وزر أعظم في الحرم من تكلّف حجّ نافلة قد سقط فرضه كيف، وفي ذلك إدخال ذلة وصغار على الإسلام والمسلمين مضاهاة للجزية، وقد روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كل واحد من المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، فإن ترك المسلمون فاشدد لئلا يؤتى الإسلام من قبلك، وفي الخبر المشهور: المسلمون كرجل واحد ومثل المسلم من المسلمين كمثل الرأس من الجسد، يألم الجسد لما يألم الرأس ويألم الرأس لما يألم الجسد، وقد يترخص القائل في ذلك بتأويل أنه مضطر إليه، وليس كما يظن، لأنه لو رجع لما أخذ منه شيء، ولو خرج في زيّ المترفين مما أحدث من المحامل لما أخذ منه شيء، فقد زال الاضطرار وحصل منه بالطوع والشهوة الاختيار، لعل هذا الذنب عقوبة ما حّملوا على الإبل فوق طاقتها من البيوت المسقفة التي علوها عليها، كان البعير يحمل الرجل ورحله فجعلوه يحمل مقدار أربعة وزيادة، فأدى ذلك إلى تلفها، فهم مطالبون بقتلها، لأن من حمّل بعيراً فوق طوقه حوسب بذلك وطولب، أو لعلّه ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول الأسباب وشبهات الأموال أو لسوء النيات وفساد المقاصد، وروينا أنّ أبا الدرداء قال لبعير له في الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحمّلك فوق طاقتك، وقد يعاقب الله على الذنب بذنب مثله أو فوقه، وينبغي أن يكون في المشاعر والمناسك أشعث أغبر فإنه سنّة، ويكثر ذكر الله في طريقه وجميع مناسكه، ويذكر به الغافلين ويقل ذكر الناس ويلزم الصمت فيما لا يعنيه، ولا يتكلّف ما قد كفى، ولا يدخل فيما لم يكلف، وإن رأى موضعاً للمعروف أمر به أو منكراً نهى عنه، فهذه المعاني تضاعف أمر الحجّ وتفضل الحجاج واستحبّ أن يقرن بين حجة وعمرة من ميقاته لأن فيه إيجاب هدى يقربه وليكون جامعاً بين نسكين من ميقات بلده، ويكون قد أتى بالعمرة لأنها مقرونة بالحجّ في الكتاب، ولأن مذهب كثير من العلماء أنها فريضة كالحجّ، وجماعة من السلف كانوا يستحسنون الابتداء بالعمرة وتقديمها على الحجّ، منهم: الحسن وعطاء وابن سيرين والنخعي.
وقد روي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بينهما وأهل بهما معاً في حديث أنس، وقد حدثت عن شقيق بن سلمة عن الضبي بن معبد قال: أردت الغزو فأشار عليّ رجل من أهل العلم أن أبدأ بالحجّ فاستشرت رجلاً من أهل الفقه فأمرني أن أجمع بين حجّ وعمرة جميعاً، ففعلت، فأنشأت إليّ بهما حتى قدمنا على عمر فأخبرته بالذي فعلت، فقال: هديت لسنّة نبيّك وإن قدم العمرة فحجّ متمتعاً ثم أفرد الحجّ بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا اختيار جماعة من العلماء، وإن حجّ مفرداً كما روي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أفرد الحجّ فيما روينا عن عائشة وجابر، وإذا فرغ من حجه رجع إلى ميقات بلده فاعتمر من هناك فحسن، وقد قال الله عزّ وجلّ: وأتموا الحجّ والعمرة لله فإفرادهما من إتمامهما؛ وهذا قول عمر وعثمان في الإتمام، وليطف لقرانه ويسع طوافين وسعيين ليخرج بذلك من اختلاف العلماء جمعهما أو فرّقهما، وليكثر العبد من التلبية في حال إحرامه فهي من أفضل الأذكار فيه، وليرفع بها صوته وإن قال في تلبيته: لبيك يا ذا المعارج، لبيك حجّاً حقّاً، تعبّداً ورقّاً، والرغباء إليك والعمل، فقد روي هذا عن الصحابة وإن اقتصر على تلبية رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحسن، وفيها كفاية وبلاغ وأحبّ أنّ يذبح وإن لم يجب عليه ويجتنب الأكل من يذبح ما كان واجباً عليه مثل نسك قران أو متعة أو كفارة، واستحب أن يأكل مما لم يكن عليه واجباً وليجتنب المعايب الثمانية في ذبيحته التي وردت بها الآثار، وكذلك في الأضحية فقد نهي أن يضحي بالجدعاء والعضباء والجرباء، ونهى عن الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء، التي لا تنقي، يعني المهزولة؛ وهذا جميع ما جاء في عيوب الأضاحي بأخبار متفرقة، فالجدع في الأنف والأذن، والقطع فيهما، والعضب الكسر في القرن، وفي نقصان القوائم، والجرباء من الجرب، والشرقاء المشقوقة الأذن من فوق، والخرقاء المشقوقة من أسفل، والمقابلة المخروقة الأذن من قدام، والمدابرة المخروقة من خلف، والتي لا تنقي المهزولة التي لا نقي لها؛ والنقي هو المخ وقد روينا في تفسير قوله تعالى ذلك: (وَمَنْ يُعظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ) الحج: 32، قيل: تسمين الهدي وتحسينه، وأفضل الهدي بدنة، ثم بقرة، ثم كبش أقرن أبيض، ثم الثني من المعز، وإن ساق هديه من الميقات فهو أفضل من حيث لا يجهده ولا يكدّه، وقد كانوا يغالون بثلاث ويكرهون المكاس، فيهن الهدي والأضحية والرقبة، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمناً وأنفسه عندأهله، وفي حديث ابن عمر أنّ عمر أهدى نجيبة فطلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً، فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدها فهذه سنّة في تخيّر الهدى، وحسن الأدب في المعاملة، وترك الاستبدال بها طلباً للكثرة، لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون، إنّ في ثلاثمائة دينار قيمة ثلاثين، فكان الخالص الحسن كافياً من الكثير المتقارب، وفي حديث ابن المنكدر عن جابر سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما برّ الحج؟ قال: العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر البدن.
وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما عمل آدمي يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من إهراق دم، وأنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها فإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، طيبوا بها نفساً، وفي الخبر: لكم بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها حسنة، وأنها لتوضع في الميزان فأبشروا ولا يضحى بجذع إلا من الضأن فقط، وهو ما كان في آخر حوله، وبالثني من المعز والبقر والإبل، فالثني من المعز ما دخل في السنة الثانية، والثني من البقر ما دخل في الثالثة، والثني من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، وإن أحرم من بلده فقد قيل إنه من إتمام الحج والعمرة ومن عزائم الأعمال، روينا عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما: وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ولتكن حاضر القلب، مشاهد القرب عند المواطن المرجوّ فيها الإجابة، وفي المشاهد المبتغي منها المنفعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله على ما رزقهم، واستحبّ له أن يمشي في المشاعر من حين يخرج من مكة إلى أن يقف بعرفة، وإلى أن يرجع من طواف الزيارة إلى منى، ومن استحبّ للحاجّ الركوب فإنه يستحبّ له المشي إلى مكة في المناسك إلى انقضاء حجّه، ولأن عبد الله بن عباس أوصى بنيه عند موته فقال: يا بنيّ حجوا مشاة، فإن للحاج الماشي بكل قدم يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: وما حسنات الحرم؟ قال الحسنة بمائة ألف وأوكد ما مشي فيه من المناسك وأفضله، من مسجد إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الموقف، ومن الموقف إلى المزدلفة في الإفاضة، ومن المشعر الحرام غداة النحر إلى منى، وفي أيام رميه الجمار وصومه يوم عرفة فيه فضل إن قوي معه على الدعاء والتلبية ولم يقطعه الصوم عن ذلك، فإن أضعفه فالفطر أفضل، ولم يصمه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرفة ولا أبو بكر ولا عمر وصامه عثمان رضي الله عنه وعنهم، وليعتبر في طريقه وسيره بالآيات وما يرى من الحكمة والقدرة من تصريف الخلق، وما يحدث الله تبارك وتعالى في كل وقت فيكون له في كل شيء عبرة، ومن كل شيء موعظة، فإنه على مثال طريق الآخرة، وليكن له بكل شيء تذكرة، وفي كل شيء فطنة وتبصرة، ترده إلى الله تعالى، وتدله عليه، وتذكره به، ويشهده منها فيتفكر في أمره، ويستدلّ به على حكمته، ويشهد منه قدرته.
وسئل الحسن ما علامة الحجّ المبرور؟ فقال: أن يرجع العبد زاهداً في الدنيا، راغباً في الآخرة، وقيل في وصف الحج المبرور: هو كفّ الأذى، واحتمال الأذى، وحسن الصحبة، وبذل الزاد، ويقال: إنّ علامة قبول الحج ترك ما كان عليه العبد من المعاصي والاستبدال بإخوانه البطالين إخواناً صالحين وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة، فمن وفّق للعمل بما ذكرناه فهو علامة قبول حجه ودليل نظر الله إليه في قصده، ومن أصيب بمصيبة في نفسه وماله فهو من دلائل قبول حجه، فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله تعالى، الدرهم بسبعمائة، وبمثابة الشدائد في طريق الجهاد، وليستكثر من الطواف بالبيت، لأنه يستوعب بطواف أسبوع مائة وعشرين رحمة يكون بكل رحمة ما شاء الله، لأنه سبحانه يختصّ برحمته من يشاء، وأقل ماله بكل رحمة عشر حسنات، لأن في حديث عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ينزل الله على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرين رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين، وفي الحديث: استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة، وأغبط عمل تجدونه، ولا تتحدث في طوافك، وعليك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والحمد وتلاوة القرآن وامش بسكينة ووقار وخشوع وانكسار، ولا تزاحمنّ أحداً، واقرب من البيت ما أمكن، واستلم الركنين اليمانيين مع تقبيل الحجر في كل وتر من طوافك إن أمكن.
وقد روينا في الخبر: من طاف بالبيت حافياً حاسراً كان له كعتق رقبة، ومن طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه، روي ذلك عن الحسن بن علي قاله لأصحابه ورفعه إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: واتق الهمة الردية والأفكار الدنية، فيقال: إنّ العبد يؤاخذ بالهمة في ذلك البلد، وعن ابن مسعود: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالإرادة قبل العمل إلاّ بمكة، وقال أيضاً: لو همّ العبد أن يعمل سوءاً بمكة عاقبه الله تعالى، ثم تلا: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) ؛ يعني أنه علق العذاب بالإرادة دون الفعل، ويقال: إنّ السيّئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، وإنّ السيّئات التي تكتسب هنالك لا تكفر إلاّ هناك، وكان ابن عباس يقول: الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم، وقيل: الكذب فيه من الإلحاد، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأن أذنب سبعين ذنباً بركية أحبّ إليّ من أن أذنب ذنباً واحداً بمكة؛ وركية منزلة بين مكة والطائف، وقد كان الورعون من السلف منهم عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهما يضرب أحدهم فسطاطاً في الحرم وفسطاطاً في الحلّ، فإذا أراد أن يصلي أو يعمل شيئاً من الطاعات دخل فسطاط الحرم ليدرك فضل المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام عندهم في جميع ما يذكر إنما هو الحرم كله، وإذا أراد أن يأكل أو يكلّم أهله أو يتغوّط خرج إلى فسطاط الحل، ويقال: إنّ آل الحجاج في سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعالهم بذي طوي تعظيماً للحرم، وقد سمعنا من لم يكن يتغوّط ولا يبولّ في الحرم من المقيمين بمكة ورأينا بعضهم لا يتغوّط ولا يبول حتى يخرج إلى الحلّ تعظيماً لشعائر الله تعالى، وتنزيهاً لحرمه وأمنه، وأعمال البرّ كلها تضاعف بمكة، والحسنة بمائة ألف حسنة على مثال الصلاة في المسجد الحرام، روي معنى ذلك عن ابن عباس وأنس، وعن الحسن البصري: أنّ صوم يوم بمائة ألف وصدقة درهم بمائة ألف درهم، ويقال: إنّ طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة، وإنّ ثلاث عمر تعدل حجة، وإنّ العمرة هي الحجة الصغرى؛ وهذا في دليل الخطاب من قوله تعالى: يوم الحج الأكبر، فدل أنّ الحج الأصغر هو العمرة، ومن العرب من يسمّي العمرة حجّاً، وفي الخبر: عمرة في رمضان تعدل حجة، فمن وفق للعمل بما ذكرناه فهو علامة قبول حجه ودليل نظر الله إليه في قصده.
ذكر فضائل الحج والحاجين لوجه الله
روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: من حجّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي حديث آخر: من خرج من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجري له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب، وقيل له: أدخل الجنة، وروي في الخبر حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها، وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلاّ الجنة، وفي الحديث: الحجاج والعمار وفد الله تعالى وزوّاره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن دعوه استجيب لهم، وإن شفعوا شفعوا، وذكر بعضهم أنّ إبليس ظهر له في صورة شخص بعرفة، فإذا هو ناحل الجسم، مصفرّ اللون، باكي العين، مقصوم الظهر، فقال له: ما الذي أبكى عينك؟ فقال: خروج الحاج إليه بلا تجارة، أقول قصدوه أخاف أن لا يخيبهم فيحزنني ذلك، قال: فما الذي أنحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله تعالى، ولو كانت في سبيلي، كان أحبّ إليّ قال: فما الذي غيّر لونك؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحبّ إليّ قال: فما الذي قصم ظهرك؟ قال: قول العبد أسألك حسن الخاتمة، أقول: يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله؟ أخاف أن يكون قد، ولقي رجل ابن المبارك وقد أفاض من عرفة إلى مزدلفة فقال: من أعظم الناس جرماً يا أبا عبد الرحمن في هذا الوقت؟ فقال: من قال إنّ الله عزّ وجلّ لم يغفر لهؤلاء، وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل البيت: أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظنّ أنّ الله عزّ وجلّ لم يغفر له، ويقال إنّ من الذنوب ذنوباً لا يكفّرها إلاّ الوقوف بعرفة، وقد رفعه جعفر بن محمد فاسنده، ويقال: إن الله عزّ وجلّ إذا غفر لعبد ذنباً في الموقف غفره لكل من أصابه في ذلك الموقف، وزعم بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف، وهو أفضل يوم في الدنيا، وفيه حجّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة الوداع، ولم يحج بعد نزول فرض الحج غيرها، وعليه نزلت هذه الآية وهو وافق بعرفة (اليَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلامَ ديناً) المائدة: 3 وقال علماء أهل الكتاب: لو أنزلت علينا هذه الآية لجعلنا يومها عيداً، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين؛ يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو واقف بعرفة، وقد روينا في تفسير قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم؛ عن جماعة من السلف قال: غفر لهم وربّ الكعبة، وفي تفسير قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم؛ قال: طريق مكة بصدهم عنه
وروينا عن مجاهد وغيره من العلماء: دخل حديث أحدهما في الآخرة، كانوا يتلقون الحاج يدعون لهم قبل أن يتدنسوا ويقولون: تقبل الله منا ومنكم، وأنّ الحاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقاً، وقال الحسن: من مات يعقب شهر رمضان، أو يعقب غرواً، أو يعقب حجّاً، مات شهيداً، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الحاج مغفور له ولمن استغفر له شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول، وقد كان من سنة السلف أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء لهم، وفي الخبر: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وحدثونا عن عليّ بن الموفق قال: حججت سنة فلما كان ليلة عرفة بتّ بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كأنّ ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه: يا عبيد الله، فقال الآخر: لبيك يا عبد الله، قال: تدري كم حجّ بيت ربنا في هذه السنة؟ قال: لا أدري، قال: حجّ بيت ربنا ستمائة ألف، فتدري كم قبل منهم؟ قال: لا، قال: قبل منهم ستة أنفس، قال: ثم ارتفعا في الهواء فغابا عني فانتبهت فزعاً فاغتممت غمّاً شديداً وأهمني أمري فقلت: إذا قبل حجّ ست أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس؟ فلما أفضنا من عرفة وبت عند المشعر الحرام جعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم فحملني النوم، فإذا الشخصان قد نزلا من السماء على هيئتهما فنادى أحدهما: يا عبد الله، قال: لبيك يا عبد الله، قال: تدري كم حجّ بيت ربنا؟ قال: نعم ستمائة ألف، قال: فتدري كم قبل منهم؟ قال: نعم ستة أنفس، قال: فتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا، قال: فإنه وهب لكل واحد من الستة مائة ألف، قال: فانتبهت وبي من السرور ما يجلّ من الوصف، ذكر في هذه القصة ستة ولم يذكر السابع؛ وهؤلاء هم الأبدال السبعة أوتاد الأرض المنظور إليهم كفاحاً، ثم ينظر إلى قلوب الأولياء من وراء قلوبهم، فأنوار هؤلاء عن نور الجلال وأنوار الأولياء من أنوارهم، وأنصبتهم وعلومهم من أنصبة هؤلاء وعلومهم، فلم يذكر السابع وهو قطب الأرض، والأبدال كلهم في ميزانه، ويقال إنه هو الذي يضاهي الخضر من هذه الأمة في الحال ويجاريه في العلم، وإنهما يتفاوضان العلم ويجد أحدهما المزيد من الآخرة، فإنما لم يذكر والله أعلم لأنه يوهب له من مات، ولم يحجّ من هذه الأمة لأنه أوسع جاهاً من جميعهم وأنفذ قولاً في الشفاعة من الجملة.
وقد روينا عن ابن الموفق قال: حججت سنة، فلما قضيت مناسكي تفكّرت فيمن لا يتقبل حجّه، فقلت: اللهم إني قد وهبت حجتي هذه وجعلت ثوابها لمن لا يتقبل حجّه، قال: فرأيت ربّ العزة في النوم، قال لي: يا علي تتسخّى عليّ وأنا خلقت السخاء وخلقت الأسخياء، وأنا أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأحقّ بالجود والكرم من العالمين، وقد وهبت كل من لم يقبل حجّه لمن قبلته، وكان ابن الموفق هذا قد حجّ عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حججاً وقال: فرأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا ابن الموفق حججت عني؟ قلت: نعم يارسول الله، قال: ولبيت عني؟ قلت: نعم، قال: فهذه يد لك عندي أكافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق في كرب الحساب.
ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه
في الخبر: أنّ الله تعالى وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله تعالى بالملائكة، وأنّ الكعبة تحشر كالعروس المزفوف وكل من حجّها متعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخون معها، وفي الخبر: أن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة، وأنه يبعث يوم القيامة، وله عينان، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحقّ وصدق، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقلبه كثيراً، وروينا أنه سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيجعل المحجن عليه، ثم يقبل طرف المحجن، وقبله عمر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك لما قبلتك، ثم بكى حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فإذا عليّ، فقال: يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات، فقال عليّ: يا أمير المؤمنين بل هو يضرّ وينفع، قال: وكيف؟ قال: إنّ الله عزّ وجلّ لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتاباً، ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، ويشهد على الكافر بالجحود، قيل: فذلك معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك يعنون هذا الكتاب والعهد، وفي الخبر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنا أول من تنشقّ عنه الأرض ثم آتي البقيع فيحشرون معي، ثم آتي أهل مكة فأحشر بين الحرمين، وفي الخبر: أنّ آدم لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: برجحك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، وجاء في الخبر: أنّ الله تعالى ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض، فأول من ينظر إليه أهل الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام، فمن رآه طائفاً غفر له، ومن رآه منهم مصلياً غفر له، ومن رآه نائماً مستقبل القبلة غفر له، وذكرت الصلاة بعبادان لأبي تراب النخشي فقال: نومة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة بعبادان، وكوشف بعض الأولياء قال: رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان، ورأيت عبادان ساجدة لجدة، لأنها خزانة الحرم، وفرضة أهل المسجد الحرام، وكنت أنا بمكة سنة فأهمني الغلاء بها حتى ضقت ذرعاً به، فرأيت في النوم شخصين بين يديّ، يقول أحدهما للآخر: كل شيء في هذا البلد عزيز كأنه يعني الغلاء، فقال الآخر: الموضع عزيز فكل شيء فيه عزيز، فإن أردت أن ترخص الأشياء عليك فضّحها إلى شرف الموضع حتى ترخص.
ذكر من كره المقام بمكة
كان سفيان الثوري يقول: والله ما أدري أي البلاد أسكن، فقيل له: خراسان، قال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة، قيل: الشام، قال يشار إليك بالأصابع، قيل: فالعراق، قال: بلدة الجبابرة، قيل: مكة، قال: تذيب الكيس والبدن، وقال رجل للثوري: قد عزمت على المجاورة بمكة فأوصني، قال: أوصيك بثلاث؛ لا تصلّين في الصف الأول، ولا تصبحن قرشياً، ولا تظهرن صدقة، إنما كره له الصلاة في الصف الأول لأنه يفتقد فيسأل عنه إذا غاب فيشتهر ويعرف إذا واظب، فيجب أن يرب الحال بلزوم الموضع، فيذهب الإخلاص ويحصل التزيّن والتصنّع، وجاء رجل إلى سفيان بمكة فسأله فقال: أرسل معي رجل بمال فقال: ضعه في سدانة الكعبة، أو قال: في سدنة الكعبة، فما ترى؟ قال سفيان: قد جهل فيما أمرك به، وإنّ الكعبة لغنية عن ذلك، قال: فما ترى؟ قال: أصرفه للفقراء والأرامل، وإياك وبني فلان فإنهم سراق الحاج، وقد كان بعض السلف يكره المجاورة بمكة ويحبّ قصد البيت للحجّ والخروج منه، إما لأجل الشوق إليه أو خشية الخطايا فيه، أو حبّاً للعود، وقد قال الله تعالى: (وَإذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا) البقرة: 125، أي يثوبون إليه يعودون مرة بعد مرة ولا يقضون منه وطراً وكان بعضهم يقول تكون في بلد وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت، خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك أو قلبك متعلّق إلى بلد غيره، وروى ابن عيينة عن الشعبي: لأن أقيم بحمام أعين أحب إلي من أن أقيم بمكة، قال سفيان يعني إعظاماً لها وتوقيتاً عن الذنب فيها وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول: يا أهل اليمن يمنكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم، وكان ابن عباس يقول: أجور بيوت مكة حرام ولا تقوم الساعة حتى يستحل الناس اثنتين إتيان النساء في أدبارهن وأجور بيوت مكة، وكان الثوري وبشر وجماعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت مكة، حتى قال الثوري: إذا طالبوك ولم يكن لك بدّ من أن تعطيهم فخذ لهم من البيت قيمة ما أخذوا منك، وقال بعض السلف من رجل بأرض خراسان أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به ويقال إن لله عباداً تطوف هم الكعبة تقرّباً إلى الله عزّ وجلّ، وحدثني شيخ لنا عن أبي علي الكرماني شيخنا بمكة وكان من الأبدال إلا أني سمعت هذه الحكاية منه، قال: سمعته يقول: رأيت الكعبة ذات ليلة تطوف بشخص من المؤمنين، وقال لي هذا الشيخ: ربما نظرت إلى السماء واقعة على سطح الكعبة قد ماستها الكعبة ولزقت بها وأكثر الأبدال في أرض الهند والزنج وبلاد الكفرة، ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلا يطوف بهذا البيت رجل من الأبدال، ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة ولا يرون لها أثراً وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا تذكر منه كلمة ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية ثم يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب يتوقع ولادتها.
روينا عن وهيب بن الورد المكي قال كنت ذات ليلة أصلي في الحجر فسمعت كلاماً بين الكعبة والأستار يقول إلى الله تعالى أشكو ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي تفكههم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا من ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه، وفي الخبر لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام، وروي أن الحبشة يغزون الكعبة فيكون أولهم عند الحجر الأسود وآخرهم على ساحل البحر بجدة فينقضونها حجراً حجراً يناول بعضهم بعضاً حتى يرمونها في البحر وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة كأني أنظر حبشياً أصلع أجدع قائماً عليها يعني الكعبة هدمها بمعوله حجراً حجراً، وفي الخبر استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة ورفعه الذي ذكرناه يكون بعد هدمه لأنه بيني من ذي قبل حتى يعود إلى مثل حاله ويحج مراراً ثم يرفع بعد ذلك.
وروينا في حديث أبي رافع عن عليّ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره، وليس بعد مكة مكان أفضل من مدينة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأعمال فيها مضاعفة، روي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام، وكذلك قيل: إنّ فضل الأعمال بالمدينة كفضل الصلاة، كل عمل بألف عمل، وبعد ذلك الأرض المقدسة فإن فضل الصلاة فيها بخمسمائة صلاة، وكل عمل يضاعف بخمسمائة مثله، روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة، ثم يستوي الأرض بعد ذلك فلا يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دلّ الشرع عليه، كما جاء في الخبر: لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وبعد ذلك فأي موضع صلح فيه قلبك، وسلم لك دينك، واستقام فيه حالك؛ فهو أفضل المواضع لك، وقد جاء في الخبر: البلاد بلاد الله تعالى، والخلق عباده، فأي موضع رأيت فيه رفقاً، فأقم واحمد الله تعالى، وفي الخبر المشهور من حضر له في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه، وقال نعيم: رأيت الثوري قد جعل جرابه على كتفه وأخذ قلته بيده، فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ فقال: إلى بلد أملأ فيه جرابي بدرهم، وفي حكاية أخرى: بلغني أنّ قرية فيها رخص فأخرج إليها، فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم، إذا سمعت في بلد برخص فاقصده فإنه أسلم لدينك، وأقلّ لهمّك، وكان يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين، هذا زمان تنقل الرجل ينتقل من قرية إلى قرية يفرّ بدينه من الفتن، وقد كان الفقراء والمريدون يقصدون الأمصار للقاء العلماء والصالحين، للنظر إليهم والتبرّك والتأدب بهم، وكان العلماء ينتقلون في البلاد، ليعلموا، ويردوا الخلق إلى الله تعالى، ويعرفوا الطريق إليه، فإذا فقد العالمون وعدم المريدون فالزم موضعاً ترى فيه أدنى سلامة دين وأقرب صلاح قلب وأيسر سكون نفس ولا تنزعج إلى غيره فإنك لا تأمن أن تقع في شرّ منه وتطلب المكان الأول فلا تقدر عليه، والله غالب على أمره ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
4hFnTkfUWdo
 |
 |
البحث في نص الكتاب
بعض كتب الشيخ الأكبر
[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]
شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:
[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]
شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:
[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]
بعض الكتب الأخرى:
[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]
بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:
[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]