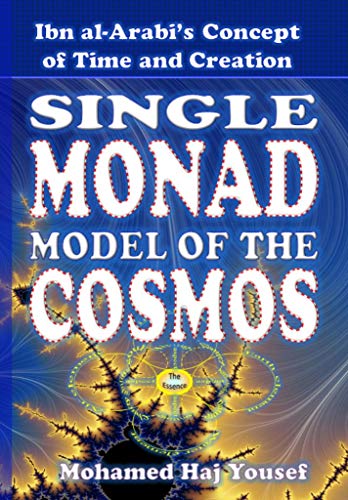المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
أبو طالب المكي (المتوفى: 386هـ)
الفصل الحادي والأربعون ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه:
 |
 |
الفصل الحادي والأربعون ذكر فضائل الفقر وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه:
قال الله الكبير المتعال: (لِلقُقَرَاء المُهَاجرِينَ الذَّينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم) الحشر: 8، وقال تبارك وتعالى: (لِلفُقَرَاءِ الَّذينَ أُحْصِرُوا في سبيل الله لاَ يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً في الأَرْضِ) البقرة: 273 فقدّم وصف أوليائه بالفقر على مدحهم بالهجرة والحصر، والله تعالى لا يصف من يحبّ إلاّ بما يحبّ، فلولا أنّ الفقر أحبّ الأوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرّفهم به، وأمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالفقر وأخبر بفضله في غير حديث؛ منها حديث إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمران عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لأصحابه: أي الناس خير؟ فقالوا: موسر من المال يعطي حق الله عزّ وجلّ في نفسه وماله، فقال: نعم الرجل هذا وليس به، قالوا: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: فقير يعطي جهده؛ ومنها حديث بلال أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: إلقَ الله عزّ وجلّ فقيراً ولا تلقه غنياً، وفي الحديث الذي روي عن ابن الأعرابي: أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: لا أفضل من الفقير إذا كان راضياً، وفي الحديث الآخر: أنّ الله تبارك وتعالى يحبّ الفقير المتعفّف أبا العيال، وفي الخبرين المشهورين: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، والحديث الآخر: اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين؛ فهذا منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفضيل الفقراء وإكرام لهم وتنبيه وحثّ على فضل الفقر، وروينا عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجيعاً في الجنة ضعفاؤها.
وروينا في خبر إسماعيل النبي عليه السلام المفسّر لخبر موسى عليه السلام: أنّ إسماعيل قال: يا رب أين أطلبك؟ فقال الله عزّ وجلّ: عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، قال: ومن هم؟ فقال تعالى: الفقراء الصادقون، وقال أبو سليمان الدارني: الأعمال كلها في الخزائن مطروحة إلاّ شيئين، فإنه مخزون مختوم عليه لا يعطيه إلاّ من طبعه بطابع الشهداء، الفقر مع المعرفة، وكان يقول: تنفّس الفقير دون شهوة لا يقدر عليها أفضل من عبادة غنيّ عمره كله، وقد كان بشر يقول: مثل الغني المتعبّد مثل روضة على مزبلة، ومثل العبادة على الفقير مثل عقد جوهر في جيد الحسناء، وقال: العبادة لا تليق بالأغنياء، وكان يقول: التقوى لا تحسن إلاّ في فقر، وقال له رجل فقير: يا أبا نصر ادع الله عزّ وجلّ لي فقد أضرّ بي الفقر والعيال، فقال له بشر: إذا قال لك عيالك: ليس عندنا دقيق ولا خبز فادع الله تبارك وتعالى أنت في ذلك الوقت، فإن دعاءك أفضل من دعائي، وقال بعض السلف: أي أهل المعرفة بالله عزّ وجلّ أنْ يقبلوا هذا العلم وكرهوا أن يسمعوه من الأغنياء وزعموا أنه لا يليق بهم، وقد كان بعض الفقراء يقول: هذا العلم يعني علم المعرفة عوضه الله سبحانه وتعالى الفقراء بدلاً من الدنيا لا يظهره إلا هم ولا يوجد إلاّ عندهم، روحهم الله عزّ وجلّ به في الدنيا وجعله عوضاً لهم مما تركوه له اليوم، فإذا كان غداً فهم الذين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين وهو المزيد، وقد روينا في تفسير قوله تعالى: (وَالمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ) الرعد: 23 قال: الفقر في الدنيا.
فمن فرائض الفقر عند الفقراء: الصبر عليه بترك المسألة قبل ورود الفاقة، وقطع الهمّ عن التشرّف إلى الخلق، وأن لا يتناول عند الحاجة ما حظره عليه العلم، ولا يجاوز حدّاً من حدود الأحكام، وإن سأل عند حاجة لم يستكثر ولم يدّخر، فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن المسألة فلا بأس به، ويتوخّى في مسألته المتّقين: ومن يعلم أنه يتحرّى في مكسبه فإن مسألته عمل له يلزمه التورع فيها، كما يلزمه الورع في مكسبه، ولا يسأل من يعلم أنه لا يبالي من أين يأكل، ومن لا يردع عن الحرام في مكسبه والعبد بنفس الحاجة والجوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم بها صلبه ويسكن بها نفسه، وبنفس العري والعدم يستحق عليهم ثوباً يواري به عورته، وذلك لازم للمسلمين وواجب له، فإن قام به بعضهم سقط عن بعض وجوبه، وإن سأل ذلك فلا شيء عليه، ويقال إنّ كفّارة المسألة صدق السائل في مسألته وصدقه أن لا يسأل إلاّ بعد فاقته ومع خوف التقصير في أداء فرائضه من اختلاف عقله وتشتّت قلبه، وأن يكفّ مع أول الكفاية، ولا يدخر بعد الشبع ليستكثر، ولا يجعل المسألة إن دفع إليها له عادة وكداً ولا حرفة، ومهما استغنى عن السؤال فليكن ذلك أحبّ إليه، فإنه أفضل له، وقد سأل ثلاثة من الأنبياء عند فاقتهم سليمان عليه السلام لما سلب ملكه أربعين يوماً، وموسى والخضر عليهما السلام لما استطعما أهل القرية.
وروينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: للسائل حقّ وإن جاء على فرس، وفي الحديث: ردوا السائل ولو بظلف محرق، فلو كانت المسألة إثماً وعدواناً لم يحثّ على الإعطاء فيكون معاوناً على الإثم والاعتداء، ولكن ذلك من البرّ والتقوى، لأنه سبب منه ودالّ عليه، فعاون بالأمر به لحرمة الإسلام، ولأن المواساة من المعروف والإحسان، وسمع عمر رضي الله عنه سائلاً يسأل بعد المغرب فقال: يا يرفا عشِّ الرجل، فعشّاه، ثم سمعه ثانية يسأل فقال: ألم أقل لك عشِّ الرجل؟ فقال: قد عشيته، فنظر عمر فإذا تحت يدة مخلاة مملوءة خبزاً فقال: لست سائلاً ولكنك تاجر، ثم نثر المخلاة بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال: لست سائلاً، أنت تاجر.
وروينا عن عليّ عليه السلام أنّ لله عزّ وجلّ في خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر، فمن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسن خلقه، ويطيع به ربّه، ولا يشكو حاله، ويشكر الله تعالى على فقره، ومن علامات الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء عليه خلقه ويعصي به ربّه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء؛ فهذا كما قال عليه السلام، وهذا النوع الذي هو عقوبة من الفقر هو الذي استعاذ منه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو فقر النفس، لأن الفقر من المال إنما هو الافتقار إلى الخلق والفقر إلى الأشياء مع عدم صدق الحال.
وقد روينا في الخبر: مسألة الناس من الفواحش ماأحلّ من الفواحش غيرها، وبايع رسول اللّّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوماً على الإسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة، ثم قال كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئاً فكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالتعفّف والكفّ عن المسألة ويقول: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله عزّ وجلّ، وقال: من لم يسألنا فهو أحبّ إلينا، وقال عليه السلام: استغنوا عن الناس، وما قلّ من السؤال فهو خير، قالوا: ومنك يارسول الله قال: ومني، فلو لم يكن في ترك المسألة لادعاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سأل عن غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم، وفي خبر آخر: كانت مسألته خدوجاً وكدوحاً في وجهه، وفي الحديث: استغنوا بغنى الله عزّ وجلّ، قالوا: وما هو؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة، وفي الخبر: من سأل وله خمسون درهماً أو عدلها من الذهب، فقد سأل إلحافاً، ومن كان معه هذا القدر من الدنيا لم يخرجه من عموم الفقراء، فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم، ومن سأل قبل الجوع أو بعد الشبع أو سأل ليدّخر أو سأل وله غداء يوم أو عشاء ليلة أخرجه ذلك من خصوص الفقراء، وسئل سفيان الثوري عن أفضل الأعمال فقال: التجمّل عند المحنة، وعلى الفقير أن لا يزكي غنياً لأجل عطائه، ولا يذمّه ولا يمقته لأجل منعه، ولا يعظم أهل الدنيا، ولا يكرّمهم لأجل دنياهم، وقال ابن المبارك: من تواضع الفقير أن يتكبر على الأغنياء، وعن عليّ عليه السلام في حكاية المنام: ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله عزّ وجلّ، وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عزّ وجلّ، ومن فرائض الفقر أن لا يسكت الفقير عن حقّ، ولا يتكلم بهوى لأجل دوام العطاء من أحد، ولا لاجتلاب نفع؛ فإن ذلك وليجة في الدين ومداهنة للمؤمنين، ومن فضائل الفقر أن لا يدّخر لأكثر من أربعين يوماً، ولا يكون المدّخر أكثر من أربعين درهماً، والأصل في ذلك أنّ الله تبارك وتعالى قال عزّ من قائل: (وَإِذْ وَاعَدنَا مُوسى أرْبعينَ لَيْلَةً) البقرة: 51 فإذا فسح له في تأميل أربعين فالادخّار من الأمل؛ فإن أمل حياة أربعين يوماً جاز له أن يدّخر لأربعين، ومن قصر أمله إلى يوم وليلة لم يدّخر إلاّ ليومه وليلته، فترك الادخّار مقتضى قصر الأمل، وقد جعل غنى الفقير في أربعين درهماً فهذا لعموم الفقراء، فأما خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم أو عشاء ليلة لقصر أملهم، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفاً: استغنوا بغنى الله عزّ وجلّ، قيل: وما غنى الله تبارك وتعالى؟ قال: غداء يوم أو عشاء ليلة، ومن فضل الفقير أن لا يهتم برزق غد كما إن الله تبارك وتعالى لا يطالبه بعمل غد قبل مجيئه، ولأنّ الرزق معلوم مقسوم والوكيل حفيظ قيوم، وأن يكون راضياً بفقره شاكراً عليه ويغتبط بالفقر لعظيم نعمة الله عزّ وجلّ عليه فيه، ويخاف أن يسلب فقره أشد من خوف الغني أن يسلب غناه لشدة اغتباطه به.
وفي الخبر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا معشر الفقراء أعطوا الله عزّ وجلّ الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلاّ فلا، وروى عبد الرحمن بن سابط عن عليّ عليه السلام عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث طويل: أحب العباد إلى الله عزّ وجلّ الفقير القانع برزقه، الراضي عن الله عزّ وجلّ، وينبغي أن يغتمّ بالاتّساع ويفرج بالضيقة والمصيبة، ويحبّ المساكين ويفضّلهم على أبناء الدنيا، ويرحم الأغنياء ولا يذمّهم لأجل غناهم، ويؤثر الفقراء ويقربهم ويحسن على الفقير خلقه، ويحمل معه صبره، ويستر بالتعفف فقره، ويظهر الغنيّ ولا يكشف فقره بالتكرّه له والشكوى، في الخبر عن الله عزّ وجلّ: إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنيّ مقبلاً فقل ذنب عجلت عقوبته، وقال موسى: يا رب مَنْ أحباؤك من خلقك حتى أحبّهم لأجلك؟ فقال: كل فقير فقير التكرار فيه لمعنيين؛ أحدهما المتحقق بالفقر، والثاني الشديد الحاجة والضرّ، وقال عيسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إني لأحب المسكنة وأبغض الغنى، وقيل: كان من أحبّ أسمائه إليه أن يقال له: يامسكين، وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعائه الذي تلقاه من ربه وأمره به: أسألك الطيّبات، وفعل الخيرات، وحبّ المساكين؛ ومما يعتبر به فضل الفقر على الغنى أنّ أفضل الخلق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمن شاركه وقارنه بمعنى وصفه فهو الأفضل لأنه الأمثل فالأمثل وهم الفقراء، وصفهم الله عزّ وجلّ بوصفه فقال تعالى: (وَلاَ عَلَى الَّذينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) التوبة: 92 الآية - فلما شاركوه في العدم وكان حال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الأفضل والأتمّ دلّ على فضل حالهم على غيرهم.
وقد قال الله عزّ وجلّ: (إنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذينَ يَسْتأذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ) التوبة: 39، وقال تعالى: (كَلاّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) العلق: 6 - 7، فوصف الأغنياء بالطفو وأوقع عليهم الحجة، وقال في وصف الفقراء: (يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ) البقرة: 372، فلولا أنّ الغنى مفضول ما نسب من وصفهم به إلى النقص، والغنى باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر المذموم، والفقر باب الآخرة وأصل الزهد والتواضع المحمود، وعند أهل المعرفة: إنّ الغنى من الصفات التي لا ينبغي أن ينازع فيها ومكروهة لمن ابتلي بمعانيها، وأنه مثل العزّ والكبر وحبّ المدح والذكر، فمن أحبّ شيئاً من ذلك وطلبه فقد نازع الله تعالى لبسته، وتركوا ذلك لأجل الله عزّ وجلّ لأنه من صفات الربو بية، وسلّموه له خوفاً منه أو حبّاً له، وإن الفقر من صفات العبودية مثل الرجاء والخوف والتواضع والذلّ، فمن طلب ذلك وأحبّه فقد تحقّق بوصف العبودية، والله سبحانه وتعالى يحبّ أن يتحقق العبد بأوصافه لأنه عبد ذليل، ويكره أن ينازعه معنى صفاته لأنه ملك جليل، ومن أحبّ الغنى دلّ على حبه البقاء، وكان سهل يقول: حبّ الغنى شرك في الربوبية؛ أي لأنّ البقاء من صفات الباقي، ومن فضل الغنى على الفقر دلّ على حبه للغنى فظهر بذلك محبة الأغنياء لأنّ حبّ الوصف دليل حبّ الموصوف، وحبّ الشيء أيضاً دليل على بغض ضده، فإذا أبغض الفقراء أبغض الفقر، وبغض الفقر لحبّ الغنى، فقد اختار الرغبة على الزهد، والكثرة على القلة، والعزّ في الدنيا على الذلّ، وفي هذا إيثار الدنيا على الآخرة، وهدم الآثار عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن الصحابة والتابعين في تفضيل الفقر وتشريف الأغنياء، ويقال: كان الفقر شرف المؤمن وكان الفقراء فيما سلف في المؤمنين بمنزلة الأشراف فيكم اليوم ولا خفاء بفساد هذا القول ونقصه عند العلماء بالله تعالى، ثم إنّ الفقراء على منازل ثلاث؛ فقراء الأغنياء وهم السؤال عند الفاقات، الكافون نفوسهم مع الكفاية، القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة الأغنياء، ومزيدهم من الله تعالى، وهم الذين جعل الله لهم في أموال الأغنياء سهماً، لأنّ منهم السائل والمحروم، ومنهم القانع والمعتر، والطبقة الثانية فقراء الفقراء وهم المتحققون بالفقر، المختارون له، المؤثرون إياه على الغنى، لعظم معرفتهم بعظيم فضيلة أهل التعفّف والصيانة، لا يبتذلون للسؤال ولا يعرضون في المقال، راضون بالميسور من مولاهم، تعرفهم إذا رأيتهم سيماهم: يحسبهم الجاهل أغنياء لترك المسألة والشكوى، ومنهم المحروم حرم السعي للدنيا، ومنهم المحارف انحرفت عنه الأسباب، ومنهم القانع قنع بما يصل إليه من غير امتهان وتبذل فيه، ومنهم المعتر رضي عن الله عزّ وجلّ بما يعتريه، وقيل: إنه ما أعطى أحد شيئاً من الدنيا إلاّ قيل له خذه على ثلاثة لثلاث؛ شغل، وهمّ، وطول حساب، وأما الطبقة الثالثة فهم أغنياء الفقراء وهم الأجواد الأسخياء أهل البذل والعطاء، يأخذون ويخرجون، ولا يستكثرون ولا يدّخرون، إن منعوا شكروا المانع لأنه هو المعطي فصار منعه وإنْ ضيّق عليهم حمدوا الواسع لأنه هو المحمود فصار ضيقه رخاء، وإنْ أعطوا بذلوا وآثروا فهم الزاهدون في الدنيا لأنهم موقنون فكفاهم اليقين غنى.
وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم حين قدم عليه من خراسان: كيف تركت الفقراء من أصحابك؟ فقال: تركتهم إن أعطوا شكروا، وإن أعطوا آثروا فقّبل رأسه وقال: صدقت ياأستاذ وقد كان بشر يقول: الفقراء ثلاثة؛ فقير لايسأل وإن أعطى لم يأخذ؛ فهذا مع الروحانيين في عليين، وفقير لا يسأل وإن أعطى أخذ فهو مع المقربين في حظيرة القدس، وفقير يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقين، وصدقه في حاله كفّارة مسألته، ودفع إلى إبراهيم بن أدهم ستون ألفاً وكان عليه دين وبه حاجات إليها فردّها فعوتب في ذلك فقال: كرهت أن أمحو اسمي من ديوان الفقراء لستين ألفاً، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف وإنّ درعها لمرقوع فقالت لها الخادمة: لو اشتريت لك بدرهم لحماً تفطرين عليه فقالت: لو ذكرتني لفعلت، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصاها فقال: إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تنزعي ثوباً حتى ترقعيه فأما معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفقراء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلعل متوهماً لم يتدبر أول الكلام فظن أنّ هذا تفضيل للأغنياء على الفقراء وإنما هو تحقيق لقوله الأول: قولوا كذا وكذا، فإنه لا يسبقكم أحد قبلكم، ولا يدرككم أحد بعدكم، فقالوه، فلما سمع الأغنياء بذلك فقالوا كقولهم هجس في قلوب الفقراء منه شيء، فاستفتوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتثبتوا في قوله فقال: الأمر كما قلت لكم لا يسبقكم أحد قبلكم إذ قد صحّ منه هذا القول في الأول وهو معصوم فيه، فلو لم يكن كذلك لنقض آخر قوله أوله، ولا يجوز ذلك، وأيضاً فإن حمل على ظاهره كما تأوله، فإنه فضل الله تعالى في الدنيا، لا تفضيل لهم به في الآخرة على مقامات الفقراء، إلاّ إنّ الأولى قد قامت بفضلهم، ويصلح بمعناهم فضل أعطاهم الله تعالى بهذا القول الذي قلتموه، زادهم الله به، لا أنه أفضل من مقامكم وحالكم بغيره، إذ قد ثبت فضلكم عليهم بوصف الفقر وحال الصبر بغير هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجحان لكم تماماً على فضلكم بغيره، وهذا القول للأغنياء تفضيل من الله عليكم ورحمة، إلاّ إنهم يفضّلون به عليكم، ونحن فلم نقل: ليس الغنى طريقاً للأغنياء إلى الله وإنما فضّلنا طريق الفقراء لأنهم الأمثل فالأمثل بالأنبياء، وعن الحسن في قوله عزّ وجلّ: (وَمَا يَسْتوِي الأحْياءُ ولاَ الأمْوَاتُ) فاطر: 22، قال: الفقراء والأغنياء، فجعل الفقراء أحياء بمولاهم، وجعل الأغنياء موتى بدنياهم، وقال الثوري رحمه الله: إذا رأيت الفقير يداخل الأغنياء فاعلم أنه مراء، وإذا خالط السلطان فاعلم أنه لصّ، وقال بعض العارفين: إذا مال الفقير إلى بعض الأغنياء نحلت عروته، فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته، فإذا سكن إليهم ضلّ، فمن فضل الغنى على الفقر بعد الأخبار التي وردت في تفضيل الفقر والفقراء والغنى والأغنياء فأحسن حاله الجهل بالسنن لإيثار الرأي والهوى على ما فيه أثر وسنّة، لأن الأثر إذا جاء في شيء لم يكن للرأي فيه مدخل، وكان في مخالفته مع العلم به عناد ومحادة، نعوذ بالله من الجهل والهوى ونسأله التوفيق للعلم والتقوى.
ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب
فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنيا وكان رزقه قد أجرى على أيدى العباد من غير تعويض منه لهم من صنائع الدنيا معتاد، فقد روينا عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن هذا المال مال الله فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه: فكان كالآكل ولا يشبع، وروينا من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه، وفي لفظ آخر فلا يرده فإن كان محتاجاً إليه وإلاّ فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه، وروينا عن الحسن وعطاء حديثاً مرسلاً أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من أتاه رزقه من غير مسألة فردّه فإنما هو يرده على الله، وروينا عن عابد بن شريح عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما لمعطي من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجاً، وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليه كما لو هرب من الموت لأدركه، وقال أبو محمد رحمه الله: لو أنّ العبد سأل ربه فقال: لا ترزقني لما استجاب له وكان عاصياً، ويقال له: يا جاهل لا بدّ أن أرزقك كما خلقتك، وقد حدثنا بعض العارفين أنه زهد في الدنيا فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار، وقال: لا أسأل أحد أشياء حتى يأتيني رزقي إن كان لي رزق، قال: فأخذ يسيح فأقام في سفح جبل سبعاً لم يأته شيء حتى كاد أن يتلف، قال: يارب إن أحييتني فأتني برزقي الذي قسمت لي وإلاّ فاقبضني إليك فأوحى الله تعالى إليه: وعزتي لا أرزقنّك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس، فدخل المصر للأمر، وأقام بين ظهراني الناس، فجاءه هذا بطعام، وهذا بأدام، وهذا بشراب، فأكل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك، فأوحى الله إليه: أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا أما علمت أني أرزق عبد بأيدي عبادي أحبّ إليّ من أن أرزقه بيد القدرة.
وقال بعض المنقطعين إلى الله من العارفين: كنت ذا صنعة جليلة، فأريد مني تركها، فحاك في صدري: من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه، تنقطع إليّ وتتهمني في رزقك على أن أخدمك وليّاً من أوليائي، أو أسخر لك منافقاً من أعدائي، وفي خبر عن بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا: اخدمي من خدمني واتعبي من خدمك، وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي دراهم أعددتها للإنفاق في سبيل الله، فرأيت ذات لية فقيراً يطوف بالكعبة في طلمة الليل، حسن الهدى والسمت، قال: فكنت أتتبع آثار قدمه وأمشي خلفه من حيث لا يشعر، فلما قضى أسبوعه وقف في الملتزم بين الباب والحجر، فسمعته يدعو دعاء خفياً، فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: جائع كما ترى، عريان كما ترى، فما نرى فيما ترى يا من يرى ولا يرى، قال: فنظرت فإذا عليه خلقان رثاث، لا تكاد أن تواريه فقلت في نفسي: لا أجد لتلك الدراهم موضعاً خير من هذا، قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية قبة زمزم يصلّي ركعتي الطواف، وذهبت إلى منزلي فجئت بالدراهم فدفعتها إليه وقلت: رحمك الله أنت في مثل هذا الموضع، وعلى مثل هذه الحالة، فخذ هذه تنفقها، قال: وصببتها في طرف إزاره بين يديه على الأرض، فنظر إليها ثم أخذ منها خمسة دراهم فقال: أربعة ثمن مئزرين ودرهم أتفوّت به ثلاثاً، ثم قال: لاحاجة لي بسائرها، قال: فرأيته الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان قد لبسهما، قال: فهجس في نفسي من أمره شيء، فقبض على يدي فأطافني معه أسبوعاً كل شوط منها في جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين، منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر، لم يظهر للناس، فقال: هذا كله قد أعطيناه فزهدنا فيه، ونأخذ من أيدي الخلق أحبّ إلينا لأنه أحبّ إلى الله، وأخف علينا في المطالبة؛ وهذه أثقال وفتنة، وذاك للعباد فيه رحمة ونعمة، وروينا في خبر: البلاد بلاد الله والخلق عباده، فأينما وجدت رزقاً فأقم واحمد الله.
وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس في كل شيء إلاّ في الرزق والأجل، أجمعوا على أنّ لا رازق إلاّ الله ولا مميت إلاّ الله، وقال: إنّ الله عزّ وجلّ لما خلق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها في أقطار الأرض ففرقها، فمن الناس من وقع رزقه في مائة ألف موضع، ومنهم من وقع رزقه في عشرة آلاف موضع، ومنهم من ألف موضع، ومنهم من مائة موضع، ومنهم في موضع وأقل وأكثر، ومنهم من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروم إليه، وكل عبد يسعى بأثره الذي كتب له حتى يستوفي رزقه الذي قسم له، فإذا فني أثره واستوفى رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه، واعلم أنّ العبد لا ينقطع رزقه أبداً منذ أظهرت خلقته كان في بطن أمه، غذاؤه مما تفيض الأرحام من دم الحيض، يعيش بذلك جسمه من ظاهره، ومعاه المستطيل من سرّته متصل بمعي أمه، يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنه، فيعيش بذلك؛ فإذا أذن الله عزّ وجلّ بخروجه بعث إليه الملك، فقطع ذلك المعي من موضع اتصاله بمعي أمه؛ فإذا دخل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنيا؛ فإذا خرج منها فآخر رزقه من الدنيا أول رزقه من الآخرة؛ فإذا دخل في الآخرة كان رزقه من البرزخ كما كان في الدنيا بتلك المعاني لمعاينته المختلفة المحتملة؛ لذلك فإذا خرج من البرزخ ودخل في القيامة كان رزقه في الموقف على قدر حاله هناك؛ فإذا خرج من الموقف دخل أحد الدارين انتقل رزقه إليها فكان منها إلى أبد الأبد؛ فإذا شهد العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه فاستوى عنده الرزق والأجل فعلم يقيناً أنّ لا بدّ من رزق كما لابدّ من أجل، فلم يكن عليه إلاّ مراعاة الأحكام فيه، وشهد من هذه الشهادة أنّ خلقاً لا يقدر أن يزيد في عمره ساعة ولا ينقص منه ساعة؛ فإذا أيقن بهذا كان مشغولاً بالمخالصة لمولاه فيما تعبده به وولاه، ثم أنّ الرزق على وجهين؛ عن معان لا تحصى وبأسباب لا تعدّ ولا تضبط، فمن الرزق ما يأتي العبد بسكونه وقعوده فيكون الرزق هو الذي تحرك إليه ويأتيه، ومنه ما يأتي العبد بحركته وقيامه فيكون يتسبب إليه ويطلبه، والرزق فيهما واحد والرازق بهما واحد، الحكمة والقدرة في المتحرّك القائم وفي الساكن القاعد واحد، إلاّ إنّ الأحكام فيهما متفاوتة، ثم إنّ الأشياء كلها على ضربين: مسخّر لك ومسلّط عليك، فما سخر لك سلطت عليه وهو نعمة عليك وعليك الشكر عليه؛ وهذا مقام الشكر على معنى الرزق، وما سلط عليك فقد سخرت له أنت وهو بلاء عليك وعليك الصبر فيه؛ وهذا مقام الصبر عن معنى الابتلاء، فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه فقام بحكم ما عرف، ومن لم يشهده جهل حاله ولم يدر مقامه فاضطرب فيه فضيّع حكم الله عليه والمستحبّ لمن لا معلوم له أن لا يأخذ مما آتاه إلاّ قدر الحاجة، وعلامة حاجته هو أن لا يأخذ إلاّ ما يحتاج أن يشتريه فهو حاجته في وقته؛ فذاك رزق من الله تعالى ومعونة له، فأخذ هذا أفضل وما آتاه مما لا يحتاج أن يشتريه أو عنده مثله فهو اختبار له وابتلاء لينظر كيف زهده في فضول حاجته، وكيف رغبته في الاستكثار، لأنه إذا ملك الشيء فكأنه قد كان له فيعلم الآن بمعرفته أنّ هذا ابتلاء من الله، وفيه حكمان؛ أحدهما أن يأخذه في العلانية ويخرجه في السرّ إلى من هو أحوج إليه منه؛ هذا طريق الأقوياء، ومن أشد الأشياء على النفس وهو الذي أمر به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر وغيره؛ وهذا حال علماء الزاهدين، والحكم الآخر أن لا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه لأن الله تعالى له عليه فيه أحكام؛ وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد، فإما أن يأخذه من غير حاجة ليتكثر به ويدّخره فلا أعلم في هذا طريقاً إلى الله تعالى، وما لم يكن طريقاً إلى الله فهو من طرقات الهوى إلى العدوّ، ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إلى أحكامه فيه، فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على أربابها المشترط له الأوصاف الستة المنصوص عليها في الكتاب؛ فذلك أضيق عليه وألزم له في الاحتياط لأخيه أن يضعه في حقيقة موضعه عند أخيه نصحاً لله تعالى في دينه ونصحاً لإخوانه في ربه فإنّ الأفضل في ذلك أن لا يضعه إلاّ في أربعة أشياء: مطعم، وملبس، ومسكن، ودين في قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما صرفت فيه الواجبات.
وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه، وفضول الدنيا وهو الزيادة على الكفاية لا يحتاج إليه، والدين يحتاج إليه، فلا ينبغي للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دنياه، فتكون صفقته خاسرة وتجارته بائرة، والشهوات لا حدّ لها لأنه لا غاية ينتهي إليها فيها، والقوت له حدّ وغاية ينتهي إليه فيها، وقد جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا حقّ لابن آدم إلاّ في ثلاث؛ طعام يقيم صلبه، وثوب يواري عورته، وبيت يكنّه، فما زاد فهو حساب؛ وهذه الثلاث مع ابن آدم في بطن أمه، وفي قبره، وبين ذلك في دنياه، وبعد ذلك في عقباه، فالأخذ لمصالح هذه الثلاث مأجور عليه العبد والردّ لما زاد عليها هو أفضل من الأخذ، وينبغي أن يكون العبد الذي لا معلوم له عارفاً بأحكام العطاء؛ فإن العطاء من الله لعبده على أربعة أنواع: نوعان محمودان، ونوعان مكروهان، فالمحمودان ما كان بمعنى الرفق والمعونة، والمكروهان ما يكون بمعنى الاختبار والابتلاء، وبين الرفق والمعونة فتفصيل ذلك أنّ الابتلاء ما جاءه من الأسباب قبل الحاجة إليه أو جاءه وله غنية عنه أو عنده مثله؛ فهذا ابتلاء من الله تعالى له لينظر عمله فيه، فالأفضل في هذا أن يخرجه فيكون معاملاً لله تعالى به في السرّ مسقطاً لمنزلته عند الناس في العلانية، فإن لم يقوَ على هذا الثقل وحمله على النفس فالأفضل بعده أن لا يأخذه ليحكم الله فيه ما يشاء ونصحاً لأخيه في ما له - سيما إن كان من الواجب والاختيار - أن يكون الفقير قد نوى ترك أكل شيء أو اعتقد التقلّل في شيء قربه إلى ربّه تعالى لمخالفة هوى نفسه وعملاً في صلاح قلبه يتباعد به مما يدخله في الكثرة ويحلّ عليه عقده، فردّ هذا أفضل وهو من الزهد والرعاية للعهد، فإن أخذه ثم أخرجه إلى محتاج؛ فهذا هو زهد الزهد، وله في هذا معاملات؛ منها أنّ العبد مندوب إلى الإيثار، فإذا كان فقيراً وملك شيئاً فأخرجه كان في ميزانه، ومنها موافقة السنّة في أنه قد أمر بأخذه أو دفعه إلى من هو أحوج إليه منه، ومنها إنّ أخذ هذا في العلانية من الناس وردّه في السرّ إلى الله تعالى كبيرة على النفوس إلاّ على الخاشعين لأنّ النفس تسقط في منزلتها، ثم لا ينال به سعتها فلا يصبر على هذا إلاّ الموقنون؛ وهذا مقام الزاهدين في النفس؛ وهو حال أغنياء الفقراء، وعلماء الزهاد، وهم أهل الطبقة العليا الذين قدمنا ذكرهم: والوجهان الآخران من العطاء هو الرفق وصورته أن يأتيه الرزق عند حاجته أو مع شهوته للشيء الذي لا يقدر عليه، فيعلم الله ذلك منه فيبعث به إليه من غير طمع في خلق، أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه ليرتفق بمنافعه، فهذا النوع من العطاء رفق الله سبحانه، الأفضل للعبد أن يأخذه وربما خيف من ردّ مثل هذا عقوبة من زوال عقل أو رد إلى غلبة طبع أو ابتلاء بطمع خلق أو دخول في دنيء من مكسب.
وقال بعض العلماء: من أعطى ولم يأخذ سأل ولم يعط، وهذا من النوع الذي قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما المعطي من سعة بأعظم أجراً من الآخذ إذا كان محتاجاً، فأخذ هذا مشاركة لمعطيه في الأجر من حيث استويا على المعاونة في التقوى والبرّ المأمور بهما، ولا يضرّ هذا العطاء آخذه، وقد كان سري السقطي يوصل إلى أحمد ابن حنبل شيئاً فيرده فقال له سري: يا أحمد إحذر آفة الردّ فإنها أشدّ من آفة الأخذ، فقال له أحمد: أعد علي ما قلت فأعاده، فقال أحمد: ما رددت عليك إلاّ لأن عندي قوت شهر فأحبسه لي عندك، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلىّ، والرابع من العطاء هو المعونة؛ وهذا يكون مخصوصاً لأهله هو أن يكون في خلق هذا الفقير البذل والإفضال وفي غريزته السخاء والاتساع من إطعام الطعام وإيثار الفقراء، فلا يتسع لذلك حاله وتضيق عنه يده فيبعث الله إليه بالعطاء معونة له على أخلاقه ليبلغه به مراده، وينفذ له من المعروف والبرّ عادته، ويعينه على خلقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو الاختبار عند العارفين والأفضل أخذه وإمضاؤه في سبله من المروءات والأخلاق؛ وهذا كان طريقة كثير من السلف، وقد غلط في هذا الطريق قوم لم يكن لهم زهد وقد كانت فيهم رغبة وهمم دنيئة، فاقتنعوا في قبول هذا العطاء لنفوسهم وتملكوه واستأثروا به وزعموا أنّ هذا هو الاختبار، فخالفوا السلف في معرفة الابتلاء من الاختبار لأن هذا عند العارفين، إذا لم ينفذ ويؤثر به ابتلاء ووافقوا أهواءهم في التوسع منه والتكثر به، وتملكوه بالدعوى فأخطؤوا في العلم لإحالة المعنى وغلطوا في طريق الحال لوجود الهوى، وقد كان بعض القاعدين من الصادقين يدان على الله لحسن ظنه به، فإذا رزقه قضاه، فإن مات هذا على هذه النية فلا تبعة عليه فيه في دينه، على مولاه قضاؤه، وأن يرضى عنه غرماءه، وقد كان فيما سلف يقضي دين مثل هذا من بيت مال المسلمين، وكان آخرون لا يقترضون حتى يبيع أحدهم أحد ثوبيه أو فضل ما يحتاج إليه؛ وهذا أحد الوجوه في قوله تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ الله) الطلاق: 7، قال: من ضيقّ عليه معاشه فليبع أحد ثوبيه، وقد قيل: فليستقرض بجاهه فذلك آتاه الله عزّ وجلّ.
وقال بعضهم: لله عباد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عباد ينفقون على قدر حسن الظن به، ومات بعض السلف فأوصى بماله أن يفرّق على ثلاث طوائف: الأقوياء والأسخياء والأغنياء فقيل: من هؤلاء؟ قال: أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الله، وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظن بالله، وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله، وينبغي لمن لامعلوم له من الأسباب أن يتورع في أخذها ويتحرّى المعطين لها، كما يتحرى أهل المكاسب في الاكتساب؛ لأن الله سبحانه وتعالى له في كل شيء حكم، والقعود عن المكاسب لا يسقط أحكامها، والقاعد عن الطلب لا تسقط عنه أحكام الطالب، لأنّ ترك العمل عمل يحتاج إلى عمل، ولم تكن سيرة الفقراء الصالحين أن يأخذوا من كل أحد، ولا في كل وقت، ولا يأخذون كلما يعطون مما زاد على كفايتهم إلاّ أنْ يكونوا ممن يخرجه إلى غيرهم، وإنما كانوا يقبلون ممن يخف على قلوبهم القبول منه وممن يرتفع الوحشة والحشمة فيما بينهم وبينه؛ لأنّ ذلك هو الذي يفرح بقولك ويرى نعمة الله تعالى عليه في أخذك ومن يثقل على قلبك معروفه فهو الذي يثقل على قلبه إخراج ما في يده ولا يغتم بردك عليه.
وقال بعض العارفين ما تواخى اثنان في الله عزّ وجلّ فاحتشم أحدهما من صاحبه أو استوحش منه إلاّ من علّة في أحدهما، فلا يستحبّ للفقير أن يأخذ إلاّ من صديق، ولا يقبل إلاّ ممن يحبّ لأن لأهل المعرفة بالله عزّ وجلّ أن يحكموا في الأسباب بما أراهم الله تعالى من الردّ أو من القبول، فإن اعتلّ معتلّ بما رويناه آنفاً من جاءه شيء من غير مسألة فردّه فإنما يردّه على الله تعالى، وبأن أهل المعرفة يشهدون أن العطاء من الله سبحانه وتعالى فلا يصلح أن يردوا عليه، قيل له: إنّ من يشهد العطاء من الله تعالى هو الذي يشهد الردّ أيضاً منه، فإن يردّ إليه له أو ردّ إليه به لمعرفته باختباره وابتلاء حسن الردّ منه وشكر الفعل له، فهو أيضاً إذا شهد تصريف الخلق بالعطاء فعل الله عزّ وجلّ، كان يشهد فعل نفسه بالردّ، فعل الله تبارك وتعالى بالمنح؛ فالحالان سواء عند من علم الأحكام، ولم يتّبع الهوى، وقام بحكم ما منه يقتضي، فليس في هذا حجة إلاّ لعالم مستكثر، أو لعابد جاهل غير مستبصر، على أنّ في القبول من بعض الناس دون بعض، وفي ردّ بعض الهدية سنّة، أهدي إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمن وإقط وكبش فقبل السمن والإقط وردّ الكبش، وقد كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل من بعض الناس ويردّ على بعض، وقال: لقد هممت مراراً أن لا أتهب إلاّ من قرشي أو ثقفي أو دوسي وفعل هذا جماعة من التابعين.
جاءت صرّة إلى فتح الموصلي فيها خمسون درهماً فقال: حدثنا عطاء أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من أتاه رزق من غير مسألة فردّه، فإنما يردّه على الله عزّ وجلّ، ثم فتح الصرّة فأخذ منها درهماً وردّ سائرها، وقد كان الحسن البصري يروي هذا الحديث أيضاً، ثم حدثنا عنه أنّ رجلاً أهدى إليه كيساً فيه مال ورزمة فيها من دق خراسان، فردّ ذلك، فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال: من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله عزّ وجلّ يوم القيامة، وليس له عند الله عزّ وجلّ خلاق، وقد كان الحسن يقبل من أصحابه، وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم ونحوه، ويعرض عليه غيرهم المائتين فلا يأخذ، وقد كان بشر بن الحارث لا يقبل من الناس شيئاً، وكان بعضهم يقول: أحبّ أن أعلم من أين يأكل؟ فقال له: من يخبر أمره؟ أنا أدري من أين يأكل، له صديق عاقل يعني نظيره في العقل والدين، لأنّ بعضهم كان لا يقبل إلاّ من نظرائه، لا من الأتباع، وهذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته، ولم يكن يظهر أمره، ولا يلتقي معه؛ هو سري بن المغلس السقطي، لأنّا حدثنا عن بشر أنه قال: ما سألت أحد قط شيئاً من الدنيا إلاّ سريّاً السقطي، لأنه قد صحّ عندي زهده في الدنيا، فهو يفرح بخروج الشيء من يده، ويتبرم ببقائه عنده، فأكون أعينه على ما يحبّ.
وقد كان سري يوجه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته فيقبل منه، وكان إذا ذكر عند أحمد يقول: ذاك الغني المعروف بطيب الغنى أنه ليعجبني أمره، وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشيء يقول: دعه عندك، وأعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد الأخذ أفضل أو دون ذلك وأصدقني، فإن قال له: أنت عندي الآن أفضل منك قبل ذلك قبل، وإن أخبره بنقصانه في قلبه لم يقبل منه، وكان بعضهم يردّ على أكثر الناس صلته فعوتب في ذلك فقال: ماأردّ إلاّ إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم، يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم، وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري، وقد كان يشترط على بعض من يأخذ منه أن لا يذكره إشفاقاً عليه من ذهاب أجره، لأنه قيل في معنى قوله عزّ وجلّ: (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذى) البقرة: 264 قال: المنّ أن يذكره والأذى أن يظهره، وقال الجنيد للخراساني الذي جاءه بمال وسأله أن يأكله فقال الجنيد: بل أفرقه على الفقراء، فقال: أنا أعلم بالفقراء منك ولم أختر هذا، فقال الجنيد: أنا أؤمل أن أعيش حتى آكل هذا، فقال: إني لم أقل لك أنفقه في الخل والكامخ والبقل، إنما أريد أن تنفقه في الطيبات وألوان الحلاوة فكل ما نفد أسرع كان أحب إلي فقال الجنيد مثلك لا يحل أنْ يرد عليه، فقبله، فقال الرجل: ما ببغداد أحد أعطم منة عليّ منك، فقال الجنيد: وما ينبغي لأحد أن يقبل منه إلاّ من كان مثلك؛ فهذه كانت طرائق أهل الحقائق، ولا ينبغي للقاعد عن المكاسب إلاّ أن يكون تاركاً ذلك لأجل الله سبحانه، عالماً في قعوده بأحكام الله عزّ وجلّ، قائماً بعلم حاله، فيحسن يومئذ قعوده عن الأسباب ثقة منه بالمسبّب الوهاب، ويحلّ تركه للمعلوم يقيناً منه بالعالم.
وقد كان بعض العلماء يقول: لا تأكل إلاّ عند من يعلم أنك أكلت رزقك، ولا تشكر عليه إلاّ ربك، ودعا بعض الناس شقيقاً البلخي وكان في طبقة من أصحابه نحو الخمسين رجلاً، فوضع الرجل طعاماً واسعاً وأنفق نفقة كثيرة، فلما قعدوا قال لهم شقيق: إنّ هذا الرجل يقول: من لم يرني صنعت هذا الطعام وأنا أقدمه إليه فطعامي عليه حرام، قال: فقاموا كلهم خرجوا إلاّ شاباً كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم، فقال صاحب المنزل لشقيق: رحمك الله ماأردت إليّ هذا؟ فقال: أردت أن أجرّب توحيد أصحابي أي كلهم، لا يراه فيما صنع ولا ينظرون إليه فيما قدّم إلاّ ذلك الغلام وحده.
وحدثونا عن موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ياربّ جعلت رزقي هكذا على أيدي بني إسرائيل يغديني يوماً هذا ويعشّيني هذا الليلة، فأوحى الله إليه: هكذا أصنع بأوليائي أجري أرزاقهم على أيدي الطالبين من عبادي ليؤجروا فيهم، والعالم القاعد عندهم أفضل من الجاهل المتصرف، والعالم المتكسّب أفضل من القاعد الجاهد، والقوي التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف المتصرف، والقوي المتصرّف أفضل من الضعيف التارك للتصرف.
وقد جعل الله المستحقين للعطاء ستة، ذكرهم في آيات ثلاث، فقال عزّ وجلّ في الآية الأولى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) التوبة: 60 وقال في الثانية: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) الذاريات: 19، وقال في الثالثة: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الحج: 36، فمن لامعلوم له من تكسّب أو تصرّف فهو أدخل شيء في هذه الآيات وأحوج أحد إلى الإعطاء، ومن كان ذا معلوم يحتاج إلى أكثر منه لفضل عيلة أو كثرة نفقة فإنه يدخل بمعنى من أوصافهم، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين نزلت في أهل الصفة، ومن كان في معناهم إلى يوم القيامة، وكانوا أربعمائة وخمسين رجلاً لم تكن لهم عشائر بالمدينة ولا أموال كالمهاجرين والأنصار، وكانوا نزاع القبائل، أسكنهم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفّة المسجد، وقسم اللّّه عزّ وجلّ لهم الأموال، ثم إنّ الله سبحانه وتعالى أفرد طبقة سابعة عن جمل هؤلاء الستة، ووصفهم بأحسن الصفات، وفضّل أجور المتّقين بطيب الاكتساب عليهم الطالبين وجه الله عزّ وجلّ فقال: (يَاأَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة: 267 وقال: (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إليْكُمْ) البقرة: 272، وكل هذا متصل متعلق بقوله عزّ وجلّ: (للفُقَراءِ الَّذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ الله لاَ يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً في الأَرْضِ) البقرة: 372، إلى آخر أوصافهم، فوصفهم بالإحصار في سبيله وبالعفة عن الدنيا وأبنائها، وأنهم لا يلتحفونها التحافاً لزهدهم فيها وسمى من لا يعرف أوصافهم جاهلاً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات الموسومة بالصدقات المقسوم عليها الزكوات، بل أمر المؤمنين بالإنفاق عليهم من الاكتساب للطيّبات من بعد وصف أحسن الخالقين لهم، والله تبارك وتعالى لا يحبّ عبداً إلاّ وصفه، فإذا مدحه بوصف وأثنى عليه ثبتت محبته له في المدح والوصف، دليل على الحبّ والمحبّة، تدل على الفضل العظيم، كما قال تعالى في آخر وصف المحبين: (ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) المائدة: 54 وقد قال بعض الصوفية في معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يد المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلى، إنّ المعطى هو الفقير وإنّ المعطي هو الغني، ويصلح أن يستدلّ له بأن حقيقة الإعطاء هو النصيب من الآخرة وعطاؤه منها، فصار هو المعطى وصار الغني هو المعطي، ويكون دليل هذا القول الخبرين الآخرين قوله: إنّ الصدقة تقع بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها في يد السائل، فقد صارت يد الفقير هي العليا، والخبر الآخر: يد الله العليا ويد المعطي الوسطى فهذا يصحح أنّ الفقير هو المعطى إذا كان يد الله تبارك وتعالى فوقه لأنها هي التي تضع في يده العطاء فكانت يده هي الوسطى.
فإن قيل: قد رتب الأيدي بقوله تعالى: يد الله هي العليا ويد المعطي هي الوسطى ويد المعطى هي السفلى، فينبغي أن يكون المعطي هو الغني إذا كان العطاء يظهر عندنا على الترتيب، قيل له: إنّ يد الله تبارك وتعالى فوقهما معاً وهي لا تدخل تحت الترتيب، فيده سبحانه وتعالى العليا عليهما جميعاً، قال تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم وقد علمنا أنّ أيديهم بعضها فوق بعض، ثم أخبر مع ذلك أنها فوق الكل ولأنه هو المعطي الأوّل لهما جميعاً، فكما لا أول؛ أول منه في العطاء، فكذلك لا يد فوق يده في الإعطاء، وإنما الترتيب بين الغني والفقير أيهما المعطي بعد يد الله تعالى فقلنا: إنّ المعطي في الحقيقة إذ كان العطاء الحقيقي هو ما يبقى ويدوم لا ما يفنى ويزول؛ وذلك هو العطاء من الآخرة الباقية، فصار الفقير هو المعطي للغني في الدنيا نصيبه من الآخرة لأنه عمارة منازله فيها، والغني رفق بالفقير من الدنيا وعمارة دنياه الفانية، والدنيا موصوفة بلا شيء، فأي شيء يعطي منها؟ فأما يد الله تعالى فإنها فوقهما، والذي أعطاهما جميعاً، لأنّ يده فوق الفوق وفوق التحت لا يوصف بتحت ولا بأسفل، تعالت أوصافه العليا عن نعوت الخلق السفلى، وهو لا يدخل تحت القياس والتشبيه، فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقال: رأيت أبا الحسن النوري يمد يده ويسأل الناس في بعض المواطن قال: فأعظمت ذلك واستقبحته، فأتيت الجنيد فأخبرته فقال: لا يعظم هذا عليك، فإن النوري لم يسأل الناس إلاّ ليعطيهم إنماسأل لهم ليثيبهم من الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضرّه، ثم قال: هات الميزان قال: فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فألقاها على المائة، ثم قال: احملها إليه، قال: قلت في نفسي إنمايوزن الشيء ليعرف مقداره فهذا قد خلط منه شيئاً آخر فصار مجهولاً وهو رجل حكيم فاستحييت أن أسأله عن ذلك، قال: فذهبت بالصرّة إلى النوري فقال: هات الميزان، قال: فوزن مائة درهم وقال: ردّها عليه، وقل آه: أنا لا أقبل منك أنت شيئاً، وأخذ مازاد على المائة، قال: فقلت هذا أعجب فسألته: لم فعلت هذا؟ فقال: الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه وزن هذه المائة لنفسه للثواب من الآخرة، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله عزّ وجلّ، فأخذت ماكانت لله عزّ وجلّ، ورردت ما كان جعله لنفسه، قال: فرددتها إلى الجنيد فبكى، وقا حلب أخذ ماله ورد مالنا والله أعلم.
ذكر اختلافهم في إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أنّ الإظهار أفضل وتفضيل ذلك:
قد اختلف فعل المخلصين في ذلك فرأى بعضهم أن يخفي ما يأخذ من العطاء، لأنه أدخل في التعفف وأقرب إلى التصوّن، وأنه أسلم لقلوب الغير وأصلح لنفوس العامة، وأنّ فيه النصرة لإخوانه من الغيبة والتهمة بمثل ذلك أو بأكثر منه، وفيه الاحتياط لأخيه وعون له على البرّ والتقوى في قوله عزّ وجلّ: (إنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة: 271، وللخير الذي جاء: أفضل الصدقة جهد المقلّ إلى فقير في سرّ، ولأنّ عمل السرّ يفضّل على عمل العلانية بسبعين ضعفاً فإذا لم يعاونه هذا على إخفاء عطائه، ولم يساعده على كتم معروفه فلم يتم له ذلك بنفسه، لأنه سرّ بين اثنين إن أفشاه أحدهما أو لم يتفقا على كتمه فقد ظهر من أيها كان الخبر كيف، وقدروي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استعينوا على أموركم بالكتمان، فإنّ كل ذي نعمة محسود، وهذا مذهب القرّاء من العابدين، وقال أيوب السجستاني: إني لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني حسد، وقال بعض الزاهدين: ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون من أين، هذا وحدثونا عن إبراهيم التيمي أنّه رأى صاحباً له عليه قميص جديد فقال: من أين للك هذا؟ قال: كسانيه أخي خيثمة ولو علمت أنّ أهله علموا به ما قبلته، ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فردّه ودفع إليه آخر شيئاً في السرّ فقبله، فقيل له في ذلك فقال: إنّ هذا أخفى معروفه وعمل بالأدب في معاملته فقبلنا عمله، والذي أظهر معروفه أساء في الأدب في المعاملة فرددنا عمله عليه، ودفع بعض الناس إلى بعض الصوفية شيئاً بين الملاء فردّه فقيل له: لم تردّ على الله عزّ وجلّ ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه وتعالى فيما لله، ولم تقنع بعين الله عزّ وجلّ فرددت عليك شركك، وقد كان بعض العلماء لا يقبل في العلانية ويأخذ في السرّ سئل عن ذلك فقال: إنّ في إظهار الصدقة إذلالاً للعلم وامتهاناً لأهله وما كنت بالذي أرفع شيئاً من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله، وكذلك حدثنا أنّ رجلاً دفع إلى بعض العارفين شيئاً علانية فردّه ثم دفعه إليه في السرّ فقبله، فقيل له: رددت في الجهر وقبلت في السرّ؟ فقال: لأنك أطعت الله تعالى في السرّ فأعنتك على برّك بقبوله، وعصيته بالجهر فلم أكن عوناً لك على المصية، وقد كان سفيان الثوري يقول لو علمت أنّ أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث بها لقبلت صلته، وفي هذا لعمري مواطأة لما ندب الله تعالى إليه من الإخفاء ولما أمر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضله من أعمال السرّ، وهو أيضاً لا يدخل الآخذ في نهي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله: من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، وقال في الحديث الآخر: أفضل ما أهدى الرجل إلى أخيه ورقاً أو يطعمه خبزاً، فجعل الورق هدية كالهدايا، وهو من أفضلها، كما قال: لأنه قيّم الأشياء، فهذا الآخذ للهدية جهراً يلزمه الإشراك للحاضرين فيها إلاّ أنْ يهبوا ذلك له، فإن لم يفعل لم يعجبني ذلك.
وذهب آخرون من أهل المعرفة الموصوفين بالتوحيد إلى أنّ الإظهار للآخذ أفضل، لأنه أسلم له، وأدخل في الإخلاص والصدق، وأخرج من الثبات والقدر والمنزلة والجاه بالردّ والزهد، وقد قال الله سبحانه: (لاَتُكَلَّفُ إلاَّ نَفْسَكَ) النساء: 84، قالوا: فليس علينا إذ علمنا في سلامتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا بالأخذ علانية ما وراء ذلك من أقوال الناس، بتولى الله عزّ وجلّ من ذلك من به ابتلاه، وقالوا: ولأن في التوحيد أنّ الظاهر والباطن هو المعطي فلا معنى للردّ عليه في الظاهر، وقد قال بعضهم: سرّ العارف وعلانيته واحد، لأن المعبود فيهما واحد، فاختلاف فعل أحدهما شرك في التوحيد، وقال بعض العارفين: كنا لا نعبأ بدعاء من يأخذ في السرّ فرفع يده به علانية، ثم قال: هذا من الدنيا والعلانية في أمور الدنيا أفضل والسرّ في أمور الآخرة أفضل، وقال بعض المريدين: سألت أستاذي وكان أحد العارفين عن إظهار السبب أو إخفائه فقال: أظهر الأخذ على كل حال إنْ كنت آخذاً، فإنك لا تخلو من أحد رجلين، رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو الذي تريد، لأنه أسلم لدينك وأقلّ لآفات نفسك، وينبغي أن تعمل في ذلك، فقد جاءك بلا تكلّف، ورجل تزداد وترتفع في قلبه فذاك هو الذي يريد أخوك لأنه يزداد ثواباً بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيده، وينبغي أن تعمل في ذلك، وقال بعض العارفين: إذا أخذت فأظهر فإنها نعمة من الله إظهارها أفضل، وإذا رددت فأخف فإنه عمل لك وإسراره أفضل، وهذا لعمري قول فصل، وهو طريق العارفين، وقال بعض علمائنا: إظهار العطاء من الآخذ آخرة وكتمانه دنيا وإظهار الأعمال من الدنيا وكتمها آخرة، وكان هذا لا يكره الإظهار، وهذاكما قال الله تعالى: (وَأَمَّا بِنعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) الضحى: 11 وقد ذمّ الله تبارك وتعالى من كتم ما أتاه الله من فضله وقرنه بالبُخْلِ؛ والبخل باب كبير من الدنيا فقال تعالى: (الَّذينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النَّاسَ بالبُخْلِ وَيَكْتُمونَ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ) النساء: 37، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أنعم الله عزّ وجلّ على عبد نعمة أحبّ أن ترى عليه، وهذا هو الأقرب إلى قلوب الموحدين من العارفين، لأنه مقتضى حالهم وموجب مشاهدتهم لاستواء ظروف الأيدي عندهم من العبيد ونفاد نظرهم إلى المعطي الأول، فاستوى سرهم وعلانيتهم في الأخذ من يده، وفصل الخطاب في هذا الباب عندي أنه يحتاج إلى تفصيل فنقول والله أعلم: إنّ الخلق مبتلي بعضه ببعض، وفرض كل عبد القيام بحكم حاله ليفضل بقيامه ويسلم في حاله، فعلى المعطي أن يخفي ويسرّ جهده، فإن أظهر ترك علم حاله فنقص بذلك، فكانت هذه آفة من آفات نفسه وباباً من أبواب دنياه، وعلى المعطي أن يذكر وينشر، فإن أخفى وكتم فقد ترك الإخلاص في عمله ونقص لذلك، وكانت آفة من آفات نفسه وباباً من دنياه مثله.
وروينا أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: إنّ فلاناً أعطيته ديناراً فأثنى بذلك وشكر، فقال: لكن فلان أعطيته ما بين الثلاثة إلى العشرة فما أثنى ولا شكر، فكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مريداً أن يشكره أو يثني عليه وهو يقول لابن الحمامة الشاعر وغيره: أما ما مدحتني به فألقه عنك، وأما مامدحت به ربك عزّ وجلّ فهاته، فإنه يحبّ المدح لكنه أراد منه القيام بحكم حاله لعلمه أنّ في الشكر والثناء حضّاً وتحريضاً على المعروف والعطاء، وأنه خلق من أخلاق الربوبية، أحبه الله عزّ وجلّ من نفسه فشكره للمنفقين وهو الرازق، وأحبّ من أوليائه أن يشكروا للأواسط ويثنوا به عليهم، وإنْ شهدوا فيه الأول، وكذلك لما قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا خيراً من قوم نزلنا عليهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كلّه، فقال كلاماً شكرتم لهم وأثنيتم به عليهم، ولذلك أمر به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الآخر فقال: من أسدي إليه معروف فيلكافئ به، فإن لم يستطع فليثن به، وفي لفظ آخر: من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فأثنوا به خيراً وادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه، والخبر العام بمعنى ذلك: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقد روينا في معنى الحدث لفظة غريبة جاءت من طريقين، وهو: من لم يذكر الناس لم يذكر الله عزّ وجلّ أن يذكرهم في العطاء ويثني عليهم به، والنوع الثاني من التفضيل أنّ على المعطي أن لا يحبّ أن يذكر معروفه ولا يشكر فإن علمت من يقصد ذلك ويحبه منك فهذا يدل على نقصان علمه وقوة آفات نفسه، فترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقير أفضل، فإن شكر له فأظهر عطاءه فقد ظلمه لإعانته إياه على ظلم نفسه، وقد قوى آفات نفسه، وهذا إذا فعله به من المعاونة على الإثم والعدوان فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره إذا كان ظالماً من حيث لا يعلم بأن يخفي عليه ما يعمل والله أعلم بالصواب.
نوع آخر من التفضيل في الآخذ للفقير:
إنّ من الناس من يستوي عنده إظهاره للعطاء وإخفاؤه لصحة يقينه بذلك وإخلاص نيته فيه ونفاد مشاهدته بدوام نظره إلى المنعم الأول، فهذا إن قبلت منه علانيته صلح وإن أثنيت عليه بذلك جاز لقوة معرفته وكمال عقله وسبق نظره إلى مولاه فيما وفقه به وتولاه، فيشكر له ذلك ويراه نعمة منه، ولمثل هذا جاء الخبر المشهور: إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه،، وقال بعض العارفين: يمدح الرجل علي قدر عقله، وقال الثوري: من عرف نفسه لم يضرّه مدح الناس له.
النوع الرابع من التفضيل
من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك واعتورته الآفات من التزين والتصنع، فمثل هذا لايصلح أن يقبل منه ما أعلن به لأنه يكون معيناً له على معصيته، وهذا أيضاً لا يصلح أن يثني عليه، فإن ذكر بمعروفه أو مدح به، كان ذلك مفسدة له واغتراراً منه لقوة نظره إلى نفسه ونقصان معرفته بربه، فمن مدح هذا فقد قبله ومن ذكره بمعروفه فقد أعانه على شركه، ومدح رجل رجلاً عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ضربت عنقه، لو سمعها ما أفلح وقد كان هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يثني على قوم في وجوههم ومن حيث يسمعون لثقته بيقينهم وعلمه أنّ ذلك مزيداً لهم، وقال لرجل أقبل إليه: هذا سيّد أهل الوبر، وقال لآخر من حيث يسمع: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، وتكلم رجل بكلام فصل فأعجبه فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنّ من البيان سحراً، وقد كان يخفي الثناء على آخرين إذا علم أنّ ذلك خير لهم، وقال الثوري ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفاً فكنت أنا أسرّ به منك ورأيت ذلك نعمة من الله تعالى عليّ وكنت أشدّ حياء منك فاشكر، وإلاّ فلا، فجملة ذلك أنّ المعطي حاله الإخفاء وأنّ الآخذ حلاه الإظهار، فمن خالف ذلك فارق حاله، وإن فرض المعطي أن يكره المدح ولا يحبّ الثناء والذكر، فمن علمت منه ذلك فعليك أن تثني وتشكر وتنشر، ومن علمت منه بحبِ الإظهار ويقتضي منك الاشتهار فحالك أن تعاونه على ظلمه لنفسه، فترك الثناء لمثل هذا أفضل له وأسلم لك فهذا تفصيل ما أجمله الصادقون ثم اختلفوا في الأخذ من الواجب أفضل أم التطوع؟ فرأى بعضهم أن يأخذ من الواجب ولا يقبل من التطوع، أي لأنّ الواجب يؤخذ بإذن الله تعالى عن قسمه، وإنّ الله تعالى أوجب عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة، لأن الفقراء والمساكين لو تواطؤوا على أن لايقبلوا الزكوات أثموا أجمعون ولعصوا كلهم بذلك لإسقاطهم فرض الله عزّ وجلّ من الأموال بالزكوات، قالوا: ولأنّ هذا أدخل له في جملة الضعفاء والمساكين وأقرب إلى التواضع والذلة، قالوا: ولا منّة لأحد علينا فيه ولا حق يلزمنا عليه إذ كنا نستحق ذلك منه، قالوا: ولأنه أسلم لديننا لئلايدخل علينا الأكل بالدين لأنّا إنما نستوجبه بالحاجة وحرمة الإسلام فقط، ونخاف أن يكون أخذنا التطوع أكلاً بديننا أو أنّا أعطينا لصلاحنا واعتقاد فضلنا فلا نحبّ أن نخصّ بشيء دون الفقراء، وهذا مذهب القراء من العابدين، ومن ينظر إلى صلاحه ونفسه في الدين هو مقتضى حالهم وموجب شهادتهم، واختارت طائفة أن يأخذوا من النوافل دون الفرائض أجروه مجرى الهدية وقالوا: قد أمر بقبولها وندب إلى التهادي للتآلف والتحبّب، قالوا: ولانزاحم المساكين في حقوقهم ولعلنا لانكمل أوصافهم، ونخاف أن لايوجد فينا ما شرط الله عزّ وجلّ لواجبه، ولانضعه في حقيقة موضعه، أو لا نحتاط لمن يسقط عنه الواجب به، فالتطوع أوسع علينا، ومع هذا فإنهم يشهدون النعمة من الله تعالى وأنّ الدين إنما هو لله عزّ وجلّ، كا قال: (ألاّ لله الدين الخالص) الزمن: 3، وأنهم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعماً عليهم لا منعمين على أنفسهم، وهذه طريقة بعض أهل المعرفة، وممن ذهب إلى هذا إبراهيم الخواص وأبو القاسم الجنيد ومن وافقهما، والأمر في ذلك عندي أنّ من لم يأخذ من كلا إنسان ولا في كل أوان، ولم يقبل إلاّ عند الحاجة، وما لابدّ له منه، ثم قام بحكم الله تعالى في الواجب وحكمه في التطوع أنّ الحالين يتقاربان، لأنّ الواجب أمر الله تبارك وتعالى فيه حكم، والتطوع ندب، وله عزّ وجلّ فيه حكم، فعلى العبد أن ينظر لدينه ويحتاط لأخيه فيعمل بما يوجب الوقت من الحكم من أيهما كان فسواء ذلك، ولا ينظر بظلمة في هوى الحظ ففي ذلك سلامته.
4hFnTkfUWdo
 |
 |
البحث في نص الكتاب
بعض كتب الشيخ الأكبر
[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]
شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:
[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]
شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:
[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]
بعض الكتب الأخرى:
[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]
بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:
[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]