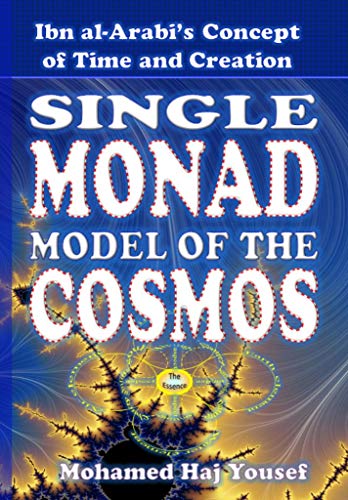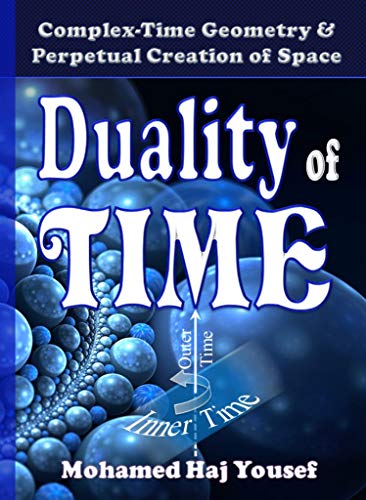المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

الرسالة الهادية
للشيخ أبي المعالي صدر الدين بن إسحق القونوي
وهي ضمن مراسلاته مع الشيخ نصير الدين الطوسي
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الحمد للّه الذي أبان بمستقرّات الهمم مراتب علم اليقين وعينه وحقه ودرجاته ، وأوضح بسكون قلق الطالبين ، حال الوصول إلى منتهى شأو نفوسهم ، تفاوت حصص عقولهم واختلاف رتب حقائقهم في منازل معرفته سبحانه وآياته المودعة في حضراته القدسية وأرضه وسماواته ، وميّز الخاصة من أهله من بين عالم خلقه وأمره بأنه لم يجعل لهم غاية سوى ذاته من جميع عوالمه ومنصّات أسمائه وصفاته . بل جعل منتهى مدى هممهم أشرف متعلّقات علمه الذاتي وأعلى مراداته ، حتى صار مرادهم وغاية مرماهم ما يريده سبحانه بذاته من ذاته لذاته ومن جهة أعلى حيثيّات شؤونه الأصلية الأولى وأرفع تعيّناته . فهو سبحانه حقيقة علمهم اليقيني وعينه وحقه في سائر مراتب علومهم الذاتية المتعلقة به أوّلا ثم بمعلوماته مع استهلاك كثرتهم تحت سلطان وحدته من حيث هم وبقاء حكمهم وسرايته في جميع موجوداته وحضراته .
وصلى اللّه على المتحقق به من حيثية الشهود الأكمل ، والعلم الأتم الأشرف الأشمل ، مع دوام الحضور معه سبحانه في جميع مواطنه - عليه السلام - وأحواله ومراتبه ونشآته ، سيدنا محمد والصفوة من أمته ، وإخوانه الحائزين ميراثه الأتمّ في علومه وأحواله ومقاماته مع تحققهم وفوزهم بنتائج حظوظهم الاختصاصية التي انفردوا بها عن خواصّ الوسائط وثمرات التبعيّة وأحكام الروابط ، صلاة مستمرّة الحكم دائمة الإيناع دوام الزمان من حيث حقيقته الكلية وصور أحكامه التفصيلية الظاهرة بالحركات العلوية والمعبّر عنها بسنيه وشهوره وأيامه وساعاته .
وبعد : فإنه لا يخفى على الألبّاء أنّ فلك العبارة بالنسبة إلى فلك المعاني المجردة والحقائق البسيطة من حيث تعيّنها في الأذهان ضيق جدّا .
وهكذا فلك التصوّرات والتعيّنات الذهنية بالنسبة إلى عرصة التعقلات النفسية والتصورات البسيطة . وهكذا الأمر في التصورات النفسانية البسيطة للأمور الكلية والحقائق العلية بالنسبة إلى تعقّل العقول والنفوس الكلية للكليات .
ونسبة تعقّلات العقول والنفوس إلى تعيّن المعلومات في علم الحق نسبة تعقّل من هو دون العقول والنفوس الكلية في المرتبة العلمية إليها .
وكل طائفة من العلماء ، وإن امتازت عن طائفة أخرى باصطلاح يخصّها ، فإنه قد تقع المشاركة بينهما في بعض الأسماء والألفاظ ، لضيق فلك العبارة وعدم التقيد أحيانا بالألفاظ ، وإن تباينا في المعتقد . فيظنّ من حيث احتمال تلك الأسماء والألفاظ المشتركة وجوها متعددة ومفهومات مختلفة أنّ تلك الأسماء والألفاظ تطلقها إحدى الطائفتين على ما أطلقها [ كذا ] عليه الطائفة الأخرى . وهذا الاشتباه لا يزول إلا ببيان المراد من تلك الإطلاقات لتتّضح أحكام ما به يمتاز طائفة عن غيرها وأنّهما فيما ذا تشتركان . فمن ذلك مما يوهم اشتراك أهل الذوق والتحقيق مع بعض الفرق ما ذكر في شأن الماهيات والقول بأنها غير مجعولة مع قول أولئك أنها عريّة عن الوجودين العقلي والعيني . ومن هذا القبيل ما أشار إليه المولى - نفع اللّه به - في أمر الوجود العام وفي كون الحق لو كانت له ماهية وراء وجوده ، لزم أن تكون سابقة عليه ولزم أيضا أن يكون مبدأ الموجودات اثنين مع أنّ كلّ اثنين محتاج إلى واحد سابق عليه . هذا إلى غير ذلك مما ذكر في أثناء الأجوبة عن السؤالات المرسلة كالإيجاد وغيره وما تيسّر الوقوف عليه من بعض فوائده ، كشرح « الإشارات » وغيره ، مثل حديث الارتسام والصدور وتفسير قول الشيخ الرئيس : « الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر » وغير ذلك .
وقد عزم الداعي أن يذكر في ذلك ومثله ، إن شاء اللّه ، ما تحقّقه ذوقا وكشفا وشهودا ليتضح بذلك مشرب المحققين وامتيازه من مشارب غيرهم وليعلم مذهبهم ومقصودهم وفيما ذا يشاركون أهل العقل النظري بالقوة الفكرية وبما ذا يتميزون عنهم وعن باقي الفرق . والردّ والقبول بعد ذلك راجع إلى إلهام الحق وإيضاحه أو ستره لما يعلم في ذلك من الحكم التي حجبها عن سواه .
فأقول : إنّ المستفاد من الذوق الصحيح والكشف الصريح أنّ تعقّل الحق باعتبار أنه واحد ، أو أنه مبدأ للموجودات ، أو أنه مسلوب عنه الكثرة والاشتراك مع شيء في وجوده ، أو أنه يستحيل أن تكون له ماهية وراء وجوده ، كلّ ذلك لا يصحّ إلا باعتبار تعيّنه في عرصة التعقّل الكوني .
وأعني بالتعقّل الكوني تعقّل غير الحق للحق ، وسيما كلّ من كان تعقّله له سبحانه وللبسائط المطلقة والحقائق الكلية بالتعقّل الفكري المنصبغ بالقوى المزاجية الحادثة الإمكانية . فإنّ تعقلات من هذا شأنه لا تكون بريئة من خواصّ قيود وكثرة ما سارية الحكم في تعقّله الموجب لتعيّن المتعقّل وانطباعه فيه بحسب محلّ الانطباع ، وإن كان محلّا معنويا . فبعيد حصول المطابقة بين المتعقل والمتعقل .
ولهذا يقول أكثر المحققين ، إنّ أتمّ تعيّنات الحق في عرصة التعقّل وأقربها مطابقة لما هو الأمر عليه تعيّنه سبحانه في تعقّل العقل الأول ، لأنه أخلى الممكنات عن أحكام الكثرة والقيود الإمكانية . فتعقّله أتمّ مطابقة وأقرب نسبة إلى ما يقتضيه شأن الحق . وجماعة أخرى من المحققين يقرّرون هذا الأمر ويقولون به غير أنهم يستثنون الكمّل من الأناسيّ ويشركونهم مع العقل الأول في صحّة المعرفة وكمالها .
وعلى الجملة ، فكل تعيّن مقيّد حاصر لما يتعيّن فيه من المطلقات ، وإنّ العقل السليم يقتضي بأنّ ذلك التعيّن مسبوق باللاتعيّن . فإن قال محقّق ، إنّ حقيقة الحق مجهولة ، والمعرفة به حاصلة ، فليس يعني بذلك أنّ للحق حقيقة وراء وجوده . وإنما يعني به أنّ الحق متى اعتبر تعقّله مجردا عن الكثرة الوجودية والاعتبارية النسبية والتعقّلات والتعيّنات التقييديّة الناشئة من تعقل غيره له ، يكون مطلقا عن التعيّن بوصف أو حكم أو نسبة ، سلبيا كان ذلك أو ثبوتيا . وهذا هو الإطلاق الذاتي الغير المقيّد لمدرك ما بأمر ما . فليس هو من هذا الوجه مثبتا له أنه مبدأ أو واحد أو فيّاض للوجود . بل نسبة الوحدة إلى ذلك الإطلاق وسلبها عنه على السواء ، بمعنى أنه مطلق عن الحصر في وصف أو حكم سلبي أو ثبوتي أو في الجمع بينهما أو التنزّه عنهما بحال . فيصدق في حقه من حيث هذا الإطلاق أن يقال ، إنّه يشهد ولا يشهد ويعلم ولا يعلم ، دون الحصر في إطلاق أو تقييد ، ليس بمعنى أنّ له إطلاقا يضادّه تقييد أو وحدة يقابلها كثرة . وأنّه من حيث هذا الإطلاق لا يقتضى ارتباط شيء به ولا صدور شيء عنه ولا تعلّق علمه بشيء ولا غير ذلك من النسب والإضافات . فمن ذهب من المحققين إلى أنّ حقيقته مجهولة ، فإنما يعني بذلك أنّ الحق من حيث هذا الإطلاق المشار إليه لا يتعيّن في تعقّل ، ولا يتجلّى في مرتبة ، ولا ينضبط بمدرك .
وإضافة الماهية هي من هذا الوجه ، لا أنّ له ماهية وراء وجوده ، فهو سبحانه من حيث هذا الإطلاق وعدم تعيّنه بوحدة أو مبدئية أو وجوب وجود أو نحو ذلك نسبة الاقتضاء الإيجادي إليه وعدمه على السواء ، لا يترتب عليه حكم ولا يتعقّل إليه إضافة أمر ما .
وتعيّن الحق بالوحدة هو اعتبار تال للّاتعيّن والإطلاق . ويلي اعتبار الوحدة المذكورة تعقّل اعتبار كون الحق يعلم نفسه بنفسه في نفسه . وهو يتلو الاعتبار المتقدم المفيد تعقّل الوحدة من كونها وحدة فحسب . فإنّ الحاصل منه في التعقّل ليس غير نفس التعيّن . لكنه بالفعل لا بالفرض التعقّلي . واعتبار كونه يعلم نفسه بنفسه في نفسه يفيد ويفتح باب الاعتبارات . وهذا عند المحققين هو مفتاح مفاتيح الغيب المشار إليها في الكتاب العزيز . وهذا المفتاح عبارة عن النسبة العلمية الذاتية الأزلية الفعلية ، لكن من حيث امتيازها عن الذات ، الامتياز النسبي ، ليس من حيث إنّ العلم صفة قائمة بذات الحق ، كما ذهبت إليه الأشاعرة ، فإنّ ذلك لا يقول به محقق عارف بالتوحيد الحقيقي ، ولا أيضا بمعنى أنّ العلم عين الذات ، فإنه لا يتعقّل من حيث ذلك الاعتبار للحق نسبة ممتازة عن ذاته يعبّر عنها بأنها علم أو غيره من الأسماء والصفات والنسب والإضافات ، بل وحدة لا يتميّز فيها العلم عن العالم والمعلوم ، فلا كثرة ولا تعدّد ، سواء اعتبرت الكثرة وجودية أو اعتبارية . فللنسبة العلمية مقام الوحدانية التالية للأحدية المذكورة التي تلي الإطلاق المجهول الغير المتعيّن . ومن حيث هذه النسبة العلمية تتعقّل مبدئية الواجب وكونه واهب الوجود لكل موجود . ويتعقّل الحق أيضا من هذا الوجه تضاعف الاعتبارات المتفرعة من النسبة العلمية والمنتشئة بعضها عن بعض . فالحق متعقّل في مرتبة هذا اللازم الأول الواحد العلمي سائر اللوازم الكلية الأولى ، التي أولها الفيض الوجودي المنبسط على جميع الممكنات ، ولوازم تلك اللوازم هكذا متنازلة إلى غير نهاية . وإذا اعتبرت متصاعدة ، انتهت إلى اللازم الأول المعبّر عنه بالنسبة العلمية بالتفسير المذكور . وهذا التعقّل الإلهي تعقّل أزلي أبدي على وتيرة واحدة .
والماهيات عبارة عن صور تلك التعقلات الإلهية ولوازمها وآثارها .
ولها الوجود العلمي الأزلي الأبدي ليس كما تظنه المعتزلة من أنها خالية عن الوجودين . ولما استحال قيام الحوادث بالحق أو أن يتجدد له علم ، لزم أن تكون تلك التعقلات أزلية وأن يكون لكل منها تعيّن في التعقّل الإلهي من حيث النسبة العلمية . وهو المعبّر عنه عند المحققين بالارتسام . وإنه عندهم وصف ومضاف إلى الحق من حيث النسبة العلمية باعتبار امتيازها عن الذات ، لا من حيث الوحدة الذاتية . هذا مع أنّ تعقّل الكثرة الاعتبارية في العرصة العلمية باعتبار امتيازها عن الذات لا يقدح في وحدة العلم ، فإنها تعقلات متعيّنة من العلم فيه . وهي من حيث تعقّل الحق لها مستهلكة الكثرة في وحدته ، وشأنها حالتئذ شأنه . ومن حيث اعتبار امتيازها بحقائقها عنه ثابتة الكثرة . ومن هذا الوجه يقول المحقق ، إنّ الماهيات غير مجعولة . فأما من حيث تعقّل الخلق لها بالنظر الفكري ، فإنها مجعولة ، كوجوداتها العينية .
وهذا التفصيل الذي يذكره المحققون وإن كان للعقل النظري فيه مجال غير أنّ المحقّق لم يحصّله ولم يدركه بنظره الفكري ، وإنما الحق سبحانه إذا سبقت عنايته في حق من اختار من عبيده وشاء أن يطلعه على حقائق الأشياء على نحو تعيّنها في علمه ، جذبه إليه بمعراج روحاني . فشا ؟ ؟ ؟ حال انسلاخ نفسه عن بدنه وترقيه في مراتب العقول والنفوس متصاعدا ؟ ؟ ؟ على العوالم العلوية ، طبقة بعد طبقة متّحدا بكل نفس وعقل اتحادا يفيده الانسلاخ عن جملة من صفاته وأحواله الجزئية وأحكام كثرته الإمكانية في مقام كل نفس وعقل جملة بعد جملة بحسب ذلك المقام ، هكذا حتى تتّحد نفسه بالنفس الكلية ، فتصير كهي ، ويزول عنها ما كان عرض لها حال التنزّل المعنوي للتلبّس بالمزاج العنصري . ثم يتّحد ، إن كمل معراجه ، بالعقل الأول . فإذا كمل اتحاده به ، تطهّر من سائر أحكام الكثرة والإمكان التي هي لوازم ماهيته من حيث إمكاناتها النسبية ، ما عدا حكم واحد ، وهو
معقولية كونه في نفسه ممكنا ، كما هو العقل الأول . وذلك لا يتمّ إلا بغلبة أحكام الوجوب على أحكام الإمكان على نحو ما سأشير إليه ، إن شاء اللّه ، غلبة بها تثبت المناسبة بينه وبين ربه . وهناك يحصل له القرب الحقيقي الذي هو أول درجات الوصول . ويصحّ له بصفته الوجوبية الذاتية الأخذ عن اللّه بدون واسطة عقل أو نفس أو غيرهما من الوسائط العلوية والسفلية ، كما هو شأن العقل الأول مع الحق .
ويتميّز الإنسان الحقيقي المشار إليه عن العقل الأول في بعض مقامات القربة قبل الفناء الأخير والاستهلاك في الحق أنّه يجمع بين الأخذ الأتمّ عن اللّه بوساطة العقل الأول وباقي العقول والنفوس بموجب خاصيّة حكم إمكانه الباقي منه ، الذي سبقت الإشارة إليه ، وخاصيّة حكم وجوب كل فرد من أفراد العقول والنفوس وبين الأخذ عن اللّه بدون واسطة أصلا بحكم وجوبه . وحالتئذ يحلّ مقام الإنسانية الحقيقية الإلهية التي هي فوق الخلافة الكبرى وغيرها من المراتب العلى ويستجلي من حيث المناسبة المذكورة مما هو منتقش في علم الحق ومرتسم فيه بالتفسير المذكور . ومقدّر ظهور تعيّنه وبروزه من ذلك الوجود العلمي إلى الوجود العيني بمقدار سعة مرآة حقيقته واستعداده الكلي وبحسب استقامة المرآة وصحة المحاذاة والمسامتة المعنوية للنقطة الاعتدالية الإلهية التي تتساوى نسبة الأطراف إليها ونسبتها إلى الأطراف . فيدرك كلّ ما ذكرنا وغيره دون حجاب . ويتعقّل الماهيات بتعيّناتها الأزلية على نحو تعقّل الحق لها بالتعقّل الأزلي من حيث النسبة العلمية الذاتية الوحدانية الفعلية ، ليس بموجب إمكاناتها النسبية لاشتراك جميعها في معنى الإمكان ، ولا على نحو تعيّنها في تعقّل المحجوبين بالعقول المقيّدة ، فإنّ لهذا النوع من الإدراك نقائص شتّى ، من جملتها أنه إدراك جزئيّ بقوة جزئية ، هي الفكرة ، وبعلم مقيّد انفعالي ، فلا يدرك إلا ما يناسبها . ولهذا عجزت العقول المقيّدة بالأفكار ، لخاصية تقيّداتها وتناهي قابلياتها وغلبة أحكام كثرتها وإمكانها عن إدراك الكليات في مراتبها الأصلية . فلا يقدر أن يدركها إلا بعد مشاهدة الجزئيات واستنزاع معنى جامع لها . هو الكلّيّ عندها ، وهو عندها أمر مفروض في التعقّل الذهني لا تحقّق له في الخارج . وهذا فيه نظر ، فإنّ الذي أفاده الشهود المحقّق حال المعراج والانسلاخ عن أحكام الكثرة والإمكان وخلوّ النفس عن خواصّ مداركها الجزئية ، كما * ذكر ، هو أنّ إدراكها للحقائق الكلية يصير سابقا على إدراك الجزئيات . فتدرك الحقائق الكلية ، كالوجود العامّ وغيره من الأمور الكلية والعامة ، أولا ، ثمّ تدرك جزئيات كل حقيقة كلية ولوازمها بطريق التبعية واللزوم على نحو تعيّنها في حضرة الحق من حيث النسبة العلمية وفي ذوات العقول المجردة والنفوس الكلية . وهكذا هو علم الحق بحقائق الأشياء وبالموجودات ، فإنّ تعلق علمه بالموجودات التفصيلية مسبوق بتعلق علمه بالعقل الأول ، الذي هو الأصل الكلي بالنسبة إلى ما دونه من العقول والنفوس وغيرهما من الكليات النسبية ولوازمها التفصيلية . وهكذا هو علم العقل بما بعده في المرتبة . والداعي وإن لوّح من ذلك بطرف في الرسالة المتقدمة ، لكنه لم ينحدر ذكر ذلك تماما . وحيث ذكر هنا أمر المعراج الروحاني وشأن صاحبه ، وجب استيفاء بيان ذلك .
ثم أرجع وأقول ، ومذهب الشيخ الرئيس على ما ذكره في « التعليقات » موافق لمذهب المحقّقين فيما ذكرناه من أنّ معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بطريق النظر الفكري متعذر ، وحكم العقل المقيّد بالفكر بأنّ الكليات لا تعرف إلا من الجزئيات وبعدها وأنّ الكليات ليست لها صورة معقولة أزلية متعيّنة في علم الحق والعقول المجردة ، بل هي أمور مفروضة لا تحقّق لها في أنفسها ، فيه نظر . بل الأمر واقع على نحو ما أدركه المحقّقون بطريق الكشف والشهود . ونص كلام الشيخ فيما ذكره الداعي بلسان الموافقة هو أنه قال : « ليس للإنسان أن يدرك معقولية الأشياء من دون وساطة محسوسيتها » . وذلك لنقصان نفسه واحتياجه في معرفة الصور المعقولة إلى توسّط الصور المحسوسة . فأما الأول والعقول المفارقة لما كانت عاقلة بذواتها ، لم تحتج في إدراك صور الأشياء المعقولة إلى صورها المحسوسة ولم تستفده من إحساسها ، بل أدركت الصور المعقولة من أسبابها وعللها التي لا تتغير ، فيكون معقولها منه لا يتغير . ثم قال : « ولكل شخص جزئي معقول مطابق لمحسوسه » . وهذا القول منه موافق لما نقله الداعي وفهمه من فحوى كلامه بأنّ مراده من قوله : « الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر » إلى آخر الفصل ، هو بيان تعذر معرفة الحقائق من حيث صورها المعقولة المتعيّنة في علم الحق أزلا وأبدا وفي ذوات العقول المجردة . لم يرد معرفة خواصّ الأمزجة والطبائع وغير ذلك مما أشار إليه المولى - نفع اللّه به - في تلك الأجوبة ، بل إنما أراد معرفة حقائقها الأصلية ، كما مرّ . ولذلك ذكر في تقرير ذلك وتمثيله معرفة ذات الحق سبحانه ومعرفة العقل والنفس والفلك وحقيقة الجسم الكل من حيث معقوليته .
ولم يمثّل بما يفهم منه أمر يتعلق بالأمزجة والطبائع والخواص . وظنّ الداعي أنّ الناسخ الناقل لتلك المسائل من تعليقه ربما لم يكتب ذلك الفصل تماما ، وإلا لم يكن يخفى على العلم الشريف مراد الشيخ منه .
والدليل على أنّ مراده - قدس اللّه نفسه الزكية - من ذلك التمثيل ما لوّح الداعي بذكره ما أكده في موضع آخر ، وهو قوله : « الإنسان لا يعرف حقيقة شيء البتّة ، لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس . ثم تميّز عقله بين المتشابهات والمتباينات ، ويعرف حينئذ بعض لوازم الشيء وأفعاله وتأثيراته وخواصه . فيتدرج بذلك إلى معرفته معرفة مجملة غير محققة ، وربما لم يعرف من لوازمه إلا البعض . ولو قيل ، إنه عرف أكثرها ، إلا أنه ليس يلزم أن يعرف لوازمها كلها . فلو كان يعرف حقيقة الشيء وكان ينحدر من معرفة حقيقته إلى معرفة لوازمه وخواصه ، لكان يجب أن يعرف لوازمه وخواصه أجمع . لكن معرفته بالعكس مما يجب أن يكون عليه » . ومما ذكره مما هو من وجه موافق لمذهب المحققين ، إن قال :
« العلم هو حصول صور المعلومات في النفس » ، ثم قال : « وصور الموجودات مرتسمة في ذات الباري ، إذ هي معلومات له . وعلمه بها سبب وجودها » ، والمحققون من أهل الذوق يقولون : الحقّ علم نفسه بنفسه وعلم العالم من عين علمه بنفسه وأوجده على نحو ما علمه . والاقتضاء الإيجادي ينضاف إلى الحق على ثلاثة أنحاء : اقتضاء ذاتي : لا يتوقف حكمه على شرط أصلا . واقتضاء آخر : ظهوره متوقّف على شرط واحد ، وذلك الشرط هو العقل الأول . واقتضاء ثالث : ظهور آثاره موقوف على شروط . وليس هذا بمعنى أنّ ثمّة اقتضاءات ثلاثة مختلفة ، بل هو اقتضاء واحد له ثلاث مراتب . فالماهيات التي قلنا ، إنها عبارة عن صور التعقلات المتعددة الإلهية المتعيّنة في النسبة العلمية ونتائجها ، وبها تعدّد مطلق الفيض الوجودي الإيجادي بآثار خصوصياتها القاضية بتمييز كل منها عن الآخر . فيدرك الفيض الواحد الوجودي متنوّع الظهور متعدد العين تعدّدا تابعا لتلك التعقّلات الأزلية العلمية ، وحكم العلم منسحب عليها ومتعلق بها وبلوازمها على ما هي عليه . فتعقّل العلم حال الشهود المحقّق من حيث إنه نسبة واحدة فقط يفيد الشعور بصورة علم الحق نفسه بنفسه باعتبار اتحاد العلم والعالم والمعلوم . وتعقّل امتياز العلم عن الذات الامتياز النسبي واشتماله على تلك التعقلات المفروضة الانتشاء بعضها عن بعض وتعقّل تعلّقه بذات الحق عينه ، أعني عين النسبة العلمية . ولوازم تلك النسبة تفيد معرفة اشتمال العلم على تعقّلات شتّى هي المعبّر عنها بالمعلومات المتعقّلة الانتشاء من الفروض وتضاعف الوجوه والاعتبارات وكونها كثرة نسبية تابعة لنسبة واحدة تسمّى العلم . وقد أشار المولى - نفع اللّه به - إلى طرف منه عند ذكره الاعتبارات الاثني عشر . وتتمّة ذلك في مشرب التحقيق أنّ تلك الاعتبارات إذا تعقّلت من حيث تأثير الحق من جهتها ، تعددت الآثار الإلهية ، وإن كانت في الأصل أثر واحد ، فسمّيت بهذا الاعتبار التعددي « أحكام الوجوب » . وسمّينا معقولية كل أمر يوصف بالتأثر في مقابلة تلك الآثار المنسوبة إلى الحق مع خواصّ الوسائط « أحكام الإمكان » ، ومن شهد ما ذكرنا ، عرف سرّ الارتسام وانضيافه إلى الحق من حيث النسبة العلمية المحيطة بتلك التعقلات الإلهية الأزلية مع نزاهة الحق من حيث أحديّته عن الكثرة النسبية الاعتبارية والوجودية معا . فلمحض الذات الإطلاق عن كل وصف ، كما سبقت الإشارة إليه . ولأحدية الحق نفس التعيّن فقط بالاعتبار المسقط للاعتبارات كلها . ووحدانيته ثابتة بالاعتبار الثاني من حيث النسبة العلمية . ولها التعيّن الجامع للتعيّنات كلها ، ومن حيثها تتعقّل مبدئية الحق وواجبيّته وكونه موجودا وفيّاضا بالذات . فالتوحيد للوجود ، والتمييز للعلم من حيث الوحدانية ، لا من حيث الأحدية القاضية باتحاد العلم والعالم والمعلوم ، والإطلاق للذات .
ثم أقول : وكل موجود من الموجودات ، ما عدا الحق سبحانه - فإنه مشتمل بالذات على جملة من أحكام الوجوب والإمكان - ولا بدّ وأن يقع بين الطرفين ، أعني جهة الوجوب وجهة الإمكان ، ممازجات معنوية وغلبة ومغلوبية ، بتلك الغلبة والمغلوبية يظهر التفاوت بين الموجودات في الشرف والخساسة والشقاء والسعادة والجهل والعلم والبقاء والنفاد وغير ذلك من صفات النقص والكمال . فصفات الكمال والقرب من جناب الحق لكلّ من كانت أحكام الوجوب فيه أقوى وأتم وأغلب .
وصفات النقص والبعد ولوازمها حيث تتضاعف فيه وجوه الإمكان وأحكامها وتظهر غلبتها على أحكام الوجوب . ومحتد أحكام الوجوب وحدانية الحق بالتفسير المذكور . ومحتد أحكام النقص الكثرة والإمكان .
وتضاعف وجوه الإمكان ينتشىء من خواص إمكانات الوسائط الثابتة بين الحق وبين ما وجوده عن الحق متوقف على جملة من الوسائط .
فتفاوت الشرف من هذا الوجه هو بحسب قلة الوسائط لعدم تغيير الفيض الذاتي عن تقديسه الأصلي . والنزول عن هذا الشرف بعكس ذلك .
وثم برزخية وسطية اعتدالية جامعة بين الطرفين مشتملة بالذات على كليات أحكام الوجوب والإمكان اشتمالا معتدلا فعليّا من وجه ، انفعاليّا من وجه آخر ، لا يغاير الطرفين إلا بمعقولية جمعها بينهما . وهي الحقيقة الإنسانية الكمالية الإلهية . وإنها كالمرآة للطرفين . فمن تعيّنت مرتبته بالعناية والاستحقاق الذاتي والمناسبة الحقيقية في هذه البرزخية المذكورة ، لم يتميّز في طرف الإمكان بل ماهيّته نفس برزخية وكونه مرآة للطرفين .
فيرتسم فيه من حيث الانطباع المعنوي المشار إليه في آخر المعراج الوجود الواحد متعددا متنوع الظهور بالأسماء وصور الأحوال والصفات . وينتشىء به بين الطرفين المذكورين سائر النسب والإضافات ظهورا وإظهارا للتعددات الاعتبارية والتعقّلات المتعيّنة في وحدانية الحق من حيث نسبة علمه الأزلي المضاف إليه الارتسام عند المحققين . لكني لا أقول إنّ الارتسام في ذات صاحب هذه البرزخية المذكورة هو ارتسام مطابق لارتسام الأشياء في نفس الحق من حيث نسبة علمه الذاتي الأزلي . فإنّ أهل الارتسام المطابق علومهم علوم انفعالية جزئية حادثة ناقصة المحاكاة . بل أقول : إنّ نفس من هذا شأنه تزكو وترقى وتصفو وتتجوهر ويتّسع فلكها ويتّحد بالجناب الأعلى وتشتعل بنور الحق ، كما قال - صلى اللّه عليه وسلّم - وأشار إليه في دعائه بقوله :
« واجعلني نورا » . فيصير نورا محضا وينسلخ من الظلمات الإمكانية وأحكامها التقييدية والجزئية . فيصير مرآة لنفس الارتسام الأزلي الإلهي .
فالقدر الذي يعلمه من جناب الحق والأشياء يعلمه على نحو ما يعلمه الحق بعلم ذاتي لا موهوب ولا مكتسب . وهذا العلم فوق العلم اللّدني الذي هو عند أكثر أهل الذوق أعلى علوم الوهب وإليه * الإشارة بقوله تعالى : ولا يحيطون بشيء من علمه إلّا بما شاء [ سورة 2 ، آية : 255 ] .
فإنه علم إحاطيّ فعليّ . إذا تعلّق بشيء علمه من جميع وجوهه ، بخلاف علوم الناس . فإنها علوم حادثة انفعالية تتعلّق بالأشياء من حيثيّة بعض الخواصّ واللوازم دون إحاطة . ولذلك كلّ من شعر بنقصانه نفى أن يكون مثل هذا علما تماما محقّقا ، كالشيخ الرئيس على ما وقف الداعي عليه من كلامه وعرضه على الرأي المنير في هذا المسطور وفي الخدمة المتقدمة . وصاحب هذا المقام البرزخي المذكور كما ينتقش في مرآته باعتبار أحد وجهيها المختصّ بطرف الإمكان الموجودات العينية بحسب تلك التعقّلات والاعتبارات العلمية الأزلية ، كذلك ينعدم في وحدته باعتبار أحد وجهيه الذي يلي مقام الوجوب ولا يغاير وحدتها كلّ عدد ومعدود . وإنه من هذا الوجه يتأتى له الأخذ عن اللّه بدون واسطة أصلا ، بل يتحقق بما هو أعلى وأفضل من ذلك مما يتعذر ذكره . هذا مع تفاوت درجات الواصلين إلى هذا المقام وتفاوت حظوظهم من الحق بموجب خواصّ استعداداتهم الغير المجعولة . بل أقول بمقتضى حكم الشهود المحقّق : إنه ما من موجود من الموجودات إلا وارتباطه بالحق من حيث هو من وجهين ، جهة سلسلة الترتيب والوسائط التي أولها العقل الأول ، وجهة طرف وجوبه الذي يلي الحق ، وإنه من حيث ذلك الوجه يصدق على كل موجود أنه واجب ، وإن كان وجوبه بغيره .
ومراد المحققين من الوجوب هنا مخالف من وجه لمراد غيرهم من هذا الإطلاق . والسرّ فيه عموم حكم وحدة الحق الذاتية المنبسطة على كل متّصف بالوجود والقاضية باستهلاك أحكام كثرة الأشياء والوسائط فيها والموضحة أحدية التصرف . والمتصرّف بمعنى أنّ كل ما سوى الحق مما يوصف بالعلّية أنه معدّ غير مؤثّر ، فلا أثر لشيء في شيء إلا اللّه الواحد القهار . لكن سرّ هذا الوجه الخاصّ الذي لا واسطة فيه بين كل شيء وبين الحق بالنسبة إلى أكثر الموجودات مستهلك الحكم والخاصيّة في أحكام الكثرة والإمكان لغلبة أحكام الكثرة على حكم الوحدة وأحكام الوجوب المشار إليها من قبل . وثمّة سرّ شريف يتعلّق بهذا المقام للعقل النظري فيه مجال ما . وهو أنه لمّا لم يجز عقلا أن يتعقّل في الحق جهتان مختلفتان ، لكونه واحدا من جميع الوجوه ، وجب أن يكون الارتباط المتعقّل بينه سبحانه وبين الموجودات ثابتا من حيث الحق من وجه واحد . ولمّا كانت الكثرة من لوازم الممكنات وصفاتها الذاتية ، وأول صورة الكثرة وأقلّها الاثنينية ، وجب أن يكون ارتباط كل ممكن بالحق من حيث الممكن من جهتين ، الجهة الواحدة وجه إمكانه والأخرى وجه وجوبه ، ووجب أن تكون الغلبة من الوجه الذي يلي الأول ، للوحدة وأحكام الوجوب ، كما يجب أن تكون الغلبة للكثرة من الوجه الآخر .
ثم أقول : وتعيّنت مراتب الموجودات ودرجاتها بحسب الغلبة والمغلوبية المتعقّلة الوقوع بين الطرفين ، كما مرّ بيانه . ومن اطّلع على ما ذكرنا ، استشرف على أسرار شريفة ، من جملتها معرفة سبب موافقة العقل النظري لنتائج الكشف والشهود وسبب التوقف في ذلك أو المخالفة .
فسبب الموافقة هو غلبة ما حاصلة من جناب وحدة الحق وإطلاقه وأحكام وجوبه على أحكام الكثرة التي اشتملت عليها ذات الموافق . وما نبّأ عنه إدراك صاحب العقل النظري مما أدركه المكاشف في شهوده . فتوقف فيه أو ردّه . فذلك راجع إلى خواصّ تقييدات صاحب النظر الفكري وانحصاره تحت أحكام إدراكاته الجزئية وتناهي قابلياتها ، بخلاف حال المكاشف . فإنه خلص من حبوس القيود وخواصّ قابلياته الموصوفة بالتناهي . فأدرك الأشياء بمطلق ذاته تارة وبربّه تارة وبهما معا وعلى الوجه المنبّه عليه من قبل في أعلى مراتب تجريد الأشياء التجريد الوجودي والإطلاق الأصلي . وصاحب النظر وإن أدرك بعض ما أدركه المكاشف الخارج من الحبوس المذكورة ، فإنما يدرك ذلك البعض في المراتب المقيّدة لتلك الحقائق . فيكون إدراكه لها بحسب تعيّن تلك الحقائق في مراتب غربتها وما عرض لها من القيود في تلك المراتب . لم يدركها في مراتب تجريدها الأتمّ الأصلي ووطنها الحقيقي الذي هو الحضرة العلمية الإلهية المشار إليها من قبل .
وتقرير ما ذكرنا وسرّه هو أنّ النفوس الجزئية لمّا كان تعيّنها بعد المزاج وبحسبه على ما هو مذهب المحققين من أهل الذوق والحكمة ، صار كأنّ في المزاج معنى يصح وصفه بالمرآتية بمعنى كأنّ النفس انطبعت فيه ، فيعبّر عن ذلك الانطباع « بالتعلّق التدبيري » . وأيضا فلمّا كان الموجب لاجتماع الأجزاء المزاجية آثار القوى العلوية وخواصّ الاتصالات الكوكبية والتشكلات والحركات الفلكية وتوجّهات نفوسها وعقولها العلية ، وكان قبول الأمزجة لتلك القوى والآثار قبولا متفاوتا بحسب استعداداتها الأصلية ، كان المزاج كالمرآة لتلك القوى والآثار أولا ، ثم استعد بما قبله وانطبع فيه منها أن يكون مرآة لقبول نفس جزئية تعيّن ؟ ؟ ؟ به وبحسبه . ولا شك بأنّ الأمزجة الإنسانية ، وإن كانت واقعة في عرض واحد ، فإنها عظيمة التفاوت في القرب والبعد من درجات الاعتدال .
ولذلك تفاوتت النفوس في النورية والجوهرية والشرف وغير ذلك من صفات الكمال ، ولزم أيضا أن لا تخلو النفوس في تعقّلاتها وتصوّراتها من خواصّ المزاج الذي هو سبب تعيّنها ، وسيّما لما يوجبه الارتباط والتعلّق التدبيري ، وإن لم تكن النفس حالّة في المزاج . ولزم أيضا أن تكون لكل نفس من النفوس الإنسانية مناسبة ما مع العالم العلوي ونفوسها [ كذا ] بموجب ما انعجن في مزاجها وما حصل لها من تلك القوى والآثار ، بحسب حكم الوقت الذي وقع فيه اجتماع الأجزاء المزاجية وبحسب مبدئية تعيّن النفس وتعلّقها به . ولا بدّ وأن تكون قوى بعض الأفلاك وآثاره [ كذا ] فيه أغلب من البواقي . فتكون نسبة تلك النفس ومزاجها إلى ذلك الفلك ونفسه وعقله أقوى وأتمّ من نسبته [ كذا ] إلى سواه . هذا وإن كان محلّا لآثار جميعها . وإذا كان كذلك كان إدراك نفس الإنسان لما تدركه من الحقائق هو بحسب المرتبة المتعيّنة له هناك ، إذ من حيث هي وفيها وبحسبها تدرك ما تدرك . فالمتعيّنة مرتبة نفسه ، وسيّما بعد الترقّي والمعراج الروحاني المذكور والانتهاء إلى بعض مقامات الكمالات النسبية الذي هو غايته من عرصات العقول والنفوس ، وخصوصا المترقّي إلى المرتبة الكمالية التي فيها تقتضى مشاركته العقل الأول في الأخذ عن اللّه وقبول فيضه الأقدس بلا واسطة ، هذا إلى غير ذلك مما يضيق عنه نطاق العبارة ولا يتعيّن في تعقّل مقيّد بنظره الفكري بإفصاح ولا إشارة . لا يكون إدراكه لحقائق الأشياء ومعرفته بالحق كتعقّل ذي النظر الفكري المنصبغة نفسه بالخواصّ الطبيعية والقوى الجزئية المزاجية . فإنه إنما يدرك ما يدرك بحسب الوصف الغالب على نفسه حال الإدراك . فأين هو من الذين يستجلون حقائق الأشياء ويتعقّلون المعلومات في مراتبها البسيطة العالية ! وأين هؤلاء أجمع من الكمّل الذين يستجلون الحقائق في أعلى مراتب تعيّناتها على نحو تعيّنها في علم الحق أزلا ، وكما سبق التنبيه على ذلك وإلى التفاوت المرتبي الذي ذكره الداعي الثابت للنفوس الإنسانية في العوالم العلوية . أخبر النبيّ ، صلى اللّه عليه وسلم ، أنه اجتمع في معراجه بآدم ، عليه السّلام ، في السماء الأولى الذي هو فلك القمر وأنّ مقامه هناك . وأخبر أنّ عيسى ، عليه السّلام ، في الثانية ، ويوسف في الثالثة ، وإدريس في الفلك الرابع وهارون في الخامس وموسى في السادس ، وإبراهيم في السابع . ولا ريب في أنّ النفوس غير متحيّزة . فما ذكره ، عليه السّلام ، إشارة إلى مراتب نفوسهم بموجب المناسبة الثابتة بينها وبين النفوس السماوية والعقول العالية وتفاوت درجاتهم ، عليهم السّلام ، في الحضرة الإلهية بحسب قلّة الوسائط وكثرتها ، كما مرّ . والسالكون الواصلون ذوو المعارج الروحانية من الكمّل ومن يدانيهم في المنزلة قاطبة متّفقون على صحة ما ذكره النبي ، صلّى اللّه عليه وسلم ، من شأن من ذكر من الأنبياء ، عليه وعليهم السّلام ، عن مشاهدة روحانية وكشف محقّق متكرّر حاصل لكلّ منهم عدّة مرار دون تقليد للنبي ، عليه السّلام ، وغيره في ذلك ومثله .
فإنه إنما بعثهم على السلوك وارتكاب المشاقّ طلب الخروج من ربقة التقليد وعدم القناعة بنتائج الأفكار لمّا رأوا عجزها وعدم براءة ساحتها وأكثر براهينها من شين الشكوك والشبهات .
ومما يؤيد ما ذكر ما أخبره ، صلى اللّه عليه وسلّم ، في تفاوت درجات أخذه عن اللّه العلوم بحسب أحواله المتفاوتة وترقياته في مراتب العقول المفارقة بعد تجاوز المقامات الفلكية ونفوسها العلية . فكان يخبر أحيانا أنه يأخذ عن جبرئيل ، عليه السّلام ، وأنّ جبرئيل يأخذ عن ميكائيل ، وميكائيل عن إسرافيل ، وإسرافيل يأخذ عن اللّه ويخبر عنه ، وأحيانا كان يأخذ عن ميكائيل دون واسطة جبرئيل . وأخبر أنه كان يلقي إليه أحيانا إسرافيل ، فيأخذ عنه دون وساطة جبرئيل وميكائيل عليهم السّلام . وأخبر أحيانا عن اللّه دون وساطة أحد من الملائكة .
وليس وراء اللّه مرمى . وقد شاركه الكمّل من ورثته في كل ذلك . وقد رآهم الداعي ، ووقعت المشاركة معهم والاتفاق في الشهود ، والحكم بصحة ذلك بفضل اللّه ومنّه مع العلم بتوقف أهل النظر الفكري في قبول ذلك والحكم بصحته والعلم أيضا بموجب ذلك التوقف والإنكار . هذا مع أنّ المتوقّفين في ذلك لا مستند لهم سوى الاستعداد والاستحسان النظري العادي . فإنّ هذه الأوصاف ومثلها تحجب العقول النظرية عن إدراك مثل هذا وعن قبوله . ولو أمعنوا التأمل في البراهين التي تقضي بردّ أمثال هذه الأمور ، لعثروا على الخلل الخفي الواقع في بعض مقدمات تلك البراهين ، سيّما البراهين المذكورة في شأن الصدور وترتيب العقول والنفوس والأفلاك وانخرام القاعدة في فلك الثوابت وغير ذلك .
هذا مع أنهم عند أكابر المحققين معذورون من وجه ، فإنّ للعقول حدّا تقف عنده من حيث ما هي مقيّدة بأفكارها . فقد تحكم باستحالة أشياء كثيرة هي عند أصحاب العقول المطلق سراحها من القيود المذكورة من قبل ممكنة الوقوع بل واجبة الوقوع ، لأنه لا حدّ للعقول المطلقة تقف عنده ، بل ترقى دائما ، فتتلقّى من الجهات العلية والحضرات الإلهية . وعلى الجملة ما يفتح اللّه للنّاس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم [ سورة 35 ، آية : 2 ] .
وبعد أن قدّمت الفصل الكلي المشتمل على ذوق أهل التحقيق وتمييز مذهبهم من مذاهب غيرهم وبيان الألفاظ الموهمة الاشتباه مع سواهم في الاعتقاد وغير ذلك ، فلنذكر الإلماعات المختصة ببعض أجوبة المسائل ، كما سبق الوعد بذلك ، إن شاء اللّه .
فأقول : وأما ما أفاده بقوله - نفع اللّه به - في حق الحق بأنه لو كان له وجود وماهية ، لكان مبدأ الكل اثنين ، وكل اثنين محتاج إلى واحد هو مبدأ الاثنين والمحتاج إلى مبدأ لا يكون مبدأ للكل إلى آخره ، فيه نظر ، فإنّ لقائل أن يقول : هذا إنما كان يلزم إن لو ادّعى القائل بالماهية أنّ الإثنينية هنا حقيقية لا اعتبارية ، فإنه يقول : إنّ الإثنينية عندي هنا اعتبارية . نعم ، والواحدية أيضا كذلك ، لأنها ليست صفة مضافة إلى ذات معلومة ، بل هي صفة للأمر المتعيّن في تعقّل الواصف . وبقي هل تعيّن الأمر في نفسه هو كتعيّنه في تعقّل الواصف أم لا ، فيه نظر ، فإنّ من البيّن أنّ وصف الواصف الحقّ بأنه واحد أو أنه واجب الوجود أو أنه مبدأ للكل ونحو ذلك مسبوق بيقين غير الحق من الأشياء في تعقّل المسمّى والواصف . فيتميّز الواصف المبدأ آخرا عما أدركه وتعقّله من الأشياء أوّلا مما لا يصلح عنده أن يكون مبدأ للكل . فإذا ميّزه عن غيره في تعقّله بفرض إفراده إيّاه عن سواه ، حينئذ بصفة ويضيف إليه من الأسماء والصفات ما يرى ويحكم عقله فيه أنه صفة كمال يليق به أو يجب أن يكون حاصلا للمبدأ لنفسه لا من سواه حتى يصحّ له أن يكون مبدأ للكل . ويسلب عنه أيضا أمورا يرى أنها لا تنبغي له . فإنه متى فرض اتصافه بها ، لزم منه محال من أجل أنها في مبلغ علم الحاكم باعتبار تعيّن الحق في تعقّله وتعقّل تلك الصفات وما يعلم من كمالها ونقصها الثابتة لمن تضاف إليه تكون قادحة في مبدئيّته وكماله . وهذا إنما كان يصح إن لو كان حكم تلك الصفات من حيث إضافتها إلى المبدأ عين حكمها من حيث إضافتها إلى سواه . فإنّ إضافة كل صفة إلى موصوف ما متى قصد بها الإضافة الحقيقية يجب أن تكون مسبوقة بمعرفة حقيقة الصفة وحقيقة الموصوف وحقيقة الحكم من حيث الإضافة . وحينئذ تتأتّى إضافة تلك الصفة إلى ذلك الموصوف ، وبقي ذلك الحكم . هل يختلف باختلاف المضاف إليه والحاكمين المختلفي الإدراك وكيفية الإضافة ، أو لا يختلف ؟ فيه نظر ، وتحقيق كل هذا عسر جدّا . فإن قيل : لا يلزم في إضافة صفة إلى موصوف ما معرفة حقيقة الصفة وحقيقة الموصوف ، بل يكفي في ذلك معرفة الصفة من حيث هذه الإضافة الخاصة التي قصدها الواصف . وهكذا الأمر في الموصوف ، فإنه يكفي في ذلك معرفته من هذا الوجه وهذه الإضافة ، لا معرفة حقيقته .
فنقول : فحينئذ من الجائز أن يثبت للموصوف من جهة هذه الإضافة أمر أو أمور وينتفي عنه أيضا أمور أخر ، ويكون من مقتضى ذاته باعتبار آخر قبول ضدّ هذا الوصف بإضافة غير هذه الإضافة وحكم سوى هذا الحكم من حاكم آخر . فلا جائز لواصف أن يثبت له أمرا ما على الإطلاق ، ولا أن يسلب عنه شيئا أيضا كذلك . بل كل ذلك من وجه مخصوص وباعتبار معيّن تابع لإدراك الواصف والحاكم . وإذا وضح هذا ، علم أنّ مرجع السلب والإثبات من المثبت والسالب راجع إلى ما تعيّن من الحق في تعقّله ، لا إلى الحق نفسه ، لعدم مطابقة تعيّن الحق عند المتعقّل تعيّنه سبحانه في تعقّله نفسه من حيث علمه به . وهكذا الأمر في الصفات وإضافتها إليه سبحانه أو سلبها عنه ، إذ لو جاز ذلك ، أعني المطابقة بين التعيّنين ، أعني تعيّن الحق في تعقّل غيره له وتعيّنه سبحانه في تعقّله نفسه ، لزم منه معرفة كنه حقيقة ذات الحق ، وأنه محال .
وإذا استحال معرفة الحقيقة ، فيقال : إطلاق اسم الماهية على الحق هو من حيث اعتبار كونه مجهولا ، فإنّ لتعيّنه في نفسه الإطلاق عن كل تعيّن يحصل في تعقّل أحد ، كان من كان . فإنّ جميع تلك التعيّنات تقييدات له في تعقّلاتنا لأنها بحسب ما تعقّلنا وتعيّن لنا منه . لا أنّا نقول : إنّ له ماهية وراء وجوده ، بل حقيقته وراء ما يعلم منه ومن الوجود المضاف إليه أو المضاف إلى سواه . ويزول بهذا احتياج معنى الإثنينيّة الاعتبارية إلى واحد هو غير . ولا يقال أيضا حينئذ إنّ الماهية لا موجودة ولا معدومة ولا صفة ولا موصوفة ، بل كل ذلك راجع إلى الاعتبارات واختلاف التعيّنات الحاصلة في التعقّلات .
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الإطلاق الذاتي وذوق المحققين في ذلك قبل هذا في الفصل الكلي المذكور . فمتى استحضر ما ذكر هناك وضمّ إليه المذكور الآن ، وضح المقصود من ذلك كله في هذه المسألة .
وأما ما أشار إليه - أبقاه اللّه - من قول المعتزلة في معرفة الحقيقة وفي خلوّ الماهية عن الوجودين العقلي والعيني ، فذلك لا اعتبار له عند المحققين ، فإنهم متى ذكروا الاتفاق ، فإنما يعنون اتفاق الحكماء معهم ، لأنهم يوافقون الحكماء فيما يستقل العقل النظري بإدراكه في طوره . ثم يتميّزون عنهم بمدارك واطلاعات أخرى خارجة عن طور الفكر وأحكامه التقييدية ، كما سبقت الإشارة إليه . وأما المتكلمون على اختلاف طبقاتهم ، فإنّ المحقّقين لا يوافقونهم إلا في النادر في مسائل يسيرة .
وأما ما ذكره - أبقاه اللّه - في الاسم المطلق على كل حقيقة مشتركة وأنها تختلف بكونها في شيء أقوى أو أقدم أو أشدّ أو أولى ، فكل ذلك عند المحقّق راجع إلى الظهور دون تعدد واقع في الحقيقة الظاهرة ، أيّ حقيقة كانت من علم ووجود وغيرهما . فقابل يستعد لظهور الحقيقة من حيث هو أتمّ منه من حيث ظهوره في قابل آخر وبه ، مع أنّ الحقيقة واحدة في الكل . والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهوراتها بحسب الأمر المظهر المقتضي تعيّن تلك الحقيقة من حيث هو تعيّنا وظهورا مخالفا لتعيّنه في أمر آخر . فلا تعدّد في الحقيقة من حيث هي ولا تجزئة ولا تبعيض .
وأما ما رسم من أنه ليس لقائل أن يقول : لو كان الضوء والعلم يقتضيان زوال العشيّ لكان كل ضوء وعلم كذلك ، فصحيح لو لم يقصد به الحكم بالاختلاف في الحقيقة ، فإنّ الضوء من كونه ضوءا حقيقة واحدة ، لكنه قد يكون من مقتضى حقيقته إزالة العشي بشرط تعيّن خاص به وظهور في أمر ما على وجه ما ، لا أنه يؤثر هذا الأثر حيث ظهر .
وأما ما أشار إليه - حفظه اللّه - في معرفة النفس من أنّ معرفتها بديهية والاستدلال بما ذكر في « الإشارات » أنّ المشار إليه بقول القائل "أنا" ليس غير النفس ؟ ؟ ؟ ففيه نظر ، لأن الصعوبة ليست في معرفة أنّ ثمة أمرا وراء البدن مدبّرا له هو المسمّى نفسا ، بل الذي يعسر جدّا هو معرفة ما حقيقة ذلك الأمر المدبّر .
ولا شك في أنّ معرفة كنهه ليس ببديهي . وأيضا ، فإنّ الإنسان من حيث ظاهره وباطنه وقواه وصفاته متكثّر ونسخة وجوده متحصلة من أمور مختلفة تجمعها أحديّة كثرة . وهكذا كلّ جملة ، فإنها متحصّلة من أفراد تجمعها وحدة تلك الجملة . فالأفراد كالفروع لتلك الجملة . فالإضافات والإشارات قد تكون من بعض الأفراد إلى البعض ، وسيّما من حيث أمّهات الأمور التي تشتمل عليها ذاته ، كالوجود ، أو كماهيّته التي عرض لها الوجود ، أو كمعنى إنسانيته أو حيوانيته أو صورته الطبيعية العنصرية . وقد تكون الإشارة والإضافة من البعض إلى الجملة من حيث أحديّتها فيما يتحقّق أنّ هدف الإشارة في « أنا » ومرجع الإضافة في قول القائل « نفسي وبدني وروحي » وغير ذلك هو إلى أمر مفارق يسمّى نفسا . بل إنما يعرف من هذا أنّ ثمّة مضافا إليه ممتازا عن المضاف فيعرف المضاف إليه من كونه مضافا إليه فحسب . وأما أنه يعرف من هذا كنه المضاف إليه وماهيته ، فغير مسلّم هذا وإن كان المحقّقون متفقين على وجود نفس مفارقة باقية غير البدن ، لكن الكلام في إثباتها بطريق البرهان هل هو متيسّر أم لا ؟
ثم نقول : العلم بالوجود والنفس والعلم ونحو ذلك من الأمور التي كثر البحث فيها بأنها شيء ما غير ، وبأنها ما هي على التعيين والتحقيق شيء آخر . والظاهر الجليّ إنما هو معرفة كون كل منها شيئا ما وأنها ليست أمورا عدميّة . وليست الصعوبة في معرفتها بهذا الاعتبار ، كما مرّ .
وإنما الصعب معرفتها بالاعتبار الثاني ، وهو معرفة حقائقها المعرفة التامة المحقّقة التي لا ريب فيها . فأما بالبرهان أو ما قام مقامه ، فقول من يقول ، إنّ العلم بوجودي أو بالوجود أو بنفسي أو بالعلم بديهي ، وإنّه لغاية الوضوح يتعذر تعريفه أو إقامة البرهان عليه ، ليس بقول سادّ ، فإنّ الواضح البديهيّ إنما هي المعرفة الأولى بالاعتبار الأول ولا كلام فيها .
فإنّ من عنده أدنى عقل لا ينازع في ذلك ولا يرتاب . ولكن الصعب إنما هو المعرفة الثانية بالاعتبار الآخر المذكور آنفا أعني معرفة كلّ ما ذكرنا من حيث حقيقته المتميّزة بذاتها عن غيرها . ولا شك في صعوبتها . ولهذا كثر اضطراب الناس فيها ، واختلفت آراؤهم ، واشتدّت حيرتهم . فلو كانت معرفة حقيقة العلم والوجود والنفس ونحو ذلك كما زعم القائلون بديهية ، لما وقعت حيرة ولا حصل نزاع ، لأنّ البديهيّ ما لا نزاع فيه . وهذا ليس كذلك ، فليس ببديهي .
وأما ما قرره - نفع اللّه به - في بقاء الأفلاك وشأن الفلك المحدّد الذي به تعيّن الزمان ، فصحيح ، لكن في حق الفلك الأعظم . والكلام في الأفلاك السبعة هل هي قابلة للكون والفساد كما أخبرت عن ذلك طائفة من الحكماء والأنبياء والكمّل قاطبة أم لا ؟ وأما ما رسمه في شأن بقية الأفلاك أنها خالية عن طبائع العنصريات ، لأنها لو كانت على طبائعها ، لكانت أمكنتها وحركاته قسرية ، والقسري لا يدوم ، وبانقطاعها يلزم المحال المذكور ، فيه نظر ، فإنّ المحال المذكور إنما يلزم في شأن الفلك الأول . ولا خلاف بين المحققين من أهل الأذواق والمحققين من المتشرعين أنه دائم البقاء . وكذلك الفلك المكوكب ، فإنهما عندهم ليسا من الطبيعة العنصرية في شيء ، بخلاف الأفلاك السبعة . ويلتزمون أنّ حركاتها قسرية وأنها لا تدوم . فوجب الدفع بالبرهان . وأيضا فقد يقال إنه لم يستحيل دوام الحركة القسرية إذا كان القاسر دائم الوجود ، وفي المقسور قابلية الأثر منه ؟ فإنه لا موجب للتناهي على هذا التقدير ، لأن المشهود من تناهي الحركة القسرية إنما موجبه تناهي قوة القاسر . فمتى فرض عدم تناهي قوّته مع قابلية المقسور ، لم يتعذر الدوام . وكيف لا ومن المعلوم أنّ في الفلك الأعظم قوة قاسرة سارية الحكم في بقية الأفلاك هي طبيعة له . والأفلاك عندهم أبدية .
فأثر هذا القسر من القاسر أبدي . وقبول المقسور له قبول أبدي والسلام .
وأما قوله : الزمان لا يحيط إلا بما تحيط به الأفلاك فثبوت هذا موقوف على بيان أنّ الزمان عبارة عن الحركة الفلكية أو هو متعيّن بها . وغير خاف على العلم الشريف ما ذكروا في ذلك من المباحث المختلفة . وقد اختار جماعة من محصّلي علوم الحكمة ، منهم أفلاطون ، في أنّ الزمان عبارة عن حقيقة معقولة سابقة المرتبة على الأفلاك ، فلا بدّ من إقامة البرهان على توقّف تعيّن الزمان ووجوده على الحركة الفلكية . ولهذا البحث أيضا مدخل فيما أشار إليه في أمر الأفلاك وبقائها الدائم .
وأما قوله - أبقاه اللّه - بناء على ما تقدم من البحث : فلو كانت للنفس نشآت أخر بين هذه الأفلاك ، لكان ذلك تناسخا ، فيه نظر ، فإنّ التناسخ الذي أبطل إنما هو في هذا العالم وبشرط حصول مثل هذه النشأة العنصرية . فأما كون النفس مدبّرة لصورة أو صور أخرى في عالم آخرى خارج عن عالم الكون والفساد ، فلا برهان عليه . ومن ادّعى استحالته ، لزمه إقامة برهان آخر على ذلك .
وقوله أيضا - حفظه اللّه - : إن لم تكن تلك الصور التي تدبّرها النفس بعد المفارقة بين الأفلاك ، لم يكن لها استكمال ، لا برهان عليه ، سيّما والأكثرون من المتشرعين والعقلاء على أنه لا استكمال بعد الموت من حيث الأعمال والصفات والعلوم الكلية ، سوى تفصيل ما تقدم تحصيله في هذه النشأة . ونحن لا ندعي أنّ تدبر ؟ ؟ ؟ النفس لتلك الصور هو لطلب الاستكمال بقصد معيّن . بل ذلك يحصل بالذات دون تعمّل .
وأما ما أشار إليه - أبقاه اللّه - في تعذر تدبير النفس الصور المتعددة في الوقت الواحد لتوقّف ذلك على الشعور ، فالخصم يدّعي أنّ الشعور حاصل لها ، ولا يلتزم أيضاً أنّ تدبيرها محصور في الصور والأبدان العنصرية حتى يجب أن تكون على هذا الوجه .
وأما ما ذكره - حفظه اللّه - في معرض قولنا : « إنّ النفس قد ترقى إلى أن تصير كلّية » من أنّ ذلك محال ، فموجبه مفهوم أنّ المراد منه الاتحاد المقتضي تصيير الذاتين ذاتا واحدة . ونحن لم نرد به ذلك ولا أنها من كونها جزئية تتّحد بالنفس الكلية . فيستنكر على المحقّق ما ذكره من أنه مفروع عنه أجزاء العالم .
وإنما نعني بذلك أنها ترقى من جزئيّتها وتنسلخ من أوصافها التقييدية العارضة التي لأجلها سمّيت جزئية ، فتعود إلى كلّيّتها الأصلية . فيصدق عليها من الأوصاف ثانيا ما كان يصدق عليها أوّلا بالاتصال الحاصل وزوال العارض . وحينئذ لا تكون أجزاء العالم مفروغة عنها .
وأما قوله - نفع اللّه به - في ارتقاء النفوس الكاملة وحصول مشاهدة المبدأ الأول ، فأمر يحصل لها في ذواتها الجزئية ، فيه نظر ، لأن ذواتها الجزئية من حيث جزئيتها محال أن تشاهد المبدأ الأول . وهذا متّفق عليه عند أهل الشهود من أرباب هذا الشأن أنهم لا يشاهدون كليّا ما حتى يصيرون [ كذا ] كذلك .
ثم يزدادون ترقّيا باتصالهم بالكليات على الوجه المذكور في أمر المعراج ، طبقة بعد طبقة مستفيدين من كل اتصال استعدادا وجوديا ونورا وبصيرة ، هكذا حتى ينتهوا إلى العقل الأول . فيستفيدون من الاتصال به ما يستعدون بذلك لمشاهدة المبدأ ، كما هو شأن العقل الأول على ما مرّ .
وأما قوله - حفظه اللّه : إنّ الانسلاخ واجب ، لكن لا بإرادة النفس ، كما لم يكن الارتباط بإرادتها ، بل إذا فسد المزاج ، انسلخت عنه ، فيه نظر ، فإنه لا يلزم منه أنه إذا كان الارتباط أولا لا بإرادة أن يكون كلّ انسلاخ بغير إرادة . فإنا قد رأينا غير واحد من أهل اللّه قادرا على الانسلاخ متى شاء . وكذلك رأينا غير واحد منهم قصد الموت وأخبر باختياره له ومات من حينه دون مرض ولا فساد مزاج . بل أخبرني شيخي الإمام الأكمل - رضي اللّه عنه - مشيرا إلى حاله بأنّ ثمّة من يكون مدبّرا لأجزاء بدنه قبل اجتماعها بعلم وشعور ، وذلك لكلّيّة نفسه ، إذ من تكون نفسه جزئية ، يستحيل عليه ذلك ، لأن النفوس الجزئية لا ؟ ؟ ؟ إلا بعد المزاج و ؟ ؟ ؟ ، ؟ ؟ ؟ و ؟ ؟ ؟ لها قبل ذلك حتى يتأتّى لها تدبير الأجزاء البدنية بعلم وشعور . فدلّت هذه الأمور الواقعة أنّ الحكم باستحالة ذلك لا تتمّ إقامة البرهان عليه ، إذ لو كان كذلك ، لما وقع في الوجود ما حكم البرهان الصحيح باستحالة وقوعه . فظهر من هذا أنّ الموجب لمثل هذا الحكم الاستبعاد العادي ونحوه .
وأما ما ذكره - حفظه اللّه - في أمر اللذة والابتهاج ونسبتهما إلى الحق بمعنى الملاءمة ، ففيه نظر أيضا ، لأن الملاءمة إنما تكون بين شيئين يلائم كل منهما الأخر من حيثها . والحق واحد من جميع الوجوه . فإدراكه سبحانه لذاته عين ذاته . فيلائم ما ذا وليس إلا هو ؟ فكيف يقال : إنه لا يكون لذاته ملايم أشدّ ملاءمة من نفس حقيقتها هذا مع الاعتراف بأنّ لا تعدّد هناك أصلا ؟
وأما ما ذكره في الفيض ، فلقائل أن يقول فيه : إذا كان الفيض الصادر من الحق أمرا موجودا فلا يخلو إما أن يكون ممكنا أو واجبا . فإن كان ممكنا ، فوجوده موقوف على فيض آخر ويتسلسل . وإن كان الواجب لزم منه محال ، لأن ذلك يقتضي بأن يكون واجب الوجود عارضا للمكنات . وليس أمر آخر غير الواجب والممكن ، كما مرّ بيانه . والعدم المحض لا ينقلب وجودا ، فإنه يلزم منه قلب الحقائق وإنه محال . وأيضا فالعدم لا يكون محلا للتأثير فيه وقبول الإيجاد من الموجد . فكيف الأمر ؟
ثم أقول : وكان من شرط الأدب الاقتصار على فوائد مولانا - نفع اللّه به - لكن ربما أوهم أنّ الموجب لذلك إهمال ما . فذكر الداعي هذه الإلماعات حبّا في استدامة المفاوضة المولوية والاستزادة من فوائده . وما سكت عنه ولم يذكر عليه شيئا فسببه أحد أمرين ، إما لأنّ البحث فيه يحتاج إلى فضل بسط يفضي إلى التطويل والإبرام ، وإما الاستشراف الداعي على كمال التحرير المولوي وتقريره ووجوب الوقوف عند ذلك لحصول الرأي الذي لا يبقي احتياجا إلى مزيد بيان .
واللّه سبحانه يزيل بنور إرشاده ظلم الشكوك الدوامس ويبقيه ركنا يلجأ إليه ويعوّل في كشف كل معضلة عليه . والسلام معاد عليه ورحمة اللّه . وحسبنا اللّه ونعم الوكيل .